ارتبط ظهور روابط أو منظمات الضحايا عام 2016 بمنظمات المجتمع المدني بشكل أو بآخر، سواء عن طريق دعم منظمات المجتمع المدني لعملية التأسيس، أو اعتباراً منها؛ أو عن طريق كون هذه الروابط في أصل برامج منبثقة عن منظمات مجتمع مدني، استقلت عنها فيما بعد؛ أو أشكال أخرى عديدة من العلاقات. تواتر ظهور روابط الضحايا في السنوات الأربع الماضية، وارتفع عدد هذه المجموعات في العامين الأخيرين. ولذلك، تدعو هذه التطورات لمراجعة التساؤلات حول العلاقة التي تربط روابط الضحايا بمنظمات المجتمع المدني، وأشكال المقاربات التي يتبنونها في عملهم معاً وعلى القضية. من خلال هذا الحوار المزدوج مع آمنة خولاني، إحدى مؤسسات حركة عائلات من أجل الحرية ومنسقتها العامة؛ وسلمى كحّالة، المديرة التنفيذية لمنظمة دولتي، وهي واحدة من ثلاث منظمات تشكل «فريق الدعم» للحركة، نقترب من نموذج مهم وفاعل في الشأن العام السوري لهذا النمط من العلاقات بين منظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا، والتحديات والعوائق التي تواجه هذا العمل، وكيفية إدارة التوترات الممكنة. وقد تكون المفارقة ما بين الحاجة لخلق رموز -أفراد فاعلين كاريزماتيين- مقابل الحاجة لخلق حركات أفقية، أكثر جماعية وتشاركية، أحد أهم هذه التوترات.
عُلا: آمنة خولاني، تُوصَفين بأنك من أكثر المناضلات شراسةً في الدفاع عن المعتقلين والمعتقلات والمختفين قسرياً، وأنتِ مؤسِّسةٌ ضمن حركة عائلات من أجل الحرية. ما الذي دفعك للقيام بذلك؟ وما الذي يدفعك للاستمرار؟
آمنة: شخصياً، كان لدي تجربة قديمة مع النضال المدني وما نتج عنه من استدعاء أمني واعتقال. في عام 2001 قمنا، مجموعة من شباب وصبايا داريا، بفتح مركز ثقافي صغير أسميناه سُبُل السلام، وخلال أيام جرى إغلاق المركز واستدعاؤنا للتحقيق، واعتقال الأستاذ عبد الأكرم السقا وهو مفكر سوري إسلامي تنويري. هذه المجموعة عُرفت فيما بعد باسم مجموعة شباب داريا (2003)، كررنا فيها تجربة النضال المدني وقمنا بحملةٍ أطلقنا عليها اسم «حتى يغيّروا ما بأنفسهم». تضمّنت هذه الحملة نشاطات عديدة؛ مثل مظاهرة صامتة وتوزيع منشورات لمحاربة الرشوة وكنس شوارع داريا. على إثرها، جرى استدعاؤنا جميعاً للأمن، وكان زوجي وأخي محمد، الذي استُشهد فيما بعد في المعتقل، مشاركين أيضاً في الحملة. تم تحويل الرجال منّا إلى محكمة ميدانية عسكرية وحُكموا في سجن صيدنايا: تخيلي أنّ أناساً كنسوا الشوارع يُحوَّلون إلى محكمة ميدانية… أمر غير قابل للتصديق.
عانيتُ منذ ذلك الوقت من الاعتقال على المستوى النفسي والحياتي، فقد كان أولادي صغاراً؛ ابني هادي كان عمره شهراً واحداً، ولم يبقَ فرع أمن إلا وقام باستدعائنا أنا وصديقاتي. لم يُسمح لنا بزيارة زوجي وأخي وأستاذي وأصدقائي في صيدنايا، وكنا نحصل على معلومات تخصهم من هنا وهناك. لقد سلكنا الطريقَين الممكنَين في تلك المرحلة: كما تعلمين، يلجأ الأهالي في سوريا إلى الواسطة أو الرشوة لمعرفة أخبار أولادهم المعتقلين، وذلك نتيجة معرفتهم بعدم وجود طريق قانوني يمكن أن يسلكوه، ويترافق ذلك مع خوفٍ شديد لأنّ أحداث الثمانينات ظلت حاضرة دائماً في الذاكرة. وفي حين لجأ بعض الأهالي إلى الواسطات، اخترنا، نحن مجموعة النساء المتبقيات وحيدات بعد اعتقال جميع الرجال، اللجوء إلى الطريق الحقوقي. في ذلك الوقت كانت المرة الأولى التي نسمع بها بحقوق الإنسان في سوريا، وتواصلنا للمرة الأولى مع رزان زيتونة (الله يفرج عنها وين ما كانت). حُكِمَ بعضهم أربع سنوات قضوا منها سنة واحدة، منهم زوجي، بينما حُكِمَ آخرون سبع سنوات قضوا منها سنتان ونصف، منهم يحيى شربجي. واعتقدنا أن الضغط والحشد الذي قمنا به أتى بنتيجة. لم أكن أعلم ماذا تعني «المناصرة» في ذلك الوقت، ولكن كنت مع صديقاتي مُصرّاتٍ على ألّا نسكت، فبدأنا بالتواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية مثل أمنستي (منظمة العفو الدولية) وغيرها، وكنا نقف أمام الأفرع الأمنية لنسأل عنهم و ننتظر جالساتٍ على الأرض. كنا نتعب في تلك المرحلة. علمنا وقتها أن هناك شيئاً اسمه «كوة رئاسية» في مكتب البريد في ساحة الحجاز بدمشق، وأن الرسائل فيها تصل للمكتب الرئاسي، فصرنا نذهب ونضع رسالة في هذا البريد كل أسبوع، نطالب فيها بزيارة أحبتنا وإطلاق سراحهم. وتوقفت بعض صديقاتي عن متابعة هذا الأمر بسبب الضغط المجتمعي، أو ضغط الأهل الخائفين من اعتقال بناتهن. أنا بدوري لم أتوقف، وهو ما جعلني أدفع ثمناً إضافياً؛ حيث جرى استدعائي مجدداً للاعتقال، ولكنّ تدخّلَ الكثير من المعارف، فاكتفوا باستجوابي لمدة شهر في فرع فلسطين. أعرف أنني أستطردُ في شرح هذه التفاصيل، لكنَّ جميعها في ذاكرتي، وهي من بين دوافعي للاستمرار.

بعد انطلاق الثورة بأشهر اعتُقل أستاذي عبد الأكرم السقا مجدداً، وبعدها بعدة أشهر تم استدعائي، ومن ثمّ جرى اعتقال إخوتي عبد ومجد، وكذلك اعتُقل يحيى شربجي وهو بالنسبة لي الأخ والصديق والقريب (وصلتنا منذ سنتين شهادة وفاتهم وأنه تم إعدام ثلاثتهم في سجن صيدنايا). تابعنا في الثورة ولازمني هاجس الاعتقال، وكنت أقرأ عن المعتقلات وأجهّز نفسي لمصيرٍ مشابه. قبل مشاركتي في أي مظاهرة أخلع خاتمي وسواري، وأقول لنفسي: «يصرفوهن ولادي بدل ما ياخدوهن الأمن». كذلك كنت ألبس طبقات من الثياب؛ فالمُعتقَل بارد، وأملأ جيوبي بالمحارم والفوط، كما أني لم أكن أضع دبوساً في إيشاربي، حتى لا ينغرز الدبوس في رقبتي في حال تعرضت للضرب. تفاصيل صغيرة لكن لا تغيب عن بالي أبداً. كنتُ أقول لأطفالي عندما أخرج لأي نشاط ثوري (أنا ما عم اطلع واترككم لانو ما بحبكم، بالعكس لأني بحبكم كتير لازم اطلع، لأني ما بتحمل يجي مستقبلكم وسوريا مزرعة الأسد).
اعتقل أَخَويّ الآخران، بلال ومحمد. هم لم يشاركوا في الحراك؛ ليس لعدم رغبتهم، ولكن تحت إلحاح والدي. كان يقول لهم: آمنة وعبد ومجد بالحراك… «خليكون بعاد شوي لحسّ فيه حدا جبني». أتانا بلال بخروجه من المعتقل بالخبر المفجع، استشهد محمد تحت التعذيب أمامه. محمد صديقي ورفيقي وليس فقط أخي، رفيق النضال في 2003 حين استدعينا إلى الأمن معاً. محمد من طلاب جودت سعيد وعبد الأكرم السقا حامل للفكر السلمي حينها. «انطفى كل شي بحياتي، استشهاد محمد طفى كل شي». روى لنا بلال كيف استشهد محمد، وهذا الألم هو ألمٌ أَختصُّ به نفسي. خرج بلال من المعتقل «جثةً تمشي». هل رأيتِ صور قيصر؟ تخيلي أنّ منظر بلال كان يشبه الضحايا في هذه الصور. هو بخير الآن… «انكتبلو عمر جديد». أنا الكبرى بين إخوتي، وحين يتحدثون عن أهمية دعم النساء أشعر بالفخر لأن الرجال في عائلتي هم أكثر الداعمين لي منذ طفولتي، أبي وأخوتي ولاحقاً زوجي.
في إحدى المرات قال لي أخي مجد في المظاهرة وأنا أهتف: «إذا بدك أنا بحملك على كتافي». كانوا بحق سنداً لي في النضال.
اعتُقِلتُ أنا وزوجي سوية، لم أتوقع أن أُعتقَلَ وزوجي في اللحظة نفسها وفي السيارة نفسها. ولكنهم عيشوني في رعبٍ آخر حين ضربوا زوجي أمامي. لقد ضربوه بشدة، وحينها كنت مستعدةً لأي شي «شو بدك بقول». لجأ المحقق إلى طريقةٍ أخرى، سألني: «هل تحبين زوجك؟». لم أفهم لماذا يسأل، ولكني قلت له «نعم». وبعد إجابتي بنعم أحضروه وشرعوا في تعذيبه أمامي. اكتشفتُ لاحقا أنهم اتّبعوا الطريقة نفسها معه. بقيتُ ستة أشهر في المعتقل، وبقي زوجي مدة سنتين ونصف. يوم خروجي من المعتقل، قرأوا الأسماء على الباب، كان اسمي واسم رويدة كنعان بين أسماء المُفرَج عنهنّ، بكينا لأننا سنخرج ونترك كل أولئك النساء وراءنا. كلهنّ متهمات بتهم سياسية أو بتهم «إرهاب»، بعضهنّ لم يكن لهنّ علاقة بأي شيء، ولكنهن أُخذن بدلاً من شخصٍ آخر. شعرتُ وأنا أتركهنّ بإحساسٍ كبيرٍ بالخيانة، ووعدتهنَ أن أكون صوتهنّ؛ ألا أسكت… «لا تسامحوني إذا نسيتكن»، وخرجتُ بعدها مدفوعةً بإيماني بالحرية والعدالة. نحن خرجنا إلى الشوارع لننادي بالحرية، وسوريا الحرة لا تكون حرةً بالمعتقلات.
أنا إنسانة مؤمنة، وأؤمن أن الله سبحانه وتعالى خلقني لأقوم بشيءٍ ذي قيمة على هذه الأرض. هذه القيمة لا تكون بالجلوس في البيت؛ إيماني يدفعني للوقوف في وجه الظلم والمطالبة بالعدالة لكل السوريين.
عُلا: سلمى كحّالة، أنتِ مؤسسة ومديرة دولتي. تعملين مع منظمات معنية بالضحايا منذ العام 2016، ومن الداعمات الراديكاليات. ما الذي دفعك للانخراط في هذا العمل؟ لماذا المنظمات المعنية بشؤون الضحايا؟
سلمى: من الصعب الحديث بعد آمنة. آمنتُ منذ صغري بالعدالة، وكان دائماً لدي ما يُسمى righteous anger؛ الغضب للحق، يعني مشاعر الغضب على سوء المعاملة والظلم واللا عدالة، مدفوعةً برغبة التغيير، لا يمكن أن نرى الظلم دون أن نقوم بفعل تغييري. ليس لدي الإيمان العقائدي أو الديني الموجود عند آمنة نفسه، لكن طبعاً لدي إيمان له طبيعة مختلفة: إيمان بأننا إن لم نعمل على التغيير فنحن جزء من المشكلة؛ إيمان بالبشرية وبقدرة البشر على الخير وعلى التغيير. منذ تركتُ سوريا وغادرتُ إلى كندا كنت منخرطة في العمل السياسي وفي السعي نحو العدالة كطالبة وكامرأة، وحين انتهيتُ من جامعتي شعرتُ بأنني، أجل… أعملُ على حقوق الإنسان والنساء ومع الطلاب وغيرهم، ولكن أريد أن أقوم بهذا الفعل في بلدي. عدتُ إلى سوريا وحاولتُ منذ العام 2004، ولكن لم أجد طريقة أكون من خلالها جزءاً من مشروع تغييري. لم تُتَح لي هذه الفرصة، وربما لم تكن موجودة حينها. لكن بعد انطلاقة الثورة انخرطت في العمل، مع مجموعة من الفاعلين والفاعلات الذين شعرت أنهم يشاركوني المبادئ والأفكار، ضمن دولتي ومعك أنت علا ومع آخرين. هنا أريد أن أقول شيئين؛ أولهما أنني أشعر بامتيازاتي؛ بمعنى كان لدي خيار، أو خيارات أخرى، ولكنّ إيماني بالقضية يدفعني للاستمرار، وآمنة لديها خيار طبعاً، والخيارات أمامها موجودة، ولكنها دائماً تقوم باختيار استكمال طريق العمل النضالي.
عُلا: أعتقد أنه من المهم الحديث عن الامتيازات التي نمتلكها كأشخاص فاعلين في الشأن العام، ربما الاعتراف بهذه الامتيازات ضمن السياقات التي نعمل فيها مهم، فعادةً ما نحمّل أنفسنا عبء هذه الامتيازات، ولكن بالمقابل قد نتمكن من استخدم هذه الامتيازات لخدمة القضية والسعي نحو العدالة.
سلمى: أنا واعية لهذه الامتيازات، وكيف يمكنني أن أستخدمها لدعم أهل القضية مثل آمنة، لكن هم في وجه المدفع والمتأثرون المباشرون، ولهذا دور كبير في تساؤلاتي حول دوري في هذا النضال وعلاقتي بالضحايا وأهل القضية، فهي إلى حد كبير مرتبطة بتجربتي وامتيازاتي ووعيي لموقعيتي.
عُلا: سلمى وآمنة، كيف بدأتنَّ العمل معاً، وكيف تطورت هذه العلاقة؟
سلمى: اجتمعتُ مع ماريا العبدة، مديرة النساء الآن، وزميلتها آنّا، وكان حديثهنّ عن أصوات النساء غير المسموعة، وعن الفجوة الكبيرة بين واقع النساء وما يحكى عن دورهن في السلام والعدالة، كما ذكرنَ أهمية وأولوية قضية الاعتقال والاختفاء بالنسبة للنساء اللواتي يعملنَ معهن. فطرحوا فكرة العمل معنا كـ دولتي باعتبار أن لدينا خبرة في مجال العدالة الانتقالية، وكنّا حينها قد بدأنا العمل مع الشباب على التاريخ الشفوي. اتفقنا على البدء بجمع قصص وشهادات النساء من ذوي المعتقلين والمختفين قسرياً، وعلى تطوير أدوات برامجية ومناصراتيّة لنقل قصصهم وتجربتهم وبناء وعي عام حول القضية. أول نشاط قمنا به هو ورشة في لبنان شاركت فيها نساء ممن شاركنَ معنا قصصهنّ، أو ممن قمنَ بإجراء المقابلات، وفاعلات في المجتمع المدني. بدأنا ورشتنا بسماع تسجيلات صوتية لبعض القصص، كانت حملة من أجل سوريا، وبالأخص بيسان فقيه، هم الذين أدركوا مدى قوة هؤلاء النساء كمُناصِرات؛ هنّ محاميات القضية وهنّ من يقدرن على اختراق الوعي العام.
آمنة: حتى حينها كان هناك فكرة حاضرة بأننا نرغب بمحاربة النسيان وحفظ الذاكرة، بالذات قضية المعتقلين والمعتقلات، فعادةً ما يتم استدعاء ذوي المعتقلين أو الناجين والناجيات كشهود، يتم التعامل معهم على أنهم شهود وينتهي دورهم هنا، وبذلك لا يكونون أصحاب قرار، كما لا يتم التحدّث عن معاناة الأهالي، وبالتالي هم من عليهم إيصال هذه المعاناة والحديث عنها.
سلمى: نشاطنا الثاني كان رحلة مناصرة إلى جنيف تزامنت مع المفاوضات حينها؛ مجموعة من النساء من بينهم آمنة، كان من المهم أن يجلسوا كذوي معتقلين معاً. خرج كامل فريق الدعم من الغرفة، وأذكر أنّ الجلسة لم تستغرق أكثر من ساعة حتى خرجت المشاركات بورقة واضحة توضح من هنّ، ورقة أهداف ومطالب واضحة.
آمنة: كنا خمس سيدات، بعضنا تلتقي الأخرى للمرة الأولى، ومن خلفيات سياسية واجتماعية متنوعة، وبالرغم من ذلك كان لدينا القدرة على الاتفاق وتحديد أولوياتنا ومطالبنا.
سلمى: بينما كُنتنَّ في الداخل، كُنّا بوصفنا فريق الدعم نخوض نقاشاتنا في الخارج مُلهَمين بأصواتكنّ. قررنا حينها أن نكون مجموعة دعم راديكالية؛ أنتنَّ أصحاب القضية وأنتنَّ من يقودها ونحن نقدّم كامل الدعم لإيصال صوتكن. أنتن البوصلة لعملنا. في اليوم الثاني التقينا بديمستورا قبل بداية المفاوضات، أذكر حينها كلامه، قال: «هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها أحد بهذه المطالب بهذا الوضوح والعملية». لاحقاً قال لي أحد العاملين في مكتب المبعوث الخاص: «أنا أعلم أنكم في فريق الدعم من قمتم بالصياغة والكتابة عنهم». قلة إيمان وثقة، وكأنّ دورنا هو تلميعهم، هم دمى ونحن نحركهم ونقول لهم ماذا يقولون. أذكر هذا المثال لأقول بأنّ هناك نظرة مشابهة من الكثيرين لأهل القضية، أو أننا نُحضِرهم ولكن نقول لهم ما عليهم قوله. ومن هنا تأتي راديكاليتنا، هم البوصلة التي تدلّنا إلى أين علينا التوجه، ودورنا يكون من خلال دعمهم بخبرتنا؛ بشبكاتنا وبتقديم الدعم اللوجستي. هكذا خُلقت ديناميكيات العمل بين عائلات من أجل الحرية وفريق الدعم المكون من ممثلين من دولتي والنساء الآن و حملة من أجل سوريا؛ علاقة قائمة على الثقة والإيمان وما زالت.
عُلا: حين التفكّر في تلك الجلسة التي ذكرتها سلمى، وفي محاولة لتفكيك العوامل التي ساعدت أو دفعتك للوصول إلى ورقة واضحة المطالب بالرغم من اختلافاتكم السياسية، كما وصفتِها، فضلاً عن عدم معرفتكنّ السابقة ببعضكنّ بعضاً؛ كيف تجاوزتنّ اختلافاتكنّ، وما الذي ساعد في ذلك؟
آمنة: العامل الأساسي هو اتفاقنا على الهدف الكبير البعيد المقدس بالنسبة لنا جميعاً. بالتأكيد اختلفنا على بعض القضايا، ولكن ما يجمعنا أكبر من اختلافاتنا، على الأقل في هذه المرحلة. كان حاضراً دوماً بالنسبة لي (وأعتقد لدى بقية المجموعة كذلك) سؤال: هل هذا التفصيل الذي نختلف عليه مهم في سبيل إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات أم لا؟ هذا كان معيارنا. بالنسبة لي جميع الناس الذين طالبوا بالحرية والعدالة والديمقراطية على امتداد الساحة الجغرافية والفكرية، وكل من يؤمن بدولة المواطنة، هم معي في المركب نفسه؛ مُركَّب قيمي وأخلاقي يجمعنا كلنا ضد الظلم والطغيان،( مع وجود الاختلاف الفكري والسياسي، ولكن يجب تأجيل هذه الاختلافات حتى تقف المذبحة السورية، وبعدها لكل حادث حديث). ناهيكِ عن الارتباط العاطفي الشديد الذي يجمعنا كذوي المعتقلين والمغيبين قسرياً، والذي كان واضحاً في ذلك اللقاء، وما زال حاضراً إلى اليوم.
عُلا: مرّت أكثر من أربع سنوات على تأسيس حركة عائلات من أجل الحرية. بالنظر لهذه السنوات، ما هي التحديات التي واجهتكن، وكيف تعاملتن مع هذه التحديات؟ وهل يمكن وصف الحركة على أنها حركة غير متجانسة بالنظر إلى الخلفيات المتنوعة للمشاركات فيها؟
آمنة: لا أحبذ استخدام كلمة غير متجانسة. نعم، لدينا اختلاف في خلفياتنا السياسية والفكرية، وهذا شيء صحي وضروري. تجمعنا قضية إنسانية، وبالتالي أي اختلاف غير قيمي وأخلاقي يمكن تجاوزه. على العكس، منذ لقائنا الأول تعاملنا مع اختلافنا على أنه عنصر قوة، وسعينا إلى أن يكون الاختلاف حاضراً في الحركة، لا بل أن يصبح شكلاً نمطياً للحركة. قمنا بدعوة سيدات وصبايا من خلفيات مختلفة، إلى درجة أننا قمنا بدعوة مواليات ممن لديهن معتقلون من ذويهم لدى فصائل مُعارِضَة. طبعاً لم تنضم أيّ منهن، ولكنّ الباب كان مفتوحاً. تذكر سلمى ربما أننا في البداية اختلفنا على رؤى سياسة، ولكن كنا نقف عند حد معين لكي لا يتحول الاختلاف إلى خلاف. توجد ديناميكيات ضمن المجموعة خُلقت مع الوقت للتعامل مع التنوع الموجود ضمن الحركة، وكان لفريق الدعم دورٌ إيجابيٌّ هنا. تشكلت لدينا قناعة أيضاً بأنّ فريق الدعم يعمل من أجل القضية، وليس مجرد مشروع للحصول على التمويل.
عُلا: ركّزتِ، آمنة، على الجانب القيمي والأخلاقي كعامل أساسي لتفادي الخلافات، وعلى الجامع بينكنّ في الحركة. بالنسبة لكِ سلمى، كيف ترين الموضوع؟ وهل العامل القيمي حاضر في عملكم كمنظمات مجتمع مدني داعمة لمنظمات الدفاع عن الضحايا؟
سلمى: بالنسبة لنا كمجموعة دعم وكمنظمات فردية، نؤمن دائماً أن دعمنا لعائلات من أجل الحرية هو جزء من مسؤوليتنا الأساسية تجاه دعم قضية المعتقلين والمعتقلات ودعم عائلاتهم، خاصة النساء. إذا كان لدينا توتر داخل المجموعة أو داخل منظماتنا أو مع الجهات المانحة أو العائلات، فإننا دائماً ما نذكّر بعضنا البعض بأن ما نحن مسؤولون عنه هو دعم هذه القضية وهؤلاء النساء، وأن ننظر للقضية من هذا المنظور. فقد ساعدَنَا التركيز على مهمتنا الكبرى، والابتعاد قليلاً عن المشاكل اليومية والسياسات التنظيمية وبيروقراطية الجهة الممولة، على تخطى العديد من المواقف الصعبة. بالتأكيد ليس بالأمر السهل العمل ضمن تحالف؛ كمجموعة دعم مشكلة من تحالف ثلاث منظمات لدينا درجات مختلفة من الخبرة والانفتاح على الشراكات. العامل القيمي مهم جداً في تحالفنا، وتَمكَّنا ليس فقط من البناء على العامل القيمي، وإنما من العمل على مقاربتنا، وعلى كيفية رؤيتنا لدورنا. ساهم في ذلك الثقة الموجودة بيننا كمنظمات، والتي تشكلت عبر شراكات سابقة لعملنا كمجموعة دعم؛ مثل حملة كوكب سوريا وغيرها. ومن خلالنا تحالفاتنا السابقة تَمكَّنا من بناء ثقافة مشتركة. بُنيت هذه الثقافة على الشفافية والحوار، خُضنا الكثير من النقاشات واكتشفنا الطريق معاً. طبعاً جزء من تحديات التحالفات أن تتمكني من التعامل مع «الإيغو» لكل منظمة ورغبتها بالظهور. جزء من دوري ضمن فريقي التذكير الدائم بأننا نعمل من أجل قضية، وليس من أجل ظهور منظمتنا. بالتأكيد وصلنا إلى نقطة نحتاج فيها للموارد المالية من أجل خلق استدامة وأثر أكبر للعمل، لكن هناك وعي ضمن المنظمة على أنّ هذا العمل ليس مجرد مشروع يحتاج إلى تمويل.
عُلا: سلمى، بما أنك وآمنة أَشرتُما إلى موضوع التمويل، فمن المهم الحديث عن هذا الجانب. يعتمد المجتمع المدني بشكل كبير على التمويل في تنفيذ تدخلاته، كيف تحققون التوازن بين خلق مشروع معتمد على التمويل في مقابل عمل أكثر عضوية وأكثر استدامة؟ فالتمويل في النهاية مرتبط بسياسات الممولين واستراتيجياتهم، فهل تصميم تدخلات معينة تعتمد على التمويل يمكن أن يتسبّب بأذية للقضية، أو أن يُعرِّضَ العمل للفشل؟
سلمى: منذ بداية عملنا لم نرغب كمجموعة في استجلاب التمويل باسم عائلات من أجل الحرية، فهذا يقع على عاتقنا كمنظمات مجتمع مدني، وليس كمشروع نحن نقوم بتنفيذه. وبالتالي كنا نغطي تكاليف حملات المناصرة من هنا وهناك. من البداية كنا واعين أننا لا نتلقى الدعم من أيّ كان، ولكن حين احتجنا التمويل لاستدامة العمل وضعنا سياسيات تمويلية تتناسب مع قيمنا، وأَلزمنا أنفسنا بها، حيث يجب، سياسياً، ألّا يكون هناك تضارب بين قيم ومواقف الجهة أو الدولة المانحة وقيمنا.
لقد حاولنا أن نكون حريصين على عدم القيام بنشاط أو صرف الأموال وفقًا لأجندة أو جدول الجهة المانحة الزمني، أو أي جهة فاعلة أخرى. لم نكن نريد خلق ديناميكية قائمة على تحديد أنشطة الحركة ووتيرتها بناءً على ما إذا كنا سنحصل على التمويل ومتى، فهذا في رأينا كان سيجعل الحركة أقل استدامة.
هناك أمر آخر مُتعلقٌ بالاستدامة؛ نحن واعون لدورنا كأشخاص يتلقون رواتب ليقوموا بتقديم الدعم للحركة، والعائلات لا يتلقون رواتب على العمل؛ لأن هذه القضية بالنسبة لهم شخصية وسياسية. هذا الاختلاف يخلق توتراً من نوعٍ ما، فنحن لا نود أن يكون دورنا كجهة تقدم الدعم اللوجستي والإداري، فلنا أيضاً دور كشركاء وحلفاء. بالمقابل، نحن مدركون بأنّ جزءاً من تمكين العائلات لا يكون بأن نقوم نحن بالعمل الإداري أو الميزانياتي دون أن يكون لهم دورٌ في هذا العمل، ولذلك هناك العديد من التوترات بين مسؤوليتنا كأشخاص يتلّقون رواتب للقيام بهذا العمل، وبين أن نكون جهة دعم راديكالية، وبين خلق نوع من الاعتمادية بأن نقوم بكل هذه الأعمال: «أنتو بس قولوا ونحنا حنعملها بدون ما يكون عندهن فكرة عن التفاصيل»، وأن يَكُنَّ هُنَّ من يَقُدنَ هذا العمل، والذي بالتأكيد يتطلب جهداً ووقتاً منهنّ.
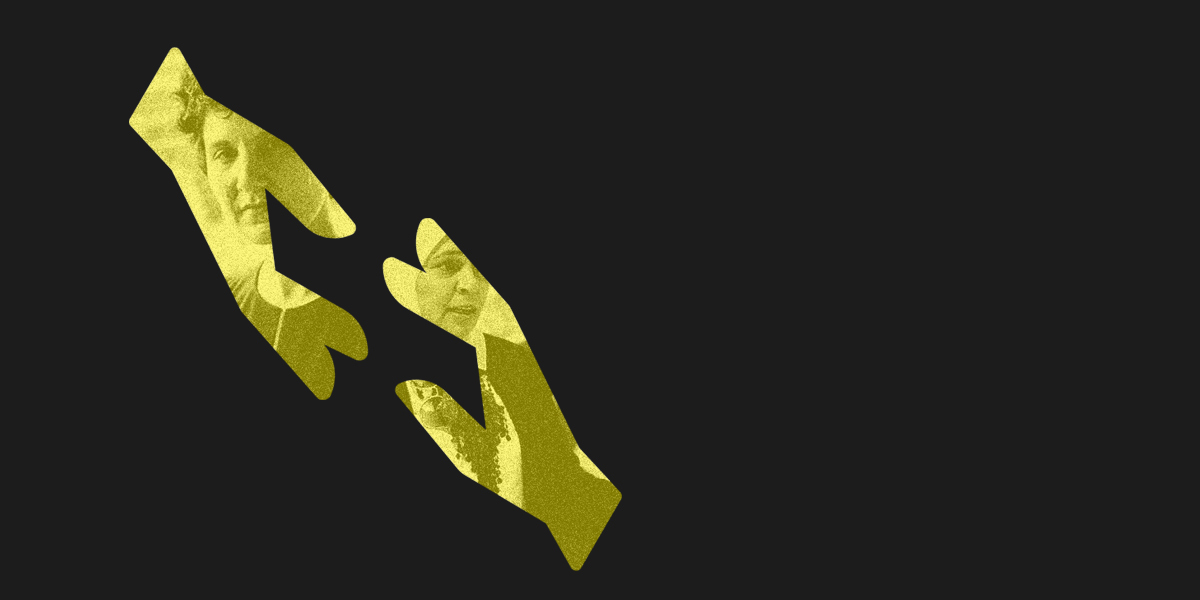
عُلا: كيف تقومون بإدارة هذه التوترات، طبعاً هناك الوعي لهذه التوترات، ولكن كيف تقومون بالتعامل معها؟
سلمى: جزء من هذا التعامل كما ذكرتِ هو وعي لها، ومحاولة لتفكيكها وإيجاد حلول في مكانٍ ما. هي حلول جزئية، ولكن ما زلنا نخوض فيها نقاشاتٍ مستمرة.
آمنة: النقاشات صعبة، وخاصةً في هذه الأمور؛ لأنها لا تنتهي. طالما أنّ العمل مستمر فإنّ هذه التوترات موجودة، ولكنها لا تصل إلى حد أن تؤثّر على العمل، وهذه هي النقطة المهمة. نخوض هذه النقاشات ضمن إطار الثقة، وداخلياً، وهنا أؤكّد على كلمة داخلياً، فنقل هذه التوترات إلى المساحات العامة؛ مثل فيسبوك وغيره كما نرى في كثير من المجموعات، يؤذي القضية. أنا أرفض الأسلوب الشعبوي في التعامل مع الاختلافات والتوترات لأنه يؤذي أي عمل جماعي.
عُلا: ما التحديات التي تواجه روابط الضحايا في علاقتها مع منظمات المجتمع المدني الداعم لها، وبالمقابل ما هي التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني في علاقتها مع الروابط؟ أودُّ هنا ليس فقط الإسقاط على تجربتكنّ كفريق دعم وعائلات، وإنّما الحديث عن تجربتكنّ في السياق الأوسع كفاعلات ضمن هذا المجال.
سلمى: على مدى السنوات الست الماضية التي شاركتُ فيها في المجتمع المدني السوري والعمل المتعلق بالعدالة، كان هناك تحسّن ملحوظ في كيفية تعامل المجتمع المدني مع الضحايا أو أهل القضية. أذكر أنه عندما بدأت اجتماعات السياسة أو التنسيق بشأن العدالة، لم يكن فيها أي تمثيل للضحايا تقريباً، ناهيك عن مجموعات الضحايا، وإذا تم إشراك الضحايا فكان ذلك عادةً في جولات المناصرة، حيث يتم استعراضهم من قبل أشخاص آخرين يسعون لرفع الوعي حول الوضع في سوريا أو جمع الأموال لمجموعة محددة.
هناك تحسن ملحوظ في مقدار وجودة إشراك الضحايا في النقاشات حول العدالة، حيث دعمت العديد من منظمات المجتمع المدني السورية مجموعات الضحايا السورية من خلال تنظيم وخلق مساحة لهم على الطاولة، وعملوا على دعم أصواتهم، سواء كان ذلك من خلال دعم مجموعات لإنشاء منظماتهم الخاصة أو تطوير برامج بقيادة الضحايا داخل المنظمات القائمة، أو ببساطة عبر خلق مساحة للضحايا للتحدث عن تجاربهم ومطالبهم لبعض الجهات الفاعلة. هناك بالتأكيد تغيير إيجابي.
هناك أيضاً بعض المنظمات التي بدأت بمجموعات الضحايا التي تطورت إلى نوع مختلف من المجموعات. على سبيل المثال مجموعة تقدم خدمات للناجيات من الاعتقال، ولديها الآن برامج ومجالات تركيز أخرى متعددة. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من المجموعات التي كانت منظمات مجتمع مدني قائمة على أساس جغرافي، وتلعب الآن دوراً في تمثيل الضحايا، وهنا أقصد مجالس التنسيق أو المجموعات التي تقودها النساء من المجتمعات التي أُجبرت على النزوح. أعتقد أنّ هذه الأمثلة والتطورات تذكّرنا بالخط الفاصل بين منظمات المجتمع المدني ومجموعات الضحايا، فهو عادةً ما يكون غير واضح، وأعتقد أن هذه ليست مشكلة في حد ذاتها طالما أن هناك وضوحاً بخصوص التموضع والتمثيل.
على الرغم من ذلك، أعتقد أنّ العديد من الممارسات الضارة لاستغلال الضحايا ما تزال موجودة، وأصبحت بطريقةٍ ما أكثر مأسسة. ما زال هناك الكثير من الأمثلة على ضحايا طُلب منهم التحدث ومشاركة تجاربهم بدون اشتراكهم بشكل هادف في هيكل الحدث، وبدون إعطائهم المساحة للتحدث بما يتجاوز تجاربهم والتحدث عن مطالبهم. للأسف يبدو أن بعض الجهات الفاعلة تدعو الضحايا من النساء للتحدث عن تجاربهنّ كطريقة لإظهار أنهم يُضمّنون الجندر والضحايا. مع ذلك، بدون مشاركة هادفة للضحايا فهذه عملية رمزية واستغلال، ودمج النساء الضحايا في فئة واحدة للظهور بمظهر الشمولي هو تنميط ضار. نعم، إنه من الجيد وجود ضحايا على الطاولة، لكن نحتاج إلى إشراكهم بصورة هادفة، وكذلك إلى الابتعاد عن صيغة «الخبير الذكر والضحية الأنثى».
آمنة: أود الإشارة بدايةً إلى أنّنا غير راضين عن استخدام مصطلح مجموعات الضحايا أو روابط الضحايا، ولكننا نُضطر لاستخدامه لأنه المستخدم رسمياً ومهنياً من قبل المنظمات الدولية. نحن نرفضه لأنه كلمة ضحية هي مصطلح يعطي مدلولاً سلبياً يوحي بأنه ليس لي إرادة في كل ما يجري، وكأن كارثة طبيعية ضربت البلد، وهذا غير صحيح في الحالة السورية، وإن كان هناك الكثير من الضحايا، لكن كل من شارك في الثورة بإرادته لا يعتبر ضحية. أنا شخصياً لا أعتبر نفسي ضحية رغم كل الخسائر المؤلمة التي تعرضتُ لها مع أسرتي، لأن كل ما قمتُ به كان عن إرادة وإيمان بما أفعل وبضرورة الاستمرار به.
كما قالت سلمى، في مرحلةٍ ما كان الضحايا أدوات لتصميم مشروع واستجلاب التمويل. نحن في عائلات من أجل الحرية كنا نتعرض دائما لأسئلة تدل على وجود صورة عامة أو فهم لدى الناس بأن أهل القضية هم أدوات لمشروع يقوم أحد بتنفيذه.
في كثير من الأحيان تُوجَّه لنا دعوات لنشاطات من جهة ما، نكتشف أن هذه الجهة لديها مبلغ من المال تود صرفه خلال فترة معينة وأنّ علينا بسرعة أن «نطبخ طبخة» تتناسب مع المبلغ ونقوم بتنفيذها. مرجعيتنا كحركة هي استراتيجيتنا وتحليلنا لـ«أين نحن الآن»، وما نود الوصول إليه، وليس التمويل المُتَاح، لذلك نحن حريصون على تصدير هذه الثقافة التي بنيناها بعملنا معاً؛ كحركة وكفريقِ دعم لباقي الروابط والمجموعات.
هناك أمر آخر أودّ الإشارة إليه، مع التضييق وتقلّص مساحات عمل منظمات المجتمع المدني: خسارة الغوطة مثلاً وأماكن أخرى، دُفِعَ كثيرون للعمل على قضية المعتقلين والناجين باعتبار أن المجال هناك ما زال متاحاً. أصبح هذا النوع من العمل «موضة»، فكثرت الجهات التي لديها مبلغ من المال تودّ أن تؤسس من خلاله مجموعة ضحايا، وذلك من دون التفكير باستدامة هذه المجموعة والأثر النفسي على أفرادها من ناحية، والأثر العملي على القضية بخلق مجموعات غير مستدامة في الفضاء العام من ناحية أخرى. من الجيد أن تكثر أصوات أهالي الضحايا وأصحاب القضية، ولكن من المهم جداً الاستراتيجة والآلية التي يضعونها لأنفسهم. من الضروري ألّا يكونوا جزءاً من مشروع أحد أو أداة لتنفيذ مشروع. من الضروري أن يكونوا هم القضية، وكل شي يتحول إلى أدوات لخدمة هذه القضية. في الحقيقة هناك مقولة تبقى حاضرة في ذهني للراحل محمد الماغوط في مسرحية غربة، حين يقول «نجحت العملية لكن المريض مات»؛ ما أخشاه أن يكون التعامل مع الملفات السورية السياسية والحقوقية ضمن هذه المقولة، أن تكون الأولوية لنجاح «العملية» المشروع بسهولة وسرعة وبَظّ إعلامي يرفع اسم المنظمة.
أما «المريض» القضية وأهلها، فهي تأتي في الدرجة الثانية بالأهمية، فتكون اللامبالاة والتهميش هي الطريقة في التعامل مع آلامهم. مع الأسف، في الحالة السورية نسمع عن الكثير من العمليات الناجحة، ولكن لا نسمع إلا القليل عن حال المرضى.
سلمى: بالحديث عن الاستدامة، أودّ إضافة نقطة حول أهمية بناء التحالفات بين أهل القضية أنفسهم. العام الماضي اجتمعت العديد من مجموعات الضحايا في بروكسل، وشكّلوا تحالف «شركاء من أجل العدالة»، واستمروا بالاجتماعات بغية تأسيس أرضية مشتركة للمناصرة ومساحة للتنسيق. هذه خطوات مهمة جداً لمجموعات الضحايا في سبيل خلق مساحة للتعاون بدلاً من المنافسة، وكذلك لتقوية أصواتهم، فعادةً ما يدفع الممولون وصانعو السياسات إلى إيجاد مجموعة واحدة تمثّل جميع الضحايا أو المجتمع المدني… إلخ. في إحدى المرات سألني أحد الممولين: «هناك العديد من مجموعات الضحايا الآن، فكيف يمكننا معرفة أي منها تستحق الثقة؟». لذلك فمن المهم أن تحاول مجموعات الضحايا أو أهل القضية التنسيق والتعاون متى كان ذلك ممكناً واستراتيجياً. مع ذلك، فقضية الاعتقال في سوريا كبيرة في حجمها وفي تأثيرها على السوريين، حيث هناك العديد من الخصائص التي تواجهها المجموعات المختلفة بناءً على جنسهم أو تجربتهم في الاعتقال أو الجهة التي أخفتهم. ولذلك فمن الضروري وجود مجموعات أو تشكيلات مختلفة لوضع رسائل أو مطالب محددة، والتركيز على جهات فاعلة معينة؛ مثل عائلات مختطفي داعش.
أريد فقط أن أضيف على وجهة نظر آمنة بالقول: إنّ إنشاء مجموعات جديدة في حد ذاته ليس بالأمر السيء إذا كان قائماً على احتياج أو فجوة في التمثيل أو احتياجات ستسدّها هذه المجموعة. يصبح ذلك مشكلة حين تكون مدفوعةً بأجندة المجتمع المدني أو الممول لتحقيق أهدافهم البرنامجية. وهنا أريد فقط أن أقول إنه ليس شيئاً خاصاً بالمنظمات السورية، ولكن رأينا أنه يتم الدفع باتجاهه من قبل المنظمات الدولية.
عُلا: آمنة، مَن هي منظمات الضحايا/روابط العائلات الموجودة على الساحة السورية اليوم؟ وكيف تتفاعلون معاً بالرغم من اختلاف تخصصاتكم أو مطالبكم، وصولاً إلى تشكيل تحالفات؟
آمنة: هناك العديد من المجموعات والروابط على الساحة السورية اليوم؛ منهم رابطة عائلات قيصر ورابطة معتقلي صيدنايا وروابط عائلات مختطفي داعش، وروابط للناجين والناجيات مثل تعافي وغيرها. نحن، في عائلات من أجل الحرية، كان لدينا وعي مبكر لأهمية التحالف والتوازن الذي تحدّثت عنه سلمى بين التخصص وبين القضية العامة التي تجمعنا؛ فالبرغم من تنوع الروابط وتنوع مطالبها ورسائلها، فإن التحالف مهم لتنسيق الجهود ودعم بعضنا وتكامل جهودنا. ومن هنا جاءت فكرتي عن ضرورة التواصل والتنسيق مع الروابط الآخرى لإنشاء التحالف الذي ذكرته سلمى، وبالفعل بدأتُ بالتواصل معهم. انطلقت تجربتنا في مؤتمر بروكسل الثالث عام 2019، حينها اجتمعنا وأرسلنا رسالةً للقائمين على مؤتمر بروكسل وجهات أخرى. كانت رسالتنا حينها أننا، كروابط ضحايا وكناجيات وناجين، لا نقبل بإعادة الإعمار قبل الكشف عن مصير أحبتنا. هذه الرسالة جمعتنا بغضّ النظر عن طبيعة التجمع؛ سواء ناجين أو روابط أهالي، وبالفعل هذا الضغط كان له نتيجة. حضرنا المؤتمر بشكل فيزيائي، وقمتُ بإلقاء كلمة، أكدتُ فيها بأنه لن نسمح بأن نكون شهوداً فقط في المؤتمرات التي تناقش قضيتنا. وشعرنا بأهمية الاستمرار في هذا التحالف من أجل الضغط والتنسيق ومشاركة تجاربنا. نحن ندعم عمل بعضنا بعضاً ونكمله، فمثلاً: نحن، كعائلات من أجل الحرية، لا نعمل على المحاسبة، ولكن رابطة عائلات قيصر يعملون في هذا الملف. وعليه، قمنا بدعمهم مناصراتيّاً حين بدأت المحاكمة، وهنالك أمثلة كثيرة من هذا النوع.
عُلا: آمنة، أنتِ كواحدة من مؤسسات حركة عائلات من أجل الحرية، أطلقتنّ على أنفسكن اسم «حركة»، لماذا؟ ما هي المقومات الاساسية برأيك لاستدامة وتطور الحركات بشكل عضوي، وكيف يمكن إدارة التوتر الناشئ بين الحاجة لخلق أبطال أو رموز للحركات، وبين الحاجة لخلق حركات أكثر تشميلية (تضمينية)؟
آمنة: في الحقيقة، استدامة الحركة وبناؤها يكون في الترابط بين المبادئ وبين التطبيق والواقع والأداء لهذه الحركة. نحن، في البداية، بدأنا كحملة، ولم نطلق اسم حركة إلا لاحقاً. حينها كان الأثر الذي تركته هذه الحملة عند الأهالي وأهل القضية هو ما دفعنا إلى قرار التحوّل إلى حركة تأخذ طابع مستداماً واستراتيجياً، وهذا يعني وضع نظام داخلي واستراتيجية عامة للقضية. والآن، نعمل على بناء الحركة داخلياً، فبدأنا بتحديد رؤانا: مثلاً، ما علاقتنا مع الأهالي؛ مع أهل القضية؛ ما علاقتنا مع بقية الروابط وما هي علاقتنا بالمجتمع المدني؟ تطورت حركتنا مع الوقت، كنا خمس سيدات حين التأسيس، أما اليوم فنحن أكثر من 100 سيدة. نسعى في الحركة إلى التضمين والتشميل وفتح الباب أمام أهالي الضحايا للانضمام.
يمكن أن تقولي لي أنّ كل قضية أو حركة تحتاج إلى نجوم؛ إلى أبطال يكونون صوت أهل القضية حتى يتسنّى لهذه الحركة أن تكبر ويكون لها صدى. هذا صحيح، لكن إذا كانت هذه هي الآلية دائماً فهو مؤذٍ. يجب أن يكون هناك توازن بين استثمار هذا الصوت أو هذا الرمز وبين أن تكون أصوات الجميع مسموعة. طبيعة العمل المناصراتي التي نقوم بها تحتاج حكماً أن يمتلك مَنْ يتحدّث باسم المجموعة أدوات ومهارات عالية إذا كانت ضمن إطار نشاط رسمي (event)، وإلا سوف يصبح الأمر «قضية عادلة ومحامٍ فاشل». ولكن علينا بالمقابل استثمار منصات أخرى للحشد، فمثلاً؛ أم تتحدّث عن ابنها المعتقل في فيديو قصير هو من أقوى رسائل المناصرة. وهو لا يحتاج الكثير من المهارات، دائماً أقول لمن حولي (لو الأم كانت بكماء لنطقت إذا قلتلها في حدا لح يسمع صوتك إذا حكيتي عن ابنك). إحساس الأهالي حين نقوم بحمل صور أولادهم أو ذويهم في وقفاتنا في مؤتمر أو أمام سفارة يشعرهم بأن أولادهم نجوم، لم يُنسوا. ومن جهةٍ أخرى لا يجب استسهال أن مجموعة صغيرة من أهل القضية يمتلكون مهارات وخبرات، وبالتالي نعتمد عليهم فقط، فإن كانوا من أهل القضية فعلاً، فعليهم مساعدة غيرهم على الظهور وامتلاك هذه المهارات. كثيراً ما أعتذر عن لقاءات ومقابلات تلفزيونية من هذا المبدأ. ظهور أصوات جديدة والعمل على تضمين وتشميل أهالي الضحايا ضروريٌّ لاستدامة الحركات، لكيلا تتحول إلى «حزب البعث» ننادي بمبادئ ونعمل بعكسها.
من الضروري أيضاً التعلّم من تجارب أخرى. نحن نلتقي، كلما أتاحت الفرصة، بروابط من بلدان أخرى؛ روابط الضحايا في لبنان، مثلاً، تحدّثوا لنا عن التحديات التي واجهتهم، وأخبرونا بألا نعتمد على شخصين أو أكثر للتحدث بمطالبنا، لأنّهم سيصلون إلى مرحلةٍ سيتعبون فيها. وأيضاً، من أجل أن يتحول الحديث عن المعتقلين والمعتقلات من لغة الأرقام إلى القصص. حين نقول إنّ لدينا 350 ألف معتقل، فإنّ هذه المعلومة لا تؤثر، وإنما ما يؤثّر هو قصص هؤلاء المعتقلين، لذلك من الضروري أن يروي الأهالي قصصهم ومعاناتهم اليومية وتفاصيل حياتهم ليكون جميع المعتقلين والمعتقلات نجوماً.

سلمى: خلال ورشة استراتيجية العائلات في 2018، ذَكَّرَتنا المُيسِّرة، وهي خبيرة في التنظيم المجتمعي، بأنّ قوة الحركة تأتي من وجود مجموعة كبيرة من عائلات المعتقلين، وأن هذا ما سيُحدِثُ تغييراً جذرياً تجاه تحقيق أهدافنا، وليس فقط أنّ أحد الأعضاء معروفٌ ويمكنه الحصول على لقاء مع هذا السياسي أو ذاك. في النهاية، فإنها قوّتهم جميعاً هي التي ستُجبر صانعي القرار على العمل، وهذه النصيحة بقيت معي بالفعل. إنّ عائلات من أجل الحرية محظوظة بوجود العديد من النساء الرائعات ضمن قيادتها وبين أعضائها في كل مكان، فهنّ نجوم بالفعل، ومن الصعب إضعاف الضوء الذي يُشعّونه. فيكون التحدي عند بناء استراتيجية هو أخذ خطوة إلى الوراء، ومعرفة كيف يمكننا تسخير قوة كل هؤلاء النساء وجميع هذه العائلات ليكون تأثيرهم أكبر من مجرد «قوة النجمة» الفردية، وما هي تكتيكات الحملة التي يمكنها إشراكهم بشكل جماعي حتى يشعر صانعو القرار بوجودهم؟ وهذا ليس بالأمر السهل حين نعمل ضمن ثقافة تنظيمية تحبّ خلق النجوم ومجتمع مدني قد تطور حول شخصيات. كما أنه ليس من السهل إنشاء هذا التنظيم الجماعي والمشاركة في هذا السياق المتقلّب سياسياً وغير الآمن. لدى عائلات من أجل الحرية فروع محلية في سوريا (إدلب) ولبنان وتركيا، وكذلك هي في بدايات تأسيس عدة فروع لها في أوروبا. وتعني حقيقة أننا لسنا في الدولة نفسها، وغير قادرين على الوقوف خارج أروقة السلطة في هذه الدولة وتقديم مطالبنا، أننا يجب أن نكون أكثر إبداعاً في كيفية إنشاء حركة تمكينية وتضمينية.







