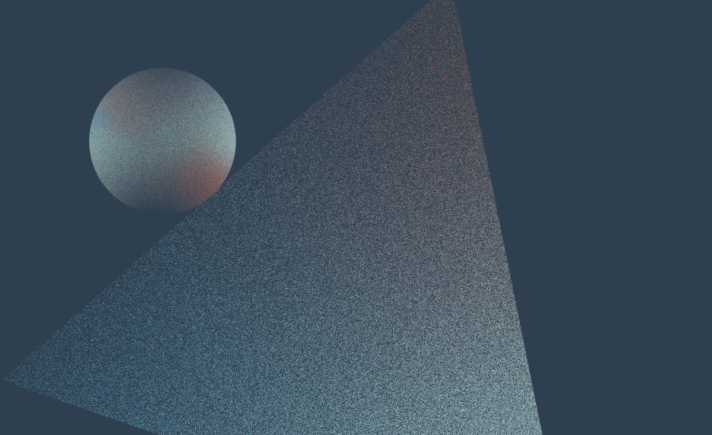يُعبِّرُ هذا المقال عن انعكاسات تولّدت من خلال محادثات ونقاشات مع صديقات وزميلات، من أقطار مختلفة في المناطق الناطقة باللغة العربية، وعن حراكات العدالة الاجتماعية عامة والنسوية بشكل خاص. عبر عملي على بناء حركات نسوية في مركز التنمية والتعاون عبر الأوطان في سوريا وفي مناطق أخرى ناطقة بالعربية، أعرض في هذا المقال ملاحظات عامة من سياقات مختلفة عن أشكال الحراكات وسيرورة تطورها والتناقضات الموجودة فيها بسبب ربطها بالمجتمع المدني والسياسات النيوليبرالية. ترتبط تلك الملاحظات بشكل كبير بظاهرة مأسسة الحراكات النسوية نتيجة السياسات الدولية التي تُرسِّخُ المفاهيم الرأسمالية على حساب العدالة الاجتماعية، وعلى حساب العدالة في التوزيع وفي الوصول إلى الموارد بكافة أشكالها. تتمثل تلك السياسات في المجتمع الدولي وادعاءاته الصورية بأنه، وبلا أي أجندات ذات مطامع اقتصادية ولها أثر سياسي، معنيٌ بترسيخ مفاهيم الحقوق والمساواة والحريات. أرى أنه لا يمكننا إلقاء اللوم في هذا على المجتمع الدولي وحسب، فتبّني خطاب المجتمع الدولي ظاهرة باتت منتشرة ما بين النشطاء والناشطات وبين المجموعات والجمعيات التي تدّعي في عملها أنها تجابه تجليات القمع. ولا يقتصر ذلك على الشأن السوري، وإنما نرى تفشي هذه الظاهرة في فلسطين ولبنان والعراق والأردن وغيرها. أدّى تفشي هذا الخطاب إلى المساهمة في خلق ثنائيات وسياسات هوية من شأنها تقويض عمل الحراك وعرقلة وصوله إلى النتيجة المرجوة منه، وزادت كذلك من تفتيت صراعاتنا ونضالاتنا المتقاطعة وخلقت حدوداً رمزية تتمحور حول «خاصية السياقات»، من شأنها أن تمحو من مخيلتنا أثر المنظومة العالمية القامعة ومساهمتها في ترسيخ الظلم والعنف والقمع، ومن شأنها كذلك الحد من قدرتنا على محاربة جذور القمع التي تؤثر علينا جميعاً بغض النظر عن أماكن تواجدنا أو أصلنا أو انتماءاتنا أو الهويات التي نُعرّف أنفسنا بها.
تأتي تصوراتي وتحليلاتي الواردة في هذا النص مما لا يقل عن خمس عشرة عاماً من الخبرة في المناطق الناطقة باللغة العربية، وما لا يقل عن ثماني سنوات من العمل في الشأن السوري عبر مركز التنمية والتعاون عبر الأوطان. في هذا المقال، أَعرضُ بعض الإشكاليات التي تعرقل عمل الحراك النسوي، في سوريا وفي دول الجوار على حد سواء، بسبب مَأسسته وربطه بالمجتمع المدني الذي يتأثر بدوره بأجندات المجتمع الدولي.
سياسات الهوية: ما بين العمل النسوي والنسائي
يعني لي العمل النسوي كثيراً على مستوى شخصي ومهني وسياسي. ولعل أكبر الإحباطات التي واجهتني خلال سنوات عملي في هذا المجال هي اللغط الكبير ما بين العمل النسوي والعمل النسائي. أُعرِّف العمل النسوي بأنه سعي نحو عدالة اجتماعية شاملة عبر أخذ جميع أوجه القمع، كالرأسمالية والاستعمار والنظام الأبوي البطريركي ومنظومة الدولة، بعين الاعتبار دون إغفال واحد على حساب الآخر. بذلك، ومن منظور تقاطعي، لا يُركِّزُ العمل النسوي على النساء وحسب، وإنما يعتبر قضايا النساء جزءاً لا يتجزأ من مجموعة مطالب ساعية نحو عدالة تقاطعية للجميع، من المهاجرين والمهاجرات وذوي وذوات القابليات الجسدية والعقلية اللامعيارية واللاجئين واللاجئات والطبقات الكادحة وغيرها من الفئات المهمشة لأسباب مختلفة. وعلى ذلك، ينبغي على الحراك النسوي أن يكون شاملاً لجميع أنواع وأشكال العنف والقمع، وأن لا يركز على جزئيات صغيرة بحدود المسموح به في إطارات المجتمع المدني المُمأسس والمُتأثِر بشكل مباشر أو غير مباشر بأجندات التمويل، إذ عادة ما يطلب منا الممولون التركيز على فئات مجتمعية معينة لها هويات واضحة وتنتمي لمجموعات من الممكن التعميم عن تجاربها مثل النساء واللاجئين واللاجئات و«الأقليات» الجنسية.

من الإشكاليات الأساسية لدى ما يُسمى بالعمل النسوي الحالي تركيزه على خلق هويات محددة للنساء ومجزأة، وكأنهنَّ فئة واحدة، ويتم التعميم على تجاربهن دون حرص، ومن ثم يتم التركيز على تلك الهويات بدلاً من التطرق إلى كافة مسببات القمع، التي يمكن أن يتم تشميل أجندات المجتمع الدولي فيها. على سبيل المثال، بالتركيز على مشاريع تحت مسمى «دعم النساء» أو «تطوير قدراتهنّ» أو «المشاركة السياسية للنساء»، نعيد إنتاج الصور النمطية عن النساء وكأنهنّ: أولاً فئة واحدة متشابهة وتجليات القمع الواقعة عليهنّ هي ذاتها، ثانياً أنهنّ ضحايا بحاجة لإنقاذ، وثالثاً بهذه الطريقة يتم تمييع القضايا بشكل يُخفّف من مسؤولية الأنظمة القمعية ودورها. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي هذه البرامج إلى إظهار النساء وكأنهنّ متلقيات سلبيات للقمع وضحايا لا حول لهنّ ولا قوة، مخففة بذلك دور المنظومات القمعية وملقية حمل النضال على النساء أنفسهن. لا نعمل بذلك إلا على عوارض المشكلة، لا على جذور القمع من أساسها. ويؤدي ذلك إلى زيادة النمطية المغلوطة، وكأن الرجال ليسوا بحاجة إلى تمكين ودعم كالنساء، ليُعادَ بذلك إنتاج تصور عن النساء وكأنهنّ «أقل قدرة»، أو «أضعف» من الرجال. كما تخلق سياسات الهوية ثنائيات ما بين النساء أنفسهنّ وما بين الرجال والنساء، وكأن جميع النساء مقموعات وأيضاً كأن المسبب الأساسي للقمع هو الرجال، ولا يتم التطرق للمنظومات القمعية بحد ذاتها كمنظومة الدولة أو الرأسمالية الاقتصادية والثقافية. وبالتالي يتم التعامل مع كل النساء كأنهن فئة واحدة دون التطرق للتجارب الحياتية المختلفة مثل تجارب ذوات الأداءات الجندرية وذوات الممارسات الجنسية اللامعيارية. أما إذا تفكرنا بالنسوية، كحراك عدالة اجتماعية لا كمشاريع تنفذها مؤسسات المجتمع المدني، فعلينا بناؤه من منظور أنَّ الشخصي هو السياسي عبر التركيز على تسييس التجارب الشخصية والتجارب اليومية، بشكل يبتعد عن خطاب ولغة المجتمع الدولي وعن الخطابات الحقوقية النخبوية، ويتمحور حول وجهة نظر الأقليات السياسية. بكلماتٍ أخرى، علينا أن نكون واعين وواعيات إلى أن التوزيع والوصول إلى الموارد بكافة أشكالها أمر مرتبط بالمنظومات السياسية التقليدية التي تخلق طبقات اجتماعية واقتصادية وسياسية مختلفة بغض النظر عن الجندر أو الجنس أو الجنسانية وغيرها من العوامل الفارقة. إذا ما أخذنا ذلك بعين الاعتبار، فعلى الحراكات النسوية دوماً مَركَزة صوت الأقليات في سُلّم الأولويات في مطالبها. وأقصد بالأقليات في هذا الإطار الفئات المجتمعية المهمشة لا بسبب قلة عددها، وإنما بسبب العراقيل التي تحد من مناليّتها للموارد الاقتصادية والثقافية والمعرفية والبشرية والبيئية، بما يؤدي إلى خلق أشكال مختلفة من انعدام المساواة والظلم والعنف. بتجنب هذه الإشكاليات في حراكاتنا، نتمكن من خلق تغيير اجتماعي لا يعتمد على مؤشرات كمية تعزز من استخدام النساء كديكورات أو مجرد رموز في مناصب سياسية أو في مؤسسات المجتمع المدني، دون أثر نوعي في سعينا نحو عدالة اجتماعية تقاطعية شاملة.
اللغة
تُعتبر اللغة جزءاً أساسياً وأداة هامة لخلق خطاب حول حراكاتنا الساعية إلى العدالة الاجتماعية. تدفعنا مأسسة الحراك النسوي من خلال منظمات المجتمع المدني إلى استخدام لغة معينة مفهومة في هذا الإطار ومتلائمة مع أجندات المجتمع الدولي، وليست بالضرورة مرتبطة بالسياقات. فبتنا نصيغ أهداف حراكنا بمؤشرات مرتبطة بإطارات منطقية (logical frameworks) ومخرجات ونشاطات وأهداف مشاريع، لا بتغيير مجتمعي حقيقي يمس جميع فئات المجتمع المهمشة ولا يحصر الموارد بأيدي الطبقة السياسية. تم تفكيك العدالة الاجتماعية إذن، وتقطعت أشلاؤها ما بين مشاريع تعميم الجندر والتمكين الاقتصادي والسياسي، خالقين بذلك لغة نخبوية لا تصل ولا تُفهم خارج إطارات المجتمع المدني. وعادة ما تكون اللغة المستخدمة في هذه الإطارات هي اللغة الإنجليزية، التي لا تصل إلى جميع الفئات المجتمعية المعنية ولا تعبر عن الممارسات المرتبطة بالسياقات المختلفة، وتكون بهذا الشكل خادمة لفئة معينة على حساب فئات أخرى. وتقوض هذه المأسسة من مطالب النساء وأصواتهنّ عبر تعليب مطالبهنّ بمصطلحات ومفاهيم مرتبطة بالمجتمع الدولي والممولين، حتى أصبح الغضب النسوي مرفوضاً وكأنه تعبير عن مشاعر غير شرعية أو عقلانية. تؤدي هذه العوامل جميعها إلى جعل قِبلة الحراك النسوي المُمأسس لغة للتمويل والأجندات الدولية. وتجعل من الحراك النسوي «حراك بروبوزال»، لا حراكاً معبراً عن الغضب في مواجهة العنف والقمع. وبذلك يتم تحويل حيواتنا ونضالاتنا اليومية إلى عدد محدد من الكلمات يتسع في صندوق «ملخص المشروع» في طلب التمويل، وعلينا اختزال خلفية الحراك في عدد محدود من الأسطر.
وتخلق هذه اللغة أيضاً طبقية ونخبوية ما بين النساء أنفسهنّ، إذ تخلق ثنائيات ما بين النساء العاملات في مجال المجتمع المدني أو في المجال السياسي وغيره والنساء الفاعلات من خلال حياتهنّ اليومية خارج هذا الإطار. وتؤدي هذه الطبقية التي تخلقها لغة المجتمع المدني إلى فصل عمل المجتمع المدني عن لغة العامة وجعل العمل محدوداً في فئات ضيقة من المجتمع، ويصبح للنشاط أو الحراك شكل واحد مرتبط بالمؤسسات. ويفتح هذا باب المزاودات على ماهية العمل الأفضل والأمثل لتقاس ماهية ومؤشرات النجاح بالإطارات المنطقية للمشاريع وقدرات التجنيد المالي، ويُفصَلُ بذلك العمل النسوي عن العمل السياسي.
ما بين الإدارة والقيادة
بينما تتمركز حوكمة الحراكات على مفاهيم القيادة النسوية اللاهرمية، حيث لكل منا دورها بغض النظر عن المواقع، فإن حوكمة المؤسسات تتمركز حول مفاهيم الإدارة الهرمية المعتمدة على الإنتاجية الرأسمالية. عبر مأسسة الحراك النسوي يحتكر مدراء ومديرات مؤسسات المجتمع المدني مفهوم القيادة، بينما يتمحور عملهنّ حول الإدارة، معيدين ومعيدات إنتاج هرميات نخبوية وسلطوية تعزز من الطبقية الثقافية، وتسمح بمساحة للتنظير والمفاضلات. من إشكاليات تلك الهرميات الأساسية أن نقطة انطلاقها من منظور أفراد بحوزتهنّ قوة بحسب هرميات القوى، ولديهنّ امتيازات ثقافية تسمح لهنّ بتكلم لغة الممول، ويعكس ذلك تناقضاً في المنهجية ما بين قيادة الحراكات النسوية وإدارة المؤسسات. أما من وجهة نظر القيادة النسوية، يتطلب منا بناء حراك نسوي فعال عكساً ذاتياً وتفكراً في الامتيازات التي نمتلكها، المتأثرة في الزمان والمكان والمتغيرة بحسب السياقات، وتحليل موقعياتنا عبر فهم أثرنا على غيرنا بممارساتنا اليومية. وتتطلب منا ممارسة القيادة النِسوية كذلك القدرة على الاستجابة للعوامل والسياقات المتغيرة وتغيير استراتيجياتنا بحسب الظروف المحيطة. كما يمكننا ربط هذه الظاهرة بالنخبوية الناجمة عن استخدام لغة إدارة المشاريع المحكية على ألسنة القِلَّة. وتختلف أهداف الحراكات كثيراً عن أهداف المشاريع المحصورة في مدد زمنية وتقارير ومؤشرات، فأهداف الحراك عادة ما تكون طويلة الأمد، إذ يُعتبر الحراك عملية وسيرورة مستمرة ومتغيرة لا يمكن تحديد نقطة بدايتها أو نهايتها. وللأسف فمع مأسسة الحراك وربطه بالإدارة، صارت منظمات المجتمع المدني تدّعي أنها تقود وتؤسس حراكات مقاومة، وتدعي كذلك أنها نسوية لمجرد تمثيل النساء في الإدارة التنفيذية ومجالس الإدارة. وفي هذا يعاد إنتاج اللبس ما بين النسوية والنسائية، فهنالك فارق شاسع ما بين النسوية كأيديولوجية سياسية ومنهجية يمكننا فهم العالم من خلالها، وما بين العمل النسائي الذي يتمحور حول سياسات الهوية والتمثيل الصوري للنساء، دون الوعي بالأبعاد الطبقية والسياسية للقمع. فعلى سبيل المثال، لا يعني إن كانت امرأةٌ مديرةً لمؤسسة أن المؤسسة نسوية أو جزء من حراك نسوي، إذا لم تكن المنهجيات التي تتبعها في عملها نسوية.
بناء على ما سبق، يمكننا استنتاج أن مأسسة الحراكات النسوية يؤدي بشكل أو بآخر إلى تمييع القضايا عبر التركيز على سياسات هوية ومفاهيم إدارة ولغة نخبوية تخلق طبقيات ثقافية وسياسية ما بيننا، وتعمم قضايا النساء وهوياتهنّ وكأنها واحدة، وكأن اهتماماتهنّ واحدة. ولا يعني ذلك إغفال موقعياتنا في هرميات القوى، وإنما يدعونا إلى التفكّر بأننا حتى لو كنا مجموعة من النساء الفلسطينيات أو السوريات أو المصريات أو اللبنانيات، فإن ذلك لا يعني أن تجاربنا متشابهة ولا يعني أن فكرنا السياسي متشابه. ولذلك يجب على جميع الحراكات تجنب تنظيم أنفسها عن طريق سياسات الهوية التي تعززها مأسسة منظمات المجتمع المدني. ومع ذلك لا يعني وجودنا في منظمات مجتمع مدني أننا غير قادرات على المساهمة في بناء حراكات، إذ يلبس أغلبنا أكثر من قبعة. كما يمكننا عبر منظمات المجتمع المدني الحرص على التصدي للقمع والعنف بممارساتنا الشخصية واليومية، والتي لا يمكن ضمها تحت مظلة مشروع أو مؤسسة أو مخرجات وأهداف. ففي تلك السياسة اليومية نبني وندعم الحراكات ونكون جزءاً منها دون الاعتماد على لغة التمويل والمشاريع النخبوية.
سعيتُ في هذا المقال إلى تقديم بعض الإشكاليات التي واجهتُها ولاحظتُها من خلال عملي مع منظمات مجتمع مدني وحراكات نسوية كذلك، وأرغب ختاماً بالقول إننا لن نتوصل للعدالة إذا لم تكن رؤيتنا شاملة وتقاطعية لأوجه القمع، وإذا لم نَكن واعيات على موقعياتنا وامتيازاتنا.