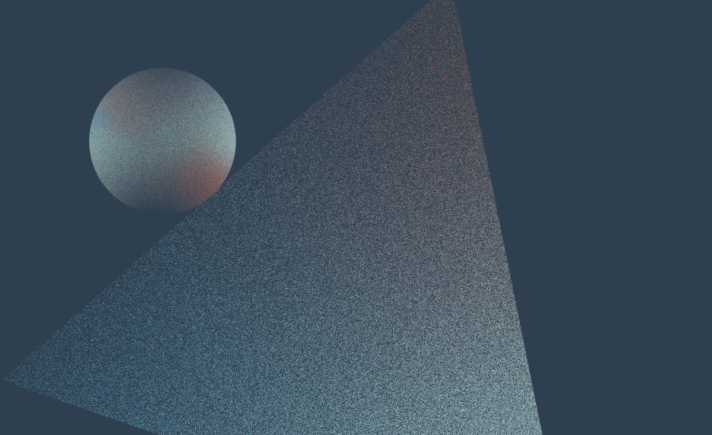مقدمة
على مدى السنوات العشر الماضية، تعاملَ المجتمع المدني السوري مع العديد من القضايا وفق ثنائية أبيض أو أسود، سواء في تأييد بعض المسائل أو في معارضتها. كما استطاع المجتمع المدني السوري الذي يلتزم بالمبادئ ويتّسم بالاستقلال والموضوعية، ولا سيما منظمات حقوق الإنسان، تكوين موقف واضح حيال مفاهيم كالعدالة والمساءلة ومحاربة الإفلات من العقاب وتعويض الضحايا، وحيال مناصرة هذه القضايا وغيرها. وقد عبّرت هذه المنظمات عن مواقفها بسطور قليلة عكست قِيمَها وأوضحت الأدوات اللازمة لتحقيق هذه القيم، كالإجراءات القانونية والإدانات وتوثيق الجرائم والتصريحات وغيرها. إلا أن العقوبات الاقتصادية كانت استثناءً في هذا الصدد، فحتى بالنسبة إلى أولئك الذين يتمسكون ببوصلة حقوق الإنسان كان من الصعب اتخاذ موقف مبدئي واضح وموجز يمكن تبنيه على المدى الطويل. ولهذا السبب استغرقَ الأمر نحو عام لإصدار ورقة حول العقوبات تعبّر عن مواقف أكثر من 20 منظمة مجتمع مدني بارزة. وجرت نقاشات كثيرة حول كيفية التعامل مع الآثار الجانبية للعقوبات، وما إذا كان ينبغي على هذه الورقة الدعوة إلى «منع تأثير العقوبات على المدنيين»، علماً أن هذا ليس أمراً ممكناً.
وفي العامين الماضيين، أصبحت العقوبات الاقتصادية مركزية في النقاش السوري رغم فرضها منذ العام 2011. وقد شهدنا ذلك في الحملات العامة، مثل حملة «لا لإقصاء السوريين»، إلى جانب الاجتماعات وورش العمل، بما في ذلك غرفة دعم المجتمع المدني التي نظمها مبعوث الأمم المتحدة. ولكن يجب الإشارة إلى أن العقوبات لم تبدأ عام 2011؛ فالولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية على سوريا عام 1979 بعد إدراجها كدولة راعية للإرهاب، وظلت مُدرجة في القائمة منذ ذلك الوقت. وفي عهد بشار الأسد بعد عام 2000، فُرضت العقوبات الاقتصادية بموجب الأمر التنفيذي 13338 لعام 2004 والأمر التنفيذي رقم 13460 لعام 2008، وقد شمل الأخير رامي مخلوف، ابن خالة بشار الأسد.
بيد أن الجدل الدائر في أوساط المجتمع المدني السوري اليوم لا يدور بين داعمي النظام والمطالبين بمحاسبته على جرائمه، فالخلاف بشأن مسألة العقوبات احتدم بين مجموعة متجانسة من السوريين الذين يجمعهم سجلّ عمل حافل في مجال حقوق الإنسان والمطالبة بالعدالة وبمستقبلٍ أفضل لسوريا والسوريين. ويعدّ الجدل الذي أعقب صدور قانون عقوبات قيصر مثالاً على ذلك.
يناقش هذا المقال المعضلات التي تواجه أصحاب المبادئ هؤلاء عند اتخاذ موقف من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، كما يقترح طرائق لحل هذه المعضلة الشائكة.
لا تطرح هذه الورقة موقفاً من العقوبات نفسها، بل تركّز على الحوار اللازم لها. وقبل الانتقال إلى المعضلات التي تثيرها، من الضروري أولاً أن نفهم سياق الجدل حول العقوبات.
سياق ظهور الجدل حول العقوبات
إذا كانت العقوبات المشددة قد فُرضت بعد العام 2011، فلماذا إذن يتزايد الجدل حولها هذه الفترة؟ هناك عدة أسباب سنورد بعضها أدناه.
أولاً، مع تصاعد النزاع المسلّح لم يكن لدى الكثير من السوريين «رفاهية» نقاش العقوبات الاقتصادية، فقد شغلتهم الجرائم التي ارتكبها النظام السوري، مثل قصف المستشفيات واستهداف الأسواق والتهجير القسري واستخدام الأسلحة الكيميائية.
ثانياً، مع بلوغ هذه الجرائم ذروتها سيطر النظام وحلفاؤه على معظم الأراضي السورية. واقتضى ذلك تجاوز المحادثات والأنشطة والندوات والمؤتمرات مسألة التوثيق والدعوة إلى منع جرائم الحرب هذه، لتركز بشكل أكبر على المُساءلة ومنع المنتفعين من الحرب من الاستفادة من إعادة الإعمار ومحاربة شرعنة النظام السوري على المستوى الدولي. وعليه كانت العقوبات، لدى الداعين إلى المُساءلة، أداةً لتحقيق كل ما سبق، خاصة وأن معايير أنظمة العقوبات المفروضة على سوريا تستند إلى أسس حقوق الإنسان.
ثالثاً، تدهور الوضع الاقتصادي في سوريا بتسارع خلال العامين الماضيين، وتصاعدت معه مستويات الفقر بين السوريين، وألقى النظام وحلفاؤه باللائمة على العقوبات الاقتصادية. وفي مؤتمر بروكسل الأخير الذي عُقد بشكل افتراضي في حزيران من هذا العام، أشار لبنان وحلفاء النظام جميعاً إلى مسألة العقوبات. ومنذ وقت قريب، سمح النظام للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإجراءات القسرية الأحادية بزيارة سوريا، وهو أمر لم يسمح به سابقاً لآليات حقوق الإنسان الأخرى التابعة للأمم المتحدة، وذلك في محاولة منه تسليط الضوء على قضية العقوبات. ونظراً إلى توسّع سيطرة النظام، تزايدت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مناطق سيطرته، وقد وجهت بعض هذه المنظمات دعوات لمراجعة أنظمة العقوبات لتسهيل تقديم المساعدات للسوريين، ومن الأمثلة على ذلك كان التقرير الصادر عن المجلس النرويجي للاجئين في نيسان 2020. وقد أدى كل ذلك إلى وضع قضية العقوبات في صدارة النقاشات.
رابعاً، أطلق النظام وحلفاؤه، وكثير منهم متواطئ في الانتهاكات التي ارتكبها، حملات لرفع العقوبات عن سوريا وتمويل إعادة الإعمار. وقد تسبَّبَ ذلك بقلق كيانات وأفراد المجتمع المدني السوري المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان، إذ اعتبروا ذلك خطوة نحو تجاهل تحقيق العدالة وتحركاً نحو سيناريو ما بعد الصراع. كما رأوا أن الدعوة إلى رفع العقوبات قد تكون مكافأة لمجرمي الحرب.
وأخيراً، في ظل غياب دورٍ قيادي للدول الغربية في الملف السوري سياسياً، كانت العقوبات إحدى الأدوات القليلة التي قررت هذه الدول استخدامها، ويُعدّ قانون قيصر وعقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة مثالاً عن ذلك. كان هذا فرصة للتعاون مع الدول الغربية في نظر من يرون العقوبات أداةً للمُساءلة. وفي مقابل ذلك، ما زال معارضو العقوبات، أو غير القادرين على/غير الراغبين في مواجهة الأطراف التي ارتكبت الجرائم لدفعها إلى وقف سلوكها (أي نظام الأسد وحلفاؤه)، قادرين على الوصول إلى الدول الغربية للضغط عليها لرفع العقوبات. إذن فمن السهل مناقشة العقوبات مع صانعي السياسة الغربيين، بصرف النظر عن الموقف منها.
لقد وضعت الطبيعة المعقدة لسياق العقوبات معضلات أمام المجتمع المدني السوري. وإضافة إلى معضلة العقوبات، شكّلت نتائج هذه العقوبات معضلة أخرى.
المعضلة الأولى: تعقيد العقوبات
إذا أردنا تناول أي موضوع بفاعلية وكفاءة، فعلينا فهمه وتحليله جيداً. لكن العقوبات المفروضة على سوريا غاية في التعقيد، إذ يختلف أساس العقوبات القانوني بين دولة وأخرى، إضافة إلى معايير إدراجها وفحواها وتطبيقها ووصولها وأثرها ونطاقها وشروط الإعفاء منها. كما تختلف القطاعات والصناعات والأفراد المستهدَفون بالعقوبات، وتتباين كيفية استهدافهم. ويتم تفصيل كل هذا في مواقع إلكترونية يصعب الوصول إليها ووثائق تتألف من مئات الصفحات. يكفي لأحدنا النظر إلى العدد الهائل للعقوبات والقوانين الأميركية وقرارات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بالعقوبات لفهم مدى تعقيد المسألة. فهناك أكثر من 600 فرد مدرجين في قوائم العقوبات، إضافة إلى الكيانات والقطاعات والأنشطة المحظورة. كما أن الاستثناءات الإنسانية مفصلة جداً، وتسرد مثلاً المادة 7432 من قانون قيصر المتعلق بالاستثناء والإعفاءات صفحة كاملة من الشروط التي تشمل المعاهدات الدولية التي أبرمتها الولايات المتحدة، أو الأسباب الإنسانية التي يقدرها رئيس الولايات المتحدة من بين آخرين. وإضافة إلى ذلك، تحدد المادتان 7425 و7426 من القانون القواعد الخاصة بدعم عمل المنظمات غير الحكومية وتقديم المساعدات الإنسانية. ولا يمثل قانون قيصر إلا إحدى أدوات العقوبات التي تعتمد عليها الولايات المتحدة. وعندما حاولنا في البرنامج السوري للتطوير القانوني – وهو منظمة لديها وحدة حقوق الإنسان والأعمال تجارية – وضع ورقة ملخصة عن العقوبات، جاءت في نحو 50 صفحة. ولهذا السبب فإن المحامين الذين يتعاملون مع العقوبات، في المملكة المتحدة على سبيل المثال، هم من أكبر المحامين نظراً لتعقيد المسألة.
يتناول ما ذكرناه آنفاً تعقيد النظام ونصوصه على الورق فقط. أما عند تحليل تأثير العقوبات على سوريا وعواقبها المقصودة أو غير المقصودة، فيصبح فهم العقوبات غاية في الصعوبة. أولاً، هناك العديد من العوامل التي لها تأثير مماثل للعقوبات على الاقتصاد، كالحرب والفساد وسوء الإدارة وعدم الاستقرار الإقليمي. إلا أن التعقيد العملي وغموض العقوبات يضيفان طبقة أخرى إلى معاناة السوريين. ويتجلّى ذلك بشكل أساسي في التحويلات المصرفية للمنظمات الإنسانية، أو حتى الشركات الخاصة التي لا يخضع نشاطها للعقوبات. فعلى سبيل المثال، يبيّن تقرير حديث (21 أيلول 2020) يتناول قطاع القمح في سوريا كيف تؤثر العقوبات على إنتاج القمح في البلاد. ففي حين قد يُعزى نقص المبيدات إلى حظر تصدير المواد الكيماوية إلى سوريا، إلا أن العقوبات تعرقل بدورها استيراد السلع وقطع الآلات بسبب إحجام الشركات والبنوك الأجنبية عن التعامل مع الأطراف السورية.

وأخيراً، هناك الكثير من المتغيرات المحيطة بالعقوبات. ففي سوريا التي لا تتوفر فيها إلا بيانات محدودة، تحاول السلطات تشويه الحقائق وانتهاج بروباغندا تسعى إلى ربط كل العواقب السلبية في سوريا بالعقوبات المفروضة عليها. وتعدّ جائحة كورونا أحدث مثال على ذلك، فالنظام يستخدم العقوبات كشماعة لتبرير عجزه عن التعامل مع انتشار الفيروس. إلا أن دراسة (28 تموز 2020) نشرها برنامج أبحاث الصراع التابع لكلية لندن للاقتصاد حددت 6 تحديات تواجه السلطات السورية في التعامل مع الأزمة الصحية، وتمثل العقوبات الاقتصادية تحدياً واحداً منها فقط.
المعضلة الثانية: هناك دائما تكلفة
تمثل العدالة والحرية والمُساءلة ومحاربة الإفلات من العقاب قيماً وأهدافاً يدعو إليها العديد من العاملين في المجتمع المدني السوري ويسعون إلى تحقيقها، وجميعها مسائل يمكن لأحدنا اتخاذ موقف مبدئي بشأنها، كأن يقال مثلاً «نحن نعمل على تحقيق المُساءلة» و«نحن ندافع عن العدالة»، إذ لا تسبب هذه المواقف ضرراً للمدنيين. أما عندما يتعلق الأمر باتخاذ موقف من العقوبات، فالأمر ليس هيّناً على هذا النحو.
تكمن مشكلة العقوبات في أن فرضها يؤثر على المدنيين دائماً، وذلك بسبب سيطرة النظام وأتباعه على أجزاء كبيرة من الاقتصاد والدولة؛ وأن رفعها يؤثر على الضحايا المطالبين بمحاسبة الجناة، ما يسهل على المجرمين الإفلات من العقاب. و بالتالي فإنه من الصعب المطالبة بأمر يُعرَف مسبقاً أنه سيسبب شيئاً من الضرر، حتى لو حقق بعض الخير. ويحتاج أحدنا إلى شجاعة كبيرة للدعوة إلى التعايش مع هذا الضرر وفقاً لمبدأ الخير الأكبر أو أهون الشرَّين. وعلى الرغم من أن هذه الحجج واقعية وعملية، إلا أنها جدليّة في أوساط المجتمع المدني السوري اليوم. لذا يصعب اعتماد مقاربة «الأضرار الجانبية المقبولة» نتيجة الضغوطات التي تطالب باختيار مواقف لا تسبِّب أية أضرار. ونتيجة لذلك، يعمد كثيرون إلى تجنّب الانخراط في هذه المسألة (العقوبات)، إلا أن هذا يتسبب في مزيد من الضرر، فالجُناة وحلفاؤهم ينخرطون بفاعلية فيها. ويتضح هذا في حالة المواد ذات الاستخدام المزدوج، المدني والعسكري. فمثلا تلعب العقوبات دوراً في أزمة الوقود الحالية في سوريا، إلى جانب العديد من الأسباب الأخرى، حيث فقد النظام السيطرة على حقول النفط السورية ويعتمد بشكل أساسي على واردات النفط. وقد أدى نقص الوقود في الآونة الأخيرة إلى تشكّل طوابير طويلة في محطات البنزين وشلّ حركة المرور. بيد أن العقوبات على تجارة النفط مع سوريا كانت تهدف إلى إيقاف آلة حرب النظام الموجهة ضد السكان المدنيين في مناطق سيطرته وخارجها.
هناك العديد من المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية والإنسانية المتعلقة بالعقوبات، والتي تتغير بمرور الوقت وتؤثر على كفاءة العقوبات. لذا، في وضع مثالي، يجب أن يكون العاملون في المجتمع المدني السوري قادرين على تغيير موقفهم السابق بشأن العقوبات. غير أنه في ظل المناخ والثقافة الحاليين، لن يُنظر إلى هذا التراجع كنتيجة للتفكير والتأمل، بل كنفاق وقرار غير متسق، وبالتالي كمسبّب للضرر.
ولا يتوقف النقاش حول العقوبات عند المواقف وحملات المناصرة، فهو يمتد ليشمل برامج وأنشطة الأعضاء المبدئيين في المجتمع المدني السوري. ويشارك العاملون في مجال المُساءَلة القضائية في النقاش بشأن العقوبات، ذلك أن الشخص الخاضع للعقوبات يُمنع من السفر أو التجارة مع الدولة التي فرضت عليه العقوبات، ومن بينها دول الاتحاد الأوروبي. و قد يعيق ذلك القدرة على محاسبة هؤلاء الأشخاص قضائياً في حال عدم الإشهار بمذكرة اعتقالهم، بسبب عدم قدرة الشخص المطلوب سرّياً على السفر إلى الدولة المعنية كونه على العقوبات. وهناك منظمات غير حكومية سورية تلجأ إلى المحاكم المحلية في الدول الفارضة للعقوبات على الجناة لمحاكمتهم ورفع دعاوى ضدهم، لكن هؤلاء لن يتمكنوا من السفر إلى هذه الدول للمثول أمام محاكمها إلا في حالات خاصة، نظراً إلى العقوبات المفروضة عليهم، إذا افترضنا أصلاً أنهم سيسافرون إلى هذه الدول للمثول أمام المحكمة.
الحلول الممكنة
في البداية، علينا ألا نبالغ في تبسيط العقوبات. ويجب استشارة الخبراء وقراءة المواد القانونية ذات الصلة لمعرفة كيفية تطبيقها. أما فيما يتعلق بتأثيرها، فعلينا إدراك أنه ليس ثمة من يُحيط بالصورة الكاملة أو يستطيع تحليلها بدقة. قد تساهم هذه البحوث في فهم العقوبات، ولكن يجب أن نجريها بعين ناقدة، وأن نضع في الحسبان التحيزات في المنهجية والمصادر وسلامة البيانات، وعلينا التدقيق في تأثّر هذه البيانات بأحد أطراف الصراع، والفترات الزمنية ذات الصلة، والافتراضات الواردة فيها، وأنواع العقوبات التي تتناولها، ومنظور ورقة البحث (سياسي، حقوقي، اقتصادي، إنساني). تعدّ هذه البحوث مهمة لتوجيه السياسة بشأن بعض جوانب العقوبات، لكنها غير قادرة على التوصل إلى الصورة الكاملة. وباختصار، يجب عدم الاكتفاء بالبيانات العامة حول الموضوع نظراً إلى تعقيد العقوبات.
يجب على المجتمع المدني السوري المستقل بذل قصارى جهده لمواجهة المعلومات المضللة والبروباغندا بشأن العقوبات. ويمكن تحقيق ذلك عبر التركيز على أسباب فرض العقوبات، كالجرائم المتعلقة بالصراع وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام في المقام الأول؛ وعلى كيفية رفع هذه العقوبات. لكن هذه ليست مهمة سهلة، فالمُساهمون في حملات التضليل يستخدمون أساليب متقدمة وغير أخلاقية، كالحسابات الإلكترونية الوهمية الآلية والأبواق المأجورة.
ويجب حدوث تحوّل في الفضاء الحالي للنقاش حول العقوبات. فهناك حاجة ماسة إلى فضاء آمن لنقاش صحي وبنَّاء، بدلاً من تراشق الاتهامات بين أعضاء المجتمع المدني السوري الذين يقرّون جميعاً بجرائم النظام ويطالبون بمحاسبته. كما يجب أن يتيح هذا الفضاء للعاملين في المجتمع المدني السوري إمكانية شرح الأسباب المنطقية وراء مواقفهم من العقوبات، وأن تُقابَل مواقفهم هذه بالتسامح، بصرف النظر عما إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأنها أم لا. وينبغي أن يتيح لهم هذا الفضاء إمكانية تغيير مواقفهم بشأن العقوبات إذا لزم الأمر، دون تداعيات وأضرار تلحق بسمعتهم. فقد يُعرب البعض عن معارضته لموقف أو لآخر في العلن، ولكن دون توجيه اتهامات بشأن دوافع هذه المواقف، ودون تخوين مناصري وجهات النظر الأخرى، فمن الضروري تقبّل غياب إجابة واحدة صحيحة أو خاطئة.
وعلى المستوى الفردي أو التنظيمي، يتطلب التعامل مع مسألة العقوبات التحلي بالقيادة والشجاعة والتحرك خارج الحدود المألوفة. علينا إدراك أن بعض الضرر سيقع نتيجة للعقوبات، بصرف النظر عن موقفنا منها، لذا يصبح اتّباع مبدأ أهون الشرّين أو الخير الأكبر أمراً ضرورياً رغم صعوبته. نحن السوريون، بحاجة إلى أن نضع كبريائنا جانباً، وأن نتحلّى بالقدرة على التفكير الموضوعي ومراجعة موقفنا من العقوبات باستمرار، وإجراء محادثات ونقاشات شائكة، وأن نتحلّى أيضاً بالقدرة على الاعتذار والتكيّف عند الضرورة. نحن مدينون بذلك لمن عانوا وما زالوا يعانون. علّ يوماً سيأتي لا نحتاج فيه إلى النقاش بشأن العقوبات؛ يوم يُحاسَب فيه الجُناة، وتتوقف انتهاكات حقوق الإنسان، ونشرع في بناء سوريا جديدة تقوم على مبدأ سيادة القانون.