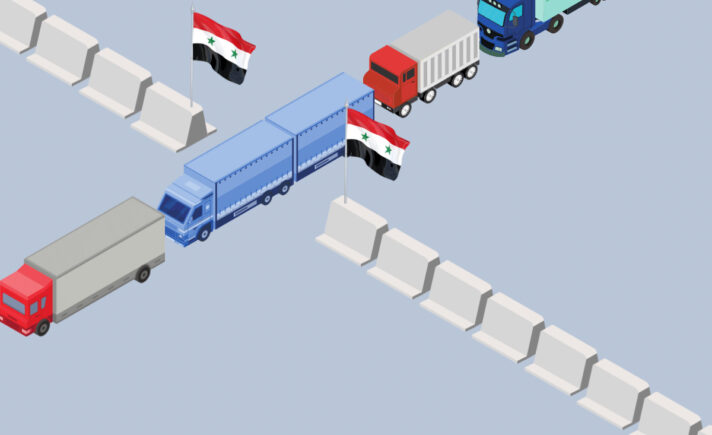في الثلاثين من أيلول (سبتمبر) 2015، طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من البرلمان تفويضاً لاستخدام القوات الجوية في دعم النظام السوري. قبل ذلك بحوالي الشهرين، كان قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني (قتل في غارة أميركية على العراق بداية عام 2020) يجلس مع بوتين في موسكو، لطلب الدعم والمساعدة للنظام السوري الذي تراجعت سيطرته العسكرية إلى ما لا يتجاوز العشرين بالمئة من مساحة البلاد.
كانت القوات الإيرانية في سوريا قد تعرضت لعدة هزائم كبيرة، من بينها المعارك الدامية في ريف حلب الجنوبي، التي انتهت بانسحاب القوات الإيرانية، على الرغم من استدعاء قوات النخبة في الجيش الإيراني الملقبين بـ «القبعات الخضر». لم تتأخر موسكو بتقديم الدعم، الذي بدأ بالوصول مع بداية شهر آب عام 2015، بالتوازي مع توقيع اتفاقية عسكرية بين موسكو والنظام السوري في دمشق، تبعتها زيارة قام بها بشار الأسد إلى موسكو في العشرين من تشرين الأول (أكتوبر) 2015.
أصبح كل شيء جاهزاً إذاً من أجل مستوى جديد من التلاعب الروسي في الملف السوري. كانت موسكو، طوال أربعة سنوات قبل هذا القرار، قد قدمت دعماً سياسياً واسعاً للنظام في المحافل الدولية، واستخدمت حق النقض (الفيتو) ضد أي قرارات تدين النظام السوري حتى تلك اللحظة ست مرات (استخدمته لصالح النظام 11 مرة حتى اليوم)، فيما حرص وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على إفراغ أي قرارات أخرى صدرت بخصوص سوريا من مضمونها. وهو ما تلاقى مع تراجع غربي في الضغط على النظام في دمشق منذ توقيع صفقة تسليم الأسلحة الكيميائية في مقابل تجنيب نظام الأسد عقاباً عسكرياً من واشنطن نتيجة استخدامه السلاح الكيميائي في ضرب الغوطة، ما تسبّب بمجزرة هائلة في آب 2013.
تمّ تجهيز قاعدة حميم لتستقبل الطائرات الروسية، فيما أعيد ترتيب قاعدة طرطوس البحرية لاستقبال السفن والمقاتلين. ولم يمضِ شهرٌ على إعلان التدخل الروسي في سوريا، حتى اندلعت معارك في ريف حماه الشمالي بدعم جوي وبري من موسكو لقوات النظام، التي حاولت التقدم على محاور مناطق سيطرة المعارضة هناك.
تعرضت العملية لفشلٍ ذريع في وقتها، وقد سجلّت اعداد كبيرة من الإصابات لدبابات ومدرعات النظام وموسكو، التي قالت تقارير صحفية محلية أنها استخدمت أحدث أنواع دباباتها في تلك المعركة. لم تنجُ دبابات T70 الشهيرة من مضاد الدروع المعروف اختصاراً باسم «تاو» الذي قدمته واشنطن لقوات المعارضة السورية، ليصبح التاو منذ ذلك الوقت أحد رموز وقف عدوان النظام على المدنيين، ويصبح عدد من رماة التاو أشخاصاً معروفين بين جميع السوريين. يبدو أن تلك اللحظة أثّرت كثيراً على اندفاع موسكو المتسرع في معارك سوريا.
خلال أشهر من إعلان التدخل الروسي لصالح النظام، لم تستطع موسكو تحقيق انتصارات واضحة، لكنّها استطاعت عكس تقدم المعارضة إلى دفاع، ووقف العمليات التي كانت قد انتهت بسيطرة تحالف لفصائل معارضة وجهاديين، من بينهم جبهة النصرة، على كامل محافظة إدلب عام 2015.
فجأةً، في 14 آذار (مارس) عام 2016، أعلن الرئيس الروسي انسحاب بلاده من سوريا. لم يحقق الروس نصراً، وكان الإعلان مفاجئاً للجميع، بما فيهم النظام الذي ارتبك إعلامه عند تعامله مع الموضوع. كان الأمر مناورة جديدة من بوتين لعلّها للضغط على نظام الأسد وتحصيل نفوذ أكبر في دولته المنهارة. لكنّ التدخل العسكري استمر، وإن بإستراتيجية مختلفة.
بحلول منتصف عام 2016، بدأت الجهود العسكرية الروسية، بتنسيق كامل مع الميليشيات الإيرانية والحرس الثوري، التركيز على مدينة حلب، التي أصبحت أحياؤها الشرقية محاصرة بعد سيطرة قوات النظام على المنافذ الأساسية مع العالم الخارجي. ضيّق القصف والحصار الأوضاع على فصائل المعارضة هناك وعلى المدنيين. قبل حلول نهاية العام كانت الدفاعات المتبقية قد انهارت أمام عمليات قصف وحشية نفذتها الطائرات الروسية، لم تعد العمليات الأرضية من اختصاص الروس بعد ذلك. كانت الميليشيات الإيرانية، التي تمتلك القدرة على تحمل خسائر بشرية عالية، هي التي تنفذ العمليات على الأرض تحت غطاء طائرات Su-34 التي حولت بلداتٍ وأحياءً بكاملها إلى أنقاض.
كان الانتصار الذي قدمه الروس للنظام في حلب عنواناً لتحوّل رئيسي في مسار الأحداث في البلاد. اندفعت تركيا إلى الحوار مع موسكو، التي أصبحت على حدودها الجنوبية؛ وإيران التي سيطرت ميليشياتها على حلب، وتمّ إطلاق مسار أستانا الذي اعتبرته موسكو بديلها الخاص عن المسار السياسي الذي كان يجري في جنيف برعاية دولية وغربية.
وفي هذه الفترة، أجبرت موسكو -عبر أنقرة- قوات المعارضة في مختلف المناطق السورية على المشاركة في هذا المسار، باعتباره مساراً ضامناً لاستقرار خطوط التماس في البلاد. لم تجر عمليات واسعة خلال الفترة الأولى، لكنّ توجه موسكو إلى محيط دمشق لم يكن لمجرد تأمين الأحياء الرئيسية، فقد جرت محاصرة حي القابون، الذي كان يعد شريان الحياة الأساسي للغوطة الشرقية من خلال الأنفاق المحفورة بين المنطقتين. ونجم عن سحق المقاومة هناك خروج فصائل المعارِضة من الحي إلى الشمال أو إلى الغوطة، التي أصبحت تعيش تحت رحمة قوافل رجال الأعمال المرتبطين بالنظام، مثل محي الدين المنفوش وهو رجل أعمال يمتلك مصانع للألبان والأجبان في الغوطة، أشار عدد من التقارير أنه يعمل كواجهة لماهر الأسد. كان ذلك يعني عودة ذكريات عام 2014، عندما توفي الناس بسبب سوء التغذية في مخيم اليرموك ومضايا وفي الغوطة الشرقية، وجميعها مناطق محاصرة في ذلك الوقت.
حاولت فصائل معارضة فتح ثغرات في هذا الحصار عدة مرات، أو تحويل أنظار النظام إلى جبهات أخرى من خلال معارك الكراجات ومن ثم معركة إدارة المركبات في حرستا، لكن الأمتار القليلة في إدارة المركبات التي لم تسيطر عليها حركة أحرار الشام كانت كفيلة بإنهاء هذا الهجوم، الذي كان واعداً، وبانقلاب الأدوار.
أسابيع من القصف على حرستا ومن ثم كلّ الغوطة، تخلله استخدام للسلاح الكيميائي على نطاق محدود في عدة بلدات، ومن ثمّ بدأت المعركة التي دمرت ما تبقى واقفاً من أبنية مدن وبلدات الغوطة، إذ خرجت مدينة حرستا من هذه المعركة مدمرةً بنسبة 80%، على سبيل المثال. (هنا تسجيل هو صورة صوتية من شارع في مدينة دوما في أحد أيام القصف العادية التي سبقت المعركة، خلال المعركة كان القصف أضعاف المسجل هنا).
هجّر أهل الغوطة، باتفاق وقّع سريعاً مع الفصائل في القطاع الأوسط الذي يضم بلدات عربين وعين ترما وكفربطنا وغيرها من البلدات، وباتفاق مع فصائل حرستا. لم يهجّر أهل دوما قبل قصفهم بالكيماوي في السابع من نيسان عام 2018. كانت الشهادات والصور القادمة من الغوطة في تلك الفترة تعبّر عن أعمال وحشية لم يجرِ اختبارها من قبل، حتى مع كل المجازر التي ارتكبها النظام. كان بوتين قد قرّر الذهاب إلى النهاية في القتل الجماعي للسوريين، لم يكن يريد الخروج إلّا منتصراً على جثثنا.
تحت وطأة المجازر في الغوطة الشرقية واستخدام السلاح الكيميائي، كانت التهديدات الروسية كفيلة بدفع قوات المعارضة في ريف حمص الشمالي إلى توقيع اتفاق تسوية مع الروس، يقضي بخروجهم إلى الشمال وتسليم المنطقة إلى موسكو والنظام.
الحكاية اختلفت في درعا، وفي عموم الجنوب، إذ كانت فصائل المنطقة تعوّل على دعمِ أميركي وأردني لها في مواجهة العمليات التي بدأتها موسكو في نفس العام الأسود 2018. لكن على العكس من ذلك، جرى تسريب بنود اتفاق سري ثلاثي بين موسكو وواشنطن وتل أبيب، يقضي بضمان روسيا ابتعاد الميليشيات الإيرانية عن الحدود مع الجولان السوري المحتل، مقابل سماح إسرائيل بتقدم قوات النظام المدعومة من موسكو. جرى توقيع اتفاق مصالحة في درعا أيضاً وتحول أحد أبرز قادة المعارضة هناك، أحمد العودة، إلى رجل روسيا الأول في جنوب سوريا. بات العودة يقود عناصر الفيلق الخامس في درعا، وأصبح ممثل الجرائم الروسية في محافظته (يحاول اليوم نقلها إلى جيرانه من خلال اعتداءات تقودها قواته مع أهالي بلدة القريّا في السويداء).
مع نهاية عام 2018، كانت موسكو قد حقّقت انتصارات أوسع من تلك التي حقّقتها قبيل نهاية عام 2016، إذ كانت النسبة الأكبر من مساحات البلاد قد أصبحت تحت سيطرة النظام، خاصةً مع تراجع تنظيم داعش تحت تأثير الضربات الأميركية، ما سمح لقوات النظام المدعومة روسيا بالسيطرة على مدن محافظة دير الزور التي تقع على الضفة الجنوبية الغربية للنهر (دير الزور، الميادين، البوكمال) بعد اتفاق روسي-أميركي يقضي بتقاسم السيطرة بناءً على خط النهر، ما أطلق في الصحافة العالمية وضمن مراكز الأبحاث مصطلح «شرق الفرات» للتعبير عن المناطق التي تقع ضمن الغطاء الأميركي (كان بالإمكان استخدام اسم المنطقة الأصلي، الجزيرة السورية) في تمثيل ساطع لتجاهل التقسيمات الجيوسياسية لحياة الناس وتعبيراتهم في مناطق التنافس المحتدم.
مع بداية شهر شباط (فبراير) عام 2019، بدأت قوات النظام والميليشيات الإيرانية المساندة لها بعمليات قصف مدفعي عنيف على قرى ريف حماة الشمالي، وريف إدلب الجنوبي. كانت تلك العمليات، التي تسبّبت بتهجير ما يقارب المئتي ألف مدني حسب أرقام فريق منسقو الاستجابة، مجرد بداية لاجتياح بري واسع بدأ في نيسان من ذات العام. وشمل الاجتياح معظم جبهات ريف حماة وإدلب مع النظام الذي حاول مراراً التقدم على محور اللطامنة وكفر زيتا وصولاً إلى خان شيخون. لم يفلح النظام إلّا بعد أن سوّى تلك القرى بالأرض، لتتوقف المعارك لشهرين مؤقتاً على حدود محافظة إدلب هذه المرة.
تجدّدت المعارك نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر). كان عدد النازحين بسببها قد تجاوز 800 ألف نسمة، وقد أصبحت الأوضاع الإنسانية بالغة المأساوية على أكثر من ثلاثة ملايين نسمة من الأهالي والمهجرين والنازحين، يعيش جزء كبير منهم بالأصل في ظروف لا إنسانية. مع حلول عام 2020 استطاعت قوات النظام والميليشيات الإيرانية التقدم تحت غطاء القصف الروسي العنيف إلى مدن خان شيخون ومن ثم معرة النعمان ومن ثمّ سراقب حتى حدود الأتارب في ريف حلب الغربي، وكان هناك 1.1 مليون نازح في إدلب وريف حلب. توقفت المعارك باتفاق تركي روسي في منتصف آذار، لكن الخسائر البشرية، والمدن التي هجّر أهلها بالكامل، لا يمكن تعويضها.
تعيش إدلب منذ اتفاق موسكو، توتراً مضبوطاً، تخللته معارك صغيرة لم تغير الواقع كثيراً ولم تساهم في انهيار الهدنة. كانت إدلب، التي دخلها عشرة آلاف جندي تركي في سبيل وقف تقدم النظام، قد أصبحت ضمن أوضاع تسير ببطء نحو نسخ تجربة السيطرة التركية على ريف حلب الشمالي، لا معارك في الأفق القريب، لكن أنقرة من يحدد ما الذي يجب فعله في المنطقة.
طوال السنوات السابقة، حاولت موسكو بشكل دائم التهرب من الانخراط الجدّي في المسار السياسي، وقامت باختراع مسارِ سياسي مضحك شحنت إليه المئات من شخصيات رشحها النظام وجمعتهم في سوتشي. ضغطت انقرة على وفد يمثل قوات المعارضة للذهاب، لكنّ الوفد لم يشارك في الاجتماعات بعد أن أعلن أحمد طعمة رئيس الوفد تفويض أنقرة بالتحدّث باسم المعارضة!
مهزلة واضحة، لا تستدعي الكثير من التحليلات، قبل نهايتها استطاع الأمين العام للأمم المتحدة انتزاع تعهد من وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بتسهيل روسيا إنشاء مسار خاص بالدستور السوري، لكنّ هذا الوعد احتاج إلى قرابة الاثني وعشرين شهراً وتهديدات متكررة من المبعوث الأميركي جيمس جيفري ليتحقّق بصورة مشوهة في جنيف خريف العام الماضي.
تعود موسكو للسياسة هذه السنة. كانت هناك مؤشرات حول هذا التوجه على الأقل، عندما قابل نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف الرئيس السابق للائتلاف السوري المعارض معاذ الخطيب. لم يحدث شيء منذ ذلك الوقت سوى ترفيع سفير موسكو في دمشق إلى رتبة مبعوث رئاسي خاص.
تحاول روسيا الآن الدخول إلى المسار السياسي من بوابة شرق البلاد، من خلال مزيجِ لوعود وتهديدات قدمتها لقوات سوريا الديمقراطية، التي أصبحت بعض مناطقها ضمن الحماية الروسية بعد الاجتياح التركي لشمال الجزيرة السورية، في عملية خلّفت الكثير من الضحايا وآلاف النازحين، وسيطرت أنقرة بنتيجتها على المساحة الممتدة بين رأس العين في محافظة الحسكة وتل أبيض في محافظة الرقّة.
بعد كل ذلك، تواجه موسكو اليوم، بعد خمس سنوات من بدء تدخلها العسكري المباشر في سوريا، تحديّاً لا يبدو أن باستطاعة طائرات السوخوي وراجمات الصواريخ حلّه. تواجه موسكو مزيجاً من الانهيار الاقتصادي في مناطق النظام، مضافاً إليه عقوبات دولية وأميركية مشدّدة، كان آخرها إقرار قانون قيصر للعقوبات، وهو ما يقود اليوم وبشكل متسارع إلى انهيار تام في اقتصاد المناطق التي سيطر عليها النظام برعاية روسية. وفيما تسيطر إيران، عبر فيلق «المدافعين عن حلب»، على مدينة حلب التي كان الدعم العسكري الروسي السبب الأساسي في سيطرتهم عليها؛ وتسيطر ميليشيا حزب الله اللبنانية على مناطق واسعة من ريفي حمص ودمشق. تستطيع موسكو قول أن لها النفوذ السياسي الأكبر على نظام الأسد، لكن كيف يمكن ترجمة نفوذٍ واسعٍ على نظام إجرامي منهار اقتصادي، بعد أن ارتكب جرائم ضد الإنسانية؟ في الحقيقة، تصعب تلك الترجمة، وهو ما يبدو أنّه سيحير بوتين لفترة طويلة: كيف لم تفلح القوة الباطشة لطائراته بتغيير كل المعادلات؟
يبدو أنّه يحتاج إلى مساعدة في تحليل ذلك.