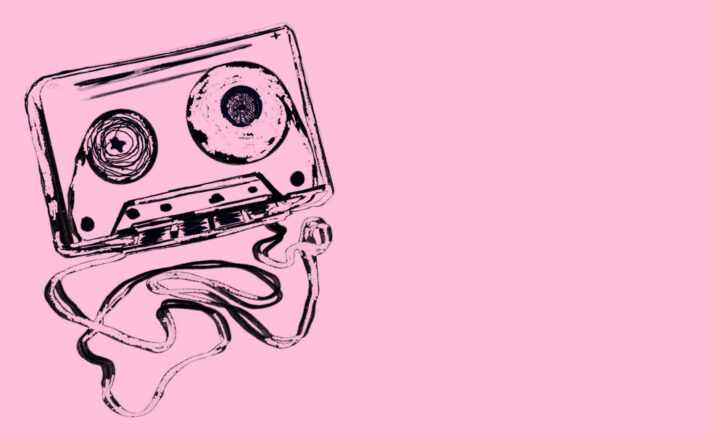في آذار الماضي، وفي تغطية خبرية عن إطلاق الملصق الإعلاني لفيلم الخيال العلمي المصري الغسالة، تشير جريدة العربي الجديد في خاتمة الخبر إلى فيلم آخر، هو عيون ساحرة (1934) بوصفه أول فيلم خيال علمي في السينما المصرية. يقتبس الخبر إشارات سابقة ومتفرقة للفيلم تحمل المضمون ذاته، ويبدو أن جميعها يرجع إلى مصدر واحد، بسبب تشابه النصوص. لكن عيون ساحرة، الذي تدور قصته حول امرأة تحاول إرجاع حبيبها الميت إلى الحياة عبر الاستعانة ببلورة زجاجية وتعاويذ وطقوس سحرية، يصعب وصفه بالخيال العلمي، فهو على الأغلب أقرب إلى الفانتازيا. شهرة الفيلم التي جعلت عنوانه حاضراً في مراجع تاريخ السينما المصرية بشكل متكرر، تعود إلى الأزمة التي ثارت حوله قبل عرضه، فالأزهر وصفه بالكفر الصريح لتجسيده عملية إحياء الموتى، والتي رأتها المؤسسة الدينية شأناً غيبياً في يد الله وحده. وكان الدفاع الذي قدّمه صنّاع الفيلم حينها، وسمح بعرضه لاحقاً، هو أن البطلة ستكتشف في النهاية أن كل الأحداث كانت مجرد أوهام في مخيلتها. يصعب نسْب الفيلم إلى الخيال العلمي، لكن ردود الفعل تجاهه، وطريقة تبريره لسرديته، والخلط بين الفانتازيا والخيال العلمي في توصيفه، سيحدّد كل ذلك الكثير من ملامح الخيال العلمي المصري لاحقاً، كما سنرى.
الخلاف على تحديد أول فيلم خيال علمي يبدو متبايناً بشكل كبير، ففي موسوعة أعلام الخيال العلمي (2019)، يضع سائر بصمه جي بداية متأخرة جداً، هي فيلم قاهر الزمان من إنتاج 1987. أما محمود قاسم في تاريخ السينما المصرية: قراءة الوثائق النادرة (2018) فيذهب إلى تاريخ أبكر بكثير، إذ يعتبر الفيلم الكوميدي رحلة إلى القمر (1959) كأول فيلم «فضائي»، وتنص كراسته الدعائية على أن «سيناريو هذا الفيلم تم إعداده طبقاً للنظريات العلمية». لكن قاسم يعود لينفي أن يكون هذا أول فيلم خيال علمي، «فهناك الكثير من الأفلام التي تنتمي إلى هذا النوع قُدّمت في ذلك العقد من الزمن (الخمسينيات) مثل بومبة والحبيب المجهول ومن أين لك هذا؟». وتضم الكثير من قوائم أفلام الخيال العلمي المصرية المنشورة في الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية خليطاً متبايناً من الأفلام، بعضها يتكرر في معظم القوائم، والبعض الآخر يُذكر لمرة واحدة أو اثنتين على الأكثر، وتظهر في تلك القوائم ظاهرة الخلط بين الخيال العلمي والفانتازيا/الرعب، فعلى سبيل المثال تتكرر الإشارة إلى فيلم سفير جهنم (1945)، والذي تدور قصته حول تجسد للشيطان، بين أفلام الخيال العلمي.

لا يبدو هذا الخلط نتاج خطأ في الفهم أو التعريف أو قاصراً على السينما فحسب. فالكاتب المصري يوسف الشاروني، الذي خص أدب الخيال العلمي باهتمام نقدي نادر ومنهجي على مدى أكثر من ثلاثة عقود، ينتبه إلى ذلك الخلط في الأدب العربي، ففي كتابه أدب الخيال العلمي في الأدب العربي المعاصر (2000)، وفي العديد من مقالاته السابقة، يحاول الإجابة على سؤال متواتر حول أصول الخيال العلمي في العربية، فهل هو امتداد للتراث وكتابات العجائب والغرائب العربية وألف ليلة وليلة، أم أنه يتبع لتقاليد غربية بالكامل؟ ويذهب الشاروني إلى أنه مؤسس على خليط من كليهما، إذ يؤكد على أن الفانتازيا هي أصل الخيال العلمي (بما فيه الغربي). وبشكل خاص، يبدو الشاروني مقتنعاً بأن أدب الخيال العلمي المصري ترجع أصوله إلى المسلسلات الإذاعية الفانتازية في الإذاعة المصرية. ويقسم الشاروني الصنف إلى خيال علمي يعتمد على الدقة العلمية (أقرب للنمط الغربي) وآخر يضع تركيزاً أقل عليها، وهو أقرب للفانتازيا وأكثر ارتباطاً بالتراث. ويضع السوري محمد عزام في كتابه الخيال العلمي في الأدب (1994) تقسيماً يبدو مختلفاً قليلاً، لكن يمكن فهمه بطريقة مشابهة، فهو يفرّق بين الخيال العلمي والفلسفي. أما نهاد شريف، الروائي المصري الوحيد الذي نذر نفسه لكتابة الخيال العلمي، فيشير في عدة مقالات له إلى تقسيمة ثنائية أخرى: خيال علمي منضبط، وخيال علمي «فانتازي أو جامح». ولا يبدو الخلط في تصنيف الفانتازيا والخيال العلمي هنا خطأ بالضرورة، بل لعله نتيجة لمسار تطور الصنفين أو أصولهما ومواردهما المشتركة وطريقة فهم المنخرطين في هذه الصناعة للعلاقة بينهما.
في رسالة دكتوراه غير منشورة تعود لعام 2011، عن الخيال العلمي في روايات اللبناني قاسم قاسم، يتعرض غاري مونرو بوتز إلى سؤال تعريف الخيال العلمي في السياق العربي، وإن كان يحتاج إلى محددات خاصة تختلف عن مقابله الغربي. ما يكشفه بوتز بجلاء هو صعوبة تعريف الخيال العلمي في أي سياق، فهو، كالكثير من التصنيفات الفنية، يمكن التعرف عليه بسهولة لكن من الصعب تعريفه. ويقول بوتز إنه يمكن تعيين مركز له، كدائرة تتقاطع وتتراكب مع غيرها من دوائر الصنوف الأخرى، لكن من الصعب تعيين حدود خارجية ثابتة له. يرفض بوتز المحددات القطعية، مثل اعتبار «الاغتراب الإدراكي» (أي تقديم سياق مختلف عن الوسط الإدراكي للجمهور أو تقديم عالم بديل أو مختلف جذرياً عن العالم الذي نعرفه) كشرط للخيال العلمي. ويكتفي بمحددات فضفاضة، هي مجموعة من الأيقونات التي يسهل التعرف عليها، مثل الكائن الفضائي والروبوت والإنسان المتحول أو المعمل والصاروخ. لكن واحداً من أهم ما تشير إليه أطروحة بوتز هي قابلية التصديق، أي العلاقة بالعلم أو أيديولوجيا الوسيلة العلمية، المؤسسة على المعرفة الحالية، وتصورات تطورها في المستقبل التي تجعل السردية قابلة للتصديق. وتثير تلك النقطة تحديداً معضلة أمام الخيال العلمي العربي، فإذا كان الخيال العلمي يُنظر إليه كرد فعل على الثورة الصناعية في الغرب، وعلى أنه خليط من الآمال والمخاوف والمعضلات تتمحور حول التطورات التقنية والعلمية المتسارعة، فما هي إمكانية تصديق الخيال العلمي المحلي في ظل السجل شديد التواضع للبحث والإنتاج العلمي العربي؟ أو بطريقه أخرى، كيف يمكن جعله قابلاً للتصديق في ظل هذا السياق المحلي؟
العقاقير العجيبة
بالعودة إلى قوائم أفلام الخيال العلمي المصرية، نجد أن معظمها يشير إلى الفيلم الكوميدي السبع أفندي (1951) بصفته أول هذه الأفلام. يعتمد الفيلم على مجموعة من الثيمات الشائعة في السينما المصرية، فسكر أفندي نموذج للرجل الصغير والمقهور في أسفل سلم علاقات القوى: رجل ضئيل الجسم، يعاني من إهانات مديرِه المستمرة وغير المبررة، ولا يستطيع الزواج من المرأة التي يحبها بسبب أحد المتنفذين في المنطقة، والذي يرغب في الزواج منها أيضاً. ينتقل الفيلم فجأة وكالعادة إلى الكباريه، حيث يقع سكر أفندي في غرام إحدى العاملات فيه، ويكتشف سريعاً أنها مرغمة على العمل هناك من قِبَل قريب شرير. إلى هنا تبدو الحبكة تقليدية تماماً، تتخللها الأغاني والرقصات، لكن نقط التحول غير المتوقعة تحدث حين يشتري سكر أفندي حبة دواء من أحد الباعة الجائلين، تمنحه قدرة خارقة، هي النفاذ عبر الأجسام الصلبة. يستخدم سكر تلك الإمكانية الاستثنائية في عقاب مديره الذي يفقد عقله ويدخل إلى مصحّ عقلي، ويلجأ البطل إلى حلول راديكالية لإعادة توزيع الثروة، حيث يقوم بسرقة الأغنياء والبنوك لمساعدة الفقراء تحت اسم مستعار هو «السبع أفندي»، وبالطبع يُنقذ حبيبته من القريب الشرير. يصعب تصنيف الفيلم كخيال علمي، فالتأثير الخارق للحبة التي يتناولها يفتقد إلى أي تبرير له أبعاد علمية ولو من بعيد، ويبدو أقرب إلى الفانتازيا، أو ربما يمكن ربطه بشكل من أشكال الخيمياء أو الخوارق التراثية. إلا أن أهمية السبع أفندي ترجع إلى أنه يمثل مقدمة لتنويعات كثيرة لاحقة على ثيمة العقار الخارق في الكثير من الأفلام، بعضها سيسعى بشكل جدي لتدعيم الجانب «العلمي» في خيالها. يتغلب الفيلم على معضلة إمكانية التصديق بأن نكتشف في نهايته أن البطل كان يحلم، أو كما يقول له الطبيب النفسي في منتصف الفيلم بأن كل أوهامه بخصوص النفاذ عبر الجدران ليست سوى نتاج عقدته من اضطهاد مديره، ومحاولة للتعويض أو الانتصار بعيداً عن الواقع. يُعيدنا الفيلم إلى أرض الحقيقة، يستيقظ سكر أفندي ويتحلى ببعض الشجاعة ويرفع صوته على مديره، وبسهولة غير مفهومة يستعيد كرامته وتتم ترقيته في العمل ويتزوج المرأة التي يحبها. تظهر الخوارق كمجرد أوهام، ولا يحتاج التصدي لغياب العدالة سوى إلى تغييرات راديكالية أو مواجهات جذرية بخيال جامح، فكل ما احتاجه الأمر من سكر هو بعض الشجاعة الفردية.

فانتازيا إكسير الشباب تتجاوز التراث الأسطوري لتكون واحدة من الطموحات القصوى للخيال العلمي في مواجهة معضلة الفناء، عقار عجيب بأبعاد وجودية. ففي الفيلم الكوميدي هـ3 (1961)، يظهر دواء بإمكانه إعادة الشباب. تبدو الحبكة أقرب إلى الخيمياء مرة أخرى، لكن العقار المخترع يظهر في الفيلم علمياً مع لمسة فانتازية، بأطقم طبية، وتغطية صحفية كبيرة، بالإضافة إلى جهاز معدني ضخم يومض بأضواء ملونة، يدخل إليه المحقونون بالعقار ويخرجون أصغر سناً. يتناول المعلم عباس هذا العقار، وهو في عمر الثمانين، فيصبح شاباً. لكن ذلك التحول الإعجازي يقود إلى نتائج كارثية، فلا أحد يتعرف عليه في صورته الجديدة، ويستولي مُساعده على كل أملاكه، ويقوده نَزَقُه إلى محاول الزواج بحبيبة ابنه، ولاحقاً يقتله عن طريق الخطأ. يلجأ الفيلم إلى تقنية الحلم مثل سابقه، للتحايل على معضلة إمكانية التصديق، فالمعلم عباس يستيقظ من هذا الكابوس المرعب، ليتوقف عن تصابيه، ويقوم بتزويج ابنه لحبيبته. تظهر سردية الفيلم وكأنها تُخبرنا بأن تحدي الطبيعة وحركة الزمن والشيخوخة تأتي بنتائج كارثية، وتخرّب أُسُس المجتمع كافة: الملكية الفردية وتماسك علاقات الأسرة والأدوار العمرية لأفرادها وتراتبيّتها. هكذا ينقلب الخيال الجامح الطامح للتحرُّر من سلطة الطبيعة والبُنى المجتمعية المرتبطة بالتصنيف العمري إلى رجوع لها وترسيخها، أما العيادة الطبية وجهازها المعدني العجيب فيدمّره الزبائن الغاضبون في نهاية الفيلم، وتعود الأمور إلى نصابها مرة أخرى.
تتكرر ثيمات مشابهة في أفلام أخرى، مثل عاشور قلب الأسد من إنتاج العام نفسه، والذي يتناول فيه البطل ضعيف البنية عقاراً يمنحه قدرة خارقة تمكّنه من جذب أنظار حبيبته. وفي أونكل زيزو حبيبي (1971) يحدث الشيء نفسه، وفي كلا الفيلمين الكوميديين تفشل العقاقير وقدراتها الخارقة في تحقيق تغيير حقيقي، فإما يكون تأثيرها مؤقتاً فقط، أو تقود إلى نتائج عكسية، ولا بدائل سوى مواجهة الواقع كما هو، أو القبول بحدوده كإمكانية وحيدة متاحة.
تصل ثيمة العقاقير العجيبة إلى حبكتها الأكثر إتقاناً في فيلم الرقص مع الشيطان (1993)، ويصبح المضمون السياسي أكثر حضوراً، مع إحالات دينية مكثفة. يعود الدكتور واصل من الاتحاد السوفيتي بعد إتمامه لدراسة الدكتوراه في علم النباتات هناك، لكنه يعود بقناعات مادية وأنانية، متخلياً عن إيمانه بالدين والروحانيات. يكتشف البطل عقاراً مستخلَصاً من إحدى النباتات يمكّنه من السفر عبر الزمن، وينهار الاتحاد السوفيتي في منتصف الفيلم، في دلالة مباشرة ورمزية أيضاً، ويقود العقار إلى نتائج كارثية كالعادة. يتحطم الدكتور واصل نفسياً ويهاجم زوجته الحامل ويحاول قتل جنينها. يتعامل الفيلم مع سؤال إمكانية التصديق باللجوء إلى تقنية التوهم أيضاً. فالفيلم ينتهي بالبطل في غرفة بمشفى للأمراض العقلية، حيث يكتشف أن العقار كان للهلوسة، وأن كل رحلاته عبر الزمن كانت مجرد أوهام تحت تأثيره، ويستعيد بعد ذلك إيمانه. يقدم الفيلم أكثر من مجرد دعاية مضادة للشيوعية والفلسفات المادية، وإعلان نهائي واحتفالي بهزيمتها. فبالإضافة إلى اللغة والعلامات الدينية التي تتخلّله، في دلالة على تحولات المزاج العام في مصر مطلع التسعينات، يتصدى الفيلم لمسألة أخلاقيات العلم، وتحديداً تلك المسموح بها في إطار قواعد الدين التي لا يتم التعدي فيها على الغيبي.
جراحة الأدمغة
يُعدّ الفيلم الكوميدي حرام عليك (1953) نموذجاً مبكراً للباروديا في السينما المصرية، تظهر فيه محاكاة ساخرة لأفلام هوليوود بشكل واضح، وتمزج ثيمات الخيال العلمي من فيلم فرانكشتاين مع فانتازيا البشر/الوحوش المتحولين من أفلام المستذئبين. سهلت كوميديا الفيلم عملية القفز على حدود الأصناف الفنية ودمجها دون جهد كبير. إذ يظهر العالِم الذي يسعى لإجراء عملية نقل دماغ من شخص حي إلى جسد فرانكشتاين كشخصية شريرة ومخيفة، ويبدو العلم هنا أيضاً أداة خطيرة ويصعب التنبؤ بنتائجها كما في حالة فرانكشتاين الأصلية. أما معركة الأبطال الحقيقية هي إيقاف العلم عند حدود مقبولة وإرجاع الأمور إلى «طبيعتها». يصعب تصنيف فيلم حرام عليك كخيال علمي، لكن يمكن اعتباره مقدمة لسلسلة من أفلام جراحات الأدمغة، بخيال أقرب إلى العلمية.

في الفيلم الكوميدي أبو عيون جريئة (1958) يصبح المضمون السياسي أكثر وضوحاً. فبعد ستة أعوام من ثورة يوليو، يسعى الدكتور النمساوي، فون روبين ستوب، إلى إجراء عملية لتبديل دماغ زوجته الأجنبية المتهتكة (تقوم بدورها الراقصة كيتي)، باحثاً عن دماغ امرأة مصرية «شريفة» بغرض تغيير أخلاق زوجته. ينجح الدكتور عن طريق الحيلة وبمساعدة عصابة إجرامية في تبديل دماغ «أم نواعم» (زينات صدقي) بدماغ زوجته، لكن النتيجة تكون كارثية كما هو متوقع، فالخليط بين جسد كيتي وسلوك زينات صدقي، وجسد زينات صدقي وسلوك كيتي، مثير للضحك والنفور أيضاً. مرة أخرى يبدو نوع بعينه من العلم دخيلاً وأجنبياً، وكذلك إجرامياً، بنتائج ذات تبعات أخلاقية خطرة، ولا يبدو أن هناك حلاً سوى فصل الدماغ الغربي عن الجسد الشرقي مرة أخرى، والدماغ الشرقي عن الجسد الغربي.
بالإضافة إلى البعد القومي، تخضع النساء في الفيلم، بأجسادهن وسلوكهن إلى سلطة العلم التي يحتكرها الرجال معظم الوقت، كما يظهر في كل أفلام الخيال العلمي التي نتناولها. الاستثناء الوحيد هو فيلم خطة جيمي (2014) حيث تتمكن ساندي، طالبة الكيمياء المتفوقة، من تطوير عقار «حجر الحياة» من بقايا شهاب سقط على الأرض. لكن العقار لا يمنحها أي قدرات خارقة، بل يمكّنها فقط من فقدان وزنها الزائد لاستمالة حبيبها، وهو الأمر الذي لا يستمر كثيراً، حيث إن تأثير العقار مؤقت فقط، فتضطر بعد ذلك إلى اللجوء للطب التقليدي وإجراء عملية جراحية لتفقد وزنها مرة أخرى، وتنجح في الزواج من حبيبها أخيراً. هكذا يبدو الخيال العلمي والطب الجراحي التقليدي في علاقته بالمرأة مرتبطاً بإخضاع جسدها للضبط، بطرق لا تخلو من انتهاك وعنف، ليتوافق مع معايير معينة تسعى لإرضاء الرجال بشكل أو بآخر.
تأتي نهاية الثمانينيات هنا أيضاً بجرعة قوية من الإحالات الدينية تهيمن على ثيمة جراحة الدماغ، ففي جري الوحوش (1987)، يعود الدكتور نبيه من الخارج كالعادة، لكن من لندن هذه المرة لا من الاتحاد السوفيتي. ويحاول علاج العقم بعملية زرع جزء من الفص الأمامي للغدة النخامية من متبرع قادر على الإنجاب، وينجح في إجراء العملية، التي تتعارض مع القوانين المصرية، في لندن، وينتهي الأمر بنتائج كارثية على كل الأطراف كما هو متوقع. ولكن الفشل لا يتم فهمه كتجاوز العلم لحدود أخلاقياته والقانون العام، بل يتم الإشارة له بشكل مباشر كتعدٍّ على التوزيع الإلهي للأرزاق، أي المال والبنون، بين البشر.
السفر في الفضاء وعبر الزمن
يصل إسماعيل ياسين إلى الفضاء عن طريق الخطأ في فيلم رحلة إلى القمر (1959). يبدو الفيلم متأثراً ببرنامج الصواريخ العسكرية المصري، الذي أشرف عليه علماء من ألمانيا الشرقية في فترة الخمسينيات. فالصاروخ الذي سينطلق من قاعدة مصرية صمّمه عالم ألماني سيكون على متنه أيضاً مع البطلَين المصريَّين أثناء الرحلة الفضائية. ويظهر الاحتفاء بالعلاقات مع السوفييت ونجاحاتهم الفضائية جلياً أيضاً، فركاب الصاروخ يصادفون الكلبة لايكا في طريقهم إلى القمر. يحمل الفيلم عنصراً دعائياً بالطبع، فأول البشر الهابطين على القمر هما مصريان بصحبة ألماني شرقي، لكن يظل جانب البروباغندا ضمنياً وخافتاً. المؤثرات الخاصة وجماليات الصورة للفيلم تبدو متأثرة بأفلام الخيال العلمي السوفيتية، طَموحة ومتقنة بشكل مدهش ومثير للإعجاب نظراً إلى تاريخ الإنتاج. يتميز الفيلم بدقته العلمية وواقعيته في تصوير سطح القمر وانعدام الوزن في الفضاء وتصميم بدلات رواد الفضاء. وينقلب الأمر بسرعة إلى فانتازيا إيروتيكية، فالأبطال يلتقون بعدد كبير من النساء القمريات المثيرات، بزي موحد وفساتين قصيرة، ولهن شخصيات في غاية البراءة أو السذاجة حين يتعلق الأمر بالعلاقات العاطفية والجنسية. لكن، مع الاحتفاء البادي بالعلم، يحمل الفيلم تحذيراً شديداً منه أيضاً، فركاب الصاروخ يصلون إلى سطح القمر ليجدوا ديستوبيا فضائية، ناتجة عن حرب ذرية بين سكان القمر، ويحذر الباقون منهم سكان الأرض من كارثية التسلح الذري. لا يبدو أن هناك مفرّاً من الرجوع إلى الأرض، وينتهي الفيلم بعودة الأبطال الثلاثة إلى القاعدة المصرية، ومعهم شيء وحيد جلبوه معهم من القمر: النساء الفضائيات المثيرات.

عن طريق الخطأ أيضاً يسافر أبطال مملكة الحب (1973)، لكن عبر الزمن، فرحلة الأبطال الثلاثة المقصود بها الذهاب إلى المستقبل، ترتد إلى الماضي بسبب مشكلة تقنية. يظهر التأثر بأفلام الخيال العلمي الأميركية واضحاً في الأزياء والديكورات وتصميم الصورة، والتي تبدو جميعها استثنائية مقارنة ببقية إنتاج الخيال العلمي المصري. يظهر العنصر الإيروتيكي هنا أيضاً، فالرحلة التي تصل إلى القارة المفقودة، أطلانتس، تستقبلها ملكة الجزيرة ووصيفاتها، وهن نساء مثيرات ومحارِبات، ويتميّزن بقدر كبير من البراءة العاطفية أيضاً. تتركز المعضلة الأساسية للفيلم حول طلب ساكنات الجزيرة من الوافدين الجدد إنقاذهن وحملهن إلى المستقبل، ويقتصر العائق الأساسي في معارضة قائد الرحلة لتغيير مسار التاريخ. ويبدو التاريخ هنا صورة أخرى لنظام الأمور القائم وتسلسلها، كالطبيعة أو الغيب أو العلم الإلهي، جميعها لا يجب التعدي عليها أو محاولة تغييرها. ينتهي الفيلم بحلول الكارثة على القارة المفقودة، بإخراج متقن لمشاهد الدمار بمستوى يتفوق على المعتاد في الأفلام المصرية. وكما انتهت الرحلة إلى القمر بالعودة إلى الأرض، يعود أبطال مملكة الحب من الماضي إلى الحاضر. يعودون وحدهم، وبلا غنائم من رحلتهم، لكن وبشكل غامض، يجدون نساء الأطلنتس المثيرات في انتظارهم عند رجوعهم إلى الحاضر. لتظهر النساء مرة أخرى كغنائم أو جوائز تذكارية لغزوات فضائية أو عبر زمنية.
خاتمة
تصل أفلام الخيال العلمي إلى أكثر صورها إتقاناً على يد المخرج كمال الشيخ في فيلم قاهر الزمان (1987)، فالشيخ، الذي قدم نجيب محفوظ وأدباء آخرين إلى جمهور السينما لأول مرة، وداوم على تقديم معالجات سينمائية لنصوص أدبية، اقتبس فيمله عن رواية لنهاد شريف تحمل الاسم نفسه، من إصدار العام 1973. تدور الحبكة حول تجارب يجريها طبيب مصري على إمكانية تجميد الأحياء، لفترات طويلة، ثم إعادتهم إلى حالتهم الطبيعية مرة أخرى. يربط «قاهر الزمان» هذا كله بعلوم الفلك لدى قدماء المصريين وطقوس التحنيط، ليُضيف بُعداً محلياً لخياله، وليؤكد على أن فكرة «العلمية» ضاربة في الماضي المحلي وليست منتجاً غربياً. يلتزم الفيلم بمنطق علمي محكم ويمكن تصديقه، وبتكنولوجيا سهلة المنال، هي تقنية التجميد، ويربطها ويبرّرها بالبيات الشتوي لكائنات حية أخرى. لكن تلك الإمكانية العلمية القابلة للتصديق تصطدم بحدود أخلاقيات العلم والقانون، كالعادة، ونجد الطبيب متورطاً في عملية خطف وتؤدي تجاربه إلى موت اثنين من المرضى الذين يُخضعهم للتجميد بقصد إنقاذ حياتهم. قضية أخلاقيات العلم والخوف من تبعات انفلاته تبدو أكثر وضوحاً وجدية وتفصيلاً هنا، فالطبيب ليس شريراً، بل حسن النية إلى حد كبير، ويقدم مبرِّرات شبه مقنعة للمغامرة بحياة عدد من الأفراد لمنفعة البشرية كلها، مثيراً أسئلة أخلاقية تتجاوز العلم إلى العلاقات الأوسع بين الفرد والجماعة. وبالقرب من نهاية الفيلم ينجح في تجربته، وينقذ أحد الأشخاص من موت محقق بعد تجميده مؤقتاً. لكن تلك النهاية كانت قد ستصبح إشكالية إلى حد كبير، ولذا تتسارع الأحداث في الدقائق الأخيرة، ويُقتل الطبيب ويُحطَّم معمله بيد أحد معاونيه الذي رأى في نجاح العملية كفراً وتحدياً للإرادة الإلهية، فإحياء الموتى هو شأن غيبي في يد الله وحده.
ننتهي إلى النقطة التي بدأنا منها. من فيلم عيون ساحرة، إلى فيلمنا هذا، واجه الخيال العلمي في السينما المصرية معضلة إمكانية التصديق: كيف يمكن تصوُّر أبعاد علمية فائقة في سياق وواقع فقير علمياً وتقنياً. تحايَل صناع الأفلام على تلك المشكلة بوسائل عديدة، أكثرها الكوميديا والمحاكاة الساخرة، أو خلط العلمي بالفانتازي، أو بحيلة التوهُّم أو الحلم، وقليلة جداً هي الأفلام المصرية التي تعاملت مع الخيال العلمي بوصفه إمكانية جادة. في أغلبية الحالات كان العالم أجنبياً، أو مصرياً قادماً من الخارج، أو صاحب قناعات معارضة للسائد. وبدت الدوافع وراء ذلك متنوعة، إما كإقرار بوضع العلم محلياً كمنتج مستورد، أو لوصم صور بعينها منه كعنصر دخيل أو أجنبي يثير التوجُّس والحرص. في العادة يظهر التقدم العلمي أو أنواع منه كتهديد وعمل إجرامي، له تبعات شديدة الخطورة على الأفراد والمجتمع، فيما كانت استعادة التوازن تتم عبر إرجاع الأمور إلى نصابها أو الحفاظ على الوضع القائم، وأحياناً القبض على العالم أو قتله وتدمير المعمل أو الآلة العلمية. حتى في حالة السفر إلى الفضاء أو القمر، يكتشف المسافرون حالة خراب كامل في تلك العوالم البديلة، ويبدو الخلاص في العودة إلى نقطة المغادرة، حيث يظهر عالمنا، ومصر تحديداً، أفضل العوالم الممكنة. لا يكشف ذلك بالضرورة عن خوف أو عداء للعلم ينتشر في سرديات الخيال العلمي التي تعرّضنا لها، بل على الأرجح يكشف عن استهداف لحدود الخيال، بعملية تقلب الخيال ضد نفسه، ليضع قيوداً على جموحه ويرسخ الوضع القائم في حدود الطبيعي والغيبي والقانوني والبنية الاجتماعية والتراتبية والأبوية، والديني الذي يصبح أكثر وضوحاً منذ نهاية السبعينات. في العقدين الأخيرين، ظهرت موجة جديدة من أفلام ومسلسلات الخيال العلمي المصري (لم يتسع المجال للحديث عنها في هذا المقال)، ظلت في معظمها كوميدية، لكن متحررة من سؤال أخلاقيات العلم، وسعت في معظمها لتوظيف محاكاة الخيال العلمي الهزلية لكشف مفارقات الحاضر ونقده أو الاكتفاء بمتعة السخرية منه.