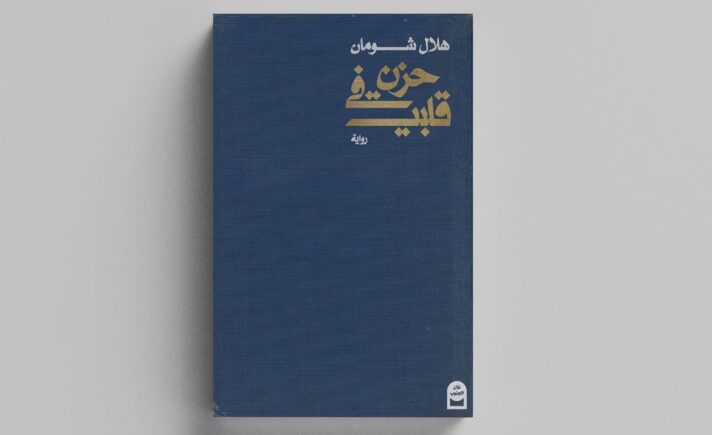لا أذكر تحديداً من رأيت أولاً: الفتاة على الدراجة أم الرجل الممتد على الأرض. لا أظن الأمر مهماً في كلتا الحالتين، ولن يؤثر في أحداث وسياق هذه القصة. الشيء الوحيد الذي لا شك فيه هو أنني رأيت الفتاة على الدراجة حين مرّت بمحاذاتي، ورجل الأرض ذاك رأيته حين كان أمامي على بعد أمتار قليلة. كان رأسه والجزء العلوي من جسمه على الطريق بينما كانت ساقاه على الرصيف.
كنت أمشي وأفكر في أشياء تخطر على بالي تحديداً في هذا اليوم ذاته من كل عام. أشياء لست فخوراً بها، كما سيخبرنا الشاب الأصلع بعد قليل، أشياء عن أمور بإمكاني القول – الآن تحديداً وأنا أحكي ما جرى – إنها تافهة، رغم أنها لم تكن كذلك حينها، ولن تكون كذلك بعد حين. أقصد، أشياء يخجل الشخص من التحدث عنها اليوم وفي هذه اللحظات بالذات، فيها حنين واغتراب وذكريات وانقشاعات وخرافات، وأتساءل مجدداً كيف يمكن للإنسان أن يصل إلى هذا الكم من الخيال والهرطقة والخزعبلات؟ لا أدري حقيقة، قد يكون هذا أعمق وصف لهذه الحالة، والدواء هو الخروج للمشي.
حين وصلت الفتاة إلى رجل الأرض الممدود، خفّضت من سرعة دراجتها تدريجياً حتى توقفت بالقرب منه. كنا في حي الجامعات: شارع طويل يمتد من قلب المدينة حتى المطار في أقصى الجنوب. لم يكن الحي مزدحماً عشية ذلك اليوم، على الأرجح بسبب خلوّه من الطلاب. لكن ثمة حركة خفيفة من المشاة وراكبي الدراجات. وكانت معظم المحلات مغلقة.
تاريخ اليوم يضيف سحنة ملساء على الجو.
* * * * *
«مرحباً، هل أنت بخير؟ هل بإمكاني مساعدتك؟».
أبعدت الفتاة دراجتها عن الطريق وأسندتها إلى الحائط بالقرب من باب المصرف المغلق، وكان هناك أيضاً مرتبة خمّنت أنها تعود للرجل الممدود. اقتربت من الرجل وجلست مقرفصة. ظلت عيناها تنظر إلى وجهه بينما تتحدث على التلفون. رأيتها تحرك فمها من وقت لآخر وراقبت تحولات ملامح وجهها وهي ساكتة تسمع ما يقوله الشخص على الجهة الأخرى من الخط. حين صرت على مسافة قريبة منهما، رفعت الفتاة رأسها وسألت إن كان عندي بعض الماء.
جلستُ مقرفصاً على طرف الرصيف حيث ساقا رجل الأرض. كان يهذي بكلام لم أفهمه، يفتح عينيه وينظر إلى السماء، يئنّ بصوت خفيض، ويحاول استجماع قواه ليخبرنا وصيّته أو نصيحة الوداع، أو لعلّه يطلب الماء. اقتربَت منه الفتاة مسافة أكبر وأشربَته من القنينة. رأيت ندبات حادة بارزة على وجهه، وكان ثمة اعوجاج في الجهة اليسرى من فمه تسرب منها الماء. لم يبدُ عليه المرض، لكن الإنهاك والتشرد صنعا طبقة غطت جلده.
سألتها إن كانت تعرف سبب فقدانه الوعي. قالت لا أدري. إلا أنها رأته هكذا حين مرت من هنا صباح اليوم أثناء ذهابها إلى العمل. وحين رأته مجدداً وهي في طريق عودتها، قالت مستحيل.
«كدت أدهس رأسك بدراجتي قبل قليل».
لم أستطع إبعاد التفكير في أبيها. أقصد، في فكرة أن هذا الرجل يذكّرها بأبيها، يُعيد إليها ذكريات ومشاهد ضبابية، لليالٍ اشتد فيها سُكْر الوالد حتى فقد وعيه هكذا كرجل الأرض الآن، لكن على أرض المطبخ. ربما اشمأزّت منه وكرهته، ولمّا كبِرت قليلاً تركت البيت لهذا السبب ولم تعد. إنّها حتى اليوم تكره الحديث عنه، لكنها اليوم في العمر الذي يتحول فيه البشر إلى كائنات متفهمة لطبيعة وظروف آبائهم. أكاد أسمعها تقول إنها لا تبرّر لأبيها ما فعله، لكنها تفهم ظروف حياته، فقط لأنها وصلت إلى العمر الذي يفهم فيه البشر أن أباءهم أيضاً كانوا أطفالاً كبرواً على حين غفلة. في صوتها نبرة حنونة. ودودة. تحاول فك رموز هذيان رجل الأرض عندما يحاول التفوُّه بشيء أثناء لحظات يقظته. أحياناً تدّعي أنها تساعده كي يشدّ من همة نفسه ويستعيد توازنه. لكن رجل الأرض يقاوم ليظل على الأرض، متمسكاً بفكرة البقاء حيثما هو. حاولت أن أساعدها، لكن رجل الأرض فتح عينيه على وسعهما ورفع يديه مشيراً إلينا نحن الاثنين بألا نقترب. ثم عاد ليمتد على الطريق.
«على أي حال، لقد اتصلت بالإسعاف. لا بد أنهم سيصلون عما قريب».
* * * * *
كان من الضروري أن أقول شيئاً أنا أيضاً عوض الجلوس هكذا والنظر إليهما كالمغفل. أن أشجعه على الوقوف مثلاً، أن أهمس شيئاً في أذنه، ربما أهدده وأقول له إن تحتي سكين وأغمز، أو أصفق له، أو أحمله على كتفي وأرميه على المرتبة أمام باب المصرف. اقترحت أن تسكب على وجهه ما تبقى من الماء في القنينة، بما أنها أول فكرة مقبولة تخطر على بالي. قالت إنها فكرة جيدة. لرجل الأرض عيون زرقاء غائرة بانت حين بخّت الفتاة على وجهه الماء. بدا كما لو أن في عينيه أسرار الكون كله، أو هذا على الأقل ما خطر ببالي في لحظات الحساسية المفرطة هذه. ربما كل ما في الأمر أنه لم يعلم أين هو وبالتالي غارت عيناه. بخّت الفتاة على وجهه ماءً أكثر وبدا للحظة كما لو أنه استعاد وعيه بالكامل. هو الآن ينظر إلينا بينما يمر أمامه شريط حياته. نظر إلى الفتاة مطولاً، ثم نظر إلي. بدا كأنه يحتضر.
«إنها فتاة طيبة. اعتنِ بها جيداً».
قالت الفتاة: «دونت بي سيلي!».
وهنا قلت ما معناه أن هذه الفتاة لا تحتاج إلى أي منا للاعتناء بها، أنها في الحقيقة قادرة على أن تعتني بنا نحن الاثنين معاً.
تعتني بنا نحن الاثنين معاً؟

كدت أسمعها تقول «دونت بي سيلي» لي أيضاً، لكن عوض ذلك رأيت اللخبطة في عينيها. ونظرَت باتجاه رجل الأرض كما لو أنها تحاول تفادي النظر إلي. هل أشرح معنى كلامي؟ لكن ما هو المعنى أصلاً؟ هذه الفتاة لا تعرفني، ولا أنا أعرفها، ولا يوجد شيء أقوله ليشرح قصدي فيما قلته. وإن حاولت فعل ذلك فعلى الأغلب لن تقول شيئاً، وربما لن تفهم، وفي أحسن الأحوال ستقول «ذاتس أوكيه»، ويزداد ارتباكها ويتضاعف حَرَجي.
ثم تساءلتُ عما أفعله هنا الآن، في هذه اللحظة بالذات؛ جالساً هنا أحاول مساعدة شخص أو إنقاذ آخر، وأنا بالكاد أقدر على مجاراة أفكاري وهواجسي، وتاريخ اليوم موشوم على عظامي. لعلي أحاول فقط إطالة الوقت بفعل أي شيء. أقصد، ربما تمنيت في هذه اللحظة أن أكون مثل الفتاة، عكس قطيع المشاة وراكبي الدراجات، قادراً على أن أجلس القرفصاء لأساعد شخصاً مرتحلاً في عقله، بعيداً جداً وإن كان لا يزال هنا، بالكاد يرانا، وإن رآنا لن يتذكرنا على أي حال.
* * * * *
«أوي، ألن تستيقظ بعد؟ إنك تشبه البصقة يا رجل».
كانت العبارة الأخيرة لشخص له صوت فخامة. لم أره قادماً. لكني أحسست به لما وقف بالقرب مني. حين رفعت رأسي رأيت سرواله الأسود، ثم وشوماً عديدة تمتد من حيث يديه عند جيوب سرواله وحتى أكمام تيشرته الأزرق. صلعته نصعت حين أُنير عمود الضوء فوقه.
«أوي، أتسمعني؟ عيب عليك أن تقضي اليوم كله نائماً على الأرض هكذا يا رجل! هيا استيقظ وقف».
ولدهشتنا انتصب الرجل واقفاً مكانه. صفّقت الفتاة له – أم للشاب؟ – وهللت. قالت إننا دللناه حتى لم يعد يقوى على الوقوف. أمسك الشاب الأصلع رجل الأرض من خصره وسأله أين يسكن، ووعده أن يأخذه إلى هناك.
«لا أظنه يسكن بيتاً».
«لعله يسكن هنا…»، أشرت للمرتبة المفروشة عند باب المصرف.
«لكنني اتصلت بالإسعاف منذ قليل، وهم في الطريق الآن. ربما من الأفضل أن يظل واقفاً».
لم يستطع الشاب الأصلع أن يظل فترة أطول حاملاً رجل الأرض من خصره. تسلحب الأخير عائداً إلى الأرض، وحين حاول الأصلع شدّه وقعا كلاهما. الشاب على الرصيف، ورجل الأرض كما في الأول، رأسه على الطريق وساقاه تتدليان على الرصيف.
«كان بإمكانك أن تضعه في مكان بعيد عن الطريق».
«لم أقدر على حمله أكثر من ذلك»، قال الشاب ومسح على صلعته.
«هيا الآن، عليك الوقوف، لن يكون باستطاعتي قضاء الليلة كلها هنا لأحميك من خطر الطريق».
«زميلي، هل عندك سيجارة؟».
أعطيته واحدة وأشعلت واحدة لي. ثم طلبت مني الفتاة واحدة أيضاً. قالت إنها توقفت عن التدخين منذ شهر، لكنها تشعر بحاجة إليه الآن، وعرضت عليّ بعض النقود مقابل ذلك. رأيتها طفلة تسرق سجائر أبيها المخمور في الصالون. حين فتح الرجل عينيه ورآنا ندخن أشار لنا بإصبعيه السبابة والوسطى. أشعلت له واحدة أيضاً.
قال الشاب الأصلع إن المدينة تغيّرت، تغيرت كثيراً. كان ينظر إلى الشارع، وللحظة خِلتُه يتحدث إلى نفسه. سألَتْه الفتاة بعد برهة إن كان مسافراً. قال شيئاً من هذا القبيل. أعادت الفتاة ما قاله، لكن هذه المرة بنبرة سؤال: «كنت في العلبة؟».
استغرق مني الأمر بضع جمل تبادلها الاثنان حتى فهمت أنه يقصد السجن.
«هل بإمكاني سؤالك عن السبب؟».
«ظروف الحياة». قال أيضاً إنه ليس في الأمر أي فخر أو قصة ظريفة يحكيها للآخرين.
نفثنا الدخان مقرفصين حول رجل الأرض. والشاب الأصلع ناداه بالطريقة ذاتها، المفعمة بالأمر والتشجيع، الطريقة التي نجحت قبل قليل في جعله ينتصب، لكن صوته هذه المرة خرج محشرجاً، حزيناً، لا يكفي لانتصاب شعرة. كان رجل الأرض قد عاد للسُبات بينما ما تزال السيجارة تتدلى من فمه. الفتاة أيضاً رددت الكلام نفسه؛ أنها لن تقدر على البقاء هنا الليل كله لتحميه من خطر الطريق، وأن عليه أن يتحرك. أنه قد يخسر رأسه لو ظل ملقى هكذا الليل كله. بدا عليها شعور الملل، وأنها لم تعد ترى في وجه رجل الأرض صورة أبيها. أما أنا – وقد امتلأت بكل أسباب الغياب! – فحساسيتي المفرطة ستقتلني يوماً، وإن لم تفعل فإنها على الأقل ستحوّلني إلى كائن كئيب.
* * * * *
«زميلي، هل بإمكاني استعارة هاتفك؟».
«أوكي».
«كل الهواتف العمومية التي مررت بها معطلة. هل توقف الناس عن استخدامها؟».
ضحكت الفتاة ملء صوتها. لم أسمعها تضحك هكذا من قبل. لم يبدُ عليها منذ قليل أنها من الأشخاص الذين يضحكون بصوت عال. كان رجل الأرض يقول شيئاً لم يختلف عن هذيانه المعتاد. لكن الفتاة هذه المرة فهمت ما قاله. بدا الرجل الآن كما لو أنه مستلقٍ على سرير مريح، يحكي لابنته حكاية من الزمن الذي ولى، مبتسماً، بشوشاً، والشاب بجانبي لم يفلح في استعادة الرقم الذي يريد الاتصال به. بعد عدة محاولات أخرى قال إنه متأكد من الرقم، لكن أحداً لم يرد. وقال حين أعاد لي الهاتف أنه اعتقد أن الناس توقفوا عن استخدام هذا النوع من الهواتف.
«مروّجو المخدرات ما زالوا يستخدمون هذا النوع من الهواتف».
مروّجو المخدرات ما زالوا يستخدمون هذا النوع من الهواتف؟
* * * * *
كل ما في هذه القصة أنني كنت أمشي متسكعاً حول المدينة محاولاً الهروب من شيء ما لست أدري ما هو، لكنه هناك، قابع في مكان ما، وأشعر بالسخافة أكثر لعدم قدرتي حتى على إدراك ما هو. أحس به كل يوم. قبل أن أستيقظ عادة، وبعد أن أنام، أما مساحة الما-بين هذه أقضيها شارداً هكذا لأجد نفسي في آخر اليوم أجلس لنصف ساعة أو ساعة، أراقب رجلاً مرتحلاً ممدداً على الأرض، غير قادر على نطق كلمة لاثنين يجلسان قبالتي، أحدهما خرج للتو من السجن، وأخرى على الأغلب تتذكر أباها السكران الذي مات دون أن تتصالح معه، تضحك وتكاد تبكي، تسب النجدة والإسعاف، وبين الوقت والآخر تقول إن هذه البلاد تتجه نحو الجحيم. ثم سألتني عن البلاد التي أنا منها. أخبرتها. سأل الشاب الأصلع أين تقع هذه البلاد. أخبرتْه الفتاة. نظرت تجاهي تبحث عن إشارة تأكيد.
«مسافة طويلة، طويلة جداً»، قال الشاب الأصلع. «وكم صار لك في هذه البلاد؟».
«وصلت في مثل هذا اليوم بالضبط قبل خمسة عشر عاماً».
اليوم باستطاعتي القول إنني قضيت نصف حياتي في هذه البلاد، والنصف الآخر في البلاد التي ولدت فيها.
لم أجد داعياً لقول هذا.
«حقاً؟ هذا مستحيل. لقد صدر حكم السجن علي في هذا اليوم نفسه قبل خمسة عشر عاماً».
الفتاة كانت أكثرنا دهشة. صاحت: «يا إلهي! ربما في هذا الأمر معنى». كنت سأقول ربما، لكنني قررت أن أترك الأمر برمته دون أي تعليق. هكذا أفضل.
وعمّ الصمت مجدداً، ندخن ونراقب رجل الأرض يغط في نوم عميق، وقد صار بامكاننا سماع أنفاسه البطيئة والعميقة كأنها تصدر عن كهف.
«ما الذي سنفعله الآن؟»، قلت قاصداً موضوع رجل الأرض، لكن الشاب الأصلع راح يتحدث عما ينوي فعله في الحياة. قال إنه ينوي فعل الكثير. ثمة أمور عليه أن يصفّيها أولاً، حسابات قديمة وعمل كثير، والأهم، أنه لن يعود إلى السجن أبداً، مهما حدث، ولن يكون عهده هذا كما في المرات السابقة. وقتها كان مراهقاً. والآن يعرف معنى السجن ويعرف أنه لا شيء يستحق السجن. مهما حدث.
«وأنت؟ ما مشاريعك بعد قضاء نصف حياتك هنا؟ لا أظنك ترغب في البقاء هنا مدى الحياة، أليس كذلك؟».
في العادة حين أخبر شخصاً عن اقتراب موعد انقسام حياتي إلى نصفين، بين بلدين، أقول أيضاً أنني احتفالاً بذلك سأهاجر لأعيش خمسة عشر عاماً أخرى في بلاد أخرى. ربما جورجيا أو إستونيا أو كينيا…، أي واحدة من هذه التي تنتهي بياء وألف. لا أعرف فيها أحداً، ولا أتحدث بلغة ناسها.
قلت: «أظنني سأعود».
«هل تقصد.. ما اسم بلادك مجدداً؟».
أخبرته الفتاة.
«بل حيث أسكن، هناك»، وأشرت إلى آخر الشارع رغم أن البيت ليس هناك.
اقترح أحدهما أن نتعاون على حمل الرجل ووضعه على المرتبة بالقرب من باب المصرف. لم أعد أذكر من الآن، لكن أحدهما اقترح والآخر وافق، وأنا كذلك. رفع الشاب الأصلع ساقَي رجل الأرض، بينما الفتاة رفعته من ذراعه اليسرى وقمت أنا بالشيء ذاته من الجهة الأخرى. وضعناه برفق على المرتبة.
«قنينة الماء هذه لك، تفضل. شكراً».
ووقفنا بالقرب من باب المصرف ندخن ما تبقى من سجائري، وتحدثنا حول ما تغير في المدينة منذ خمسة عشر عاماً. قالت الفتاة انها تعيش هنا منذ عام، ولم تحظ برؤية المدينة قبل خمسة عشر عاماً؛ كانت طفلة حينها. ثم رمت عقب السيجارة، وقالت إنها تأخرت، عليها العودة إلى البيت وإعداد حقيبة سفرها، غداً ستسافر لقضاء إجازة الصيف مع أسرتها في بلاد ينتهي اسمها أيضاً بألف وياء.
«هل سيكون والدك هناك؟».
قالت «نعم». بعد برهة سألت لماذا.
«لا أدري. خطر السؤال على بالي فقلته. هذا كل شي».
صار الشارع فارغاً بأكمله الآن. لا بشر ولا سيارات، ولا حتى صوت لسارينات الشرطة والإسعاف. شعرت بشيء من الراحة يغمرني، أنني سعيد لكوني واقف هنا الآن، أن تظل هذه اللحظة إلى الأبد، أن أموري هانئة، وأن لا حاجة للذهاب إلى أي مكان آخر.