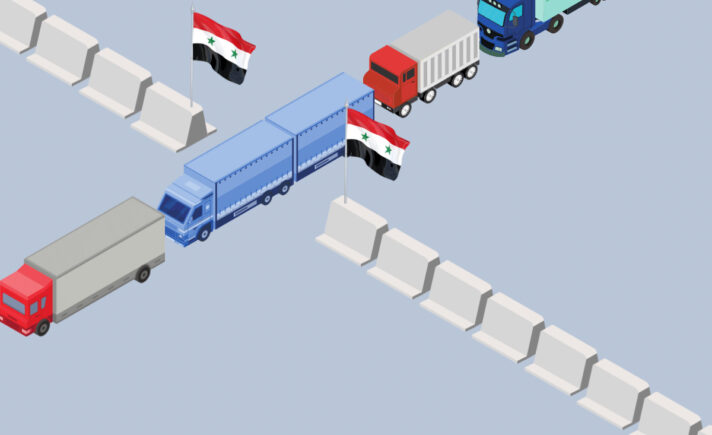مرّ أكثر من عامين على تعيين المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، والذي كان في واجهة العمل حول سوريا طوال هذه المدة، خاصةً في ما يرتبط العلاقة بالمعارضة السورية وتركيا. وقبل شهر من تعيين جيفري، كان قد جرى تعيين جويل ريبورن مساعداً لنائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد الشام ومبعوثاً خاصاً إلى سوريا، وهي ذات الفترة التي مرّت على إعلان الولايات المتحدة، عبر مبعوثها السفير جيفري، عن استراتيجية الأهداف الثلاثة في سوريا، والتي تتمثّل بمواجهة النفوذ الإيراني وإنهاء تنظيم داعش ومنعه من العودة، بالإضافة إلى تنشيط المسار السياسي.
وحتى انعقاد اللقاء الذي جمعه بأعضاء من الائتلاف المُعارض والهيئة العليا للمفاوضات في تركيا الشهر الماضي، لم يكن ريبورن في واجهة اللقاءات الدبلوماسية الخاصة بسوريا، بل كان يعمل بطريقةٍ مشابهةٍ لعمله السابق في مجلس الأمن القومي؛ من الخلف لمراقبة الأنشطة المعادية لواشنطن. وقد كان تقسيم العمل المُعلن عنه عند تعيين المبعوثين هو تسلم ريبورن مسؤوليات العلاقة مع الأردن ولبنان والضغط على حزب الله، بينما تسلّم جيفري العلاقات مع تركيا والمعارضة السورية. ويبدو أنّ جيفري، الذي كان في واجهة الأحداث طوال العامين الماضيين، قد بدأ يترك المجال لزميله من أجل القيام بأدوارٍ تتجاوز مهامّه المعلنة، ما قد يكون مؤشراً على صحة أنباءٍ، كان جيفري قد نفاها في وقتٍ سابقٍ من الشهر الماضي، تتحدث عن تركه لمنصبه على أن يتسلّم جويل ريبورن مهامّه.
بكل الأحوال، سيكون من المناسب اليوم إعادة النظر في استراتيجية الأهداف الثلاثة بعد عامين على إعلانها من قبل الإدارة الأميركية، فما الذي تحقَّقَ من تلك الاستراتيجية حتى الآن؟ وما هي الأهداف التي تواجه خطراً حقيقياً نتيجة التطورات المُستجدّة وسوء إدارة الملف السوري؟
كان المبعوث الأميركي جيمس جيفري قد أعلن، إبّان تسلّمه لمنصبه كمبعوثٍ خاص، عن استراتيجية واشنطن في سوريا. جيفري، القادم حينها من عمله الأخير كزميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، كان يمثّل وجهة نظرٍ ناقدةٍ لسياسات عهد باراك أوباما في سوريا، خاصةً في ما يتعلّق بالتراجع عن تهديداته بتوجيه ضربةٍ عسكريةٍ للنظام السوري في حال استخدم السلاح الكيميائي؛ هذا التراجع الذي كان، بالترافق مع عوامل أخرى، سبباً في تعزيز نفوذ طهران في سوريا، وإبعاد شبح السقوط عن نظام الأسد.
تُقدّمُ سنوات عمل جيفري كسفيرٍ أميركي في العراق تفسيراً معقولاً لتلك التوجهات التي نظّر لها قبل تسلّمه لمنصبه بشكلٍ رسمي، فعلى ما يبدو كان جيفري يرى أنّ الانسحاب الأمريكي من العراق، وما سبقه من تغيير في مهام القوات الأميركية، قد ساهم بشكلٍ ما في عودة تنظيم الدول الإسلامية إلى الحياة مجدداً. لكنّ سنتين من العمل تُظهران أن سياسات الولايات المتحدة وتوجهات جيفري قد وقعتا أيضاً في مشاكل ومعضلات، ربّما ليست أقل حجماً مما نجم عن سياسات واشنطن في العراق خلال عهد أوباما.
جيفري، الذي دافع بشكلٍ حاسمٍ دوماً عن قرارات رئيسه المرتبكة أحياناً في سوريا، اكتسب سمعةَ أنه حليف أنقرة المقرب في وزارة الخارجية الأميركية، نتيجة دعمه الدائم لمواقف أنقرة، وإعلانه الدائم عن تفهّمه لمخاوفها، حتى بعد إعلان تركيا بدء عملياتٍ عسكرية في منطقة الجزيرة السورية، وهو ما تسبّب بخسائر بين المدنيين وتهجير واسع لهم، كما تسبّب بشرخٍ في العلاقة بين الولايات المتحدة وحليفتها على الأرض في المنطقة، قوات سوريا الديمقراطية (قسد). وعلى الرغم من ذلك، كانت تصريحات جيفري بعيدةً جداً عن انتقاد أنقرة، التي أصبحت تمتلك موقعاً جديداً في السياسة الأميركية الرامية إلى الضغط على إيران في المنطقة.
اشتهر جيفري أيضاً بالرسائل التي كان يوجهها بشكلٍ مستمرٍّ إلى موسكو، بهدف الضغط على نظام الأسد لتمرير العملية السياسية، ودعواته لها للتخلي عن حليفها في دمشق الذي أصبح عبئاً عليها بعد العقوبات المتكررة التي طبقّتها الإدارة الأميركية بهدف شلّ أيّ عملية إعادة تعويمٍ سياسي للنظام، المسؤول عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقد كانت ضغوطات جيفري وتهديداته المستمرة لنظام الأسد، ولموسكو ضمنياً، أساسيةً خلال العام الماضي لتمرير مسار الدستور، إلّا أنّ الصورة التي خرج بها هذا المسار كانت هزيلةً للغاية، ما وضع تلك الجهود أمام نتائج صفرية، وهو ما يعني أنّ مجرد استمرارها في العمل لم يكن إنجازاً في الحقيقة.
في المقابل، فإنّ السياسات الأميركية تجاه طهران، سواءً بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر عبر سوريا، قد أدّت إلى تراجع طهران عن الواجهة في البلاد، كنتيجةٍ للضغوط الاقتصادية المتشددّة، التي قادت في النهاية إلى إضعاف القدرات الاقتصادية لإيران وإضعاف قدراتها على تمويل حركة الميليشيات الموالية لها في المنطقة، لتدفع تلك الميليشيات إلى اعتماد أدواتٍ أخرى للتمويل؛ تتمثّل في معظمها في نهب المجتمعات المحليّة، وهو أمرٌ سيكون بالغ التأثير على قدرات تلك الميليشيات ومستقبلها في المنطقة.
يحوز جيفري على حصة جيدة من تنفيذ تلك التوجهات على الصعيد الدبلوماسي والسياسي، وهو ما يمكن أن يكون الإنجاز الأساسي لواشنطن خلال العامين الماضيين في المنطقة عموماً وفي سوريا على التحديد. إنجازٌ لم يكتمل بالطبع، وليس من المتوقع أن يكتمل قريباً.
عامان من استراتيجية الأهداف الثلاثة، لم تحقّق فيها واشنطن تقدّماً حقيقياً على صعدٍ عديدة؛ أهمّها المسار السياسي الذي ما زال عالقاً، وتنظيم داعش الذي يمتلك حتى اللحظة القدرة على التحرك وتوجيه ضرباتٍ متعددة، سواءً في الجزيرة السورية أو في البادية، عدا عن عودة حالةٍ مشابهةٍ للظروف التي عاش خلالها سلفه، تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق»، حيث يتراجع إلى مخابئه خلال النهار، ويمتلك السيطرة الأمنية شبه الكاملة في الليل. ينذر هذا بأنّ أيّ قلاقل تصيب المنطقة ستكون فرصةً سانحةً لعودة التنظيم مجدداً، ما يشكّل تحدّياً هامّاً خلال الفترة المقبلة.
عامان من عمل السفير جيمس جيفري مبعوثاً أميركياً خاصاً إلى سوريا، كانت مؤشراً واضحاً على أن الرؤية الواضحة غير كافيةٍ لتحقيق الأهداف، إذ أنّ سوء إدارة التوازن بين حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة قد أدى إلى تصادمات ساهمت في إفساح المجال أمام موسكو لتلعب دوراً جديداً في شمال شرق سوريا، هذا في حين كان عدم التنسيق بين الوكالات والهيئات العاملة على الأرض، مثل وزارة الخارجية ووزارة الدفاع (البنتاغون) قد أدّى لأن تكون الأولويات وطرق تنفيذ السياسات مختلفة إلى درجة التناقض أحياناً.
لقد أظهرَ عامان من استراتيجية الأهداف الثلاثة أنّ قلب نتائج الانسحاب الأميركي من المنطقة لصالح قوى إقليمية ودولية أخرى يحتاج الكثير من العمل، عملٌ لم يكتمل حتى اللحظة من أجل عكس نتائج أوضاع ساهمت سياسات واشنطن في صناعتها.