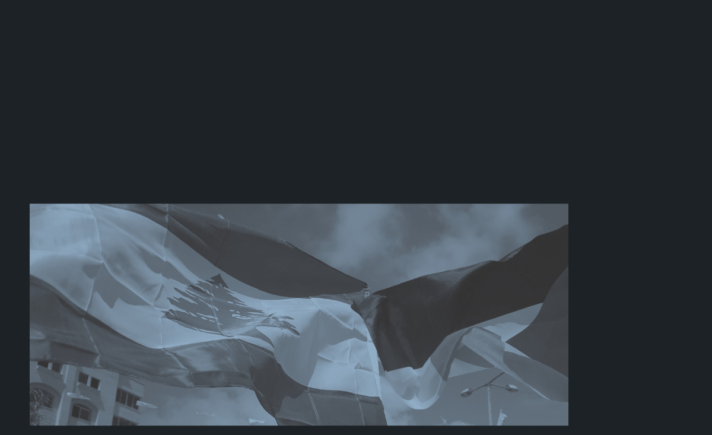بيروت لا تشبه نفسها هذه المرة
محمود درويش
لردود الفعل الشخصية والجماعية التلقائية التي انبثقت عن مجزرة مرفأ بيروت مراحلُ متمايزة ومتتالية. أولها الذعر البحت المطلق، البديهي، الذي يليه الارتخاء المفاجئ والشعور بانفراج قد يصل حدَّ الفرح في حال التأكد من أنك لا تزال حيّاً، وأن الأحباء والأصدقاء حولك على قيد الحياة أيضاً، فَوَقْتُ التفكير في الآخرين الخارجين عن مرمى النظر، الذين أُصيب بعضهم حتماً بجروح مروعة، وربما مميتة، لم يحن بعد. عندما يحين، تبدأ مرحلة الجزع الشديد والهلع النفسي، بينما يستوعب العقل، رويداً رويداً، ما يمكن استيعابه من وقائع الفاجعة المرعبة المذهلة. تستمر هذه المرحلة لفترة لا تقل عن أيام عدة، قبل أن يأتي طورُ الخَدَر والخمود، والسكون الصاخب، والتَوَهان.
هذا التَوَهان، أو الإحساس باللاتوجُّه، وضياع البوصلة، وعدم اليقين حيال أدنى تفصيل من تفاصيل المستقبل، له عناصر وأنواع مختلفة بدوره. هناك، على سبيل المثال، التَوَهان السياسي بالمعنى المباشر، في ظل استقالة حكومة حسان دياب مساء الإثنين، بعد ثلاثة أيام قمعت الأجهزةُ الأمنية فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين بكل ما في يدها من أدوات، من قنابل الغاز المسيل للدموع إلى الرصاص المطاطي وصولا إلى الرصاص الحي في بعض الحالات، لتُغطّى ساحة الشهداء وباقي ساحات وشوارع وسط العاصمة المنكوبة بغيوم من الدخان والصراخ مجدداً، فيما أشلاء ضحايا المذبحة لا تزال تحت أنقاض الميناء على بُعد أمتار. فيحلل المحللون ما يحللونه، ويستنتج البعض أنّ سعد الحريري سيعود إلى رئاسة مجلس الوزراء عمّا قليل، بعد إجراء المساومات اللازمة مع منافسيه على حصص الكعكة المتبقية المتضائلة، وعلى رأسهم صهر الرئيس ميشال عون؛ بينما يحاجج بعضٌ آخر أن الظروف الدولية الراهنة لا تسمح بمثل هكذا حكومة صريحةِ المحاصصة وواضحةِ الملامح الفاسدة، فيُرجِّحُ التوافقَ على اسم جديد كنوّاف سلام رئيساً للحكومة هذه المرة. لكن الحقيقة أن هذا النمط من التَوَهان بعيد جداً عن هموم معظم المواطنين المفجوعين في هذه الأثناء.

أكثر ما يشغّل بال اللبنانيين من أقاربِ ورفاقِ الكاتب في اللحظات الحالية هو علامات الاستفهام الكبرى بالنسبة لمستقبل بيروت، بصفتها مدينتهم وعاصمتهم، التي كانوا يعيشون فيها، يسكنون ديارها، ويعملون في معاملها ومكاتبها، يجالسون أصدقاءهم في مقاهيها ومطاعمها، يربّون أولادهم في مدارسها، يتسامرون ويتنادمون ويتراقصون في حاناتها وملاهيها، ويضحكون ويعشقون ويحلمون بغدٍ أفضل لهم ولأعزائهم. ماذا تبقى اليوم من بيروت تلك؟ لعله يصعب على من لم يتجول بين ركام المدينة بعد ليلة الانفجار تَصوُّرُ وفَهْمُ مدى وحجم الدمار. بالكاد توجد بناية واحدة في أحياء مار مخايل والكرنتينا والجميزة والجعيتاوي والأشرفية والبرج وعين المريسة وكليمنصو لم يتحطم زجاجها، على الأقل. في المناطق الأكثر تضرراً، كالجميزة، هناك العديد من المباني «ذات الطابع التراثي» انسحقت جزئياً أو تهدّمت كلياً، ولا إمكانية لإنقاذها إطلاقاً. حتى البنايات التي لا تزال منتصبة وتبدو سالمة للوهلة الأولى، يُحتمل كل الاحتمال أنها تعاني من مشاكل هيكلية خطيرة للغاية، قد تسبب سقوط العمارة في أي لحظة، فضلاً عن الأضرار في أنابيب الغاز والمياه والكابلات الكهربائية؛ (وبهذا الخصوص، يمكن لأي أحد يقلق على سلامة بنايته من الناحية الهيكلية الاتصال الفوري بخط ساخن، أنشأه فريق من المهندسين والخبراء المتخصصين من الجامعة الأميركية في بيروت، الذين سيقومون بزيارة المبنى وتقدير مدى الخطر بدون مقابل). هذا يشكّل، أولاً، مأساة عظمى لثلاثمائة ألف ساكن فقدوا مأواهم فنزحوا إلى بيوت الأقارب أو المعارف في انتظار المجهول؛ وثانياً تهديداً وجودياً لهوية المدينة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمعمارية والتاريخية. هناك شوارع بكاملها قد تحتاج إلى إعادة إعمار شاملة، وكأنها شهدت سنيناً من الحرب، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى معارك شرسة بين المجتمع المدني وشركات البناء لاحقاً، لا سيما في ظل تجربة سوليدير المريرة بعد انطفاء الحرب الأهلية.

على كل حال، ثمة مجال للجزم بأن ملامح المدينة قد تغيرت بشكل نهائي. عدة محلات من أركان الحياة البيروتية قد أعلنت عن قرارها بعدم خوض المحاولة للعودة إلى العمل من جديد، من بينها فندق حدائق الصيفي الذي كاد ينزل به جميع السياح والزوار الأجانب (بمن فيهم هذا الكاتب)، مع مطعمه أمّ نزيه والحانة على سطحه كوب دي تاه، المطلة على المرفأ مباشرة. «لقد قررنا أننا لن نعود إلى الفساد التافه لدى الشرطة والبلدية والوزارات والمصارف ورجال الأعمال والسياسيين، الذين امتصوا الحياة من كل حلم وجهد صادق قام به الشعب»، قالت إدارة الفندق على صفحتها على موقع فيسبوك، مضيفةً: «تُقرفنا فكرة إعادة الإعمار من جديد لكي يبتزّونا مرة أخرى بالرشاوي والضرائب التي لا نستلم شيئاً مقابلها». أماكن أخرى، كمقهى كاليه الواقع في مار مخايل، تقول إنه لا يزال من المبكر تحديد مصيرها، ولكن احتمال الإقفال النهائي وارد تماماً. «الذي حصل لمدينتنا قد كسر قلوب الجميع على نحو لم يحدث من قبل، وليس بوسع أي تصليح أن يشفي ذلك»، حسب تعبير إدارة المقهى. «الشيء الوحيد الذي نستطيع الجزم به بالنسبة للمستقبل هو أنه سيكون مليئاً بالتحديات»، تقول إدارة مكتبة كُتُب عليا الواقعة على شارع الجميزة الرئيسي، في مبنىً قد مَنَعَ الدفاعُ المدني المشاةَ المارّين من الاقتراب منه خوفاً من انهياره. يضاف إلى هذه الأمثلة كنوز لا تحصى ولا تقيَّم من مقاهٍ ومكتبات أخرى، ومَعارض فنية صغيرة مستقلة، ومطاعم «شعبية» عزيزة على قلوب الكثيرين، كـ لو شيف وسندويش ونُص، ناهيك عن المباني التراثية التي تعود أعمارها إلى زمن ما قبل تأسيس الجمهورية اللبنانية. قد يقال إن معظم هذه المحلات لا تعني إلا النخب الاقتصادية والطبقات الوسطى والبرجوازية، وهو قول حق إلى حد ما، لكن المصيبة شملت الجميع بدون استثناء، وهذه الأحياء مليئة أيضاً بمحال حِرَفية وتجارية متواضعة، وورشات تصليح للسيارات ودكاكين لا يملك أصحابها شيئاً سواها. إن كان صحيحاً أن جُلّ الضوء الإعلامي قد سُلّط على المنازل الفخمة والقصور المنيفة، مثل قصر سرسق والمتحف المجاور له والأبراج التي عمّرها المعمار المشهور برنار خوري، فبالتأكيد يبقى الواقع أن من سيدفع الثمن الأعلى هم «صغار» التجار والعمال والعاطلون عن العمل، الذين قد وَقعوا اليوم، أو أُوقِعوا ، إلى قعر الهاوية تماماً.

بالتالي، فالتَوَهان الأقوى والأعمق هو ذاك على المستوى الشخصي، الوجودي والمصيري، حيث بات السؤال الأكثر إلحاحاً في ذهن كل ساكني بيروت هو السؤال عن مدى وشكل مستقبلهم في المدينة، والبلد ككل. حتى قبل الانفجار، دفعت الأزماتُ المالية والاقتصادية والمعيشية والسياسية المتكررة والمتصاعدة بسرعة هائلة كثيرين لاتخاذ قرار الرحيل، من بينهم شخصيات وثيقة الترابط بالمدينة، كالإعلامية جيزيل خوري، رئيسة مؤسسة سمير قصير وأرملة الراحل قصير نفسه. ما بالك، إذن، بعد انكشاف أن الطغمة التي تحكمك لم ترَ رادعاً عن أن تخزن المفرقعات إلى جانب ثلاثة آلاف طن من المواد المتفجرة، في قلب عاصمة مكتظة بالسكان الغافلين كلياً عن وجود هذه القنبلة شبه النووية جنب سُرر أطفالهم؟ حتماً، ما زال هناك العديد ممن لم ييأسوا بعد، بل عززوا عزمهم على المزيد من النشاط السياسي والثوري من أجل إسقاط ومحاسبة هذه الطغمة بالذات، وطي صفحة نظامها نهائياً إلى أبد الآبدين. «إنّ الثورة تولد من رحم الأحزان»، كما قال نزار قباني، في مقطعٍ عمد الجيش اللبناني إلى حذفه من فعالية احتفاله في عيده قبل الانفجار بثلاثة أيام فقط. لكن ثمة أيضاً من رأى أنه قد عانى بما فيه الكفاية، وأن على غيره أن يخوض المعركة من اليوم فصاعداً. ولا ينطبق هذا الكلام على أصحاب الغنى وحدهم، فالسائق اللبناني المهاجر، الذي ينقلك إلى منزلك من مطار برلين، لم يعش طفولته في شارع سرسق، وليس خريج الجامعة الأميركية. أَلَمُ الهجرة، كسائر الآلام في لبنان، متاحٌ للجميع. في عام 2011 أخرجت المخرجة البيروتية نادين لبكي فيلماً بعنوان وهلأ لوين؟ إنه السؤال الذي يطرحه كل اللبنانيين اليوم، من كل النواحي، وبكل ما تَحِمل الكلمات من معانٍ.