يسيطر على الفضاء العام والأكاديميا مفهومٌ يُمكن الاصطلاح على تسميته «الأصل الواحد» و«التعاقب الخطّي» في نشوء «القوميّة العربيّة» وتطورها؛ إذ جُمعت تحت يافطة «العروبة» تياراتٌ متضاربة، بغضّ النظر عن اختلافها في البرنامج السياسيّ، أو الحيّز الجغرافيّ أو حدود الجماعة أو حتى الجمهور المستهدف، ثمّ وُضِعت في سياق كرونولوجيّ لتوحي بتتابعيّة ما، يبدو بموجبها أن «الوعيّ القوميّ» بجملته يعود إلى «أصل واحد» مثّلته «النهضة العربيّة» في القرن التاسع عشر.
يعمل الباحثون الأكثر تحفظًا في قبول الرواية الأثيرة على تمييز «أشكالٍ» للعروبة وقوميّتها، وهو تمييز يقوم كليًا على افتراض «جوهر» ثابت، متسامٍ، و«أشكال» مختلفة يظهر بها؛ وذلك ما يتعذّر الدفاع عنه: فالواقع أنّ سياق الأفكار التي طُرحت لا تختلف في معناها السياسيّ فقط، ضمن برامج يمينٍ ويسار على سبيل المثال، لكي يكون ممكناً اعتبارها مجرّد «أشكال»، بل إنها تتعلق بكلّ شيء تقريبًا: من حدود الجماعة وصولاً إلى الغاية أو «الهدف» الأسمى الذي تصبو الحركة القوميّة لتحقيقه؛ وذلك تمامًا ما يغوي بالحديث عن «أصول متعددة» لمعَت وخَبَت تِبعًا لسياقات معيّنة، ودون أن تشكّل – إذا استثنينا التماثل اللفظي على صعيد المصطلحات المستخدمة – شيئًا واحدًا قط.
صحيحٌ أنّ الرواية القوميّة لا تحتاج لأنّ تكون عِلمًا، لكنّ انتشار الرواية المذكورة أعلاه حول القومية العربية، وسيطرتها على الفضاء العام، أمرٌ لا ينبغي القبول باستمراره في عالم ما بعد الربيع العربي، خاصة أنها لا تزال إطارًا مقبولًا، وشِبه «خطاب رسميّ» و«حصري» لتاريخ المنطقة وتطوّرها حتى اليوم، لا سيّما بالنسبة لأجيالٍ ترعرعت على سرديات قوميّة أو سرديات مشتقّة عنها، فضلاً عن رعايتها إظهار العالم العربي كمنعزلٍ عن التفاعل مع العالم الخارجي، وكأنّ العرب يعيشون في كوكب خاص (إلا عندما يأتي «الاستعمار» للتآمر عليهم)، وإظهارها لهم أيضًا كضحيّة أبديّة، للعثمانيين، للأوروبيين، ومن ثمّ لأنظمتهم الخاصة الرجعيّة والتقدميّة، بعد فِردَوسيّة مفقودة أمويّة وعباسيّة.

وعلى ذلك، فإن تطوير فهمٍ أكثر«طبيعيّة» لتاريخنا، وأكثر «تحررًا» من إيديولوجيا أنظمة ما بعد الاستقلال ومنظرّيها، هو واجب يمليه «تحرير التاريخ»، وبالتالي فهو أيضًا يساهم في تحررّنا. وهذا ما تحاول هذه المقالة العمل عليه: تفكيك الرواية وإعادة تركيبها، دون أن تدّعي إحاطةً شاملةً بالموضوع؛ ذلك أنّ رصد مزيدٍ من الجهد البحثيّ، أكثر شمولاً من تركيز الأسطر أدناه على الرواية كما عُممت في سوريا، يبقى ضرورة، لبلورة نتائجٍ تامّة وخلاصاتٍ مستقرّة.
العروبة العثمانية
وجدت في نجد والحجاز طبقات حكمٍ محليّة، وقامت بغداد والقاهرة على طبقات حكم خارجيّة لكنّها توّطنت إلى درجة كبيرة: سلالات من المماليك في العراق، وأسرة محمد علي باشا في مصر، لكنّ حُكم سوريا بقي أخلاطًا من ولاةٍ وعسكرٍ مستوردين، وأما طبقة الأعيان المحليّة، فرغم نجاحاتها التجاريّة ووساطاتها مع البيروقراطيا العثمانية، فهي لم تَحُز قط حُكمًا محليًا بالنيابة عن العثمانيين أو كجزءٍ منهم – باستثناء آل العظم في القرن الثامن عشر؛ ولو أنّ صعود آل العظم تمّ في القرن التاسع عشر لأمكن تخيّل خديويّة سوريّة أو نسخة موّسعة عن الإمارة الشهابيّة في برّ الشام؛ إلا أنّ صعود واندثار حُكم السلالة المبكر، لما مثّلته من منافسة محتملة للسلطة المركزيّة العثمانيّة، قد منع أنجح التجارب المحليّة من أن تكون وَلودًا؛ وبقي إذّاك أقصى ما استطاعت النخب المدينيّة تحصيله هو أن تملأ مناصب إدارية دُنيا في ولاياتها، وأن تحتفل بثلّة لا تتجاوز نسبتها أصابع اليد، حازت وزارة أو نُصبت عينًا أو خُلعتَ عليها صفة استشارية في الدولة المركزيّة.
مُزوَّدين بهذه الخلفية، يُمكن أن يُفهم هدف النخب المدينيّة المتوّلدة في القرن التاسع عشر بوصفه الولوج إلى حُكم ولاياتها، أو بكلمات أخرى، التطوّر من طبقة تجّار مجرّدة إلى طبقة مواطنين؛ وأما تحقيق تلك الغاية فمثّله الاندماج في هويّة مواطنة عثمانيّة، التقت مع أصوات أخرى «تحديثيّة» داخل الدولة، وهو ما تطلَّبَ أولاً أنّ تجد النخب أجوبةً لأسئلة صعبة، فكيف لها أن تندمج في هوية عثمانيّة تمامًا دون أن يؤدي الاندماج لغير استتراك جماعيّ؟ وكيف لمطالبها، في الوقت ذاته، ألا تؤذي الإسلام ممثلاً بالسلطنة وشرعها وذلك بأن تكون مجرّد «شعوبيّة معكوسة»؟ وما هي قدرة المؤسسة العثمانيّة ذاتها على التحوّل من إمبراطورية – إقطاعيّة، إلى دولة قائمة على عقد اجتماعيّ يتولى فيه مجموع أفراد العثمانيين بذاتهم ولاية أمرهم؟
وحول الأسئلة الثلاثة، كان الحل يقوم على اختراع هويّة محليّة خاصّة، أكثر اتساعًا من الهويّات المناطقيّة الراسخة، وأقل تجريديّة من الجامعة الإسلاميّة التي طالما انحصر تجسيدها في الشرع بوصفه النظام القانوني للدولة؛ وأما احتمال تطوير هذه الهويّة فكان ذا شقين، إثنيٌّ عربيّ أو جغرافيٌّ سوريّ – وبين أشعار ابراهيم اليازجي عن عزّ العرب واستنفار بطرس البستاني لسوريا، جاءت النتيجة تواطئًا اتسّع فيه كلا الأساسين برحابة: لقد نشأ مشروعا العروبة وسوريا الحديثة من رحم واحد هو النهضة، وتحت سقف واحد هو الرابطة العثمانيّة، ولهدف واحد، هو الدخول إلى مؤسسة الحُكم العثمانيّة، وضمن إطار جغرافيّ واحد، إذ تركّز المفهومان حول ما اصطلح عليه «الولايات السورية». ليس غريبًا والحال كذلك، أنّ نرى مع بدايات «النهضة العربيّة»، أواسط القرن التاسع عشر، فرنسيس مرّاش من حلب، يتحدث عن سوريا وطنه، والدولة العثمانية بلاده، وأن يستمرّ الأمر على ما هو عليه، حتى خواتيم المرحلة العثمانيّة الطويلة، وذلك بأن تكون مطالب المؤتمرين في المؤتمر العربيّ في باريس، بعد خمسة عقود من وفاة مرّاش (1913)، تتلّخص باللامركزيّة في الولايات.
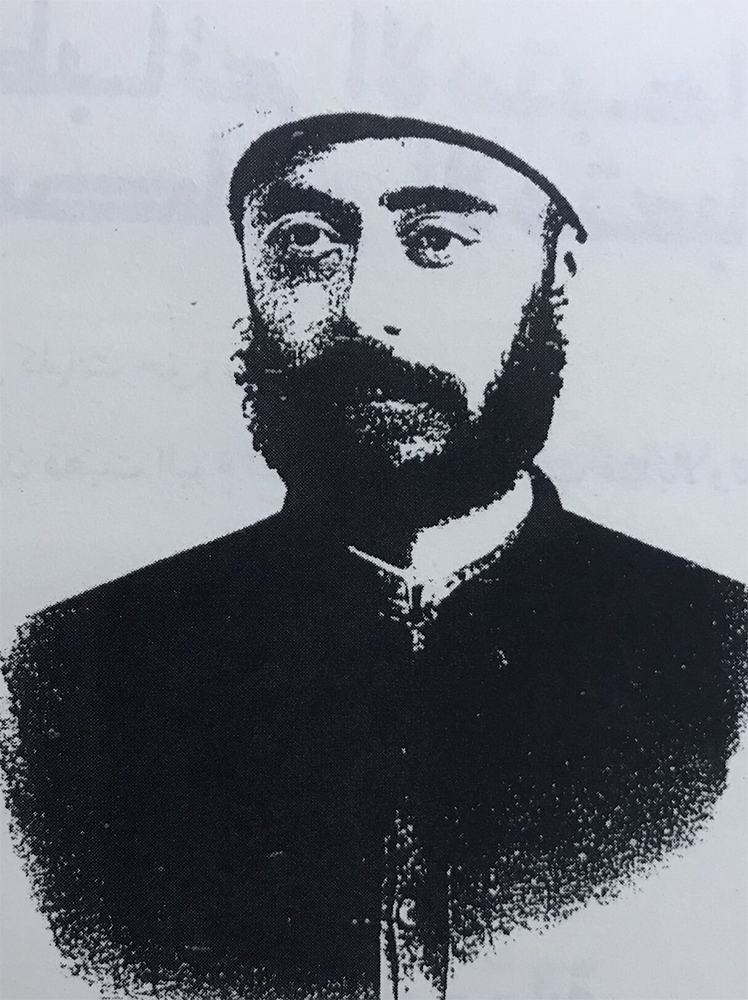
وُجِدَت على الهامش طبعًا دعوات «استقلاليّة»، تبدأ مع حلبيّ ثانٍ هو رزق الله حسّون، الذي دعا الولايات العربيّة لخلع طاعة العثمانيين وتأسيس مملكة عربيّة خاصّة بهم، وتبلغ ذروتها مع حلبيّ آخر -للصدفة- هو عبد الرحمن الكواكبي، وبين الرجلين، برز نجيب عازوري، الذي يعود له صكّ مصطلح «الوطن العربيّ»، لكنّ ارتباطات الثلاثة بالدوائر المصريّة المعادية لعبد الحميد الثاني، والتي عملت على إشاعة بدائل محتملة لآل عُثمان، أمرٌّ يتعذّر إنكاره من جهة، وسياق الأفكار التي استخدموها بقيت ملتصقة بتيار النهضة العريض من جهة ثانية. وعلى المقلب الآخر، فإنّ التقارير القنصليّة التي تشي بحالة تململ داخل الأوساط المدينيّة السوريّة من الحُكم العثماني، وما نقل تزامنًا عن «مؤتمر دمشق» (1880)، وفيه تشاور رهطٌ من أعيان المدينة ومتنفّذيها، حول إعلان استقلال سوريا ومبايعة عبد القادر الجزائري ملكًا عليها بالتنسيق مع أعيان بيروت؛ أو ما سبقه خلال «قومة حلب» (1850)، من إعلان الثائرين البدو خلع طاعة السلطان وانتخاب رجلٍ، لا نعرف سوى أنّ اسمه ابن حميدة، سلطانًا؛ قد بقيت محدودة عرضيًا من حيث الانتشار وطوليًا من حيث التأثير: فـ«قومة حلب» انتهت كمجزرة طائفيّة، و«مؤتمر دمشق» دُفن في مهده؛ وبذلك فالدعوات الاستقلاليّة يجب أن تفهم بوصفها تمظهرات راديكاليّة على هامش «النهضة»، لا تيارًا قائمًا مؤثرًا بحدّ ذاته. كما وتستحيل البرهنة، بكل الأحوال، أن دعوات الاستقلاليين هذه على محدوديتها، قد أدّت، بأي شكل، للتشكّل الفكري للقوميين العرب في انبعاثهم اللاحق، وبالأحرى، فإنّ الانبعاث اللاحق للقوميين العرب، قد أعاد صناعة «أسلاف» كان منهم الكواكبي وحسّون والجزائري، بشكل يتلاءم مع سرديّتهم القوميّة الخاصة.
لا يجوز أن يغيب عن البال أيضًا، أنه قد وجدت دعوات «اعتراضيّة» من داخل «النهضة» نفسها حول حدود التعامل مع الدولة المركزيّة في الأستانة؛ وبالعودة إلى المؤتمر العربيّ في باريس، مثلاً، فعلى الرغم من تواضع المطالب واعتدالها من وجهة نظر قوميّة، فلم يكن المؤتمر المذكور دون معارضة، وإحدى العرائض الموقعة
وإذ لا يتسع المقام لعرضٍ أكثر تفصيليّة حول التيار الرئيسي في «النهضة»، وما كان على هامشه من دعوات استقلاليّة واعتراضيّة
العروبة الهاشميّة
فكرة برنارد شو القائلة بأنه إذا تبادلنا التفاح، سيكون لكلّ منا تفاحة، بينما لو تبادلنا فكرة، سيكون لكلّ منّا فكرتان، تشخصّ بالضبط مآلات النهضة. في 1915، زار (الملك لاحقًا) فيصل بن الحسين دمشق، واتفق مع الجمعيات العاملة فيها على أن تدعم تحرّك الهاشميين ضد الدولة العثمانيّة. بذلك، اكتسبت الهاشميّة إرثَ وشرعية المطالب المُسيّسة للنهضة العربيّة ومجالها الجغرافيّ؛ واكتسبت النهضة العربيّة، من جهة ثانيّة، درعًا سياسيًا هو الهاشميّة. يُمكن أن يُنظَر للأمر أنّه خليط من خلافة الكواكبي العربيّة، وقد غدت ملكيّة هاشميّة (برمزية الهاشميين الدينيّة)، ومدنيّة حسّون، في إصرار حزب الاتحاد على «دولة مدنيّة في كل شيء، عدا قوانين الأحوال الشخصيّة»، والحيّز الجغرافي، أي الولايات السوريّة، تبعًا لنشاط المشاركين في المؤتمر العربيّ. والعروبة الهاشميّة هذه، المتوّلدة في بداية ويلات السفربرلك والمجاعة، قد رَامت بشكل عريض استقلال البلاد العربيّة، أو أن تُحكم البلاد العربيّة من قِبل أهليها، لكنّ فكرة الدولة العربيّة «الآسيويّة» بزعامة الحجاز الهاشمي، التي تسيّدت السرديّة القوميّة اللاحقة، لم تكن الفكرة الوحيدة عهدئذ، ناهيك عن كونها «مطلب» الثائرين
يُستخدم طبعًا الإنكليز والفرنسيون عادةً لتبرير «تنازلات» قدّمها العرب على حساب «وحدتهم»، وهو ما يَسهُلُ نقضه من جهتين: سلبيًا، لم يكن لدى الأوروبيين المجال لتقرير شكل الحُكم والمعاركُ لا تزال مشتعلة؛ إيجابيًا، فإنّ بيانات الأوروبيين العامة ومراسلاتهم الخاصّة آنذاك تحدّثت عن إقامة حُكم يتناسب وتطلعات الأهلين؛ ولا ينفي الأمر أن يكون الأوروبيون قد نكثوا العهود في 1920 وما بعدها، أو أنهم قد لعبوا دورًا في بلورة الأفكار ودفعها، لكنّ ذلك كلّه لا ينتقص من أهلية الجمعيات السوريّة من جهة، ولا السلالة الهاشميّة من جهة ثانيّة، في الوصول إلى معانٍ سياسيّة نتجت عن تحرّكهم بشكل حرّ

في التركيز والتفريد الذي مُحّصت به قضية شكل الدولة إثر «الثورة العربيّة الكبرى» طوال القرن الفائت، وما قِيل وأعيد حول الدولة الآسيويّة الشهيدة، ثمّة تهميش وتبخيس استثنائي، بأنّ صُلب الموضوع آنذاك لم يكن شكل الدولة ومن يترأسها، بل مآل ومصير سوريا – التي لم يكن لها طبقة حُكم محليّة؛ وباستئناف ما سبق بيانه، فإنّ تتّبع الأحداث فيما بعد اندراس سوريا العثمانيّة، يوحي بأنّ أفكار السنوات الثلاث قد تمخّضت عن المضيّ قدمًا نحو الخيار الرابع، كما تظهرها تصريحات أخرى للملك فيصل: «العرب أمم وشعوب مختلفة باختلاف الإقليم، فالحجازي ليس كالحلبي»؛ «دافعتُ في باريس عن سورية، بحدودها الطبيعيّة، وقلت أن السوريين يطلبون استقلال بلادهم»؛ «ما ندعوه الآن، بشكل محتوم، ثورة عربيّة، فُهِمَ غالبًا من قبل قائده فيصل، ثورة سوريّة»؛ وفي هذه الأجواء، أعلن المؤتمر السوريّ العام استقلال سوريا وطالب باستقلال العراق، أي مجددًا الحيّز الثقافي لمرحلة النهضة
الأكثر من ذلك، أنّ العروبة الهاشميّة، كمحاولة لإنشاء دولة – أمّة في سوريا، قد عارضها سنّة وعلويون ومسيحيون، بشكل أساسيّ نتيجة مخاوف على الهياكل الاجتماعيّة السائدة، أو «طريقة ممارسة السلطة المحليّة، التي لم تتمزق بانحلال الامبراطورية العثمانية»، لكنها سقطت بمدافع الفرنسيين وحدهم
مشكلة العروبة الهاشميّة هذه كانت أنها «محدثة النعمة»: فأولاً، قد خلَفت العروبة العثمانيّة دون تمهيدٍ كافٍ، وثانيًا، أنها لم تحظَ بظروف اجتماعيّة داعمة، فمع تجاوز نسب الأميّة في سوريا ثمانية أعشار السكان، يغدو الواقع كما أشار إليه فيصل بن الحسين في بيانه الصادر في حلب في تشرين الأول 1918، بأنّ «السواد الأعظم من الشعب لا يفقه معنى الوطنية والحرية ولا ما هو الاستقلال حتى، ولا ذرة من هذه الأمور»، ورغم فجاجة التعبير لدى فيصل، فلغة الخطاب ككل وروحيته تجعل من الواجب فهم عبارته ضمن إطار «الرعاية الأبويّة» أكثر من كونه فوقيّة نافرة؛ وأما ثالثًا، فهي أيضًا لم تحظَ بظروف سياسيّة موائمة، فرغم واقع الأميّة والتشتت، لم تكن البلاد بأسوأ مما كانت عليه فرنسا إبّان ثورتها أو الأناضول عشيّة إعلان الاستقلال، وبالتالي كان من الممكن لحكم «المؤتمر العام» أن يشكّل قاعدة مقبولة للاستمرار، لو أنّ القوى المحليّة كانت أقلّ راديكاليّة في مطالبها الاستقلاليّة، أو لو أبدت السياسة الدولية آنذاك مرونةً أعلى في التعامل مع المؤتمر ومطالبه.
ومع الرضّة العنيفة التي مثّلتها ميسلون، ما كان للعروبة الهاشميّة أن تستمر، ولم تحتج سلطات سوريا الانتدابيّة كثيراً من الوقت والجهد، كي تفرط عقد ما حاولت نخب سوريا العثمانيّة جمعه: لم يبالِ عرب الرها وحرّان في أن يكونوا جزءًا من تركيا أو سوريا، وأخذ «الوحدويون» في لبنان بالتراجع عن رفض ومقاطعة لبنان الكبير منذ 1926، واستقبل صالح العلي دعمًا ماليًا من فيصل وأتاتورك على حدّ سواء، وتوقّفت النخب الفلسطينيّة عن اعتبار نفسها سوريا الجنوبيّة مع أواخر العشرينيات، للتفرّغ لقضيتي الاستيطان والعلاقة مع شرق الأردن، وفشل مشروع جمع المؤتمر العام وتشكيل حكومة منفى في معان أو العقبة، وآخر المغادرين كان الكتلة الوطنيّة في دمشق، التي قررت قبول الحدود كما رسمها الانتداب في 1942؛ وسيبدي الملك فيصل المرارة من أنّ السوريين «أخفقوا في وقوف الموقف الذي كان يُتوقَّع منهم، وإفراطهم في القول، وتقصيرهم في الفعل».
بكل الأحوال، ثمّة عنصران بارزان هنا، أوّلهما، أنّ العروبة الهاشميّة، كما العثمانيّة، كانت في نطاقها وموضوعها الرئيسيّ تتعلق بسوريا، والثانيّة، أن الرواية القوميّة العربيّة اللاحقة، لم تحترم أية خصوصيّة للمرحلة، واكتفت باستخدام الأطُر الخارجية لها، من قبيل «وجود حكومة عربيّة» في دمشق. العروبة الهاشميّة، وإنّ كانت بمعنى ما، «قوميّة» «عربيّة»، فهي تختلف جذريًا عن ما نسميه اليوم، وما يتبادر في الذهن، عند الحديث عن «القوميّة العربيّة»؛ وبينما يمكن البرهنة بسهولة عن الترابط والتعاقب الفكري بين النهضة العربيّة والعروبة الهاشميّة، عبر «ميثاق دمشق»، فلا يمكن الحديث في الحالة الثانية عن «أشكال أولى»، كما لو أنّ الموضوع مجرّد تطوّر فكريّ. ليس في رأي هذه المقالة ما يدعم ذلك بشكل موضوعيّ. وهو ما يحتّم الاعتراف، عند دفع الأمور نحو خواتيمها الطبيعيّة، بأنّ ما اصطلحت تسميته «الثورة العربيّة»، يمثل موضوعًا منفصلًا تمام الانفصال عن القوميّة العربيّة.
عروبة ما بين الحربين
في معرض حديثه عن نشوء الأمّة الألمانيّة، يقدّم فيلهم رابه تقديرًا للقطار. سكّة الحديد التي ربطت ناطقي الألمانيّة عبر الدويلات العديدة، مختلفة اللهجات والمذاهب، فسهلّت التواصل البشريّ والثقافيّ والتجاريّ، قد مثّلت في رأيه أساس ولادة ألمانيا كأمّة. بشكل مشابه، وليس دون شيء من المجازفة، يمكن الحديث عن «المذياع» و«الصحافة»، بدءًا من ثلاثينيات القرن العشرين، بوصفها الأدوات الأكثر أهميّة في صناعة مشروع «الأمّة العربيّة». إذ مثلّت تقنيات العصر، المذياع والصحيفة، أهمية مضاعفة من وجهتين، الأولى، أنها سمحت لناطقي العربيّة على رقعة جغرافيّة أوسع وبشكل أعمق تبادل الفنون والثقافة والآداب، وبالتالي عزّزت الروابط المشتركة فيما بينهم، والأمر الثاني، أنها ساهمت في صناعة الأساس الفكري لتشكّل تيارت القوميّة العربيّة في بلادنا والمنطقة، في إطار عقد الثلاثينيات المُلتهب مع «توحيد» السعوديّة، ثورة فلسطين، ضمّ اللاذقيّة والسويداء وفكّ اسكندرون، وعلى مستوى دوليّ، صعود الفاشيّة.
ويمكن الحديث بدءًا من هذه المرحلة، لا قبلها، عن «أشكالٍ» و«تيارات» داخل الحركة القوميّة؛ فمعيار العروبة، هو اللغة بوصفها أداة تجسيد الثقافة عند ساطع الحُصري

وضمن فعّاليات بناء الحركة وتطويرها، كان أن تماهت أوجهٌ من القوميّة الناشئة مع تيارات الفاشيّة الأوروبيّة، ولم يقتصر هذا التماهي على ما كتبه مثلاً سامي الجندي بطريقة غير اعتذاريّة عن «إعجاب الشعب العربي» بالنازيّة بوصفها «القوّة التي تأخذ بثاراته»، بنتيجة التجربة البائسة مع الحلفاء بعد الحرب العالمية الأولى، إنّما تعدّاه نحو الاقتباس عن التجربة الفاشيّة والنقل عنها، فقام الأرسوزي يريد «زعيمًا» هو «صورة علمانية لإمام الزمان الذي يُقتدى به في الصلاة ويُطاع فيما يقضى فيه، فهو الحاكم السياسي الديني، مبدع الأفكار والدولة»، وتبرعمت في البلاد المنظمات المبنيّة على النسق الفاشي: «عصبة العمل القوميّ» و«الإحياء العربي» و«الحزب القومي العربي» و«االنادي العربي» و«القمصان الرماديّة» -وأهمية هذه الأخيرة تكمن في أنها مرتبطة بـ«الكتلة الوطنيّة»، التجمّع السياسيّ الأكبر في سوريا آنذاك. ويمكن لنا مرّة أخرى، العودة لصاغيّة، الذي استعان ببارينغتون مور للتمييز بين الفاشيّة الأوروبيّة واليابانيّة، بما ينطبق في الآن ذاته على الحالة الشرقيّة: فـ«الفاشيّة ظهرت بشكل أكثر طبيعيّة في اليابان، أي أنها وجدت عناصر مجانسة في المؤسسات اليابانيّة حتى أكثر مما وجدت في ألمانيا»، ذلك لأنّ اليابان، كما دول المشرق، «لم تمرّ في حقبة ديموقراطيّة كجمهورية فايمار» ليمثل الانقلاب الفاشيّ قطيعة جذريّة معها، وبالتالي كان صعودها أقلّ جلبة من مثيلاتها في الغرب

وقوميّة ما بين الحربين هذه، بأشكالها المتنوّعة، لم يكن لها من أمل لتقوم بما اضطلعت به من دور في تاريخ المنطقة الحديث، حتى لو تبناها سياسيون من طراز القوتلي والخوري، إذ كانت لتبقى محدودة وهامشيّة، بحكم الدور المتواضع والطاقات المحدودة لسوريا. لكنّ الدور الذي قُيّض لها أن تلعبه، يأتي من توظيفها في إطار أوسع ضمن الحلف الجديد في المنطقة، مصر والسعودية، والذي قام أساسًا لإجهاض طموح الهاشميين في استعادة ما فقدوا. وتبعًا لأجواء التحالف هذا، وُقِّعَ بروتوكول الاسكندرية، وتأسست جامعة الدول العربية، لتكون قرارتها «ملزمة لمن يقبل بها»، ومن بين أهدافها «حماية استقلال الدول العربية» و«احترام نظام الحكم القائم في سائر الدول العربية»؛ وكما أشار غير باحث، فإنّ جامعة الدول العربيّة قد أُوجِدَت بشكل خاص لمنع سيطرة الهاشميين على سوريا. وبذلك، فإنّ العروبة القديمة قد أُفرِغَت تمامًا من محتواها، وغدت انعزاليّة وقُطريّة، بل ومشاريعَ استعماريّة تبعًا لما ارتآه مجلس النواب السوريّ سنة 1947، في إدانته للملك عبد الله ومشروعه «سوريا الكبرى»؛ وهو ما يُنشِئُ نوعًا ثالثًا أو رابعًا من العروبة، سوى عروبة الرابطة العثمانية، والعروبة الهاشميّة، وعروبة ما بين الحربيّن في سوريا والعراق (حيث، ساهم نشاط الحُصَري في العراق بصناعة نخبة عراقيّة حول أفكاره)، وهي عروبة جامعة الدول العربيّة، وتقوم هذه الأخيرة على التنسيق والتشاور بين حكومات مستقلّة، بهدف درء تنافساتها في السيطرة على بلدان بعضها بعضاً وإقامة مناطق نفوذ لنفسها؛ في المقام الأوّل.
قسوة التاريخ
كان التحالف بين المملكتين السعودية والمصرية في طريقه لأن يفسد مع ثورة الضباط الأحرار وصعود جمال عبد الناصر، وكما أنّ النهضة الثقافية في القرن التاسع عشر ارتدت درعًا سياسيًا في الهاشميّة، فإنّ قومية ما بين الحربين، ابتغت أن تكون مصر عبد الناصر درعها الخاص؛ على أنّ الأطر والأهداف التي وضعتها الناصريّة لم تتطابق مع تلك التي سادت في «بلاد الشام». وبأية حال، فليس من المعروف تمامًا لماذا حوَّلَ عبد الناصر سياسة الدولة في مصر، من قوميّة وطنيّة إلى «قوميّة عربيّة»؛ لعلّها رغبة في القطيعة مع النظام السابق بشكل جذريّ، أو في «تصدير» الثورة من مصر «التي تجمع بين الحيويّة والسكون، الخلود والهشاشة»، أو أنها مجرّد نِتاج شعبيّ لم يكن متوقعًا بنتيجة تأميم السويس وحرّبها وما ارتبط به من طموحاتٍ وآمال. الأكيد على صعيد الوقائع، أنّ الناصريّة قد أعادت خلق المنطقة برّمتها «على صورتها»، فمهدّت للإطاحة بالهاشميّة في العراق، وكادت أن تفعل بالأردن، وأوصلت لبنان إلى شفير الحرب الأهلية، وقدّمت مآلاً لقوميّة ما بين الحربين السوريّة عبر الجمهورية العربيّة المتحدة (ورعت بذلك بشكل مسبق، شرعيّةً للبعث، بوصفه نظام إعادة الوحدة)، وجلبت إلى دائرة الضوء حركات هامشيّة التأثير حتى ذلك الوقت كـ«حركة القوميين العرب»، وصَنَّفَت، قبل طفرة النفط حتى، الخليج بوصفه الممثل الحصري للـ«الرجعيّة العربيّة». ستبقى المنطقة طويلاً، تفهم نفسها بـ«أفكارٍ» ناصريّة.

هُزمت الناصريّة خارج ديارها، في سوريا (1961)، واليمن (1962) ومن ثمّ على أرضها بالتحديد (1967)، ولكنّها بقيت رغم هزائمها في شعبيّة لم تضاهى في المنطقة، «ولئن تألَّمَ الشعب العربيّ، وأسرف في التألّم على عبد الناصر، فلأنه قد فقد فيه المعبّر الساحر عن المشاعر الجمعيّة، والترجمان الذي أبان طيلة سبعة عشر عامًا، من خلال منطوق خطاباته، عن بعض الصبوات العميقة للمجتمع، فكان وكأنه لسانها الناطق»؛ وعلى ذلك ستوّلِّدُ الناصريّة في انهيارها حركاتٍ مختلفة وتؤثر في غيرها من الشخصيات الفكريّة والسياسيّة، لكنّ إرثها الأخير سيبدو جافًا: هزائم عبد الناصر في الخارج منعته من أن يكون بيسماركًا عربيًا، وانفضاضه التام عن الفكرة المصريّة، مع إرث السادات وسياساته، منعته أن يكون أتاتوركًا مصريًا، ورصيده الشعبيّ قد تبخّر بصعود الإسلاميين؛ وبذلك تكون قد انتهت أنجح تجارب القوميّة العربيّة.
قسوة التاريخ العربيّ تتوّضح إذًا في نزعات قوميّة مختلفة، من أصول متباينة، متراكبة ومتداخلة، جميعها ادّعت لنفسها عروبة ما، لكنّ التحليل الأخير لا يُمكن أن يجمعها كلّها في بوتقة واحدة: لا في المنطلقات اتفقت ولا في الأهداف أو الحِيّز الجغرافيّ، وبين المنطلقات والأهداف، اختلفت واصطرعت في السياسة، بأساليب دامية أحيانًا. يُمكن طبعًا أنّ ندّعي أنّ القوميّة العربيّة تقتصر على الناصريين والبعثيين، وأن هؤلاء وسواهم في بوتقة أوسع ندعوها «العروبة»، لكنّ المشكلة التي صادفتنا في بدء التحليل، ستصادفنا هنا أيضًا: ما هو القاسم المشترك بينها تحت إطار العروبة الأوسع، لتكون لها تعريفًا؟ لن يجدَ المرء كثيراً من مقومات «الأمّة»، كرابطة مسيّسة لا تقوم فحسب على مشتركات إثنيّة محدودة من لغةٍ ودين (لهما أكثر من طريقة وفهم)؛ بل سيجد بالأحرى مجرّد شعاراتٍ عريضة عن عِزّ العرب واستقلالهم؛ أو بكلمات أخرى مشاعر. وهذا ما يبقى من القوميّة العربيّة: مشاعرُ الانتماء لفضاءٍ ثقافيّ واحد.
وهو، ربما أيضًا، ما يمنع تفككها الأخير.







