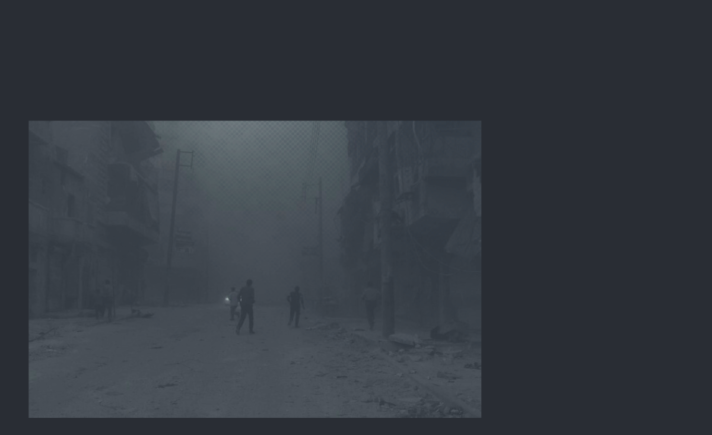المدن المليئة بضجيج الثرثرة كانت قد أصبحت شيئاً من الماضي حين عرفتُ الحياة على هذا الكوكب.
في هذه السنوات، يحلو للبعض إطلاق تسميات من قبيل «المدن البكماء» على التجمعات البشرية التي يعيش فيها أهلهم، وهي تسميات تحمل من المعنى -على بساطتها- ما لا طاقة للبشر به، لا سيما أنّ هؤلاء البشر قد فقدوا حقهم في الكلام منذ أمدٍ بعيد.
مع الطفرة التكنولوجية والتقدم العلمي الهائل في الربع الأول من القرن 21، كان البشر قد عرفوا كثيراً من الحقائق عن مجتمعاتهم، التي يُرجَّحُ أنها ساهمت بشكلٍ ما في دفعهم إلى الثورات في عدة دول حول العالم. بدأت بعض الأصوات ترتفع مطالبة بالعدالة الاجتماعية، خاصةً مع علمها أن الفقراء والمسحوقين يشكلون أغلبية ساحقة على هذا الكوكب، في مواجهة رجال السلطة والأثرياء، وما لبثت أن توجهت هذه الثورات من المطالبة بالتغيير في أوطانها، إلى تدمير النظام العالمي برمته.
بالنسبة للسلطات؛ كان هذا أسوأ من كابوس تراه بعينين مفتوحتين على اتساعهما.
أول ما يمكن ملاحظته في هذه الثورات هو انتقال الهتافات بين المتظاهرين من دولة إلى أخرى، فما أن تعتقد سلطة ما أنها أخمدت الثورة في بلادها، حتى تسمع الهتافات ذاتها في بلد آخر، ويبدو أن الأمر بدأ بشكل جلي مع المتظاهرين في لبنان عام 2019، حين أخذوا ألحان الهتافات السورية، ودعوا لثورة واحدة من بيروت إلى صنعاء، ومن جدّة إلى طهران، ومن دمشق إلى موسكو.
هكذا بقيت القوى الأمنية والعسكرية في هذه الدول في غاية التوتر حتى بعد انتصارها على شعوبها.
استمرت الهتافات بالانتقال بين الحناجر الغاضبة دون أي مراعاة للحدود السياسية بين الدول، حتى تفتق ذهن أحد المستشارين الحكوميين عن حل عبقري؛ هو حرمان الشعوب من حناجرها. (تختلف المصادر حول جنسية المستشار، بعضها يرجّح أنه روسي، والبعض الآخر يؤكد أنه من إيران، وبالرغم من رواج هذين الاعتقادين، إلا أننا لا نملك أية وثائق أو أدلة تثبت بشكل قطعي جنسية المستشار).
هكذا جيّرت حكومة المستشار كل مختبراتها وآخر ما توصلت إليه العلوم، لاختراع مادة سامة، مهمتها الوحيدة إتلاف الحنجرة دون أن تلحق الضرر بأعضاء الجسم الأخرى، وبعد مئات التجارب التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء من المعتقلين السياسيين والمختفين قسراً، توصّلَ العقل البشري لما سوف يسميه «إكسير الصمت». (يا للسخرية! حين نجد أن كل أحلام وأساطير البشر حول «إكسير الخلود» تجسدت في نهاية المطاف بإيجاد إكسير للصمت، وكأنَّ الصمت المطبق هو الخلود الذي بحثوا عنه طيلة هذه الأزمنة).
سمّمت الحكومة موارد المياه العامة في المدن والقرى والبلدات (هنا أيضاً يوجد بعض الخلاف بين المؤرخين، يُعتقد أن هذه العملية جرت في شريط حدودي واسع بين سوريا والعراق، بالإضافة لاستهداف بعض المدن الكبرى في البلدين، مثل حماة وحمص والنجف والديوانية وغيرها، والبعض الآخر يرجح حدوثها عقب ضربات مؤلمة تلقاها حزب الله في لبنان كادت أن تؤدي إلى انهياره بعد تمرد حاضنته الشعبية عليه، إلا أن مؤرخاً وصلتنا بعض أوراقه يقول إن التجربة جرت في كل هذه المناطق، وفي فترات زمنية متقاربة للغاية، وإن صراع الآراء حيال هذه النقطة يعود إلى رغبة الناس باتخاذ وضعية مميزة في المظلومية التاريخية، كأحد أشكال الانتصار، بعد أن فقدوا الأمل من القدرة على مواجهة السلطات. من المثير للعجب تنافس المهزومين على اتخاذ مراتب في هزيمتهم، بحيث يكون الأكثر هزيمة هو الفائز، لأنه دفع الثمن الأكبر من التضحية، على حد تعبير المؤرخ).
أول ردة فعل للسكان كانت الجنون، خرجوا إلى الشوارع وحطموا كل شيء رأوه في طريقهم، لكن بصمت، لم يكن لأحد أن يسمع سوى أصوات تهشيم وتكسير، وكان الذعر واضحاً على وجوه الجميع، بما في ذلك القوى الأمنية التي دفعها هذا المشهد المرعب للإفراط بشكل جنوني في استخدام البطش، حتى المستشار صاحب الفكرة، كان مرعوباً. (نُسِبَت الفكرة لعشرات الأشخاص الذين لا مجال لذكرهم، وادّعت كثيرٌ من الأخبار إشرافهم بشكل شخصي على التجربة، لكن يُلاحظ تكرار اسمي آزر خسرو ويوجين بولغاكوف، اللذين لا نعرف عنهما أي شيء).
ما أن شاع خبر التجربة حتى سارعت حكومات أخرى إلى تنفيذ ذات الخطة، وكما تمَّ تناقل الهتافات بين الحناجر كومضات تضيء تاريخ التحرر، استمر هذا الابتكار بالانتقال من حكومة إلى أخرى، كبقعة ظلام تتفشى في جسد الكوكب.
لم يستغرق الأمر سوى بضع سنوات، حتى شكلت هذه الحكومات منظمة «الأمم الهادئة»، التي استقطبت مع الوقت معظم الدول «الديمقراطية» حول العالم، عقب احتجاجات عنيفة لأسباب اقتصادية أو سياسية فيها، منهية بذلك التاريخ الطويل من الفشل لمنظمة الأمم المتحدة. (تشرح لنا بعض الوثائق التي تعود إلى مؤرخين معاصرين للحدث، أو ربما مجرد مواطنين ناشطين في الشأن العام، أن دخول الدول الديمقراطية في منظمة «الأمم الهادئة» جاء بتدريج شديد، وتحت غطاء ظروف الطوارئ، إذ سمحت السلطات لنفسها في البداية باستخدام «إكسير الصمت» في بعض المقاطعات والمدن التي شهدت عنفاً مفرطاً من قبل المتظاهرين خلال الاحتجاجات ضد القوى الأمنية والعسكرية، متعهدةً بعدم التوسع باستخدام هذا الإجراء، وبالعمل على إيجاد حلّ طبي وعلمي للإجراء الذي اتُّخذ بحق المواطنين، أي أن هذا الإجراء كان مؤقتاً، لكن ما لبث أن اكتشف الناس مرونة ومطاطية هذه الإجراءات، فما إن يتم خنق أصوات مدينة ما، حتى تحتل مدينة أخرى المرتبة الأولى في العنف، بحسب منطق السلطات، إلى أن شملت هذه الإجراءات جميع البلاد).
اتفق قادة الأمم الهادئة على «معايير الهدوء»، التي تُجرِّمُ بشكل قطعي أي فن أو نشاط قد يسمح للبشر باستخدام الأصوات عن طريق أجهزة مساعدة، كما تم منع أي نوع من أنواع فنون الأداء التي قد توحي للجمهور بذكريات حول أعمال الشغب، مع التساهل بما أسموه الفنون الصامتة، مثل الكتابة والرسم والنحت وغيرها، شريطة ألّا يُنشر أو يُعرض شيء خارج رقابة الدولة، في حين تكفّلت السلطات نفسها بتقديم الأنواع الأخرى من الفنون مثل الموسيقى والرقص وما شابه، لتكون جميعها إما خاوية من المعنى، أو ممجدة للسلطة.
هكذا فقد البشر في ضربة واحدة حناجرهم وأسماعهم أيضاً، منحطين بذلك من رتبة كائن حي إلى «شيء».
في الصباح لا تُسمَعُ سوى همهمة الآلات، ولا تُرَى سوى العيون المفجوعة. الآن فقط يمكنك أن تعتبر نشاطات دأب البشر على ممارستها، مثل تحطيم السيارات التالفة في المكاسر وبيع قطعها فرادى، بمثابة حرب أهلية بين «الأشياء».
امتلأت الطرقات بالحواجز العسكرية التي نفذت اختبارات صوتية قاسية على السكان، وفتّشت هواتفهم بحثاً عن أي تسجيل صوتي لحذفه، وأصدرت شركات كبرى، مثل واتس آب وفيسبوك وإنستغرام، تحديثات حذفت منها أزرار تسجيل الصوت، وأزرار القدرة على التفاعل بأي مشاعر تعبر عن الغضب أو الحزن أو الاستياء. كما طرحت شركات مثل مايكروسوفت وآبل وغيرها أجهزة الكترونية ذكية دون أدوات خاصة بالصوت، سواء للاستماع أو التسجيل، مثل السماعات والميكروفونات.
مع مرور بضع سنوات أخرى بدأت الأعراض الجانبية للصمت والسمّ بالظهور، مثل الجفاف الحاد في الحلق، وحكة مؤلمة في الحنجرة، ما دفع بالبشر للإذعان والتوجه إلى المستشفيات الحكومية والعسكرية بطوابير طويلة لاستئصال الحنجرة «مجاناً»، بعد أن فقدوا الطاقة والأمل في إحداث تغيير ما، واستعادة ما سُلِبَ منهم بالمكر.. (تحكي إحدى الأخبار أن طوابير الناس المتجهة إلى مشفى تشرين العسكري في دمشق مثلاً، كانت تصل مبنى إدارة الخدمات الطبية في دوار الشرطة العسكرية على امتداد 1200 متر! ما دفع بقوى الأمن إلى الاستنفار في المنطقة بالعتاد الكامل).
البعض لم يحتمل فكرة الهزيمة المطلقة هذه، فارتفعت معدلات الانتحار بينهم إلى درجة ملحوظة، وأمام تخوف السلطات من تحول الانتحار إلى أداة احتجاج جديدة، أعلنوا مذعنين عن اختراع حنجرة عامة، تحت حراسة مشددة من الدولة، يمكن للمواطنين تجربتها مرة واحدة في السنة، في ما يشبه احتفالاً قومياً عامّاً سُمّي بـ«يوم الحنجرة». (قد تكون هذه الحنجرة واحدة من أهم الإنجازات التي تعاون البشر مع الذكاء الاصطناعي للتوصل إليها في أسرع وقت ممكن، وشهدت تطويرات وتحسينات على مدار أعوام تالية لإعلانها رسمياً من قبل منظمة «الأمم الهادئة»، لكن الهدف الأول منها كان تشكيل حاجز يمتص صدمة الفقدان الكبيرة التي ألمّت بالمواطنين. واستمرت معدلات الانتحار، رغم انخفاضها وعودتها إلى المعدل «الطبيعي»، بتحقيق قفزات استثنائية بين فترة وأخرى، لكن السلطات غيّرت هذه المرة تعاملها مع المنتحرين، وأعلنت عنهم كمحكومين بالإعدام بسبب شغبهم أو محاولتهم تعكير الهدوء العام، ذلك أن تبني إعدام هؤلاء المنتحرين كان أكثر نجاعةً من الاعتراف بانتحارهم، لأن الهدف أولاً وأخيراً هو إيهام الناس بنجاح الابتكار الذي طرحته السلطات، وفق منطقها الخاص طبعاً).
وحصرت السلطات تجربة الحنجرة في حجرة صغيرة معزولة تحت رقابة أمنية (يوجد نُسخ منها موزعة على القرى والبلدات والمدن بحسب الكثافة السكانية)، ويمكن للناس اختيار التحدث وحيدين، أو التحدث برفقة أشخاص آخرين، على أن يتخلى كل من يدخل مع شريك عن حقه في الكلام، ليكون مجرد مستمع هذه المرة.
بهذه الطريقة أحكمت السلطات قبضتها على شعوبها مجدداً، بمنحهم قليلاً من الأمل، يحوّل الحياة إلى فترات صبر طويلة، بانتظار لحظة الإشباع السنوية. ثم بمرور بضعة عقود فقط، احتلّت طقوس استئصال الحنجرة لدى المواليد الجدد مكان طقوس الختان، وتوقّف الأطباء عن انتظار صراخ الطفل الوليد، مكتفين برؤية الرعب يخيم على حدقتي عينيه، ليتأكدوا أنه حي.
وبالرغم من مرور بعض الفترات الهادئة، إلا أن أجيالاً لا تعرف اللغة إطلاقاً بدأت تظهر للوجود، وتلمست السلطات بداية تأسيس أسلوب تواصل خاص بين أولئك الخرسان بالولادة، فتخوفوا من تشكل عالم موازٍ لا قدرة لهم على مراقبته، ما دفعهم إلى تصميم منهج شديد الصعوبة لتعليم أحرف الأبجدية دون صوت للأطفال، ومنحهم فترات إجبارية للتمرين بحناجر حكومية مخصصة لهذا الغرض في المدارس، بغية القضاء على أي بادرة تكيّف مع الصمت وصعوبة التواصل. (بحسب بعض المصادر، حلّت هذه التمارين مكان دروس التربية العسكرية في دول مثل سوريا ومصر، وأخذت الجزء الأكبر من دروس الموسيقى في الدول التي وُصفت سابقاً بالديمقراطية).
من جانب آخر، كانت أيادٍ وعقولٍ خفية تعمل بدأب لإنتاج نسخ مزورة من الحنجرة، ووفّرت بعضاً منها بالفعل في فترات متباعدة، بعضها كان سيئاً للغاية، وبعضها يسبب أضراراً جانبية بعد الاستعمال. وقد انتشرت شائعات تتحدث عن انفجار حنجرة مزورة في عنق أحد المستخدمين، أو تَسبّبها بمرض خبيث لآخر، واكتفت السلطات بتسيير دوريات أمنية في الأسواق، ولم تأخذ الأمر على محمل الجد، حتى أتت تلك الفترة التي تحوَّلَ فيها الناس إلى دائنين ومديونين، يركضون بين بيوت الأقارب والأصدقاء والثقات، يجمعون مبالغ طائلة لاقتناء ذلك النوع المزور من الحناجر، والمطابق للأصل، فردّت السلطات بسنّ مجموعة قوانين جديدة، تُجرِّمُ أي مستهلك أو حامل أو بائع للحناجر المزورة بالإرهاب، وتُعاقِبُ المدانين بالإعدام، دون منحهم فرصة النقض أو الطعن أو الاستفادة من أي أعذار مخففة.
وانتشرت شائعات تقول إن مصدر هذه الحناجر هو المقاومة في الشتات، وهم مجموعة من الناجين فرّوا، في بداية حقبة تسميم موارد المياه، باتجاه ضفاف الأنهار البعيدة والبحيرات أولاً، ثم فروا مرة أخرى من حملات الملاحقة الأمنية باتجاه موارد المياه الشحيحة في المناطق شديدة الوعورة والغابات كثيفة الأدغال.
تسببت هذه الشائعة بنشوب أزمة سياسية جديدة، فتبنت منظمة «الأمم الهادئة» حملة دولية ضد إرهاب المقاومة، نفذتها طائرات حربية من عدة دول، نفثت دخاناً سامّاً في الأراضي الشتات التي لجأ إليها المتكلمون، لتخريب حناجرهم. (يمكن الاستنتاج من هذه الأخبار أن العمل على تطوير المادة السامة لم يتوقف، بل كان في تقدم مستمر، فقد اتخذ هذا العقار أشكالاً متعددة سائلة وصلبة وغازيّة، لاستخدام كلٍّ منها مع الظروف المناسبة لكل عدو).

وأتت هذه الحملة بنتائجها المرجوة، إذ وجَّهت ضربة في مقتلٍ للمقاومة التي يُقدَّر عددها بعشرات الأشخاص المنتشرين حول العالم، حارمة معظمهم من حناجرهم بعد تاريخ طويل من الصمود امتد من في بعض المجموعات من الأجداد إلى الأحفاد الذين ولدوا في شتات المقاومة أساساً.
كانت المقاومة قد هاجمت عدة مرات سابقاً موارد مياه المخصصة لرجال السلطة في العراق وسوريا، ونجحت بإقصاء حناجر كبيرة ومهمة في هاتين الدولتين، دون أن تتمكن السلطات من الكشف عن الأساليب التي تمكن من خلالها المقاومون من تنفيذ أعمالهم العدائية. (كان رجال السلطة يشربون من موارد مياه خاصة وخاضعة لحماية مشددة، وشكلت هذه الموارد جزءاً أساسياً في الاتفاقيات السياسية بين الدول، إذ اعتمد معظمها على جبال الجليد في القطبين المتجمدين، ما أدى إلى بروز لاعبين دوليين جدد مثل كندا والدنمارك القريبتين من القطب الشمالي، والأرجنتين التي سارعت إلى نقض معاهدة أنتاركتيكا الموقعة خلال الحرب الباردة، والتي تُحيّدُ القطب الجنوبي عن أي صراع دولي، لتصرخ بشراسة في وجه العالم: «هذا الصقيع لي!»).
ومع التخوّف من وجود خلايا نائمة داخل دول منظمة «الأمم الهادئة»، صادقت المنظمة مجدداً على تنفيذ حملة بالدخان السام في دول المنظمة، للقضاء على أي جاسوس محتمل. (لا سيما وأن الرتب العسكرية تضمنت أعرافاً غير معلنة حول حرمان بعض الفئات العسكرية من حناجرها، تبعاً للانحدار من مناطق أو خلفيات عائلية معينة خلال فترة الاضطرابات العنيفة، وبعض هؤلاء الضباط قدّموا حناجرهم طوعاً في مشهد مثير للعجب، كدليل على الولاء. بشكل أو بآخر، يمكننا أن نفهم أن الجسم العام للسلطات، بالرغم من تماسكه أكثر من أيام الديكتاتوريات الفردية، لم يكن منسجماً تماماً).
هكذا انقطعت أخبار العالم نهائياً عنّا. كنتُ قد وُلدتُ أنا لأبوين مُقاوِمين في أحد الغابات، وكنتُ في تلك المرحلة من العمر التي يظهر فيها زغب خفيف على الوجنتين حين بدأت حملات الإبادة بالدخان، التي نجوت منها بأعجوبة أنا وبَهران، وهو أحد أفراد مجموعتنا. ويمكن اعتبارنا محظوظين بشدة كوننا سويّاَ، إذ تحولت المقاومة بعد حملات الإبادة إلى أفراد تائهين كل على حدى في الأرجاء، دون أي تواصل، يبحثون عن بعضهم ليل نهار، ويموتون خلال البحث إمّا من قلة الموارد، أو جراء الافتراس من الحيوانات اللاحمة، أو نتيجة الإعدام على يد القوات الأمنية التي تلقي القبض عليهم مصادفةً.
أعاد عليّ الرجل الناجي من مجموعتنا تاريخ عالمنا كما ورثناه عن الأجداد عشرات المرات، خلال تجولنا بحثاً عن أقران ناجين من المقاومة بعد حملات الدخان، لأن أولئك المصابين أصبحوا بلا فائدة لأنهم باتوا بدون أصوات يمكنها حفظ التاريخ وتوريثه لآخرين، وباتت فرصة العثور عليهم شبه معدومة. وحتى في حال العثور على أحدهم، فإنه سوف يكون عبئاً على المقاومة في هذه المرحلة بالذات، فالمقاومة هنا والآن، تعني الصوت البشري الأصيل، ولا سبيل للتفرقة بينهما.
نحن بلا فائدة دون حناجر يمكنها حفظ الحقيقة، وغاية الوجود بالنسبة لنا هي أن نُذكّر أولئك المساكين من أهلنا الذين يعيشون تحت حكم سلطات «الأمم الهادئة» بما فقدوه، بأصواتهم الأصيلة وليس تلك المصطنعة من حناجر معالجة. كما أن جود أفراد صامتين بيننا سوف يجعل ظهورنا مكشوفة دوماً، إذ لا يمكنهم تنبيهنا حول أي خطر، وسوف يشاركوننا مخابئنا وطعامنا لكنهم لن يستطيعوا أن يحملوا الحقيقة معنا، لأن لا مكان آخر للحقيقة سوى الحنجرة. لذلك، فإن وجودهم بعيدين عنّا، أو حتى دخولهم إلى دول «الأمم الهادئة» وانتظار لحظة الانقلاب الحاسمة، سوف يكون أكثر أمناً لنا ولهم.
كنّا قد مشينا ما يمكن تقديره بسنوات، على حد تعبي وفزعي وجوعي في كثير من الفترات، فارين من الوحوش والحملات الأمنية، مُلاحقِين بغباء صوت حركة غامضة في سهلٍ ما، أو ضوء نار في تلة نائية، على أمل اللقاء بناجين، دون أدنى طائل بكل تأكيد، حين قرَّرَ بهران على حين غرّة أن ينفّذ مهمة تجسس لتحديث التاريخ. وبالرغم من اعتراضاتي الملحّة، أصرّ مؤكداً قدرته بعد كل هذا العمر على التخفي وجمع بعض المعلومات المفيدة من داخل دول منظمة «الأمم الهادئة»، لتصويب مسار المقاومة مجدداً، يوماً ما حين يلتقي أفرادها من جديد.
أعتقدُ أن بهران كان يشعر بالملل فقط، ثم ألم يكن هذا الملل نفسه وراء أكثر الأحداث التاريخية جنوناً؟!
طبعاً هذا الاستنتاج غير علمي، أنا أحاول فقط أن أقيس ما يعتمل داخلي في الملل على ما قد تفعله أمة كاملة تشعر بالملل، لا سيما وأنني الآن، الأمّة الوحيدة من الناجين التي تسير على قدميها، والمكونة من فرد وحيد يملك صوتاً، وعلى وشك فقدان عقله، بعد أن اختفى رفيقي الأحمق منذ عدد كبير من السنوات، عدد لا نهاية له، انشغلت خلاله بالتنقل جيئة وذهاباً من أمام الشريط الحدودي الطبيعي الذي اختفى فيه الأحمق، متعلقاً بأمل خروجه حياً من جديد، ومعيداً على نفسي تاريخ البشرية منذ ثورات الربع الأول من القرن 21، كما رويته عليكم سابقاً.
وحين رأيته في يوم من الأيام، جاراً جسده الضئيل في سفوح جبال زاغروس، وكأنه يبحث عن شيء ما في الأرض، ظننتُ أنني جننتُ أخيراً، وأن عقلي يهلوس من وطأة التعب والعزلة، حتى نظر إليَّ بعينين مندهشتين ومليئتين بالدموع، وقال «ولد؟!». (كنتُ أصغر أفراد مجموعتنا، وجرت العادة أن يناديني الآخرون باسم «ولد»، حتى أنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء العثور على اسم آخر لي!)
تعانقنا وبكينا كثيراً، أعتقدُ أنه لم يحدث شيء جميل في تاريخ المقاومة منذ حملات الإبادة سوى لقاءنا الآن مجدداً. من المرعب مجرد التفكير في كيف يمكن أن يكون حدثٌ شخصيٌ وعاديٌ كهذا، علامة مميزة في التاريخ!
نظر في عينيّ وهمس بابتسامة مرّة: «ولد! شعرك شاب». (هل شاب حقاً؟! بكل الأحوال لن أثق بكلام أحمق مثله، حتى ولو كنت أبكي الآن وأنا لا أصدق أنني أراه أمامي).
حكى لي بهران عن هدوء البشر في الداخل، عن انكسارهم، عن هزيمتهم التي تتكرر كل صباح، عن انتظارهم المذل ليوم الحنجرة، وعن ما لا يمكن لعقل أن يتخيله.
فبعد كل ما عانوه من آلام ومذلّة، يتوقع الإنسان أن يقوم هؤلاء البشر بشتم السلطات في الغرفة المعزولة، حين تسمح لهم الفرصة بامتلاك حنجرة لأقل من دقيقة واحدة كل عام، لكن شيئاً من هذا لم يحدث، حتى أن السلطات نفسها لم تتمكن أبداً من إخفاء دهشتها.
كان البشر يدخلون جماعات أو ثنائيات إلى الغرفة المعزولة، متخلّين عن أدوارهم في الكلام لصالح واحد منهم، ونادراً ما تكلم شخص ما منفرداً، فما معنى أن تمتلك صوتاً ما لم يكن بمقدور أحد أن يسمعك؟! ورغم ذلك، كانت عيون بعض ضباط الأمن تضيق بحنقٍ على رابطة التضحية هذه التي تجمع بين هؤلاء التعساء.
كانت الأحاديث في الحجرة المعزولة لا تمت للسياسة بصلة، ولا حتى للغضب، كانت مجرد أحاديث شخصية وبسيطة وعاطفية ومليئة بالأشواق.
أحد الأطفال مثلاً دخل برفقة أبيه إلى الغرفة، وأخذ الدور بالكلام هذا العام، فقط ليقول:
«بعرف أنك زعلان لأنك ضربتني هديك اليوم على راسي، وضربتك وجَّعتني، بس أنا عم أنوجع أكتر كل يوم لما شوف عيونك بكيانين، كرمال الله بابا، لا عاد تضربني ولا عاد تبكي، لأنو هدول الشغلات بوجعوني كتير».
زوجةٌ قالت لزوجها:
«ما عندك فكرة قديش كنت مبسوطة لما هديتني جرابات ملونين أول الشتوية، حتى لما اتخانقنا كنت مبسوطة فيون، بحب لما تعمل شغلات بسيطة توصل اهتمامك فيني لأصغر تفاصيل بحياتي بدون ما تفرضه فرض، بحب أنك بتقدر تخليني معجبة فيك بعد كل هالعمر».
طفلة مع والدتها في الغرفة:
«ماما عمليلي شعراتي جدولات متل ما كنتي تعمليون زمان، كنت حس حالي أحلا فيون، وما عم أعرف أعملون متلك، عمليون كل يوم أي!».
طفلان في الغرفة ذاتها:
«لما بابا يلاقي شغل رح صير جبلك معي سندويشات بدل يلي عم تطعميني ياهون بالمدرسة، والله وعد أنا ما بكذب».
عاشقَين دخلا بعدهما مباشرةً:
«آسفة أخدتلك دورك هالسنة، بس بدي قلك أني مشتاقة لصوتك كتير، سمعته مرة وحدة من 3 سنين، وبعدها كل سنة بصير شي معك بتضطر تسمع أو تحكي حدا من عيلتك، كرمالي، السنة الجاي بس خليني أسمع صوتك».
هكذا بدأت تطغى على ملامح الناس تعابير رضى عميق عوَّضَ الانكسار، بينما اشتدت قبضات رجال الأمن على أسلحتهم بترقب حذر.
سعل المقاوم الهرم، وبكى: «ولا كلمة عن السلطة! ولا كلمة عن الثورة! هل يعقل؟! مجرد أحاديث شخصية، كل هذه الأعوام الكثيرة التي لا يمكن جمعها بكفي يدي، وأنا أعمل بجد حتى تمكنت من جمع أربع قصص فقط، كدتُ أُقتل عشرات المرات، وفي النهاية هذا ما وجدته».
انقطع نَفَسه بسبب السعال، وفي أول جرعة هواء ملأت رئتيه، قرر هذا الحقير أن يجعلني أشهد على ما لن أستطيع نسيانه طيلة حياتي، استل سكيناً من جيبه، وبسرعة خاطفة قال بحقد: «كان أولى بصفحة بيضاء أن تسرد هذه الحكاية كلها»، ثمّ نحر حنجرته، وخرّ قتيلاً بين يدي.
هربتُ بأقصى ما استطعت. تركتُ جثته بدمائه الدافئة الفائرة في العراء، وركضت. أصابني بلوثة في عقلي ابن الحرام.
كثيراً ما توقفتُ لأتمكن من إعطاء جرعات كافية من الشهيق والزفير للانتحابات المتشنجة التي انتابتني، أو لأوفر ما يكفي من طاقة ليدي حتى ألطم وجهي ورأسي كما يجب. أطاح بما تبقى من صواب في عقلي بسكينته هذه.
خلال زمنٍ كثيف وثقيل، لم أفعل شيئاً سوى الهرب، وكأنني إذا ما صرتُ أبعد عن الجثة سوف أصير أبعد عن الذكرى بما يكفي لنسيانها.
استمر الركض المذعور على هذا النحو حتى قابلتُ أول رجل مقاوم غريب من خارج مجموعتنا، ركضتُ بضع خطوات اتجاهه، ثم صرختُ وفررت بعكس الاتجاه، بينما ركض هو ورائي دون أن يفهم ما يجري، وألقى بي أرضاً، ممسكاً بجسدي المختلج وكأنني في نوبة صرع.
قدم لي الرجل الغريب، والنساء والصبية الذين كانوا معه، ما يكفي من رعاية على مدار ليالٍ حتى أهدأ قليلاً، وأتمكن من النظر في وجهه، أو بالأحرى تفقد المسافة بين ذقنه وعنقه كل بضعة دقائق، والفزع من كل حركة ليديه.
شرح لي الرجل كيف التقى مصادفةً ببعض المقاومين قبل زمن حاول أن يقدره بتشكيل دائرة واسعة من ذراعيه النحيلين. (في الحقيقة، نتيجة الشتات الطويل اختلطت علينا الأزمنة، ولم نتمكن أبداً من ضبط قياسها بشكل صحيح، رغم نجاحنا في فترات معينة، فإذا كنا بوضع طبيعي خالٍ من الخطر، وهو شيء نادر للغاية، نستطيع أن نقول إننا وصلنا إلى هنا منذ يومين أو ثلاثة، لكن إذا بدأنا الركض، والنوم في العراء، والسهر بما يكفي لنُصَابَ بالتهيؤات، نفقد الزمن من جديد. كل تقدير السنوات يعود لوثائق وصلتنا من خلال جواسيس، أي أنه زمن مقدر من قبل أشخاص كانوا ما يزالون يعيشون ضمن مجتمع، ولو كان منكوباً كمجتمعنا الأبكم الذي غادره والداي. باستثناء ذلك، نقيس الزمن كالحب والغضب والطرائد من الأرانب وغيرها، بفتح قبضات أيدينا وأذرعنا للتعبير عن الكمية).
شرح لي الرجل كيف شكَّلَ برفقة المقاومين الآخرين خلية عمل جديدة، وكيف طوروا تدريبات من ذاكرتهم لتجهيز رجال ونساء لاختراق دول «الأمم الهادئة» من جديد، وكيف قُتل العديد منهم على يد الجوع أو الحيوانات أو رجال الأمن، وأنهم كثيراً ما وجدوا جثث لأخوة لنا في الغابات أو الجبال أو الصحارى، محطمة الضلوع أو منحورة الأعناق. (التمعَ نصل سكين مؤلم في ذاكرتي، في الوقت ذاته الذي سمعت فيه أحد الصبية من بعيد يقول «مع الخرفان»، هل كان يقصدني أنا هذا السافل؟! أم يقصد الرجل الذي يحدثني؟!).
أكلتُ جوزاً، وشربت شيئاً ساخناً ومرّاً، وعطف عليّ المقاومون الغرباء، وعاملوني برفقٍ بدى من خلاله وكأنني أنا الخرفان.
وحين وضع الغريب كمشة جوز في ظهيرة أحد الأيام بيدي، شعّت عيناه سعادة، وهو يهمس بحماس «أعتقدُ أن الثورة على الأبواب، الكل متربّص بما سيحدث هذا العام».
فمن بين عشرات الأخبار الغثّة التي يعود بها الجواسيس كلّ ما سمحت الفرصة، كان هناك خبر كفيل ببلبلة أكثر الخواطر ركوناً للاستسلام، يحكي عن يومٍ ظهرت فيه منشورات ثورية، على جدران أحد الغرف المعزولة في يوم الحنجرة العام الماضي، تحمل جميعها عبارة واحدة بإصرار عنيد: «اسمع بقلبك».