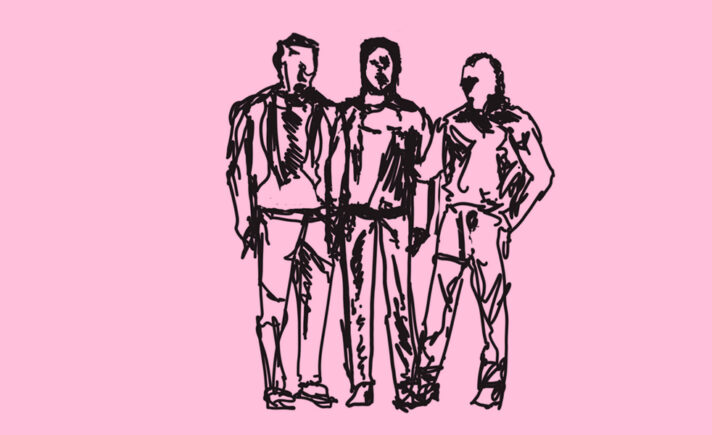حرس
نصّبَ البعثُ حارسين، على الأقل، على كلِّ مدخلٍ من مداخل السكن الجامعي. عساكر، حُماة ديار، واقفون نواطير للطلاب. واستكمالاً، حُمِّلَ كل عسكري بندقيةً خاليةً من الرصاص لا يخيف مِنها إلا عقبُها المشقق ككعبِ القدم.
والحارس عسكري هارب من الجيش بواسطة أو رشوة، يختار الوقوف ساعاتٍ على باب السكن بدل الركضِ فجراً في الكتيبة، يختار السلطة والحق في إزعاج العابرات بدل دروس الـ«نظام منضم». والحارسُ في حاله هذه، دخيلٌ على عالمٍ هو ليس جزءاً منه، له مخافةُ الغريبِ وخُضوعهُ وذِلّته، باقٍ كالظّل، لا يقوى على الحركة، مُقيماً كشجر أو كحجر، ومُحيلاً على أصلٍ غامض وهدفٍ غامض. بعد حينٍ يعجز المرء عن ملاحظته لأنه أمام العين طول الوقت، ثابتٌ في مكانه، حاقدٌ على عابرين لا يعرفُ أحداً منهم.
السكن القديم وأهله
في دمشق، شُيدتْ أولُ مباني المدينة الجامعيّة قبل نحو خمسين عاماً، بمرسومٍ صدر حينها عن رئيس الوحدة جمال عبد الناصر. توسَّعَ السكنُ لاحقاً ليمتد على كامل المساحة الخضراء بين أوتوستراد المزة ومشفى المواساة. السكن القديم هذا يُعرف عموماً باسم «سكن المزة» تمييزاً عن سكن الطبالة للذكور من طلاب الهندسة، وسكن برزة للذكور من طلاب الهندسة الزراعية.
والسكنُ، كقسمٍ من الجامعة، حَرمٌ، استباحه البعثُ بالعساكر والحرس، مُغيراً الاسم في سنواته اللاحقة إلى «مدينة الشهيد باسل الأسد الجامعيّة»، ومُطلِقاً سلطة فروع «الاتحاد الوطني لطلبة سورية». الاتحاد الذي يفترض أن يكون شبه نقابة مستقلة داعمة للطلاب يوردُ التعريف التالي في موقعه على الإنترنت: «منظمة شعبية تضم طلبة الجامعات السورية الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والتقانية، وله فروع داخل سوريا وخارجها. تأسس الاتحاد رسمياً في الثالث والعشرين من نيسان عام 1963، مستنداً إلى الموروث النضالي الطلابي الكبير الذي أسسه وقاده القائد الطلابي الأول القائد المؤسس حافظ الأسد».
قاطنو السكن أبناءُ المدنِ البعيدة الأفقر حالاً. طُلابُ عِلمٍ مُكدّسون في مبانٍ ممراتها باهتة كالمتاهات وجدرانها مُتعفنةٌ بفعل الرطوبة والتدخين. الوحدةُ الأولى، سكنُ طُلابِ الطب -والأطباء أوائل- يتقاسم فيها الغرفة طالبان فقط. في باقي الوحدات يُجمَع أربعةُ طلاب أو أكثر في كل غُرفة. غرفٌ شبهُ خاوية، دون حمامات أو أماكن للطبخ، يستلمونها موقّعين أوراقاً تقول إن لكلِّ واحدٍ منهم سريراً وطاولة وخزانة، ولا أسرة هُناك تكفي ولا طاولات ولا خزائن. سقفٌ يرى الطالبُ نفسه تحتهُ، للمرة الأولى غالباً، هارباً من سقفِ قَمعٍ آخر، مُفلتاً من قيود العائلة والتقاليد، واقفاً على هامِشِ عالمٍ غنيٍ متحرك، مليءٍ بالاحتمالات، لا يَعرفُ له مدخلاً.
في البدايات ينشدُ المنتقلُ حديثاً أُلْفةً غائبة. يغطّي البلاط بالمفارش ويشتري سخاناً كهربائياً يحرق في كل عام طالباً أو اثنين. في البداياتِ أيضاً يظهرُ الخلاف بين الساكنين على الحقِّ في السرير الأرضي*.
* الأسِرَّةُ في السكن من طابقين، وكُنتُ أحسبُ خوفَ السقوط عند الغالبية التي لم ترى من قبلُ سريراً بطابقين سبباً وحيداً لهذا الخلاف المستمر على السرير الأدنى. صديقٌ عارفٌ بالسكن وأهله اقترح لي تفسيراً قُروياً أخر لهذه الرغبة العميقة في القُربِ من الأرض. قال إن الضيوف لا ينقطعون عن غرف السكن. ضيوفٌ مقيمون وآخرون عابرون، ولا مكان للجلوس إلا السرير. أصولُ الكرمِ تقتضي أن تُفسحَ سريركَ مضافةً للجالسين، أصحاب الأسرة العالية لا يملكون هذا الفخر، حيث لا يجلس أحدٌ في الأعلى.
ثم، مع الوقت ومن غير قصد، يعتادُ الطالب ويسكنُ. ولأن الحنين أشدُّ من الحُلم، ينتهي الطالبُ إلى تأثيث زاويته الموحشة على شكل بيت العائلة الذي هرب منه.

في السكنِ أيضاً يدخلُ الطالبُ عالماً جديداً فيه، للمرة الأولى غالباً، حيزٌ كبير للاختلاط بالجنس الآخر. عالمٌ مليء بالوجوه والملامح لم يعتده من درسَ وكبر في سياقاتٍ يصعب فيها الاختلاط. ورغم أن الإناث والذكور لا يقطنون في مباني السكن نفسها، لكن المكان العام بمقاهيه ومساراته وحدائقه يبقى واحداً وفيه مجال للقاء.
أول كُل مساء يرددُ الشابُ «الملائكة في الخارج تنتظر، اذهبوا إليها» ثم يخرجُ مُتأنقاً، ماراً بمحلات الخبز ونَتفِ الفروج، ليقف تحت الوحدة الرابعة عشر، أظنّها الأقرب إلى أوتوستراد المزة. اتصالٌ على الخط الداخلي للوحدة وتنزل الفتاة حاملةً عُدةَ الشاي أو المتة وبزراً مالحاً. على العُشب المُتسخ تحت كَتِف المبنى يجلس تاركاً مسافةً تُبعدُ الشُبهات. من لم يزرُها أحد تُراقبُ من بعيدٍ الزائرين. في الساعة التاسعة شتاءً والعاشرةِ صيفاً يَقرعُ الحارس بمفتاحٍ معدني على بابِ الوحدة. جَرسُ إغلاقِ الأبواب إلى الأبد. مع كُل قرعةٍ يتذكر الجالسون أحاديث لم تكتمل، «اللي عندو شي عالمسودّة ينقلو عالمبيّضة» يتهكمُ الحارسُ وتُسرعُ الفتاة. العشاقُ الأكثر إلحاحاً، وهرباً من لؤم الحرسِ، ظلّوا يقاطعون الأحاديث مُتوسِّلين أن يمضوا إلى بيوتٍ للآجار «أخلاها الأصدقاء كي يحمِّلوا العاشق جميلتهم». ويعود الأقل حظاً منهم بعد كل إغلاق للباب، ليقطعوا بكامل أناقتهم شوارع المدينة الجامعيّة دون إتجاه، راكلين في طريقهم أغطية الكازوز والحصى.
ويحدثُ أن يبقى الشاب جالساً تحت الوحدة الرابعة عشر، وحيداً كأنه ينتظر الفتح التالي. ويحدثُ أن تُغني فتاةٌ لحنَ شوقٍ في نافذةٍ مُعتمة. وهكذا، ألفُ صبيةٍ مسجونة بعد الساعة التاسعة ليلاً شتاءً والعاشرةِ ليلاً صيفاً، وعشرةُ آلاف شابٍ يبحثُ عن كأس ماء يُذهبُ مُلوحة البزر.
مَرافِق
مُكملاتُ السكن مرافق موزعة داخل الباحة. محلاتٌ للبقالة وصبِّ المفاتيح، مكتبةٌ مركزية تنقطعُ عنها الكهرباء قبل الامتحانات، ومقاهٍ عديدة يُمنعُ دخول الحرس إليها.
مقصفُ المدينة، المقهى الأثير، أكثر رسوخاً من الأظافر، على جهة اليمين من مدخل المواساة. بأسعاره الرخيصة يبقى مُلتقى من لم يرغب في الجلوس على باب الوحدة. يتغير مُستثمروه كلَّ عامٍ وتبقى فيه النوافذ المعدنية العالية وطاولات البلاستيك التي تشوهتْ بفعل جمْرِ الأراكيل.
قرب المدخل، خارج السور، مقهى أوركيد الأهدأ قليلاً، حيث تتخلل «يا مهيرتي فوق الجبل» أغاني فيروز، و«حيث يشربُ الشعراء الصغار شايهم ويزهون بما دخنوا من سجائر وآخر ما كتبوا من قصائد».
جماعات
والسكنُ جماعات. ككلِّ اغترابٍ يبحث الوافدون عن هويةٍ تربط. هويات مُتوهمة، مناطقيّة، إثنية، دينيّة أو سياسيّة لم يفكر بها حاملوها من قبل. بطاقة الطالب التي يُمحى الاسم منها لكثرِ التداول لا تكفي انتماءً، ولا نجاة لفردٍ في هذه الزحمة. الفرزُ الأول يلمُّ أناساً لم يلتقوا من قبل. طلاب من درعا والرقة وعامودا وإدلب في غرفةٍ واحدة، ولا شيء يجمعُ إلا مشاكل السكن والطرنيب. مطلعَ كُلَّ عامٍ تكثر طلباتُ النقل بين الغرف، مُرفقةً غالباً بمبلغٍ أو هدية يحملها الطالب إلى حاجبِ شخصٍ يملكُ القرار.
وللجماعاتِ في السكن طباع ومراجع، امتيازات وحدود. أبناء الجولان يسكنون غرفاً أنظف وأوسع، ويدخلون الجامعات بشروط مخففة. الشيوعيون بارعون في تنظيم الرحلات والهُتافِ تنديداً بالإمبريالية. وأبناءُ دير الزور يُعلّقون أعلاماً زرقاء من النوافذ، أزرقُ الفتّوة.
ويحدثُ أن تختلف الجماعات، انتفاضاً لشرف فتاةٍ، شرف جماعةٍ، تمادى منتهكوه في عدم التستر، أو عقبَ مباراةٍ تَخسرُ فيها الأرجنتين. الطلاب الأكبر مني بأعوام أخبروني عن معركةٍ بين الكرد والعلويين مطلع الألفية، أُمُّ المُعارك في السكن. خِلافٌ على الدور في طابور كولبة الهاتف العمومي** بين شابٍ من ديريك وفتاةٍ من ريف جبلة، استجلبَ حميّة الجماعتين. استنجدتْ الفتاةُ بجماعتها فتكاثروا على الكردي، في اليوم التالي في مقصف السكن ثأرَ الكردُ. اليوم الثالث صادفَ الذكرى الأولى لموتِ حافظ الأسد فكان هُدنةً، ثم كانت الموقعةُ الكبرى في اليوم الرابع، قتالٌ بالحجارة والعصي وبوكسات الحديد، شارك فيه كثيرون ولم يتدخل فيه الحرس. صرخاتٌ لبثِّ الحماسِ، ثُم ركضٌ وضرباتٌ بالأحزمةِ على جوزاتِ الحلق.. رواةُ الكُردِ قالوا إنهم انتصروا.
** كان الهاتف الداخلي في غرف السكن مخصصاً لاستقبال الاتصالات فقط، وقبل انتشار الهاتف المحمول اعتاد الطلابُ استعمال كولبات الهاتف العمومي. غُرفٌ زجاجية صغيرة موجودةٌ في أرجاء المدينة الجامعية فيها حصالاتٌ تعملُ بالعملاتِ المعدنية القديمة ولا تقبلُ «العشرة الحديد» الجديدة. يطولُ طابور الانتظارِ على أبوابها مطلع كُلِّ شهر حينَ اتصالِ الطلابِ بالأهل طلباً للمال. لاحقاً اكتشفَ الطلاب حيلاً تجنبهم خسارة النقود، منها أن يمرروا خيطاً ثخيناً في ثقبٍ صنعوه في العملة المعدنية، ثم يكررون ادخال وسحب العملة نفسها المُعلقة بالخيط من الحصالة طول الوقت.
هامشٌ أخير
أحكي هُنا بعضاً من سيرة من كانوا هُناك، مُستغرقاً في استنطاق الذاكرة، والذاكرة كالحلمِ تختارُ وتكذب. الحكاياتُ نهرٌ والتداعياتُ تُجرُّ التداعيات ثم لا أدري إن كان أي شيءٍ مما قلتُ في مكانه. تفاصيلٌ تكثرُ ثم تسقطُ من بين الأصابع، ويدهشني بعد ذلك أنّ ما بقي لم يسقط أيضاً لشدّة ما فقدتُ إحساسي فجأةً بكل شيء.
المدينةُ هُناك والحكاياتُ نهرٌ. أغاني الصباح التي كُنا نُدندِنُها منتعشين في مداخل دِمشق تصدحُ الآن من مُسجلات البولمان. ومُلاّكُ البيوت في ركن الدين و جرمانا أسكنوا مستأجرين جُدداً. أذكرُ، وغَبشُ الفجرِ على عيوني، تمثالاً وأقفالاً ونادلةً عرجاء سعيدة ولُقمةَ لحمٍ أخيرة تنتقل من صحنٍ لصحن، وأذكر قصصاً أخرى مات أصحابها.
المدينة هُناك والحكاياتُ نهرٌ… ولو لم ينبح كلبُ الجيران الأسود لكُنّا حتى الآن نحلم.