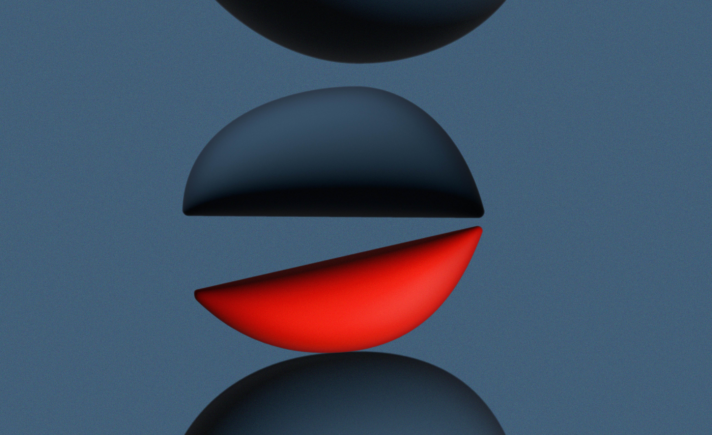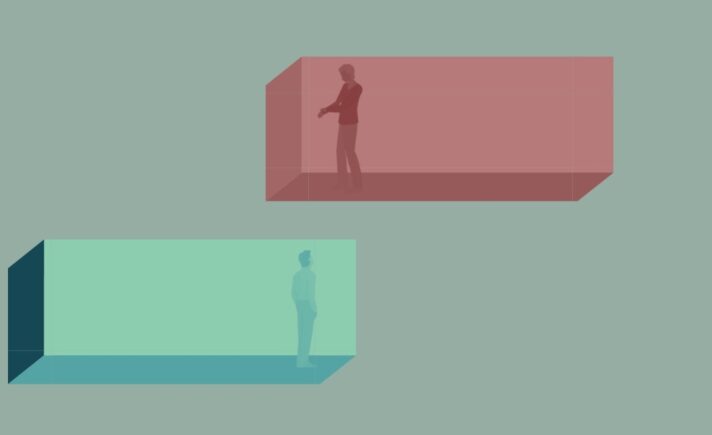الحسد موضوع غير شعبي بين النساء المتحررات، فهو يحاكي بشكل كبير الصور النمطية حول الإناث اللواتي لا يتورّعنَ عن فقء أعين بعضهنّ من أجل رَجُل أو فستان أو وظيفة بمرتبٍ معقول. كما أن الحسد موضوع مزعج، لأنه إحساسٌ مقيت لا يسمح لنا بتقديم أنفسنا على أحسن حال. ألم نقرر نحن النِسويات الجديّات أننا سوف نهجر العداوات والحسد، لأننا بخلاف الرجال لا نؤمن بالمنافسة، وإنما بالتعاون والتضامن؟ وألم نشطب لذلك السبب مصطلح «حسد» من قاموسنا النِسوي؟ الإجراء الأول والوحيد الذي طبقناه كي نتخلص من ردود أفعالنا الإناثية التقليدية، أي المنافسة على الرجال، كان بنفي الرجال عن جمعياتنا. من دون رجال لا حاجة للتصنّع، وسوف يكون لدينا أخيرًا وقت لمحادثة حقيقية نصغي فيها إلى بعضنا. من دون رجال لا حاجة للخلافات، أو هكذا ظننا. ويبدو أن هذه الوصفة قد نفعت في البداية، وكم استمتعتُ بعمل الرائدات في المجموعات الأفقية أو «الجمعيات التعاونية»، من دون قيادة ثابتة أو أن يكون صوت إحدانا من حيث المبدأ مسموعًا أكثر من الأخرى. نظّمنا مؤتمرات، وأنشأنا جريدة للنساء ودار نشر. وقد كانت للمبالغة في تطبيق الأفقية مزايا إيجابية بكل تأكيد، حيث اكتشفت الكثيرات في تلك الأجواء التشجيعية مواهب غير متوقعة. ومن ناحيتي لم أكتشف متعة الكتابة إلا ضمن الجو الآمن الذي منحته جريدة النساء من خلال نشر المقالات من دون توقيع، لأني ارتحتُ كثيرًا لفكرة كوننا لا نتسابق على أي مقالة هي الأفضل. سعادتي بكتابة المقالات لا تفوق غبطتي بتشجيع الأخريات على الكتابة، أو الرضا الذي ينتابني حين أَراهُنَّ في الاجتماع التالي حاملات دفاترَ لتدوين الملاحظات. هذا ما يسمى الفخر بالوكالة: نحن قادرات! بيد أننا سرعان ما بلغنا حدود إيديولوجية المساواة. إذ بمقدورنا التصنّع أننا متساويات ضمن حلقات الكلام، حتى ولو ظهر أن بعض النساء كلمتهنّ مسموعةٌ أكثر من الأخريات، ولكن ما إن نخطو خارج الحلقة، حتى نكتشف أن تلك المساواة مجرد وهم. ونرى أن بعضنا تتمتع بمستوى تعليمي أعلى، أو تفلح بتحويل عملها التطوعي إلى وظيفة مدفوعة الأجر، أو تعتلي المناصب ضمن الأحزاب السياسية. ويحصل أن يُطلَب من بعض النساء أن يُلقينَ محاضرة أو يكتبنَ مقالة لجريدة مقابل أجر. وهكذا نشأت الشجارات حول فيما إذا كان نِسويًا أن تشتغل إحدانا على نجاحها المهني، أو تكسب المال من خلال الكتابة عن بؤس الأخريات. وألن تكوني قد لطّختِ يديكِ جرّاء ذلك؟ ألن تكوني قد أُدمِجتِ، وصرتِ شريكة النظام عبر تنمية الفروقات بين النساء بدل التضامن معهنّ؟
كما أن إيماننا بتساوي الجميع ضمن المجموعة بدأ بالانهيار، حيث أن إلغاء القيادة الرسمية لم يفضِ إلى تساوي النفوذ على الإطلاق. كنا نعلم جميعًا من هي القائدة: لعلّها صاحبة المبادرة، أو تلك القادرة على التعبير بشكل جيد، أو التي تنسحب عليها معايير النِسوية الضمنية أكثر من غيرها. وهكذا استبدلنا منافستنا على الرجال بخلافاتٍ من نوعٍ جديد: من هي المضطهَدة أكثر من غيرها ويحق لها الكلام قبل الجميع؟
لا أعتقد أني الوحيدة التي أحسَّت أن غطاء الحركة النِسوية الدافئ لم يكن حنونًا فقط، بل خانقًا في بعض الأحيان. في البداية لم نكن نملك المصطلحات التي تساعد على فهم ماذا حلّ بنا. فغالبًا ما كنا نتقاذف المصطلحات السياسية أثناء الشجارات: أكثر ما يهمنا هو النِسوية الحقيقية، والموقف الحقيقي من العالم. وأعتقد أن دور المشاعر الشخصية في كثير من الخلافات كان أكبر مما نودّ الاعتراف به. وحتى لو باتت الأمور الآن أقل جذرية من ذلك الحين، إلا أن كثيرًا من الشجارات المهنية بين النساء تخفي مروحة من المشاعر التي نود التخلص منها. وبما أنه لا ينبغي للنساء العصريات والواثقات من أنفسهنَّ أن تنتابهنَّ مشاعر الحسد والعداوة، يصعب عليهنَّ التعامل مع الأمر بأريحية. وكما ينسحب على جميع المحرّمات، فالمشاعر الممنوعة تميل للتسرب بين الشقوق أو الانفجار في لحظات غير متوقعة.
مرّ وقت طويل على النشوة التي رافقت إرهاصات التضامن بين النساء. وكما في سائر الحالات الرومانسية، فقد تكشَّفَ بعد انتهاء شهر العسل أن الرومانسية بين النساء أكثر تعقيدًا مما كنا نتوقع في بادئ الأمر. وحصل أن احتجتُ أثناء نوبات غضبي إلى اقتباس ما قالته إحدى النِسويات الأمريكيات: «الأختية قوة، وبمقدورها أن تقتلك». ففي الولايات المتحدة كان كل شيء يحصل قبلنا بقليل، وينسحب ذلك على «الحرق» أيضًا والإيقاع بالزعيمات النِسويات، كَكيت ميليت، من قبل الحركة النِسوية نفسها. أقول اليوم إن الأختية قوة، ولكنها معقدة، ولن يمنحها أحدٌ كهدية. فكما في العلاقات الأخرى، لا تبدأ الفصول المثيرة حقًا إلا بعد عبارة «وعاشوا في ثبات ونبات». وها نحن نتابع تدوين تلك الفصول الآن، لأننا لا نكدّس الخيبات فقط، بل نكتسب رؤية أوسع كذلك. كما بتنا نفهم أن العالم الخارجي ليس هو الوحيد الذي يحصرنا في مكاننا جرّاء العنصرية والقواعد المفروضة على سلوك المرأة. لم نعد نشتكي من «القمع» فقط، لأننا نستبطن كثيرًا من تلك الآراء بأنفسنا. أصحاب السلطة الرجال غير مضطرين أن يبقوا بلا حب، أما صاحبات السلطة النساء، فقلما أحبهنّ أحد، وهذا مؤلم، إذ أن الرجال ليسوا الوحيدين الذين لا يحتملون النساء الطموحات، فالنساء، وحتى النِسويات، قادرات على تعقيد الأمور إلى درجة كبيرة. هذا يعني أننا لسنا الحل فقط، بل جزء من المشكلة أيضًا.
سأحاول من خلال هذه المقالة أن أركز على جانب واحد من العلاقة بين النساء، بغض النظر عن كونها علاقة صداقة أم حب أم زمالة: ظاهرة الحسد والجوانب الهدّامة للخلافات التي تزيد قدرتها على التحطيم في حال استمرَّ إنكارها أو عدم الاعتراف بها.
بداية أريد أن أوضح عمّا أتكلم، إذ يحصل في عديد من اللغات بعض الخلط بين المعاني المختلفة لكلمتَي الغيرة والحسد، فتُستخدم إحداها بدل الأخرى. أغار حين أشعر أن شخصًا ينوي سرقة حبٍ أو صداقة مني، فالغيرة أمر يخصّ ثلاثة أطراف واقعيين أو متخيلين: أنا والحبيب والخصم. ويميل البعض للغيرة أكثر من غيرهم، وعلى الأرجح أن الأمر يتعلق بماضيهم، وبرُهاب الهجران، أو بعدم الثقة بجاذبيتهم الشخصية. وقد تصل الغيرة إلى درجة مَرَضية، فيصاب الغيور بالأوهام، ويميل إلى مراقبة حركات وسكنات الآخر، حتى ولو لم يكن هناك أي داع، والنتيجة هي أن يحصل بالفعل ما كان يخشاه. غير أن الخوف من الفقدان مفهوم ضمن حدود معينة، ففي النهاية نحن نعلم أن الهجر أمر واقعي فعلًا. لذلك يتلقى الغيور بعض السند من محيطه إن لم يبالغ في سلوكه. أما الذين يبالغون، فتُعتبر غيرتهم من الظروف المُخفِّفة عند القتل أو محاولة القتل.
أما بالنسبة للحسد، فالأمر يختلف. أنا حسود (نقول: غيّور) حين يكون أو يمتلك الآخر شيئًا أرغب أن أكونه أو أمتلكه. هي أرشق وأجمل مني، ولديها زوج جذاب، أو طفل، أو ليس لديها طفل، أو مراجعات أفضل لكتاباتها، أو عشيق أو عشيقة. الحسد أمر يخصّ شخصين، فهو يشير إلى عجزنا وفشلنا ونواقصنا، لذلك لا بد أن يكون شعورًا مزعجًا للغاية، كما لو أننا لا نتمنى الخير للآخرين. حين نحسد، نتعرف على أنفسنا في أقل حالاتنا لطفًا وكرمًا وشهامة. غالبًا لا نريد أن نكون كذلك حين تحصل صديقتنا المقرّبة على عمل رائع. والحسودة، بخلاف الغيورة، لا يمكنها الاعتماد على تعاطف كبير من محيطها أو نفسها، إلا في حالة تمكّنت من «ترجمة» حسدها إلى شيء يسهّل عليها تحمله، ولا يهزّ صورتها عن نفسها. لذلك نراها تعكس شعورها على موضوع حسدها كجزء من آلية دفاعية. لستُ أنا المسؤولة عن تلك المشاعر المزعجة التي تثيرها في نفسي، بل هي. هي المتعجرفة، وهي التي تتوهم مكانة لا تمتلكها. أما وظيفتها، فلا قيمة لها، ولم تحصل عليها إلا من خلال المحسوبيات.
ونرى الحسد عند الأطفال بشكله الفج. كعكتها أكبر من كعكتي، ولعبته أجمل من لعبتي، وها هي جالسة في حضن أمها لأنها حَرون، أما أنا فلا، لأني شجاعة. ثمة ميل طفولي لدى الحسودين أن يخرّبوا على الآخر متعته. إن لم أتمكن من الحصول على سيارة الإطفاء، سأكسرها. وسوف أضرب أختي الحرون بالعصا على رأسها. ولحسن حظنا طبعًا أن أبدان الأطفال ليست قوية، وإلا لن تنتهي جرائم القتل في حدائق الألعاب. وحين نكبر لاحقًا، لن تغادرنا تلك الأحاسيس، غير أننا سنكون قد تحضّرنا إلى درجة تمنعنا عن الصراخ والطرق على رؤوس الآخرين. وعوضًا عن ذلك نخترع أساليب التوائية كي نخرب متعة الشخص الذي نحسده: الغيبة والصمت العدائي والنبذ البارد والإطراءات المبطنة. رأيت ذلك يحصل حين أصبحت هيدي دانكونا وكيل الوزير: ما إن ركبت سيارة العمل الفاخرة بعد أربعة أيام من استلامها المنصب، حتى احتد التهكم في برنامج تلفزيوني نِسوي: تعالوا تفرجوا عليها! كما لو أنها لم تعد واحدة منا من حيث المبدأ. وحصل ذلك أيضًا حين ظهرت بعض النساء في الإعلام أكثر من غيرهن، وكذلك حين حازت عدد من النساء على الأستاذية الجامعية التي ناضلنا طويلًا من أجلها. فجأة فقدنَ ثقة الأخريات، وطفقت بعض النِسويات يتساءلن فيما إذا كنّ «واحدة منا». من صفات الحسد أننا نوجهه إلى الأشخاص الذين تسهل مقارنة أنفسنا معهم، أي إلى أشخاص قريبين منا من حيث المبدأ. هذا هو سبب تمجيد النِسويات الأجنبيات أو المتوفيات كبطلات حقيقيات، بينما تُهاجَم النِسويات المعاصرات اللواتي ما زلن على قيد الحياة. لا تعتبر سيمون دوبوفوار خصمًا، فهي أجنبية ومتوفاة. لذلك بمقدورنا الإعجاب بها من دون تلك الأحاسيس الجارحة التي ترافق سؤال ما هو الشيء الذي تملكه ولا أملكه أنا. المسافة أكبر من أن يكون ذلك ممكنًا. ولكن المسافة ليست كبيرة بيننا وبين النساء اللواتي نعرفهنَّ وينتمينَ للخلفية الاجتماعية والفئة العمرية ذاتها ويمتلكنَ المواهب ذاتها في بعض الأحيان. أكثر ردود الأفعال إزعاجًا بالنسبة لي، والتي تسببت بحزنٍ وغضب شديدين، هي تلك الصادرة عن نساء يتقنَّ الكتابة وينتمينَ لجيلي. الرجال ليسوا لطفاء أيضًا، ولكنني كنت أتوقع ردود أفعالهم، فأنا في النهاية أحاول نزع ألعابهم من أياديهم. لذلك لن أستغرب أنهم سوف يحاولون ضربي على رأسي بأقرب فأس في متناول اليد.
حين يتعلق الأمر بالحسد، تكون العلاقة بين الشخصين غير متساوية من حيث المبدأ. كما تبدو المحسودة صاحبة امتيازات سلفًا: هي تملك شيئًا، أو قادرة على شيء، أو تكون شيئًا تفتقده الأخرى. وترى نفسها عاجزة أمام الحالة، إذ غالبًا ما تكون موضوع تلك الأحاسيس أكثر من أن تستدرجها بنفسها. بعض الحسناوات يتعرضنَ لحسد بنات جنسهنّ، وربما سوف يسبب ذلك كرهًا شديدًا لديهنّ تجاه النساء الأخريات في حال تعرّضنَ كفاية لذلك النوع الخاص من الارتياب. وبذلك يقدّمنَ الحجة العقلانية للأخريات كي يقلنَ: ألم نقل إنها غير متعاونة، وتفضّل الرجال علينا؟ كما تنشأ ضمن هذه الحلقة المفرغة الآليات التي تجعل النساء يحسبنَ حساب حسد الأخريات، وخاصة حين يكتشفن أن الشيء الوحيد الذي بإمكانهنّ فعله هو عدم استعراض النجاح والسعادة. لدينا عدة طرق لتحقيق ذلك: أَطري على ملابس امرأة، وستلاحظين أنها تسع من عشر مرات سوف تقول إنها اشترت البلوزة بالتنزيلات أو أنها ليست ماركة جيدة. وطبعًا لا بد أن تستعجل بقول شيء لطيف لإعادة التوازن إلى نصابه. وقد تكتسب بعض النساء سماكة جلد الفيل، وخاصة أولئك اللواتي يصلنَ إلى مناصب عالية في السياسة. وحينها سوف تكتمل الدائرة بردود فعل من قبيل: يا لها من متعجرفة!
فكرتُ أني لا أشكي من الحسد (بل أشتكي منه). ربما لأني حاولتُ الجري وراء طموحي بطريقة ما، ونجحتُ بتحقيقها فعلًا. أعرف كل شيء عن الغيرة، أما الحسد فلا. لا أدري من هي التي كان بودي أن أكون في محلها. ما زلت أحلم بأنف آخر، وساقين طويلتين ونقدٍ لطيف لكتاباتي، ولدي لائحة دوّنتُ فيها أحلامي، ولكن حين أرى النساء ينجحن بشيء، ينتابني شعور بالفخر بالوكالة وسعادة. قلت لنفسي: هذا هو الحل، لو شجعنا بعضنا بعضًا على تحقيق طموحنا، وعلى تجاوز مخاوفنا والقيود التي في داخلنا، سوف يختفي الحسد والكره. أي إنني كنتُ قادرة على النظر إلى ظاهرة الحسد عن بعد. ولم أقع في الفخ إلا حين قرأتُ في مقالة كلمة «حسد» وبجانبها مصطلح «عدم الغبطة». إذ أنه لا يمكنني إنكار أني لا أغبط بعض النساء أشياء كثيرة، بل أصبّ اللعنات على أولئك اللواتي يقرّفنني عيشتي بحسدهنّ. وكما يليق بأنثى تنتمي لعصر ما قبل النِسوية، لم تسعني سعادتي حين رأيت أن الصحفية البغيضة التي كتبت مجددًا مقالة سامّة عني قد خسرت المعركة مع دهون البطن، بينما استرجعتُ لتوي مقاس خصري القديم.
لا أنوي ردّ كل صراع بين النساء أو المجموعات النسائية إلى ظاهرة الحسد. إذ توجد اختلافات مثبتة وموضوعية بيننا، اختلافات على صعيد الامتيازات الاقتصادية وفرص التغلغل في التعليم العالي. ثمة اختلافات طبقية وقومية وفي الميول الجنسية وغيرها. وفي بعض الأحيان كانت السوداوات وذوات الاحتياجات الخاصة والعاملات والمثليات ينقدنَ نسويات الطبقة الوسطى البيضاوات نقدًا لاذعًا، ولكنه قيّم ومحق في الوقت نفسه. قد يشوب النقدَ بعضُ الحسد، ولكن ذلك لا يبرر عدم أخذه على محمل الجد. ينبغي علينا تجنب الاختزالات الجديدة، فإن سمينا كل الصدامات التي تحدث بين النساء «حسدًا»، وحلّلنا كل شيء انطلاقًا من أسبابه النفسية، فإننا نتصرف بالضبط مثل أطباء النفس التقليديين الذين طالما لُمناهم على تشخيص كل شيء كمرض، حتى ولو لم يكن الأمر شخصيًا بحتًا، وإنما سياسيًا. ولكن من ناحية ثانية، أحتاج أن أقول للنِسويات اللواتي يطلقن تسمية «سياسة» على كل ما هبّ ودبّ إن الاختزال السياسي لا يقل خطرًا عن الاختزال النفسي. فالمشاكل بين النساء لا تذوب فجأة حين نعزوها للنظام الأبوي. ينبغي أن نبحث أين الشخصي من السياسي، وما الربط بينهما حين نقول «الشخصي سياسي».
وتبعًا للتقاليد النِسوية الجيدة أريد تجنب عدم ذكر سبب اهتمامي بموضوع الحسد. لذلك لن أتكلم عن النساء كما لو أني لستُ واحدة منهنّ، ولا عن الحركة النِسوية كما لو أني خارجة عنها. حين انضممتُ للنِسوية، رميتُ نفسي في أحضان الحركة، كما لو أني أخيرًا وجدتُ أمي الحقيقية التي كنتُ أبحثُ عنها طوال الوقت. أُشبّه انضمامي للنِسوية عن قصد بالعودة إلى أحضان الأم، لأني بتُ متأكدة أن النِسويات الأوائل لم يصبحن نِسويات فقط من أجل صراع الكرامة وتحسين العالم. أعتقد أننا كنا بناتًا يحملن كمًّا هائلًا من الصراعات الداخلية غير المحسومة، ونبحث عن نساء أخريات يعالجن جراحنا القديمة، ويَردُدنَ لنا بعضًا مما فقدناه. بوسعي وصف تجربتي الأولى مع الحركة النِسوية بالانصهارية، كما لو أني وجدتُ وطني، وجدتُ أخيرًا من يفهمني ويحبني من دون شروط.
أولى مشاكلي ظهرت في مرحلة «الفطام». بعد مدة استمتعتُ فيها بفعل كل شيء مع النساء الأخريات، شعرتُ بحاجة لمساحة لنفسي. بدأتُ مشواري كمعلمة، وحصلتُ بعدها على شهادتي الجامعية، وشرعتُ أكتب وأنشر. وكلما نجحتُ في عملي أكثر، نقدتني النِسويات الأخريات أكثر. وحين تصدّر كتابي لائحة الكتب الأكثر مبيعًا، رحتُ ضحية هجومٍ في غاية العدوانية. لم أفهم شيئًا حينها، بل صُعِقتُ أن بعض النساء ممن ساعدنني بالحصول على وظيفة حين كنتُ أحاول التوفيق بين العمل والكتابة، انقلبنَ عليّ بعد أن نجحتُ بالمهمة. كانت ردة فعلي غضبًا مجروحًا مفعمًا بالذنب (هل أستحق فعلًا كل ذلك الاهتمام، وِلمَ أنا بالذات؟) وبالشعور بالوحدة والعزلة التي عرفتُ أحدَ أشكالها من قبل. حين أعود بذاكرتي إلى تلك الأيام، أدرك أني كنتُ أعيش تكرارًا لرضِّ نفسي قديم. فأنا مثل جميع البشر أعاني من التناقض الوهمي بين حاجتين: أن أكون أحد أفراد الجماعة من ناحية، وأن أكون مستقلة من ناحية أخرى. كم تمنيتُ لو حلّت الحركة النِسوية تلك المعضلة بمنحي مكانًا واعدًا بالحب والدعم لفردانيتي. ولكن بدلًا من ذلك وصلتني الرسالة ذاتها التي تربيتُ عليها: إذا أردتِ أن تكوني فردًا ضمن الجماعة، فعليكِ أن تتخلي عن طموحكِ، أو ابتعدي عنا إن رغبت بالاستقلالية. حاولتُ أن أجد حلًا وسطًا عبر إخفاء نجاحاتي قدر الإمكان. وكلما أطرى أحدهم على كتابي، أكدتُ له أن جميعنا قادرات على ذلك الإنجاز، ولكن الصدفة شاءت أن أكتبه أنا. أحبُّ الإطراء، ولكنه يوترني في الوقت ذاته: كما لو أجبرتُ على أكل وليمة من الكريما، بينما أشتهي قطعة من الخبز والجبن بين الحين والآخر.

ما زلتُ أذكر لحظة الانقلاب جيدًا. في الحقيقة بودي أن أشكر إحدى مدرّباتي على ذلك، ديانا بلسر. فقد شاركتُ مرة في ورشة عمل كبيرة للنساء، وكنتُ طوال الوقت منشغلة ألا أبدو مختلفة عن الأخريات. لم أنطق اسمي بوضوح، ورحتُ أبالغ بالمساعدة في الأعمال المنزلية كي أُثبتَ أني لستُ نجمة الحفل. كنتُ قد عرضتُ لتوي خدماتي كمترجمة في إحدى المظاهرات، وقدّمت استعراضًا بهلوانيًا كَربّة بيت ساذجة، في محاولة مني أن أبدو مفيدة وغير مرئية في آن، حينما أمسكت ديانا بذراعي وجرتني لأقف في وسط المجموعة: «أخبرينا، كيف هو شعوركِ أن تكوني مشهورة؟». ويا للعجب، فقد أجهشتُ مباشرة بالبكاء، لأني انتبهتُ فجأة أني أحاول طيلة الوقت طلب الصفح عن نجاحي، وأدركتُ كم أحب أن أكون واحدة منهنّ. حتى إني كنتُ مستعدة أن أتخلى عن جزء من نجاحي لأجل ذلك. ولكن حين يتم تقبلكِ بشرط أن تنكمشي على نفسك وتختفي، يساوركِ الشك فيما إذا كنّ يحبنّكِ فعلًا. وهنا يمدّ الحقد رأسه: أنا أتخلى عن هذه الأشياء لأجلكنّ، لذلك ينبغي أن تُكافئنني. عندما طلبت ديانا مني أن أصف شعوري، قلتُ إني أحسّ كما لو كنتُ واقفة لوحدي على رأس جبل، وأواجه ريحًا عاتية، وأرغب بالنزول. أريد أن أصل إلى مكان الآخرين حيث يعم الدفء. ولكن لِمَ لا تقولي للناس تعالوا إلى فوق، فعندي مكان يكفي للجميع؟ لا، لن أتمكن من قول ذلك لأنه كلام متعجرف جدًا. ولكني اكتشفتُ أنه جوهر المشكلة فعلًا، وأن علينا جرّ بعضنا إلى الأعلى، وليس إلى الأسفل. ومن خلال الردود فهمتُ أني لست الوحيدة التي تعاني من معضلة المفاضلة بين تطوير الذات بشكل فردي والرغبة بالانتماء للجماعة. كنتُ عضوة في أكثر من جمعية تعاونية نسائية، وعدة مجموعات سياسية، ودور نشر نِسوية، ولجان تحريرية، وفرق تعليمية. وفي كل مرة ألاحظ الآلية ذاتها: طالما النساء ما زلن يحاولن الوقوف على أرجلهنّ، سوف يتلقين دعم الأخريات. ولكن حالما تنجح المرأة بالحصول على تلك الوظيفة، أو تتخرج من تلك الجامعة، أو تُطلِّق فعليًا عوضًا عن مواصلة التذمر من زواجها، أو تتمكن من الوصول إلى منصب مرموق، أي باختصار: حالما تنتقل إلى خانة النساء «القويات»، يُسحَب التعاطف والمساندة منها، ويصبح من واجبها أن تثبت أنها ليست أفضل من الأخريات. وقد عبّرت الكاتبة النِسوية فاليري مينر عن هذه الحالة قائلة: أحيانًا يبدو التعثر على الطريق أكثر نِسوية من تحقيق النجاح.
يبدو أن إيديولوجية المساواة سيطرت على معظم الآليات التي ذكرتها. وكما في مجالات العمل الأخرى صار لدينا تحالفات سلطة ومحسوبيات وقدح وثرثرات بين الكواليس. والصبيّة التي تتجرأ على البروز، سوف يرتطم رأسها لا محالة. ما زلنا لا نفهم أن المبالغة في البنية الديمقراطية لا تمنحنا الحماية من الحسد والعداوات. بل على العكس: من ميزات البنية التراتبية هي أنه معروف من الذي يتخذ القرارات، وأنه بإمكاننا توجيه أحاسيسنا نحو صاحب السلطة عوضًا عن توجيهها إلى بعضنا.
دعونا نبحث في الأمر، ونضرب مثال صديقتين تعملان في مجلة نِسوية تعاونية. أحيانًا يكتبان مقالاتهما سوية، ولكنهما يراجعان أعمال بعضهما بعضًا ويقدمان الملاحظات بشكل دائم. وفي يوم من الأيام تشرع إحداهما، دعونا نسميها تريكس، بكتابة كتاب. وبعد عودتها من إجازتها التي استثمرتها في الكتابة تعطي المخطوطة لصديقتها، دعونا نسميها ميكه، وتكتشف أنها ليست متحمسة كما توقعت. وبدل أن تسارع تلك بقراءتها، تؤجل المهمة عدة مرات، فهي مشغولة جدًا حسب قولها. لذلك ترسل تريكس مخطوطتها إلى دار النشر دون أن تقرأها ميكه. وبعد أن يتم نشر الكتاب تسمع تريكس أن ميكه تقول إن الكتاب جلب اهتمامًا أكثر مما يستحق، وأنه ليس بتلك الأصالة. تتضايق تريكس دون أن تخبر ميكه. ومع الوقت تلاحظ أن مقالاتها تتلقى نقدًا لاذعاً أكثر من ذي قبل. وعندما تنظر إلى ميكه طلبًا للدعم، ترى أن صديقتها لا تنبس ببنت شفة. وعندما ترسل تريكس مقالاتها إلى مجلة ليست نِسوية، تتلقى تقديرًا عميقًا، أما مجلتها فلا تتطرق أبدًا لمقالاتها أو بشكل عابر فقط. وهكذا تضعف العلاقة بين تريكس وميكه، وتغادر تريكس المجلة بعد حين.
هل يمكننا اختراع نهاية من نوع آخر لهذه القصة؟ نهاية سعيدة؟ ربما. بوسعي أن أتخيل سيناريوهين آخرين. على سبيل المثال كان يمكن أن توافق تريكس صديقتها على أن كتابها لا قيمة له، أو أن تُظهر شكوكها وارتباكها بشكل أفضل. وكان بإمكانها أن تخبر صديقتها أن الكتابة بمفردها في غاية الصعوبة وتطلب منها أن تراجع مقالتها القادمة. لربما تُنقِذ صداقتها ووظيفتها في المجلة بهذه الطريقة.
السيناريو الثاني هو أن تتحدى تريكس ميكه وتطلب منها أن تعبّر عن مشاعرها. وقد تعترف ميكه أنها فعلًا «غارت» وخافت أن تفقد تريكس وتبقى وحيدة. وكان بوسع تريكس أن تقول: «لا أريد أن أفقدكِ، ولكني سأستمر في الكتابة. ماذا نفعل كي تحقق كلانا طموحها ونبقى صديقتين رغم ذلك؟».
في السيناريو الأول تصعد الأولى نحو القمة وتبقى الأخرى تحت. هذا هو السيناريو الأغلب حدوثًا برأيي، إذ أني رأيت صداقات كثيرة تتحطم جراء ما صرتُ أسميه الحسد الخفي والعداوة المبطنة. رأيت ماذا يحصل على الجهتين: تشعر الأولى بالذنب جراء «الامتيازات» التي حصلت عليها بعرق جبينها، وتشعر الاثنتان معًا برُهاب الهجران وفقدان الحب والدعم الذي نحن بأمس الحاجة إليه. كما أرى الشعور بالخذلان لدى الطرفين.
وقد لاحظت أن السيناريو الثاني الذي «تنزل» فيه الأولى إلى الأسفل ليس نادر الحدوث كذلك. هذا ما أسميه «أثر العقارب» (ضعي عقارب في سلة ولن تحتاجي لإحكام إغلاقها، فكلما حاول أحدهم الخروج جذبه الآخرون إلى الأسفل). أما السيناريو الثالث الذي تعبّر فيه النساء عن رُهاب الهجران الذي يعتريهنّ، ويتجرأنَ على مواجهة بعضهنّ بعضًا وتحدي الأخريات بطريقة لطيفة كي يصعدن جميعًا إلى الأعلى، فهو نادر الحدوث. ما زلنا لم نتعلمه بعد.
هل الحسد موضوع نِسوي، وهل هي ظاهرة تخصّ النساء الساعيات إلى التحرر؟ نعم ولا. فالنساء التقليديات لسن بريئات من الحسد على الإطلاق. لدينا النساء اللواتي لا يملنَّ من الإصغاء إلى شكواكِ من سوء سلوك زوجكِ، ويتخلينَ عنكِ حالما تقررين أنكِ لن تتحملي أكثر من ذلك. أعتقد أني أتحدث عن آليات تظهر عند جميع الأقليات الساعية إلى التحرر، حيث يكون التضامن شرطًا في غاية الأهمية. غير أن التضامن نفسه يقف في وجه التحرر الفردي. وطبعًا الحسد ليس غريبًا على معشر الرجال أيضًا. ولكن ثمة فروق بين الجنسين، فالرجال يحصلون بشكل عام على فرصٍ لتحقيق طموحهم أوسع بكثير من النساء. مشكلتهم هي أنهم مطالبون بالمنافسة فيما بينهم، حتى ولو كانوا لا يرغبون. يتدربون على ذلك منذ نعومة أظفارهم. كما أن كثيرًا من الطقوس المنتشرة بين الرجال تعتمد على حسّ المنافسة: واجب الفوز والقبول بالخسارة كذلك. ولكن الرجال الفائزين يحصلون على مكافآت سخية، وسوف تعشقهنَّ النساء في جميع الحالات.
أما النساء المنتصرات فيضعنَ محبة الرجال على المحك. كما أننا نقف في طريق بعضنا بعضًا، حتى ولو لم يكن ثمة رجال يضموننا تحت جناحهم. نفزع من التخلي عن دورنا كضحية، ونفضّل السكون والتذمر بأننا لا نحصل على الفرص على أن نختطفها حيث وجدت. وهكذا ينقلب التضامن إلى آلية تجعلنا نتحمل القمع، وليس سلاحًا للتخلص منه.
نعم إذن، الحسد ظاهرة نِسوية بشكل من الأشكال. كنتُ أتمنى ألا يكون كذلك، لأنه يحاكي التنميطات المنتشرة حول النساء. وكم ستكون الأمور أبسط لو أننا احتجنا لإدانة الرجال فقط على وضعنا المتردي. لا شك أنهم يلعبون دورًا كبيرًا، فهم قلّما يساندون النساء على تحقيق طموحهنّ، لا في المنزل ولا في العمل. ولكن يؤسفني القول إن هذا جزء من الحقيقة فقط.
لماذا من الجدير أن ننشغل بظاهرة الحسد؟ بما أن الحسد من المحرّمات، أعتقد أنه أكثر بكثير من شعور شخصي مزعج. أعتقد أن له قدرة تحطيمية على العلاقات بين النساء. سأذكر بعض الأمثلة:
أولًا: بسبب الحسد تصبح المسافة بين الزعيمات و«التابعات» أكبر من اللزوم، فتنعزل الرائدات ليبدو الأمر كما لو أنه نبوءة ذاتية التحقق. نتوقع من تلك المرأة أنها ستغادر الحركة طالما أصبحت بتلك «الأهمية»، وأنها ستهتم بمسيرة عملها أكثر من ولائها للنساء الأخريات. وطبعًا هذا بالضبط ما سيحصل، لأنها بدورها تشعر بخيبة أمل كبيرة جرّاء نقص دعم النساء، وقد يطفح الكيل معها لأنها مضطرة أن تدافع عن نفسها على جبهتين. حصل أكثر من مرة أن ساررتني امرأة سياسية أنها تتلقى دعمًا من زملائها الرجال أكثر من النِسويات.
ثانيًا: يمنع الحسد النساء أن يتعلمنَ من بعضهنّ أو أن تتخذ إحداهن دور المعلمة والثانية دور التلميذة. مما يعرقل نقل الخبرة والمهارات، وخاصة في البنى التنظيمية «الأفقية» التي لا تملك رئاسة رسمية، كما في حال الفرق التعاونية. قلّما تسير الأمور من دون صراعات، مما يجعل العمل في غاية الصعوبة للمشرفات والمعلمات والمعالجات.
ثالثًا: الخوف من الوقوع ضحية الحسد يجعلنا نخفي ما اكتسبناه من خبرات ونمثّل دور الوسطية. إذ أن الحصول على التعاطف جراء هشاشتنا وفشلنا أسهل من الحصول عليه جراء مهاراتنا. وهكذا يتم التأكيد على الصور النمطية التي تربينا عليها سلفًا: لن تستفيد المرأة من محاولة استعراض قدراتها خارج نطاق المقبول للنساء. من الخطر أن تكوني طموحة أكثر من اللزوم، كما أن مسيرة عملٍ ناجحة سوف تجلب العزلة معها. سوف تفضي المبالغة بالخوف من الحسد إلى ثقافة تتنازع النساء فيها على مرتبةِ من هي الأكثر بؤسًا، والأكثر اضطهادًا. ثقافة لا يتلقّى فيها أحدٌ أي اهتمام سوى الضحايا.
بالطبع أبالغ. أنا لا أطالب بإلغاء أي شعور بالتعاطف مع الألم الحقيقي. ولا أقول إن التزاحم والسعي المحموم وراء الأهداف الخاصة، حتى ولو على حساب الآخرين، هو حتمًا استراتيجية نِسوية أفضل من التمتع ببؤس الجماعة الدافئ، والذي نطلق عليه أحيانًا اسم «التضامن». ولكن ربما من المفيد أن نبحث عن توازن بين حسّ الجماعة والفردانية.
نحن لم نبتكر شعار «الشخصي سياسة» من دون سبب، بل لأن ثمة ربطًا بين الصراعات الشخصية التي نعاني منها أثناء محاولاتنا للتخلص من القمع المستدمج وبين الصراعات السياسية داخل الحركة، حتى ولو كان علم النفس والسياسة يتكلمان لغتين مختلفتين.
يرتبط التوق للانتماء إلى الجماعة بأمثولة التعاون والجمعية والوحدة، بينما ترتبط الاستقلالية والسعي وراء الأهداف الخاصة بأمثولة التطور الفردي وحرية النساء. وكما من شأن البحث عن التوازن أن يكون هدفًا شخصيًا، قد يتحول إلى هدف للحركة النِسوية أيضًا، أو بالأحرى لكل تعاونٍ نسائي. ينبغي على كل حركة تحررية أن تجد التوازن بين النشاط الجماعي ودعم التطور الذاتي للأعضاء. لا يمكننا الانتظار حتى تتمكن جميع النساء من اتخاذ الخطوة ذاتها إلى الأمام، ويجب أن نتقبَّلَ مؤقتًا أن مواصلة العمل سوف تجلب المنفعة لبعض النساء أكثر من أخريات. ولكن إذا كان ذلك كل ما يمكننا فعله كحركة نِسوية، فهذا يعني أننا لن نحقق شيئًا سوى مساندة النساء الأفضل حالًا. إذن: النِسوية لن تفضي فورًا وأوتوماتيكيًا إلى المساواة.
دعونا نفهم ماذا يحصل. سبق أن قدّمت بعض المعالجات والمحلّلات النفسيات عملًا عظيمًا في هذا المجال. سأذكر هنا بضعة أسماء لنساءٍ ألهمنني: نانسي شودورو، جين فلاكس، سوسي أورباخ، لويز آيخنباوم، ويسيكه بنجامين. رغم أن الجدل ما زال قائمًا حول فيما إذا كان الحسد يولد مع الإنسان، كما تزعم ميلاني كلاين، أم إنه ردة فعل على تجارب الألم والإحباط الباكرة، إلا أن معظم الباحثين يعتمدون أن حجر أساس الحسد تشكل في السنوات الأولى من عمر الإنسان. ورغم احتمال تطور حسّ الحسد لدى الصبيان، إلا أن ثمة فروقاً بين الجنسين. (ولا أقصد هنا النقاش القديم حول حسد الرحم لدى الرجال، أو حسد القضيب لدى النساء. بالنسبة لي حسد القضيب ليس موجودًا سوى بين الرجال). بالنسبة للنساء ثمة أسباب أكثر تدفعهنّ إلى الحسد، وإمكانيات أقل للتعبير عنها. فقد وصفت نظرية العلاقة بالموضوع أن الفرد يتعلم في المرحلة الأولى من حياته كيف يتعامل مع التوتر القائم ما بين الرغبة بالحميمية والحاجة إلى الاستقلالية، أي القُرب من الراعي الأول والاعتماد على النفس في آن. ولا داع أن تتناقض هاتان الحاجتان طالما الأمور تسير على ما يرام. فلأننا نشعر أن وظيفة الأم هي الاستناد عليها، سوف نتمكن من اتخاذ أولى خطواتنا بعيدًا عنها. ولأننا قادرون على الاعتماد على أنفسنا، سوف نتمكن من الدخول في علاقات دون الخوف من أن نفقد أنفسنا أو تضيع فردانيتنا.
غير أن علماء نفس نِسويين أثبتوا أن الأمور غالبًا لا تسير على ما يرام. فبينما يُدفع الصبيان نحو استقلالية تطغى عليها الدفاعية أكثر من التوازن، توضع العراقيل أمام الفتيات. (اعذروني على التنميطات التي لا مفرّ منها حين نتكلم عن «الرجال» و«النساء»، كما لو أن هذه القوالب تنطبق علينا جميعًا). أعتقد أن معظمنا سيوافق أن المرأة التي تمتلك حسًا سليمًا بقيمتها الذاتية، ويتم تشجيعها على الإنجاز من جهة والتعاون من جهة ثانية، وتتلقى الحب جراء إنجازاتها، لن تشكو من أحاسيس الحسد حين تقف أمام إنجازات النساء الأخريات. لا بد طبعًا من الحد الأدنى من التنافس، ولكن دون أن ينكأ المواجع. بوسعنا أن نفرح ونشعر بالفخر حينما تنجح امرأة أخرى، لكن معظم النساء تختلط عليهن المشاعر، حيث أن قلّة قليلة تربّت على حسٍ عال بالقيمة الذاتية. وحسب تجربتي فقد اضطرت كثيرات للقتال لأجل ذلك.
الأمومة مهمة تجلب العزلة للأمهات، وخاصة لجيل الأوروبيات اللواتي عشنَ بعد الحرب العالمية الثانية، وينتمينَ للطبقة الوسطى البيضاء التي تتوقع منهنّ التخلي عن طموحهنّ لصالح الأسرة. على الأرجح أن معظم أولئك الأمهات رغبن بحياة أفضل لبناتهنّ، ولكن يبدو أنهنّ نقلن تلك الأمنيات مرفقة بمثال المرأة التي ينقصها احترام الذات. وقد تختبئ مشاعر الحسد المتناقضة خلف الأمل والحب الذي تكنّه هؤلاء الأمهات لبناتهنّ. فقد شرحت شودورو أن كثيرات يرغبن بالإنجاب، لأنهن لم يتلقين الحنان بما فيه الكفاية. يتوقعن أن العلاقة الحميمية مع الطفل سوف تعوّض جميع الأمور التي افتقدنها في الماضي، والتي يفتقدنها الآن في العلاقة مع الرجل. وحين يكون الطفل المنتظر بنتًا، يحدث أن تتماهى الأم بطفلتها، ويصعب عليهـا الانفصال عنها أو أن تستمتع كأم بإرهاصات استقلاليتها حقًا. وقد تغار من الاهتمام الكبير الذي تتلقاه طفلتها ولم تحصل على ربعه طيلة حياتها.
ويحصل أن تحسد الأم ابنتها على شبوبيتها، وعلى الإمكانيات التي ما زالت مفتوحة أمامها. أعتقد أن كثيرات منا اكتشفنَ أنه من أجل الاحتفاظ بعطف أمنا، يجدر بنا أن نمكث على مقربة منها ولا نبتعد سريعًا. وعندما تكون حاجتنا للفطام والانفكاك أكبر من حاجتنا للإبقاء على العلاقة، نكتشف أننا سندفع ثمن حريتنا، والثمن هو الوحدة. هذا هو الإحساس الذي سيتكرر ويتضخم لاحقًا.
يصعب على الرجال التعامل مع النساء الماهرات والناجحات لأسباب لا مجال لذكرها هنا. هذا يعني أنه ينبغي على اللواتي يرغبن بعلاقة مع رجل أن يتحملنَ التتفيه، أو يبحثن عن سبل لإخفاء إنجازاتهنّ، حتى على أنفسهنّ. ولكن من المؤلم أن نكتشف أن التتفيه لا يقتصر على الرجال فقط، فالنساء يتقنّ ذلك أحيانًا. وكما قالت أورباخ وآيخنباوم: «كل امرأة تعلم، عن وعي أو لا وعي، أين هي العتبات التي لا ينبغي تجاوزها كي لا ينصبّ غضب النساء وحسدهنّ على رأسها».
ويصعب التعامل مع هذه الأحاسيس لاختلاطها بجراح وخيبات أمل الماضي البعيد. لا أظن أنه توجد نساء كثيرات يشعرن بالمحبة الكافية. وها قد هرِمنا ووصلنا إلى درجة معقولة من الحكمة لندرك أنه لا فائدة من لوم أمهاتنا، وخاصة أن الجميع يحملهنّ وزر كلّ الأخطاء. غير أن المسامحة وتفهّم أن الأم قدّمت أحسن ما لديها لن يحلا أوتوماتيكيًا معضلة التوتر القائم بين الرغبة بالحميمية والتوق إلى الاستقلالية. أعتقد أن هذه الرؤية تعلل جزئيًا سبب نشوب الصراعات بين النساء، وتشرح لمَ هي مؤلمة إلى هذا الحد.
تشعر كثير من النساء بالعجز على أكثر من صعيد، أو شعرنَ بذلك في الماضي. حتى «القويات» يعانين أحيانًا من عدم الثقة، على سبيل المثال تعتريهن شكوكٌ فيما إذا كنّ أمهات جيدات، أو جذابات فعلًا ويستحقنَّ أن يكنّ محبوبات. بيد أن الشعور بالعجز يغدو أقل إزعاجًا حين نعلم أننا لسنا الوحيدات. حين ندرك أن جميع النساء عاجزات، نشعر ببعض العزاء والأمان، لأن الذنب ليس ذنبنا، ولأن الرجال هم الذين يقيدوننا. حين تكون جميع النساء ضحايا، سنحظى بالرفيقات. وإذا كان إحساسنا بقيمتنا الذاتية مرتبطًا بتصديق ذلك فقط، فسوف تشكل كل امرأة تخرج عن الدائرة، أو ترفض دور الضحية، تهديدًا وموضوعًا للغضب والحسد. تلك المرأة التي تجرأت على نبذنا تستحق أن ننبذها بدورنا. وسوف نثبت أن نجاحها لا أساس له، وإنجازاتها لا قيمة لها.
مشاعر الحسد مفهومة. ولكن ما يجعل التعامل معها صعبًا، وخاصة بين النساء «المتحررات»، هو أولًا أننا نتصنّع عدم امتلاك تلك المشاعر، وأنه لا ينبغي امتلاكها، وثانيًا عدم إدراك كم هي مليئة بالصراعات القديمة غير المحسومة.
في الحلقات النسائية استيقظَ شوقٌ قديم لدينا، واكتشفنا أننا نتوق إلى تلقي الحب بلا شروط، وأن نُفهم دونما شرح. ولطالما لاحظتُ أن توقعات الطالبات مني كمعلمة أكبر بكثير من رغبتي أو إمكانياتي. إذ توجد في كل مجموعة طالبة واحدة على الأقل سوف تأتي إلى عندي بعد نهاية الدرس كي تلومني أني لم أنتبه كم هي تعيسة أو كئيبة، كما لو أني قادرة على قراءة أفكارها. كما لاحظتُ أن ذلك يحدث في الصفوف التي أبدي فيها اهتمامًا كبيرًا أكثر من تلك التي أكون فيها فاترة. فالاقتراب من النساء، وخاصة المشرفات اللواتي يأخذن على عاتقهنّ دور الأم، يحرّض مشاعر مختلطة وتوقعات يشوبها الغضب والحسد. ما زلت أذكر طالبة غضبت مني لأني نسيتُ أن أستفسر عن حالها بعد مرضٍ استغرق عدة أسابيع. وعندما سألتها هل كانت ستغضب في حال كنتُ رجلًا، أجابتني: «بالطبع لا!».
لعلّي رسمتُ عبر هذه المقالة صورة كئيبة عن الواقع، ولعلّ الأمور ليست بذلك السوء. فنحن قادرات اليوم على نبش المواضيع المؤلمة والتعامل معها، كما انتهت مرحلة التصلب والدوغمائية. وبتُّ ألاحظ لدى النِسويات تسامحًا كبيرًا حيال الفردانية مقارنة مع بدايات الحركة النِسوية. غير أني ما زلت أقابل نساءً يعتقدن أنه ينبغي علينا كنساء إلغاء صراعات المنافسة، وأن كلمة «سلطة» ملوثة. وما زلت أتساءل إلى أي درجة تنطوي تلك الإيديولوجية السياسية على قناعة حقيقية، وإلى أي درجة تعبّر عن خوف في النفوس: من الأفضل ألا نرغب الأمور التي لا يمكننا الفوز بها. ومع ذلك ألاحظ ارتفاعًا في عدد النساء الجريئات بفضل تزايد الأمثولات في حياتهنّ. وعلى الأرجح أن الجيل القادم من النساء سوف يمنحنَ بناتهنَّ فسحة أكبر، لأنهن تربّينَ على يد نساء لم يتخلّينَ أوتوماتيكيًا عن طموحهنّ لصالح الأمومة. ومن يعلم كيف ستكون النتيجة، ولكن إلى ذلك الحين سيفيدنا التعامل الصريح مع العداوات، حيث لا مفر من ذلك إن أردنا مواصلة المشوار. ما زالت المناصب الاجتماعية التي تشغلها النساء محدودة، ولا يمكننا انتظار بعضنا بعضًا حتى نتمكن من اتخاذ الخطوة الأولى سوية. فضلًا عن أنه لا يمكننا تجنب لقاء الأخريات في محاولات الحصول على تلك المناصب، ولا إنكار أن إحدانا سوف تصل مؤقتًا أسرع من الأخرى. بيد أن الحسد غير المقموع لا يمتلك نصف القدرة التحطيمية التي يمتلكها حين لا نعترف به ونعكسه على الآخرين. يخبرنا الحسد ما هو الشيء الذي نريده، لذلك بمقدورنا أن نتحداه.
قابلتُ منذ فترة صديقة لم أرها منذ زمن طويل. نظرت إلي بغضبٍ وقالت: يا غليظة، ها أنذا أكدح لسنوات على أطروحة الدكتوراه ذاتها، وما إن التهيتُ عنكِ، حتى اعتلى كتابك الجديد رفوف المكتبات. أكرهكِ. وهنا علت قهقهاتنا وقضينا أمسية جميلة معًا.