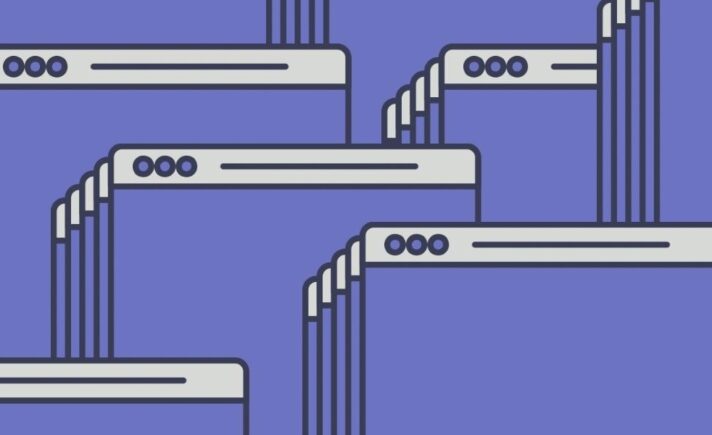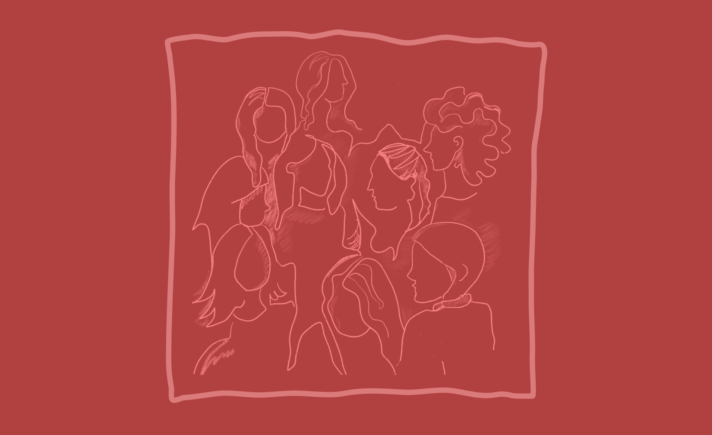تصاعدت الاحتجاجات الغاضبة مجدداً في لبنان منذ أواسط نيسان (أبريل) الماضي، بعد أن انحسرت منذ مطلع آذار (مارس) نتيجة انتشار فيروس كورونا وما رافقه من إجراءات، وبعد أن كان زخمها قد تراجع أصلاً خلال شهر شباط (فبراير)، نتيجة استعصاء يمكن تلخيص أسبابه في عدم قدرة التكتيكات التي انتهجها الحراك الثوري على انتزاع تنازلات جوهرية من النظام الحاكم، ومناورات هذا الأخير التي تجلت في مزيج استخدام العنف والترهيب وشبح الحرب الأهلية، وفي تشكيل حكومة حسان دياب أواخر كانون الثاني (يناير)، بالإضافة إلى يأس وتعب قطاعات من المحتجين اللبنانيين، وانسحاب قطاعات أخرى من الشوارع على خلفية الطروحات التي قالت بضرورة منح الحكومة الجديدة فرصتها.
وكان تدهور الأوضاع الاقتصادية الشديد هو المحرك الأساسي لتجدد الاحتجاجات في لبنان، في ظل استمرار مسلسل انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، والارتفاع الهائل في الأسعار، بالتزامن مع مواصلة المصارف لسياستها في تقييد سحب المودعين لأموالهم، ما زاد من صعوبة تأمين لقمة العيش والاحتياجات اليومية الأساسية، فضلاً عن التداعيات الناجمة عن فيروس كورونا وما رافقه من إقفال المحال والتزام المواطنين منازلهم لعدة أسابيع متتالية.
صبّ المحتجون اللبنانيون غضبهم على المصارف، الأمر الذي تجلى في تحطيم واجهاتها وإحراق العديد من مقراتها في مناطق عدة. وقد تميزت هذه الموجة الاحتجاجية بارتفاع سوية العنف الذي تمارسه وحدات الجيش والأجهزة الأمنية، والذي شمل الاعتقالات الواسعة والتعذيب، والاستخدام المكثّف للقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والحي، ما أسفر عن عشرات الجرحى، وعن استشهاد الشاب فواز السمّان في طرابلس يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من نيسان 2020.
مزاعم إصلاح اقتصادي
يوم الخميس الثلاثين من نيسان، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب عن إقرار خطة «إصلاحية اقتصادية شاملة»، تضمنت خطوات عديدة يُفترض تنفيذها على مدى السنوات القليلة القادمة، من أبرزها طلب الدعم الخارجي بما يفوق عشرة مليارات دولار، والاستعانة بصندوق النقد الدولي، وتعديل سعر صرف الليرة اللبنانية حسب سعر السوق في المستقبل القريب، وإعادة هيكلة الديون العامة، وإعادة التوازن في الموازنة العامة من خلال تحسين التحصيل الضريبي، واستعادة الأموال المنهوبة، وإصلاح مؤسسات كبرى من القطاع العام كشركة كهرباء لبنان، وإنشاء شبكات أمان اجتماعي واسعة النطاق.
لم يقتنع المتظاهرون بمضمون الخطة، إذ راحوا يحتجون في اليوم التالي الذي صادف عيد العمال العالمي، وكذلك في يوم الأحد، حين جاء متظاهرون من مختلف المناطق إلى شوارع وساحات طرابلس، حاملين صور الشهيد فواز السمان. في حديث للجمهورية، يشرح جاد شعبان، أستاذ الاقتصاد المشارك في الجامعة الأميركية في بيروت، نواقص الخطة الرئيسية؛ «لا تختلف الخطة كثيراً عن الخطط التي طُرحت في السنوات الماضية» يقول شعبان، «كل المقترحات قائمة على سيناريوهات وافتراضات ليست تحت سيطرة مجلس الوزراء، وإنما هي تحت سيطرة الطبقة الحاكمة ومراكز السلطة الحقيقية في البلد. إن كانوا يريدون إقناع الرأي العام باستعدادهم لمحاربة الفساد، على سبيل المثال، فيجب اتخاذ قرارات قضائية بالغة الوضوح تطال أفراد السلطة».
يتابع شعبان: «المؤشرات ليست إيجابية. قُمع المتظاهرون الذين عادوا إلى الشوارع، واستُخدم العنف وصولاً إلى التعذيب والقتل، في حين لا يوجد أي مؤشر على أن القضاء سيتخذ إجراءات جدية ضد أي من الفاسدين. لا معنى لتشكيل لجنة جديدة لمحاربة الفساد في هذه الشروط. لقد أنشأنا مليون لجنة سابقاً».
يشرح شعبان أنه ينبغي أولاً استعادة ثقة الناس من خلال إصلاحات سياسية، على رأسها إجراء انتخابات نيابية مبكرة على أساس قانون انتخابي جديد؛ «يجب إبداء استعداد لتغيير الطبقة السياسية، ولو جزئياً، من خلال انتخابات ديمقراطية. يحتاج أي بلد يدخل مرحلة من الاضطرابات العظمى إلى انتقال سلس للسلطة، وإلا سيواجه الفوضى التي نحن أمامها الآن. كذلك يجب اشتراع قانون القضاء المستقل الذي يتيح وجود قضاة مستقلين يحققون في ملفات الفساد الكبرى، بدلاً من تشكيل لجان من النظام الحالي. من دون ذلك، فإنه لا يمكن استرجاع أي من الأموال المنهوبة، ولن يمنع أحد من أن تُصرف الأموال الجديدة القادمة من الخارج بالطريقة السابقة نفسها».
يختم شعبان: «تهتم الخطة المطروحة بمجموعات المصالح ذات الغنى، كالمصارف والحكومة، وتتجاهل تماماً حاجات عموم اللبنانيين. هي خطة تفتقد المصداقية السياسية والقضائية، وتعتمد مقاربة نيوليبرالية تقوم على الإصلاحات المالية مع إعطاء بعض الخبز للفقراء، دون توفير السُبُل لإخراجهم من فقرهم».
استقطاب طائفي يحاول ابتلاع الحراك الثوري
في هذه الأجواء، يتفاقم استقطاب حاد في لبنان بين جناحين؛ الأول داعم لحسان دياب، وعمادُه الأساسي حزب الله والتيار العوني، وهو يُحمّل رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المسؤولية عن تدهور الأوضاع في البلاد. أما الجناح الثاني فعماده الرئيسي تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط، وهو يرفض الطروحات التي تجعل سلامة مسؤولاً أساسياً عن الأوضاع المتأزمة، مصوباً سهامه على حسان دياب والقوى التي تقف خلفه.
كان الكاتب اللبناني حازم صاغية قد قال، في مقال له في صحيفة الشرق الأوسط، إن ساسة الطوائف اللبنانية «يتجهون إلى إعادة بناء الاستقطاب الطائفي… على حساب الاستقطاب الذي أسفرت عنه ثورة 17 تشرين»، معتبراً أن هذا الاستقطاب «ينقضّ على اللبنانيّين وثورتهم». وقد تحدثنا إلى صاغية، وسألناه عمّا إذا كان ذلك يعني في رأيه خروج الشارع الثوري من مشهد الفعل السياسي المؤثر في لبنان؛ «هل انتهت الثورة إذن، ورجعنا إلى السياسة اللبنانية كما عهدناها في الفترة ما بين 2005 و2019؟».
يجيب على سؤالنا: «لا أظنّ أنّ المسألة على هذا النحو تماماً. فالصراع ضدّ النظام، بأوجهه السياسيّة والاقتصاديّة والحزب-اللهيّة، يُرجّح أن يمضي قدماً ويتّخذ اشكالاً جديدة. لكنّ هذا لا يلغي أنّ اليد العليا هي للنظام بمعناه المركّب والعريض. إنّها كذلك اليوم، وإلى أمد قد يطول. في هذه الغضون، قد يُضطرّ النظام لتقديم تنازلات هنا وهناك، وقد يضحّي ببعض رموزه، إلاّ أنّ المبالغة في التوقّعات قد يتأدّى عنها إحباط ينبغي السعي دائماً إلى تجنّبه».
يشرح صاغية أن هناك شروطاً كثيرة يحول غيابها دون حسم الصراع مع النظام، «أولها أنّ سلاح حزب الله نجح وينجح في وضع طائفة كبيرة خارج الثورة، وثانيها أنّ الوضع السوريّ خصوصاً، والعربيّ عموماً، هو وضع ثورة مضادّة، وثالثها أنّ البدايات اللاطائفيّة لم يُقيّض لها النماء والتوسّع، فيما جاءت جائحة كورونا لتقوّي بعض أسوأ ميول الانعزال والخوف من الآخر على حساب التضامنات الوطنيّة العابرة للطوائف، كما على حساب تطوير نقاش عامّ تفيد منه الثورة وأطروحاتها».
ولكن هل يمكن أن يكون الانهيار الاقتصادي، ودخول صندوق النقد الدولي على الخط، سبباً في خلخلة الاصطفافات الطائفية-الإيديولوجية القديمة، ونشوء تحالفات جديدة؟ يجيب صاغيّة أن هذا ربما يحدث، لكن أكثر ما يخشاه هو أن تنجح الزعامات الطائفيّة في تحويل الأزمة الاقتصاديّة إلى مادّة لشدّ العصب الطائفيّ؛ يقول «نلاحظ مثلاً أنّ الجماعات التي دفعتها الأزمة الماليّة الخانقة إلى تحدّي الحجر المنزليّ والنزول إلى الشارع تعرّضت لموجات تشهير طائفيّ الخلفيّة، وقد تندفع هي نفسها إلى الاصطباغ أكثر فأكثر بألوانها المناطقية والطائفية، في ظلّ تراجع صيغ التضامن الوطنيّ. وإذا كان من الجائز أن نتوقّع تزايداً في ضمور دور الدولة المفلسة، يقابله تزايد في التردّي الأمنيّ القابل دوماً للتأويل طائفيّاً، جاز أن نتوقّع تالياً دعوات إلى الأمن الذاتيّ للطوائف والمناطق. من السابق لأوانه الجزم باحتمال كهذا، وبفُرَص نجاحه، لكنّ المؤكّد أنّ هذا الاحتمال هو ممّا لا يجوز أن نستبعده مدفوعين بالحماسة».
خلخلة التحالفات الحالية أمرٌ وارد إذن بحسب صاغيّة، لكنه يقول إن التجارب المديدة للطوائف تُعلّمنا أنّ هذه الأمور، على أهميّتها، تبقى قابلة للتذليل قياساً بـ«التناقضات الرئيسيّة». التناقض الرئيس المقصود هنا طبعاً هو صراع النظام الطائفي بكل أجنحته من أجل البقاء، ويقول صاغيّة إن هذا النظام سيستخدم كلّ قواه للضبط والسيطرة ولجم الشارع المنتفض، «لكنّ السؤال الذي يحضّ على التفكير فيه، في هذه الحالة، مزدوج: هل سيستطيع النظام الحفاظ على ضبط أجنحته؟ وفي حال تفاقم النزاع داخل الأجنحة وفي ما بينها، هل سيترافق ذلك مع عمليّة تبلور لحركة شعبيّة على نطاق وطنيّ، تستأنف ما بدأ في 17 تشرين 2019 قبل أن تقطعه كورونا، أم أنّ الشعبويّات الطائفيّة والمناطقيّة هي التي ستسدّ الفراغ بطريقتها؟».
طرابلس تتصدر الاحتجاجات
تحدثت الجمهورية إلى الناشط السياسي اللبناني شربل خوري، الذي قال إنه «على خلاف الموجة الأولى من 17 تشرين، نحن اليوم أمام موجة متركزة في طرابلس، وصيدا نوعاً ما، والمظاهرات التي تخرج في مناطق أخرى تخرج دعماً لطرابلس، وهي صغيرة وخجولة، حتى في بيروت. طرابلس تعاني أكثر من غيرها من المدن اللبنانية، والاتهامات بأن تيار المستقبل يحرك المتظاهرين فيها هي اتهامات سخيفة، لقد أحرقوا مصارف متحالفة مع تيار المستقبل».
يقول خوري أيضاً إنه على الرغم من الخطاب الوطني العابر للطوائف في الحراك الثوري اللبناني، وعلى الرغم من أنه حاول بشكل حثيث كسر الاستقطاب الطائفي في البلد، إلا أن «ما يُقال عن أن الناس تركت طوائفها جانباً ونزلت إلى الشارع هو كلام عاطفي وغير واقعي. الاحتجاجات لها جانب اقتصادي جمع لبنانيين من مشارب مختلفة، ولم تكن سياسية بحتة كمظاهرات 14 و8 آذار». ويشرح خوري كيف أن سياسات القمع تلعب دوراً رئيسياً في هذا المجال؛ «هناك تمييز طبقي وطائفي واضح في العنف، فالجيش اللبناني، الذي تتلمذ على يد الجيش السوري، يضرب متظاهري اليوم في طرابلس، أما مظاهرات بيروت السابقة، فكانت قوات مكافحة الشغب، المدرّبة أوروبياً، تتعامل معها. الفارق في العنف واضح، ولطالما عوملت طرابلس بنذالة من قبل النظام الذي يعتبرها بؤرة إسلامية وإرهابية».
يختم خوري: «أعتقد أن القمع في الأيام القادمة سيكون أكبر من السابق، وأن المظاهرات لن تكون شعبية مع تصاعد المواجهات. كذلك فإنه كلّما ازدادت حاجة الناس، فإنهم سيزدادون عنفاً».
الصحفية اللبنانية يارا الدبس تقول للجمهورية إن «الاحتجاجات اشتعلت مجدداً لأن مطالب الشارع لم تتحقق، ولأن أغلب المتظاهرين يعتبرون حكومة حسان دياب مثل سابقاتها، لكن بغير وجه. يمكننا الحديث هنا عن موجتين للثورة اللبنانية، الأولى في 17 تشرين الأول، وكانت استثنائية في لامركزيتها وسقف مطالبها العالي. أما الثانية فقد تركزت في طرابلس، وكانت أشد غضباً. طرابلس هي الأكثر فقراً، وأضعف المناطق من ناحية التنمية، وهؤلاء الفقراء هم من يقودون الحراك في الموجة الثانية».
تعتبر الدبس أن «الموجة الثانية أكثر جذرية من سابقتها، ويتضح فيها العنف لأن الناس استنفدوا كل الأساليب. الغضب أكبر لأن الأزمة أكبر، فالدولار أصبح بـ 4250 ليرة، وبدأ الناس يجوعون. تفاقمت الأمور أيضاً بسبب نشر الجيش وتوكيله سريعاً بمواجهة هذه الموجة، وقد كان الجيش عنيفاً جداً، حتى أنه لم يتورع عن إطلاق الرصاص الحي موقعاً شهيداً وكثيراً من الجرحى».
أخيراً، تقول الدبس إن الحديث يتزايد في أوساط المتظاهرين والنشطاء عن «ضرورة الانتظام لخوض المواجهة، وهو ما لم يكن مطروحاً على نطاق واسع في الموجة الأولى، إذ كان كثير من المحتجين آنذاك يرفضون الانتظام. يعزز استشراس السلطة اليوم من ضرورة وجود تكتيكات منّسقة وعمل منظّم لمواصلة الثورة».