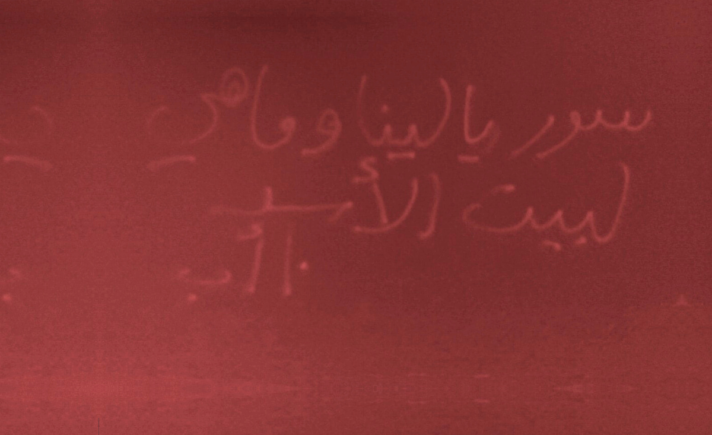نظرتُ إلى الساعة فوراً لأتأكد من التاريخ، وأُسجّلَ ملاحظاتي على دفتر أسود سميك. طابقتُ الوقت على ثلاث ساعات؛ ساعة هاتفي وساعة كومبيوتري وساعة الحائط. هي إذن الساعة الثانية إلا عشر دقائق فجراً، ساعة المفترق الضيق الذي مرّت من خلاله الثورة الوليدة إلى مكان آخر مختلف، إلى الطيران الذي يحلّق في أرجاء حمص، والرصاص الذي لم نسمع له مثيلاً قبل ذاك الوقت. كان مفترقاً ضيقاً، استنتج كثيرون بعده أنه لا سلمية تنفع مع نظام فاق الإجرام، في وقت كانت السلمية هي السائدة بوصفها طريقاً إلى إسقاط النظام كما في تونس ومصر؛ السلمية مع نظام لا يقبل أن تهتف أمامه ولا أن ترفع لافتة أو تصرخ بالصوت، لأنه لن يعمل على إسكات الصوت فقط، بل سيعمل أيضاً على إسكات المكان الذي صرخت فيه رافعاً صوتك.
قبل تسع سنوات، بداية الثورة السورية عام 2011، اجتمع الآلاف حول ساعة حمص منذ ما بعد ظهر يوم الإثنين 18 نيسان (أبريل)، وسرعان ما تحولت تلك الساعة إلى رمز في كل سوريا، فأصبحت مجسماتها تزين ساحات الأحياء والبلدات والمدن السورية، بِدءاً من حي باب هود ثم حي الخالدية في مدينة حمص، مروراً بعامودا في ريف الحسكة ومناطق عدة في ريف إدلب؛ رمزاً للسلمية التي بدأت الثورة بها، ولكيفية سلوك النظام حيال هذه السلمية.
*****
تقع الساعة الجديدة في مركز مدينة حمص، في ساحة جمال عبد الناصر كما هي مسجلة لدى البلدية، إلا أن اسم «ساحة الساعة» هو الغالب لدى عموم أهل المدينة. وهي تقع في نهاية شارع القوتلي الذي يبدأ من عند الساعة القديمة، أو «العتيقة» كما يلفظها الحمامصة، والتي يقال إنها بنيت خلال فترة الانتداب الفرنسي عام 1923. ينتهي شارع القوتلي إذن بالساحة التي تتوسطها الساعة الجديدة، ويأتي لفظ الجديدة تمييزاً لها عن القديمة، لكنَّ لها اسماً آخرَ كما سنرى لاحقاً.
عملياً، هذه الساحة هي الفاصل بين الأحياء القديمة لحمص والأحياء الأحدث فيها، وتتفرع منها خمسة شوارع أخرى غير شارع القوتلي؛ شارع البريد على يمين الساعة بالنسبة لمن يأتي من القوتلي، وهو الشارع المؤدي إلى نادي الضباط على بعد مئة متر من الساحة؛ وشارع الدبلان الشهير الذي يبدو كأنه فرع صغير هارب من امتداد شارع القوتلي، وسُمّي بالدبلان نسبة إلى مقهى شعبي كان في نهاية الشارع في مكان حديقة الدبلان الآن، على اسم صاحب القهوة أمين الدبلان الذي يُقال إن أصله من طرابلس في شمالي لبنان. والدبلان شارعٌ تجاريٌ بامتياز، يتسم بأنه يستقطب زبائن الفئة الأعلى دخلاً بالمقارنة مع من تستقطبهم أسواق حمص القديمة. أما الشارع الثالث على يسار الساعة فهو شارع عبد الحميد الدروبي، المؤدي إلى طريق الشام. والشارع الرابع هو الشارع الواقع يمين السرايا والمؤدي إلى باب هود أحد أحياء حمص القديمة، وأبرز ما فيه صالة صبحي شعيب. والصالة مقرٌ لاتحاد الفنانين التشكيليين أيضاً، والداخل إليها يجد أمامه مباشرة باباً صغيراً يفضي إلى باحة خضراء، هي عبارة عن مقهى يُعرف بمقهى الفنانين، بسقف مغطى بعرائش ونباتات كثيرة لتغطي المكان وتخرجك عن ضجيج مركز المدينة. الشارع الخامس والأخير، هو شارع فرعي صغير يقع على اليسار من السرايا، ويصلنا بجامع الأربعين وسوق الناعورة.

ثبّتت الساعة نفسها كمركز للمدينة، بارتفاع يصل إلى أحد عشر متراً، تبدأ في الارتفاع من قاعدة شبه دائرية فيها درج صغير يفضي إلى قاعدة حجرية بيضاء بشكل متوازي مستطيلات، ترتفع أوجهه الأربعة ليتوسط كل منها ما يشبه الباب، ويبرز فوقه إطار على شكل قوس من الرخام الأسود، وفوقها يتربع برج الساعة المُكوَّن من حجر كلسي أبيض مُزيّن برخام أسود، ليحاكي فن العمارة الأبلقية المنتشرة في بيوتات حمص القديمة، والأبلق هو تناوب العمران بين الحجر البازلتي الأسود والحجر الأبيض. وتبرز فوق برج الساعة قاعدة مكعبة الشكل كالتاج عن جسم العمود، تعلوه قبة صغيرة نصف كروية تقريباً، بيضاء مثل قباب الجوامع، ويحمل كل وجه من القاعدة قرصاً من أقراص الساعة له عقربان أسودان، أحدهما للساعات والآخر للدقائق، وأجزمُ أنه لا حاجة لعقرب ثواني، ليس لأسباب ميكانيكية تتعلق بعمل الساعة، بل لأن الوقت كان يجري على مهل في حمص الهادئة، يجري غير آبه بما يدور حوله من صخب تطور الحياة؛ عقرب الثواني سيكون نافراً في ذاك المشهد.

ترتبط الساعة باسم آخر كما يعرف جميع أهل حمص؛ ساعة كرجية. وكرجية هي مهاجرة برازيلية من أصل حمصي، كانت قد وصلت مدينة ساو باولو عام 1902، وبعد ما يقارب نصف قرن، عام 1951، عادت إلى بلدها الأم رفقة ابنتها وصهرها وسفير سوريا في البرازيل آنذاك الشاعر عمر أبو ريشة، للقيام ببعض الأعمال الخيرية، والتبرّع لمشاريع عديدة بينها بناء ساعة جديدة للمدينة مقابل سرايا حمص «قصر العدل»، فكان المبلغ الذي تبرعت به آنذاك ثلاثين ألف ليرة سورية، لكن البناء لم يبدأ إلا بعد ست سنوات من التبرع. استمرّ العمل على بناء برج الساعة مدة سنتين، إلا أن المبلغ المخصص لم يكفِ لشراء جهاز الساعة، فأضافت السيدة كرجية مبلغاً آخر مساوياً للمبلغ الأول، ليكون الافتتاح الرسمي للساعة في الرابع عشر من آب (أغسطس) 1964، بحضور السيدة كرجية حداد، التي توجد لوحة رخامية تحمل اسمها فوق الباب الجنوبي للساعة. وقد تأخّر وضع هذه اللوحة أيضاً نحو عشرين عاماً، لتوضع في الثمانينيات، مع إضافة لازمة مهمة لم تخطر في بال كرجية، التي تبرعت بإقامة نصب الساعة لذكرى زوجها أسعد عبد الله حداد ابن المدينة الذي توفي في المهجر، لتبقى ذكراه في المدينة التي ولد فيها ومات خارجها. مكتوب على اللوحة أن التشييد كان في عهد «ثورة آذار» التي جاءت بالبعث إلى السلطة، «الثورة» التي لم يعرفها الراحل أسعد حداد!
*****
ثمة مشاهد كثيرة للساعة في ذهني كونها تتوسط المدينة، لكن قليلاً منها فقط هو ما تركّز عليه ذاكرتي المثقلة بتلك المشاهد، ربما بسبب أهمية هذا القليل بالنسبة لي. أول ما أتذكره عن الساعة من طفولتي، بداية التسعينيات، هو صوت دقاتها المنتظم عند كل ساعة، الذي كان يُسمَع في أرجاء واسعة من حمص، خصوصاً في ليل المدينة التي كانت تنام باكراً، والتي كانت قليلة الضجيج لأنها مدينة صغيرة نسبياً مقارنة بمدن أخرى. ما أتذكره أنهم قالوا لي يومها إن صوت الرنين يشبه صوت رنين ساعة بيغ بن في لندن، وقد استمرّ هذا الرنين فترة طويلة وما زالت أذنيّ تتذكره حتى اللحظة، لكنه خفتَ لاحقاً في المدينة التي ازدادت كثافتها السكانية مع النمو الذي شهدته خلال الفترة اللاحقة، أو ربما لأنني كبرتُ ولم أعد أذهب كثيراً إلى بيت عمي أو بيت جدي في حي جورة الشياح المحاذي، أو ربما لأن الساعة توقفت عن إصدار ذاك الصوت؛ لا أعرف في الحقيقة.
ذاكرتي الثانية مع الساعة الجديدة كانت في العام 2007، تحديداً في العام الذي شهد الاستفتاء على ولاية ثانية «مضمونة» لبشار الأسد، عبر كرنفالات ومسيرات بالسيارات شهدتها كل المناطق السورية بما فيها حمص، إلا أن أكثر ما لفت نظري آنذاك هو اللافتات التي عُلِّقَت في أعلى برج الساعة على شكل مستطلات فيها صور لبشار الأسد لتغطي قبتها البيضاء بالكامل، مع العبارة التي ملأت الشوارع في تلك الفترة؛ «منحبك».
على النقيض من هذين المشهدين الحاضرين في ذاكرتي، فإن الذكرى الثالثة والذكرى الرابعة كانتا متقاربتين زمنياً، والفاصل بينهما أقل من شهر، كما أن أياً منهما لم تكن ذكرى فردية أسترجعها هنا في هذه الكلمات، بل كانت كلٌّ منهما ذكرى جماعية، وصارتا جزءاً من الذاكرة الجمعية لأهالي المدينة، وعلامتين على حدثين فارقين في تاريخها، وحتى لو رويتهما من ذاكرتي الشخصية دون الاستعانة بذاكرة غيري، فالأرجح أن الرواية لن تختلف على الإطلاق.
الذكرى الثالثة كانت في 25 آذار (مارس) 2011، في أول مظاهرة حاشدة وعلنية سارت من مسجد خالد بن الوليد ومساجد أخرى باتجاه الساعة الجديدة، ليكون الهتاف أول الأمر ضد محافظ حمص محمد إياد غزال، ويتحول بعدها إلى «الشعب يريد إسقاط النظام»، وأعقبتها الحادثة الشهيرة بتمزيق لافتة نادي الضباط القريب من الساعة، والتي تحمل صورة حافظ الأسد وابنه الوريث.
الذكرى الرابعة والأهم كانت بعد مجزرة السابع عشر من نيسان 2011، بالتزامن ذكرى جلاء القوات الفرنسية عن سوريا؛ المجزرة التي جاءت بعد خروج مظاهرة في حي باب السباع، استشهد على إثرها تسعة شبّان في أول مجزرة في مدينة حمص، وكانت إعلاناً من النظام أن الجدّ قد بدأ، وأن الرصاص سيكون الفيصل في كل شيء.
نامت حمص يومها بانتظار اليوم التالي، ولم يكن أحدٌ يدري ما الذي سيحصل بالضبط، إلا أنه كان ثمة شعورٌ طاغٍ بأنه سيكون يوماً فارقاً في مسيرة الثورة في حمص، وربما في مسيرة الثورة السورية كلّها. وبالفعل، ما بعد 18 نيسان 2011 ليس كما قبله.
عند ورود الأنباء عن وصول جثامين الشهداء إلى الجامع النوري الكبير عند صلاة الظهر، أغلقت المحال التي فتحت أبوابها منذ الصباح، وفرغت الأسواق تماماً في إضراب غير معلن وغير متفق عليه لتشييع الشهداء من الجامع النوري الكبير إلى مقبرة الكتيب، وهي مقبرة يُقال إنه قد دفن فيها صحابة الرسول الذين أقاموا في حمص، وكان الدفن فيها ممنوعاً منذ زمن طويل، لكن من كان يستطيع أن يوقف تلك الحشود؟!
youtube://v/l_lntNCOXiQ
خرج المشيعون من الجامع النوري الكبير باتجاه الساعة العتيقة، ثم إلى شارع الحميدية المتفرع عنها، الذي يسكنه خليطٌ من المسيحيين والمسلمين، وصولاً إلى المقبرة التي تقع نهاية شارع الحميدية عند دوار باب تدمر. بعد الدفن تداعى الناس باتجاهين، قسمٌ اتجه نحو جامع خالد بن الوليد، وقسمٌ آخر باتجاه الساعة الجديدة للاعتصام وسط غياب مؤقت لقوى الأمن والشرطة، لينتهي الأمر مع العصر تقريباً بعدد كبير من المعتصمين في ساحة الساعة الجديدة؛ كان الجميع يهتفون «اعتصام اعتصام حتى يسقط النظام».
التفاؤل العظيم، وتوافد الآلاف في أوقات متفرقة إلى ساحة الاعتصام، أشاع بين الناس أن وقت التغيير قد حان، وأن ساحة الساعة تحولت إلى ساحة تحرير أسوة بميدان مصر الذي أسقط مبارك. عند منتصف الليل، تناقص عدد الناس على أمل أن يعودوا صباحاً، وانتشرت بعض الخيام التي بناها بعض المعتصمين بانتظار الصباح الذي كان يُفترض أن يحمل عودة من ذهبوا إلى بيوتهم، حتى جاءت الساعة الثانية إلا عشر دقائق فجراً، التي كان لها كلام آخر.
youtube://v/JeGd3jmxOsE
تحوَّلَ كل شيء إلى كابوس، حلم ساحة التحرير وحلم إسقاط النظام تلاشى أمام ساعة الصفر تلك، الساعة التي قررها النظام لفض الاعتصام بالقوة، وسط هدير طائرات حربية تخترق جدار الصوت فوق أحياء المدينة، وهدير سيارات يخرج منها الرصاص عشوائياً في كل شوارع حمص، بهدف ترهيب السكّان.
في صباح اليوم التالي أغلقت حمص جميع محالها، مُعلنةً حِدادها على شهداء لم يُعرَف عددهم في ذلك الوقت، ولم يعرف عددهم حتى الآن، حتى أنه لم يعرف أيضاً إن كان هناك شهداء فعلاً في تلك الليلة. لكن الأكيد أنه كان هناك إصابات كثيرة، كانت كمية الرصاص الذي أطلق في تلك الليلة هائلة، وكان صوت إطلاق النار الرهيب مع هدير الطائرات الحربية التي حلقت في سماء المدينة كافياً لأن يخلق حالة ذعر لن ينساها من عاشها أبداً؛ كان ذلك هدف النظام، ترهيب المدينة التي تجاوزت الحدود باعتصامها.
أعلنت حمص في اليوم التالي عصيانها المدني الأول، الذي لم يكن معلناً ولا متفقاً عليه أبداً، وسط خوف وقلق وترقب لما سيحصل بعد الاعتصام، الذي بات واضحاً أنا ما بعده لن يكون كما قبله.
*****
بقي الاعتصام حُلماً يداعب مخيلة الحمامصة، ومع كل مظاهرة في حي من أحيائها كانوا يسترجعون ذكرى اعتصام الساعة، التي ربما لم يجرب أحد الوصول إليها خلال الفترة القريبة التي تلت الاعتصام، لأن رسالة النظام قد وصلت. حتى جاء يوم 22 آب، عندما زارت لجنة دولية مدينة حمص، فاجتمع عدد كبير من المتظاهرين عند الساعة مستغلين مرورها من هناك، لكن قوات النظام لم تمنحهم إلا دقائق معدودة حتى أطلقت الرصاص عليهم، ليسقط عدد من الجرحى، أحدهم هو الشاب فريد الأخوان، الذي استشهد بعد أيام بسبب اختراق رصاصة رأسه، ليكون شهيد الساعة الجديدة.

بعد ذلك بأقل من شهر حوصر حي الخالدية بالآليات الثقيلة وقوات الأمن لمدة ساعات قليلة خلال الصباح، وحاولت قوّة من الثوار الذين حملوا السلاح بعد أشهر من السلمية فكَّ الضغط عن الحي بمهاجمة قيادة الشرطة عند الساعة العتيقة في بداية شارع القوتلي قرب مدخل الأسواق القديمة. تمّ فكّ الحصار سريعاً عن الخالدية آنذاك، إلا أن النظام قرر إغلاق شارع القوتلي، بين الساعتين، نهائياً أمام أهل المدينة، وكان ممنوعاً على أي أحد المرور من الشارع ولو مشياً على الأقدام. أصبح مركز المدينة منذ تلك اللحظة محرماً على المدنيين، ولم يرَ أحدٌ منهم بعد ذلك شارع القوتلي وساعتيه العتيقة والجديدة، إلّا بعد تهجير ثوار حمص القديمة عام 2014، بعد حصار دام سنتين.
*****
في الحقيقة، ثمة ذكرى خامسة أيضاً أحملها عن الساعة الجديدة، وهي أيضاً ذكرى جماعية، سأرويها كما شاهدتها وعشتها. بعد إغلاق شارع القوتلي بما يقارب الشهر فقط، في صباح السابع والعشرين من كانون الأول 2011، صباحاً، علمنا بتواجد اللجنة التي شكّلتها جامعة الدول العربية في حمص، فسارع الجميع إلى حي الخالدية لإقامة اعتصام مهيب في ساحة حديقة العلو، حيث بلغت أعداد الجموع عشرات الآلاف.
بعد الهتافات والقَسَم الثوري الذي اعتدنا على ترداده عند كل مظاهرة، هتف بعض المتظاهرين: «عالساعة عالساعة». الجميع يعلمون طبعاً ما يعني ذلك من مخاطرة هائلة، هذا في حال استطعنا الوصول إلى الساحة أصلاً. كان عبد الباسط الساروت يحاول تهدئة الثائرين المطالبين بالنزول إلى الساعة، لأن المسير إلى هناك من جديد كان يعني حدوث مجزرة. كان باسط يعلم ذلك جيداً، لكن بعد إلحاح الشباب المطالبين بالوصول إلى الساعة، طلب باسط رفع الأيدي لمعرفة رأي الجموع؛ من يريد الذهاب فليرفع يده. كنتُ كمعظم الناس أعي خطورة ذلك، وأعي أننا لا نريد مجزرة جديدة بهذا الحجم، فلم أرفع يدي، ومن رفعوا أيديهم كانوا قلّة، لكنهم لم ينتظروا الساروت ولم ينتظرونا، بل ساروا باتجاه جامع خالد بن الوليد، والحميّة وحدها جعلت باسط ينزل من أعلى كوّة الكهرباء الإسمنتية التي كان يعتليها كي ينشد ويهتف ربالمتظاهرين، ويسير باتجاه السائرين نحو الساعة الجديدة. لحقهم باسط، ومعه جميع من لم يرفعوا أيديهم أول الأمر، وكنتُ من بين اللاحقين لإنه «إذا جن ربعك عقلك ما ينفعك».
سارت الجموع من الخالدية باتجاه جامع خالد بن الوليد، ثم قطعنا طريق حماة الفاصل والخطير بسبب رصده من قبل قناصة النظام. وصلت الجموع إلى الشوارع الخلفية القريبة من الساعة، عند شارع نادي الضباط وشارع مقهى الروضة، لكن عناصر الأمن والجيش المنتشرين هناك منعوا الجموع من اختراق الساحة عبر إطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي. كذلك حاولت جموع أخرى اختراق الساحة من جهة شارع الدبلان، فاصطدمت بالأمن ورصاصه أيضاً. كانت الحصيلة عدداً من الجرحى، وشهيدين اثنين.
طُويت منذ ذاك التاريخ مرحلة محاولات الاعتصام عند الساعة الجديدة، طويت نهائياً، لتبقى ذكرى نسترجعها في كل نيسان يمرّ، نسترجعها نحن الذين فقدنا أماكننا وبيوتنا وشوارعنا وساحاتنا، ونعمل الآن على أن لا نفقد ذاكرتنا أيضاً. أحاول عبر هذا النص أن أقاوم النسيان، أن أقاوم المنفى الذي يطحننا ويطحن ذاكرتنا، أن لا أنسى كلّ ذلك؛ انفعالاتنا وأملنا وصوتنا المبحوح الذي ترك صداه في تلك الأماكن ومضى بعيداً عنها. نستعيد هنا ذاك الصدى، ونتذكره كما نتذكر رنين الساعة الجديدة.