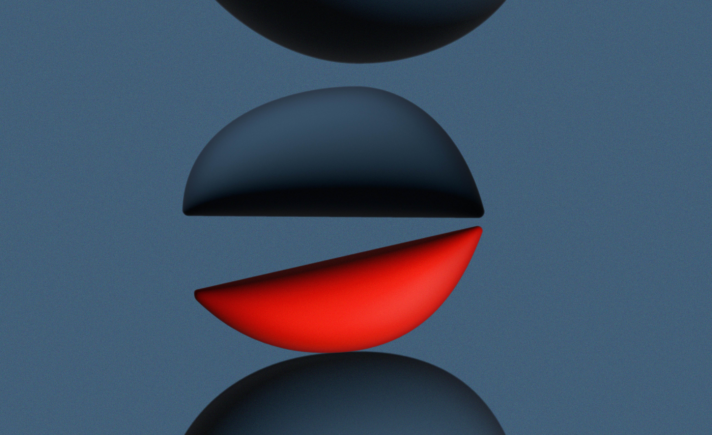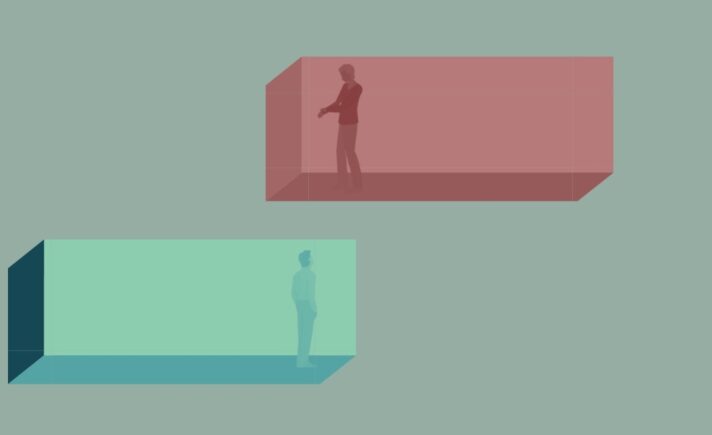بعد كل محاضرة يتخللها نقاش، يُطرح عليّ السؤال ذاته: كيف انتهى الحال بابني؟ هل حالفه الحظ؟ وماذا يعمل الآن؟ وهل هو لطيف مع النساء؟ لفترة طويلة حسبتُ هذا السؤال جزءًا مما يرغب الناس بمعرفته عادة، وأنه نابع عن فضولٍ حقيقي حول تفاصيل حياة النساء المعروفات. هل صحيح أنك مرتبطة بذلك الرجل؟ (نعم)، وهل شعركِ أحمر حقًا؟ (لا)، وهل ما زلتِ مثلية؟ (أكيد)، وهل يمكنكِ العيش من وارد كتاباتك؟ (بصعوبة). ولكن شيئًا فشيئًا بدأتُ أنتبه إلى نبرة السؤال حول مصير ابني: كما لو أنه غطاء لسؤال آخر: هل من الممكن أن تلاحقي أحلامكِ بكل هذا الإصرار، وألّا تلتزمي بالعرف الذي يملي أن الطفل يحتاج إلى أب وأم، وتعيشي على هواكِ من دون أن يكون ذلك على حساب ضناكِ؟ هل من الممكن أن تكوني نسوية وأمًا جيدة في آن؟ ألن يشعر الصبي بالانضغاط، ألن يشعر برفض أمه المثلية له، ألن يتمرد على تلك المرأة الأنانية التي تقوم بما يحلو لها، ولا تخفي عدم إعجابها بالرجل الوسطي؟ ألم يكن من الأسهل عليكِ لو أنجبت بنتًا بدلًا من صبي؟
جوابي هو أن ابني أصبح من ألطف الرجال الذين أعرفهم. كان هذا يريح البعض، إذ لعلّ التوازن بين ما تطمحينَ إليه لنفسكِ وما يحتاجه الأطفال ممكنًا. غير أنه كان يزيد من قلق البعض الآخر، كما لو أن معيارًا جديدًا أُضيف إلى مجموع الضغوطات الممارسة على الأم ليصبح أطفالها صحيين ومتوازنين ومتأقلمين: على بناتنا أن يغدون نساءً واعيات لذواتهنّ ومستقلات، بينما يفضل أن يصبح الصبيان نُسخًا عن الرجل الجديد. إذ كيف يمكنكِ كأم نِسوية أن تنتجي يافعًا مغرورًا يتوقع من النساء أن يلملمن الكركبة من وراءه؟
كانت الأمومة المثالية في أن تنتظري إلى جانب إبريق الشاي عودة أطفالك من المدرسة، وألا تملكي رغبات تتعارض مع رغبات أطفالك، وأن تكوني دافئة وحساسة وصبورة دائمًا بغض النظر عن الظروف، وألا تحبي أطفالكِ أكثر أو أقل من المطلوب. لحسن الحظ بتنا ندرك أن هذه الأمثولة غير ممكنة في الواقع، ولكن ألم نستبدلها خطأ بأمثولة جديدة لا تقل عدم واقعية عن سابقتها؟
يتغير تعريف الأم الجيدة من عصر إلى آخر، ومن طبقة اجتماعية وخلفية إثنية إلى أخرى. ولكن لا أحد يشك في أن ثمة تعريف لـ «الأم الجيدة». كان جيل أمي يعتقد بشكل عام أنكِ تقومين بواجبكِ تجاه أطفالك عندما تطعمينهم وتلبسينهم جيدًا، وتعلمينهم أساليب التعامل الملائمة لطبقتهم الاجتماعية، كي يسير الولد في درب والده، أو يرتقي قليلًا عنه، وكي تتعلم البنت أن تغدو ربة بيت وأم، فتتزوج من رجل مثل والدها أو شخصٍ يضمن لها مستقبلًا أفضل بقليل. ولم تكن فكرة تأثير الأم الكبير على نفسية الأطفال قد انتشرت بعد، كل ما هنالك أنها قادرة على تخريب سلوكهم بالدلال أو بعدم فرض قواعد الانضباط عليهم. وعندما أعود إلى طفولتي، أرى آثار هذه القناعات في تربيتي. إذ كان أكبر همّ لدى أمي هو أن نأكل ما تسكبه لنا في صحوننا، وأن نذهب إلى الفراش في الوقت المحدد. لا يهمّ إن كنا جياعًا أو متعبين أم لا. وميزان الحرارة هو الوحيد الذي يقرر إن كنا مرضى. ويعاقب العصيان بالطرد من غرفة الجلوس، أو بالحرمان من المصروف أو التحلاية بعد الغداء، أو بفرض الذهاب إلى الفراش أبكر من المعتاد. بيد أنّ الوضع بدأ يتغير مع الوقت، حيث وصلت فكرة أن روح الطفل رقيقة إلى المجلات النسائية، وبتنا ندرك أنه من الصعب إصلاح الضرر الذي يلحق بالطفولة الأولى. كانت الأمور واضحة بالنسبة لأمي: عندما يكون ابنكِ شقيًّا ولا يسمع الكلام فعليكِ رفع وتيرة النظام. كانت لا تلوم نفسها على نزقي وعِنادي، لأني ورثتُ الطبع عن أهل والدي. أما الآن فقد شاعت فكرة أن سلوكَ الطفل المنحرف ذنبُ الأم. هي المسؤولة عندما يتبول ابنها في فراشه، أو لا يتوقف عن مصّ إصبعه، أو لا يكوّن صداقات، أو يتصرف كالبنات إن كان صبيًا وكالصبيان إن كانت بنتًا، أو يكذب ويسرق ويتشاجر. لا يتوجب عليها أن تكون على أهبّة الاستعداد أربع وعشرين ساعة فحسب، بل أن يكون مزاجها رائقًا ومتفهمًا. ينبغي عليها أن تعرف ما يدور في رأس طفلها الصغير طوال الوقت، وأن تجيد التعامل مع غيرته في حال كانت على وشك الولادة، وأن تحرص على علاقة متناغمة مع زوجها لمصلحة الأطفال. ينبغي عليها الانتباه ألا تحمي أطفالها أكثر من اللازم وألا تهملهم، مع أن الحد الفاصل بين الحالتين رقيق جدًا. يا له من تناقض: من ناحية تُعتبر الأم قادرة بطبيعتها على تدبير أمور طفلها، ومن ناحية أخرى يصطف لفيف من المساعدين المختصين والمرشدين والعلماء حولها كي يصححوا لها إن أخطأت. لا أظن أن نساء كثيرات كنَّ آنذاك راضيات عن أنفسهنَّ.
كانت الأمومة من أهم الموضوعات التي اشتغلت عليها الحركة النِسوية الجديدة بغية إزالة الأسطرة عنها. وما زلت أذكر مدى الارتياح الذي اعتراني عندما اعترفت في جلسة مع أمهات أخريات بكل أخطائي. وكيف أنني أفكر أحيانًا أن أرمي ابني من الشباك من شدة يأسي من الكركبة والضوضاء والأرق وانشغالي المتواصل. لا أحتاج أن أشرح لهنَّ مدى حبي لطفلي، فجميعنا خبِرنا فيضَ الأحاسيس الدافئة أثناء الوقوف إلى جانب أسِرَّة أطفالنا وهم نائمون. يا ليتهم ينامون مدة أطول، ويا ليتهم يكثرون من ساعات هدوئهم أثناء الرسم. ولكن الأهم أنه كان بوسعنا الاعتراف لبعضنا بشعورنا أننا أمهات فاسدات. وأننا نغضب حين لا نتوفر على أكثر من نصف ساعة لأنفسنا، ونيأس جراء الفوضى الدائمة ورتابة التكرار والتشتت، ونشعر أننا أصبحنا غبيات ومتعبات بشكل دائم، وأننا بعد يوم طويل من ملامسة أيادي الأطفال لأجسادنا نفقد الرغبة بجسد الرجل المتطلب في نهاية المساء. بتنا لا نعرف من نحن. الأمومة في الواقع تجربة أكثر تناقضًا من الأمثولة التي وضِعَت نصب أعيننا، وثمة إجحافٍ كبير في طريقة تنظيمها. لذا كان عنوان إحدى أولى المقالات التي كتبتها: كان بإمكاني أن أصير أبًا جيدًا، ولكنني أم سيئة. إذ أن شروط الأب الجيد تختلف تمامًا عن شروط الأم الجيدة. على الأب الجيد أن يجلب مالًا كافيًا للأسرة، مما يمنحه الحق بالراحة عند عودته إلى البيت. وإن تطوّعَ مرةً بالمساعدة على إرسال الأطفال إلى الفراش، أو لعب معهم، أو أخذهم في نزهة يوم الأحد، أو اشترى لهم الآيس كريم كما كان يفعل والدي، فلا بد أنه أب رائع. أنا قادرة على فعل ذلك أيضًا، قلت لنفسي. وبما أني مضطرة أن أكسب مالي بنفسي في جميع الأحوال، فلا بأس أن ألعب مع ابني قبل النوم وبعد أن تكون أيادٍ أخرى قد غسلته وألبسته البيجاما. وكم سأكون سعيدة بأخذه يوم الأحد إلى مدينة الألعاب، إذا كان بإمكاني إيداعه بعد ذلك متسخًا ومتعبًا من الطريق بين يدي أمه.
عشت كأم بين جيلين، ولكل جيلٍ منهما أمثولته المختلفة عن الأمومة. سبقتُ عصري حينما صرت أمًا غير متزوجة، إذ أني أنجبت قبل أن أفكر إن كنت أريد ذلك أصلًا. وتزوجت بعدها وتطلّقت قبل أن أكتشف أنه لا داعِ للزواج. بيد أني كنت متأكدة من عدم رغبتي أن أغدو مثل أمي التي تنتمي لجيل الحرب أو الذي قبله أو بعده بقليل، وتعتقد أن عليها التضحية بطموحها من أجل أسرتها. تاريخيًا، تُعتبر أمومتها أكثر عزلة من أي وقت مضى، فقد ولّى من غير رجعة زمنُ أن تترك نساء الطبقة الغنية مهمة تربية أطفالهنّ للموظفين. وصار ينبغي أن تستلم الأم المهمة بنفسها، ولوحدها. وإذا كنتِ «بنت عالم وناس» فلن تتركي طفلكِ عند الجيران من غير سبب، فقط نساء الطرف «الهابط» من الشارع يسمحنَ لأطفالهنّ بدخول بيوت الجيران والخروج منها، وأن ينادوا بعض الجارات بالخالة. حتى أن العائلات الكبيرة التي ينتبه فيها الأطفال الكبار على الصغار صارت دقة قديمة. وما زلنا حتى الآن نتظاهر بأن النموذج الطبيعي هي الأسرة النواة، بأب غير مرئي أثناء النهار وأم متواجدة لدوام كامل. في الحقيقة هي ظاهرة حديثة بعض الشيء، وقد كانت لفترة طويلة مرتبطة بطبقة معينة قبل أن تنتشر اجتماعيًا كأمثولة لكل الطبقات الأعلى والأخفض.
كانت أمي من النساء اللواتي لم «يضطررن» إلى العمل. كان هذا حقًا من حقوقها من ناحية، ولكنه من ناحية أخرى زاد من عُزلتها. تخلت عن عملها دونما احتجاج، فهذا هو المتعارف عليه حين تنجبين أطفالًا، ولأنك كزوجة المدير لا يحق لكِ القيام إلا ببعض الأعمال الطوعية. لم يكن هذا سهلًا على أمي، فقد غدت كئيبة ونقاقة، وقلبت العذاب الأنثوي الصامت، والاستعراضي بما يرافقه من نوبات الشقيقة أيام الآحاد، إلى فنٍ من فنونها. ودون أن تدرك طبعًا ما هو سرّ شكواها، فقد كنا، أنا وأخي وأبي، نفتقد برأيها لأدنى حسِ بالامتنان. جاءت النِسوية متأخرة بالنسبة لها. كان بوسعنا أن نشرح لها أن الزوج الذي يأكل صحنه خلال عشر دقائق من دون أن ينبس ببنت شفة، ليجلس بعد ذلك بالصمت ذاته خلف جريدته، لا يحمّس على ابتكار طبخة جديدة كل يوم. وأن الإجازات لم تكن إجازات بالنسبة لها، بل هي مجرد تحويل المهام المنزلية إلى أمكنة أكثر بدائية. وأن الأعياد لم تكن كذلك، ولا حتى عيد ميلادها، لأنها سوف تضطر إلى مزيد من التنظيم والعتالة والوقوف في المطبخ. حتى فكرة أن أولادها سوف يكبرون ذات يوم لم تكن تفتح الأفق أمامها، فهي لا تعرف ما البديل عندئذ؟ وحين جاءت الحركة النِسوية لتشرح لها سبب تعاستها، لم تعد تصغي. إذ كيف تعترفين بعد كل هذا الشقاء والتضحية أنكِ لم تكوني مضطرة؟

في بداية الأمر كانت أمي تستحي مني، أنا ابنتها «الأم العازبة» التي ترفض أن تعقل. ولكن السؤال الحقيقي كان من منّا عازبة أكثر من الأخرى. يبدو لي أن أمي كانت تغار مما تسميه أنانيتي، ومن علاقتي مع ابني، حتى ولو لم تكن تسمح لنفسها بذلك. وكانت تنتظر اليوم الذي يتمرد فيه عليّ كما تمردتُ أنا عليها، فوقتئذ سيكون بوسعنا كأمهات أن نتشكى لبعضنا من المراهقين صعبي المراس، ونبكي أن لا أحد يقدّر تعب الأمهات. ربما كان الأمر سيواسيها قليلًا لو أصبح ابني شخصًا أهوج ولا يعرف النعمة. بيد أنها لم تحصل على ذلك العزاء.
لا بد من وجود أمهات من ذلك الجيل ممن ينظرن إلى الوراء برضا أكبر من أمي. ومع ذلك لا زلت ألمس تلك المرارة المحبوسة في القلوب حول أولئك الأبناء الذين سلبوا سنوات من العمر، من دون أن يحملوا أنفسهم عناء اتصالٍ صغير.
أنا لست من جيل أمهات ما بعد الحرب مباشرة، ولا من أولئك النساء اللواتي اخترنَ عن وعي أن ينجبن أم لا. ولا كان عندي الخيار بين العمل أم لا، إذ أن راتب البطالة لم يكن يوجد حينها، مما منحني بعض الميزات التي أعفتني من الشعور بالذنب. وعندما شرعت صديقات من عمري بالتفكير في الإنجاب أم عدمه، وكيف ينبغي التعامل مع العمل والرجال، راحت تنتابني مشاعر مختلطة. بعض الغيرة: كم جميل أن ترغبي بالحمل، وأن يكون ثمة مجال للتفكير حول طريقة الولادة، وأن تبلغي النضوج الذي يسمح لك بالتمتع بأمومتك. ولكن من جهة أخرى كنت راضية أني أتممتُ المهمة. يا لتلك الهموم! ويا لتلك السلسلة اللامتناهية من الاعتبارات: هل سأندم إن لم أنجب؟ وهل سأندم إن أنجبت؟ وهل يمكنني الاعتماد على شريكي أم أختار القيام بكل شيء منذ البداية؟ هل أقلل من ساعات عملي؟ أم أتوقف عن العمل نهائيًا لبضعة سنوات؟ هل أرسل أطفالي إلى الحضانة أم لا، وأي حضانة بالضبط؟ طفل واحد، أم أن هذا سيجعله وحيدًا وانطوائيًا؟ لطالما تساءلت ماذا كنت سأفعل لو لم يكن لدي طفل. أنا سعيدة اليوم أن لدي ابن بالغ يمكنني السهر معه، وشرب كأس من النبيذ أثناء الدردشة عن الحب. ولكن هل كنت سأختار الأمومة عن وعي لو أدركتُ حجم المسؤولية وحجم المجازفة بأن أُستعبد لسنوات طويلة من دون أن تكون النتيجة مُرضية؟ صدقًا لا أعرف.
تغيرت الأمومة، ولكنها لم تغدُ أقل إشكالية بالضرورة. قد تتيسر أمورنا حين لا نضطر بالقيام بالعمل لوحدنا، أي عندما يأخذ الرجال قسطًا على عاتقهم. هؤلا الآباء موجودون، الآباء الذين لا يكتفون بمعاقبة أطفالهم أو اللعب معهم في أوقات الفراغ، غير أن عددهم قليل جدًا إحصائيًا. نقابلهم أحيانًا في الشارع يتبضعون وهم يحملون أطفالهم على الدراجة أو فوق صدورهم. وبما أنهم يلفتون انتباهنا كثيرًا، نبالغ في تقدير أعدادهم. وقد أسخرُ حين أقول أن الآباء اللطفاء متواجدون بين الرجال المُطلّقين أكثر من المتزوجين، أي أنهم يهتمون أكثر بتوطيد علاقتهم مع أطفالهم حين لا يساكنون الأم. هؤلاء الآباء يتقاسمون التدبير المنزلي عندما يكون الأطفال عندهم، ويشاجرون حول لملمة الكراكيب، ولا يقومون فقط بتلك النشاطات التي تجعلهم محبوبين، بل كذلك بالمهام التي توطد العلاقة فعلًا. أتوقع الآن أن يرفع أحدكم صوته متسائلًا، كما يحصل دومًا عندما نطرح هذه النقطة الحساسة للنقاش، ألسنا نحن الأمهات اللواتي أنشأنا الرجال على ذلك؟ لماذا لا نربي أولادنا بشكل أفضل إذن؟
الإيمان بقدرة الأم منتشر حتى بين النساء العارفات أن الأمور ليست بتلك البساطة. الإيمان بقدرة الخبراء، كما لو أني أم نالت شهادتها من ابنها الناجح وباتت قادرة على تلخيص كيف يتحول الطفل الصغير إلى رجل لطيف. في الحقيقة لا أؤمن بالتربية، فهي مثل الحكم. فقد سُئل ملك إيطاليا ذات يوم فيما إذا كان حكم البلاد أمرًا صعبًا، فأجاب أن حكم إيطاليا ليس صعبًا على الإطلاق، غير أن لا جدوى منه.
من جهة نحن لسنا الوحيدات اللواتي يؤثرن على الأطفال، فهم محاطون بالأمثلة في كل مكان وحساسون لما يرونه أكثر مما نقول لهم. يمكننا القول للصبي أن الرجل الحقيقي يكوي قميصه بنفسه، ولكن كم رجل في محيطه يقوم بذلك فعلًا؟ ومن جهة ثانية، بمقدورنا أن نقدم مثالًا للأنوثة يختلف عن الأمومة التقليدية، ولكننا بتنا ندرك أن ذلك سوف يضعنا أمام معضلة: حين نحاول أن نكون أمثولة للمرأة العصرية القادرة على دمج العمل والأمومة، فمن المحتمل أن يرى امرأة متوترة تروح وتجيء أمامه، فيتمنى كردة فعل أن نكون غير مضطرات للعمل. أما حين نكرس أنفسنا للأمومة – وحتى ولو فعلنا، من منا قادرة على تلبية كل احتياجات الطفل؟ – سوف لن نتمكن من تطوير أنفسنا ولا تقديم الأمثولة التي بودنا أن يربى طفلنا عليها. وحتى لو نجحنا أن نكون ذوات طاقة لا حدود لها وأتقنّا فنون السرعة، لن نقدم نموذجًا مختلفًا عن الرجولة. قد نقرأ لأطفالنا قبل النوم لائحة مواصفات الرجل المثالي كما صاغتها إتيكه فيدا، إلا أن تأثير الرجال اللطفاء عليهم أكبر من أي لائحة. طبعًا لا بد أن نَلقى بعض العزاء فيما اكتشفته العالمتين شيريل بينارد وإيديت شلافر من خلال حواراتهما مع كثير من الرجال، وهو أن أولاد النساء التقليديات أقل تقديرًا لأمهاتهم من أولاد النساء المتحررات. إذ تميل الأم التقليدية المتفانية في خدمة أطفالها إلى إبراز كشف الحساب في وقت لاحق، والمطالبة بالامتنان، ما يسبب بالشعور بالذنب. أما الأمهات العصريات والديناميات والمبادِرات، فصحيح أنهنّ كنّ أقل تواجداً من أجل الأطفال، إلا أنهن تركنهم يصبحون ما يشاؤون، وبقين نساء ممتعات أثناء الحديث حتى في سن متأخرة. أولاد هؤلاء الأمهات يبحثون لاحقًا عن صديقة تملك تلك المواصفات، كما أن كثيراً من الرجال العصريين يقولون إنهم يفضلون المرأة الندية التي تشجعهم و لها آراؤها واهتماماتها المستقلة، على المرأة التي تعتمد عليهم ولا تكف عن السؤال إلى أين أنت ذاهب ومتى تعود. ولكن ثمة شيئًا مريبًا: فالرجال الذين تربوا على أمثولة أنثوية مختلفة لم يحصلوا معها على أمثولة ذكورية يتماهون بها، ولا على مثال لعلاقة زوجية مبنية على الشراكة الحقيقية. لذلك يحافظون على الصورة الوحيدة للعلاقة الناجحة التي تقوم بين رجل وامرأة، وليس بين شخصين بالغين، لا، فالعلاقة المثالية بين الرجل والمرأة تكون بين الأم وابنها. أمي قادرة على كل شيء، هكذا قال ابني في حوار أجري معه، وكم كنت فخورة بذلك. كما أني أعرف أبناء بالغين لأمهات متحررات، وغالبًا ما يكونون لطفاء، ولكن هل صديقاتهم سعيدات معهم؟ وماذا يتوقع هؤلاء الشباب من المرأة؟ أن تتحرر ويكون لها انشغالاتها الخاصة وتدفع ثمن مشروبها بنفسها مثل أمه؟ وأن تهتم به كثيرًا، وتقدم العناية دون مبالغة، وتسانده عاطفيًا دون أن تطالبه بالمثيل أو أن يحتاج للسعي وراء ذلك. وطبعًا دون أن يلاحظ أنها وحدها المعنية بالمحافظة على التوازن العاطفي داخل العلاقة، إذ أن أمه كانت تفعل ذلك من تلقاء نفسها.
سألت برنارد وشلافر عددًا من الطلاب من هو أهم شخص في حياتهم. 22% من الشباب الصغار أجاب: أنا، وجاءت النساء في المرتبة الثانية بالنسبة لهم: زوجاتهم وصديقاتهم وأمهاتهم. أما الآباء والرجال الآخرون، فلم يحصلوا على أكثر من 7%. ولكن ماذا كان جواب الشابات الصغيرات؟ 29% قلن أن أهم شخص في حياتهن هو الصديق أو الزوج، ولم تضع أكثر من 5% نفسها في مركز العالم. وحتى بالنسبة لهنّ كان دور الأمهات أهم من الآباء.
أبناء النساء المتحررات يتوقعون منا أن نكون أمهات، أمهات عظيمات، أمهات مقنّعات كنساء عصريات قادرات على كل شيء. لا عجب أننا بدأنا نملّ منهم.
هل الوضع أسهل مع البنات؟ ليس لدي ابنة، ولكني لا أظن ذلك. أتذكر صديقتي النِسوية اليائسة من ابنتها التي كانت ترفض العيش السليم. تذهب إلى المدرسة بتنورة قصيرة جدًا وكعبٍ عال، ولا تقوم بكتابة واجباتها المنزلية، وتتعامل مع الصبيان الصايعين ولا تعود إلى المنزل إلا متأخرة، وليس لديها أدنى فكرة ماذا تريد أن تصبح في المستقبل. لماذا أتعبتُ نفسي، صرخت الأم متعجبة، ألم نفعل (قصدها نحن النِسويات) ذلك من أجلكِ؟ وبينما هي تقول ذلك، تنبهت فجأة أن الكلام الذي خرج من فمها دون تحضير ليس غريبًا عليها. ألم تقل لها أمها ذلك من قبل؟ وهل سمعت كلامها يا ترى؟ بالطبع لا. لقد انتهى أمر ابنة صديقتي على خير، ولكن ذلك لم يحصل إلا بعد أن توقفت الأم عن الضغط عليها. من ناحيتي، لم أتوقع يومًا أن يصبح ابني مثلي، فهو في النهاية رجل. وحتى في أسوأ مراحل العنترة التي مر بها، كنت أواسي نفسي: رجل واحد أزيد أو أنقص لن يغير شيئًا بين الملايين. يؤسفني ذلك، ولكن هل الأمر بيدي؟ وألن يعاني الشاب المختلف عن محيطه من الوحدة؟ أليس له دوافعه ليتبع أترابه أكثر من أن يتأقلم معي؟ وها هو يعترف الآن أنه لم يمتنع عن أسلوب العنترة إلا بعد أن أصابه الملل. وبالطريقة ذاتها ملّت ابنة صديقتي مع مرور الوقت من مماحكة أمها، لأن الأم اكتشفت أخيرًا أنها لم تعد وصية على ابنتها. كما صارت الإبنة تعي أي ثمن دفعته أمها مقابل تحررها: رجل تركها على الطريقة الكلاسيكية كي يلاحق امرأة يافعة وأقل نِسوية، فاضطرت أن تتكبد مصاريفها ومصاريف ابنتها التي راحت تنفق كل مالها على المكياج وتسمح لأصدقائها الشباب أن يصرفوا عليها في مشاويرها. لم يتحسن وضع هذه البنت إلا عندما أحست أنها قادرة على اتخاذ قرارها بنفسها دون أن تضطر أن تكون درعًا لأمها. لا، طالما بقينا نتأمل أن تستلم بناتنا مشاعل النضال منا وينجزن ما لم نقدر عليه، لن تكون تربية البنات أمرًا سهلًا على الإطلاق.
هل هذا يعني أنه لم يتغير شيء؟
بلى.
ما كسبناه هو كسر وحدة الحال المقدسة بين الحب والجنس (الغيري) والزواج والتدبير المنزلي والأمومة. فبعد أن واظبت كثير من النِسويات على رفض مؤسسة عماد الحياة، صرن قادرات على اختيار أي جزء يحتفظن به وأيه يرفضنه: جنس غيري من دون زواج، أو أطفال من دون تدبير منزلي مشترك، أو زواج من دون أطفال، أو أطفال من دون زواج. تأجيل الإنجاب. إلغاء الإنجاب. طبعًا هذه التطورات لا تحصل من دون مشاكل. ورغم أن تربية الأطفال من دون رجل ليست بالضرورة أسهل من تربية الأطفال مع رجل، إلا أن المرأة في الحالة الأخيرة غالبًا ما تفتقد راتب الأب. ما زالت معظم السيدات في هولندا معتمدات اقتصاديًا على الزوج أو الدولة، مما يحد من حرية الخيار. وها قد بدأ «الرجال الغاضبون» يعارضون ويتحدثون عن حقوقهم في أطفالهم، بعد أن زاد عدد المتفردات بالعناية علنًا بعد أن كُنَّ يقمن بكل شيء لوحدهن أصلًا. ولدينا طبعًا الرجال الذين لا يريدون أي شيء من أطفالهم بعد الطلاق ولا يساعدون بالنفقة في حال رفضت المرأة أن تعتني بهم مع أطفالهم. فضلًا عن المختصين القلقين على مستقبل الأطفال إن تربوا من دون نموذج ذكوري يتماهون به، هم لا يناقشون النموذج الذكوري الوسطي الذي قدمه الآباء إلى الآن. يُقال دائمًا إن الأطفال يريدون معرفة من الذي بذرهم، ولكن هل نسوا الـ 15% من الأطفال الناشئين ضمن أسرة نموذجية من دون أن تخبرهم أمهاتهم من هو والدهم؟ (المعلومة من إتيكه فيدا). ماذا يعني أن يهتم الآباء فجأة بأمور أطفالهم، هل هذا شعور متأخر بالمسؤولية؟ أم أن المسألة أكثر من مجرد قلب أبٍ نابض: الخوف من فقدان زمام السلطة وأن ترفض النساء أن يعتنين بهم أثناء عنايتهن بالأطفال؟ الإبن الأكبر الذي لا يريد أن يكبر.
وضمن هذه الظروف، تُطالَب الأمهات العصريات أن يكُنَّ قادرات على كل شيء. كما أننا مطالبات أن نحرص ألا تقع الأجيال القادمة في المطبات ذاتها التي عانينا منها، وأن تصبح بناتنا نساءً مبادرات، وأبناؤنا رجالًا لطفاء وبالغين في الوقت نفسه. ربما علينا أن نسامح بعضنا سلفًا إن لم ننجح في ذلك.
ألاحظ تقدمًا بكل تأكيد، ولا أريد تبادل الأدوار مع أمي. ولكن هل يعني هذا أن حياة الأمهات الجدد أسهل؟