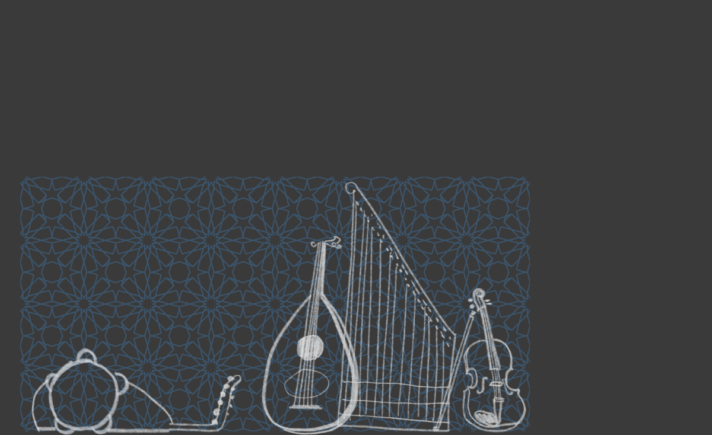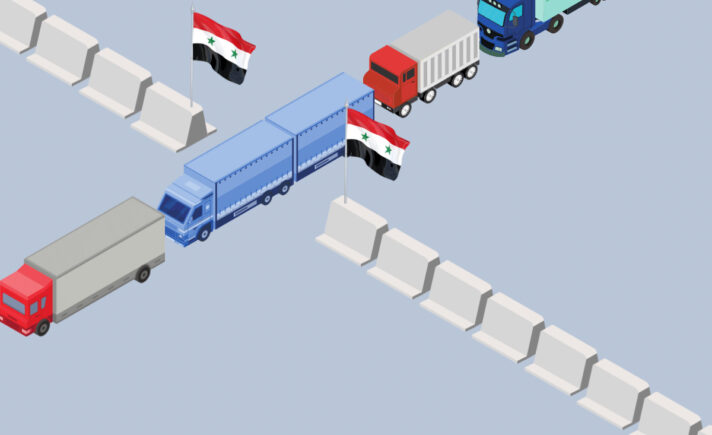وقفتُ أمام الشارع، لم أدخله، وقفتُ شبه مشلول وبيدي كاميرا لم أُشغّلها كما كنتُ قد قررت. كان منظر حارتي المدمرة قد أوقف الزمن ودوران العالم. لم أدخل إليها ولم أشغّل الكاميرا بالطبع، بعد أن كنت صورت بعض مشاهد الدمار والقصف، ثم قرّرتُ أنني لا أريد التصوير بعد الآن.
سبع سنوات كاملة وأنا أحاول كتابة الأسطر السابقة، سبع سنوات تفصل بين هذا اليوم وذاك الذي قررتُ فيه العودة إلى الغوطة طالما كان ذلك ممكناً، سبع سنوات وذلك المشهد كان قد سكن كوابيسي. في الكابوس، أرى أحمد صديقي الذي قتله النظام في معلولا، أرى الحارة، وصالون بيتنا مليئاً بالتراب، ليس على مشاهد متقطعة بل دفعة واحدة في مكان واحد.
قد لا يكون ذلك أقسى مشهد يمكن رؤيته في سوريا اليوم، قد يكون نكتة الآن ربما، لكن كما في كل الأشياء، هناك أول مرة، أول صدمة، وتلك هي التي تحفر عميقاً، إذ تبدو لي الآن أقسى من لحظة هروبي من البرميل الذي رمته المروحية على سراقب.
هل من المهم كتابة تلك السطور؟ في كل مرة أحاول كتابتها تعود التروما ذاتها؛ شللٌ كامل ورغبةٌ شديدة بالخروج من مكاني الذي أنا فيه. لم يكن السؤال بالنسبة لي عن الشجاعة اللازمة لاستعادة تلك اللحظة، ولم تكن تلك اللحظات في الحقيقة سبباً في أي أثر نفسي غير محتمل، لا أحتاج للتخلص منها كي أتابع حياتي، لا أحتاج تذكرها على كرسي مُحلل نفسي. كنت أعرف دوماً أنها بداية مهمة لقصتي أنا، لكن هل يجب أن أكتب تلك القصة.
خلال عملي كصحفي، كان هناك سؤال شديد الإلحاح دوماً عندما أطلب من الناس رواية قصصهم؛ هل أتسبّبُ بألم جديد؟ ما هو المهم وما هو غير المهم؟ وكيف أتجنب أن أتسبب بمزيد من الصدمات الناتجة عن التذكر؟ التعامل مع الأحداث الصادمة ليس أمراً بسيطاً، كما أنك لا تعلم متى تتسبب دون قصد باستعادة ذكريات قد تكون مدفونة. سألتُ عند إعدادي ريبورتاجاً عن الخبز السوري في تركيا رجلاً مهجراً من ريف دمشق عن رأيه بالخبز السوري في مدينة غازي عنتاب، فاكتشفتُ لاحقاً أنّ الرجل فقد ولده أمام فرن الخبز بعد أن قصفت طائرات النظام فرناً للخبز، وقتلت المنتظرين أمام بابه.
لا يمكننا التوقف عن التذكر أو رواية ما يجري، سيكون نفاقاً أن أقول أنا هذا، وفي نص أكتبه في الجمهورية مناقشاً التذكر ورواية حكايتنا، لكن ما هي الحدود الفاصلة التي يمكن أن نرسمها؟
لا يوجد جواب نهائي، لكن هناك ما يمكن فعله. لنبدأ بالبسيط، بحادثة مذيعة قناة الدنيا ميشلين عازار التي استنطقت ضحايا مجزرة داريا وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة، في مشهد مروع. لا يمكننا استنطاق الضحايا وهم في حالة الصدمة، وبالتأكيد لا يمكننا استنطاق أهالي القتلى والجرحى. بالطبع ستكون تلك جريمة، مشهد تلك المذيعة التي اقتحمت شوارع داريا وأهلها مرميين على جوانب الطرقات، كان موتاً مروعاً أمام عدسة كاميرا القاتل. لا يمكن لبشري أن يرتكب مثل هذا، تقول لنفسك، للأسف هذا المثال يكذبك، لكن الأصعب أنّ مثل هذه الحادثة قد تكررت لا على يد القتلة، بل على يد صحفيين سوريين يريدون ببساطة توثيق انتهاكات النظام. رأيتُ كثيراً من التسجيلات لآباء وأمهات يحملون أبناءهم القتلى، يريد الصحفي أن يوثق الحادثة، الأمر جدلي، أعلم، لكن في بعض تلك الحالات كان الصحفي يتوجه بأسئلة لهؤلاء الأهل مباشرة؛ هنا تصبح جريمة.

ضمن موجة التصعيد العسكري الأخيرة وحملة القصف الوحشية على إدلب، كان السماح التركي للقنوات الدولية بالدخول إلى إدلب قد أدى إلى دخول عدد كبير من الصحفيين الشجعان حقيقةً، لتغطية ما يجري في المنطقة التي تشهد واحدة من أكبر كوارث العصر. ضمن هذا السياق، سيكون من المحتمل جداً أن تلتقي بصحفيي سي إن إن وواشنطن بوست في الطريق، في مدينة إدلب أو قرب المخيمات الحدودية. أحد الأصدقاء من إدلب روى لي أنّ فريق تصوير، يتبع قناة دولية، ضغطَ بشدة على أحد ضحايا النزوح والقصف، للتصوير معه، وساهم سوريون آخرون بالضغط عليه، ووجهوا له إهانات مباشرة من نوع «أنت شبيح شي؟ ليه خايف تصور». موقف ليس هو الأول بالتأكيد، الإكراه على التذكر أو رواية ما جرى في أي حال، والضغط على الضحايا أو إيهامهم أو الكذب عليهم لقول ما جرى، ليس مقبولاً على الإطلاق أيضاً.
ليس الكلام السابق دعوة للصمت بالتأكيد، هو بالعكس، دعوة للكتابة ومساعدة الضحايا على رواية ما جرى، لكن ليس بأي ثمن. اليوم، ونحن نواجه نتائج سحق النظام التام للثورة في سوريا، نحتاج صوتنا الخاص، ونحتاج أن نقول ما جرى، لأن نسيانه يعني نسيان كل الشهداء والمعتقلين الذين مازالوا في الأقبية الأمنية، لكن ليس بأي ثمن، إذ ليس الضحايا أدوات مجردة من الإنسانية لتكرار رواية القصص الحزينة في أنشطة المناصرة أو صفحات المقالات والكتب التي تريد تدوين الجريمة. لا يمكننا محاربة الانتهاكات بانتهاك جديد.
وأمام الحاجة الشديدة لتدوين كل التفاصيل العامة والشخصية، التي تُكوّنُ جميعها الرواية الكاملة للسنوات الماضية منذ 2011، فإن القدرة على مساعدة الراغبين والمستعدين نفسياً لرواية قصصهم وشهاداتهم، هي المهمة الرئيسية، ولكن ليس استنطاقهم. كانت قضية المعتقل السابق مازن الحمادة شديدة التأثير، لا أملك أي تفاصيل دقيقة ولا يمكنني بالطبع الاعتماد على الشائعات والروايات التي انتشرت باعتبارها دلائل ثابتة، لكن وضع الرجل النفسي كان حسب أغلبها غير متزن، فقد عانى حسب الروايات من ذهان. وليست الدعوات التي قُدِّمَت لمازن ليروي حكايته هي التي أصابته بذلك، على افتراض دقة الروايات تلك، وفي الحقيقة قد لا يكون هناك أي سبب واضح للذهان، إذ ليست الصدمات النفسية لوحدها سبباً في تطور الذهان أو الأعراض الفصامية، لكن هل كان الذين قدموا تلك الدعوات على دارية بوضعه النفسي، إذ ليست معرفة أعراض الذهان أمراً شديد الصعوبة. تحتاج القصة إلى كثيرٍ من التفاصيل الإضافية بالطبع لكي نعتبرها مثالاً. لكن باعتبار وجود تلك الظروف فعلاً كيف يمكن أن تطلب من مريض الذهان، أو يعاني من مشاكل نفسية ربما تفقده أهلية الاختيار، أن يروي ما جرى؟ في الحقيقة يجب أن لا نطلب منه ذلك أبداً، الشخص الوحيد المؤهل هنا هو الطبيب والمعالج النفسي.
الذي يجري ليس مجرد مجموعة من المحاولات حسنة النية لدفع الناس إلى رواية فظائع النظام في سوريا، لقد تطورت خلال السنوات الماضية بنية شبه منظمة لتوثيق وتدوين تلك الفظائع، وطوّرت تلك البنية آلياتها الخاصة لتصدير الصورة حول ما جرى في سوريا، وهو عمل دفع الناس أرواحهم في سبيله، لكن تلك الآليات المنظمة الحقوقية والصحفية، التي تعتمد مقارباتها الخاصة كلّ على حدة لرواية ما جرى، ارتكبت وما تزال ترتكب تلك الأخطاء. بالطبع يجب أن يحكي المعتقلون وأهاليهم عن تلك الفظائع التي عانوها، وهي أشياء لا يمكن أن تتخيل أنها تحدث، أو أنها حدثت فقط في الذاكرة السوداء للعالم في أوشفيتز، في الهولوكست.
لكن مرة أخرى، ليس بأي ثمن، ليس بدفع ضحايا يعانون من عدم الإتزان النفسي للحديث، واستعادة صدماتهم خارج المساحات الآمنة التي قد يوفرها العلاج النفسي، أمام غرباء يرونهم للمرة الأولى ولن يروهم مرة أخرى. سيحكون تفاصيل شديدة الفظاعة عن ما واجهوه، ألا يجب أن يمتلكوا قبل ذلك حرية الاختيار والقدرة على الموافقة بكامل إرادتهم الواعية على ذلك. يبدو أن الطلب المنتظم على الرواية الذي أنتجته برامج التمويل الحقوقية، وحاجة وسائل الإعلام العالمية لقصص إنسانية من الحرب، أي حرب، قد دفعت إلى تشكيل مساحات غير آمنة للضحايا خلال كل ذلك. من عذّبته المخابرات بأبشع الصور، يحق له الصمت ويحق له النسيان، ليس مجبراً على الحديث، وبالطبع لا يجب دفعه والضغط عليه ليقول حكايته.
كما نمتلك الحق في الكلام، الحق في رواية ما جرى لنا، فإننا نمتلك حق الصمت، حقّ أن لا نمتلك الشجاعة في استعادة الفظاعة التي واجهناها. ما الذي يضمن لمن لا يريد الحديث أنّ استعادته المؤلمة لتلك الفظائع ستفعل شيئاً؟ في رواية وزارة الألم، التي تمت ترجمتها إلى العربية بعنوان موطن الألم، للروائية الكرواتية (لعلها تفضل اليوغسلافية) دوبرافكا أوجاريسك، تقول: «كم هو مؤلم البطء الشديد للعدالة»، تتسائل عن معنى أن يُحاسَبَ مجرمون بعد أن يكون ضحاياهم، الذين بقوا أحياء بعد تلك الجرائم، قد رحلوا قبل تحقق تلك العدالة. في الحقيقة، العدالة التي ينصرها تدوين ما جرى هي ذاتها تلك العدالة البطيئة؛ من حق أولئك الذين نطلب روايتهم أن يتساءلوا عن المغزى.
ليس هناك شخص واعٍ وحسن النية يريد أن يصبح مثل ميشلين عازار مذيعة قناة الدنيا، التي شاركت في جريمة داريا. لا أقول أن أحداً سيصل إلى هناك، لكن يبدو أن هناك هوامش رمادية في ما نفعله لرواية ما جرى، قد تودي بنا إلى أمكنة بالغة السوء. استنطاقُ الموت قد يكون جريمة، واضحة مثل جريمة ميشلين أو غير واضحة كما حدث في كثير من المرات. يجب أن نقول ونروي ونواجه الفظيع ونبقيه حيّاً، لكن ليس بأي ثمن.