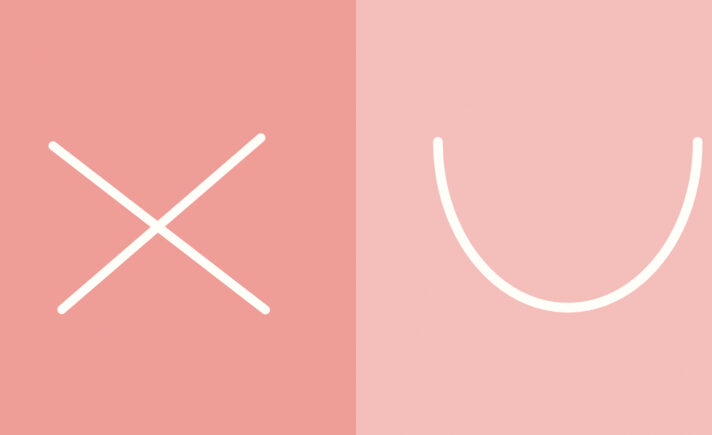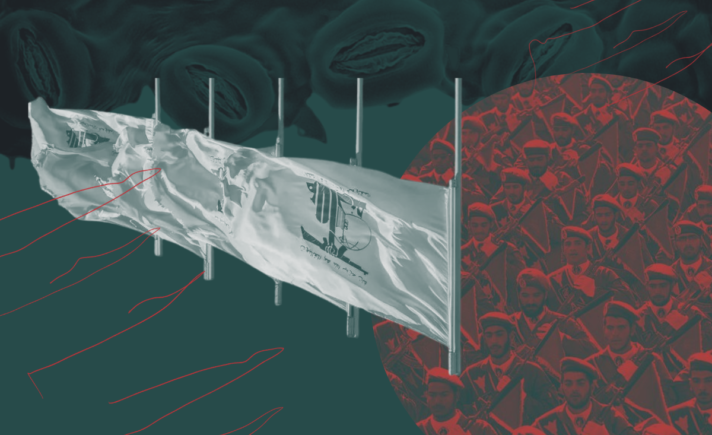زهدتْ نفسي وراعتْ نقص أكلٍ وشرابٍ وطعامْ
فطعامٌ قلّ يوماً بعد يومٍ وبعيداً عن دجاجٍ ونعامْ
رُقِّيت نفسي وشاءت اعتزال عن أناسٍ وصحابٍ هم نيامْ
ومعيشٍ في رفاهٍ وديار فأردت العيش دوماً في خيامْ
الشاعر مقتدى الصدر
في الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، دعا الزعيم الديني والسياسي العراقي مقتدى الصدر أنصاره إلى الانسحاب من ساحات التظاهر، التي يطالب المتظاهرون فيها برحيل الطبقة السياسية التي تحكم البلاد منذ أكثر من 16 عاماً. ولم يكتفِ بذلك، بل وجه الأوامر إلى ميليشيا القبعات الزرق التابعة له بمساندة قوى الأمن والجيش العراقي وباقي الميليشيات غير الحكومية في عمليات التصدّي للمتظاهرين، بهدف فضّ الاعتصامات، وإنهاء الحراك الثوري السلمي الذي تشهده مدن وسط وجنوب العراق منذ بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2019.
وقد جاء قرار الصدر الأخير غداة مظاهرةٍ ضمّت بعض أنصاره والمقاتلين التابعين له، ومقاتلين في ميليشياتٍ شيعية أخرى، تحت مسمّى «ثورة العشرين الثانية»، للمطالبة بخروج القوات الأميركية من العراق، وهو الأمر الذي عدّه المتظاهرون انقلاباً من مقتدى الصدر على حراكهم، ومحاولة لإعادة ترتيب المشهد الميليشيوي الذي يحكم العراق، على أساس المكاسب الشخصية التي حصل عليها مقتدى بعد التقارب مع باقي الميليشيات المدعومة إيرانياً، لا سيما بعد دعوة طهران للتوحّد في مواجهة الولايات المتحدة ووجودها في المنطقة، وذلك بعد عملية الاغتيال التي طالت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ومعه الزعيم في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.
ولكن هل هي المرة الأولى التي ينقلب فيها مزاج مقتدى الصدر وتتغير قناعاته؟ هل كان دعمه للمتظاهرين مرحلياً تمليه الحنكة السياسية والزئبقية التي تعوّد عليها الصدر خلال السنوات الماضية، من أجل التخلّص من الخصوم وتحصيل أكبر قدرٍ من المغانم السياسية؟ هل أراد إيصال رسالةٍ لحلفائه وخصومه من الأحزاب العراقية والدول الداعمة لهم، وبشكلٍ أساسي إيران، تقول إنّه الرقم الأصعب في المعادلة العراقية، وإنه لا يمكن أن تسير البلاد إلا بالطريقة التي تضمن مصالحه؟ وهل انطلت براغماتية مقتدى على المتظاهرين، الذين أملوا أن يشكّل حضور أتباعه في ساحات التظاهر نوعاً من الحماية الأمنية من الميليشيات الأخرى أو من القوات الحكومية؟
لم يتكوّن وعي مقتدى الصدر السياسي في أروقة الأحزاب أو التجمعات السياسية، فقد كان شابّاً في مطلع الثلاثين إبان الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وكان هذا التاريخ حدثاً بارزاً سيغيّر حياة سليل عائلة الصدر ذات المكانة الدينية المرموقة بين شيعة العراق. ولم يكن مقتدى حينها محمولاً فقط على إرث العائلة الديني ، بل السياسي أيضاً، فجدّه محمد حسن الصدر كان رئيساً لوزراء العراق في العام 1948، كما يُضاف إلى إرث مقتدى ثاراته وثارات شطرٍ كبيرٍ من المؤمنين بتيّار آبائه الذين قُتلوا على يد نظام صدام حسين، إذ أنّ والده محمد محمد صادق الصدر صحبة اثنين من إخوة مقتدى قُتلوا عام 1999 على يد النظام العراقي السابق، ما أدى إلى اضطراباتٍ وأعمال عنفٍ حملت اسم انتفاضة الصدر، وظلّت مستمرةً لأيام، إلى حين تمكّن أحد فيالق الجيش العراقي من السيطرة عليها وإخمادها. وقد سبق ذلك بعقدين إعدامُ عمه محمد باقر الصدر رفقة شقيقته نور الهدى في العام 1980، وباقر الصدر هو مفكّر إسلامي معروف ومؤسّسُ حزب الدعوة الإسلامية.
وإذا بات الشاب مقتدى الصدر محطّ أنظار العراقيين بعد سقوط نظام صدام حسين، فذاك ليس فقط لأنه قد صار منوطاً به إعادة الحياة إلى التيار الصدري بعد أن أنهى البعثيون وجوده تقريباً، بل كذلك لأنه قرّر، بخلاف معارضي صدام الآخرين، تأسيس ميليشيا جيش المهدي بهدف طرد القوات الأميركية الغازية، وذلك بدلاً من المشاركة في الحياة السياسية التي رعاها الأميركيون في البلاد. غير أنّ اللحظة التي نقلت اسم مقتدى من المحلية إلى العالمية، كانت لحظة تكرار اسمه ثلاث مرّاتٍ أثناء عملية إعدام صدام حسين، في رسالةٍ واضحةٍ من أتباعه الذين حضروا تنفيذ الحكم، بأنّها لحظة الثأر التي طال انتظارها.
توارى مقتدى الصدر عن الأنظار إبّان صراعه مع الأميركيين، بينما ظلّت ميليشياته تتوالد من بعضها تحت مسمياتٍ عديدة، وتقلق راحة القوات المحتلّة وتحشد حولها تأييد أوساطٍ عراقيةٍ كانت تعارض الغزو الأميركي أو تعارض سلطة هيئة الحكم الانتقالي التي عينها الأميركيون. وفي شباط (فبراير) عام 2008، أعلن مقتدى وقف العمليات العسكرية التي يشنها جيش المهدي وباقي ميليشياته ضدّ الأميركيين، مُخلياً مسؤوليته من الأعمال التي ربّما ينفّذها جماعاتٌ وأشخاصٌ «غير منضبطين» كانوا جزءاً من قواته، في حين ظلّت تلاحق مقتدى اتهاماتٌ بأعمال تفجير وتصفية وإرهاب تطال مواطنين عراقيين سُنّة وشيعة، في إطار الصراع الطائفي الدموي الذي شهده العراق بين عامي 2006 و2008.
وقد شهدت ذات الفترة بداية نزاعٍ مسلّحٍ بين جيش المهدي وقواتٍ حكومية وميليشيويّة تدين بالولاء لرئيس الحكومة العراقية الأسبق نوري المالكي، الذي كان يريد اجتثاث ميليشيات الصدر، وعلى رأسها جيش المهدي. وقد انتهى الاقتتال بانتقال مقتدى الصدر إلى قمّ الإيرانية مطلع العام 2007 «متفرغاً لطلب العلم»، وقبوله بتقديم الدعم السياسي لنوري المالكي الذي كان يتزعّم حزب الدعوة المنبثق أصلاً من رحم الصدرية السياسية، وذلك قبل أن يتحول عنها إلى الخمينية بحكم المُقام الطويل في إيران والرعاية والتمويل الإيرانيين.
لكنّ انقطاع مقتدى عن السياسة لم يدم طويلاً، فسرعان ما عاد إلى المشهد السياسي في العام 2011، منقلباً على نوري المالكي باعتباره فاسداً، وحاجزاً لنفسه موقعاً في المعارضة العراقية رغم وجود عددٍ من أتباعه في حكومة المالكي. وفي العام 2014، أعلن مقتدى الصدر تشكيل سرايا السلام لقتال داعش، وانخرط مقاتلوه في العمليات العسكرية التي قادها الحشد الشعبي المُشكّل بموجب فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الديني علي السيستاني.
ولأنّ علاقة الصدر بالمالكي ظلّت متوترةً، فقد أيّد في سبتمبر (أيلول) من العام 2014، وبعد الانتخابات البرلمانية العراقية، وصول شخصيّةٍ سياسيّةٍ غير المالكي من حزب الدعوة لرئاسة الحكومة، وهو ما أدّى بالفعل إلى وصول حيدر العبادي بديلاً عنه، بينما ظلّ مقتدى الصدر محتفظاً لنفسه بصفة المعارض الدائم للحكومة، ومجدداً بالرغم من حضور عددٍ من الوزراء المحسوبين على تياره أو المقربين منه في حكومة العبادي أسوةً بباقي الحكومات المتعاقبة التي شكّلها نوري المالكي.
أما في الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2018، فقد استفاد مقتدى الصدر من عجز الحكومات العراقية عن النهوض بالبلاد وتحسين المستويات المعيشية في ترسيخ قاعدته الشعبية بين فقراء الشيعة، وراح يستخدم خطاباً مرناً تجاه سُنّة البلاد، داعياً إلى الوحدة الوطنية وتجاوز الانقسامات الطائفية.
وقد ترافق ذلك، تحديداً في العام 2017، مع تحوّلٍ بارزٍ في مسار مقتدى السياسي، فقد قرّر توسيع علاقاته العربية، متخذاً خطاً سياسياً جديداً رافضاً للهيمنة الإيرانية على الشيعية السياسية في العراق، وقد تمخّضت عن هذا التوجه الجديد زياراتٌ إلى كلٍّ من السعودية والإمارات، كما دعا حينها بشار الأسد إلى التنحي، رافضاً قتال الميليشيات الشيعية العراقية إلى جانب قواته، وذلك بالرغم من أنّ كثيراً من تلك الميليشيات كانت قد تناسلت من الميليشيات التي أسسها مقتدى بنفسه. واللافت أنه سبق لبشار الأسد، في شهر أيار(مايو) من العام 2012، أن منح مقتدى الصدر وسام الجمهورية في محاولةٍ مبكرةٍ منه لخطب ودّ الصدر إزاء التهديدات المتصاعدة التي باتت تواجهه عسكرياً بعد صعود المعارضة السورية المسلحة وسيطرتها على مساحات من البلاد.
ولاحقاً، تُوّج الخط السياسي الجديد لمقتدى بتحالفٍ بدا غريباً للمراقبين في الانتخابات البرلمانية العراقية عام 2018، إذ تحالف مع الحزب الشيوعي العراقي لخوض الانتخابات النيابية، ليحصد تحالفه «سائرون» أربعاً وخمسين مقعداً في البرلمان. وقرّر مقتدى حينها التخلي عن حيدر العبادي الذي دعمه في مواجهة نوري المالكي، والانتقال لدعمٍ مرشّحٍ جديد هو عادل عبد المهدي، وتمكّن من إيصاله إلى رئاسة الحكومة والاحتفاظ مرة ثالثة بموقعه كمعارضٍ قوي، مُشدّداً على رغبته بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة في العراق «شلع قلع»، وهو الشعار الذي ستتبناه لاحقاً التظاهرات التي ستشهدها مدن وسط وجنوب العراق في العام 2019.
أما علاقة مقتدى مع إيران، فقد ظلّت متقلبةً على الدوام، فحيناً يعتزل مقتدى العمل السياسي ويذهب إلى قم لينقطع فيها عن العالم، وحيناً ينتقد الميليشيات التي تدعمها طهران في العراق، ويصف عصائب أهل الحق التي يتزعمها قيس الخزعلي بالميليشيات الوقحة، ويقرّر التقارب مع خصوم إيران الخليجيين متبنياً خطاً شيعياً عروبياً مستقلاً عن طهران، بسلاسةٍ لا تختلف عن تلك التي تحالف فيها عام 2014 مع ميليشيات تمولها إيران في إطار الحرب على داعش.
مؤخّراً، وبعد اغتيال سليماني والمهندس، افتتح الصدر طوراً جديداً في العلاقة مع طهران، بدأه بصلحٍ مع قيس الخزعلي برعاية إيران الساعية لتوحيد الجبهة الشيعية العراقية في وجه الحضور الأميركي، وما هي إلا أيامٌ قليلة حتى انقلب مقتدى على المتظاهرين الذين ساندهم ودعا أنصاره للتظاهر معهم، ليقرّر الوقوف في وجه المتظاهرين، وتوجيه الأوامر لأحدث ميليشياته، القبعات الزرق، بمساندة رجال الأمن والجيش في عمليات فض الاعتصامات. وبالفعل، انتشر عددٌ من المقاطع المصور التي توثّق هجوم هذه الميليشيا على المتظاهرين السلميين في عددٍ من ساحات التظاهر، بينما توجهت جهود مقتدى نحو دعم رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي، ومطالبة الأميركيين بالخروج الكامل من العراق.
لا يثبت مقتدى الصدر على موقفٍ واحد، فهو شديد التقلب، ويبدو أنّ هذا التقلب لا يندرج دوماً تحت البراغماتية المبنية على استراتيجياتٍ سياسيةٍ مدروسة، بل قد يأتي مدفوعاً بأهواء رجل الدين المتقلبة وميوعته الذهنية والسياسية التي تجعله يفعل الشيء وضدّه خلال فترةٍ قصيرة، ففي الرجل شيءٌ من القذّافيّة في التعاطي مع السياسة والأصدقاء والخصوم.
ومهما كانت أسباب مقتدى في خياراته السياسية، فإنّ الرداءة غالبةٌ عليها، ويبدو أنّ حجم ابتذاله في السياسة لا يقلّ عن رداءته في ابتذال الشعر والخواطر. وإنْ كان العراقيون والعراقيات قد قرّروا النزول إلى الشوارع للمطالبة باستعادة البلاد من أيدي الميليشيات وقادتها، فإنهم لن يخرجوا من شوارعهم وساحاتهم بمجرّد انسحاب طرف ميليشيويٍّ حاول الالتصاق بثورتهم، التي لا تزال مستمرة، ويطالب شبابها وشابّاتها بأن يُزال هو وأمثاله من فوق صدورهم.