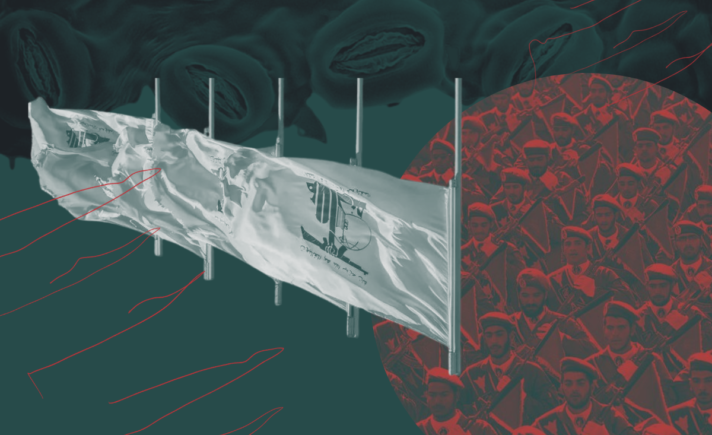لا يمكن لدولةٍ تشهد ظروفاً مشابهةً لما يحصل في سوريا منذ ثمانية أعوام، أن تحافظ على اقتصادٍ جيدٍ كذلك الذي يدأب النظام السوري وإعلامه على الحديث عنه، بهدف إنكار التدهور الاقتصادي الواضح للعيان. وإزاء حالة الإنكار هذه، يجدر السؤال عن دور المؤسسات الحكومية التي من شأنها التعامل مع هذا التدهور، ويقع على عاتقها وضع الخطط والبرامج الهادفة لتخفيف الضرر الاقتصادي الذي يصيب السكان والدولة.
والموازنات العامة للدولة هي الخرائط التي تبيّن الآليات التي تتصرف من خلالها أي حكومة للتعامل مع الوضع الاقتصادي، وإدارة الأموال والموارد المتوافرة. وفي الحالة السورية اليوم، نجد أن هذه الموارد قد باتت قليلةً جداً، وهو ما يضع الموازنة أمام تحدي تدارك الأزمات والحد من تفاقمها، في ظلّ الانخفاض الشديد في عوائد الصادرات السورية، التي كان يتم من خلالها تمويل قسم مهم من الموازنة العامة، فضلاً عن كون هذه العائدات هي الأداة الأهم في تأمين القطع الأجنبي. وهنا تنبغي الإشارة إلى أنّ سوريا صارت تستورد مواداً كانت مُصدّرةً لها منذ عقود؛ كالقمح والغاز والنفط والصناعات الغذائية وقائمةٍ طويلة من المواد، نتيجة خروج كتلةٍ وازنةٍ من حوامل الاقتصاد السوري الأساسية عن الخدمة بفعل العقوبات، أو نتيجة تدميرها أو خضوعها لقوى أجنبية ومحلية غير النظام السوري، تحديداً في شرق سوريا وشماليّها الشرقي.
ويضاف إلى ذلك خروج عددٍ كبيرٍ من الكفاءات السورية والقوى العاملة إلى خارج البلاد، أو نزوحها في الداخل، وبالتالي خروجها من الدورة الاقتصادية. هذه الأسباب، فضلاً عن أسباب كثيرة أخرى، تفسّر الارتفاع الشديد في معدلات الفقر والبطالة وتدهور المستوى المعيشي في البلاد، ولكن ينبغي أيضاً عدم إغفال دور الإجراءات والتصرفات والخطط الحكومية التي زادت أوضاع الدولة والناس بؤساً، من خلال انتهاجها عدم العدالة في توزيع الثروات وعدم العدالة في توزيع الدخول بين رأس المال والعمل.
إذن، لا يمكن تحميل كل المشاكل الاقتصادية على الحرب التي تشهدها البلاد كما يدّعي النظام، بل يعود قسمٌ من تلك المشاكل إلى الآليات وطرق الإدارة المالية التي اتّبعها النظام، وأقرّتها مؤسساته التشريعية والتنفيذية، ويمكن قراءة هذا كله بوضوح في الموازنات المتلاحقة التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة، فهي لا تراعي أبداً احتياجات السوريين العاديين، بل تستغلهم في سبيل جعل النظام متماسكاً اقتصادياً بعض الشيء من جيوبهم.
توضح الموازنات المُتلاحقة أنّ الدولة الأسدية لم تعد توظّف أموالاً في الاستثمار، بل فتحت المجال واسعاً أمام رؤوس القطاع الخاص الكبار من محاسيب آل الأسد، ليأخذوا مكان الدولة ويسيطروا على الفرص الاستثمارية في البلاد. ويمكن أيضاً أن نرى من خلال مطالعة الموازنات المتلاحقة أنّ واحدةً من آليات تمويل العجز تعتمد بشكل مضطرد على تخفيض الدعم أو حجبه عن العديد من السلع والخدمات، طبعاً دون أن يترافق ذلك مع تحسينٍ في مستوى الرواتب والأجور يتناسب مع تقليل الدعم، وذلك رغم الزيادة في الأجور والرواتب التي تمّ إقرارها نهاية العام 2019 بعد الهزة التي تعرضت لها الليرة السورية. فهذه الزيادة لم تكن مبنيةً على دراساتٍ واضحة، بل جاءت عشوائيةً وتماشياً مع ظروفٍ لم يستطع النظام السيطرة عليها، وذلك خشية أن تفضي إلى عواقب احتجاجية ينبغي التعامل معها. ونقول إنها عشوائية لأنها لم تكن واردةً في بنود الموازنة، ولم تكن في الحسبان، كما لم يكن ممكناً إقرارها لولا أنّ النظام قد موّلها من خلال طرح كمياتٍ مُضافة من النقد في الأسواق كحلٍّ طارئ، سيعود بآثار سيئة على الاقتصاد السوري مع مرور وقتٍ ليس بالطويل.
ولكون السياسات المالية للنظام عشوائية ولا يمكن الوثوق بها، فإنّ تعويل النظام على زيادة الاستثمار الإيجابي في السوق السورية، سواءً عبر المُستثمر الداخلي أو الخارجي باءت بالفشل، واقتصر الأمر على الاستثمار بالهيمنة والاستيلاء الذي تمارسه روسيا وإيران، فضلاً عن الاستثمار الفاسد الذي تمارسه منذ عقود أوليغارشيا النظام المالية نفسها. الحصيلة هي أنّ سوريا لم تسجّل أي نوعٍ من أنواع الاستثمارات الإيجابية خلال سنوات الثورة، رغم أنّها حاولت جذب المستثمرين من خلال معارض وفرص استثمارية وتسهيلات مالية وضريبية، فقد حالت دون ذلك قلة الثقة بالسياسات المالية للنظام، معطوفةً على عدم الثقة بالوضع السياسي والعسكري المُتغير والمضطرب في البلاد.
وإذا كانت الموازنة العامة للدولة تعبر عن أهداف الدولة وتطلعاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فإنها في الوقت نفسه كشفٌ محاسبيٌّ يبيّن الإيرادات والنفقات المستقبلية ومقدار العجز فيها. ورغم عدم الثقةجميع الأرقام والنسب الواردة في هذا المقال مأخوذة عن ورقة عمل حول «تحليل الحالة الراهنة للمالية العامة في سورية»، نشرها المرصد العمالي للدراسات والبحوث في دمشق مطلع العام 2019، وذلك بالاستناد إلى الأرقام الواردة في الموازنات العامة. بالأرقام التي يعلنها النظام، ولا بالموازنات التي ينشرها ولا نسب التنفيذ التي يتم الإعلان عنها، فإنّ الأرقام المحدودة التي يمكن الحصول عليها من دولة كسوريا تجعلنا مضطرين للتعامل معها كمصدرٍ شبه وحيدٍ للمعلومة.
بقراءة هذه الأرقام، يمكننا ملاحظة انخفاض نسبة كتلة الرواتب والأجور من 34.18% في عام 2011 نسبةً إلى النفقات الجارية، حتى وصلت 17.35% في عام 2019، وهي أدنى نسبةٍ وصلت إليها مخصصات الرواتب والأجور من الإنفاق الجاري على مدى السنوات العشر الأخيرة. كما أن النصيب الأكبر من الإنفاق، في موازنة العام 2019، جاء متمثّلاً في مخصصات مساهمة الدولة في تثبيت الأسعار من خلال دعمها، وذلك بنسبة 29.15% من إجمالي النفقات الجارية؛ ولكن هل استفاد المواطن فعلياً من هذا الدعم؟ بتحليل الأرقام الواردة في موازنات السنوات الأخيرة، نجد أن تغطية أكثر من 90% من الدعم الاجتماعي قد جاءت من خلال ارتفاع الأسعار في العام 2014، وقد ارتفع هذا الرقم في العام 2019 حتى صار تمويل 95.5% من الدعم الاجتماعي يأتي من فروقات الأسعار، التي يدفعها السوريون لمؤسسات النظام التي تبيع المحروقات وغيرها من السلع.
وبذلك يتّضح عدم وجود دعم فعلي للناس تؤديه الحكومة، وهو عكس ما تدعيه على أرض الواقع. بل يلمس السوريون في معاشهم اليومي عدم وجود أي اهتمام حكومي في تحسين مستوى المعيشة، وأن حكومة النظام تعتمد في تمويل إنفاقها العام على رفع المستوى العام للأسعار، بحيث تكون أي زيادة في الرواتب لا قيمة لها، ولا تأتي زيادة الرواتب إلا لسدّ جزءٍ صغيرٍ من الفجوة بين معدلات الأسعار ومستوى الأجور، وهو الأمر الذي ما فتئ يتعمّق مع مرور الوقت.
وبالنظر إلى أهم مصادر الإيرادات العامة التي تمّ اعتمادها في موازنة النظام عام 2019، نجد أن 27.58% منها يمثّل فائض الموازنة وفائض السيولة، و44.4% هي إيرادات الخزينة العامة من ارتفاع أسعار الإسمنت والمازوت والبنزين والفيول التي تباع محلياً، و10.87% هي ضرائب ورسوم غير مباشرة. أما الضرائب المباشرة، فلم تتجاوز 5.37% من إجمالي الموارد العامة، في حين يبلغ حقّ الدولة من شركات النفط وحدها 4.74%.
يمكننا أيضاً أن نلاحظ أنّ 55.29% من إجمالي الموارد العامة يتم تمويلها من خلال القطاع العام، وهي عبارة عن ضرائب القطاع العام وبدلات الخدمات وأملاك الدولة وإيرادات مختلفة فضلاً عن الفائض المتاح، يليها التمويل من خلال الأفراد بنسبة 42.15%، وهي عبارة عن ضرائب على الرواتب والأجور وضرائب ورسوم غير مباشرة، كما يضاف إليها إيرادات الفروقات السعرية. أما قطاع الأعمال فلا يسهم بأكثر من 2.55% من الموارد العامة، وهذه النسبة تتمثل في الضرائب والدخل المقطوع.
نستخلص من الأرقام أعلاه ثلاث خلاصات رئيسية؛ الأولى أن نحو نصف إيرادات الخزينة يأتي من رفع أسعار المواد التي تبيعها الدولة للسوريين، والثانية أن نسبة مساهمة رؤوس الأموال الخاصة في إيرادات الخزينة منخفضة جداً، أقل من 3%، وأقل بكثير من مساهمة الضرائب التي تقتطع من رواتب موظفي القطاع العام. أما الخلاصة الثالثة، فهي استقالة الدولة تماماً من التدخل الإيجابي في مستوى معيشة عموم السكان.
لقد اتسعت المساحات التي يسيطر عليها النظام في سوريا، وبالتالي تتواصل نفقاته بالازدياد، في الوقت الذي لا تزال فيه المناطق الغنية اقتصادياً في شرق البلاد خارج قبضته، ولا يبدو أنها ستعود إليه قريباً في ظلّ سياسة أميركية جديدة تريد الاحتفاظ بها والاستيلاء على مواردها كما صرّح ترامب. وكذلك تبقى العقوبات الغربية مستمرّةً ومرشّحةً للازدياد، ما سيعطّل أي نشاطٍ اقتصاديٍّ واستثماريٍّ ممكنٍ في المدى المنظور. لا يمكن تجاوز هذه العقبات بالمجازر وبالبراميل، ولعلّها المعركة الأبرز التي سيخوضها النظام لسنواتٍ طوال، وذلك إذا ما قُدّر لدولة الأبد أن تبقى مستمرة.