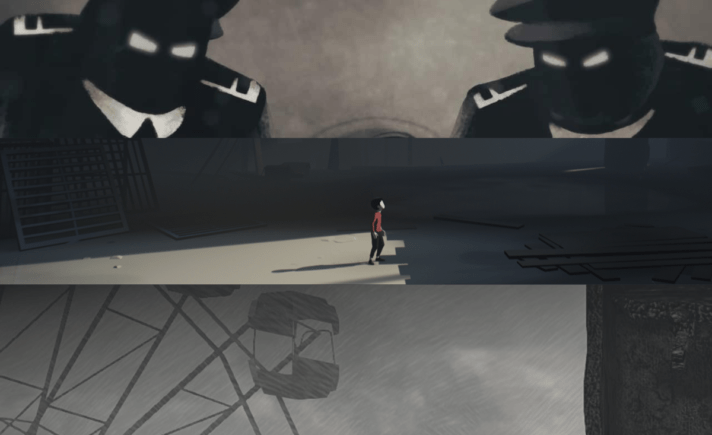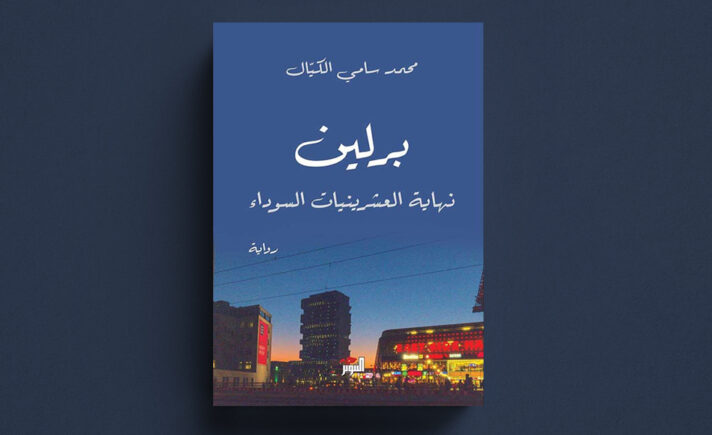في كل عام قبل عيد الميلاد، كانت جدتي لوسي تصنع البسكويت المُسمّى برديل في الألزاسية، لهجتها الأم. لم يكن هذا مجرد تقليد، كان قاعدة لا استثناءَ لها بالنسبة لجدتي: لا ميلاد بدون برديل. لا أتذكر أي لحظة لم تكن جدتي تفعل فيها شيئاً ما.
كانت تعيش لوحدها في بيت كبير صاخب بالحياة على الدوام. كان بإمكانك سماع أصوات الراديو أو التلفزيون الصادرة منه من الشارع: كانت تستمع لأخبار العالم، أو المناظرات السياسية طيلة الليل والنهار. كانت طاهية مذهلة، لا يخلو بيتها من الكيك والأطباق الألزاسية التقليدية والحلويات والشوكولا.
كانت تعتني بأحفادها، وبيتها، وحديقتها، وحيواناتها. كنا نزورها لنقضي يوماً في باريس، وكانت تتحول، لأجل هذه المناسبة، إلى سيدة باريسية مثالية: نظارات شمسية، كعب عالٍ، عطر، مساحيق تجميل، وحقيبة حمراء أنيقة للغاية. كانت تقول لي: «صغيرتي، لم أعتد الجلوس في حياتي. ولن أفعل هذا اليوم». كانت جدتي الشخص الوحيد القادر على قطع الأخشاب، والزراعة، وجز العشب، ودهن الجدران، وإصلاح التسريبات، والطبخ لكل العائلة، والظهور بالمظهر المثالي، بعد كل ذلك، لدى مغادرة المنزل.
بلغت لوسي اليوم 91 عاماً. ولم تعد أصوات الراديو والتلفزيون، وأصوات ضحكاتنا، ورائحة الكيك، تملأ منزلها، فقد أصيبت بالزهايمر قبل سنوات، ولم يعد باستطاعتها العيش لوحدها. وتفقد، تدريجياً، قوتها وقدرتها على الإحساس بالواقع، وتنسى الأسماء والتواريخ، وكل الأشياء التي تربطها بحياتنا اليومية.
أزورها كلما عدتُ إلى فرنسا. هي ما زالت تتذكرني، إلا أنها تنسى أين أعيش وماذا أعمل، ما يعني أننا نكرر المحادثة ذاتها، وأخبرها مجدداً في كل مرة عن العمل والحب والحياة. وتفاجئني، ونحن نتحدث، بعد أن تستدير إليّ، بالسؤال حول ما إذا كانت الحرب قد انتهت، وكأنها تغادر الحاضر كلياً، بشكل مفاجئ، لتعود إلى صباها، وذكرياتها عن الحرب العالمية الثانية.
الزهايمر هو مرض عصبي نفسي، يُدمّر بعض أنظمة الذاكرة، فيما تبقى أجزاء منها محفوظة لوقت طويل. يؤدي هذا تدريجياً إلى تغيّر المريض، الذي يصبح شخصاً آخر لدى المقربين. حيث تطفو ذكرياتٌ منسية على السطح. وإذا تأثرت الذكريات الحديثة والشخصية بالمرض، يُلاحظ أحياناً أن الأحداث الحاسمة من الطفولة والصدمات تغزو الأجزاء التي لم يتأثر بها دماغ المريض.
قرأت أن الزهايمر في الصين لا يُعتبر مرضاً. ففي حين ترى الثقافة الغربية مفهوم الزمن من منظور خطّي -الولادة، فالحياة، فالموت- يرى النهج الصيني أن الحياة دائرية، فلا يكون الماضي منفصلاً عن الحاضر. لذلك، كلما تقدم الإنسان في العمر، أصبح أقرب إلى مرحلة طفولة جديدة مُحتملة. الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الذاكرة الحديثة أو العاجلة ليسوا مرضى: إنهم ببساطة يعودون إلى الطفولة، حيث سيبدؤون حياة جديدة.
كنا نسمع جدتي تتحدث عن الحرب على الدوام. إذ أخبرتنا بحكايات وأسماء وأحداث من تلك المرحلة في حياتها وفق ما أتذكر. ويبدو مذهلاً لي كيف شكَّلَت الحرب العالمية الثانية عالمنا المعاصر، بقدر ما أثَّرَت في حياة جدتي.
وُلدت لوسي عام 1928 في فينغن، القرية الصغير في منطقة الألزاس الفرنسية. للوصول إلى هذه القرية، عليك صعود الطريق الوحيد، المتعرج عبر البساتين. تتكون فينغن من عدة شوارع فقط، تصطف على جانبيها البيوت الخشبية الملونة والنوافير. وثمة غابة في الأعلى، تنتصب، كأنها تحرس القرية. إذا مشيتَ على طول السكة، ستنتهي إلى الحدود الألمانية، الواقعة على بعد بضعة كيلومترات. تبدو فينغن كقرية جبلية في آخر العالم.
كانت لوسي الابنة الكُبرى في عائلة من ثلاثة أطفال. ما زالت تتحدث عن أبويها وتسميهما فاتغ (الأب)، وموتغ (الأم)، بحسب ما تقتضي لهجتها الألزاسية. كان لدى العائلة أرض ودجاجات وأرانب وأبقار، وكانت تعيش مما تنتجه هذه الحيوانات، إضافة إلى معاش «فاتغ» المتواضع كحارس على الحدود.
اقتحمت الحرب العالمية الثانية حياة عائلة جدتي الهادئة. وفي سبتمبر 1939، مثل جميع سكان خط ماجينو خط ماجينو: هو حاجز دفاعي شمال فرنسا، على الحدود الألمانية، أُنشئ عام 1930 وسُمّيَ باسم من بناه، أندريه ماجينو، الذي كان وزير الدفاع الفرنسي بين عام 1929-1931.، غادرت لوسي البالغة 11 عاماً حينذاك بيتها، بأفضل ملابسها المخصصة لأيام الآحاد، مع إخوتها الصغار، وأمها، والأبقار.
تقول لوسي: «لم أفهم ما الذي كان يحدث فوراً. كان يوم ثلاثاء. كنت أظن أننا نغادر بسبب أمر هام، لذلك ارتديت أفضل ما لدي: ملابس الأحد. وقد صفعتني خالتي لأني أضعتُ القبّعة. لست غاضبة منها، فالجميع كان متخبّطاً. كان على فاتغ البقاء في القرية مع رجال آخرين. لقد بكينا كثيراً، اصطحبنا الأبقار معنا، لأنها كانت أغلى ما نملك، وغادرنا. وصلنا قرية تدعى كغيسباخ، كانت القطارات تنتظرنا فيها، وقد اضُطررنا لترك الأبقار. وضعونا في عربات الماشية واضطررنا للنوم على القش». غادرت لوسي مع آلاف الأشخاص إلى جنوب فرنسا الشرقي، حيث أمضت سنة في منفى داخلي. ولكن، بعد استسلام فرنسا لجيش هتلر، أرسلت حكومة فيشي حكومة فيشي أو فرنسا الفيشية: هو اسم شائع للدولة الفرنسية التي ترأّسها المارشال فيليب بيتاين خلال الحرب العالمية الثانية، وانتقلت من باريس إلى فيشي، الواقعة في المناطق المحررة، جنوب فرنسا، التي ضمت الجزائر حينها، وكانت الجهة الإدارية المدنية في فرنسا والمناطق المُستعمرة. جدتي وجميع الألزاسيين مجدداً إلى قراهم التي صارت جزءاً من ألمانيا النازية.

ولدت لوسي فرنسية، ولكنها لم تكن تتكلم الفرنسية، في منطقة أصبحت تابعة للنفوذ الفرنسي منذ هزيمة ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، وهي منطقة متنازع عليها بين ألمانيا وفرنسا لعدة قرون. ورغم تفضيل أغلبية سكان المنطقة لفرنسا، إلا أن قلة التنظيم الإداري، واستخدام الألزاسيين لهجة ألمانية، إضافة للالتزام الديني، كل ذلك أعطى الألزاسيين موقعاً استثنائياً في فرنسا بين الحربين العالميتين. وأدت هزيمة فرنسا أمام ألمانيا النازية إلى اعتبار الألزاس مندمجة بحكم الواقع مع الأراضي الألمانية. عنى هذا لعائلة جدتي وآلاف الألزاسيين العيش في وسط من الخوف، لاعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية، بسبب تفضيلهم الحكم الفرنسي، واعتبارهم خونة وفقاً لذلك.
كانت المدرسة إلزامية حينذاك، ووسيلة قوية لفرض سياسة «الجرمنة»، حيث أصبح استخدام الفرنسية محظوراً، وتمت «تنقية» اللهجة الألزاسية من الدلالات الفرنسية. كان المدرّسون نازيون في مدرستها. وكانت عبارة «بونجور» بدلاً من «هيل هتلر»، بالنسبة لجدتي ورفيقاتها، سلوكاً عصيانياً ونوعاً من المقاومة للنظام اللواتي يكرهنه. وقد قاد هذا لاعتقال صديقة لها، أُرسلت إلى أقرب مخيم لإعادة التأهيل في شيرميك.
اعتُقل والد لوسي بعد هزيمة فرنسا، وأُرسل إلى ألمانيا لأداء الخدمة الإلزامية، التي يؤديها الرجال قسراً. وقد هرب من هناك، واختبأ في الغابة لشهور مع مجموعة من الرجال، بينهم شقيق لوسي، أملاً بأن تحميهم الغابة من الذهاب إلى الجبهة الروسية. اضطُر معظم الرجال لمغادرة القرية، فيما بقيت النساء والفتيات الصغيرات كلوسي في البيوت مع الأطفال والمسنّين. كان على الحياة أن تستمر، في قرية نُهبت، وساد فيها الحرمان والإذلال والخوف.
ما زالت تبكي حين تخبرنا عن قصص تلك الأيام، التي مرت عليها عقود من الزمن، إلا أن الصور والذكريات تبدو حية في ذاكرتها وأقوى من الحاضر.
تضيف جدتي: «كان هناك شيء على وشك الحدوث. غادر النازيون القرية قبل أيام، وكان ثمة قصف مستمر. لم نستطع الخروج من القبو الذي اختبأنا فيه مع عدد من الجيران. لا أتذكر تحديداً كم بقينا هناك. سمعنا هدير أقدام وأصوات رجال يتحدثون الإنكليزية. كان علينا الذهاب إليهم لإخبارهم بوجود أناس هنا، وأننا لسنا نازيين. لم يرغب أحد بالمخاطرة والتعرض للاعتقال أو ما هو أسواء من ذلك. لكني خرجت مع امرأة أخرى. تحدثتُ قليلاً من الإنكليزية، وفهموا منها أننا لا نشكّل خطراً. كنا سعداء بأنهم جنود أميركيون. بعد ذلك أعدت أمي لهم الطعام لأنهم كانوا جائعين للغاية. أكلوا الطعام كله، وأعطونا لباناً وشوكولا».
كان هذا هو التحرير. انتهت الحرب العالمية الثانية عام 1945، وكانت الألزاس من آخر المناطق التي تحررت من النازيين، فيما جعل انتصار الحلفاء المنطقة تابعة لفرنسا حتى يومنا هذا. غادرت لوسي قريتها فور انتهاء الحرب، واستقرت في باريس، حيث أمضت 40 عاماً من حياتها، لتشهد على الأحداث المصيرية في النصف الثاني من القرن العشرين: الحروب ضد الاستعمار، وحرب الجزائر، وبيبي بوم بيبي بوم: زيادة ملحوظة في معدل الولادات، خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية.، وأحداث مايو 1968أحداث مايو 1968: مرحلة من الاضطراب المدني في فرنسا، استمرت مدة 7 أسابيع، وتخلّلتها الإضرابات، كان بينها الإضراب الأكبر في فرنسا، إضافة للاحتجاجات واحتلال الجامعات والكليات والمصانع، احتجاجاً على الرأسمالية والاستهلاكية والإمبريالية الأميركية.. تزوجت، وأنجبت ثلاثة أبناء، ثم تطلقت وانتقلت إلى المدينة الصغيرة، التي نشأتُ فيها، لتساعد أبي وأمي في تربيتي أنا وأخي.
لا يبدو أن كثيراً من هذه الحياة، التي بنتها بعد الحرب، بقي في ذاكرتها. فالصور تصبح ضبابية في ذاكرتها، وتختلط الوجوه، وتُنسى الأسماء. تحدثت قبل مرضها عن آمالها وسعادتها وندمها. عن باريس وزوجها السابق. ولكن هذه الذكريات تبهت وتختفي يوماً تلو الآخر.
أمام الزهايمر، تشعر بأنك شخص عاجز أمام عقول من تحبهم، التي تختفي في مناطق غامضة. أتساءل أحياناً إن كان ما يحدث للوسي سببه المرض، أم قرارها المبطّن بالغوص في الماضي وترك الحاضر وراء ظهرها، كما لو أنه لم يعد مُثيراً للاهتمام. وكأن كل ما حدث بعد الحرب صار سحابة تراها لوسي وهي تنسحب بعيداً. وكأنه ليس مهماً ما تبنيه وتخوضه في الحياة، فالحرب وصدماتها تبقى أثراً راسخاً تتجدد ذكراه على الدوام، مع ما يحدث في عالم اليوم. فرغم أن قصص لوسي انقضى عليها 80 عاماً، إلا أنها تتقاطع وتتشابه، بشكل مؤسف، مع أحداث نعيشها اليوم في عالمنا، الذي أعرف أن فيه فتاة عمرها 11 عاماً، تبكي اليوم لأنها اضطرت للفرار من الحرب، والخوض في دروب لا تعرف مُنتهاها.
حكايات جداتنا هي بالتأكيد الهدايا الأثمن لنا، نحن الأحفاد، وللعالم. هي إرثهنّ الذي لا يُقدّر بثمن، ودواؤهنّ للنسيان.
قالت لي لوسي قبل المرض: «كان الجميع يعرف عن المعسكرات، والمحرقة، والاعتقالات، والترحيل. لم يكن لدينا هواتف أو تكنولوجيا حينها، ولكن الناس كانوا يتحدثون بلا توقف عن ذلك. لقد حاولنا فعل ما نستطيع ضد النازيين. فيما أيّدهم البعض، لكن معظمنا كان يكرههم، وقد شارك بعض الرجال في حركات المقاومة، ولم يعد منهم سوى عدد قليل. لقد تحدثنا عن حقيقة ما جرى بقدر ما نستطيع. قلنا ما جرى مراراً، لأننا عانينا، ولم نرغب أن يتكرر ذلك. ما الذي كان بإمكاننا فعله سوى الحديث عما جرى لنا؟».
قد يكون عليَّ تذكُّرُ أن جدتي يتم اعتبارها، وفقاً للمدرسة الصينية لعلم النفس، طفلة تُعبّر عن نفسها مرة أخرى. قصص جدتي عن الحرب ليست بطولية. هي مجرد قصص بسيطة لفتاة صغيرة حاولت النجاة ذلك الوقت، والتصرف كشخص ناضج. وهي الفتاة ذاتها، التي تخرج اليوم من أعماق ذاكرة لوسي المبعثرة، وتعود إلى الحياة مجدداً، لكي نراها.