فيما نُعرّف نحن عن أنفسنا عموماً كـ«فلسطينيين-سوريين»، كانت جدتي لأمي، أم الشريف، تُعرَفُ بأنها «السورية-الفلسطينية». انتقلت أم الشريف بعمر الرابعة مع عائلتها من دمشق إلى يافا، وعاشت فيها طفولتها. تزوجت في الثالثة عشرة، وأنجبت طفلتها الأولى هناك، ثم عادت هاربة في عام النكبة إلى بلدها الأصلي، سوريا. رحلة مرّت فيها بـ«جبل الدروز»، قبل أن تصل جوبر في دمشق، ثم القزّازين، فمخيم اليرموك، لتصبح فيما بعد «الشامية اللاجئة في الشام».
في صورة عائلية ملتقطة في عيد ميلاد قديم، لم تكن جدتي تنظر إليّ، كانت تجلس على الأريكة ذاتها التي تظهر في صور كثيرة التُقطت على مدار سنوات، بينما أتناول الحلوى، وأرمقها بنظرة غاضبة.
لم تكُن أم الشريف تكنّ ودّاً لي كشقيقَيّ، هي التي أنجبت على مدى اثنين وأربعين عاماً، تسع بنات، وثلاثة أولاد، توفي أصغرهم برصاصة طائشة لم يُعرف من أطلقها خلال احتفال بعودة أحد الحُجَّاج في مخيم اليرموك. ارتابت أم الشريف من الجميع، وشكّت بكل من رأته بأنه قاتِل ابنها، لتصاب بمرض السكر إثر تلك الحادثة. لذا لم تجد نفسها مضطرة لإخفاء مشاعرها بتفضيل أولادها وأحفادها الذكور على الإناث. في الأعياد، تُوزِّع علينا الـ«عيديات» تنازلياً، بدءاً من الذكر ابن الذكر الذي يحصل على أكبر عيدية، ثم الذكر ابن الأنثى مع الأنثى ابنة الذكر، بينما نحن الفتيات، بنات البنات في المرتبة الأخيرة.
لم يُغضبنا هذا التفضيل العلني للأولاد، وكان حبُّنا التلقائي نحو جدتنا يقابله الكثير من الأعطيات التي تفيض على الجميع، مثل «العنبر» (التفاح المحلى) ومربَّى اليقطين، وغير ذلك الكثير، فضلاً عن حكاياتها المثيرة التي ترويها: الغولة و«حسّو» و«زيزون وزيزونة».
حافظت جدتي على لهجتها الشامية، لكنها اكتسبت شخصية فلسطينية، بسبب انتماء زوجها وأولادها، وذاكرتها التي تشكَّلَت في سنواتها الأولى، والتي كانت تُبكيها، كلّما ذُكرت يافا.
في دمشق، احتفظت أم الشريف بعاداتها المنزلية كأنها لم تُهجَّر من يافا، فهي تطبخ «المسخَّن» و«الملوخية الناعمة». ومن الطحين الذي توزعه الأونروا كمساعدات ضمن «كرت الإعاشة» على اللاجئين، تعجن وتُعدُّ الخبز الفلسطيني السميك كل يوم. لم تتردد في خلع الملاية، ثم المنديل عن وجهها. وأصرّت على تزويج بناتها التسعة لشبّان فلسطينيين.
بدأت أم الشريف في دمشق من الصفر، غُرفة مستأجرة تنقَّلت بعدها بين بيوت إيجار عدة. تُرتِّب الأمكنة، تنشئ كتبيّة (خزانة حائطية) في جدار كل منزل. وتستعيض عن الحقائب بالبُقَج المكدَّسة في الخزانات وزوايا الغرف. تلفُّ فيها الملابس الصيفية أو الشتوية، وتحتفظ بمستلزمات الخياطة؛ دبابيس وأقمشة ملونة أو بيضاء مطرزة، ومجلات تعرض موديلات مصوَّرة وخطواتٍ تعليمية لها. كانت أم الشريف تترك كل صباح ماءً وطعاماً للقطط التي تزور «أرض الديار»، وتُغني ما حفظَت من أغنيات فريد الأطرش في الساعات الطويلة التي تمضيها في المطبخ أمام بابور الغاز والمجلى والغسالة اليدوية. وقد أوْصت بأن تأخذ إحدى بناتها ماكينة خياطة «سنجر»، وأخرى عربة زرقاء كانت تعينها على شراء حاجياتها من السوق. ونالت اثنتان من بنات ولَديها في هذه الوصية سوارين من الذهب، وخصّتني أنا بوسادة ذات لون أخضر باهت صنعَتها من الريش.
قبل بلوغ حفيداتها، تراقب أم الشريف وتسأل الأمهات عن التطورات البيولوجية التي تطرأ على كل حفيدة. وتُنبِّه بأسلوب يجمع الفخر بالحرص على التعليم، بأنها صارت ربَّة منزل وأمَّاً «جابت أول بطن» عندما كانت في الرابعة عشرة، وتكتفي بهذه الإشارة لحثِّ بناتها على التدريب المبكر والتذكير بالمسؤولية دون أن تتدخل مباشرة في تنشئة الحفيدات، ابتداء من كيفية «ضم الإبرة» وتنظيف أرضية المطبخ، وانتهاء بكيِّ الملابس ومسح الزجاج. لكنها سرعان ما «تغسل يديها» من أي حفيدة عند فشلها في أول مهمة منزلية، كعدم تجفيف بقع الماء المتبقية حول البالوعة أو ترك آثار المنظفات على الصحون. لتكفَّ نهائياً عن تكليفها بأية مهمة بعد ذلك.
في الهوية كان اسمها إسعاف، وهو اسم استخدم لعدد قليل من السنوات، حتى أنجبت مولودها الذكر الأول، لتُعرف بعد ذلك، بل وتُعرِّفَ نفسها بأم الشريف. إذ غابت كلمة إسعاف بمرور الوقت من التداول لدى أفراد المستعمرة الكبيرة من الأبناء والأصهرة والكنَّات والأحفاد الـ44، وصار وقع هذا الاسم، عندما يرد في الورقيات، غريباً على العائلة. الاقتران باسم الابن البكر مبعث فخر واعتداد بالنفس لدى الأمهات-الجدات. لكن أم الشريف، لم تنادِ بناتها إلا بأسمائهن، ولم تُعرّف بنا، لكثرتنا ربما، إلا بنسبتنا لهنَّ وكأننا من دون أسماء.
في آخر سنواتها، انتظم يومها حسب مواعيد أدوية السكري والضغط، وتحولت فجيعتها بابنها إلى حزن قاسٍ يندر أن تتحدث عنه أمام أحد. وطوال الأعوام الـ72 التي عاشتها، انتظرت أم الشريف العودة التي لم تتحقق إلى يافا، والمشي بين أفران الكعك التي امتلكها والدها هناك، وركوب«الفلوكات» في نهر جريشة. ظلت تتجاهل الواقع وتأمل العودة كأنها أمنية قابلة للتحقق، حتى وفاتها ودفنها في مقبرة مخيم اليرموك.
إسعاف، دمشقية الأبوين والمولد، صارت فلسطينية بالنشأة، والزواج، ثم بالتهجير والنكبة واللجوء الطويل حتى لو كان في مسقط رأسها. امتلكت جواز سفر سوري، وهوية مركَّبَة بين يافا ودمشق، بين فلسطين وسوريا، حيث التقاطعات في التاريخ تظهر عبر مقارنة سيرتها بسيرة ابنتها «الفلسطينية السورية».
*****
يُقال إن المرء يتحول إلى نسخة عن أحد والديه كلما تقدّم بالعمر. لكن أم عمّار (حنان)، ليست كذلك. تقول أمي إنها اكتسبت القليل من والدتها أم الشريف، فهي مختلفة في الطباع والاهتمامات. نهار جدتي كان عملاً متصلاً من الصباح حتى المساء، بين ماكينة الخياطة والمطبخ ثم اختراع أي شاغل في أوقات الفراغ، فالعمل المنزلي هدف بحدِّ ذاته، تفلت عبرَه من الأحزان المزمنة. لم تمسك أمي إبرة وخيطاً كي ترقِّع الثياب، ولم تعدَّ النجوم أو تخنق الثآليل بالخيوط. هي متفائلة، عقلانية، ولا مكان للندم أو الذكريات السيئة أو التعلق بالأماكن في نفسها. لم تكن أي من الجدَّتين تشبه أم سعد بطلة غسان كنفاني الفلسطينية، وبما أن «خيمة عن خيمة تفرق» بين لجوئين لحنان وأمها، فقد تقاطع الحنين لديهما بطريقة معاكسة، تلك أم الشريف السورية كانت تشتاق إلى يافا، وهذه ابنتها الفلسطينية اللاجئة اليوم في اسطنبول تشتاق إلى دمشق.
منذ أن أصبحت جدة، نشأت علاقات صداقة جمعت أم عمّار بأحفادها، تشوبها بعض الخلافات الطارئة مع الحفيد الذي يعيش معها في المنزل ذاته منذ 9 سنوات. هذا الحفيد، يلقب جدته بـ«الأسطورة». صحيح أنها تستفزّه، ويرى سؤالها المعتاد: «مين بتحب أكتر أنا ولا إمك»، بأنه لا يحمل أي بعد منطقي. قد يتلقى من جدته، التي عملت 20 عاماً كمديرة مدرسة، عشرات الأوامر الواجب تنفيذها في وقت واحد، لكن «تيته» حنان تدلّلـه، أكثر مما دللّت والدته في صغرها. تغني له وتروي الحكايات، وتطعمه إن كان جائعاً أو غير جائع. أحياناً، يدرسان اللغة التركية معاً، ويختلفان على نطق بعض الكلمات. تشاركه حبَّ الحلويات، ويشيدان معاً منازل على شكل مثلثات مصنوعة من ورق اللّعب.
أمي لا تريد من الزمن أن يعيدها إلى دمشق دون أولادها، حيث يقع قبرَا والدتها وزوجها. القبران التي لم تُدرك أن زيارتهما في خريف عام 2012 قد تكون الأخيرة، إلى حين عودة غير مؤكدة.
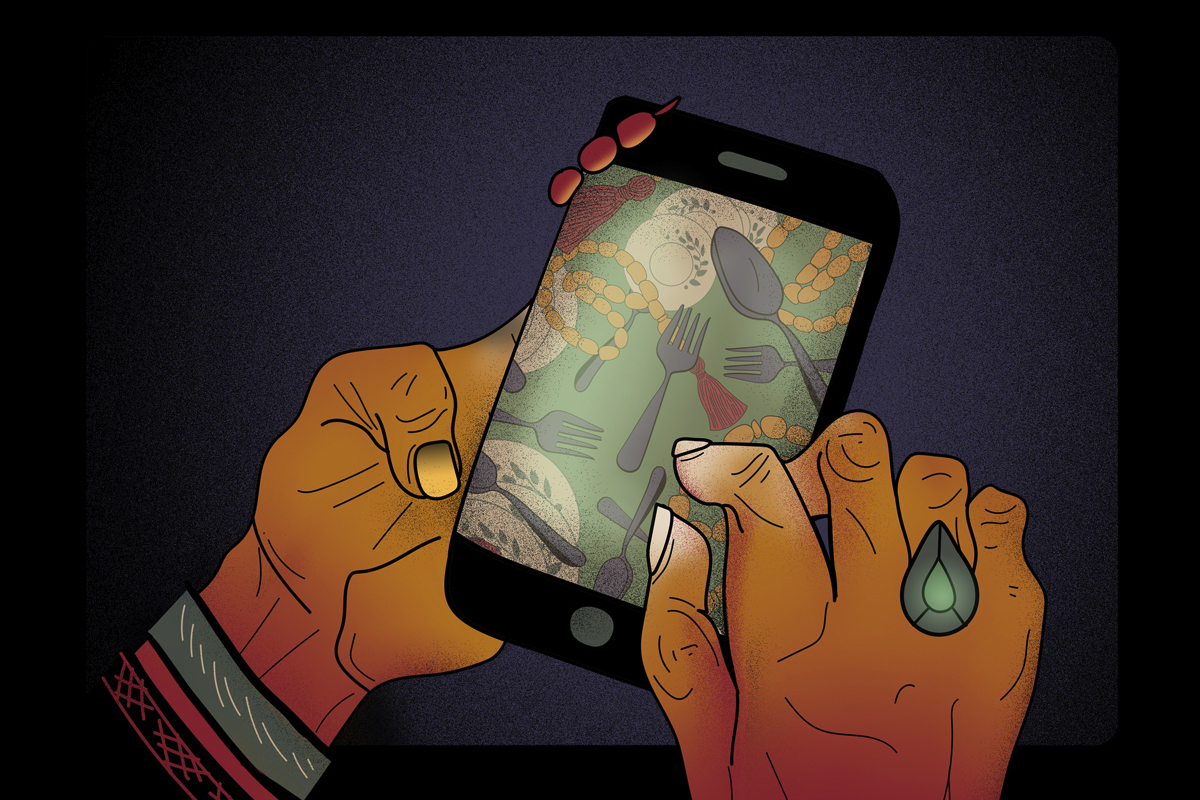
في أواخر ذلك العام قصفت قوات النظام جامع عبد القادر الحسيني المجاور لمدرستها في المخيم. كانت الأونروا تعمّم يومياً تعليماتها عن الدوام أو التعطيل في المدارس حسب خطورة الأوضاع الأمنية. ولحسن الحظ لم تداوم في ذلك اليوم، لا هي ولا معلماتها الثلاث والعشرون، ولا «بناتها» الألف، كما اعتادت أن تسمي الطالبات. كان القصف الصاروخي الذي تعرض له المخيم كفيلاً بنزوح معظم السكان. لكن، وبعد أيام، عادت وحدها لتجلب ما استطاعت، وبما يتسع له «الڤان» الذي استأجرته، من ملابس وأغطية وأشياء أخرى غالية على القلب.
أطلقت قوات النظام في نيسان 2018 عملية عسكرية أضافت المزيد من الدمار في عمران المخيم. انشغلت حينها أم عمار بملاحقة الأخبار والصور عبر هاتفها المحمول، تتابع جميع صفحات المخيم المؤيدة والمعارضة في فيسبوك. تمسح الهاتف بطرف كفِّها الجانبي مرات عدة حتى تستطيع التقاط «سكرينشتس»، وتخزّن العشرات من الصور لتتفحَّصها لاحقاً، علّها تتعرف على واجهة منزلها. فحسب ما سمعَت، تعرّض المنزل لثلاث ضربات، لكنها أمِلت أن يظهر سالماً في إحدى الصور. تُعدد الأشياء التي تركتها هناك، وتتذكر أين خبأتها: «الزبادي، والصحون الأزاز التقيلة، كلون كنت مخبيتون بالتخوت والكنبايات… جاكيتي الفرو، الستاير، الغاز صحيح من أيام أبوكي، بس كنت كل يوم عم بنضفو ولساتو جديد». رحلة بحث وتقصٍّ يومية، انتهت بصور حصرية لها، ومؤكَّدة هذه المرة للمنزل. كان مدمراً مثل كل المنازل والمباني حوله، يخلو حتى من حطام الأثاث والأبواب والشبابيك، لم يبق من أثر البيت سوى الركام.
من المخيم إلى ضاحية قدسيا في دمشق، ثم إلى مدن ودول لجوء مختلفة، لينتهي بها المطاف في اسطنبول، تلك مسيرتها بعد العام 2012. ومثل مئات الآلاف من الجدات والأمهات اللاجئات والنازحات، كان عليها أن تتعلم أشياء جديدة، أن تتغير، وأن تبدأ، إن أرادت أن تبدأ بأي شيء، من الصفر. وكأنها متخرجة للتو، قدمت طلبات توظيف لعشرات المدارس العربية والسورية في اسطنبول، دون جدوى، لتحاول بعد ذلك تعلّم اللغة التركية وببطء شديد، دون دورات تعليمية أو مدرسين، مقاطع اليوتيوب تكفي، وتؤمِّنُ الحدَّ الكافي للتفاوض مع الباعة وتحيَّة الجيران. كيف لها أن تتعلم من أحد، وهي التي أمضت واحداً وثلاثين عاماً من عمرها في تعليم الآخرين. تخلَّت عن الكثير من عاداتها السابقة، لكنها لا تزال تمتلك البراعة ذاتها في عدم الاستماع أو تلقِّي أية معلومة جديدة، حتى لو كانت عن أسعار صرف الدولار أو درجات الحرارة أو قرارات الحكومة التركية بخصوص اللاجئين. هذا الطبع الذي اكتسبته من إدارة المدارس، يكشف عن إحساسها بالمعرفة الكاملة، وعن تجاهلها للمخاطر والمفاجآت التي تُهدد هذا الإحساس.
بوسعها إنشاء علاقات جديدة في اسطنبول، لكن ذلك لن يعوِّضها عن محيطها السابق الذي تناثر في دول لجوء مختلفة، ولا عن ولَديها البعيدين. لكن، بقليل من التآلف مع الواقع الجديد، وكثير من الاتصالات مع الأبناء والأقارب والأصدقاء عبر الموبايل، تحاول مواجهة شعورها الغربة. بل إنها بدأت تعتاد هنا في اسطنبول على التنزه واكتشاف المدينة، بعد أن كانت مشاويرها المشابهة في الشام تقتصر على المناسبات، كولائم الغداء في أعياد المُعلّم، والأعراس والمباركات الجماعية مع المعلمات والمديرات الأخريات.
في اسطنبول ترغب بأن يفهم لغتها جميع من تتحدث إليهم، وأن تمشي دون الاستعانة بـ«غوغل مابس». تعبت من استدعاء ذاكرتها لأسماء الشوارع الجديدة التي تحمل حروفاً لا تجيد ترتيبها بالشكل الصحيح دائماً. ومن حفظ حروف وأرقام الباصات المؤدية إلى محلات السوريين. ومن الشرح لسائقي سيارات الأجرة الأتراك كيف أنها فلسطينية وسورية في آن واحد، وأن الموت والظلم في غزة، ليسا ببعيدَين عن الموت والظلم في مخيم اليرموك. تقلقها شائعات رفض تجديد الإقامات والهواجس باحتمال ألّا دولة قد تسمح لها بالإقامة فيها بعد الآن. وبأن تركيا، البلد الذي لم تتخيل يوماً أن تقيم فيه، هو البلد الوحيد الذي يتقبّل وجودها، ولو إلى حين.
ما تبقى لأم عمّار، هو نحن، البنات والأولاد، وإن لم نكن معها على مائدة واحدة. وخاتم الزواج، وإن كان الزوج راحلاً، وعقد ملكية منزل في مخيم اليرموك، وإن كان مُدمّراً.
في اسطنبول تعرف والدتي أشخاصاً أقل من عدد أصابع اليد، أما في دمشق فكانت تعرف الآلاف ويعرفونها، حفظت شوارع الشام شبراً شبراً، ولم تكن لاجئة هناك إلا في الورقيات الرسمية التي تعتبرها «بحُكم السوريّة». في المخيم الذي لم تحبّه إلا بعد أن خرجت منه، تصادف إذا مشت في شارع مؤدٍّ إلى مدرستها الكثير من الأحبة والأقارب والجيران والتلميذات اللواتي أصبحنَ نساء ناضجات. في حارة منزلها ذكرى طيبة لزوجها، يُحيّيها الجميع، ويترحم من يسألها عن أخبار الأولاد، على روح أبيهم. في ضاحية قدسيا خبّأت راديو بحجم كفّ اليد يبث أخباراً وأغان بأصوات مشوَّشة، كان رفيقاً لقيلولة زوجها، وفستان طفولة معقود بالدَّانتيل عند الصدر ومطرَّزاً بورود ملونة في أطرافه، صنعَتْه لها أم الشريف من معطف جدي، قبل أن يبدأ يوم العيد بساعات.







