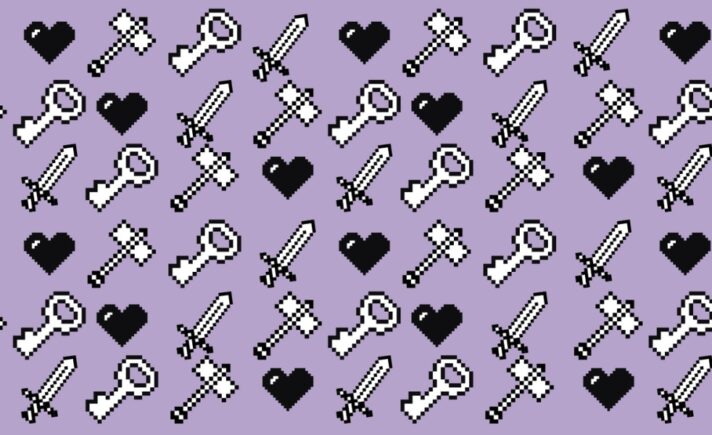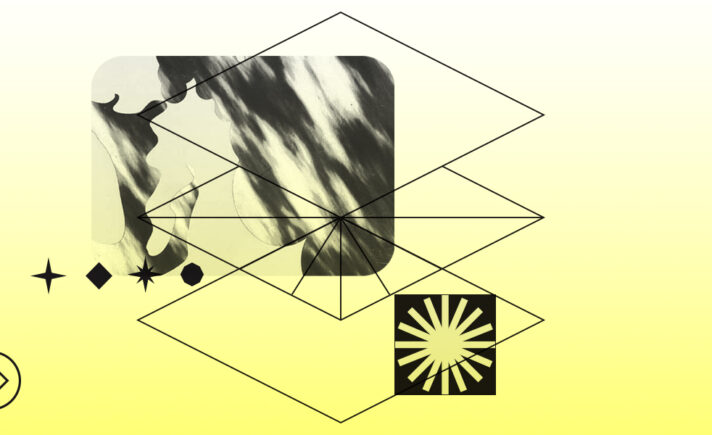في المنام يجلس حبيبها وزوجها بهدوء قربها على مصطبة أمام بيت غير واضح الملامح، يقف ويتوجه بهدوء أكبر ليقطف لها ثمار الأكدنيا والخوخ المتدلية من أشجار أمام البيت. منذ فترة بات يتساءل كما يتساءل إيغوشي بطل كاوباتا في الجميلات المنوّمات: كيف أمكن لثدي الأنثى البشرية، من بين كل أنواع الثدييات، أن يتطور ليصبح على هذا الجمال والاكتمال وكأنه المجد الأبهى للتطور البشري؟ ويتعجّبُ من مخترع عطر «جوب» الأنثوي الذي فهم بدهاء أن رائحة التفاح هي المرأة. باتت تساؤلاته من هذا القبيل تكثر، وأَخَذَ الكلام الذي كانت تتمناه دائماً، والذي لم يكن يجد له موجباً في حضرة حمىّ مغازلاتهما، يحتلّ مساحةً أكثر. تتأمل صورها في الألبومات القديمة، كانت جميلة على ما يبدو، لحظة التقاط الصورة لم تكن تجد نفسها جميلة. لم تكن يوماً منضبطة في مواعيدها مع خط سير الحياة، متأخرة غالباً، وخاصة في إدراك الأشياء، وبخصوصية أكبر حين يتعلق الأمر بإدراك مكامن جمالها، اللهم إلا عبر الصور الفائتة. إلا أنها على الأقل لا تمزّق صورها مثلما تفعل إحدى صديقاتها، مُبهِرة الجمال التي لم ترَ أو تشعر يوماً بجمالها. أخذ إيقاع مشيتها يتغير حسب هوى ومهوى الفقرات، ولكن كل ذلك لا بأس فيه؛ الكلام الذي بدأ يزيد في محادثاتها مع حبيبها، والبطء في المشية، وفتور وهج رغبات الآخرين الذي شعرت به مع أول كلمة «خالة» وُجِّهَت إليها. في الحقيقة، في هذا الكثير من التخفّف والتقليل من الارتباك والخجل المُعيق الذي لازم حياتها.
*****
لا نعرف إن كانت لوسيّة صبيّة قبل أن تكون جدة. من الحكايات التي سمعناها عن أمّ جدتي، شعرنا وكأنها خُلقت جدة ولم نعرف شيئاً عن سيرورتها كامرأة شابة. كانت هي التي تُستدعى في المصائب مع ارتفاع حرارة الأحفاد، لتحضّر لهم «سيروماً» طبياً مصنوعاً من الدبس والثلج، وهي التي تُحضِّرُ طبق العرسان والولّادات، الزرزورة المثقل بالمكسرات فوق طبقة من العنب المغلي مع النشاء. وهي التي تصنع من اجتياز شهادة البروفيه للبنات والصبيان من الأحفاد حدثاً يتوجب الاحتفاء به، بشراء ساعة يد كعلامة نضوج ودخول في عالم الكبار. في بيتها الصغير على سفح تلة صغيرة، والمستكين لجارٍ شفيعٍ قويٍّ هو مار جرجس، تستجديه في الملمّات كما يجدر بقانون الجيرة وكثرة القديسين الشفعاء، والمظلل بشجرة رمان وشجرة تين، عاشت لوسيّة قرابة القرن دون أن تشتكي من كثير من الأمراض، ودون أن تبرك دون حركة. في عشية إحدى الأفصاح وبعد صيام قارب الخمسين يوماً، قررت لوسيّة أن تُعزّل تعزيلة الفصح، وتستحمّ كما يليق بالعيد الكبير، لوحدها. ثم نامت ولم تستفق، كما يليق بميتات القديسين والأولياء الصالحين. لا نعرف إن كانت تنتظر حقاً ولديها المهاجرين إلى الأرجنتين لتحسين ظروف حياتهما، بعد أن توقف عمل أحدهم على خط الشام طبرية في شحن البرتقال الفلسطيني. في تلك الأيام، كان الحزن، حزن الانتظار، أبرأ وأخفّ، وكان العيش مع الأحفاد يأخذ وقتاً أكبر دون لهاث مسعور حتى نحسب أن الجدّات جدّاتٌ منذ الأزل.
*****
كل ما في الأمر أنها لم تشعر بالوقت يمر. التخفّف جميلٌ بلا شك، التخفّف من الرصانة، التخفّف كما تصفه الشاعرة الإنكليزية جيني جوزيف في قصيدة شهيرة عن الشيخوخة بعنوان حين أشيخ، تقول فيها:
حين أشيخ سأجلس على الرصيف حين أتعب،
حين أشيخ سأسرق الأزهار من حدائق الجيران،
وسأتعلم البصاق،
وسأتعلم الخروج بشبشي للمشي تحت المطر،
حين أشيخ سألبس الأرجواني مع أحمر لا يليق بي وغير مناسب،
وأشتري صنادل الساتان والكفوف الصيفية،
وأقول لا مال لدينا لشراء الزبدة
كل ذلك صحيح، كل ما في الأمر أن كل شيء مرّ بسرعة البرق.
مما بقي في ذهنها أن أمّها كانت تحزن عندما تسمع أصوات زمامير الأعراس في الحارة. وعندما كانت تتلقى بطاقات الدعوة للأعراس، كانت تحزن لحال العروس التي بدأت ماراثونها في اللهاث. في خضمّ لهاث نسائنا كان الأحفاد هم وعد القطاف، أن نخطّ في مبيضات بعد مسودّات خربشناها في تربية أولادنا المباشرين. الأحفاد، وأن تكوني جدّة، هو انتباهٌ أخير، انتصارٌ صغير في المعركة الحادة بين مرور الزمن وإدراكه. إدراك التزامن قبل فوات الأوان، التحاق قبل ثوان بخط النهاية في سباق الماراثون.
*****
كل شيء في الخالة وديعة كان يُنبئ أنها ستستحقّ مكانتها كجدّة حين تحين اللحظة. هادئة، صبورة، حييّة ومحبة ومن «تم ساكت». بعد تخرجها من كلية الآداب قسم اللغة العربية، انتقلت للعمل من هيئة من الهيئات الفلسطينية في دمشق إلى التدريس. لم تكن من الأشخاص الذين يشعّون بحضورهم، ربما بسبب خجلها، أو بسبب القمع الشديد الذي وقع عليها وجعلها قليلة المبادرة على العموم. لم تكن امرأة سعيدة في زواجها، ولكن حضورها الهادئ آنَسَ طفولتنا. كانت من أكثر حرّاسنا وفاءً في حديقة التجارة، وأكثر المثابرين على وضع الميكروكروم الأحمر على ركابنا التي بقيت حمراء كل سنوات لعبنا. أثناء مراهقة ابنة خالتنا الكبرى، كانت تتغاضى عن شرائها لمجلات لم أعد أراها في دمشق بعد الثمانينات، ليست كوميكس ولكنها مسلسلات ورقية عن علاقات حب تحوي بعض القبل السريعة. اليوم، أفكر كم كان تغاضيها رائداً نظراً لما عاشته من تشدد. في أول مرة اصطحبتنا إلى سينما الكندي لحضور فيلم أحلام المدينة لمحمد ملص في بداية الثمانينات، انبهرتُ يومها بجمال ياسمين خلاط التي اختفت من عالم التمثيل بعد ذلك وتفرّغت للكتابة، وغُمِرتُ بأجواء السينما وطقوسها. ومن الأحلام التي رافقتني فيما بعد، كان العمل كقاطعة تذاكر يبقى لها كثيرٌ من الوقت لنفسها بعد انتهاء عرض الفيلم وانصراف المتفرجين، وذلك من بين أحلام غريبة عديدة متعلّقة بالأعمال المغمورة حيث لا ثرثرة كثيرة، كأن أعمل في المؤسسة العسكرية الاجتماعية لتوزيع المنتجات، الواقعة في أول شارع الطلياني في تقاطعه مع شارع الحمراء، مقابل مئذنةٍ أنيسةٍ مربّعة لجامع متوارٍ لم أعد أذكر اسمه. وكان طقس السينما مع خالتي يُتبع قطعاً بتناول الـ«شوكولا مو» في محل كان يسمى «ديليس» في إحدى دخلات الصالحية شهداء، يقدم المياه الباردة في كؤوس من الستانلس تُذكّرُ بسبل دمشق ومياهها الطيبة. لم نكن نعير، نحن أطفالها وأطفال أخوتها، مكتبتها العربية كثيراً من الاهتمام، ولكنها كانت تغترف لنا منها بعض المقاطع، وتقترح قراءات وتواسي مللنا بحزوّرات الإعراب التي كنتُ أبدعُ فيها، ما عدا التمييز بين إذ الفجائية وإذا الشرطية، والأعداد التي لم أستوعبها يوماً رغم تكرارها لي «لك سهلة سهلة… احفظيها بقى!». بعد السينما، كانت وديعة هي السبب في تعرّفنا على مفهوم المكتبة العامة، حين رافقتنا أول مرة أنا وابنة خالتي ممسكة بقوة بأيدينا لنخترق الجموع في سوق الحميدية وننعطف يميناً نحو العصرونية، وتبدأ رائحة لحم الجمل المشوي بمباغتتنا من المحلات المحيطة بحمّام الظاهر بيبرس، حيث يتربع رجال بمناشفهم قبالة الباب الرئيسي، لندخل بعدها من البوابة العريضة للمكتبة الظاهرية. في تلك الأيام، لم يكن ذلك البناء المملوكي الجميل قد جُدِّدَ بعد على طريقة وزارة الثقافة بوضع بحرة زرقاء إيرانية في وسط الفسحة السماوية؛ كان البناء قديماً يلفّ الحاضر بغرفه ومقاعده ودروجه الخشبية الصغيرة، بِهالة غريبة، يشتاقها المرء بعيداً عن دمشق؛ أفولٌ أخيرٌ مع اطمئنان أننا هنا. الهنا الآفلة في دمشق غير موحشة. كانت المكتبة الظاهرية لخالتي مثل الغرفة الخاصة بفيرجينا وولف، لم تكن تبدع فيها الكثير، اللهم إلا بحثاً صغيراً عن الكاتبة وداد سكاكيني، ولكنها مساحتها الخاصة. مساحة جعلتني أقرأ في عينيها الحييتين شيئاً من الراحة بعد وفاة زوجها الذي لم تحبه يوماً. كانت اللحظة مواتية لتبدأ الاستمتاع بأول حفيدة بعد ماراثون الحياة وتنشئة أولادها. عاقبتها الأقدار على زفرة الراحة بأسوأ أنواع السرطان، ولم تعرف باقي أحفادها. مع أنها أتمت طقوس الانتظار كما ينبغي، على أحسن وجه. حين بِيعت كل أجزاء كتاب الأغاني للأصفهاني من مكتبتها على عجل بعد موتها، انقبض قلبي وفاض برائحة الدروج الخشبية الصغيرة في المكتبة الظاهريّة الدمشقية.

*****
في طقوس القرابين على الطريقة السورية، ينبغي استحقاق الجدودية بطريقة ما أقساطاً من العذابات، أدت معظمها، وربما حان الوقت لتستمع بأحفاد، ما زالوا باكرين على كل حال. في حضور الرضّع تشعر بالامتلاء الذي لا يحتاج إلى كلام. امتلاء دون ثرثرة. قرأتُ مرةً أن بعض المستشفيات في دولةٍ ما تبحث عن أشخاص يحضنون المواليد الجدد، وخاصة المتروكين منهم. سيكون أنجح عمل قد تقوم به، أنجح من أعمال رعاية المسنين المتوفرة بكثرة في هذه البلاد. في كل الأحوال، لا يمكنها أبداً أن تعمل في رعاية المسنين، سيذكرها كل أخدود في جسد المسنّ الذي ترعاه؛ سيذكرها بأجساد بقيت هناك لا تجد من يرعاها.
*****
صديقتي الجميلة التي تمزق صورها لأنها لا تجد نفسها جميلة وُلدت في مجدل شمس في الجولان، وبسبب تجوال الأسرة في سوريا، لم تكن أمها متفرغة لها كلياً عند ولادتها مع وجود خمسة أخوة أكبر منها. يُروى عنها أنها كانت تبقى مستكينة وهادئة لا تصرخ في مهدها منذ شهورها الأولى بانتظار أمها المرضعة.
انطبعت حياتها بهذا المشهد منذ مجدل شمس، طفلة مطيعة لا تتمرد وتساعد الجميع في العائلة. بمعايير أيامنا هذه، ما كان يُلقى على عاتقها من مهمّات منزلية يعتبر سوء معاملة أطفال وتعذيب. بعد شهادة الثانوية، أُتيح لها أن تبتعث إلى دولة أوروبية للدراسة على حساب وزارة التربية، ولكن بما أن الاغتراب والسفر غير مسموح بهما للبنات في محيطها، التحقت بقسم تفضّله من أقسام كلية الآداب، وقبل أن تنال شهادة الليسانس، دق ماراثون الزواج أبوابها وابتدأت رحلة عذابها. طفلٌ وعملٌ وإكمال دراسة، ومن ثم طفلٌ ثانٍ. ثمان سنوات زواج قضتها مع زوجها قبل أن يُعتقل وتبدأ مستوى ثانياً في صعوبة أداء الحياة، لتكمل تربية أطفالها لوحدها وتحافظ على عملها وعمل زوجها رغم غيابه. أول تعليق خدش أسماعها عند اعتقال زوجها هو أنه «مهما كان طارق بيتك يوماً سيقولون أنه عشيقك في غياب زوجك». لم تفهم صديقتي ما ذنبها كي تسمع كل ذلك العنف، حتى أنهم قالوا لها «انتبهي لأولادك حتى لا يُوسموا يوماً بأنهم ترباية مرا». قضت عقداً ونصفاً من عمرها على إيقاع الانتظار وزيارات السجن. انتظار الزيارة الأولى، انتظار نهاية أحداث حماة ومجزرة سجن تدمر، ومعاودة الزيارات التي انقطعت للتأكد من أن الزوج لم يقضِ في إحدى تلك المجازر. انتظار الأحداث الكبرى في العالم التي قد تغير شيئاً ما من حياتها، سقوط الديكتاتوريات في أوروبا الشرقية، موت تشاوتشيسكو، لقاءات الرؤساء فيما بينهم، إرهاصات انهيار الاتحاد السوفياتي، حرب الخليج الأولى ثم اتفاقات أوسلو. في سوريا العجيبة التي نصنع فيها حلويات بأسماء سماوية رقيقة مثل «المنّ والسلوى»، تُعاش الحيوات الصغيرة على وقع الأحداث الكبرى والحروب. لا مدهشَ في أن أحد نزلاء واحد من السجون السورية في ثمانينات القرن الماضي كان متأكداً بأن غورباتشوف متآمرٌ ضده، وكان يرسل له مكاتيب وينتظر جواباً منه لاستهجاناته المتكررة.
حين خرج زوج صديقتي من السجن، لم تستطع أن تحمل بولد جديد، توقف جسدها فوراً عن قابليته للأمومة. أُرهقت من عنف المجتمع ومن الانتظار. بعدها مباشرة، سافر أولادها تباعاً للدراسة في الخارج، وبقيت تنتظر عودتهم لتبدأ العيش حقاً، دون انتظار شيء ودون انتظار أحد، وكانت الأمراض قد بدأت تتغلغل في جسدها المتعب، ولكن لا بأس، فهناك بضع بقية للأحفاد، المكافأة الأخيرة.
بعد سنوات تُعدّ على كف اليد الواحدة، اندلعت الثورة السورية، وطار صوابها وكأنها لم تكن تنتظر شيئاً إلا الثورة رغم خوفها على أولادها، ولكن حماسها لم يداخله شيء سوى الخوف الشديد من البطش القادم. بقيت مقتنعة حتى بعد 2014، وبِدء تبيّن ممارسات الجماعات المتطرفة المتأسلمة وداعش في سوريا، ظلت مقتنعة دون نقاش ممكن بأنهم آل الأسد، آل الاسد الذين سرقوا شبابها. في عام 2014، خرج أولادها وأحفادها الذين كانت تأمل أن تبدأ بالعيش معهم حقاً، خرجوا من سوريا. ولم تعد تنتظر شيئاً، لقد أتمت كل ما عليها من تأدية قرابين ولم تعد تنتظر شيئاً، بقيت تمارس هوايتها في مرافقة المرضى من أفراد العائلة في آخر حياتهم، وفي إعدادهم للدفن حين يموتون.
*****
حين وُلدت ولادة عسيرة عانت منها أمها الأمرين، امتعضت إحدى نساء الدائرة المقربة من كونها بنتاً وقالت ممازحة لأمها «بدي أقبرها». من يومها وهي تهرب من أي شبح للموت، وتحاول إثبات أنها تستحق الحياة بتقريب أنواع عديدة من القرابين قرَّبَت مثلها الجدّات السابقات، وتحاول أن تقترب أكثر من نعمة الاستمتاع بالأحفاد دون أمراض وانتظار. انتظار الولادات، وأن يشبّ الأولاد، وأن يرجع فلان من خدمته العسكرية بخير في زمن الحروب وأن يُشفى المرضى وأن ينهي فلان شهاداته الجامعية وأن يرجع فلان من السفر، انتظار أن يتزوج الأولاد وأن يلدوا. انتظار السعادة المفقودة معظم العمر المسحوق يقترب كمفارقة من الموت الذي تهرب منه باستمرار. تلك هي المعضلة.