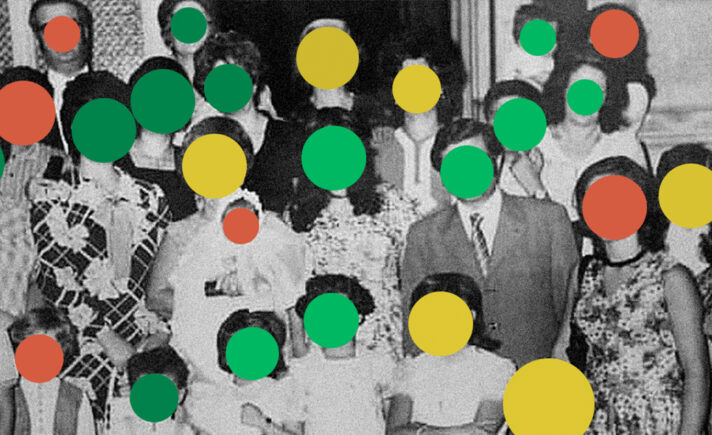كانت سيارته الفارهة هي مخدعنا المتحرك، يقودها بسرعة معتدلة، وأحياناً «يتصبيَن» ويُسرع. أصابتنا الحتمية التاريخية وانفجرت البلاد، فحملت هذه السيارة كثيراً من المعونات الغذائية وفرشات النوم ومواد التنظيف والشوادر لنازحي درعا وحمص في البداية، والنازحين الحلبيين بعد عام ونيّف. تسللت هذه السيارة إلى كثيرٍ من أزقة المناطق التعبة، في حلب «الشرقية» قبل الانقسام الحربي، اختارت السيارة كرم الجزماتي وكرم ميّسر وصلاح الدين والقاطرجي وغيرها في الصباح، وفي المساء جالت في أغنى مناطق حلب «مالاً»، المناطق التي لم يكن أهلها يدرون ماذا يحدث في شرقي المدينة. وما بين الصباح والمساء كنا ملتصقين في تلك السيارة، نتبادل الأحاديث والتُرّهات وكلام الصِبية، من أسئلة عن المستقبل وسقوط الأسد «بعد رمضان»، إلى عدد البنات اللواتي غمزن لنا من زميلاتنا في الجامعة، وعدد الضحكات الغزلية التي تبادلناها مع رفيقاتنا في العمل الإغاثي، وبالطبع عن مغامراتنا الجنسية وبوليسيتها.
كان أحياناً يوقف السيارة فجأة في منتصف الشارع ويخفضُ الشباك على عجل، ويقول لي: «شفلي هالـ ط**»، ويقوم بمتابعة أحاديث الصِبية المُسلّعة لجسد الأنثى، ونقوم معاً بالتحديق المقرف ورمي المفردات المليئة بالشهوة بصوت منخفض، علماً أنني كنت أستغرب من مُراهقاتية تصرفات صديقي، الذي تلقّى أفضل التربية في منزله ومدرسته الخاصة وكشّافه، كشاف الطبقة ميسورة الحال. ومع أنني كنتُ باطنياً أستمتع بهذا الخطاب حينها، إلا أنني كنتُ أقول له أحياناً إننا نؤذي النساء وإننا كبرنا على هذه التصرفات، نحن شباب الثورة السورية اليوم. لم يكن يبلغ عمري عشرين عاماً وقتها، يكبرني صديقي بثلثي عقد ما شعرتُ يوماً بوجودها.
إنه صديقي المسيحي، من المسيح وليس من المسيحية، من ميسوري الحال، ليس من وفرة المال ولكن من وفرة القيم والرِقّة، تعرفتُ عليه قبل بدء الثورة السورية بقليل، عن طريق أصدقاء مشتركين من الكنيسة والكشّاف، الذي هو غطاء السوريين المسيحيين الذين يستطيعون من خلاله التجمع. جذبتني إليه دهشته لجميع الأمور، وحبه للمعرفة وسخريته من نفسه على أتفه الأشياء، ولا أخفيكم/نّ سراً أنه وسيمٌ جداً، فمن مصلحتي أن أُصادقه كي تنجذب إليَّ النساء عن طريقه، فهو سهل المعشر، ولديه ابتسامة ساحرة، وكريم.
عندما بدأت انتفاضتنا كسوريين، انزاح العديد من أصدقاء الكنيسة عن خُطاها، لكن لحسن الحظ، أو لحسن الضمير، أن صديقي لم يكن من المنزاحين، وأنا بدوري لم أكن منهم أيضاً، كُنّا مليئين بالطاقة والحماس، (على عكس كسلنا وخذلاننا اليوم). جذبتنا الثورة كما الكحوليّ إلى الحانة أو كما المصلي إلى القِبلة، خسرنا كثيراً من الأصدقاء الذين لم يشاركونا الحلم نفسه. لستُ هنا بصدد تحليل الأسباب، أو كسب صكوك اعتراف كينونة ثورية للأقلية الثانية في الترتيب، التي دعمت الوحشية في غالبيتها.
قبل تلك الأيام بقليل، أقصد أيام انتفاضتنا، اعتدنا الذهاب إلى معمل صديقنا المشترك في الشيخ نجار، الذي كان من المفترض أن يكون مرشداً ومرافقاً لنا في الأمور الدينية لثقافته الواسعة وإلمامه ودراسته للّاهوت، ولكن بما أن «النجار بابو مخلوع» فقد تلقينا التشكيك والشكّ منه، عن طريق سجالات وحوارات وإمكانية نقد وانتقاد أشدّ النصوص دينية مركزية، وأكثر الصخور ثباتاً في الإيمان وفي أي كتابٍ سماوي. رُحنا نكسر الثوابت الواحد تلو الآخر، برصانة وحزم عاليين، وبالطبع كنا نتشارك مشاكلنا عن العلاقات مع الأنثى والمجتمع ككل، منطلقين تارة من فرويد وماركس ونصر حامد أبو زيد، وطوراً من جون بول اليسوعي وهنري بولاد على سبيل المثال، مروراً بالتوراة والإنجيل والقرآن.
أمضينا الساعات نسمع أحدنا الآخر، نتشارك مشاكلنا مع أهلنا وتشبيحهم اللفظي والبطريركي علينا، وتصغيرهم لنا بسبب تأييدنا للثورة. لقد تشاجرنا مع أهالينا بشكل شرس، ومع أقرب الأصدقاء حتى، لم تَخلُ تلك الأحاديث من مشاركة أحدنا الآخر خبراته في الفراش والجنس والفحولة، من عشقنا لجسد الأنثى وهيامنا بتعرجاته، وبالمقابل عن قدسيته ومحرماته، عن عدد الرعشات التي أذهلنا بها الفتيات التي كنا نشاركهنّ الحب.
للصراحة، لم تكن لدي تجربة حقيقية وقتها، كنت فقط أتخيل وأتكلم، كنتُ أشعرُ بالخجل من نفسي ومن الغيرة الشديدة من صَديقَيّ مُحترفَيّ الجنس!، ولربما أنت كقارىء/ة تفعل كذلك أحياناً.
كان صديقي «السكّرة» (كما نُلقِّبه اليوم) يعشق الغزل والكلام عن الحب وسموه وإضافته المعنى للحياة، لكنني لم أذكر يوماً أنه استفاض في وصف جسد امرأة قال لنا إنه مارس الحب معها. كان يقول لنا القسم المتعلق بالكلام فقط! وكيف غازلها ولاطفها إلى أن أصبحت في فراشه، ولا يغوص في تفاصيل الجِماع ومنعطفاته وما إلى ذلك، كنتُ أظنه يخفي عني أسراره الجنسية كي لا أشاركها مع رفاقنا المشتركين بسبب غيرتي منه.
كان يقرأ آنذاك رواية الحب المحرر للكاتبة الأميركية فرنسين رفيرز، كنت أقول له «حاج لوطنة» من «لوطي»، فالرواية عبارة عن محاكاة قصصية مستوحاة من سفر هوشع، تدور أحداثها بين امرأة زانية وفلّاح صالح لطيف تزوَّج بها، فيها السردية المسيحية المملة المتعلقة بمحبة الله المفتدية غير المشروطة التي تخترق جميع الحدود. كنتُ أصف الرواية بالغبية الخاصة بـ «الطنطات»، وأنا كنتُ آنذاك أبحث بين الكتب عن ما يغذي فحولتي وشرّي واندفاعي، فأقرأ زردشت والطوطم والتابو أو أية قصص بوليسية شقيّة. لم يكن صديقي يشاركني أنماط القراءات نفسها، وكان يصمت أمام سخريتي عليه حينها، ويتهمني بالعنجهية والجحشنة وبأنني أجرحه، كنت أضحك وأستغرب. كم كان محقاً! كم كنتُ جحشاً!
اشتدّت المعارك في أرياف حلب، وأصبحت القذائف تتساقط هنا وهناك، واقتربت لتسقط إلى جوارنا في عدة مناسبات حزينة. كنا ننتهي من العمل في مدارس النازحين، أقصد مراكز إيواء النازحين، حيث كان صديقي منسّق مدرسة/مأوى بشارة الخوري، وأنا كنتُ متطوعاً صغيراً أقوم بما ملكت يُمناي من أعمال جسدية، متنقلاً ما بين مدرستيّ/مأويَيّ هدى شعراوي ومازن دباغ. كنا ننتهي من أعمال اليوم، ونتمشى في العتم على طرف نهر قويق الواصل ما بين بيتي وبيته، نتبادل الأحاديث والكآبة كعادتنا.
عادةً، كان هناك تجمّعٌ لشباب على الجسر الواصل بين محطة بغداد والعزيزية أمام مطعم قرطبة، كانت مظاهر أولئك الشباب مقزّزة بالنسبة لي، يتبرجون ويضعون المساحيق على وجوههم، ويلبسون الكعوب العالية، والجينزات الضيّقة المشقوقة من الركبة، تفوح منهم عطورٌ غريبة، يعلكون المسّكة، يمسكون أيدي بعضهم بعضاً. كنتُ أخاف منهم وأعبّر لصديقي عن كرهي لهم ولأشكالهم، أولئك (الغييات) الطنطات، الذين لا يملكون أي فحولة، المقرفون. هكذا كانت نظرتي إليهم، وكان صديقي يبتسم لي ويحاول أن تغيير الموضوع، لنعود إلى الحديث في مشاكلنا مع الأسد وذوي اللحى.
غطى رماد «المقتلة» المدينة، فرحل صديقي «السّكرة» مع أهله إلى بيروت، وبقيتُ أنا في حلب حتى أنهيتُ إجازتي الجامعية، تلك «الكرتونة» المرمية اليوم ضمن أحد المصنفات المغبرّة، ثم تبعتُهُ هرباً من العسكرية إلى تلك المدينة المشبّعة بالتناقضات، الحرية والانفتاح وفساد الحكام وتبعات اتفاق الطائف، خطابات التعددية والتنوع المكبوت، الفنون بأنواعها والمتسولون وأوجاعهم، المراقص ودور العبادة، المنظمات التي تعنى بالسوريين وبنيوية الإذلال تجاههم، وسؤال المخيمات ما بين الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين «المعتّرين»، الذين لا يستطيعون تحمل نفقات العيش في لبنانهم.
شاءت الصدف أن نعود ونعمل أنا وصديقي السكّرة في المنظمة الإغاثية ذاتها، كان أحد مخيمات اللاجئين ذا التاريخ الطويل من الألم أهمّ مراكز عملها. شغلَ صديقي منصب مدير أحد مشاريع المركز يومها، وعملتُ أنا مع الفريق المعني بمشاريع القسم الجنوبي من سوريا، فقد كنا نقوم بتطبيق مشاريع إغاثية وتنموية، نديرها وننظمها «عن بعد» في معظم المناطق المحررة هناك، والتي تم مسحها بالطيران والكيماوي اليوم. وبالطبع كان فريقي يتخفى تحت عدة أسماء وهمية، حتى على العاملين معنا في المنظمة نفسها، كان زملائي يحسبوننا فريق التواصل أو فريق الترجمة أو حتى فريق تصليح المكيّفات، المهم أنني كنتُ أدلّع صديقي بطريقة تشبه تدليع الأطفال الصغار، لا أعلم لماذا، لربما بسبب دماثته ورقته (وربما لأنني متنمر، ووضيع بالفطرة). ولسوء الحظ، اعتاد جميع من في المركز من موظفين ومتطوعين على مناداته بلقبه الفظّ خاصتي، مما سبب تقليل احترامه في أغلب الأحيان، ومع ذلك كان يتغاضى عن هذا «الخراء» تحت شعاريّ الصداقة والموانة. كان جميع من في المركز يعتبرونه أباهم الروحي، ويحكون له مشاكلهم في العمل والمنزل، لما لديه من قدرة عالية على الاستماع والتعاطف مع الآخرين.
في أغلب الأحيان، كنا ننهي عملنا حوالي الساعة السادسة أو السابعة مساءً، لأن فريقي متأخر دائماً في عمله جرّاء تغيير الأوضاع الإنسانية المأساوية في الجنوب السوري حينها، وصديقي السكّرة أيضاً يبقى لساعات طوال في مكتبه، يسمع زملاءنا ومشاكلهم التي لا تنتهي، يصرخ من الطابق الثاني عبر «المنور» عليّ أنا الذي كان مكتبي في السطوح، ويقول لي «حرّك طيزك»، أنزلُ إليه وقد احترقت من شمس الصيف أو عفنت من رطوبة الشتاء بحسب الفصل. نمشي في المخيم الطيني، نتلقى نظرات بائعي الخضروات والمخدرات بحنية وخشوع، يصطحبني بسيارته إلى منزله في مار الياس وتستقبلني عائلته التي هي عائلتي في بيروت أحرّ استقبال، تركض والدته لتحضّرَ لنا أشهى المأكولات الحلبية التي هي هويتنا الجامعة التي ننقلها من بلد لآخر، نتبادل أحاديثنا المناطقية عن تفوق مطبخنا الحلبي عن سائر المطابخ السورية أو الشرق أوسطية وحتى العالمية (من أقنعنا بتلك السردية الشوفينية؟!)، نأكل بشراهة سوية، ونتبادل الضحكات وذكريات «أيام العز» في حلب؛ أهل صديقي يقفون وضوحاً مع «النظام» سعيد الحظ، وأنا معي شهادة في فقه التشبيح العائلي المتماسك.
ننهي وجبات الطعام التي تُدمَجُ ضاغطة الفطور والغذاء والعشاء في ساعتين مضغيتين متواصلتين، ومن ثم يذهب صديقي لتفقد وإرسال بعض الإيميلات التي لم ينته منها بعد، وأنا بدوري أذهب «مُرغماً» إلى شرفة المنزل العالية مع والدته لتدخين الأركيلة واحتساء الشاي الأخضر من دون سكر، لنهضم جرائمنا الطعامية.
تبدأ «والدتي» بتوجيه الابتسامات المشبوهة لي، فأبادلها إياها، وتقول لي: «إش أخبار ابني، حكيلي، أنت بتعرفو أكتر مني»، أفهم أنها تسألني عن وجود فتاة في حياته؛ عموماً صديقي يحب إخفاء علاقاته مع النساء، لم أكن أعلم لماذا حينها، فأنا صديقه الأقرب، ومع ذلك لم يكن يشاركني إلا بقصصه الجنسية معهنّ. أحاول التهرب من الجواب الذي لا أملكه كاملاً، تأخذ والدته «مجّة» طويلة من الأركيلة وتنفخ الدخان في السماء وتقول: «أنت أصغر منو، والبنات “الحلبيات المسيحيات” يلي بعمرك مناسبين كتير الو، حلمي إني أفرح فيه وأشوف ولادو، وهوة متييس ما بدو علاقة، متل الحيط راسو، قال بكير ومافي حدا مستاهل، محروق قلبنا عليه أنا وأبوه، وعدني أنك تدفشو يعملّو حركة…». أسهو في الشمس التي أنصتت إلى حديثنا وهي تحني رأسها في البحر خجلة، أؤكدُ لوالدتنا أنني سأبذل قصارى جهدي في أن أُعرّفه على «بنات الحلال» الجميلات من صديقاتي الكثيرات.
يأتي صديقي بعد إنهاء عمله أو تأجيله لليوم التالي، نصمت أنا وأمه ونقلب الحديث كالمعتاد حول حلم العودة إلى حلب وانتهاء الحرب، يرمقنا صديقي شذراً فهو لا يعرف «الكولكة»، يعلم أننا نتكلم عن مستقبله العاطفي، يرقص جهازه الخليوي أمامي على طاولة البلاستيك الخضراء، أمازحه بأن ألتقطه لأرى من هي الصبية سعيدة الحظ، فينتشله من يدي بقوة ويقول «التهي بشغلتك».
للأمانة، شاركني صديقي قصة عاطفية واحدة بالتفصيل، أقامها مع فتاة أميركية حسناء بيضاء، ذات شعر بني مسدول، وصدر صلب مكوَّر، تعرّفَ عليها في مخيم للاجئين على الحدود السورية، أُغرِم بهذه الفتاة لشدة دعمها للثورة السورية، وإنسانيتها التي تمثلت في التطوع في المخيمات، لكنه لم يكن سعيداً في هذه العلاقة أبداً بسبب فرق اللغة والخلفية الاجتماعية/الثقافية بينه وبينها، على الرغم من حبه الشديد لها، وتضحيتها بالقدوم من وإلى أميركا لرؤيته في بيروت. كان يؤكد لي أن أمه لن توافق عليها، لأنها ليست «بنت أصول» مسيحية من حلب، ويطلب مني مترجّياً ألا أخبر أمه عنها على الرغم من نقّها عليّ، وكنتُ بدوري أشجّعه بالاستمرار مع تلك الفتاة الأميركية على الرغم من جميع الفوارق.
عندما يسعفنا القدر للزحف إلى يوم السبت بعد عناء الأسبوع البيروتي والكوارث السورية، نخطط للذهاب إلى البحر، نحن أصدقاء العمل الحلبيون والحمصيون والدمشقيون واليبروديون والمنبجيون والخببيون والهولنديون والبيروتيون والبقاعيون وعرب الثمانية وأربعينيون… إلخ؛ نتفّقُ بعد عدة سجالات في مجموعات الواتساب، وبعد التحايل على الانقسامات الشللية، على موقع الشاطئ الذي سنذهب إليه وعلى الأشخاص والمأكولات ومُذهبات العقل التي سنأخذها معنا. نتجمع في «الدوّرة» عموماً، وننطلق في سيارتين أو ثلاث، نقف عند أبو عرب لنشتري المناقيش ومن ثم نتابع وجهتنا، ونحن في تلاصقنا العددي في السيارة، وبسبب زحام أوتوستراد لبنان يتسنى لنا فتح مختلف المواضيع، ومن أكثرها جدلية حينها، غير السياسية بالمبدأ، كانت المثلية الجنسية.
كانت الشلّة مقسومة حينها لمن هو من متقبّليّ ومحترميّ المثلية الجنسية، ومن كان يأخذ وضعية (الصامت الرنان)، أي لا يشارك، أما أنا فقد كنت حينها من أشرس الكارهين لمفهوم المثلية و«قرفها».
كنتُ أطعن أفكارهم عن تقبل الآخر والحريات ببعض قراءاتي المنقوصة للفيلسوف إيمانويل كانط، فقد كنت أتبنى وجهة نظره المثالية، إذ حرّرَ هذا الفيلسوف السلوكَ الأخلاقي من قيود الميول والأهواء، ولهذا استبعد اللذة والمنفعة كغايات قصوى لأفعال الإنسان الإرادية، إذ جعل الباعث يقوم في الإرادة نفسها، وبذلك ارتدت عنده الأخلاقية إلى مبدأ الواجب. الواجبات والأفعال تُقاس في مذهبه بأننا إذا عمّمناها، وأدّت إلى خير عام، على مستوى البشرية جمعاء، فالواجب والفعل مُلزِم، أما إذا كان الواجب والفعل لا يسببان نفعاً عاماً، فهما مكروهان. وبذلك الفهم المُجتزأ، أخذتُ على عاتقي حينها مهاجمة أي كيان يتبنى المثلية قولاً أو فعلاً، رأياً أو طبيعةً، «عن معرفة أو عن جهل»؛ أُهينه/ا بأنه ضد الطبيعة، وضد استمرارية الحياة وإنجاب الأطفال، وضد مفهوم العائلة وقدسيته، وبأن المثلية مفهوم حداثوي مستورد من الغرب السائل معدوم القيم والأخلاق، منتوجٌ رأسماليٌ له انعكاسات اقتصادية، لا بل إنه موضة كما اللباس، وإنه شذوذ في شذوذ، ويدمّر المجتمعات.
أشعرُ بضيق في التنفس عندما أكتب هذه الكلمات، وأتذكر كيف كان صديقي في الثورة والمصير يقود السيارة وهو صامتٌ تماماً يسمع شجاراتنا بهدوء، دون أن يتدخل، يتيح المجال ليسمع جدالاتنا إلى أن نصل إلى البحر، فتشفينا جميعاً رحابة صدره الزرقاء التي تتعلم الرحابة من صدر صديقي.
وهنا لا بدّ من أن أقتبس من نص أنا الشاذ للكاتب الشجاع رئيف الشلبي، الذي أعتبره أفضل وأعمق نص كُتب باللغة العربية عن الموضوع: «يعتقد الأكثر بلاهة من كارهي المثليين والمثليات، ممن يتبدى امتيازهم الغيري بشكل أساسي في عدم اضطرارهم للتفكير في القضية كثيراً قبل النطق بأحكام نازية، يعتقدون أننا أتينا من العدم، ليس لنا أهلٌ نحبهم ونخاف عليهم، ولا مجتمع هو مجتمعهم نفسه تشرّبنا بوعي وبدون وعي كثيراً من قيمه وأفكاره، ولا تاريخ متنوعاً بالغ القدم، ولا نحن منقسمون كجميع البشر بين أغنياء وفقراء ورجال ونساء ومتعولمين ومحليين ومتدينين وملحدين وجذريين جريئين ومحافظين خجلين: نحن كتلةٌ واحدة، صرعةٌ طارئة، أضحوكةٌ عابرة، شياطينُ لقطاء «قرّرنا» أن نعبّرَ عن شهواتنا الجنسية بشكل يتعارض مع الله و«الطبيعة» والمجتمع لغاية شريرة في أنفسنا».
كم كنتُ من «الأكثر بلاهة» حينها.
ركلتني بيروت إلى خارجها، رمتني الصدفة والقليل من الحظ في القارة العجوز، رحتُ أتدحرجُ وأحاول التأقلم مع الفردانية والعزلة وتعلّم لغات جديدة، بالإضافة للتعود على المطر الذي لا يتوقف. بدأتُ دراسة الجامعة منذ البداية أيضاً، مَلِكُ البدايات أنا، (وربما أنتَ أيضاً)، السوريون/ات في حالة بداية على طول الوقت. عاد سرطانٌ قديمٌ منذ البداية أيضاً، لكني في هذه العودة كنت وحيداً لا شريك لي (كما الله)، فلا أهلٌ يدرون ولا أصدقاءٌ يشاركونني الهزل (إلا على الهاتف أحياناً). أقمتُ في السكن الجامعي خاصتي، أذهب وأعود إلى المشفى، و«أتسبّب» كما نقول في اللهجة الحلبية، أي أقوم بما يُطلب مني من عمليات وعلاجات إشعاعية وكيماوية و«سفّ» الأدوية والعقاقير. كان جاري في السكن الجامعي، شاب حقوقي مجتهد، ولم أتأخر في اكتشاف مثليته، عن طريق غزله بشاب وسيم كان معنا في السكن، ولم يتوان هو عن مدّ يد العون لي، والذهاب من وإلى المشفى معي، وإحضار بعض الأطعمة لي، عندما تكون حركتي صعبة. على الرغم من أنه صارحني لاحقاً بخوفه السابق من رفضي له كونه مثلي، وكوني شرق أوسطيّ.
أصبحنا نتشارك وجبات الغذاء والعشاء في مطعم الجامعة سوية، تطلّبَ مني الموضوع ترك ما ورثته من صور نمطية وقبول وجود ما لست معتاداً عليه ضمن حيّزي الوجودي، والتفاعل معه على أساس البساطة والمساواة. للصراحة، لم أتقبّله بسرعة في البداية، لكن العيش المشترك انتصر على رُهابي بسهولة، ذلك أن تخطي الرهاب كما تخطي العنصرية، يحتاج إلى كفاح يومي، وليس كما حبة الدواء لمرة واحدة أو إثنتين ويشفى المرء.
فتح صديقي الأجنبي عينيّ على عوالم لم تكن لدي أية وسائل للتعرف عليها، تقدمت علاقتي معه بسرعة رهيبة، وأصبح يشاركني قصصه العاطفية والجنسية مع حبيبه، وأصبحتُ أعتاد على مشاركته أيضاً قصصي العاطفية و«النوستالجيا السورية». كان على علم ودراية بالمحرقة السورية، يندد بالخذلان الأوروبي والعالمي تجاه السوريين، ويقول إنه يجب إعادة دراسة حقوق الإنسان من جديد، ويعبّر عن كرهه لليمين الشعبوي الصاعد في أوروبا الغربية. جمعتنا كثيرٌ من الأفكار والهوايات المشتركة، وأصبحنا في وقت قصير من أقرب الأصدقاء، رغم أنف الهوموفوب الذي كان سابقاً في داخلي، ورغم استغراب أغلب شباب السكن الجامعي عن علاقة الشاب السوري فاقد الشعر (بسبب الكيماوي) مع المثلي. لا أخفيكنّ/م بأن صديقي هذا يعاني الأمرين من مثليته، على الصعيدين المجتمعي والعائلي، حتى بالرغم من جنسيته الأوروبية، فأهله يقومون بتنظيم «قدّاس» له في مطلع كل شهر، يوم الأحد، على نية تغيير ميوله وإصلاحه وعودته سليماً معافى. لقد شاركني بكاءه وقهره طويلاً، فهو من المؤمنين بالمسيحية بشكل مُرهِق لي، وأهله ومجتمعه يكفرّونه ويصلون على نية شفائه! ساعدتُهُ على ترجمة مقالة كتبها بلغة بلده إلى الإنكليزية، لكي تُنشر في أحد المجلات ذات التوجه المسيحي. تتكلم المقالة عن عدم التعارض بين المثلية واللاهوت المسيحي المتحرر اليوم، وعن تجربته كمسيحي مؤمن ومثليّ في الوقت ذاته، لكنه لم ينشرها خوفاً من الفضيحة التي قد تصيب عائلته «الداعشية» المسيحية.

شاركتُ قصصي معه، السعيدة منها والحزينة، مع أغلب أصدقائي السوريين (المنفتحين) المشتتين في أصقاع المعمورة، وخاصة صديقاتي الفتيات اللواتي كُنّ أكثر انفتاحاً وتقبّلاً للمثلية من أصدقائي الذكور، لا أعلم لماذا. وهنّ الصديقات أنفسهنّ اللواتي كنتُ أتشاجر معهن سابقاً عن الموضوع؛ عبرّتُ لهنَّ مندهشاً عن مدى «طبيعية» العلاقة معه، ومدى فهمه لي على الرغم من «جنسانيته» وجنسيته المختلفتين عني، ورحتُ أعتذر منهنَّ على رجعيتي السابقة.
لم ينقطع التواصل بيننا أنا وصديقي «السكّرة» أبداً، بعد أن طردتنا بيروت، على الرغم من سكننا في مدينتين أوروبيتين مختلفتين، تاريخاً وفرقَ توقيت، فكُنّا على الأقل نجري اتصالين في كل أسبوع نتبادل فيهما ألم الغُربة، وذكرياتنا الجميلة في حلب وفي بيروت، وقصصه الجنسية مع حسناوات أوروبا الشرقيات منهنّ، وشوقي الكياني لحبيبتي السمراء التي كانت ما تزال العلاقة عن بعد معها تتحكم فيَّ حينها.
في يوم من الأيام غير المميزة إلا بسوء الطقس المعتاد، أرسل لي رسالة جدّية الصيغة يقول فيها: «بدي أحكي معك بكرا ساعة 2 بتوقيتك فيديو كول»، رددتُ له مُمازحاً: «من ايمتا مناخد مواعيد من بعض طيزي»، ردّ: «ما عم أمزح»، رددتُ ممتعضاً: «اتفقنا».
استيقظت صباح اليوم التالي وأنا أقوم بفحص ضمير معّمق عن ما هو الشيء الذي قد اقترفته لصديقي، ولما كل هذه الجدّية. المهم، اتصل بي في الساعة الثانية تماماً، بدأ حديثه بشكلٍ مضطرب ورسمي، يسألني عن الطقس وعما أكلتُهُ في الصباح. امتلأتُ بالتوتر جرّاء طريقته في الكلام، فنحن بالعادة نباشر المزاح والشتائم من بداية اتصالاتنا الهاتفية، فصرختُ في وجهه وقلت له أفصح عما لديك، ردّ بنبرة ترتجف وصوت قاسٍ، وهو يضع عينيه في منتصف الشاشة: «أنا غيّ إي غيّ»، وانفجر بالبكاء.
تفاجأت بشكل لا يوصف، شعرتُ بالبرودة والسخونة في آن واحد، أصبحتُ كما الصنم أحدّقُ في الشاشة، ضربني ألمٌ وجودي لا تسعه لغتي التي استعملها هنا، ألمٌ مليءٌ بالقهر على علاقتنا التي كانت من طرف واحدٍ هو طرفي أنا فقط، وأغلب ما كان من طرفه هو محضُ كذبٍ وتحايل. شعوري كان الغضب أولاً، حتى لو أنني كلّيّ المعرفة بعدم أحقيتي بهذا الغضب الآن. كان يبكي، كان صوت دمعه عالياً في سماعة الأذنين وفي قلبي، ثَبُتت عيناي في النافذة المفتوحة للمطر أمامي، لا أعلم ماذا أقول.
أكملَ وبدأ يذكرني بتحجّري وعنجهيتي وقسوتي وحقدي تجاه المثلية في كل مناسبة يتم فيها ذكر الموضوع، وتجاه ما كان هو عليه طيلة حياته، وبأنه أحبني جداً منذ أن التقينا أول مرة في معمل صديقنا في الشيخ نجار، الذي كان يعلم كل شيء عنه، أحبّني على الرغم من كرهي لحقيقته التي كنت أجهلها على طول علاقتنا. فضّلَ أن يكسبني كصديق لا يعرف حقيقته، على أن يخسرني كصديق كامل المعرفة بحقيقته. ومن ثم تابع بأنه كان يظن أنني من المستحيل أن أتغير، لولا شهادة صديقتينا المشتركتين المتكررة بأنني تغيرت، وأصبح شابٌّ مثليٌّ من أعز أصدقاء غربتي، فاقتنع بدوره وقرَّرَ الإفصاح لي عن ما أخفى لمدة عقد كانت سنواته مكثّفة بشكلٍ أكبر من تاريخ بحاله لنا نحن السوريين.
أغلقنا الهاتف بعد أن اعتذرتُ له عن ما مضى من بؤس قد سبّبته له، ووعدتُهُ بألّا يأخذ اعتذاري على محمل الجد حتى نعيد تكوين صداقتنا من جديد بشكل صريح وحقيقي. أغلقنا المكالمة تحت شعار انتهاء البطارية خاصة هاتفي الأخرق، وشكرتُ ربي لانتهائها، لأنني احتجتُ إلى الصمت لتقبّل عقدٍ كاملٍ من الكذب من طرفه، والألم المُسبَّب من طرفي.
رحتُ أتذكّرُ الحوادث حادثةً حادثةً، أتذكر رحلاتنا بسيارته و«تلطيشه» للنساء للتمويه، وأحاديثه الجنسية والعاطفية المفبركة، أتذكّرُ تهجمي على المثليين المنبوذين المتألمين الذين أقصاهم المجتمع وأقصيتهم خطابياً بدوري، الذين كانوا يتجمعون على جسر محطّة بغداد، وكان صديقي يمشي بقربي حينها. تذكرتُ علاقته المسمومة مع مجتمعنا وعائلته وأمه وأبيه، المبنية على الوهم ووعود الزواج وإنجاب الأطفال؛ تذكرتُ عدد المرّات التي قلت له فيها أمام والدته: «بدنا نفرح فيك مع شي بنت حلوة»، ونظرته العابسة تجاهي؛ تذكرتُ خوفه الجنوني من رؤيتي لرسائله الخاصة، وأحاديثي في سيارته عن كرهي للمثليين وحججي الخرقاء المدعمة ببعض قراءاتي الفلسفية. تذكرتُ قصة عشقه للفتاة الأميركية التي هي شابٌّ أميركي في الواقع، وعن كل لفظٍ مهين تجاه المثليين/ات استعملته في حضرته. لم تكن جدران غرفتي الصغيرة قادرة على استيعاب اتساع حزني، بكيتُ بحرقة واتصلتُ بصديقتي ذات الغمازتين، وعاتبتها بألم، وتفهمتُ بعد وقت طويل مدى حساسية الموضوع بالنسبة لصديقي، ومدى الهوموفوب الذي كُنته.
لستُ بصدد توزيع أدوار الضحايا على «المثليين/ات»، أو أدوار الشياطين على «الغيريين/ات»، كما أنني لست متخصصاً وليست لدي النية لخوض غمار البحث عن أجوبة لأسئلة «لماذا» و«كيف» حول المثلية، ولم يعد يهمني للصراحة، ما تعلّمته من تجربتي القاسية هذه، كان فقط بالعيش والخبرة الشخصية، لا أكثر ولا أقلّ. ببساطة، أيقنتُ أن البشر لديهم مطلق الحرية في ميولهم وأجسادهم، وأن ما اعتدتُ عليه ليس بالضرورة هو الوحيد أو «الطبيعي»، وأن «الرهاب» ذا أصل واحد على اختلاف تسمياته، رهاب مسلمين، رهاب مهاجرين، رهاب السود، رهاب مثليين، وأن المثلية لا تتعلق فقط بممارسة الجنس بين أشخاص يحملون الأعضاء الجنسية ذاتها، لا بل تتعلق بعشق وكينونة وهوية وانجذاب، علاقة عاطفية وجسدية متكاملة.
صديقي اليوم في علاقة حب مع شاب مصري، جرّاح أطفال، مسلم بالهوية، متعدد الهوايات، يشاركني اليوم أغلب تفاصيلها، وأتعلم منها الحب والاحترام والحميمية والتفاهم، ولو كانت هذه العلاقة محكومة بالسر والتخفي عن عائلته ومجتمعنا المتصلبين.
اليوم أنا وصديقي «السكًرة» من أقرب الأرواح لبعضنا بعضاً، سامَحَني على الرغم من كل الأذى الذي سبّبته له، وسامحتُهُ عن إتقانه لدوره الكاذب «كغَيريّ»، وتمثيله عليَّ لمدة تقارب العقد من الزمن. أصبحنا أكثر قرباً، وأنا أجزم أنه يذرف دمعةً أو اثنتين وهو يقرأ النص الآن. أنا الآن أطلب منه على الملأ الصفح والغفران عن الهوموفوب الذي كُنتُه، والذي لن أكونه مجدداً. بحبك صديقي السكّرة.