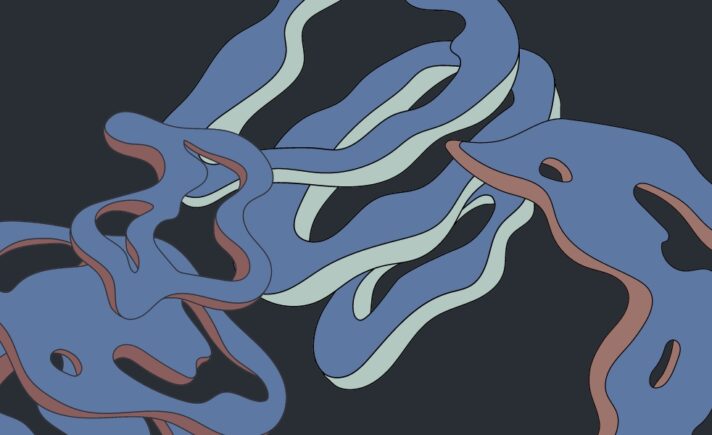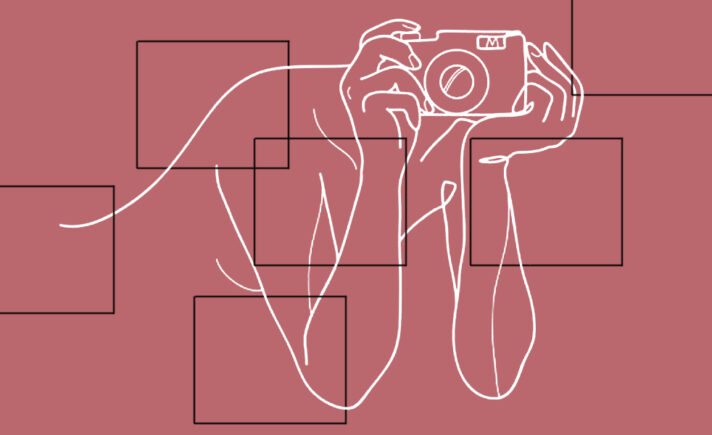لم نكتب الخبر، لم يكتب أحدٌ خبر إعدام هدى عام 2014 على يد جبهة النصرة، حتى أنّ أهلها قد هُدِّدوا بعد مقتلها فيما لو أشاعوا الخبر. يسألني صديقٌ بالصدفة: «أتعرفين هدى؟»، فأقول: «نعم، وأحاول الوصول إليها منذ فترة»، ليُعلِمَني بأنها «قد أُعدمت بعد عودتها من المشاركة في تدريبٍ مع مؤسستكم (شبكة الصحفيات السوريات)». عدت مسرعةً حينها إلى بيت صديقتي في غازي عنتاب التركية، وجلستُ على الأرض مُبتلعةً رأسي بين يدي، وغبتُ لدقائق. حاولتُ إدارة غضبي؛ يأسي وخيبة أملي؛ صدمتي، وأنا أفكّر فقط في لحظاتها الأخيرة.
أحاول كتابة هذه النص وأنا معلّقةٌ في السماء، في الطائرة عائدةً من لبنان بعد رحلة عمل، وكأنه أمر لا يحتمل الانتظار. أصبح الإلحاح والحالة الطارئة نمطاً للحياة، ولكنني لا أريد أن أنسى أيضاً، خاصةً أن النسيان قد صار عادةً أو ربما آلية دفاعٍ منذ سنوات نتيجة تتالي الخيبات والفقدان، أو ربما لذكرى هدى؛ تلك الآلية التي أتشارك فيها مع العديد من المُدافِعات اللواتي تجمعني بهنّ علاقةٌ شخصيةٌ ومهنية، نتشارك أوجاعنا الجسدية التي أصبحت في طورها الأخير سريريةً، بعد سنواتٍ من تجاهل الضغط النفسي الذي واجهته معظمهنّ نتيجة نشاطهنّ ووجودهنّ في الشأن السياسي العام.
تواجه المُدافِعات عن حقوق الإنسان، وخاصةً النِسويات والمدافِعات عن حقوق النساء والعدالة الجندريّة، تحدياتٍ كثيرةً ومستمرةً نتيجة تصاعد التوتر السياسي والأمني في سوريا ودول الجوار. ويأخذ الصراع مع السلطات القائمة في سوريا اليوم مظاهر متعددة في كل منطقة، وتشتد حدة هذه المظاهر بالنسبة للمدافعات لكونهنّ نساءً. أصبح السفر من منطقةٍ لأُخرى داخل سوريا وبين دول الجوار صعباً على نحوٍ متزايدٍ وشبه مستحيل.
تربطني وميساء علاقةٌ بدأت منذ عدة سنوات، منذ نزحتْ من حلب إلى الأتارب. عرفت ميساء كصحفيةٍ مصورة ومدافعةٍ شجاعة عن ما تسميه «قضايا حساسة»؛ كزواج الطفلات وزواج السوريات من المهاجرين؛ «المقاتلين متعددي الجنسيات الذين جاؤوا إلى سوريا نصرةً للإسلام». انشغلت ميساء في السنوات الأخيرة بقضية «أين النسب؟»، ونتيجةً لذلك واجهت مضايقاتٍ من جبهة النصرة، تطورت إلى درجة خطف شخصين كانت قد عملت معهما على ذلك الموضوع، ولحسن الحظ تمكن أحدهما من تنبيهها مبكراً عبر إرسال رسالةٍ مفادها؛ «عليك الاختفاء لأن الجبهة إن أمسكت بك سيكون حكمك الإعدام حتماً». هربت ميساء في شتاء 2018 من الأتارب، تاركةً خلفها كل حياتها، لتسيطر الجبهة على منزلها وجميع مقتنياتها.
أول تهمةٍ وُجِّهت لها هي «أنّها علمانيةٌ تعلّم النساء على الفلتان، وتشجّعهنّ على الخروج من المنزل»؛ أي الخروج عن طاعة ولي الأمر. وكان ذلك نتيجة نشاطها السياسي في الضغط نحو مزيدٍ من تمثيل النساء محلياً. وجرى الاعتداء مرتين على المركز الذي أسسته لذلك الغرض من خلال تكسيره وسرقة مقتنياته. تقول ميساء: «الأمور تخرج عن طاقتنا، ربما لعدم وجود جهةٍ على الأرض نحتمي بها؛ لربما وجود بطاقةٍ ما قد يحمي من الاعتقال، ولكنه لن يحمي من الاختطاف أو الاغتيال، أو حتى المساومة على الكرامة كامرأة».
جرى في السنوات الأخيرة، وبشكلٍ ممنهجٍ، تقليص حرية التواجد في الأماكن العامة وفرض حظر السفر، ولاحقاً إغلاق الحدود كلياً، كما استُخدمت القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، دون مساءلة، من قبل النظام السوري في استهداف المجتمع المدني والمدافعات، وهنالك أيضاً التهديدات التي يتلقينها من كلّ من يستشعر في نفسه القوة؛ كالتوعد بتعريضهنّ لأذىً جسديٍّ وجنسيٍّ بسبب نشاطهن وعملن في الدفاع عن حقوق والمساواة، أو بسبب تعبيرهنّ عن آرائهن حول القضايا العامة؛ خاصةً الجنسية والدينية والإثنية منها.
استمرت ميساء بتلقي تهديداتٍ من جبهة النصرة، تقول «تُهدَّدُ المرأة بالخطف والقتل في مناطق سيطرة الجبهة، وليس لديهم أيُّ مشكلةٍ بتنفيذ ذلك، ورغم أنّ ذلك لم يوقفني، فإنّه بالتأكيد دفعني لترك الأتارب باتجاه عفرين».
في مكانها الجديد تتردّد ميساء بالتصريح عن الجهات التي تهددها وتضايقها، وتختصر ذلك بالقول: «فقط لأنني وقفت في وجه الاعتداءات التي كانت تتعرض لها النساء الكرديّات في المنطقة من قبل الفصائل المسيطرة، دون وجه حق، بدأت التهديدات بضرورة الصمت تتالى». في هذه الظروف الخانقة، تجد ميساء أنها محمية إلى حدٍّ ما لكونها معروفةً بنشاطها وشبكة علاقاتها التي بنتها في السنوات الأخيرة، وتتخذ بعض الإجراءات لتكون آمنة: «لا أخرج أبداً وحدي من البيت، دائماً ما أكون برفقة أحدٍ ما».
طبيعياتٌ في سياقٍ غير طبيعي
الأوجاع التي تُعبّر عنها المُدافِعات لم تعد عادية، ورغم ذلك فهي غير مرئية؛ هي تلك الأوجاع السياسية التي تنال كثيرات ممّن لا زلنَ شاباتٍ أو في منتصف عمرهّن، وقائمة الآلام تطول؛ تبدأ بتوترٍ وغضب، وتتطور لتصبح ألماً في الرأس يَعتدنَ عليه. غالباً ما يُقال: «الأمر ما زال محتملاً»، لكن بعد تجاهله لسنوات، واستمرار الضغوط المالية والنفسية، يبدأ الألم بالتجول في الجسد، وينتقل ليصبح في المعدة وفي الظهر وفي المفاصل، يداهمهنّ ليلاً بكوابيس لا تنتهي، يرافقه ضغطٌ يتمثّل بصرير الأسنان طوال الليل، لا ينعمن بنومٍ كافٍ أو عميقٍ أو هادئ. تقول العديد من المدافِعات اللواتي قابلتُهنّ: «في هذه المرحلة أعي الأمر، لقد أصبح جدياً، ولكن لا نجد الوقت ولا القدرة المالية للعناية بأنفسنا». هنا أفهم أكثر ماذا يعني «أن يكون الشخصي سياسياً»، وأن يكون، حرفياً، موجعاً.
في لبنان، قابلت سهى القادمة من تركيا في زيارة عمل. تعمل سهى كمديرة برامج في مؤسسةٍ تهتم بحقوق النساء والنوع الاجتماعي، ويفرض عليها العمل في الشأن العام نوعاً من القيود التي تُضطرّ، بدورها، لفرضها على نفسها؛ كتفادي أيّ ظهورٍ إعلاميٍّ للحديث عن عملها، وكذلك اقتصار العارفين بطبيعة عملها على محيطها الضيق؛ خوفاً من تهديد عائلتها فقط بسبب عمل ابنتهم في مؤسسة مجتمعٍ مدني، وأيضاً تحاشياً لإثارة السلطات التركية بسبب الوضع الأمني والقانوني، حيث أن مشاركة معلوماتٍ عن العمل قد يكون سبباً للترحيل أو الحجز أو الغرامة، كون سهى لا تملك إذناً للعمل أسوةً بمعظم السوريات والسوريين في تركيا، وهو ما أجده نوعاً من التضييق على المجتمع المدني السوري العامل في تركيا، تزيد من خلاله القدرة على استغلاله وفرض السيطرة عليه، فضلاً عن نوعٍ آخرٍ من التضييق على عمل الأجانب عموماً، ومن ضمنهم السوريون/ات، حيث يُفرض تشغيل عددٍ كبيرٍ من الأتراك، بموجب القانون، مقابل كل عامل/ة أجنبي/ة.

تقول سهى عن ذلك التعب اللامرئي: «في البدايات لم أكن واعيةً للآلام التي أعاني منها في المفاصل، ووجع المعدة والتشنجات، ولاحقاً آلام الرأس. تنبّهتُ لذلك، وارتبط الألم بمستوى التوتر الذي أمر به».
من القضايا التي تولي المُدافِعات لها وقتاً وجهداً كبيرين، قضايا العنف الجنسي، والانخراط في هذا المجال له تبعاته النفسية المعقدة، وبشكلٍ خاص نتيجة الاحتكاك بالناجيات من الاعتقال أو من العنف الجنسي، وقد يُعزى ذلك إلى عدم توفّر الخبرة الكافية في التعامل مع آليات الاستماع وتوثيق شهادات التعذيب، كما أنّ عدم توفر الموارد الكافية وإدراك التأخر الزمني في تلبية احتياجات الناجيات النفسية والاقتصادية في تركيا، يجعل من العمل في هذا المجال صعباً للغاية على الصعيد الشخصي، وفق ما تخبرني به سهى.
تتواصل النساء من سوريا مع المؤسسة التي تعمل فيها سهى ليخبرن بأنهنّ تعرضن لانتهاكاتٍ جنسية، أو اغتصاب في بعض الحالات، ولكن لا يمكنهنّ إعلام أحدٍ بذلك، ولا توجد مصادر أو جهات تساعدهنّ، وبالتالي يكون الحديث معهن والاستماع إليهنّ نوعاً من المساعدة، غير أنّ ذلك يولّدُ عبئاً كبيراً، وهنا يكون ضرورياً البحث عن أي شيءٍ ملموس لإعطاء العمل قيمةً ومعنىً؛ بحيث يكون التواجد من أجلهنّ أمراً كافياً. ولكن، للأسف هذا لا ينفع دائماً، ففي بعض الأحيان أعاني هبوطاً معنوياً كبيراً، وذلك حين لا أجد أثراً ملموساً لما أقوم به، مما يضعني تحت ضغطٍ نفسيٍّ كبير.
عادةً ما تعرفُ المُدافِعات أنفسهنَّ من خلال العمل، ويسمى ذلك في علم النفس الاجتماعي «مرض النشاط» Activism Sickness، ويصنف على أنّه من الأمراض غير المرئية، إذ تهيمن آليات كالعمل والتنفيذ لا التفكير، خاصةً التفكير بماذا وكيف يشعرن. العمل لساعات طويلة، وعادةً لقاء مقابلٍ ماديٍّ أقل من الجهد المبذول بكثير، وتغطية تكاليف مالية من الأموال الخاصة، حتى أن الأمر يصل أحياناً إلى الاحساس بالذنب نتيجة تلقي مقابلٍ مادي على ذلك العمل، ويترتب على ذلك إهدار المال كردّ فعلٍ انتقامي وتطهّري، ثم يأتي عادةً ضغطٌ وإرهاقٌ من أنواع أخرى، وبشكلٍ يتوازى مع ذلك السياق اليومي.
منذ انطلاق الثورة السورية، بدأ النشاط السياسي والمدني يأخذ شكلاً أكثر تنظيماً من خلال منظمات المجتمع المدني، وأغلب المُدافعات منخرطاتٌ في العمل بهذا الشكل. هناك ضغطٌ خاصٌّ تتشاركه أغلب المُدافعات، وخصوصاً القياديات منهنّ في تلك المؤسسات؛ ضغط أن تكون المؤسسات التي يدرنها مستدامةً وذات استراتيجيات لعدة سنوات، وذلك ضمن سياقٍ وسردٍ متغيرٍ كلّ عدة أيام. ويتزامن ذلك مع عدم وجود أي حساسية من الجهات الدولية الداعمة تجاههنَّ أو تجاه غيرهنّ من الأفراد، بما يدفع إلى ضرورة الاعتناء بهنّ جميعاً ويحول دون إغراقهنَّ بالعمل الإداري، في الوقت الذي لا يتمّ فيه توفير موارد مالية كافية ولفترة طويلة من أجل القيام بذلك العمل بشكلٍ مستدام. إنّ الإرهاق غير المرئي بالنسبة للقياديات هنا هو الجهد المبذول بين الاستمرار في العمل وتوفير الدعم المالي والأمان الوظيفي لفِرَقهنّ ومبادراتهنّ، وفي الوقت نفسه الاستجابة للطلبات غير المنتهية من الجهات الدولية الداعمة، والجهوزية الدائمة للسفر والاجتماعات اللامنتهية، ومن ثم مطالبتهنّ بالحفاظ على طاقة إيجابية، والبدء من جديد في اليوم التالي، وتناسي حقهنّ بالرفاه النفسي، أو الراحة على أقلّ تقدير.
لا تكترث ميساء بما يُمكن أن يُقدَّم من الخارج، وتقاومُ واقعها رغم كلّ التناقضات، غير أنّ ذلك يُكلّفها الكثير من أجل أن تبقى صامدةً، وتقول عن ذلك: «أشعر بانفصام في الشخصية أحياناً، وبقدر ما أنا قويةٌ جداً، فإنّ في داخلي رعب. المكان هنا مرعب. يرافق الرعب كلّ حركة؛ رعبٌ من كل شي؛ من الرجال الموجودين، والذين للحظةٍ أتصورهم وحوشاً مفترسةً، وأقل ما يُقال لي: (أنتِ امرأةٌ لا تنفع)، لكنّ هذا التناقض يزيد من إصراري على أن أبقى قويةً ومتماسكة. يجب أن أضع نفسي مكان كل امرأةٍ هنا، بغضّ النظر عن انتمائها وقوميتها، وأن أقوم مقامها».
أسأل نفسي: «هل يستحق ذلك التنبّه، وأن يُفعَلَ شيءٌ حياله؟»؛ بالنظر إلى التاريخ القريب للمُدافعات السوريات، نجد أن كثيرات بدأنَ بالتخطيط للانسحاب، أو قد انسحبنَ بالفعل من العمل في الشأن العام، أو حتى من التفاعل في المجال الإلكتروني. لقد غِبنَ نهائياً عن التعليق أو المشاركة في النقاشات الدائرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك نتيجة هول المشاعر المتضاربة على وسائل التواصل الاجتماعي في الدقيقة الواحدة، وعدم القدرة على الاحتمال والإتيان بردود فعل مقبولة، ففي اللحظة نفسها، وعند النزول إلى أسفل الشاشة، تبدأ الأخبار المتوترة بالتحفيز على البكاء والضحك والغضب والتعاطف. كتابة جملة عزاء هنا، ومباركة بعد ضغطتين للأسفل. كل هذا التناقض، بالإضافة إلى الحملات المضادة التي تُشَنُّ على الناشطات والمُدافِعات نتيجة جرأتهنّ ومناقشتهنّ لأية قضية بشكلٍ علني، وهو ما يجعل من النشاط عبر الإنترنت مرهقاً ومساحةً غير آمنة ومُشتِّتَة للغاية؛ هو معركةٌ خاسرةٌ على حدّ تعبير كثيرات منهن.
تتلقى تمارى (اسم مستعار)، وهي صحفية سورية ومعتقلة سابقة مقيمة في لبنان، تهديداتٍ منذ ثلاث سنوات، تقول: «لقد كان من الغباء مني حذفها جميعها، ولكني كنت خائفةً جداً. تلقيت تهديدات من لواء أبي الفضل العباس في سوريا، عن طريق شابٍّ من حيّها، وعرفها من خلال الفيسبوك. أتت التهديدات بسبب مشاركتها في المظاهرات والتعبير عن تأييدها للثورة، وقد توعّدها الشاب وتوعّد عائلتها وكل الناس الذين تعرفهم، حتى أنه أرسل لها تفاصيل عن حياتها ومكان عملها وإقامتها. مفاد التهديد حينها أنه، وفور وصولها إلى لبنان، سيقوم حزب الله بالإمساك بها». تشرح تمارى كم يرعبها الأمر، خصوصاً أنّ الذي كان يراسلها قد فعل ذلك بصفته مقاتلاً، وله ارتباطٌ بالحزب. تضيف: «أعتقد أنني ما زلتُ مُراقبةً حتى اللحظة».
ما تزال تمارى تتلقى تهديداتٍ عشوائيةٍ على انستغرام حتى اليوم، ورغم قيامها بحجب المُهدِّدين، إلا أنّ بعضهم تمكن من مراسلتها باستخدام رقم هاتفها الخاص، مستغربةً كيفية حصولهم عليه. تأخد الرسائل منحى الشتم والتهديد بالنيل منها، وتعطيني نموذجاً عن تلك الرسائل لأطّلع عليه: «ليش حذفتيني يا شرموطة، بس تنزلي ع بيروت رح ورجيكي قدرك وقيمتك، بما أنك معارضة كنتِ رحتي على إدلب وما جيتي ع لبنان». تقول تمارى: «إن صورة بروفايل الشخص الذي أرسل الرسالة كانت علم حزب الله»، وتضيف أنها عندما كنت تشارك بحملاتٍ لها علاقة بالسلام، كانت تصلها رسائل من نوع «روحي اعملي سلام بإدلب»، رفقة شتائم بذيئة جداً، وتتابع: «مهما كتبتُ أو نشرتُ دائماً ما تصلني رسائل على الخاص تتضمّن الشتائم والتهديدات».
لا تشعر تمارى بالأمان في لبنان، خصوصاً بعد الحملة الأخيرة ضد السوريين/ات. تقول: «لَحمست على راسي»؛ إذ أنها كانت بانتظار دورها في الترحيل نحو الحدود السورية؛ «كنت في حالة رعبٍ دائمة». إنّ وضع لبنان لا يختلف كثيراً عن سوريا كما تقول؛ «خايفة كتير، وهالشي أثّر على شغلي، حتى إني ما بقول وين بشتغل، خاصةً عملي الأخير مع مؤسسة تطوير إعلام نِسوية سورية».
شحذ الهمم الذاتي
بشكلٍ ساخر، تضحك المُدافِعات اللواتي أعرفهنّ (ليس فقط السوريات، بل الجميع)، حين تقال كلمة «عطلة»، فكثيراتٌ منهنّ قد نسين معناها، سواء العطلة الصيفية أو عطل الأعياد أو حتى نهاية الأسبوع، بل يجدن في ذلك فرصةً رائعة للقيام بعملٍ ما في الوقت الذي تكون فيه أغلب المؤسسات الدولية في إجازات، ويبرّرن ذلك لأنفسهن بالقول: «هناك الكثير للقيام به».
تنشغل كثيرات من المُدافِعات بالعمل على حماية حقوق غيرهنّ وأنفسهنّ، حتى أنّهنّ ينسينَ أن يتنفسن، وأن يمارسن بعض الرياضة أو قضاء وقتٍ مع العائلة والأصدقاء. إنهنّ يقبلن بالقليل في سبيل القضايا التي يؤمنَّ بها، ويُعتبر الحديث عن استراتيجياتٍ للوقاية والحماية، أو ربما للتأقلم، رفاهيةً لا تعطيها أغلب المُدافعات أولوية، ولكن حتى الحديث عن ذلك سيكون مكلفاً مالياً إذا تمّ قياس الضرر الواقع سلفاً نتيجة مستوى صدمات والاحتراق المهني والآلام الجسدية التي تحتاج علاجاً طبياً ونفسياً، ولكن يبقى أنّ الأهم هو إيجاد الوقت لذلك، والشجاعة لفتح تلك الآلام من أجل فهمها والتعامل معها.
من وجهة نظري، لا الظروف ولا الموارد ولا السياق السياسي (المحلي والدولي)، ينذرون بخير، أو بأدنى اهتمامٍ بحقوق الإنسان في سوريا. أسأل ميساء: «ما الذي يدفعك للاستمرار؟»، فترسل لي تسجيلاً صوتياً تقول فيه: «إنها المرة الأولى التي أُسأل فيها هذا السؤال، بجد، كثيراً ما أقول لنفسي أني قد تعبت، والله ليس لدي القدرة بعد اليوم، ولكن حين أنظر حولي وأجد أن الأخريات لا زلنَ راغباتٍ في العمل والتعلّم، وهنّ يدعمنني بشكلٍ مستمر، ويصرّحنّ بأنهنّ يقوين بي، فإنّ ذلك يعطيني قوةً ودافعاً للاستمرار»، فأردّ عليها بأنني حين كنت في نيويورك، العام الفائت، وخلال فعاليات الأمم المتحدة الثانية والستين للجنة وضع المرأة، سُئلت ذات السؤال، فأجبت: «هناك ميسا في الأتارب تعمل دون ملل، وهي من تعطيني الدافع حين أعتقد أنّني تعبت من كل هذا النضال».
السياق لا يتغير، بل حتى إنه يتغير للأسوأ، ورغم ذلك لا تزال المُدافِعات منشغلاتٍ ومناضلاتٍ من أجل القضايا التي يؤمنَّ بها، لكنّ ذلك يحتاج للكثير من التحفيز الذاتي واختراع تقنيات تتناسب مع الواقع المعاش، رغم أنّ أغلبهنّ على يقينٍ بأن جلسات علاجٍ نفسي ستساعد دون شك، ولكنها مكلفة وغير متوفرة في أماكن تواجدهنّ، وبالتالي عليهنّ أيضاً التعلم من خلال ممارسة بعض التقنيات بحسب توفّر المصادر والوقت والطاقة لفعل ذلك. تقول سهى: «المشي في الحدائق، كوني أحب الطبيعة، يعطني شعوراً نفسياً مريحاً، ولكنه لحظي. أحاول الخروج من وسط العمل والأخبار المشنجة غالباً، وأتجه للأصدقاء خارج هذا الوسط. أقوم بنشاطاتٍ مختلفةٍ وبعيدةٍ عن وسط عملي، لأنّ ذلك يفتح لي المساحة للتعرف على أناسٍ جُدد، وتعلّم شيءٍ جديد. أحياناً أخرى أفضّل الانعزال في المنزل والقيام بنشاطاتي لوحدي وسماع موسيقاي الخاصة، واعداد الطعام لنفسي وخلق مساحة للجلوس مع نفسي، وفي ذلك يكون الحل. لا أقوم بذلك بشكلٍ منتظم، ولكن حسب الحالة النفسية التي أمرّ بها».
تحاول ميسا، من جهةٍ أخرى، خلق تقنيات دعمٍ ذاتية ضد هجمات الاكتئاب، تقول: «حينها أراجع عملي وعمل الآخرين الذين عملت معهم سابقاً، أسترجع ذكرياتي معهم؛ المكان والتحديات التي عشناها معاً، وأجد أنّ هذه القضية أصبحت جزءاً مني، وكاميرتي أصبحت امتداداً جسدياً لي. العمل على القضايا التي لم تحظى بالتغطية بعد، خاصةً تلك المتعلقة بحقوق النساء، أصبحت هاجساً لدي، لذا أفكر بأنه لا بدّ من العمل. لا يمكنني تجاهل ذلك».
أرى أنّه، أولاً وقبل أيّ شيءٍ آخر، لا بدّ من الاعتراف بوجود وأهمية عمل المُدافِعات عن حقوق الإنسان ووجهات نظرهنّ محلياً ودولياً، وتوفير الموارد لإنشاء شبكات الدعم والمساندة، حيث لا يوجد سوى التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في المنطقة، لأنّ ذلك سيساهم بدوره في الإبقاء على المُدافعات في الميدان، وفي خلق حراكٍ نِسويٍّ أكثر استدامة.
أُنهي كتابة مقالي في وقتٍ متأخرٍ قليلاً في مقهىً في هولندا. أنظر حولي لأجد مجموعةً من البشر البيض يستمتعون بطعام العشاء، يتسامرون بهدوء، أحاول استراق السمع لشخصين بجانبي، لأني أودُّ أن أعرف، بعد أن غصتُ مع ميساء وتمارى وسهى ونفسي في السنوات العشرة الأخيرة من الدفاع عن الحرية والعدالة، كيف يعيش أناسٌ آخرون معنا على الكوكب نفسه بشكلٍ طبيعي، وبعيداً عن كلّ ذلك. أحاول أن أستعيد من خلال استراق السمع بعضاً من الذاكرة؛ لربما أتذكّر عن ماذا يتحدث الناس حين لا يعيشون ما نعيش.