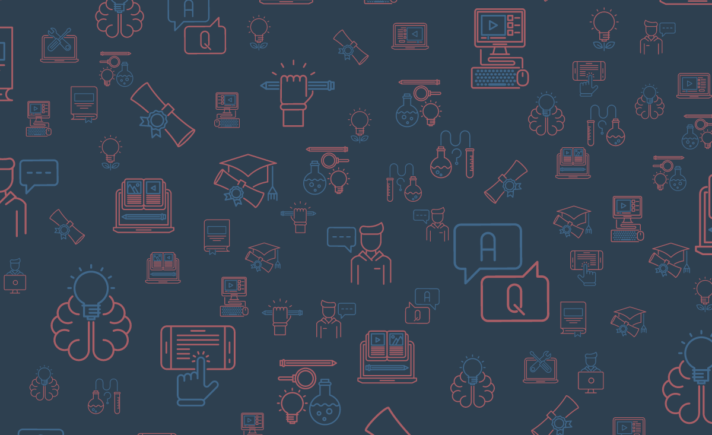لعلّ أكبر خيبات الأمل التي واجهتها في السنوات العشرة الأخيرة على الصعيد السياسي كانت الأزمة السورية، وتداعياتها على التضامنات السياسية النضالية النِسوية في المناطق الناطقة باللغة العربية. أذكر عند بداية الثورة السورية النشوةَ التي شعرت بها معتقدةً أن الحِراكات التحررية في المنطقة ككل ستقضي على الأنظمة القائمة على حماية الكيان الصهيوني. أذكر ذلك الشعور الثوري الذي دفعني إلى الانخراط مع الثوريين/ات الشغوفين/ات بإحداث تغيير أشتاق إليه. كنت أرى انخراطي ذلك نابعاً، لا من شعور بالتضامن، بل من الشعور بالانتماء. كنت أخت الزيتون كما اعتاد رفاقي في النضال مناداتي، وكانوا شعاع الأمل في تحرير فلسطين وكلّ المنطقة من أشباه القيادات الناطقة عربياً والمؤدلجة غربياً. ولم يتبدد الأمل رغم سقوط شعاعات من الأمل غدراً بواسطة أسلحةٍ مصنعة في دول الشمال العالمي، فغالباً ما يولّد الشعور بالفقدان غضباً يُؤجج فينا الرغبة بالتغيير، وغالباً ما تُوَّلِد فينا أرواحُ موتانا ومفقودينا ومفقوداتنا رغباتٍ عارمةً بالسعي نحو العدالة لهم/نّ ولغيرهم/نّ من المظلومين والمظلومات. كنتُ عند بداية تأجُّج الثورات في المنطقة من متابِعات الكرّ والفرّ والحراك المُسلَّح على الأرض، تحديداً في سوريا. وكانت بعض الانتصارات على الأرض تُفرحني، إلى أن وعيتُ أن المستفيد الوحيد من التسليح هم تُجار الدم والسلاح، فقد كانت المملكة المتحدة، على سبيل المثال، تمُرُّ بأزمةٍ اقتصادية حادة في الوقت ذاته الذي يبدأ فيه التسليح، ولم تخف وطأةُ تلك الأزمة عليها إلا عند زيادة مبيعاتها للأسلحة، وجعلني ذلك الوعي أؤمن أن الكفاح المسلح لن يصنع تغييراً حقيقياً، فهو إن خدم فلن يخدم إلا الواحد بالمائة من طغاة العالم المستفيدين والمستفيدات من الأنظمة الاستعمارية التي لا يمكن فصلها عن المصالح الرأسمالية القائمة على كدح المظلومين والمظلومات ودمائهم/نّ. وبذلك كانت انطلاقة وعيي السياسي النِسوي التقاطعي من خلال العمل مع الثوريين من السوريين والسوريات، ومن خلال ذلك المنظور حلُمتُ بعالمٍ أفضل، وتصوّرتُ إمكانيات تحقيقه. ولكن الأمل بدأ يتبدّد مع بدء الحديث عن حل سياسي، يتمثل بمفاوضات ومساومات وأرباح وخسائر، من خلال أنظمةٍ صُمِمَّت بعد الحرب العالمية الثانية، أساساً لخدمة المستعمِر الصهيوني القائم على مصالح تُجار السلاح في المنطقة، والمُفتِّت لأشلاء أراضينا في دول الجنوب العالمي، والمستولي على خيراتنا، بأشكالٍ مختلفة؛ مباشرة وغير مباشرة.
إن ما دفعني لكتابة هذا المقال، على الرغم من عزوفي السابق عن الانخراط في التعليق على السياسة التقليدية، وجود أسماء عشتُ معها روح الثورة في قائمة اللجنة الدستورية المُشَكَّلَة من وفود مُمثِّلة للمعارضة ووفود ممثِّلة للنظام ووفود من المجتمع المدني، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً. وعلى الرغم من خيبة أملي لرؤية تلك الأسماء، إلا أنني لا أرضى بالتخوين ولا أسعى في مقالي هذا إلى المزايدة على الأفراد، وإنما أسعى إلى فتح الباب لطروحات وسيناريوهات سياسية بديلة تسعى نحو عالمٍ أفضل؛ تسوده عدالة نِسوية تقاطعية لا ترتكز على المساومات السياسية، ولا تُرسِّخ مخالب تُجار السلاح، لا في منطقتنا ولا في مناطق الجنوب العالمي ككل؛ عالمٌ تسوده عدالة لا ننسى من خلالها موتانا، بل نحيي ذكراهم/نّ من خلال رفضنا مقاليد السياسة التقليدية التي ما انفكت للحظة تفرق فيما بيننا لكي تسود، من سوريا إلى مصر إلى السودان إلى اليمن إلى المغرب الكبير إلى جنوب إفريقيا إلى المكسيك والبرازيل والباسك وغيرها من أراضينا التي لم تشهد يوماً عدالة تاريخية إصلاحية، تُعيدُ إلينا ما سُرِق منّا وتعتَرِفُ بظلم موتانا، لكي نتمكن من المضي قُدُماً في بناء عالمنا كما نشاء وكما نُريد. عالمٌ نستعيد من خلاله مواردنا المادية والثقافية والحضارية التي نُهِبت على مر العقود.
وعلى ذلك، فإنني أبني حُجتي في رفض مقاليد السياسة التقليدية على عدم اتساقها مع المنظور النِسوي التقاطعي، الذي يُمركِزُ وجهات نظر السكان الأصليين/ات والمهمشين/ات في مناطق الجنوب العالمي، والواقع الحالي الملموس لمن تمّت المساومة عليهم/نّ من خلال طاولات المفاوضات باسم السلام والحلول السياسية. وعلى الرغم من عدم قناعتي بحل سياسي تقليدي للشأن السوري، إلا أنني آمل أن تتمكن الثوريات النِسويات من تجنُبِ أخطاء المساومات السياسية من خلال الدروس المستفادة التي يطرحها هذا المقال، لعلنا نتعلم من اتفاقية أوسلو التي ساهمت في بيع أراضي فلسطين والتنازل عن حق اللاجئين واللاجئات في العودة، ومن سلسلة المفاوضات التي أدت إلى الإزالة الصورية لنظام التمييز العنصري في جنوب إفريقيا والحفاظ على النظام الطبقي المبني على اللون الذي خلقه نظام الفصل العنصري. ولا يمكننا حصر عجز النظام السياسي العالمي عن إحقاق العدالة في حالة جنوب إفريقيا وفلسطين، لا بل يمكن لمسه في الحلول السياسية التقليدية وحلول إعادة الإعمار في البوسنة وفي البرازيل وغيرها من الأمثلة الكثيرة.
لتفادي إعادة إنتاج الأخطاء نفسها، فإن التعلّم من تجارب مشابهة أمرٌ ضروري لأي حراك سياسي نِسوي، فإن كان فاقد الشيء لا يعطيه، إلا أن فاقد الشيء والمظلوم بذلك الفقدان يعيه، ويستمدّ هذا التعلّمُ قوته من وعينا بشتى أنظمة القمع التي نجابهها في حيواتنا المختلفة من موقعياتنا المختلفة، ومن تلك الأنظمة القامعة للأصوات المختلفة والمهمشة للسياسة التقليدية القائمة على تمثيل النُخب للعامة، والتي ترتكز في أساسها إلى هرمياتٍ طبقية سياسية تتقاطع عادةً مع الطبقية الاقتصادية والثقافية وإمكانية الوصول إلى الموارد. فمن هنّ القادرات منا على التغلغل في الأنظمة السياسية التقليدية؟ من يتمكنَّ من ذلك؟ وما هي موقعياتهن؟ حتى في الدول التي تتباهى بأنظمتها الديمقراطية، لا يتمكن من الوصول إلى الحكم إلا فئات ضئيلة جداً من المجتمع، لا تُمثِل أكثر من واحد بالمائة من المواطنين/ات، وبذلك يستحيل أن يكون ذلك التمثيل عادلاً أو شاملاً بأي شكلٍ من الأشكال.
وإذا نظرنا في اللجنة الدستورية، فقد تكون اعتمدت في اختيارها لفئات المعارضة والمجتمع المدني على تمثيل فئات مجتمعية عديدة، إلا أنها ما زالت لا تلبي حتى أدنى شروط التمثيل الديمقراطي من نظام ومعارضة ومجتمع مدني، ولعل ذلك الحلّ العملي والبراغماتي هو الأنسب في الوقت الحالي للحدّ من سفك الدماء، إلا أنني أخشى اتهام عدم التمثيل في حال عدم الوصول لحلول سياسية مجدية وعادلة. وإذا ما وضعنا مسألة التمثيل على جانب، فهل في الدستور حلٌ سياسيٌ للأزمة أساساً (فقد أصبحنا نتفاوض على الفُتات).
كان وضع المفاوضين/ات الفلسطينيين/ات في أوسلو مشابهاً للجان الدستورية المنتقاة للتفاوض، فلم تكن لديهم شرعية حقيقية لتمثيل الشعب، وقد رسخوا شرعيتهم من خلال امتطاء خيل المقاومة المسلحة، دون عمليات تشاورية شعبية تعطيهم الحق في التفاوض باسمنا، فهل نعيد إنتاج نظام الوصاية السياسية اللاشرعية في حالة ثورة أخرى؟ أَنتخلى عن حالة ثورة قد يكون لها القدرة على البناء لثورات عالمية فكرية تسعى إلى مجابهة جميع أنظمة القمع المفروضة علينا عالمياً بسبب انعدام التوزيع العادل للموارد المتوفرة على هذه الأرض؟ أليس هذا ما تسعى له الثورات الشعبية الحقيقية؟ ويعيدنا هذا إلى مثال جنوب إفريقيا، إذ على الرغم من الاعتقاد السائد، يؤمن المُهمَّشون والمُهمَّشات من السكان الأصليين أن نيلسون منديلا قد باع وساوم على قضيتهم/نّ، ولم يتوصل إلى حل سياسي عادل من خلال مفاوضاته، ولم تخدم تلك المفاوضات إلا المصالح الاستعمارية الرأسمالية في جنوب إفريقيا. هذا ولا يمكننا إنكار شعبيته العالية وقت ما قضى في سجون الفصل العنصري أكثر من ثمانية عشرة عاماً، ولكن يمكننا استشفاف خنوع مانديلا في ما قالته تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية المخلوعة، في آب (أغسطس) من العام الماضي وقت زيارتها لجنوب إفريقيا، عندما سُئِلت عن رأيها في الرجل بعد أن تجنبت نعته بالإرهابي كما كان ينعته حزبها المحافظ وقتها، قالت: هو رجلٌ بعد أن قضى سنواتٍ عديدة في السجن، خرج ولديه اتساعٌ في الرؤية وأسلوبٌ هادئ، وهذا ما مكّن جنوب إفريقيا من أن تصبح الدولة التي هي عليها الآن. ليست تلك شهادة يفتخر بها السكان الأصليون/ات في جنوب إفريقيا، فلم يتوصل مانديلا إلى حلٍّ عادلٍ لشعبه من خلال تلك المفاوضات، على الرغم من نزاهته وشرعيته المستمدة من المقاومة في ذلك الوقت، بل أصبح شخصيةً يُحتفى فيها في الغرب، وتُدشَّن له تماثيل أمام مجالس الأمة في قلب العواصم الإمبريالية التي قامت ونهضت على تجارتها بالعبيد. ألا تستحق شعوبنا في الجنوب العالمي فرصة تمثيل مصالحها، لا مصالح طغاة العالم؟
وعلى الرغم من يقيني بأن العديد من الشخصيات المذكورة في اللجنة الدستورية لن ترضى بالتنازلات والمساومة، إلا أنني أشكّك في قدرتها على التغيير الفعلي في إطار الأمم المتحدة؛ فهل يمكننا المراهنة على توصيات الأمم المتحدة التي يعتمد تمويلها على دول الشمال العالمي التي تعتمد بالمقابل على تجارة الأسلحة؟ تجارة الأسلحة التي تزدهر في حالات النزاع والتي تعتمد في أساسها على إخضاع الشعوب من خلال العنف؟ الأسلحة ذاتها التي تستخدمها كل الدول كأدوات للقمع والحفاظ على حكم الأقلية النخبوية.
ويدعونا هذا إلى التشكيك في قدرة الأمم المتحدة، وإن كان فيها أفراد نزيهون ونزيهات، على فرض حلول سياسية نِسوية عادلة، إذا كان مصدر رزقهم/نّ مُسيطراً عليه من قبل طغاة. فعلى سبيل المثال، منذ استلام ترامب للحكم، وبناءً على مواقفه الوضيعة ناحية الصحة الإنجابية؛ من الحق في الإجهاض إلى الوصول إلى وسائل منع الحمل ومعالجة الالتهابات الجنسية، تم تخفيض تمويل صندوق الأمم المتحدة بنسبٍ كبيرة، ما ترك فجوةً ضخمةً لا يسدها الآن إلا القليل من النِسويات المعنيات بالتغيير، كما تمّ تجريم الإجهاض في عدة ولايات أميركية، فكيف لنا أن نثق برجالٍ، مجرمين في الغالب، يحكمون العالم من خلال أنظمة ذكورية استعمارية في تصميمها، قائمة على مصالح مادية واقتصادية، إن راضتنا لحظةً، فقد تنقلب علينا في أي لحظة؟ كيف لنا أن نثق بمؤسسة للإشراف على حل سياسي بينما أسياد تلك المؤسسة، من أمثال ترامب وغيره، يحتفون بالديكتاتوريات التي تحكمنا.
والآن، لنفترض مرة أخرى فرضية ثانية مستحيلة التحقق؛ لنفترض أن الأمم المتحدة مستقلة عن الممولين من الشمال العالمي وقادرة على تحقيق نواياها الحسنة. إن دققنا جيداً في آليات عملها سنجدها عاجزة تماماً عن فرض أي شكل من أشكال العدالة التاريخية الإصلاحية، فإنّ النهج المتبع في الأمم المتحدة هو نهج مبني على حقوق الإنسان، لكنها حقوق مجزّأة ولا تجعل من العدالة المحور الأساسي لمجابهة أنظمة القمع العالمية، بل يؤدي هذا النهج إلى تجزئة الصراعات والحفاظ على الوضع القائم، أو في أحسن الأحوال يُحاسب مُحاسَبَاتٍ صورية على جرائم الحرب دون تعويضات تذكر عن الخسائر البشرية والمادية من جرّاء الحرب. على سبيل المثال، في محاكمة ملاديك في المحكمة الجنائية الدولية وصدور الحكم عليه بالسجن المؤبد لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها بحق البوسنيين والبوسنيات، لم تُذكر تعويضات للخسائر الفادحة التي لحقت بضحاياه، بل على العكس، فمن خلال مشاريع إعادة الإعمار التي قادها الواحد بالمائة من طغاة العالم، تم تدمير كل الآمال بتحسّن مادي في حيوات البوسنيين والبوسنيات. وبالعودة إلى مثال جنوب إفريقيا، التي مرت فيها الشعوب الأصلية بالعبودية والذل والاستضعاف والتهميش السياسي والاقتصادي وحالات هجرة قسرية وهدم للبيوت ودفع نحو ما يشبه المخيمات المؤقتة التي لا تزال موجودة حتى يومنا هذا، فإنه لم يرد أي ذكر من قبل الأمم المتحدة أو حتى من الساسة والقياديين التقليديين الجنوب إفريقيين عن أهمية السعي نحو عدالة تاريخية إصلاحية قادرة على تغيير الظروف المادية الملموسة التي نشأت بسبب نظام الفصل العنصري، الذي ارتكز على سرقة أرض وخيرات السكان الأصليين.
أيضاً، تكثُر الأمثلة عن فشل آليات السياسة التقليدية في إحقاق عدالة نِسوية تقاطعية، ولكي نفتح باب النقد البنّاء والعملي، أُلخّصُ تلك الدروس المستفادة في خمس نقاط أساسية على اللجنة الدستورية أخذها في عين الاعتبار؛ من أجل تجنّب تلك المطبات والأفخاخ التي تنصبها السياسة التقليدية لنا:
1- من المهم للغاية تحويل مسار الخطاب السياسي من العدالة الانتقالية، المشابهة للبوسنة، إلى خطابٍ يتمحور حول العدالة التاريخية الإصلاحية؛ لا يركز فقط على عقاب المجرمين والمجرمات وحسب، وإنما يسعى إلى الحقوق واسترداد كرامة الشعوب. فكيف لعائلةٍ فقدت معيلها الاستمرار بالعيش الكريم من دون تعويضات مادية ملموسة؟ وكيف يمكننا تعويض عائلات فقدت منازلها وتشرذمت في أنحاء الأرض عن الخسائر المادية والمعنوية التي أصابتها نتيجة أنظمة القمع؟
2- على الفئات المُمثَّلة في اللجنة الدستورية إشراك القواعد الشعبية بشكلٍ فعال في عمليات المفاوضات، ويجب ألا يتم ذلك عن طريق استفتاءات شعبية تعتمد على بيانات كمية ثبت فشلها في نطاقات واسعة في العالم، فعلينا ألا ننسى أن هنالك فئات مجتمعية سورية لا تمتلك أوراق ثبوتية تمكنها من ممارسة حقوق المواطنة، ولذلك من المحبذ أن تكون عمليات المشاركة الشعبية متمركزة حول احتياجات الفئات الأكثر تهميشاً، لا الفئات القادرة على الوصول إلى السلطة؛ من أجل الوصول إلى تمثيل شعبي حقيقي، يستند على القاعدة ورغبات المظلومين والمظلومات.
3- من المهم تحويل مسار اللغة الحقوقية التي تُجزّئ الصراعات وتدّعي أن الحل هو «إعطاء الحقوق»؛ وكأن الحقوق تُمنح بشكلٍ تدريجي وتَفضُّلاً للشعوب؛ وكأن الحل في سنّ القوانين لا في الحد من القمع والظلم. هذا الدرس المستفاد من فلسطين وجنوب إفريقيا وغيرها من الدول التي وقعت تحت ظلم وقمع؛ فقد نتمكن من تثبيت الحق في التعليم في الدستور، ولكن ما قد يُعجزنا عن تنفيذه هو عدم توفر الموارد الاقتصادية لأسباب تاريخية حَصرتْ الثروات في يد الفئات الحاكمة الظالمة. بينما شرعنت أوسلو حقّ التمثيل السياسي للشعب الفلسطيني في الساحة السياسية العالمية، كانت تلك الخطوة الأولى لإغلاق ملف اللاجئين واللاجئات، وعلى ذلك لا يمكننا اعتبار إضافة نصوص دستورية تذكر الحقوق وكأنها مُجزأة ومفصولة عن بعضها بعضاً نجاحاً أو تقدماً فعلياً سيُحدث تغييراً حقيقياً على الأرض.
4- لا ينبغي حصر المفاوضات السياسية في الأحداث التي تبعت الثورة، بل ينبغي العودة أيضاً إلى النقاط التاريخية التي خلقت أشكالاً مختلفة من الظلم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي والعرقي والديني والبيئي وغيرها، وخلقت فجوةً طبقية سياسية واقتصادية وثقافية بين الفئات الحاكمة وباقي الشعب. علينا ألا ننسى مجازر الثمانينات في حماة والمختفين قسرياً والمختطفين والمعتقلات والمعتقلين السابقين، وينبغي أن يُطرح فساد الفئات الحاكمة المالي الذي اجتث موارد الأرض على طاولة المفاوضات.
5- على جميع أطراف المفاوضات السعي نحو حقن الدماء ونزع السلاح، وقد تعتبر تلك خطوةً أولى نحو الحد من العنف والقتل، وقد يتطلب ذلك محاسبة ومساءلة تجار السلاح والساعين لإبقاء الوضع كما هو عليه لتحقيق مكاسب مالية. ويُلزم هذا المفاوضين والمفاوضات التشبيك مع مناطق الجنوب العالمي التي تعاني من تداعيات تجارة الأسلحة؛ مثل كشمير وفلسطين واليمن والسودان ومصر وغيرها؛ فقد تمكننا تلك التضامنات من إيجاد حلول حقيقية نحو عالمٍ خالٍ من العنف.
يطول الحديث عن كل محور من هذه المحاور، فجميعها لها حيثيات من منظور الحوكمة النِسوية الرشيدة يمكن أن يُبنى عليه أوراق بحثية طويلة ومُفصلة، وقد سعيت هنا إلى اختصارها لفتح باب النقاش والبحث فيها بشكلٍ معمقٍ أكثر.
ختاماً، آمل أن يكون هذا المقال خطوةً أولى نحو بداية نقاشات نِسوية فعالة ترتكز في تضامناتها على وعي بأنظمة القمع العالمية، وعلى الأبعاد الجيوسياسية والعابرة للأوطان والاقتصادية والتاريخية والبيئية للعمل النِسوي السياسي، كما أتمنى منا جميعاً، كنساء من مناطق الجنوب العالمي، ابتكار أطر بديلة للحوكمة النسوية الرشيدة، تمكّننا من هدم منازل الطغاة دون استخدام أدواتهم. متى سنبدأ عمليات النقد الذاتي والتفكير بموقعياتنا وأثرها على غيرنا؟ هل يتمثل الحل النِسوي السياسي بالمراوغات وانعدام الشفافية؟ هل يمكننا الوصول إلى حلٍّ سياسيٍّ عادلٍ وحقيقي من خلال حكم قانون يخدم الطغاة؟ هل يمكننا تصوّرُ عالم أفضل إذا سعينا في عملنا إلى مناصب سياسية صورية قائمة على هرميات طبقية سياسية من الأعلى؛ لا تُمركِز وجهات نظر القواعد الشعبية في عملها؟ هل يمكننا بناء عالم أفضل من دون السعي إلى عدالة تاريخية إصلاحية؟ هل سنرضى بالتمثيل الرقمي للنساء في السياسة التقليدية دون العمل نحو حوكمة نِسوية رشيدة، تسعى إلى استبدال النظام العالمي الذكوري واجتثاثه من جذوره؟ ومتى ستصبح سياساتنا مبنية على تضامنات واعية وفعالة تتمحور حول سياسات رعاية، لا سياسات سيطرة وعنف؟ ومتى سنتمكن من استبدال ثقافة الإدارة الذكورية للدول بثقافة القيادة النِسوية؟ كيف سنتمكن من الاستجابة للمظلومين والمظلومات من خلال نظام يسمح للمجرمين بإدارة دول؟ متى سنتمكن من تفكيك الحدود التي فُرِضت علينا لتفرِّقنا من أجل أن تضمن سيادة القوى الإمبريالية وطغاة العالم؟ تراودني هذه التساؤلات، ولا أتوقع من الثورة السورية التغيير العالمي المطلق على المدى القصير، ولكنني أدعو إلى فتح باب النقاشات البنّاءة نحو عالمٍ أفضل، وأدعو إلى التعلم من فشل طروحات الحل السياسي في شتى أنحاء المعمورة؛ فهي أشياءُ لا تُشترى. وعلى هذا، فما زلتُ أرفضُ المساومة على العدالة التاريخية الإصلاحية لجميع مناطق الجنوب العالمي، كما أرفض نسيان شعاعات الأمل التي فقدناها بسبب السياسة الذكورية التقليدية، كما أنني غير مستعدةٍ بعد لأُقِرَّ بأن من ماتوا قد ذهبوا، بل ستبقى أرواحهم/نّ بيننا على الرغم من شحوبها بسبب التعب والإرهاق.