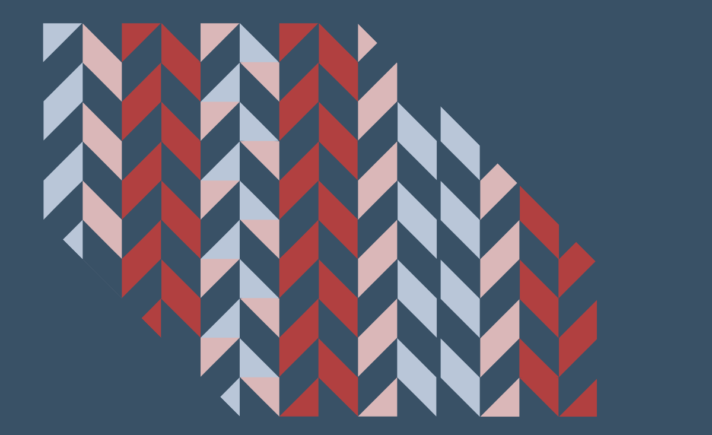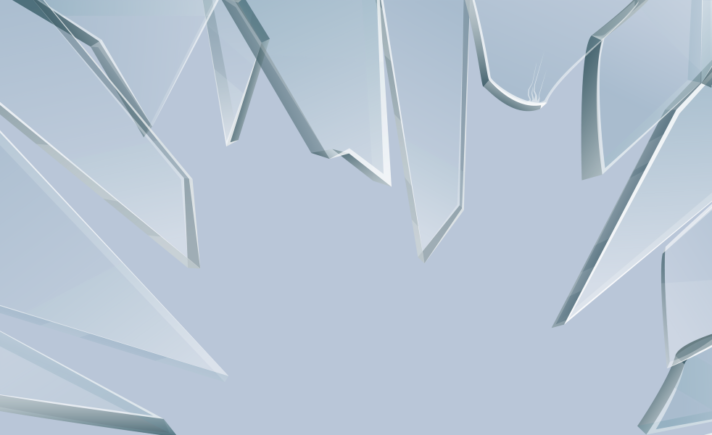«لكني لم أعطك أدنى فكرة عن الأمواج العالية المهولة التي تحملني إلى أعلى القمم ثم تهوي بي إلى وديان جهنمية سحيقة في غضون أيام»
هكذا وصفت الكاتبة الإنجليزية والمناضلة النسوية فيرجينيا وولف لطبيبتها ما كانت تشعر به -والذي يعرّفه الأطباء النفسيون اليوم بـ «الهوس الاكتئابي»- وكانت تصفه هي بالجنون قبل أن تأخذ قراراً بإنهاء حياتها في التاسعة والخمسين من عمرها، تاركةً لنا هذا الإرث النسوي الأدبي الذي ما زلنا نتناقله عبر الأجيال.
ورغم أن وولف تعتبر من أهم الكاتبات الإنكليزيات في القرن التاسع عشر، ومن المناضلات البارزات من أجل حقوق النساء في لندن؛ ورغم الذخر الأدبي التي تركته لنا، إلا أن هذا الهوس الاكتئابي كان رفيقها منذ الثالثة عشرة من عمرها تقريباً، واستمر معها حتى أودى بحياتها في نهاية المطاف عام 1941. تركت حينها رسالةً لزوجها تقول فيها: «أنا واثقةٌ أني سأجن مرةً أخرى، وأشعر أننا لا نستطيع أن نعاني مجدداً شيئاً من تلك الأوقات الفظيعة. لن أشفى هذه المرة». ثم تركت منزلها وأنهت حياتها في أحضان نهر أوس.
نوباتٌ من الغضب، تليها نوباتٌ من العزلة، تتخللها نوباتٌ من الهلع أو البكاء؛ فقدان الثقة في النفس أحياناً، وفي الآخرين أحياناً أخرى؛ أوقاتٌ من انعدام الرغبة في الحياة، بعدها أوقاتٌ من شراهة الرغبة ثم الذعر الذي يتشبث بتلابيب الروح بالكامل، حتى أثناء كتابة هذه الكلمات.. كل هذا وأكثر – ما وصفته وولف بالجنون- هي أعراض ذلك المرض الذي شخّصه عندي طبيبي النفسي بعد ما يقرب من ثمانين عاماً على رحيلها، ولا أعلم شيئاً يجمعني بها سوى أننا «سيدتان نسويتان» رغم البعد الزماني والمكاني والثقافي بيننا.
عندما أخبرني طبيبي بحالة مرضي لم أكن أعي وقتها ما هو الاضطراب النفسي، ولماذا أُصاب بالاكتئاب في العشرينيات من عمري -وقتها-، ما يُفترض أنه سنُّ الحيوية وعنفوان الرغبة في الحياة لدى الشباب. الآن، وأنا على مشارف منتصف الثلاثينيات، بدأت أفكر في الأمر من جديد، لماذا تحديداً في هذه الفترة من حياتي يزورني وحش الاكتئاب؟
في محاولةٍ حثيثةٍ لمراقبة ملامح تلك الفترة من حياتي وأهم التغيرات التي طرأت عليها على المستوى الفكري والنفسي، أعود بذاكرتي لأكتشف أنها كانت بداية تمردي على كل المساحات التمييزية التي نشأت بداخلها، وجهري بذلك بشكل واضح ومباشر. أو، بالأحرى، ميلاد ما يعرف بـ «الوعي النسوي» داخلي، وهو الذي عرّفته الباحثة النسوية جيردا لينر على أنه «وعي النساء بأنهن ينتمين إلى فئةٍ ثانوية، وأنهن تعرضن للظلم باعتبارهن نساء، وأن وضعهن الثانوي الخاضع ليس وضعاً مرتبطاً بالطبيعة، وإنما هو مفروض اجتماعياً، وأنه يجب عليهنّ التحالف مع نساءٍ أخريات للتخلص من أشكال الظلم الواقع عليهن، وأخيراً أنه يجب عليهنّ تقديم رؤيةٍ بديلةٍ للنظام الاجتماعي، بحيث تتمتع فيه النساء، مثلهن مثل الرجال، بالاستقلالية وحق تقرير مصيرهن».
بدأت تلك الفترة من حياتي تحديداً بعد ثورة 25 يناير، التي أدين لها بالفضل في تبلور ذلك الوعي لديّ، كما لدى العديد من النساء اللواتي أدركن الخلل في علاقات القوى بالمجتمع، وما يتبعه من قهرٍ ينصبّ علينا، نحن النسوة، أشكالاً مختلفةً من التمييز والقمع والظلم، وسلسلةً كبيرةً من الانتهاكات؛ مردّها فقط أننا خُلقنا داخل تلك الأجساد التي تحمل أعضاءً لا تشبه تلك التي تمنح القوة والسلطة والحرية لأصحابها.
تزامن هوسي الاكتئابي مع بوادر إدراكي بأنني لا أنتمي إلى تلك المساحات التي نشأتُ بداخلها واعتبرتها -ربما خطأً- مساحاتٍ آمنة، فوجدت نفسي أرفض الانخراط في مجالس وأحاديث اعتبرتها مشوِّهة للإنسانية، بينما كانت بالنسبة للآخرين مصدراً للسعادة؛ أو عندما أعلنت رفضي للأطر المعادية للنساء وما يرتبط بها من فقدان حقوقهن وحرياتهن؛ بل تجاوزت ذلك إلى الجهر بالمطالبة بالمساواة بين الجنسين في كافة الحقوق والواجبات، وهكذا بدأت الرحلة في التغريد خارج السرب.
في مقالها نسويات قاتلات للبهجة، عبرت الباحثة المستقلة والناشطة النسوية سارة أحمد، وهي كاتبة إنكليزية-أسترالية من أصول باكستانية، عن تلك المشاعر واصفةً إياها بـ«الغربة» -التي أكاد أجزم أننا، النسويات، قد مررنا بها جميعاً في مرحلةٍ ما- حين أدركتْ أن النسويات، منذ بداية وعيهنَّ النسوي، يجدن أنفسهن «غريبات المشاعر»؛ أي يشعرن بأحاسيس غريبة تُفضي بهنّ إلى فقدان مقعدهن على «مائدة السعادة» التي مُنحت لهن، بينما اخترن أن ينشققن أو ينعزلن عنها في ظل إحباط مشاعرهن، وهو ما خلق في النهاية «النسويات قاتلات البهجة»، وهو المصطلح الذي استخدمته الكاتبة للتعبير عن أشكال الرفض والعزلة التي يواجهنها النسويات.
ليس فقط الإحباط والعزل عن مائدة السعادة هو الثمن الذي تدفعه النسويات، كما أوضحتْ في مقالها، بل التورط أيضاً في خلق التعاسة لمن نحبهم؛ ذلك أن التعبير عن رفضنا لهذه المساحات والتخلي عن السعادة الممنوحة في ذلك النظام الاجتماعي، «المـصون كنظام أخلاقي ونظام للسعادة» بحسبها، هو سببٌ في إتعاس الآخرين، وهو شعورٌ آخرٌ يضاف إلى القائمة التي تأتي مجاناً مع وعينا بأننا نسويات قرّرن المجاهرة بذلك، بل والتضامن من أجل تغيير الظلم الواقع علينا.
تتبنّى أحمد «قتل البهجة» كإيديولوجيا سياسية وفلسفة لحياتها، وتكرّس للحديث عنها معظم كتاباتها التي تنشرها من خلال مدونتها الإلكترونية نسوية قاتلة للبهجة في عدة مقالات، منها «قتل البهجة… النسوية وتاريخ السعادة» و«التعددية الثقافية ووعد السعادة». فتتحدث بلسان حالنا جميعاً عندما «نلفت الانتباه للحظات التفرقة العنصرية» على سبيل المثال؛ أو «الكشف عن المشاعر السيئة» عندما نعلن عن رفضنا لمواضيع «غير سعيدة»، مضيفةً أن الحضور النسوي في الغرفة يمثل إحباطاً للآخرين، لكنني أود أن أوضح أننا أيضاً لم نختر عزلنا أو إقصاءنا عن السعادة. نحن فقط اخترنا أن نكون أنفسنا، وكان ذلك الثمن الوحيد، فنحن في واقع الأمر «مقتولات البهجة».
بالفعل، كان هذا الخروج الراديكالي من دائرة السعادة الذي يفرضه علينا الوعي النسوي الشرارة التي ولّدت الغضب الذي وصفته أحمد بـ «اللحظة التي تطفح فيها تلك المشاعر السيئة التي تدور بين الأجسام بطريقةٍ ما إلى السطح»، وما استتبعه من جميع أعراض الهوس الاكتئابي التي لم يتعذّر عليها الوصول والسيطرة على حياتي بأكملها، تلك النوبات التي قد تبقيني مستيقظةَ لأيام بأكملها حتى يجن جنوني، فأسقط في سباتٍ تتناوب فيه الكوابيس على رأسي، لأنتفض من نومي في فزعٍ يستكمل معي ما تبقى لي من حياتي.
مراحل مختلفة من العلاج النفسي، واللجوء إلى بعض العقاقير من المهدئات ومضادات الاكتئاب، وتعديل جرعاتها أو إيقافها أو العودة بين الحين والآخر، المتابعة مع الطبيب لسنوات، ثم اليأس من الشفاء.. إلى أن نصل لأكثر الحلول أمناً وألماً في الوقت نفسه، وهو الانسحاب من كل المساحات التي تستنكر وجودنا وتتهمنا بالشرود عن الطريق السليم الواضح والمرسوم منذ قديم الأزل؛ كي نسير عليه جميعاً دون أي محاولة للتملّص من الأدوار المتوقع منا تأديتها، مع الالتزام بالحدود المبينة لكل منها، ذلك لأنها السبيل الوحيد للسعادة.
لا أُخفيكم أنني حاولت كثيراً ألا أقع فريسةً للغضب أثناء كتابة هذا المقال، كي أحافظ على الطرح الموضوعي للمسألة، فلم أفلح أبداً. لكنني هذه المرة لن أبرّر غضبي، ذلك أنني أرفض وصمنا بأننا «غاضبات». نعم، نحن غاضبات، بل نحن نعيش في غضبٍ مستمر، فكيف يتسنى لنا أن نكتب دون غضب؟ ماذا لو كان ذلك الغضب مُبَرّراً؟ وبالعودة لوولف وكتابها غرفة تخص المرء وحده، نجدها تقول -عن كتابات النساء المُطعّمة بالغضب-: «وكيف يتأتّى للنساء فرصة للخيال والإبداع النقي وهن يقعن تحت سيطرة الغضب المستمر جرّاء ما يتعرضن له في مجتمعاتهن».
وأوضحت أن الوصول للحالة الذهنية التي تسمح للأشخاص بالكتابة هو أمرٌ ليس باليسير على المرأة التي تقع تحت ضغوط نفسية هائلة قد تودي بحياتها في النهاية، وهو ما يبرر التشوش الذهني والسخط الذي غلب على كتابات النساء في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، رغم وصفها لتلك الكتابات بـ «العبقرية»، لكنها كانت عبقريةً منقوصةً في نظرها، لم تتمكن من الخروج على أتم نحو، في ظل اضطرار النساء للكتابة بغضب، وصبّ مشاعرهنّ الشخصية داخل كتاباتهن، أو كما قالت: «إن المرأة في حالة حربٍ مع قَدَرها وظروفها».
كنت أتمنى لو لم تزل فرجينيا وولف على قيد الحياة؛ كي أطرح عليها سؤال إنْ كانت تريد العودة إلى الوراء، وتغيير الوعي الذي أصابها إنْ استطاعت، مع أني واثقة أن الإجابة كانت لتكون قاطعة بـ «لا»، ليس فقط لثقتي في نِسوية وولف، بل لأنها ستكون إجابتي على السؤال نفسه.
أدركتُ أن التغريد خارج السرب له ثمنٌ كبير، وحيث أن الوعي يأتي ولا يزول، فقد وصلنا إلى نقطةٍ لا رجوع منها. وحتى إن كانت هناك فرصة للرجوع، فإنني سأختار ألا أعود أبداً، بل سأختار أن أستمرّ في رحلتي برفقة الكوابيس ونوبات الهلع والغضب والعزلة. سأستمر حتى لو كان رفيقي الوحيد في الرحلة هو الهوس الاكتئابي.