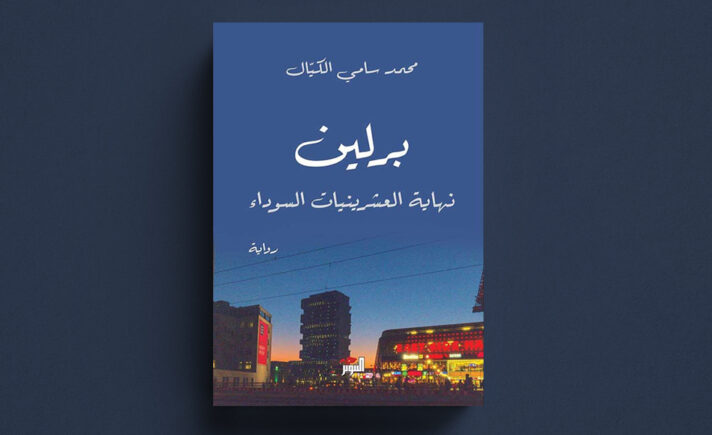عند تقديم نصّ أو مقال أو ملف، أو حتى كتاب، يضيف بعض الكتّاب تنويهاً («ديسكليمر»، بلغة بوريس جونسون) بأن النص لا يدّعي الإحاطة بكل جوانب المسألة المُعالجة، أو لا يحاول أن يشمل كل الأفكار التي تكوّنها، أو يقتصر سعيه على طرح مجموعة من التساؤلات لتشكيل مداخل لنقاش أعمق. يأتي هذا التنويه بدافع النزاهة والتواضع، بقدر كونه «مخرجاً» من انتقادات ممكنة بسبب غياب زوايا غير مُغطاة من الموضوع. هذا عدا أنه يمنح مساحة لما هو ذاتي في المقاربة، طالما أنه لا يدّعي اكتمال موضوعيته.
أحب القراءة عن المدن والأماكن والسفر، وأعتقد أن هذه النصوص والكتب من أصعب الأنواع إنتاجاً، وتحتاج قدراً مضاعفاً من التنويه إياه. ثمة مسؤولية كُبرى في أن تكتب عن مدينة ما -والمدينة هي تكثيف شديد لأعمق ما هو «مشترك» بين مئات الآلاف، أو الملايين من البشر-، وتحتاج هذه الكتابة لمساءلة الكاتب لنفسه ومنظوره وموقعه وأدواته و«شرعيته» على طريقة الأنثروبولوجيين، خصوصاً إن لم تكن هذه المدينة مدينته. وأعترف أنني أُعجب بجرأة من يستطيع -أو يجرؤ على- إنتاج نصّ عن مدينة أو مكان خلال زيارة سياحية قصيرة، على طريقة «رحّالة» العصور السابقة، ويكون الإعجاب مضاعفاً في حال كان النص فاقعاً في سطحيته واستسهال كتابته، خاصة حين يظهر على شكل إعادة صياغة نثرية لخريطة المواقع السياحية للمكان، أو خوض في المساحات الشائعة والمطروقة من تاريخه أو سياسته. لا أدري ماذا يحتاج إنتاج هذا النوع من النصوص.. جرأة؟ ثقة بالنفس؟ نرجسية؟ أياً يكن، بعض هذه النصوص «الجريئة» ساحرٌ في انتهاكه المرِح لرهبة المكان؛ بديعٌ في كونه «كيتش»- رداءةٌ خلاّبة، حسب هلال شومان-.
عشتُ في اسطنبول حوالي أربعة أعوام ونصف، وقد كانت ثالث مدينة أعيش فيها وأول مدينة أكون «أجنبياً» فيها بعد مدينتين، الرقة وسانتياغو، هما «بيتاي» لأسباب عائلية، ولأنهما تقاسمتا أغلب سنوات طفولتي ونشأتي. ومن البديهي القول إن أي قادم جديد إلى مدينة، خاصة إذا كانت عاصمة أو مدينة سياحية، سيرى بعد أسابيع قليلة أن أكثر الأماكن شهرةً في هذه المدينة هي أقلّها معنىً لسكانها، وقد لا تشكّل ولو جزءاً بسيطاً من حياتهم لسنوات وسنوات إن لم يضطروا للمرور بجانبها أو عبرها، وسيكون عبورهم مختلفاً تماماً عن عبور زائر أو سائح في المكان نفسه، اختلافَ مراكب السياحة عبر البوسفور عن السفن التي تعمل كوسائل مواصلات بين الشطرين الآسيوي والأوروبي، بازدحامها وتأخيراتها وتأففات ركّابها من رتابتها. ولا تقف هذه الاختلافات عند طريقة التعامل مع المكان الفيزيائي، فمكانة ومعنى وتاريخ مدينة ما تعني أموراً مختلفة لزوارها وقاطنيها، وقاطنوها ليسوا كتلة واحدة، فمنهم أهلها ومنهم مهاجرون داخليون وآخرون خارجيون، ويختلف الجميع فيما بينهم حسب الطبقة والجندر واللغة والمهنة والأهواء والثقافة والصدفة والزمن.. إلخ. وصلتُ إلى اسطنبول خريف عام 2013 ورحلتُ عن اسطنبول مختلفة أواخر ربيع 2018، تغيّرتُ أنا كثيراً خلال تلك الفترة، وتغيّرت اسطنبول كثيراً أيضاً. عرفتُ اسطنبولات عديدة، بعضها متراكب في الوقت نفسه وبعضها الآخر متتابع زمنياً خلال تلك الأعوام، رغم أن لغتي التركية بقيت دوماً على مستوى السؤال عن سعر شيء، أو للتفاهم البدائي جداً مع سائق التاكسي. وفي الأيام الأخيرة، للأسف، عرف من بقي هناك اسطنبول جديدة، هي عبارة عن خارطة من الحواجز التي تتصيّد سوريي اسطنبول وتحملهم إلى ما وراء الحدود، في مناورة سلطوية لتقديم مُستباحين ضعفاء، هاربين من مجزرة متواصلة، ككبش فداء إرضاءً لغضبٍ ما نتيجة استحقاقات سياسية واقتصادية. لا يستحق سوريو اسطنبول هذا -ولا يستحق أي إنسان أن يُستباح-، كما لا تستحق اسطنبول أن تعيش، ويُعاش فيها، هكذا عار.
والحال أنني تركت اسطنبول منذ عام وشهرين ولم أكتب عنها أي نص يُذكر، عدا بوستات فيسبوكية متفرّقة. صحيحٌ أن جزءاً من الامتناع عن الكتابة نابع من إحساس بالرهبة والخوف من أن لا يكون النص متبحّراً وباحثاً وشارحاً و«عميقاً» بما فيه الكفاية، وبهذا لا أدّعي أن منطق التهيّب أصلح من الاندفاع نحو الكتابة. أعتقد أن الوقت قد حان لكي أواجه نفسي بحقيقة أن الرهبة ليست السبب الوحيد، بل أن الكسل مهم للغاية في تفسير العطالة الإنتاجية، وجزء لا بأس به من الرهبة والخوف ليسا إلا تمويهاً للكسل وهرباً من الذنب الذي يسببه، والسمعة السيئة (والظالمة) التي يحملها. خلط الرهبة الكتابية بالكسل يلوّث الأخير ويحقن في الأولى بعض السينيكية اللزجة بدل أن تكون نزاهةً بحتة. ينبغي أن يُعطى الكسل حقّه، وألا يُذمّ أو يُموّه بحجج تخفيه وكأنه عارٌ عتيق. ويجب ألا يُربط إعطاء الكسل حقّه بتقديمه على أنه طريقة لتحسين «الإنتاجية»-على طريقة «خبراء» التنمية البشرية-، بل لذاته، ومن أجل ارتياح ذواتنا مع زواياها الكسولة دون إزعاجات ضميريّة.
يحتاج خليط الكسل والتهيّب هذا لمرور وقت كافٍ قبل أن يحسم نفسه. حتى ذلك الحين، لنتحدّث عن برلين..
في العقد والنصف الأخيرين، تحوّلت العاصمة الألمانية إلى مقصد لأصحاب المهن الإبداعية من شتى أرجاء العالم، إضافة لكونها مركزاً اقتصادياً لأنماط العمل عن بُعد، وأخذت تفرز نتيجة لذلك أنماط حياة ولهو واستهلاك وإعادة تدوير وحفاظ على البيئة طليعية أوروبياً. ونتيجةً لهذا الإقبال العالي من أصحاب دخل جيّد وأذواق وأساليب حياة غير محلّية، فقد عانت غالبية أحياء برلين، أسوةً بعواصم كثيرة، من رفع هؤلاء كلفة المعيشة في مناطق كانت تُعتبر شعبية وذات كلفة مقبولة للسكان المحليين أو المُهاجرين الأقدم، ما يدفع هؤلاء خارجها، ليتشكّل الطابع الاقتصادي والاستهلاكي والستيتيكي حسب أهواء الوافدين الجدد، أي ما يُسمّى بالاستطباق (جنتريفيكيشن بالانكليزية، والجَنتَرة بعربية مُجنترة).
أياً يكن، برلين مدينة كونيّة فعلاً، ويلاحظ ذلك مثلاً في التنوّع الكبير في خيارات المطاعم: تركية، تايلندية، فييتنامية، صينية، إسبانية، إيطالية، برازيلية، سوريّة (طبعاً)، لبنانية، يونانية، مغاربية، كوريّة، يابانية.. وحتى ألمانيّة! ونتيجة لهذا الطابع الدولي، يشيع قول أن برلين «ليست ألمانيا»، أي أنها لا تُعبّر عن الطابع الألماني «الحقيقي». هذا صحيح إلى حدّ بعيد، لكن البحث عن موقع هذا الطابع الألماني «الحقيقي» ليس سهلاً للمبتدئين أمثالي، فإن ذهبت جنوباً ستجد ألمانيا أكثر من برلين، لكنك ستسمع أن الشمال أكثر ألمانيّةً، ولو ذهبت شمالاً فسيُقال لك إن الغرب في وستفاليا ووادي الرور أكثر ألمانيّة. بافاريا؟ ساكسونيا؟ لا مفر.. ستجد دوماً من يؤكد لك -بحصافة ومحاججة أو بدونهما- أن «الأصانص» الألماني في مكانٍ آخر. ما يجري مع هذه الألمانيا الحقيقية هو المعاكس التام لما يحصل لـ«ريف حلب» بالنسبة لأصحابي الحلبيين: ريف حلب بالنسبة لهم كونيّ الأبعاد. ستسمعهم يقولون لك «إش هاي؟ كلها ريف حلب» في أنطاكيا وكلّس وعنتاب ومرعش ومرسين وأضنة، وفي عموم النصف الشمالي من سوريا -هذا إن لم يتذكروا الموصل في لحظةٍ ما- وأحد أصحابنا رفع الرهان بتأكيده في إحدى السهرات في اسطنبول أن كل ما بعد بورصة «ونِيزِل» ليس إلا ريفاً لحلب.
لم يُسعفنا الوقت اليوم للحديث عن برلين، ربما في أسبوع مقبل.