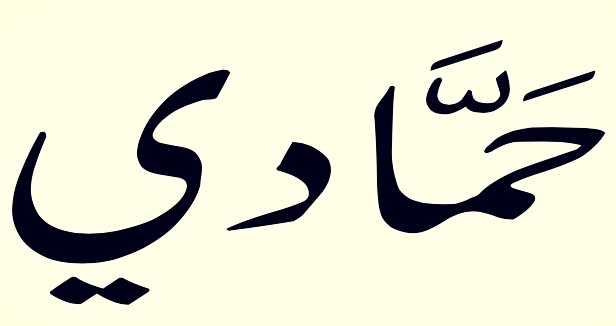قبل نحو شهرين، قُبيل الانتخابات البرلمانية الأوروبيّة، شنّ اليمين المتطرف الألماني حملةً جديدة لإدانة أسلمة أوروبا بمناسبة ظهور مواد صحفية تستنتج من تقريرٍ سنوي تصدره جمعية اللغة الألمانية GfdS حول أكثر أسماء المواليد الجدد شيوعاً -بعد كثيرٍ من الطبخ والاقتطاع وإساءة قراءة الاحصائيات عمداً- أن اسم محمّد بات ضمن صدارة أسماء المواليد الجدد في ألمانيا. وتماشياً مع الإبداع المعتاد عند الأخوة في اليمين المتطرف الألماني فقد أنتجوا بوستر لطفل رضيع بلحية سلفية، وآخر لمُعلّمة مدرسة محجبة أمام جمع من الطلاب يبدو واضحاً، دون أن تظهر وجوههم، أنهم قطعاً «محمّدون». وقد ظهرت تقارير وتحقيقات صحافية وتصريحات مضادّة توضّح سوء القراءة المتعمّد للإحصائيات، وتُدين خطاب الكراهية المُعادي للاجئين والمهاجرين العرب والمسلمين، أو تحاول شرح «براءة» معنى كثرة المحمّدين (من قبيل توضيح أن تسمية طفل بمُحمّد ليست بالضرورة دينية الدوافع)، شروحات غالباً ما يتعب حسن نواياها ونبل دوفعها خلال محاولة التغطية على عوز ذكائها.
يُساعد غوغل على استعراض موسمية الأخبار عن صدارة اسم محمّد ضمن المواليد الجدد في ألمانيا أو فرنسا أو بريطانيا أو غيرها خلال العقد الأخير. أخبار، كهذا الأخير، مُزوّرة أو مُحوّرة أو مُضخّمة يتداولها ويُشهرها يمين متطرف مهووس بمُحمّدين وما ومن حولهم، وصحف ومواقع تركية وعربية ترى الخبر مُبشّراً باقتراب استرجاع الأندلس ودحر الصليبيين. جهتان تُصرّان على عدم ترك مُحمّد ودين محمّد وغير محمّد وغير دين مُحمّد في حالهم..
وقد كان اهتمام الأخوة في اليمين المتطرف الألماني بفقرٍ مفترض في تنوّع أسمائنا (على أساس أنهم أقل عنصرية مع نديم أو شاكر أو ديمة أو راما من عنصريتهم مع عائشة ومحمد وفاطمة ومحمود) مناسبةً للتفكير في تعاطينا الدارج مع اسم محمّد، وتعاملنا مع انتشاره. عندنا في الرقة، على سبيل المثال، لو أردت مناداة أحد في الشارع لا تعرف اسمه، فالأرجح أنك ستنادي «أبو جاسم!»، أي الكناية الشعبية الشائعة، الديفولت، لأي محمّد. الموضوع إحصاء واحتمال بحت إذاً. لكن هذا ليس إلا تفصيلاً أولياً ضمن علاقة اللهجة الرقاوية مع اسم محمّد، وهي علاقة واسعة التفاصيل.
اللهجة الرقاوية، أسوةً بأغلب اللهجات المشرقية، لا تضمّ الميم الأولى من اسم محمّد، بل تُسكّنها، إلا إذا جاء إشارةً للنبي، أو لشخصية تاريخية ما، أو كلفظ تعجّب واندهاش دارج جداً «يا مُحمّد!». بعد هذه النقطة، نشير إلى تمييز بين محِمّد (بكسر الحاء) ومحَمّد (بفتح الحاء). الأول لفظ رقاوي محلّي، يُستخدم لأهل البلد حصراً، فيما الثاني يحمل ضرباً من الرسمية والمسافة والبرود، غالباً ما يعني أن محمداً هذا ليس رقّاوياً. هكذا، لا يمكن تخيّل أن أحداً يمكن أن يلفظ اسم الراحل محِمّد الحسن، ألمع مؤدّي الشعر الغنائي الفراتي في القرن العشرين، بفتح الحاء؛ في حين لا يمكن أن يرد اسم محَمّد سلمان، محافظ الرقة الأسبق (ووزير الإعلام لاحقاً) وصاحب الذكرى التعِسة في المحافظة، نهباً وظلماً وتجبّراً، إلا بفتح الحاء.
لاسم محمّد اشتقاق تحبّبي عريق في اللسان الرقّاوي، وهو «حَمّادي». ليس تدليعاً تماماً، وقطعاً ليس تصغيراً. يُلفظ بتفخيم الألف، وليس بإمالتها على طريقة لفظ مذيع نشرة الأخبار المحلية في القناة الأولى للتلفزيون السوري في التسعينات لاسم عائلة الرفيق سعيد حمّادي، البعثي المُعتّق لدرجة الشكّ في كونه «الرسالة الخالدة» شخصياً. قبل التسعينات، كان محِمّد الرقاوي «حَمّادي» منذ ولادته حتى ما بعد الخدمة الإلزامية، إذ يبلغ حينها أعلى درجات حمّاديته، ويصير عكر المزاج ونزِقاً، ما يُقرأ عند الأهل على أنه «متجيهل» و«يريد الجيزة»، ليصبح محِمّد بعد الزواج، أو «أبو فلان»، وإن كان بالإمكان أن يبقى اسمه «حَمّادي» عند أهله، خصوصاً عند أمه وأخواته. في صغري، كنت معتاداً على أن يُنادي الجميع والدي «دكتور» أو «حكيم»، حتى أقاربه وأخوته في جلسات عامة، لكن جدّتي وعمّاتي كنّ ينادينه «حَمّادي» في الجلسات الأضيق، في لحظات مساررة أو طلب أو «تواطؤ» عائلي، ما كنت أراه منذ ذلك الحين أمراً بالغ الدفء، وأتذكره الآن بحنان.
ثمة تخيّل ساخر عن مشهد مألوف في حارات الرقة، وهو التقاء مجموعة نساء في زيارة أو تهنئة أو عزاء أو فرح بعد فترة غياب وانقطاع أخبار، وبعد السلام وتبادل الحُبّات (أي تقبيل يجب أن يُسمع صوته في حلب، على الأقل) يبدأ سيل الأسئلة البروتوكولية التي غالباً ما لا تنتظر إجابة: شلونكم؟ شأخباركم؟ شلونه الحجّي؟ الوِلد شلونهم؟ چنّتكم (كنّتكم) جابت؟ حمّاديكم تسرّح؟ والسؤالان الأخيران هما الإضافة الساخرة في الطرفة الدارجة، إذ يفترضان أن الوضع الطبيعي لأي عائلة رقاوية يحتم أن يكون فيها دوماً كنّة حبلى، وحمّادي يؤدي الخدمة العسكرية. «حمّاديكم» هنا منسجمة مع الشائع في اللهجة الرقاوية للإشارة لأبناء العائلة: أحمدنا، محِمّدنا أو حمّادينا، عبّودنا.. الخ. في هذه الـ «نا» قدر كبير من القُرب والاحتضان الذي توفّره اللهجات الفراتية. الرقّاويون، كلهجتهم، «حنيّنين» حين يستطيعون (وما هو أهم: حين يريدون). و«حنيّن» مختلفة عن «حنون» كما يختلف محِمّد عن محَمّد.
اعتباراً من أواخر الثمانينات ومطلع التسعينات، أخذ «حَمّودي» بالظهور، ولا ندري إن كان للأمر علاقة بانهيار جدار برلين. في مرحلةٍ أولى، كان «حَمّودي» هو بُرعم حَمّادي: يكون محِمّد حمّودي في صغره، إلى أن يتمرّد على ذلك في نهاية المرحلة الابتدائية ويصبح حَمّادي، مُكملاً السيرورة الرقاوية المُعتادة. وقد تغيّر ذلك تدريجياً في العقدين الأخيرين، وبات بالإمكان لحَمّودي أن يبقى كذلك حتى عشريناته أو أكثر. ربما تكون هذه إحدى تمظهرات ما-بعد الحداثة عندنا. لست من المعجبين باشتقاق «حَمّودي»، ولسبب غير منطقي ومستحيل التفسير خارج رأسي أشعر أنه نيوليبرالي جداً، ومُعولم، بالمقارنة مع «حَمّادي»، الأقرب لمفاهيم دولة الرفاه بالمعنى الاسكندنافي.
في السنوات القليلة الماضية، بدأت تظهر تنويعات غرائبية من نمط «ميدو»، متأثرة بنجوم كرة القدم والغزو الثقافي الذي يُشوّه أصالتنا التراثية. يحصل أننا طبّعنا وجود «حَمّودي» بسهولة كونه ينبع -بشكل أو بآخر- من صُلب لهجتنا. لكن أشياء مثل «ميدو» غير مقبولة، فهي تشويه لهويتنا يُنافس في عدوانيته ما فعله مخرج مهرجان تلفزيوني سوري قبل سنوات، حين رأى أن وصلة غنائية فراتية لإبراهيم الأخرس وخولة حسين الحسن بطيئة وقليلة «الأكشن»، فأدخل عليها طبّالاً يتقافز، خالقاً مسخاً من رُبابة تدبك.
والحال أن حمّادياتنا وغير حمّادياتنا لم يعودوا غالباً «يتسرّحون»، مُطمئِنِين سؤال خالاتنا الرقاويات الشهير، وذلك لأنهم يتجنبون الخدمة الإلزامية ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، ولو عن طريق قطع آلاف الكيلومترات بعيداً عن بلدهم: لا يريدون أن يَقتلوا، ولا يريدون أن يموتوا. هذه معادلة غير مفهومة لأمثال الأخوة في اليمين المتطرف الألماني، ولأحبابهم وحلفائهم من جبران-باسيليين وأسديين.
لا تريد أن تَقتل، ولا تُريد أن تُقتل، وتريد أن تبحث عن أمانك ورزقك، وفوق كلّ هذا اسمك محمّد؟!