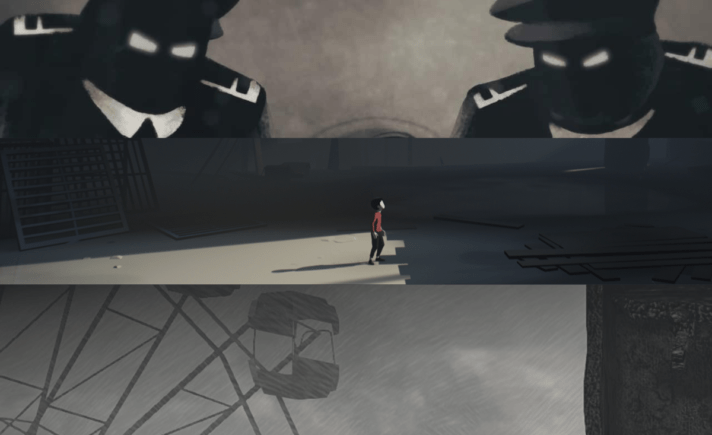لم تكن مستغربة تلك الصّدمة التي تلت صدور القانون رقم 10 لعام 2018 وما رافقها من نقاش وجدل لدى السوريين عامةً، كما لدى الحقوقيين والإعلاميين والسياسيين، خاصة إذا ما عرفنا المخاطر الواردة في نصوصه وأحكامه في ظلّ الظرف الاستثنائيّ الذي تمرُّ به سوريا وشعبها، وهي مخاطر لا تقتصر على النّيل من حقوق ملكيّة السّوريين في عقاراتهم ومساكنهم فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى قضايا تهتمّ بها بشكل مباشر جهات دولية كثيرة كقضيّة اللاجئين السوريين، حيث يؤثر هذا القانون على عودتهم إلى مناطقهم، ويتقاطع تأثيره السلبي مع الحلّ السياسيّ وقضية إعادة الإعمار وغيرها، وهي أمور تهتمّ بها كثير من دول العالم والمنظمات الأمميّة؛ فهل يُعتبَر القانون المذكور مجرد نصّ مثير للجدل حين صدوره؟ أم أنّه حلقة ضمن سلسلة من التشريعات التي دأبت السلطة الحاكمة في سوريا على سنّها مساساً بحقوق الملكية في البلاد، ومن ثم فهو جزءٌ من حرب على أملاك السوريين؟ وما مدى الحماية الدستورية والقانونية لحقوق الملكيات العقارية؟ وإذا كان في سوريا انتهاكات عديدة لحقوق الملكية، كما يذهب كثير من الحقوقيين، فما هي أبرز هذه الانتهاكات؟ وما هي تأثيراتها المستقبلية؟ وبالنتيجة ما هي الحلول التي يمكن اللجوء إليها لحل مشاكل انتهاكات حقوق الملكية في بلادنا؟
تهدف هذه الورقة البحثية إلى إلقاء الضوء على موضوع الانتهاكات الواقعة على الملكيّات العقاريّة في سوريا، من حيث أسبابها وأهدافها ووسائلها، وموقعها في ظلّ القوانين والمعاهدات والمواثيق الدّوليّة.
الانتهاكات المتعلقة بالعقارات في سوريا قبل عام 2011
كانت سوريا تخضع للحكم العثماني وقوانينه المتعلقة بالعقارات والملكيات. وبخروج سوريا من الدولة العثمانية كان لا بد من إطار قانوني ودستوري للدولة الجديدة. فكان دستور عام 1920 أول دستور لسورية بعد انعقاد المؤتمر السوري عام 1919. وقد أكّد الدستور المذكور أن أموال الأفراد والأشخاص الحكومية في ضمان القانون، فلا يجوز نزع ملكية مالك إلا للمنافع العامة بعد دفع التعويض وفقاً لقوانينه الخاصة
لم يدم هذا الدستور طويلاً حتى جاء الاحتلال الفرنسي الذي استمر حتى عام 1946. تعددت الدساتير بعد ذلك، وكان أبرزها دستور عام 1950 من حيث شرعية صدوره. وقد بدت فيه تأثيرات الأحزاب الاشتراكية عندما أكّد على صيانة الملكية الخاصة، وأحال إلى القانون كيفية التصرف بها بحيث تؤدي وظيفتها الاجتماعية. وتضمنت المادة 22 أنه يُحدَّد بقانون حدّ أعلى لحيازة الأراضي، كما نص على جواز الاستملاك بقصد النفع العام مع إعطاء تعويض عادل. وقد تعددت الانقلابات العسكرية أيضاً بعد الاستقلال، ولكن سوريا بدت بلداً يستند إلى حرية اقتصادية وسياسية حافظت على نوع من الاحترام للملكية الخاصة وصيانتها، وكانت من الدول المشاركة في تأسيس الأمم المتحدة والموقّعة على ميثاقها الصادر عام 1945 الذي تبعه صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 الذي جعل حق الملكية ضمن الحقوق الإنسانية المحمية دولياً، ونصّ على حماية الملكية الفردية والجماعية للناس، وأكّد على حق الشخص في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، وعدم جواز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
ولم تكن الصراعات السياسية في فترة الخمسينات والستينات من القرن العشرين في بلادنا بعيدة عن موضوع الملكيات، سواء المتعلقة منها بالعقارات أو غيرها من مصادر المال، حيث بدأ الاستخدام السياسي للملكيات العقارية على خلفية الصراع بين القوى السياسية الحاكمة وبين قوى جديدة تريد الحصول على الموارد الاقتصادية وإعادة توزيعها في المجتمع من جديد أولاً، وإضعاف خصومها سياسياً من خلال تجريدهم من مصادر قوتهم المتمثلة بالملكيات الزراعية بشكل خاص.
يعتبر التأميم والإصلاح الزراعي أول مساس بالملكيات والأراضي خلال عهد الوحدة مع مصر بين عامي 1958-1961، والذي كان بداية فقدان الحماية الدستوريّة للملكية، باعتبار النصوص الدستورية – بدايةً من دستور الوحدة مع مصر وانتهاءً بدساتير البعث – صارت تعبّر عن إرادة السلطة الحاكمة المنفردة، بعيداً عن الإرادة الشعبيّة، وقد باشرت سلطة الوحدة بحركة تأميم واسعة شملت مصانع وشركات ومصارف، كما شملت وضع اليد على الملكيات العقارية بعد إصدار قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958، الذي يحدد سقف الملكية للأراضي بأنواعها البعليّة والمرويّة بهدف توزيع المساحات الزائدة على المنتفعين. لم يَدُم حكم الانفصال عن مصر الذي حصل عام 1961 طويلاً، حتى حدث انقلاب حزب البعث على السلطة عام 1963، وسرعان ما أُعيد العمل بقانون الإصلاح الزراعي الصادر في فترة الوحدة وخُفّض سقف الملكية من جديد. وكانت عمليات الاستيلاء سلاحاً فعالاً في فرض ما يريده الحكام الجدد، وهو إضعاف القوى الاجتماعية التي كانت تسود البلاد، وتقوية وكسب الحاضنة المفترضة للحزب عبر توزيع الأراضي المستولى عليها على أفرادها.
لم يكن الاستيلاء عمليةَ الانتهاك الوحيدة لموضوع العقارات والملكيات الخاصة، وإن كان آنذاك السلاح الأقوى، فقد كان الاستملاك انتهاكاً إضافياً بسلاح القانون، تلجأ إليه السلطة تحت ذريعة المنفعة العامة.
صحيح أنّ الاستملاك لم يكن يحمل معنىً وهدفاً سياسياً كبيراً كما هو الحال في الاستيلاء، ولكنه انتهاك لحق الملكية في نهاية الأمر، ويتمثل ذلك بانتفاء عدالة التعويض للمالكين عند نزع الملكية، التي أكدت عليها القوانين والمعاهدات الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث جاء في المادة 17 أنه لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
وإذا كان قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1974 غير عادل من خلال تقدير قيمة العقارات المستملكة، أو المنشآت القائمة عليها، وكذلك عبر التأخر في إيداع بدل الاستملاك في البنوك لصالح المالك، وجواز إعادة تخمين قيمة العقار بعد خمس سنوات، فإن قانون الاستملاك الذي جاء بعده برقم 20 لعام 1983، والنّافذ حتى اليوم، قد ألغى حق إعادة التخمين واستبدله بفائدة سنوية بسيطة عن مبلغ الاستملاك الذي تتأخر الدولة بتسديده للمالك، كما أنّه حدد مبالغ التعويض بشكل مسبق، من خلال تحديد قيمة الأراضي الزراعية بعشرة أمثال إنتاجها السنوي، أما المقاسم (العرصات) فقُدّرت قيمتها بما لا يتجاوز 30% من قيمة إنشاء البناء عليها على الهيكل وفق نظام ضابطة البناء، ما جعل التعويض بعيداً عن العدالة. وهذا ما ذهب إليه الأستاذ نصرت ملا حيدر في مقال له منشور في مجلة المحامون: «إنّ وضع منتهىً للتعويض أو القيمة ينافر التعويض العادل الذي نص عليه الدستور». إن هذه الأحكام الواردة في قانون الاستملاك تشكّل انتهاكاً لحقوق الملكية، يضاف إلى انتهاكات الاستيلاء التي ذكرناها.
عام 1976 صدر القانون رقم 3 الذي يمنع بيع نوع من العقارات، حيث نصّ على منع من يشتري أرضاً ضمن حدود أي مخطط تنظيمي مصدّق ومناطق الاصطياف من بيع هذه الأرض أو التوكيل بذلك، ويشمل هذا المنع الهبة، إلّا كانت لإحدى الجهات العامة، أو الجمعيّات الخيريّة وبدون عوض، ولا يُعتدّ بأيّ تصرف يجري خلافاً لهذا القانون، الذي يمنع أيضاً الدوائر العقارية والكتّاب بالعدل وكل الدوائر الأخرى من توثيق أيّ عقد يتضمن انتقال ملكية هذه الأراضي، كما يعتبر من يقوم ببيع الأراضي المذكورة مرتكباً لجرم الاحتيال المنصوص عليه في قانون العقوبات العام. وبغضّ النظر عن الأسباب الموجبة لصدور هذا القانون، فإنه يعدّ انتهاكاً لحقوق الملكية التي ينصّ عليها حتى الدستور الذي صدر القانون تحت ظلّه وهو دستور عام 1973
ولعلّ مشكلة السكن العشوائي والبناء المخالف الذي شمل كل المدن السورية كان انتهاكاً لحقوق الملكية ابتداءً، وأساساً خطيراً لانتهاك مستقبليّ لهذه الحقوق تبيّن بشكل جليّ بعد الانتفاضة الشعبية عام 2011 وما تلاها من انتهاكات سنبينها لاحقاً. وقد أحاط هذا السكن والبناء العشوائيّ بالمدن، في ظاهرة خلقتها سياسات السلطة القائمة، تمثلت أساساً في انهيار الحالة الاقتصاديّة للريف السوري، وما تبعه من هجرة إلى المدينة. وكان السكن العشوائي قد بدأ مع بداية حكم البعث، وتفاقم بشكل كبير في عهد الأسد الأب. واللافت أنّ الجهات الإدارية والخدمية للنظام الحاكم كانت تقوم بتقديم الخدمات من مياه وكهرباء وأرصفة وشبكات هاتف لهذه التجمعات العشوائية بعد نشوئها، في ظاهرة تعاكس ما تقوم به الدول عادة من تنظيم الأراضي للسكن وتجهيز الخدمات لها قبل البناء عليها.
ومن القوانين التي تمسّ بحقوق الملكية، القانون رقم 41 لعام 2004 المعدّل بالمرسوم رقم 49 لعام 2008، الذي يمنع إنشاء أو تعديل أو نقل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على أرض كائنة في منطقة حدوديّة، أو إشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، لاسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري، إلا بترخيص مسبق من وزير الداخلية، بناء على اقتراح وزير الزراعة، وبموافقة وزارة الدفاع. ويعتبر رفض وزير الداخلية هنا مبرماً غير خاضع للمراجعة، كما ينصّ القانون على أنّ المناطق الحدودية تحدّد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدّفاع. لقد استُخدم هذا القانون أساساً بمواجهة المعارضة السياسية في البلاد من خلال ربط كلّ العمليات المتعلقة بالعقارات الواقعة ضمن المناطق الحدوديّة بموافقة وزير الداخلية. كما أن عمق المنطقة الحدوديّة غير ثابت وقابل للتغيير والتوسيع، باعتبار هذه المنطقة تحدد بمرسوم بناء على اقتراح من وزارة الدفاع.
الانتهاكات المتعلقة بالعقارات في سوريا بعد عام 2011
خلال فترة حكم البعث وحتى نهاية حكم حافظ الأسد بموته عام 2000، حدثت تغيرات شاملة في سوريا، لصالح دولة الاستبداد وحكم الفرد المتمثل بالأسد الأب، وكانت القوانين التي من حق الرئيس إصدارها وفق دستوره أحد الأسلحة في فرض السلطة وإخضاع الناس عبر الاعتداء على حقوق الملكية بموجب نصوص تشريعية. وعند استلام بشار الأسد حكم البلاد خلفاً لأبيه، كان الحكم محاطاً بطبقة من المُوالين بعد إضعاف الطبقة السياسية القديمة، بل والقضاء عليها. وعندما بدأت المظاهرات الشعبية الرافضة لحكم آل الأسد، لم تكن السلطة مستعدة لأي تنازل للشعب، فكانت المواجهة بالنار والسلاح خياراً وحيداً للنظام الحاكم تجاه المحتجين. وبعد تطور الأمور، كانت السلطة تذهب بعيداً بتفكيرها وسلوكها، من خلال الاستعانة بالميليشيات الطائفية القادمة من الخارج. وتحت تأثير وحجم المعارضة، كان التهجير السكاني هو الخيار الجديد بعد تدمير المدن والقرى ومحاولة إحداث تغيير ديموغرافي، ليس باستخدام السلاح فحسب، بل باستخدام القانون سلاحاً قديماً-جديداً للاستيلاء على ملكيات المعارضة وحاضنتها الشعبية، وإحداث الهندسة السكانية التي يريدها النظام الحاكم.
ويعدّ الانتهاك الأكبر على الملكيات، الذّي أسّس للانتهاكات القانونية اللاحقة التي قامت بها حكومة دمشق، هو تهديم منازل وممتلكات المواطنين بالقصف بواسطة الطيران والصواريخ والمدفعية، وعبر اجتياح المدن بالدبابات بواسطة الجيش السوري والميليشيات الأجنبية الداعمة له منذ أواخر عام 2011، والذي أدى بطبيعة الحال إلى نزوح بشريّ واسع النطاق، داخل البلاد وخارجها، حيث بدأت هذه السلطة بإصدار مجموعة من التشريعات التي تنتهك حقوق الملكية، والتي سنستعرضها على سبيل المثال لا الحصر.
صدر قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 الذي أعطى الحق للنائب العام بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لكلّ من يرتكب الجرائم المتعلقة بالأعمال الإرهابية أو أية جريمة من جرائم هذا القانون
وهذا نصّ غريب حقوقياً، لأنه يُلزم المحكمة عندما تحكم على شخص بجريمة واردة في القانون، أن تحكم بمصادرة كل أمواله، ولأنّ حق الملكية مصان بغض النظر عن الجريمة التي يرتكبها الإنسان، وهو نصّ مخالِف حتى لدستور 2012 الذي كتبته السلطة الحاكمة، والذي تؤكّد المادة 15 منه على صيانة الملكية الخاصة. ومن الواضح أنّ إجبار المحكمة على مصادرة أموال المدعى عليه يهدف إلى إضعاف المعارضين عبر الاستيلاء على ممتلكاتهم باستخدام الأحكام القضائيّة.
وقد تلاه المرسوم رقم 63 لعام 2012 الذي خوّل الضابطة العدلية، في معرض تحقيقاتها بالجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الواردة في قانون مكافحة الإرهاب، أن تطلب خطياً من وزير المالية اتخاذ الإجراءات التحفظيّة على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهم، كما أعطى المرسوم الحق للنيابة العامة وقاضي التحقيق أثناء النظر بالدعوى بالحجز على أموال المتهم أو المدعى عليه، بما في ذلك منع السفر، وذلك إلى حين البت بالدعوى بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية
في عام 2012، صدر المرسوم 66 القاضي بإحداث منطقتين تنظيميتين في محافظة دمشق، لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي: الأولى تنظيم منطقة جنوب شرق المزّة من المنطقتين العقاريتين مزّة – كفرسوسة، والثانية تنظيم جنوبي المتحلّق الجنوبي من المناطق العقارية مزّة – قنوات بساتين – داريّا – قدم.
كان المرسوم خاصّاً بمناطق محددة من العاصمة، وهي مناطق شعبية وفيها سكن عشوائي، وقد أعطى إشارة لما تفكر به السلطة المذكورة وتهدف إليه من إعادة التوزيع السكاني في البلاد، بعد قصف المناطق وتهجير أهلها، وفقدان أغلب هؤلاء لوثائق ملكياتهم.
ورغم خطورة المرسوم المذكور، إلّا أنّ القانون رقم 10 لعام 2018 كان أكثر خطورة، حيث كان شاملاً لكل سوريا، وهذا ما جعل النقاش حوله والاهتمام به أوسع نطاقاً، إن على المستوى السوري أو الدولي. وقد تضمن القانون 10 تعديلات واسعة على المرسوم 66 المذكور، كما أن القانون رقم 42 لعام 2018 – الذي صدر إثر الضجة الدولية على القانون 10 – قد عدّل كلاً منهما، فيمكن القول إن القواعد الواردة فيهما أصبحت متشابهة.
نص المرسوم 66 وكذلك القانون 10 على أن الوحدة الإدارية تدعو المالكين وأصحاب الحقوق العينية، خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة العقارية، وبإعلان يُنشَر في صحيفة محلية، وفي إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والموقع الإلكتروني التابع لها وفي لوحة إعلاناتها، وذلك لأجل التصريح بحقوقهم، وعلى أيّ من هؤلاء المالكين وأصحاب الحقوق أن يتقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بطلبات يعيّن فيها محل إقامته ضمن الوحدة الإدارية، مرفقة بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه. هذه المدة كانت شهراً واحداً إذن، وقد مُدِّدت بعد صدور القانون رقم 42 لعام 2018 الذي يجعل المهلة سنة بدلاً من شهر
لكنها تجعل من المستحيل على أي صاحب حق أن يتمكن خلالها من تقديم وثائقه؛ لأسباب متعددة: منها الدمار الذي ألحقته قوات السلطة بالمدن والقرى والأحياء في مختلف أنحاء سوريا، وما نجم عنه من تهجير، وفقدان للوثائق بالنسبة لأكثر الناس من جهة، ومن جهة أخرى العدد الكبير من المطلوبين لأجهزة الأمن من سكان المناطق التي يراد تنظيمها، وخوفهم من مراجعة أي دائرة من الدوائر في البلاد، كما أن مراجعة أقربائهم نيابة أو وكالة عنهم يتضمن الخطورة نفسها على هؤلاء الأقرباء، أمّا توكيل محامين أو غيرهم بموجب وكالة ضمن بلاد اللجوء التي يتواجد فيها السوريون فتعترضه عقبات كثيرة من تعقيدات مقصودة تفرضها الأجهزة الأمنية لقبول الوكالات الصادرة خارج سوريا، وأخيراً فإنّ ظروف السوريين وتشتتهم في مختلف الدول، وحتى النازحين داخل القطر، يجعلهم غير مطلعين على ما تصدره الوحدة الإدارية من إعلانات تتعلق بأملاكهم.
ويتضمن المرسوم 66 وبعده القانون 10 إحداث صندوق خاص لكل منطقة تنظيمية لدى الوحدة الإدارية لتغطية كل نفقات المنطقة التنظيمية وإشادة السكن الاجتماعي والبديل، وتكون إحدى مصادر تمويله الإيرادات الناتجة عن عقود المبادلة أو المشاركة التي يُبرمها مجلس الوحدة الإدارية مع الأشخاص الاعتباريين المختصين، مقابل تمليكهم حصصاً في المقاسم العائدة للوحدة الإدارية وقيمة ما تبيعه من مقاسمها بالمزاد العلني. وهذا ما يفتح الباب للشركات الأجنبية – وخاصة الإيرانية منها – لتملك المقاسم تمهيداً لتمليك أعضاء الميليشيات الطائفية وإحلالهم محل السكان الأصليين.
الحقيقة أن المرسوم 66 والقانون 10 كانا من الناحية النظرية نتاجاً للقانون رقم 23 لعام 2015 الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن. وكان يفترض أن تصدر مراسيم وقوانين التنظيم العمراني استناداً إليه، باعتباره القانون العام الذي تضمن فكرة الاقتطاع المجاني من الملكية مقابل المنفعة التي يجنيها المالك، على أن يكون ما يتبقى من الأرض ملكاً لصاحبها وليس كما جاء في المرسوم 66 والقانون 10 من إلغاء موضوع التوزيع الإجباري واقتصار حقوق المالكين على أسهم ومساحات طابقية مقابل الأرض، في تجاهل تشريعي للقانون 23 المذكور. وهذا ما يشكّل انتهاكاً لحق التملك، باعتبار أن التنظيم يتم على أساس إنشاء أبنية طابقية عبر شركات التطوير العقاري العربية والأجنبية التي سُمح لها بفتح فروع لها في سوريا لممارسة نشاطاتها بموجب أحكام قانون التطوير العقاري رقم 15 لعام 2008، إضافة إلى الشركات القابضة التي أُجيز إحداثها بموجب المرسوم رقم 19 لعام 2015. وهذه الشركات تستهدف الربح بالدرجة الأولى، كما أنها تنفذ سياسة سلطات دمشق وداعميها، لذلك فإن إعطاء المالكين أسهماً ومساحات طابقية يجعلهم يخسرون أكثرية ملكياتهم.
وبما أنّ جميع مقاسم المنطقة التنظيمية المخصصة للمالكين وأصحاب الحقوق تغدو مملوكة على الشيوع فيما بينهم، بعد أن كانوا مالكين مستقلين في السجل العقاري، وتُسجَّل هذه المقاسم لدى المصالح العقارية باسم المنطقة التنظيمية، فقد وضع القانون 10 ثلاثة خيارات قسريّة أمام أصحاب الحقوق لتسجيل المقاسم ونقل ملكيتها بالسجل العقاري على أسمائهم: الأول التخصص بالمقاسم، والثاني المساهمة في تأسيس شركة مساهمة لبناء وبيع واستثمار المقاسم، والثالث بيع أسهمهم بالمزاد العلني، مما يفسح المجال أمام الشركات المذكورة لشراء وتملك هذه الحصص.
ومن المعلوم أن القصف الجوّي قد دمّر كثيراً من مباني السجل العقاري في مختلف مناطق سوريا، وأدّى ذلك لحرق أو إتلاف كثير من السجلات العقارية. فصدر المرسوم رقم 11 لعام 2016 الذي يتضمن وقف عمليات تسجيل الحقوق العينية في سجلات الملكية في الدوائر العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة، واستبدال ذلك بمَسك سجل يومي مؤقت تدون فيه معاملات إنشاء الحقوق العينية العقارية.
أما المرسوم رقم 12 لعام 2016 الذي صدر بعد إيقاف التسجيل في السجلات العقارية، فهو يشكل خطراً كبيراً على حق الملكية في سوريا، باعتباره يعطي الصفة الثبوتيّة للنسخة الرقمية لوقوعات الحقوق العينية المنقولة عن الصحيفة العقارية، ويجعلها أساساً لإنشاء نسخة ورقية للصحيفة المذكورة. ويتم الإعلان عن إنشاء نسخة ورقية طبق الأصل عن النسخة الرقمية سابقة الذكر في صحيفة محلية وإحدى صحف العاصمة، وتعلَن في بهو المحافظة والوحدة الإدارية أرقامُ العقارات ومناطقها وأسماء المالكين والإشارات المدونة على النسخة الرقمية، وتحدد فترة الإعلان بأربعة أشهر يتم خلالها قبول الاعتراضات، وهي مهلة غير كافية حتماً نظراً للظروف سابقة الذكر من تهجير وفقدان للوثائق وغيرها. والتي تمنع أصحاب الحقوق من العلم أصلاً بمثل هذه المراسيم أو وجود مُهَل للاعتراض والتقدم باعتراضاتهم. وهو ما يعطي الفرصة لسلطات الاستبداد ومعها مؤيدوها والميليشيات الأجنبية لتملّك عقارات السوريين الغائبين بالتلاعب بالسجلات العقارية بطرق غير قانونية، من خلال تقديم اعتراضات تتضمن ادعاء الملكية دون علم المالكين الحقيقيين.
أمّا القانون رقم 33 لعام 2017، الذي ينظّم آلية عمل إعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة كلياً أو جزئياً والتي ثبت فقدانها نتيجة الحوادث الطارئة، فقد تضمّن طريقتين، إدارية وقضائية، لإعادة التكوين. وما قيل عن القوانين سابقة الذكر يمكن أن ينطبق على هذا القانون، والذي لا تقل خطورته على ملكيات السوريين العقارية وفق الإجراءات التي يتضمنها، وهذه تهدف إلى إيجاد وثائق عقارية مدّعى بتلفها أو تضررها. كما أن المدد التي حددها القانون وطرق الإعلان لا تحتوي ضمانات بإمكانية علم أصحاب العقارات بها في ضوء التهجير وظروف السوريين التي تمّ ذكرها، وهذا ما يتيح لسلطة الاستبداد في دمشق تسجيل عقارات مدّعى بتلفها أو تضررها بغير أسماء مالكيها الأصليين.
ويأتي القانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة الأنقاض نتيجة القصف أو لخضوعها لأحكام القوانين النافذة التي تقضي بهدمها ضمن سياق القوانين التي تنتهك الحقوق العقاريّة، حيث يقرّر المحافظ تحديد المنطقة العقارية والمباني المشمولة بهذا القانون ويُنشَر في الجريدة الرسمية وفي صحيفة محلية ويُعلَن في بهو المحافظة لمدة خمسة عشر يوماً، ويعطي لمالكي العقارات والأنقاض ولكل ذي مصلحة مهلة ثلاثين يوماً للتقدم بالوثائق المؤيدة لحقوقهم. ويكون قرار لجنة التوصيف والتثبت من الملكية قابلاً للاستئناف أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً أيضاً. ويصدر قرار محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة مبرماً، ولا يوقف الاستئناف المذكور الذي يتقدم به المالكون إجراءات البيع بالمزاد العلني التي تُجريها الوحدة الإدارية للأنقاض التي يودع ثمنها في أحد المصارف العامة لصالح من يثبت ملكيته.
الآثار المترتبة على الانتهاكات العقارية
من المعلوم أنّ ما يقترب من نصف الشعب السوري أصبح نازحاً أو لاجئاً استناداً إلى تقارير المفوضيّة السامية لحقوق اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والتي قدرت عدد اللاجئين السوريين بـ6.7 مليون،
وتبدو مشكلة اللاجئين مستمرة، سواء على صعيد معاناتهم الشخصية أو على مستوى موقف الدول التي تستضيفهم كلاجئين وترغب بإعادتهم إلى موطنهم. وفي ضوء المخاطر والانتهاكات المرتكبة بحقهم وحق ممتلكاتهم ثمة ما يستدعي حلاً حقيقياً لمشكلتهم تحت هدي القوانين والأعراف الدولية.
كما تؤثر القوانين التي تنتهك الحقوق العقارية على إعادة الإعمار التي يتوجب حصولها بعد انتهاء ما تطلق عليه الأدبيات الحقوقية الدولية «فترة الصراع». فالمجتمع الدولي يريد إعادة إعمار تستند إلى بيئة سياسية وأمنيّة مستقرّة وناتجة عن حل سياسي للمسألة السوريا، بعيداً عن حالة الاستبداد والتفرد بالحكم، إضافة إلى البيئة القانونية والتشريعية المناسبة للقيام بأعمال إعادة الإعمار، والتي يجب أن تكون شاملة لبناء المجتمع والمؤسسات، في حين تريد سلطة الاستبداد من إعادة الإعمار وسيلة لشرعنة استمرارها في حكم البلاد واستخدام إعادة الإعمار مكافأة لمواليها وداعميها من دول وميليشيات، والاقتصار على البناء المادّيّ فقط، إضافة إلى منع اللاجئين والنازحين من العودة لأراضيهم وممتلكاتهم بعد الاستيلاء عليها باستخدام التشريعات التي ذكرناها، وإحلال سكان آخرين مكانهم تحقيقاً للمجتمع المتجانس الذي تحدّث عنه رأس النظام الحاكم بتاريخ 20 آب 2017.
الخاتمة والتوصيات
من الثابت ومن خلال ما تم بيانه أن مسألة الانتهاكات للملكية العقارية التي تقوم بها سلطة الاستبداد في سوريا لم تكن جديدة، بل إنها بعمر هذه السلطة الذي يتجاوز الخمسين عاماً. ولكن الانتهاكات الأكثر خطورة وتأثيراً هي تلك التي بدأت بعد عام 2011، والمتمثلة بالتدمير واسع النطاق لمساكن ومنشآت السوريين في كل المحافظات، والقوانين التي تستهدف ملكيات الحاضنة الاجتماعية والشعبية للمعارضة، بهدف سلبها وحرمانها منها، ومنع عودة اللاجئين السوريين، وإحداث تغيير ديموغرافي يناسب استمرار هذه السلطة، وإضعاف خصمها الشعبي. وهذا بدوره يؤسّس لصراع اجتماعي مستدام، ويمنع تحقق السلم الاجتماعي في سوريا على المدى الطويل بعد انتهاء فترة الصراع، ويجعل الوصول إلى سوريا مستقرّة تتحقق فيها أهداف السوريين في دولة حرّة وديمقراطية لكل أبنائها، دونه صعوبات كثيرة. لذلك فإننا نرى أنّ التوصيات التالية يمكن أن تشكّل بعضاً من الحل للمشكلة التي نحن بصددها:
- الحل السياسي الجذري العادل للمسألة، والذي يعيد السلطة للشعب وينهي سلطة الاستبداد بإرادة وإشراف الأمم المتحدة.
- إنشاء العقد الاجتماعي السوري لسوريا الجديدة الديمقراطية عبر دستور نابع من الإرادة الشعبية، والذي يتضمن نصوصاً تحمي الملكية للسوريين.
- مراجعة وإلغاء كل القوانين الجائرة التي تشكّل انتهاكاً لحقوق الملكية في سوريا.
- توفير البيئة الآمنة والهادئة والمحايدة لتمكين الشعب السوري من ممارسة حقوقه السياسية والمدنية بحريّة وعودة النازحين واللاجئين عودة طوعية وآمنة وكريمة.
- إعادة إعمار سوريا إعماراً شاملاً وعادلاً بإشراف الأمم المتحدة ومن خلال هيئة مستقلّة يقررها الشعب السوري.