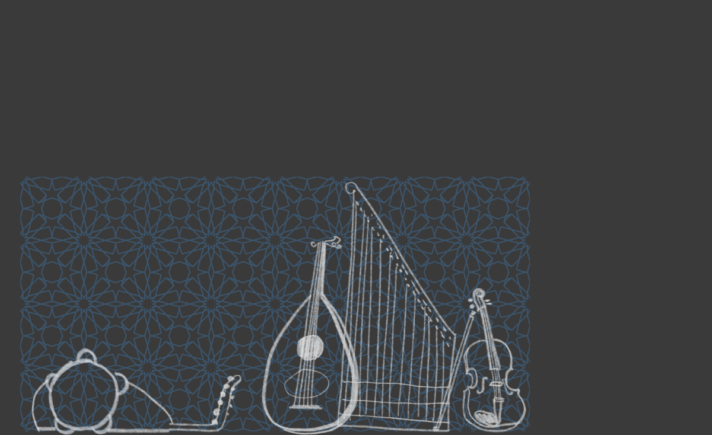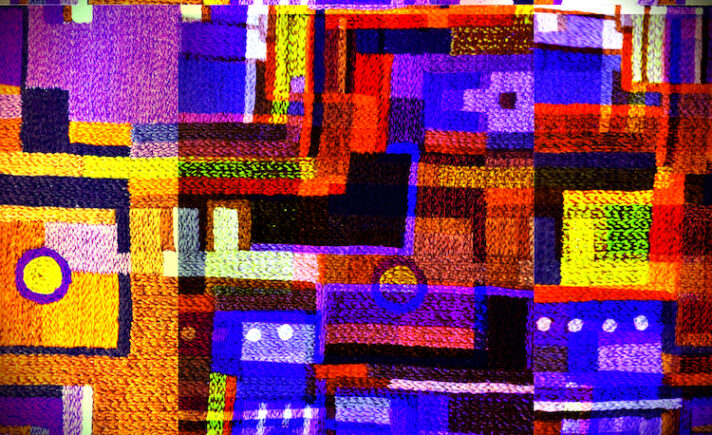تعريف غير المعرّف
أصبح سؤال الهوية سؤالاً ملحّاً أكثر من أي وقت مضى، لا سيما في الجولان المحتل، في سياق التحوّلات والتغييرات الدراماتيكية والصادمة الأخيرة في الشرق الأوسط عامة وفي سوريا على وجه الخصوص. في مادّتي الأولى في زمالة الجمهورية للكتّاب الشباب، كتبت عن انهيار المسلّمات والقوالب التقليديّة في المجتمع الجولاني نتيجة لأحداث الثورة السّورية وما أثّرت فيه على القرى المحتلّة. تعالج هذه المادّة بشكل مفصّل الهوية الوطنيّة والقوميّة والسياسيّة، ولكنّ الطرح بكونه مستعاراً من مجال الهوية الجنسية والجندريّة، فقد يصلح أيضاً لوصف مركّبات أخرى في الهويّة وممارساتها.
استكمالاً للمادّة الأولى، أريد هنا طرح معالجة أعمق لممارسات الهويّة في الجولان المحتل بحيث يكون الاستنتاج الأساسي أن هنالك ممارسة «كويريّة» في ما يتعلّق بالهويّة الذّاتيّة على مختلف مركّباتها في المجتمع السّوري في الجولان المحتل، وأن هذه الممارسة باتت أداءً يوميّاً قد يمثّل عامةً طريقة للتعامل مع الحياة في سياق أزمات تغيّر وتبدّل وتحطّم البُنى والمسلّمات الإجتماعيّة. برأيي، إن المجتمع في الجولان السّوري المحتل يعيش هذه التغييرات الصعبة بشكل سريع وصادم، ويحاول التعامل معها بشكل خاصّ ومعيّن. وهو مثال واحد فقط من أمثلة كثيرة في الشّرق الأوسط والعالم.
اعتمد في هذا المقال على معالجة الهوية على أنّها هوية أدائيّة – بمعنى أنها هويّة يقوم الأفراد والمجتمع بممارستها تحت شروط معينة – في مكان أو زمان معيّن، وذلك بالاعتماد على نظريّة جوديث باتلر في الجندر – «الجندر كأداء». هنا، يجب القول أن الحالة الاستعماريّة الاسرائيليّة، إضافة للحالة التي تشكّلت في الجولان ما بعد الثّورة السّورية تخلقان معاً (بحيث لا يمكن فصلهما كثنائيّ فاعل ومغيّر سلباً أو ايجاباً على المجتمع في الجولان المحتل) أزمنة وأمكنة مختلفة في مساحة واحدة، بحيث على الجولانيّ التفكّر بكيفيّة التّعايش والتكيّف معها وتشكيل وعيه وتعريفه لنفسه وفقها.
يكتب بينيدكت أندرسون في كتابه الجماعات المتخيّلة عن منبع الأيديولوجيّة القومية، ويصفها كظاهرة مجتمعيّة سياسيّة حديثة، غير موجودة في حقب ما قبل الحداثة. يقول أندرسون أن القومية هي شيء متخيّل، ويتكلّم عن مفارقات مختلفة في الفكرة القومية تثبت كونها نتاج ظواهر الحداثة في أوروبا.
أسباب ظهور الفكر القوميّ بحسبه تتعلّق بانهيار ثلاث أفكار مهمّة مع مجيء «الحداثة»: فكرة اللغة المقدّسة (اللاتينيّة) وفكرة المصداقيّة الالهيّة للحكم الملكيّ، وفكرة الزمن التي تربط التاريخ الانسانيّ والكوزمولوجيا معاً، أي أن للعالم وللإنسانيّة نفس المصدر الإلهيّ. وكل هذا بشكل طبيعيّ يتعلّق بالفكر الدينيّ. يزعم أندرسون أن انهيار هذه المنظومات أدّى لتكوّن مساحة فارغة، ملأتها القوميّة. في هذا السياق نستطيع أن نرى الفكر الديني والفكر القومي كبُنى موازية وشبيهة.
تصبح الأمّة في هذا السياق، مجتمعاً سياسيّاً متخيّلاً، لأن أفرادها جميعاً غير قادرين على التواصل المباشر ما بينهم، أي معرفة بعضهم حقاً، فيصبح ما يربطهم هو الشعور القوميّ/الوطنيّ المشترك، المتخيّل. وإن أخذنا بأقوال أندرسون، نستطيع معاينة الهويّة القوميّة أو الوطنيّة كهويّة غير جوهريّة – بل كنوع من المظهر أو الممارسة اليوميّة والموسميّة، بحيث تظهر هذه الهويّة للعين بالأخص في المناسبات الوطنيّة وفي بعض الطقوس الشبيهة أحياناً بالعبادات، كالنشيد الوطني وأعياد الاستقلال. هذه الممارسات في السياق المطروح أعلاه تصبح ممارسات استراتيجيّة وضعيّة «لحظويّة» (أي متعلّقة باللحظة – التاريخية، أو التوقيت المعيّن في الشهر أو السّنة)، وسرعان ما تصبح عناصر أساسيّة ومهمّة في بناء الحيّز الشخصي والحيز العام. ومن هناك، تصبح أحجار الزاوية التي تبني الإدراك الفرديّ والجماعيّ. والفكرة هنا أن الواقع يخلق التعاريف والهويات، وليس بالعكس.
تفهم السرديّة التاريخيّة كسلسلة أحداث كرونولوجيّة يكسوها غلاف قصصيّ، أي أن السرديّة التاريخيّة هي طريقة لمعالجة وطرح الأحداث الكرونولوجيّة بإضافة مكوّنات قصصيّة. هذه هي فكرة السرديّة التاريخية الكلاسيكيّة، وهي التي تنتهجها الهويّات عامة والهوية القوميّة خاصّة. فتفصل السرديّة التاريخيّة بين الزمن المتخيّل (كما المجتمع المتخيّل، أيّ الزّمن وأحداثه كما ندركهم ونعيد انتاجهم في وعينا الجماعيّ والفرديّ) وبين الزمن القصصيّ بشكل يلائم أساس بنيويّ.
يرى هايدن وايت السرديّة التاريخيّة كنتاج أدبيّ معرفيّ نثريّ فيه وصف لتطوّر أحداث بشكل منطقيّ. يصبح التأريخ، وبالتّالي التاريخ، لوناً من ألوان بُنى القصّة أو الرواية، يمكن سرده بعدّة طرق مختلفة بواسطة التّشديد على أمور معينة وإغفال أخرى. مما يعني أنه من المستحيل أن نكتب تاريخاً بحسب الحقيقة المطلقة الموضوعيّة.
بسبب هوس الانسانيّة، ولا سيما مفكري ومنظّري عصر الحداثة بفكرة اليقين، أصبحت العلاقة بين الحقيقة والموضوعيّة علاقة مهمة جداً، وبحسب وايت، فإنها علاقة معدومة أو حتى مستحيلة. ولتجنب هذه الفكرة الكئيبة، نستطيع أن نرى السرديّة التاريخيّة وعلاقتها مع الحقيقة بشكل آخر، وذلك عن طريق مصطلح «الواقعيّة العمليّة» الذي طرحته جويس أبلبي ولين هانت ومارغريت جاكوب في ردّهن على وايت، وهو يمثّل شكلاً أقل قطعيّة من الواقعيّة، ولكنه لا يزال صنفاً من واقعيّة ترى اللغة والكتابة كنتاج لتفاعلنا ولقاءنا بالعالم الحقيقيّ (سأطلق عليه اسم الحقيقيّ الكلّيّ هنا) وهكذا يصبح منظور أو جزء معيّن من الحقيقة التامّة ممكن للكتابة والسّرد والتّعامل، فيصبح هدف التّاريخ «العلميّ» ممكن تحت إطار حقيقة براغماتيّة معيّنة، مما يعني حقيقة تتحقّق في الممارسة، وهي أحدى أوجه الحقيقة في عالمنا.
إن الطريقة التي يرى بها وايت التّاريخ كسرديّة قصصيّة، تكوّن أزمة ما بسبب ارتباط التاريخ الوطيد بالهويّة القوميّة والوطنيّة، فعندها نتوجّه إلى انتهاج منظور كالواقعيّة العمليّة، التي تتعامل مع الحقيقة بشكل نسبي ومريح لهكذا حالات، ممّا يحدث السلوك «الكويري» في الهوية، وهذه الصّيرورة التي خلقت ممارسة الهويّة في الجولان المحتل بعد 2011 بفعل واقع يفرض تعريفات قسريّة كل الوقت، سآتي على ذكره لاحقاً.
المكان والزّمان الجولانيّ
تعمل اسرائيل بتعريفها وفق مبدأ الابادة، الذي تتشاركه مع نظام الأسد، وذلك باعتبار الاثنين بنية عوضاً عن حدث عينيّ، أي أن النظام الأسدي والدولة الاسرائيلية يطبّقان الإبادة كحدث تاريخيّ بموجب طبيعتهم المبنيّة على مجموع أحداث وظواهر وعناصر اجتماعيّة لا يمكن تعريفها بمعزل عن علاقاتها مع هذا المجموع، بحيث يصبح هذا المجموع بنية حقيقيّة وذات معنى بفضل الوعي الانسانيّ الذي يراها ويعيها ويتعامل معها وضدها، فيصبح فعل الإبادة جزءاً من هذا المجموع الذي يكوّن بنية النظامين، ولا يمكن فصله وتعريفه بمعزل عن البنية الأسديّة أو الاسرائيليّة التي تضمّه.
هكذا تصبح ابادة السكان –«الأصليين» في حالة إسرائيل و«غير المتجانسين» في حالة النظام – بهدف «الهدم من أجل الاستبدال» مما يعني استبدال المجتمع الاصليّ/غير المتجانس بالنظام المجتمعيّ الاستيطانيّ/المتجانس، وهذا التطابق شبه التام يمكنّنا من أن نرى النظام الأسديّ كنوع من الاستعمار الداخليّ. ولهذا أمثلة كثيرة في الأراضي المحتلّة وفي سوريا، كالمستوطنات في الجولان السّوري المحتل وكمخيّم اليرموك اليوم في جنوب دمشق.
قامت اسرائيل بأوسع عملية «هدم بهدف الاستبدال» في تاريخ الصراع العربي-الاسرائيليّ في الجولان عام 1967، بحيث تم تهجير 130 ألف نسمة، لم يبق منهم غير 6 آلاف. وبالمقابل، مع الاحتلال الفعليّ الاسرائيليّ للمكان السّوري في الجولان، جرى احتلال للزمن السوري، وفرض زمن اسرائيليّ قام على محو الزمن السّوريّ، تماماً كما احتلّ الزمن البعثي الزمن السّوريّ. فأصبح الأبد («لانيتساح» بالعبريّة) شعاراً سياسيّاً اسرائيليّاً، يُستعمل دائماً عند ذكر الجولان المحتل، وهو يمثّل الإبادة عامة وإبادة الزمن السوريّ خاصّة. وهنا يقول ياسين الحاج صالح، في سياق «الأبد» البعثيّ، في مقالته التي الهمت هذا التحليل: «دولة إبادة، وليس نظام دكتاتوريّ» أنّه: «دخل الأبد كشعار سياسي في سورية في ثمانينات القرن العشرين بارتباط وثيق مع المذابح والإبادة. أقصد بالإبادة التوسُّعَ في قتل الناس بغرض تأمين السلطة عبر الزمان، ومنع التغيير. ليس القتل هنا عقابياً ولا حتى انتقامياً، إنه تحطيمي واستئصالي، عينه على استعباد من لم يُقتَلَوا، وعلى خلود القاتلين».
أولاً، قام الاحتلال الاسرائيلي في الجولان باحتلال المكان وتبديل الزّمان، وبعدها بدأ بمحاولة احتلال النفس، وهذا ما جاء بالحراك الشعبي المقاوم للاحتلال، الذي لم يظهر إلا في نهاية السبعينات عندما بدأت اسرائيل محاولة فرض الجنسيات الإسرائيلية على المواطنين السوريين واستبدال التعريف الذاتيّ الجمعيّ السوري بالإسرائيلي. إن محاولة فرض الجنسيات التي فشلت فشلاً ذريعاً بعد إقامة اهل الجولان لإضراب دام نصف سنة ضد هذا الفرض عام 1981-1982، هي تجسيد لاحتكار اسرائيل للتعاريف. حتّى عام 2011، كان في الجولان خطابان متناقضان وقويان: الخطاب الإسرائيلي الاستعماري، والخطاب السوري الوطنيّ القوميّ، الذي مر بتغييرات ومراحل عدّة حتّى 2011، عندها أضيفت عدّة خطابات قسّمت الخطاب السوري الوطني القومي بين المعارض والمؤيد للنظام. قبل 2011، أنتجت القطبية بين الخطابين الكولونيالي والوطنيّ على الرغم من كل شيء حالات وجوديّة وممارسات «شيزوفرينية» نوعاً ما على الجولانيين والجولانيّات الباقيين في أرضهم التعامل معها. وإن كانت النفس السوريّة في الجولان المحتل قبل 2011 عليها أن تتكيّف وتتواجد وتعيش مع خطابات وممارسات متقطّبة وثنائيّة، فالثورة السوريّة هي نقطة التأزّم الأهم، حيث تمّ تذويت الفقدان الذي حدث بسبب الفصل القسري عن الوطن والعائلة والفشل المتكرر في تحقيق الهويّة والوصول إليها.
بعد 2011، أصبحت ممارسات الهوية في الجولان المحتل وأداؤها تعتمد على سياق المكان والزمان الذي يوجد فيه الفرد. ولأن المبدأ الأساسي في تركيبة اسرائيل وفي تركيبة نظام الحكم في سوريا هي السيطرة على الزمان والمكان، فنرى ممارسات لهويات في أمكنة وأزمنة معيّنة، واخفاءاً لها في أمكنة أخرى وأزمنة أخرى. ففي الحملة الشعبية لمقاطعة الانتخابات الإدارية الإسرائيلية في الجولان (أكتوبر 2018)، نرى الهوية السورية «الحياديّة» (بمعزل عن سياق الثورة والنظام) تحت علم سوريا الرسميّ في وجه قوات الاحتلال العسكريّة، بينما نرى على مدرّج مقبرة الشهداء إحياء لأيّام الجمعة وفق الثورة السورية تحت علم الثورة السوريّة، وفي ساحة سلطان باشا الأطرش نرى احتفالات عيد الجلاء مع صور الأسد الأب والابن، لنرى بعدها معارضين ومؤيدين على تلّة الصيحات، بلا أي علم فوقهم، يلوّحون لعائلتهم المبتورين عنهم منذ الاحتلال، وفي أماكن أخرى نرى نوعاً من الإخفاء للهوية السورية، كمداخل البلدات في الجولان، التي تلعب دوراً مركزياً في اقتصاد المجتمع المحليّ حيث تمثّل الشوارع السياحيّة، فنجد اللافتات باللغة العبريّة، ونجد فرقاً بين ادائيّات الهويّة في «الحارة الغربيّة» (مدخل القرية السياحيّ) وبين «الحارة الشرقيّة» الموازية لخط وقف إطلاق النار.
بيت ومنفى وسجن
ضمن هذه الممارسة «الكويريّة» للهويّة يأخذ التّعريف القسريّ الذي أعطته اسرائيل لأهالي الجولان في أوراقهم الثبوتيّة «غير معرّف» معناه التّام. فنحن نعيش في البيت والسّجن والمنفى في الوقت نفسه