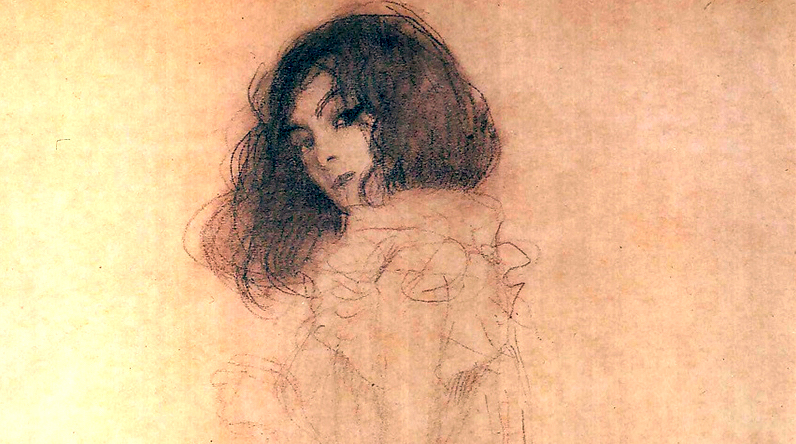غالباً ما يرتبط الطلاق في ذاكرتنا بالعار، فهو سبيل لتفكك العائلة وتشرذم الأولاد، ومصدر للخجل والإحساس بالإهانة والفشل، تمتدّ تبعاته السلبية إلى كلّ أفراد العائلة، ويبقى وصمة عار ترافق المرأة المطلقة بالدرجة الأولى، ثم بناتها وأبنائها، وأهلها، إلى أجل طويل غير مسمّى. من أجل ذلك وغيره من الأسباب التي تختلف بين حالة وأخرى، يعتبر الطلاق في المجتمع السوريّ كارثة ينبغي تجنّبها بأي ثمن، فهو الشرّ الأعظم، ومن الجيّد إبعاد شرارته عن العائلة، وذلك بأن تدفع المرأة هذا الثمن غالباً، وتصمت، فواجب الصبر يقع على عاتق المرأة بالدرجة الأولى، وإن لم تنجح، فالطلاق عار عليها!
لكن وقْع الكلمة جاء غريباً على مسمعي عندما قالتها ليلى؛ إنها تتحدث بكلّ فرح وحماس عن بدئها بإجراءات الانفصال عن زوجها، مستخدمة كلمة طلاق ولكن بإيقاع سعيد لا يحمل أيّ شعور بالعار، كما لو أنها عندما تقولها تحمل معنى مختلفاً عن كلمة طلاق التي اعتدنا على سماعها.
ليلى أم لأربعة أولاد وبنات، تبلغ من العمر اليوم 42 عاماً، تروي قصّتها والابتسامة لا تفارق وجهها. «عم إتمسخر على حياتي» هذا ما قالته عندما سألتها عن سبب تلك الابتسامة.
قابلتُها عن طريق صديقة مشتركة، ولم يَطُل الوقت حتى تتالت لقاءاتنا. هي سهلة المعشر، مَرَحُها وحيويتها، بالإضافة لمحبتها، يجعل منها إنسانة مقربة في وقت قصير، وهذا بالضبط ما سهّل عليّ إشباع فضولي لمعرفة المسار الذي قادها إلى هنا.
ما هو الطريق الذي سلكته ليلى حتى بات الطلاق بالنسبة لها أمراً لا يرتبط بالعار، بل بالتحرر والفرح؟
عالوعد يا كمّون
تروي ليلى حكايتها:
وكأن الحياة منذ ولادتي كانت مصرّة ألا أرتاح فيها، لكنني عنيدة، وعاندتها!
ولدتُ في عائلة محطّمة، أب بسيط، ضعيف الشخصية، وأم متجبرة، قادرة، وظالمة. أعتقد أنها فقدت جزءاً من رشدها وتضعضعَت نفسيتها بعدما ورثت أموالاً من أهلها، وخلال وقت قليل خسرتها كلّها، بسبب عدم تدبيرها، ومصاريف أدويتها وأمراضها الكثيرة. طردَتنا أنا وإخوتي مرات عديدة من البيت، وكانت نوبات غضبها تتعاظم عندما يصرّح أحدنا برغبته/ها بمتابعة الدراسة. كانت أمي تتصرف كما لو أنها ترى في التعليم الخراب الأعظم، ولم تكن أبداً تُعلن عن سبب موقفها هذا، لكنني أعتقد أنها كانت تكره كلّ ما من شأنه أن يجعل من حياتنا هانئة ويجعلنا سعداء. كانت ترغب في رؤيتنا تعساء، وكأنها تعاقبنا على فعل لم أعرفه حتى يومنا هذا. أمي تكره كل من وما حولها، بما في ذلك ذاتها!
أبي المسكين، الحنون، يحبّ أمي حباً جماً، ويحزن لِمَا هي عليه من قسوة مرضيّة تجاه أولادها وبناتها. وقد ساعد إخوتي الشباب على شقّ طريقهم والعمل في عمر مبكّر، كما شجعهم على الزواج المبكّر، وبالطبع لم ينسَ بناتِه، وبطرق غير مباشرة كان يحثّ أقاربنا على الزواج من إحداهنّ. كنت أعرف أنه يذهب ويطلب منهم أن يأتوا ليرَوا بناته، ويسعوا في تزويجهنّ، كي يساعدهنّ على الخروج من جحيم البيت، فلا قوّة لديه ليحمينا منه إلا بإبعادنا، بناتٍ وصبياناً.
أنا، العنيدة، قاسيت وتحمّلت أكثر من أَخَواتي اللواتي تركن المدرسة مبكراً – أقصد مبكراً جداً، فأختي الكبرى لم تتعلم، والثانية درست الصف الأول الابتدائي فقط، أما أنا فقد صمدت حتى التاسع، ونجحت فيه بعلامات جيدة.
كنت أنهض في الثالثة فجراً، أطبخ، أغسل وأرتب البيت، ثم أدرس، وفي السابعة صباحاً أتوجه إلى المدرسة، وعند عودتي أبدأ بإعداد الطعام لأمي التي لا تقوى على النهوض أو القيام بأي عمل منزليّ منذ أصابها ما يشبه الشلل الكلّي، ولأبي الذي كان مريضاً جداً في تلك السنوات. أطعمهم ثم أتوجّه للترتيب، والغسل، والقيام بكلّ ما قد يتطلّبه بيت فيه عجوزان وأخ شاب يعمل بالشحم والزيت.
صيفَ عام 1993، وهي سنة حصولي على الشهادة الاعدادية، نجحت إحدى جاراتنا بتدبير «عريس» لي. لم أكن أرغب بأي شيء في ذلك الوقت إلا إكمال الدراسة والدخول إلى الجامعة. وببعض الراحة؛ فقد تعبت جداً من الصراع اليومي ومحاولتي أن أدرس في السرّ، بعيداً عن ناظرَيْ أمّي. كان بيتنا يشبه الحجيم.
«هو وعدني إقدر كمّل دراستي بعد الزواج، وأبي وعدني إخلص من ظلم وقهر إمي… بس التْنين ما وفوا بوعدن إلي».
تزوجتُ في عمر السادسة عشرة، وبدأت أشعر بمرارة وجود الزوج والزواج منذ ليلة العرس. بعد ثلاثة أشهر كنت حاملاً، أنجبت ولدي الأول، وفي السنة اللاحقة أنجبت ولدي الثاني، وبدأت أشعر بالإنهاك، فزواجي هو اغتصاب يومي؛ عذاب وقرف وتوتّر لا ينتهي. لقد كنت في حبس، فلم يكن يسمح لي بالذهاب إلى بيت أهلي أو الاهتمام بهم، ولا باستقبال إخوتي أو جاراتي في البيت. كان على شجار دائم مع إخوتي الشباب، وكان يمنعني من زيارتهم أو حتى رؤيتهم. وصلت إلى مرحلة اللاتحمّل، أخدت طفلَيَّ وهربت إلى بيت أهلي. استقبلني أبي بالدموع، وأمّي بالطرد. «يمكنك البقاء هنا لوحدك، أما الأولاد فلا… هدول ولادو، مو ولادك». لم أستفق من صدمة كلامها حتى جاء زوجي وحَمي، وما قاله لي وقتها كان أقسى من قول أمي: «طالما هدول التنين عايشين (يقصد أبي وأمي)، فيكي تجي تشوفيهن، بس وقت يموتوا ماعاد إلك جية عهاد البيت»، قال ذلك أمام أبي وأمي بكل قسوة، وبرودة. حقاً كنت في صدمة مضاعفة حينها (تبتسم وتتابع)، «ما لحّقت إبكي، قبل ما تنزل الدمعة، وقع عمّي عالأرض، يمكن إجيتو جلطة وقت سمع حكي ابنو». خرجت من بيت أهلي محمّلةً بأولادي، وجروحي وقهري، وعدت إلى جحيمي الزوجيّ.
*****
تتحدّث ليلى عن زوجها وتقول «هو»؛ لا تلفظ اسمه، حتى أنها استغرقت ثوانيَ كثيرة للإجابة على سؤالي لها: ما اسم زوجك؟ بدت وكأنها قد نسيت اسمه.
زرتُها عدّة مرات، وتعرّفت على أولادها، لمست مدى صداقتهم معاً، وانسجامهم. سبق أن قالت لي في عدّة مناسبات إنها تشعر بالراحة والسعادة معهم، وبدافع قويّ لتمشي إلى الأمام، وهذا ما رأيته في تصرفاتهم ونكاتهم وضحكاتهم معاً. تبدو ليلى أختهم، لا أمهم؛ فملامحها وقصر قامتها، وأسلوبها في اختيار الملابس، بالإضافة للطريقة التي تتحدث فيها معهم، كله يبعث في البيت جوّاً لذيذاً من المرح. في إحدى زياراتي تَصادف وجودي مع مجيء زوجها من العمل، وفجأة تغيّر المكان وأصحابه؛ شعرت بارتباكهم وتوتّرهم جميعاً، وقد انتقل هذا التوتر لي، فما كان منّي إلا أن اعتذرت ورحلت.
غريبةٌ هي ملامحنا وتغيراتها، علاقاتنا وتعقيداتها، وقيودُنا التي تجعل من أيامنا بؤساً حقيقياً. نعتصر ألمنا ونختبئ في الظلّ، خوفاً من الوقوف في عين الشمس. نستمرّ في الحفاظ على علاقات موجعة، نتوجّع ونتوجّع ويتراكم القيح… ولماذا كلّ هذا؟!
بيجي الولد وبتجي رزقته معه!
تحكي ليلى:
كنتُ قد سمعت من أخواتي اللاتي تزوّجن قبلي عن طرق منع الحمل، وقد كنت حريصةً جداً في أشهر زواجي الأولى. «ما بدي جيب اولاد، بدّي كفّي دراستي، لهيك تزوجت، ما تزوجت لجيب ولاد فوراً». لكنني فوجئت بعد ثلاثة أشهر بحملي، وخلال أيام الحمل والولادة الأولى لاحظت أن اهتمامي بطفلي يُشغلني عن التفكير بجحيم زواجي، وبكل خيباتي.
لم تمضِ سنة أخرى حتى كنتُ أماً لولدين، شَغَلاني عن كل الدنيا، كبِرا وكبُرت أحلامي معهما، وعندما بدأ الأولاد بالخروج من المنزل واللعب في الحارة، أو عند ذهابهم إلى الروضة، كنت أشعر بالقلق والتوتر. فقد يأتي زوجي في أية لحظة ويطلب مني أن أقترب منه. «كنت إكره اتطلع بوجهه، إكره قول إسمه بيني وبين حالي، كنت إقرف من حالي وقت كون جنبه، كتير كان يغتصبني… بالحلال».
يصفرّ وجه ليلى، ومع ابتسامتها الساخرة تكمل وتقول: «حسيت إنو الاولاد هنن حجتي لحتى كون مشغولة وبعيدة، وكل ما يقرّب مني، كنت إتحجج لقوم طعمي أو إهتم أو غيّر حفوضة للولد… الأولاد هنّن الحلّ، هيك كنت فكّر، وجبت بنتين كمان، الكبيرة اليوم بصف التاسع، والصغيرة بصفّ الخامس».
رحمة ولو كان فحمة!
في سوريا كانت ظروفي معقدة، المجتمع والعائلة وكل من حولي يرفض فكرة الطلاق، وهنالك الكل يشارك في أية فكرة أو قرار، وأحاديثهم كلها تنتهي إلى المثل الذي يقول «الرجال بالبيت رحمة ولو كان فحمة». إنه لَمثل قبيح وخاطئ، لكنني حينها لم أكن أجرؤ حتى أن أفكر بالطلاق، فلا مكان ولا عمل ولا سند لي. «نصيبي وبدي إصبر عليه».
*****
لم يكن ممكناً بالنسبة لليلى في سوريا أن تنفصل عن زوجها، أولادها وبناتها كانوا صغاراً، ولم تكن تتلقى أي دعم من عائلتها، والمجتمع يحاصرها باعتباراته المتعلقة بضرورة الحفاظ على الزواج، أما القانون السوري فهو لا يساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق المتعلقة بالزواج. لم تكن ليلى تعرف أية معلومة حول قانون الأحوال الشخصية، لكن ما كانت تسمعه من هنا وهناك أن الانفصال عن الزوج بالغ الصعوبة ما لم يكن الزوج يريد هذا الانفصال، وأن انفصالها عنه قد يحرمها من أولادها وبناتها. والواقع أنها كانت مصيبة في هذا التصور، لأنّ رفعها لدعوى تفريق ضد زوجها أمر معقّد ومُكْلف في سوريا – مالياً واجتماعياً – ولأنها قد تخسر حقها في حضانة أطفالها ببساطة بعد إنهاء الزواج. ومن بين الأسباب التي قد تؤدي إلى خسارتها هذا الحق زواجُها من رجل آخر، أو أن تعمل خارج المنزل إذا أثبت طليقها أن عملها خارج المنزل يؤدي إلى عدم تقديم الرعاية الكافية للأطفال. وفي الوقت نفسه، لن تكون النفقة التي سيفرضها القانون على الزوج كافية. كما أنها كانت ستخسر حضانتها لأولادها الذكور بمجرد تجاوزهم سن الحادية عشرة، ولبناتها بمجرد تجاوزهن الثالثة عشرة.
كان تفكير ليلى في السير بخطوات جدية للانفصال عن زوجها في سوريا أمراً مستحيلاً بدون دعم عائلتها. كانت داخل سجن محكم الإغلاق، يتشارك القانون مع التقاليد الاجتماعية مع قسوة الأهل في إغلاقه. أما في تركيا، فإن ظروفاً جديدة ستساعد ليلى على امتلاك قرارها ومصيرها.
شو بدّي بالبلاد/ الله يخلّي الاولاد
انتقلت ليلى إلى اسطنبول سنة 2013، فالحرب تشتعل وتأكل البلاد وأولادها؛ تقول:
لا شيء سيقف في طريق حمايتي لأولادي، لا سفر ولا خطر. دخلتُ مع أولادي إلى تركيا بطريقة غير شرعية، كما أغلب السوريين في ذلك الوقت. لم أكن أعرف ما الذي سينتظرنا هنالك، ولكن الخوف واقتراب أعمار طفلَيَّ الكبيرَين من سن الخدمة العسكرية الإلزامية جعلا من قراري سريعاً ونهائياً. سنرحل!
بمساعدة بعض الأقارب استأجرنا بيتاً. «هو» بقي في سوريا، لأنه موظّف وكان يحاول تسوية أوضاعه الوظيفية قبل السفر. «وبعد 6 شهور إجا وقعد على قلبنا». ابني الكبير بدأ يعمل في ورشة للخياطة، وأنا أيضاً، أما «هو» فقد وجد عملاً وكان يصرف كل قرش من راتبه على شراء المشروبات الكحولية. لم يساهم بأي مصاريف، ولم يشارك بأي نشاط قد يدعم فيه أولاده، لا مالياً ولا معنوياً. ابني الكبير هو ربّ الأسرة والبيت، وهو السند المادّي الأول في العائلة، والمعنوي أيضاً، لي ولأخيه وأُختَيه.
عن طريق جاراتي، علمت بوجود منظمة تساعد الناس في إجراءات السفر، ففكرت أن أذهب وأسجل فيها. عندما ذهبت إلى مركز المنظمة قالوا لي نحن لا نساعد اللاجئين في إجراءات السفر، نحن نساعدهم على التأقلم للبقاء في تركيا، وستبدأ قريباً دورة لتعلّم اللغة التركية. على الفور سجّلت في دورة اللغة، وقد شعرت حينها باقتراب أشعة مضيئة نحوي، وبالفعل، من هنا بدأت مسيرة انعتاقي!
*****
المركز الذي تتحدث عنه ليلى موجود في منطقة إسنلر في اسطنبول، وهو أحد المراكز التابعة لمكتب دعم اللاجئين في منظمة تنمية الموارد البشرية، المنظمة غير الحكومية التركية والشريك التنفيذي للمفوضية السامية للأمم المتحدة، حيث يساعد المركز السوريين المقيمين في اسطنبول على الوصول إلى الحقوق والخدمات المقدمة لهم من قبل الجمهورية التركية عن طريق تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، بالإضافة لإقامة ندوات وورشات في مختلف المجالات. كل ما يقدّم في المركز مجاني تماماً لحاملي الكيملك الصادرة عن ولاية اسطنبول، ولا يقدم المركز خدماته إلا لهؤلاء.
تتابع ليلى:
تعلمت اللغة التركية مع 15 امرأة أخرى، واستمرت الدورة لمدة سنة قبل أن توقفها الحكومة التركية، فلم يعد مسموحاً إلا لمراكز التعليم المرخّصة إجراء هكذا دورات. مرة كلّ أسبوع كنت أذهب للدرس، وعند انتهائه أعود مسرعة إلى البيت. لم أسأل ولم أكن أعرف عن النشاطات المقامة في ذلك المركز ما عدا دروس اللغة، إلى أن جاء يوم وسمعت أصوات غناء قادمة من غرفة مجاورة لنا، وعرفت أن هنالك كورال قد تم إنشاؤه حديثاً لنساء سوريات، يتعلمن فيه الغناء، ويغنين بالعربية والتركية.
في مركز إسنلر، تعرّفت على نساء معظمهنّ أصبحن صديقات لي، أتواصل معهنّ بشكل يوميّ، ونلتقي كثيراً في المركز. لوقت طويل كنت أشعر أن هذا المكان هو ملجأي، هو مكاني الذي استرخي فيه وأنسى بعضاً من مشاكلي اليومية. فيه أيضاً أقيمت عدّة محاضرات قانونية من قبل محامٍ تركي شرح لنا عن القوانين التركية، وكيف تحمي المرأة نفسها إن تعرّضت لأذى، ومعلومات لم نكن نعرفها عن قوانين الزواج والطلاق في تركيا.
عندما بدأت أتخيّل أنني حرّة وسعيدة ومطلّقة، تسلّل شعور الذنب إلى قلبي، ما ذنب أولادي أن يعيشوا في أسرة مفككة كما عشت أنا، هل سيرَون أمهم أنانية وتبحث عن خلاصها الفردي؟
أفكار وأسئلة كثيرة أصبحت تؤلمني وتخيفني، وتُجبر مخيّلتي على العودة إلى الواقع الزوجيّ، وجحيمه. مرّت ليالٍ كثيرة لم أنم فيها وأنا أفكّر بأولادي وبهذه الحياة البائسة التي نعيشها جميعاً. وبخطوة مجنونة، وأراها اليوم شجاعة، قررت أن أذهبت إلى الطبيب النفسي المتواجد في نفس المركز. وقد ساعدني في التحايل على شعور الذنب عن طريق مصارحة أولادي، وشجّعني على بدء الحديث معهم، ليكون القرار جماعياً وناتجاً عن حوار بيني وبينهم هم الأربعة.
أولادي أصدقاء ماضِيَّ وحاضري، كانوا سنداً كبيراً لي في قرار الطلاق. بدايةً أخبرت ابني الكبير ما أنوي القيام به، فشجّعني، ومعاً أخبرنا إخوته. بكيت عندما رأيت ضحكاتهم وسعادتهم بقراري، وكأنهم كانوا ينتظرون هذا الانعتاق منذ زمن. عندما خرج ابني الثاني من البيت، ظننت أنه مرتبك ومنزعج قليلاً، ثم ما لبث أن عاد وفاجأ الجميع بقالب «كاتو» مزيّن. كانت لحظات مؤثرة علينا جميعاً، بكينا وضحكنا، واستعدينا لقدومـ«ـه» إلى البيت وإخباره بقرار الانفصال… وتمّ الأمر.
أغضب لأنني تأخرت باتخاذ قراري والمضيّ قدماً بالطلاق. كنت أعتقد أنني أحمي عائلتي من خلال الحفاظ على ذلك الزواج المهترئ، الصدئ؛ زواج هو الجحيم بعينه. لكنني كنت مخطئة، أرى تأثير غيابـ«ـه» عن البيت في كلّ أولادي: ابنتي الصغيرة لم تكن ترغب بالطعام، وتعاني من اصفرار دائم وشحوب ونحول لا سبب عضوياً له، وهي اليوم مختلفة تماماً، تأكل وتتلذذ بالطعام؛ باتت أطول، وأجمل، وفي نظرتها ابتسامة لم أكن أراه سابقاً.
في تركيا أنا أقوى والقانون يحميني، وأولادي باتوا شباباَ، يحمونني كما أحميهم، يحمونني من أبيهم في الدرجة الأولى، فهو لا يجرؤ أن يضربني أو يوبخني أثناء وجودهم. لكنه يفعل ذلك وأكثر في حال غيابهم عن البيت. أجل، أنا اليوم أقوى، وحرّة من قيود كثيرة كان المجتمع يكبّلني بها. مجتمعي قاسٍ وظالم، ومهترئ، لكنني عنيدة، وسأقاوم!
لن أدّعي أنني تحررت تماماً، فهناك الكثير لأخوضه، نفسياً وقانونياً واجتماعياً. فالانفصال لم يكتمل قانونياً بعد، و«هو» ما زال يأتي إلى البيت بشكل شبه يوميّ، قائلاً «بدّي أعرف شو عم يصير بغيابي، مين عم يجي لعندك بغياب الأولاد». نحن منفصلان نفسياً وجسدياً، لكنني حتى اليوم لم أستطع منع زياراته. مؤخراً، إذا كنت وحيدة في البيت لا أفتح الباب له، وأبقى متيقظة لأتأكد من كونه مقفلاً. وفي حال وجود البنات في البيت، أفتح الباب، وأذهب إلى المطبخ، والبنات يلتحقن بي، أو يذهبنَ إلى غرفة النوم. يبقى وحيداً في صالة الجلوس، وكثيراً ما يقترب من المطبخ ويقول بصوت لا تستطيع البنات سماعه في حال تواجدهنّ في غرفة النوم: «والله لنكّد عيشتك». يجلس لعدة ساعات وحيداً، ثم يذهب.
*****
تخاف ليلى على مشاعر بناتها وأولادها. تقول إنها قررت تحمّل ثِقَلِ وجوده وزياراته الكثيرة المفاجئة، كي لا يتفاقم شعورها بالذنب، وبأنها حرمتهم من أبيهم. والمفارقة أن بنات ليلى لا يرغبن بوجوده في البيت، ولا يرحّبن بزياراته مطلقاً، وأما الأبناء فلا يعلمون بقدوم أبيهم إلا عن طريق شكوى أخواتهم الدائم من حاجتهم لانتهاء هذه المأساة.
عساه خيراً لكم
حسب القانون المدني التركي، تقوم المحاكم التركية بتطبيق القانون التركي في حالات الطلاق التي تحدث على الأراضي التركية حتى لو كان المتزوجان سوريَّين وتزوّجا في سوريا. وبموجب القانون التركي، يتمتع الرجال والنساء بحقوق زوجية متساوية، فيحق للزوجة كما الزوج تقديم طلب الحصول على الطلاق. قد يكون الطلاق بالتراضي بين الطرفين، أو قد يكون طلاقاً متنازعاً عليه. ويحق لكلا الطرفين تقديم طلب الطلاق للمحكمة في حال عدم التوافق وعدم إمكانية استمرار الحياة الزوجية، كأن يقوم أحد الطرفين بتهديد أو طرد أو إيذاء الآخر، إو إعلان الكراهية، أو عند محاولة أحد الطرفين قتلَ الطرف الآخر أو الإضرارَ به أو عدمَ احترامه أو تعريضَه للضغط النفسي أو العنف البدني، فيحق للضحية حينئذ البدء بإجراءات الطلاق.
وهناك أسباب أخرى عديدة تمكّن أحد الطرفين من التوجه إلى محكمة الأسرة الموجودة في نطاق الدائرة التي يقطنها، والبدء بإجراءات الطلاق. وإذا تم استكمال جميع الإجراءات يتم إرسال نسخة من قرار المحكمة إلى مكتب السجل المدني، وبعد انحلال الزواج رسمياً يحق لكلا الطرفين الزواج مرة ثانية، مع مراعاة ما إذا كانت المرأة حاملاً في تلك الحالة فلا يحق لها الزواج لمدة 300 يوم من تاريخ صدور قرار المحكمة.
ووفق القانون التركي المدني فإن الطفل يحتاج للحضانة ما لم يتجاوز عمره 18 عاماً، وعند الطلاق يقوم القاضي بمنح حق الحضانة لمن يعتقد أنه سيقوم بتوفير رعاية أفضل للطفل. ولا يعتبر الرجال متفوقين على النساء في هذا الصدد، ويُتوقع من الطرف الذي لم يتم منحه الحضانة تقاسم العبء المالي لرعاية الأطفال، حسب إمكانيات وموارد الطرف الثاني المالية.
تقول ليلى إنها تنتظر مع أولادها وبناتها انتهاء إجراءات الطلاق، علّهم يحظَون بأيام أقلّ توتراً، ويستعيدون شيئاً من الثقة بمؤسسة الزواج: «جحيم الزواج يطال الجميع، ويؤثر على الجميع، وقلّة منّا تخرج من هذه التجربة بشيء من التوازن يحميها من عدم إصدار الأحكام المطلقة على كل الرجال أو النساء أو الزيجات. هنالك سلام ما ينتظرني وأولادي، أراه وأشعر باقترابه، سأكون الأم المطلّقة المنطلقة إلى الأمام، وسأنتصر».
*****
أثناء بحثي في أسباب طلاق السوريين خارج البلاد، لاحظت أن كثيرين يتحدثون عن هذه الحالة في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مقالات في مواقع سورية وعربية عديدة، ويُرجعون الأمر إلى الخيانة الزوجية، أو تغيّر القيم الاجتماعية، مع ذكر متكرر لعبارة «الفلَتان الأخلاقي» أو ما يشابهها! لكن هناك خللاً لا تخطئه العين في هذه المقاربة، وهو أن كثيراً من الزيجات المأساوية كانت تستمر أصلاً لأن القانون لا يساوي بين الرجال والنساء في سوريا، ولأن الأوضاع الاجتماعية كانت تفرض استمرار تلك الزيجات، وهذا ما يؤكده ازدياد نسبة طلاق السوريات والسوريين خارج بلادهم، وتحديداً في البلاد التي تمنحهم أوضاعاً قانونية واجتماعية أفضل.
اخترتُ أن أكتب قصة ليلى، علّها تبيّن كيف تبنى الجدران حول أشخاص كثر، وكيف يستطيع القانون أن يحميهم أو يُعيق تحررهم. وأعتقد أن خروج ليلى وأولادها من البلاد، على قسوته ومأساويته، كان فرصتهم لاكتشاف رحابة العالم وتعدد الإمكانيات والفرص فيه، وممراً لينطلقوا خارج سجون القانون والمجتمع، لعل مستقبلهم يكون أفضل ويضم مزيداً من السلام الذي يستحقونه.