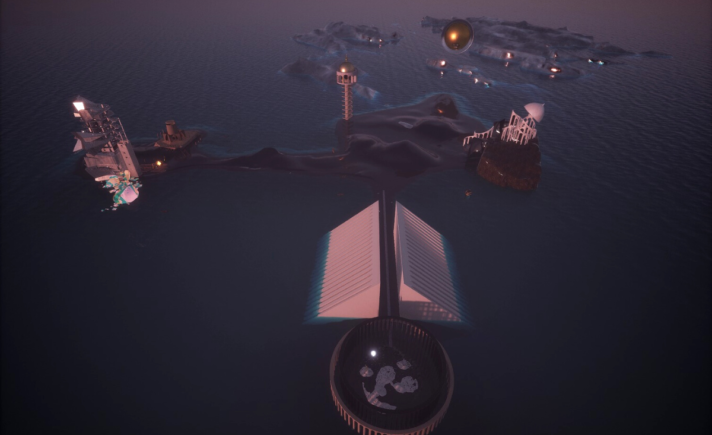في جميع مراحل طفولتي، وإلى وقت قريب قبل الثورة، كانت تربطني علاقة استثنائية مع السماء والبحر والمطر، ولم يكن يخطر ببالي قط أن تتغير هذه العلاقة بعد إعلان الحرب على السوريين الذين انتفضوا لكرامتهم في آذار 2011.
في سنوات طفولتي الأولى، لطالما كان الطيران أحد أقرب أحلام اليقظة إلى قلبي، كنت أحلم أن ينبت لي جناحان قويان لأحلق بهما في السماء العالية، بحيث تلوح لي الأرض من بعيد كحبة بندق صغيرة. تخطيت الطفولة بسنوات وبقي حلم ركوب الطائرة يلازمني كتعويض واعٍ وممكن عن فكرة الطيران المستحيلة.
في طفولتي أيضاً، لم أرَ البحر إلا في الصور أو على شاشة التلفزيون. كنا في فترة السبعينات، ستة أولاد في مراحل دراسية مختلفة، والأم ربة المنزل، ورب الأسرة الموظف في دائرة حكومية ودخله بالكاد يغطي حاجاتها الأساسية من إيجار السكن والطعام والملابس واحتياجات الأولاد والتعليم. في تلك الفترة وما بعدها، أصبحت السياحة الداخلية رفاهية مفرطة وترفاً غير متاح لذوي الدخل المحدود، الذين كان عليهم أن يعتادوا أن يقيسوا إنفاقهم بالمسطرة ليتجنبوا تجاوز الدخل الضعيف ويتفادوا الغرق في الديون. فلم يتسنّ لنا، نحن العائلة الكبيرة نسبياً في ذلك الوقت، أن نستمتع برحلة قصيرة إلى البحر ولو لمرة واحدة في السنة، رغم أن البحر على مسافة لا تتجاوز 50 كيلومتراً من بلدتنا مصياف. كنت أتخيل أحياناً لمسة قدميّ على الرمل وأنا أتجه صوب البحر وصوت الموج يعلو ويعلو وهو يتقدم باتجاهي ليقذفني بعيداً على الشاطئ. ومرة حدث أن سخر مني أحد أقاربي – وكان في مثل سني تقريباً – عندما ذكرت عَرَضاً أمامه أنني لا أعرف البحر، فاتّسع البحر في مخيلتي وأغرق كل أحلامي الأخرى.
أما في مراهقتي، وإلى وقت قريب مضى، فكان للمطر وقع خاص في نفسي. وبحكم الطبيعة الجبلية للبلدة، فقد أفقت على الشتاءات الطويلة الباردة المصحوبة بالمطر الغزير؛ وفي الخريف بشكل خاص، كانت رائحة التراب وهو يستقبل زخّات الهطل الأول في حديقة البيت وفي حارات البلدة القديمة تملأ المكان وتفتح شهيتي على الحياة. ولم تكن الرائحة فقط هي ما يشدني للمطر؛ كان تخيّل عاشقين يمشيان تحت المطر لوحةً شاعرية عذبة لا يضاهيها أي عمل فني في إبداعها وكمالها. كنت أراقب هطول المطر على الأسطح والشجر، فتقع حبات المطر في قلبي قبل أن يرشفها الزرع وتبتلعها الأرض. ولم يحدث أنني اقتنيت مظلة خلال كل مراحل حياتي.
كيف تتحول المشاعر إلى أضدادها؟ كيف تنقلب أحلام اليقظة العذبة إلى كوابيس؟
في سنوات الثورة الأولى، كنت أقطن في جرمانا بريف دمشق، وكانت طائرات الهليكوبتر تمشّط السماء نهاراً في رحلتها إلى المناطق القريبة الثائرة. كانت الطائرات تحلق على ارتفاعات قريبة وفي وضَح النهار، مما مكنني من رؤيتها لحظة قذف حمولتها على رؤوس السكان في جوبر أكثر من مرة. لم أكن أصدق ما أرى؛ كان المشهد أشبه ما يكون بلقطة مسروقة من أحد أفلام التشويق والإثارة السينمائية، إذ لا يعقل أن يكون ذلك حقيقياً. في تلك الفترة، كان القصف بالطيران متعذراً في الليل على الأرجح لأنه كان يتوقف يومياً مع اقتراب المساء؛ ولحسن الحظ أن الليل كان يهبط على رؤوسنا بشكل دوري منتظم ليترك لآلاف العائلات المستهدفة بالقصف فسحة صغيرة مؤقتة للملمة الجراح التي خلفها النهار.
إلا أن الأوضاع لم تستمر على هذا النحو طويلاً. قبل خروجي من سوريا بوقت قصير، انتقلت للإقامة في صحنايا في منتصف 2015، وكان الطيران الحربي الوحشي يمر في سمائها على ارتفاعات عالية ليلاً ونهاراً بشكل متواصل ليقذف حمولته الحاقدة على داريا الجارة القريبة. صوت الطائرات كان مدوياً ومتواصلاً. لم يعد هناك فسحة للحياة في المناطق المنكوبة بالقصف؛ صار الموت متاحاً على مدار الساعة. ولطالما رغبت بالصراخ بأعلى صوتي «كفى» وانكمشت على نفسي في السرير تحت الغطاء لأنخرط بعدها في بكاء هستيري طويل. في هذا الوقت ربما بدأت الصورة الجمالية للطيران التي تغذّت عليها طفولتي تتغير في شعوري اللاواعي. لم تعد السماء فضاءً للحرية، حريتي؛ لم تعد فسحة أتحرر فيها من التصاقي بالأرض وأتخفف من وزني؛ كانت الطائرات القاتلة تشل رغبتي بالحركة والتنقل والعلوّ مع كل سقوط لأحمالها على رؤوس العائلات والأطفال.
وفي تلك الأثناء أيضاً وقبلها، كانت قوافل الفارّين من الجحيم السوري تتسابق إلى البحر أملاً بالنجاة. عائلات بأكملها، أطفال ونساء ورجال، ابتلعهم البحر ولفظ أجساد بعضهم إلى الشواطئ؛ آلاف البشر هربوا من الموت فاستقبلهم موت آخر. أذكر أنني رأيت مرة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسترات نجاة مكوّمة على أحد الشواطئ. لم أعد أذكر اسم الشاطئ، ولم أحتفظ بالصورة، لكنها كانت الصورة الأسوأ وقعاً على نفسي، حتى أنها كانت أشد تأثيراً من عشرات الصور الأخرى التي تزاحمت على فيسبوك للغرقى أنفسهم. لا تزال هذه الصورة تدق في رأسي مساميرَ كلما قال أحدهم بحر. الموج الذي كان يداعب أقدامي ويرميني على الشاطئ في أحلامي الطفولية هو ذاته الذي يبتلع اليوم قوارب الموت ويُنهي آلاف الحيوات لبشر من لحم ودم وحكايات وضحكات. العائلات التي حَلَمَت بالخلاص وأَمَلَت بعبور البحر لينعم أطفالها على الشاطئ الآخر بالأمان والدفء والتعليم الجيد؛ لم ينجُ منها سوى صور لأشخاص مبتسمين وسترات نجاة. كيف للبحر أن يكون عذباً في قصائد الشعر ومخيلات العشاق وهو بهذه القسوة؟ هذا السؤال بالتحديد هو ما تبقى لي من البحر.
كان خروجي من سوريا أول آذار 2016 إلى لبنان، حيث أمضيت سنتين كاملتين في بيروت قبل وصولي إلى شاطئي الأخير.
بعض المدن أقرب ما تكون إلى الصورة النمطية لزوجة الأب التي طالما كرهناها في قصص الأطفال؛ امرأة مكتنزة وقاسية وبشعة رغم كل مساحيق التجميل التي يختبئ وجهها خلفها؛ هكذا وجدت بيروت. أما بيروت الشابة الجميلة والمثقفة التي يتغزل بها المثقفون فلم ألتقِ بها إلا لماماً. والآن، من هذه المسافة البعيدة، أستطيع أن أفكك مشاعري هذه وأفهمها بشكل أفضل.
لا تحتمل بيروت وجوه السوريين؛ تتذمر من وجودهم باستمرار، في التكاسي ومحلات التسوق ومكاتب العقارات. أذكر أنني نزلت من التكسي عدة مرات قبل وصولي إلى وجهتي بسبب صدامي مع السائقين الذين كانوا يتعمدون الإساءة إليّ لمجرد اكتشافهم من لهجتي أنني سوريّة. ولم أتمكن من تجديد إقامتي رغم زياراتي المتكررة لمديرية الأمن العام، كحال غالبية السوريين، وكان هذا سبباً كافياً لفقدان الشعور بالأمان.
وليس هذا فحسب؛ فعندما خرجت من سوريا كنت أشعر أنني لن أعود إليها ثانية، ولأن بيروت كانت المدينة التي أقمت فيها مباشرة بعد خروجي هذا، صرت أراها المنفى ومكان الإقامة البديل الذي يصعب عليّ تقبله. فيما بعد، لن تكون مشاعري على هذه الصورة في كندا، ربما لأن وصولي إليها كان من لبنان وليس من سوريا مباشرةً.
لفت انتباهي أثناء عبوري بالسيارة في شوارع بيروت للمرة الأولى باتجاه مكان إقامتي العدد الكبير للبنوك ومكاتب تحويل الأموال ومحلات الصرافة مقارنة بمساحة المدينة، ودُهشت بالفوضى العمرانية ورائحة النفايات الواخزة. لا تزال آثار الدمار على بعض المباني هنا وهناك تذكّر المارّين بالحرب القريبة. سأكتشف لاحقاً أن الحرب لم تنتهِ بعد، إذ تركت شروخاً عميقة في النفوس وفي جغرافيا البلد. حركة المطار أيضاً كثيفة؛ يبدو لبنان محطة ترانزيت للعابرين بين الشرق والغرب.
من مكان إقامتي في الأشرفية، كنت أشاهد الطائرات على ارتفاعات منخفضة عند الإقلاع أو الهبوط. صوت الطائرات كان مألوفاً هناك. الطائرات مدنية، لا داعي للقلق! أعي ذلك بالطبع، ولكنني أنتفض لحظةَ سماع صوتها.
بحر بيروت أيضاً كان قريباً، أستطيع أن أذهب إليه سيراً على الأقدام، لكنه هو ذاته بحر سوريا وبحر اليونان وبحر تركيا؛ البحر الذي سرق أعمار السوريين وحكاياتهم وضحكاتهم ورمى في وجوهنا صورهم التذكارية وسترات النجاة. في المرات القليلة التي جلست فيها على البحر، كان عليّ أن أَجهَد في طرد هذه الفكرة من رأسي.
وأما المطر، فكانت لي معه قصة أخرى. كان لي شرفُ العمل مع اللاجئين السوريين في المخيمات بالبقاع. تختلف المخيمات في الصور والفيديوهات التي تصلنا يومياً عنها في الواقع. أن تدوس بحذائك على الحصى القاسية وتغوص أقدامك في الوحل؛ أن تختبر الاحساس بقسوة الطقس بينما تحتمي بقطعة قماش ليس إلا؛ أن تنتفي الخصوصية لك ولعائلتك؛ وأن تأخذ الخيمة، مسكنك، رقماً؛ ويصبح طفلك مقصداً للباحثين عن فرصة للاستعراض الزائف لالتقاط الصور والتعاطف الكاذب الرخيص… هل يمكن لصورة مهما بلغت حرفيتها أن تنقل هذه الأحاسيس كما هي بكل ما فيها من بشاعة وقسوة؟
في الماضي القريب، كان لكل فرد من هؤلاء البشر بيت وجيران، اسم ولون عيون وطريقة تفكير، وأحلام. كانوا يتمايزون في أشياء ويتشابهون في أشياء أخرى… كيف اختزلهم العالم في صورة واحدة وتحت مسمى واحد، «لاجئين»!
لا تزال الزيارة الأولى للمخيمات في ذاكرتي بكل تفاصيلها؛ بداية آذار والطقس ماطر والوجهة أحد المخيمات. سيكون علينا أن نقطع بالسيارة مسافة طويلة على طريق غير معبّدة ومفروشة بالحصى لنصل إلى البيوت، أقصد الخيام. تمكّن المطر من تشكيل مستنقعات موحلة هنا وهناك. طفلان يحاولان فتح مجرى لتصريف مياه بحيرة أغلقت مدخل الخيمة، البيت. تجولنا بين الخيام ترقُبُنا عيون الأطفال بلا مبالاة؛ يُلقون علينا نظرة ثم يَحيدون بعيونهم التي اعتادت زياراتِ غرباءَ بملابسَ نظيفة وابتسامات زائفة. لم أستطع أن أبتسم، ولم أنظر مباشرةً في عيون الأطفال؛ لم أنطق بكلمة واحدة منذ بدأت الخيام تلوح من بعيد ونحن ما نزال على الطريق العام؛ بكيت بصمت وهدوء كأنني أؤدّي صلاة. كان المشهد قاسياً والمشاعر مختلطة: مزيج معقد من مشاعر الغضب والحقد والعجز والخيبة والذهول والذنب والحزن. كان الحزن طاغياً، لم أستطع احتمال هذا الاحساس الصادم بالفجيعة، لم أنزل من السيارة. قطعت زيارتي وعدت إلى بيروت.
فيما بعد سأزور المخيم بشكل متكرر. وستربطني علاقة استثنائية مع ياسمين، الطفلة ذات العشر سنوات، وسأحتفظ بصورتي معها إلى الآن؛ الصورة الوحيدة التي التقطتها في المخيمات بناءً على إلحاحها. ياسمين لا تشبه صورة طفل المخيم التي تُشهرها التلفزيونات ووسائل التواصل الاجتماعي في وجوهنا. طفلة مفعمة بالطاقة والحيوية، تحب الأغاني والحكايات، وتحب حصة الرياضيات وتحلم أن تصير مدرّسةَ رياضيات عندما تكبر لتعلّم الأطفال الحساب. عيناها خضراوان وملابسها نظيفة وشَعرها مرتب. جريئة وتتحدث مع الغرباء بطلاقة وثقة محببتَين.
دُهشت عندما علمت للمرة الأولى أن سكان المخيم يدفعون إيجاراً مقابل سكنهم، إذ كيف يمكن لإنسان أن يدفع ثمن إقامته في العراء!
هذا العراء عادةً ما يتحول إلى بحيرة كبيرة عندما تشتد غزارة المطر ويستمر لفترات طويلة. تفيض المياه في الممرات بين الخيام وتدخل إلى البيوت وتغمر كل شيء، الأرضيات والفرش البسيط والملابس وأطباق الطعام، فيضطر السكان إلى النزوح المؤقت، حاملين ما استطاعوا من حاجياتهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وبعد انتهاء العاصفة يواجه المخيم مشكلة جديدة لإعادة ترميم الأرضيات ورصف الممرات وتعويض الخسائر. في نهاية 2018، أتت عاصفة مطرية أغرقت بعض المخيمات بالمياه مما اضطر السكان إلى النجاة بحياتهم، فلجأ بعضهم إلى معارفهم وأقاربهم في مخيمات أخرى، بينما لم يجد آخرون سوى حظيرة للحيوانات يحتمون فيها من العاصفة والبرد الشديد. كنت حينها في كندا.
في الأول من آذار 2018، غادرت لبنان إلى كندا. لحظةَ اقلاع الطائرة، أغمضتُ عينيّ وأنا أنصت لصوتها. كنت أبكي وعشراتُ الصور تتزاحم في رأسي؛ تذكرة الـ«ذهاب فقط»، صوت الطائرة الحادّ، أهلي وأصدقائي، بيتنا وحارتنا، بلدتي والشام وهذا الخراب الذي تركته خلفي ونجَوت. شعرت بأنني نجَوت فعلاً عندما استقبلني موظف المطار بابتسامة ودودة وترحيب دافئ: «أهلاً بك في بلدك كندا» بينما يسلّمني وثيقة الإقامة الدائمة. تمنيت لو أعانقه وأخبره أنني ممتنّة له لأنه يقدّم لي ببساطة – حتى قبل أن تطأ قدماي أرضَ كندا – ما كنت أفتقده في وطني.
أنا الآن على مسافة عشرة آلاف كيلومتر من سوريا. الحياة هنا لا تشبه حياتنا في سوريا. ثقافة مختلفة في كل شيء، إيقاع الحياة وعلاقات العمل والمدرسة والعلاقات الاجتماعية والعلاقة مع الطبيعة والحريات والقانون، انتظام الناس في طوابير في المتاجر، ووقوفهم على إشارات المرور، ولباقة الموظفين الحكوميين مع المراجِعين، الحدائق وأرصفة المشاة. كندا بلد المهاجرين؛ يكفي أن تقف في أحد المتاجر الكبيرة ليمر على مسامعك كل لغات العالم؛ مجموعات بشرية من قوميات وأعراق وأديان مختلفة، يتمايزون في اللغة ولون البشرة وشكل العيون والأزياء وأطباق الطعام، ويتماثلون في الحقوق والواجبات، ويحتكمون لنفس القانون وينعمَون بنفس الحريات. الحريات… الكلمة التي كلفت السوريين بحراً من الدماء وكلَّ هذا الخراب. أحب هذا التنوع وأشعر بالاطمئنان.
يستخدم الكنديون مصطلح «القادم الجديد» للتخفيف من وقع كلمة «لاجئ». يُرهقون هذا القادمَ الجديد بدروس اللغة الجديدة، وورشات التدريب والتعريف بالثقافة الكندية؛ يلقّنونه كيف يستعد لمقابلات العمل، ويدرّبونه على عدم تخطي المسافة المثلى مع الأشخاص الذين يلتقيهم في الأماكن العامة. مئات المراكز الحكومية والمنظمات غير الربحية تتسابق على تقديم خدمات التوطين للقادمين الجدد وإكسابهم الخبرة الكندية، ليجد القادم الجديد نفسه في نهاية المطاف عاملاً في مطعم أو مغسل سيارات – مهما بلغ مستواه التعليمي وخبرته العملية التي حملها من بلاده البعيدة. يقسم القادم الجديد يومه بين عمل فيزيائي طويل بأجر منخفض، وفرصة دراسية لتحصيل شهادة علمية كندية تسمح له مستقبلاً بالحصول على عمل أقرب ما يمكن إلى تاريخه المهني. ويزيد في متاعبه التنازع الدائم بين محاولات الاندماج والقلق على الهوية. السنوات الثلاث الأولى على الأقل هي أشبه ما تكون بالخدمة العسكرية؛ وقت ضائع أو ممر إجباري لإيجاد موطئ قدم ثابت ومريح والوصول إلى نوع من الاستقرار.
إيقاع الحياة صاخب وسريع، والفرص لا تنتظر المتقاعسين. يمر الوقت سريعاً فأنشغل عن التفكير بالسماء والبحر والمطر. ويحدث أحياناً أن أغرق في الذكريات، فأنتفض فجأة لتخيل صوت الطائرة وأتخيل البحر غولاً بفم كبير شَرِه، والمطر ثقيلاً كالكابوس. وفي كل مرة ألقي القبض على نفسي محاصرةً بالذكريات، أدرك أنني لم أنجُ كما اعتقدت في المطار، وأن الحرب التي تركتها ورائي هناك أغرقَتْنا جميعاً، نحن السوريين، في الألم.