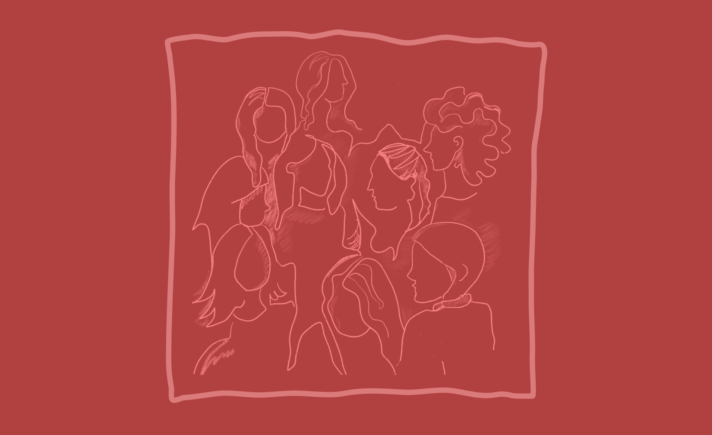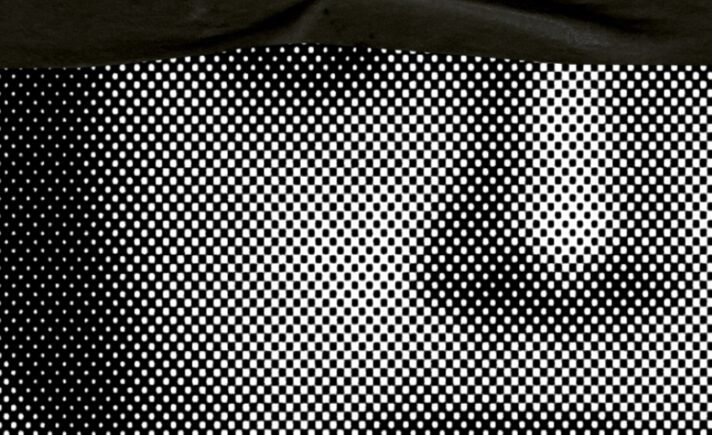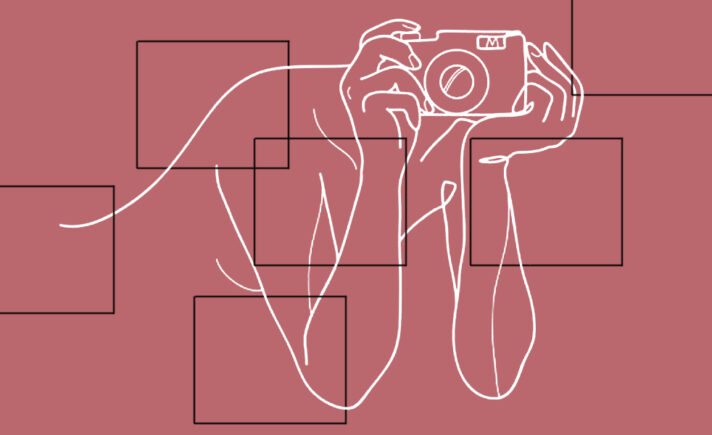أعرف أنكم هنا، وأنكم موجودون، وأنكم تتابعون الكلمات تتالى بسرعة أمام أعينكم، أعرف أنكم ستغضبون قليلاً أو تتألمون قليلاً بسبب ما ستقرؤونه عنا، نحن الرازحات في مناطق سيطرة النظام السوري، اللواتي فقدنَ خطيباً أو زوجاً أو حبيباً، أو لم نلتقِ بأي منهم أصلاً.
نحن اللواتي لطالما أصبحنا هزؤاً على صفحات فيسبوك وعلى ألسنة المتسامرين، عندما تتنشر أخبار تخصنا عن احتمال سوق النساء في سوريا إلى الخدمة الإلزامية، أو تسريبات من مديريات النفوس تقول إن نصف مليون امرأة منّا قد أصبحن فوق سن الثلاثين بلا زواج.
نحن اللواتي سنكون ربما بعضاً من أخواتكم أو أمهاتكم أو قريباتكم المتبقيات بين براثن حضن الوطن، وسيكون الردّ جاهزاً علينا بأن الوطن قد خلا تقريباً من شبّانه، أو بأن هذا مصير من تطلب مهراً فوق طاقة الشاب، أو بأن هذه هي اللعنة التي نستحقها لأننا بقينا في «المدجنة»، أو أي من الملامات الأخرى التي تلاحقنا من بعيد، ومعها وصمات طالتنا مراراً حتى حفظناها، لأننا لم نحقق معايير مجتمع يحافظ على نظرته للمرأة رغم كل ما حدث.
فليكن لديكم بعض الصبر إذن، وبعض الحكمة، فلكل نتيجة سبب، ولكل فعل أسبابه التي أدت إليه، وهنا بعض مما يحدث، وبعض مما نفعله في السجن مغلق الإحكام، الذي يسمى «سوريا الأسد».
*****
هل جربتم أن تقرؤوا رواية ضيعة الأرامل؟
أنتم الآن في سوريا الأسد، في منطقة تحت سيطرة النظام، بعد أن غادرها كثيرٌ من شبانها ممن تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة والثالثة والأربعين، ولكم أن تتخيلوا معنى استمرار نزف الشبان والرجال خلال فترة حرب متواصلة ومستمرة لثماني سنوات، الشوارع ملأى بالإناث، المقاهي، الأسواق، الجامعات، أماكن العمل، الشركات، الجمعيات.
تاء التأنيث سيدة الموقف الآن، والكفة الراجحة لحضورهنَّ تُربك ميزان الناظر إلى تخلخل التوازن الطبيعي في مجرى الأمور هنا، حيث لا شيء طبيعي، وكل شيء أقرب لأن يكون شاذاً بفعل الحرب، ليضاف إلى كل ذلك طغيان الإناث على المشهد في كل مكان، متزامناً مع طغيان الاستبداد الذي يبدو بلا نهاية.
أفترضُ أني لم أفقد انتباهكم بعد، قلت: هل تخيلتم معنى فقدان الرجال في وقت الحروب بالنسبة لنساء يُسمّينَ الرجل «رب البيت»؟ هل تخيلتم العبء الثقيل على كاهل امرأة تسمونها تصغيراً «الحريمة»، ثم إذا كانت قوية أسميتموها «أخت الرجال»، لأن العلاقة بينكم وبينها كانت دائماً علاقة التابع بالمتبوع. ثم تستهينون بها في مواقف الشدة لتصبح عبئاً عليكم في حال الخطر، بدل أن تكون في نظركم سنداً وظهراً وبديلاً عنكم في غيابكم الاضطراري، وهو ما يحصل غالباً بطبيعة الحال، إذ تقوم النساء بكل المهام في ظروف الحرب الصعبة، وهو الأمر الذي يعلمه كثيرون منكم رغم عدم الإقرار الصريح به.
ربما تشعرون بالظلامة من أصابع اتهام تمتد في وجوهكم بعد الذي مررتم به، وهو ما أربأ بنفسي عنه، وأرفضه، لا سيما أن كثيرين منكم طريدون مطاردون من موت إلى موت، ومن شقاء إلى شقاء فرضه عليكم «إخوتكم في الوطن». أعرف أنكم معذورون في غيابكم، وأن كثيرين منكم تحملوا أثماناً باهظة لا طاقة لهم بها. لكن معاذيركم هذه لا تسقط عندما يتعلق الأمر بنا، نحن أخواتكم وبناتكم وزوجاتكم، حين لم تحسبوا حساب اللحظة التي تضطرون فيها للغياب، ونضطر فيها للبقاء وحيدات دون أن نكون مهيئات لذلك، لنجد أنفسنا وجهاً لوجه مع أعباء ومسؤوليات لم نعتد حملها لوحدنا. هو ذنبٌ ندفع ثمنه جميعاً، بعد أن وُضعنا في مقام لا يكتمل توازنه إلا إذا كان بجانبنا رجل يتولى زمام أمورنا وحياتنا. أنتم من جعلتم الأمر على هذا النحو، ونحن اللواتي ندفع ثمنه الآن.
بعد كل ذلك، لكم أن تتخيلوا تعداد المشاكل والآلام الحاضرة في غيابكم. تعالوا نبدأ إذن بفقدان الأمان، بفقدان السند، بفقدان الظهر، والمعيل، والزوج، والخطيب والحبيب والأب والأخ والصديق والابن….
تعالوا نبدأ بهم جميعاً:
أريد طفلاً
كانت تبكي وتردد أنها تريد طفلاً، وأنها ستتبنى واحداً من الأطفال الأيتام. هي المرأة الجامعية الثلاثينية المثقفة، تقول إنها لن تسامح المجتمع والحرب وكل من حرمها من حقها الطبيعي في الأمومة. تقول إن من حقها أن تصبح أماً، ومن حقها أن تحتضن طفلاً، أن تسمع نداءً دافئاً يلبي غريزتها الأولى، لتحصل على هبة الأمومة، تلك الهبة التي أصبحت أشبه بفرض يجب أن تسعى إليه المرأة لتكون مكتملة ومقبولة من بيئتها الاجتماعية، وإلا فإنها ستبقى ناقصة ومكسورة حسب أوصافكم الضمنية والصريحة، التي يكررها الجميع، بمن فيهم النساء من بنات جنسها.
أنتم الذي يتنفس بعضكم الصعداء ألف مرة لأنكم خرجتم من هنا، ومليون مرة لأنكم لستم في مكانها، مكاننا، مكان أي امرأة في زمن الحرب، حيث لا تملك واحدتنا خيار حياتها بيدها، فالسفر والزواج والدراسة وغيرها ليست رهن قرار الواحدة منّا، بل هي رهن موافقة الأسرة والمجتمع، بما يحمله من عادات وتصاريح حول ما يجوز أو ما لا يجوز، وهو الأمر الذي فُرضَ علينا مذ وعينا نحن وأمهاتنا وجداتنا.
لعل من أقسى المشكلات التي يمكن أن تمر بها النساء هنا، لا سيما اللواتي قطعن سنّ الثلاثين دون زواج، تلبية حاجتهنّ للأمومة، والتي غالباً ما يكون الحلّ لها، وخصوصاً بالنسبة للمرأة التي لا تملك مصدر دخل خاص بها، إما الزواج من رجل يكبرها بعشرات السنين، أو من رجل مصاب بعاهة لا شفاء منها، أو القبول بكونها زوجة ثانية، أو «الزواج عن طريق الصورة» إلى مغتربٍ في لبنان أو السعودية، أو الزواج من رجل غير سوري نتيجة طمع الأهل بالمال والسترة، وطمع المرأة بالحصول على زوج وطفل.
تقلّ الخيارات هنا، لتصل إلى مرحلة أن تنعدم، وأن ينغلق الدرب معها، لتجد نساء كثيرات خلاصهنّ في السعي للحصول على شهادة علمية أعلى، يضمنَّ من خلالها مستقبلهن واستقرارهن وموقعهن المرموق في المجتمع، ويكسبن من خلالها ورقة دفاع قوية بوجه كلمة «خطيّ»، التي تحمل الرثاء لوضعهنّ. بينما تلجأ بعض النساء إلى «واسطة» تضمن لهنّ أمان وظيفة الدولة، ليرفعن بذلك رصيدهنّ المعنوي والمادي أمام الجميع. أما من لم تحظ بهذه ولا تلك، فهي تستسلم ببساطة، ولا يبقى أمامها سوى البقاء في بيت أسرتها، مع الوحدة، مع الغضب، مع الانتظار، ومع حنين يمزق القلب لطفل لم تلده.
لو أنك كنتَ موجوداً (1)
عل الشريحة الأكثر معاناة من النساء المتبقيات في حض الوطن، هي شريحة النسوة الأرامل اللواتي استشهد أزواجهن، أو اللواتي لا يعلمنَ شيئاً عن أزواجهن، أو اللواتي اعتُقل أزواجهن. وعدد أولئك النسوة ليس باليسير، ومآلات أوضاعهن ليست بالأمر السهل، وإذا كانت لا توجد إحصائية واضحة لأعدادهن الفعلية، إلا أنه يمكن القول بثقة إنها تتجاوز عشرات الآلاف.
ولكم أن تتخيلوا مع هذا العدد الهائل من النساء الوحيدات، اللواتي اعتدنَ العيش في بيت يحمل مسؤوليته رب الأسرة الذكر، ثم فقدنه وغاب عنهن، فوجدنَ أنفسهن وحيدات مع أطفال صغار، ومعظمهن في ريعان الصبا، وكثيرات منهن غير متعلمات، وكثيرات منهن غير موظفات، وبلا صنعة، وبلا بيت يؤويهن مع أطفالهن، وهنّ أنفسهن يشعرن بسبب ما تعلّمنه وورثنه بأنهن ضلع قاصر يحتاج للحماية والسترة ودرء العيون الشرسة المتربصة. لكم أن تتخيلوا ما سيحدث، وإذا كنتم أنتم، القراء من بعيد، المتابعون من بعيد، غير منتبهين إلى أن أعداد المعتقلين والمفقودين والشهداء بالآلاف المؤلفة، يقابلهم أعداد زوجاتهم الوحيدات، فتلك مشكلة كبيرة.
تختلف مصائر النسوة الأرامل بحسب بيئاتهن الاجتماعية والاقتصادية، وبحسب قدرتهن على التحكم في أمورهن وحياتهن. وتختلف قصصهن من النقيض إلى النقيض، من اللواتي اخترنَ العيش وحيدات بجانب أطفالهن، مع نضال مستميت لتعليم هؤلاء الأطفال وتأمين احتياجاتهم، وصدّ من يحاول استغلالهن لمآرب دنيئة، وهؤلاء كثيرات، وقصصهن أشبه بالمعجزات نظراً لظروفهن المأساوية؛ وصولاً إلى اللواتي ضحينَ بأطفالهن في سبيل تمتعهن بحماية رجل، إلى اللواتي ضحينَ بعمرهنَّ وحريتهنّ، وبقينَ سجينات في بيوت عائلاتهن أو بيوت عائلات أزواجهن من أجل البقاء مع الأطفال حيث يوجد من يصرف عليهم، إلى اللواتي ضحين بكل شيء في سبيل لا شيء، إلى اللواتي غير ذلك كله.
السيدة نون
لدى نون، وهو الحرف الأول من اسم امرأة سورية، قصة تشبه كثيراً من القصص التي تحصل في المدن السورية، فقد اعتُقل زوجها منذ سنوات على أحد الحواجز، أو بالأصحّ تم اختطافه ليختفي تماماً من عالمنا، دون أن تعرف عنه أي خبر منذ حينها. ورغم أنها ما تزال في العشرينيات من عمرها، إلا أن الحزن المرسوم على وجهها يجعلها تبدو أكبر من عمرها بسنوات.
تقول نون بما يشبه الابتسامة إنها منذ اختفاء زوجها لم تجرؤ على التزين أو وضع أي شيء على وجهها، خشية اتهامها ممّن حولها، وأولهم أمها، بـ «المحظور». لكن نون أيضاً، ما زالت في ريعان الصبا، وخُطّابها ليسوا قلة، وهم من أقاربها الذين يسكنون خارج مناطق سيطرة النظام، في الشمال السوري.
نون أيضاً لديها طفلان صغيران، ويجب أن يكون الزوج الحلم بعيداً عن أجواء الحرب التي كرهتها، ويجب أن يحتضن طفليها قبل أن يحتضنها. وعند حديثها عن خططها للمستقبل، تداعب نون طفليها، ثم تأمرهما بالخروج، وتقول إنهما رغم صغر سنيهما، لا يصغيان إليها، وبأنها لا تعرف كيف تربيهما وحدها، وبأنهما يحتاجان أباً في حياتهما، وبأن ابنها الكبير يخبر أصدقاءه ذكريات متخيلة عن أب متخيل. تقول إن أهل زوجها لم يرسلوا لها أي مال منذ سنوات ولم يسألوا عن طفليها، وإنها انتظرت زوجها لسنوات مديدة، وبذلت كثيراً من المال لأجل أن تعرف شيئاً عنه دون أي جدوى، وإنها لن تحبّ رجلاً كما أحبته.
تقول أيضاً إنها تعبت من المسؤولية التي كانت أكبر من احتمالها، وتقول أخيراً إنها لم تعد تحتمل فكرة تعريض طفليها للخطر، ولذلك فقد اختارت رجلاً طيباً، يسكن في قرية بعيدة آمنة، لكنها لمست فيه محبة لأطفالها، ورجولة هي في أشد الحاجة إليها.
لم تقل نون كل الحكاية، لكن والدتها قالت إن ابنتها ستتزوج رجلاً من عناصر الأمن، ونون تحبه، وقد هددت بأن تهرب معه في حال عدم موافقة الأسرة عليه. حتى أنه هددهم بالشر والأذى إن لم يوافقوا على تزويجها له كما توقل والدتها، وخشية الفضيحة، وافق الأهل في النهاية على الخطبة، عسى أن يقوم القدر بدوره، ويخرب الموضوع قبل تمامه.
بدت نون في منتهى السعادة وهي تشاهد زوجها المستقبلي، رجل الأمن، يداعب طفليها. يشعر الناظر إليهما بالفانتازيا السوداء التي نعيشها، إذ لا يمكن لمن يرى هذا المشهد أن ينساه بسهولة. ومهما اختلف تحليل المشهد وتأويله، إلا أن حقيقة واحدة تبقى، وهي أن نون تحب هذا الرجل، وهو يحبها، وبأنها تبدو في منتهى السعادة وهي تمسك بعلبة للزينة، وكأنها سبيكة نفيسة من ذهب.
خمار أسود
أزاحت الخمار عن وجهها، كانت لديها كل تلك الميزات التي تجعل المرء يرتاح بمجرد النظر إليها، اندفع أطفالها الثلاثة مثل إعصار هادر وجلسوا إلى جوارها، أخرجتْهم من الغرفة بصعوبة، ثم تحدثت وهي مُطرقة عن زوجها الذي استشهد منذ أربع سنوات، عن الصعوبات التي تعانيها لكي تصرف على أولادها، عن أسرتها التي تعيش في لبنان والتي رفضت أن تستقبلها هي وأولادها، عن أهل زوجها الذين رفضوا احتواءها، لأنها رفضت الزواج من أخ زوجها، الذي قالت إنها رفضته لأنه يكفر ولا يصلي، ولأنه يضرب الأولاد.
ثلاثة أسباب كانت كافية بالنسبة لها لاحتمال الحرب الشعواء التي شنها أخو زوجها عليها لرفضها الزواج به، فهو يلاحقها من مكان إلى مكان، يترصدها إن ذهبت لبقالية، أو ذهبت لاستلام المعونة أو توصيل أطفالها للمدرسة. احمرارُ وجنتيها أجابنا عمّا إذا كان يوجد خطّاب يتقدمون لها: «آخرهم كان شاباً في الثالثة والعشرين، أصغر مني باثني عشر عاماً، طلب الزواج مني ورفضت».
قصتها واحدة من بين مئات القصص الأخرى، لا سيما مع قضية أصبحت رائجة منذ سنوات بين الأُسر التي فقدت أبناءها، حيث يعمد الأهل إلى تزويج زوجة ابنهم المتوفى غصباً من أحد أخوته، ولو كان متزوجاً، مهددين الأرملة إن لم توافق بأخذ أطفالها منها. بهذا الزواج الذي يتم إجبار نساء كثيرات عليه، يبقى الأطفال في كنف أهل الزوج، ويسقط عبء الزوجة وأطفالها عن كاهل أهلها.
لكن الضحية هنا ليست الأرملة فقط، بل أيضاً زوجة الأخ التي ستحتمل وجود زوجة ثانية في بيتها. كما حصل مع «ف» التي تزوج زوجها من أرملة أخيه، والتي لم يخطر في بالها يوماً أنها ستسكن مع امرأة ثانية تشاركها زوجها. قالت إنها لم تنم ليلة زواجهما، وإنها فقدت خمسة عشر كيلوغراماً من وزنها من شدة حزنها وغيرتها، قالت إن زوجها باع خاتمها ليتحمل تكاليف الزواج الثاني، وإنها لم تستطع أن تعترض بحرف كي لا يتم الاستغناء عنها.
لا تنتهي القصص التي يمكن أن تُقال عن هذه الشريحة الواسعة المظلومة من ضمن البقية، بينما تبقى قصص أخرى طي الصمت والكتمان، لكن لعلكم الآن مستعدون لأن تقرؤوا قصة السيدة «سين»، وهي أرملة شهيد لم تتجاوز الخامسة والعشرين من عمرها، جاءت يوماً لتستأجر بيتاً لها ولطفلها في أحد الأحياء.
في هذا الحي يُجبر الأمنُ الأهالي أن يستأذنوا الحاجز قبل القيام بأي إجراء من هذا القبيل، وقد أُعجب رئيس الحاجز بالمرأة حين رآها وحاول التقرّب منها، لكنها رفضته تماماً، فما كان منه إلا أن فرض على أهالي الحي ألا يؤجروها بيتاً من بيوتهم تحت طائلة المسؤولية. لم تقبل المرأة ما حصل، وحملت الشكوى إلى حاجز قريب آخر، حيث قدمت بلاغاً ضده وشكته إلى رئيس الحاجز الآخر، وهذا بدوره سمع شكوى المرأة واستجاب لها ورفع شكواها لسلطة أعلى منه، وكان من خواتيم الأمر أن سُجن رئيس الحاجز الذي ابتزَّ تلك المرأة حينها.
لكن هل يُحسب الأمر نصراً حين تشكو الظالم لظالم؟ أو حين يصبح الأمر أشبه بمقامرة تحمل في داخلها كل احتمالات الربح والخسارة القاتلة، أو عندما تنتصر امرأة لنفسها، بينما البقية خائفون بعيدون مبعدون لائذون بالصمت والنكران.
لذا تخفَّفوا من شعور الراحة والسعادة لأن امرأة استطاعت انتزاع حقها، لكن ممن؟ وضد من؟ وكم عدد اللواتي يملكن تلك الجرأة لفعل ذلك؟ وما هو المسار الآخر الذي كادت أن تؤول إليه الأمور كما حصل مع نساء أخريات لم يمتلكن الجرأة ذاتها، فالتحفنَ الطرقات والحدائق، أو اتّبعنَ سبلاً أخرى لا داعٍ لذكرها.
لكن دعكم من كل ذلك، واستمعوا لما سأقوله الآن.
لو أنك كنتَ موجوداً (2)
سأكون عيونكم في الشارع الآن، نعم إنهنَّ يتمايلنَ بغنج مفرط، هنا صبيّة صغيرة تمشي مع عسكري، وهناك امرأة أخرى كذلك. وهنا مجموعة هائلة من النساء بكامل أناقتهنّ، يجلسن في مقهى وعيونهنَّ على الشبان القليلين المتواجدين فيه، عيون العساكر والشبيحة عليهنّ أيضاً، إذ ينجح الإغواء أحياناً.
لديكم كثيرٌ من النساء وقليلٌ من الشبان الوحيدين الذين لا عسكرية لهم، أو المصابين بعاهة أو بمرض يحول دون انضمامهم للجيش، أو المنتظرين على قائمة الاحتياط، أو الذين يتجهزون أصلاً للسفر عند اكتمال أوراق، أو قبيل تخرجهم من الجامعات. ولديكم بالمقابل أعداد هائلة من العساكر القادمين من شتى المحافظات، حلب حمص دير الزور درعا، سمّوا ما شئتم من المدن، ستجدونهم من بين المئات الذين يتمشون في الشوارع مع المدنيين باعتياد الضرورة التي لا مفر منها.
بعض النساء أصبحنَ يفتخرنَ بتزويج بناتهنّ لعسكري، بعض الفتيات أصبحنَ يفتخرنَ بعلاقتهنّ بعسكري. يختلط كل شيء بكل شيء، يختلط الصواب والخطأ في لحظة واحدة. تقول والدةُ فتاة في السادسة عشرة من عمرها إنها اضطرت لتزويج ابنتها بعسكري لأنها يتيمة الأب، ولأنها لا تستطيع تحمل مصروفها، ولأن وضعها الدراسي سيء ولم يبق أمامها سوى أن تزوجها.
تقول أم أخرى إنها اضطرت لتزويج ابنتها لعسكري لأنه لا يوجد غيرهم هنا، بينما البقية مسافرون أو في المعتقلات أو في القبور أو غير مناسبين لعمر ابنتها. تقول أم ثالثة إن حظوظ الأرامل بالزواج أكبر من حظوظ الفتيات اللواتي لم يسبق أن تزوجنَّ هنا، فكثيرات من الأرامل، لا سيما اللواتي يعانين ظروفاً اجتماعية واقتصادية مأساوية، يجدنَ أنفسهنّ مضطرات في النهاية للقبول بأي متقدم لهنّ أياً يكن وضعه، وهو ما يدفع رجالاً كثيرين للتفكير في خطبتهن قبل غيرهنّ.
في خضمّ كل ذلك، تسمع من يرمي النكات ساخراً عن كوكب زمردة، وعن أن النساء سوف يخلعن الحجاب قريباً في الطرقات لندرة الرجال، وبأن «الآية انعكست وبات الشاب ملاحقاً من الفتيات». وبين إطلاق النكات وإطلاق ناقوس الخطر، شجّع القاضي الشرعي في سوريا الرجال على الزواج من امرأة ثانية للحد من ظاهرة العنوسة، لكن من حسن حظ السوريات المقيمات في المدن خصوصاً، والواقعة تحت سيطرة النظام تحديداً، أن هذا النداء لم يأخذ صداه المطلوب، لأن تردي الواقع الاقتصادي لا يسمح بانتشار هذه الظاهرة على نطاق واسع، دون أن يعني ذلك أن هذه الظاهرة لم تبدأ بالتوسع أكثر من ذي قبل، حتى سادت الخشية من أن تصبح الفكرة أكثر قبولاً، مع تبعاتها السلبية الهائلة والمشاكل التي ستسببها.
جنة النساء
انتشرت في مدينة حمص منذ فترة ظاهرة ملفتة، تتعلق بقيام النسوة بحجز صالة أفراح لمدة عدة ساعات لقاء مبلغ معين، وتحت مسميات مختلفة. يرتدينَ أجمل ما عندهنّ من ثياب ومجوهرات، لتبدأ مراسم الاحتفالات والرقص، أو ما يسمى «عرس من دون عروس وعريس». يقام هذا الاحتفال بهدف عرض النسوة لبناتهنّ في سبيل تزويجهن، أو استعراض مادي بحت لمقتنياتهن أمام الأخريات، إضافة إلى كونه بديلاً مقبولاً في المجتمع الحمصي عن الذهاب إلى أماكن عامة «غير مرغوبة».
تعددت الآراء، بين معارض لهذه الأمر كونه فسحة للأغنياء للاستعراض، وبين مؤيد قال إنه فرصة لعرض الفتيات للزواج. وبين مؤيد ومعارض لهذه الظاهرة، تستمر الاحتفالات الوهمية في المدينة المحطمة، التي تشكل هذه الظاهرة فيها جزءاً صغيراً من صورة أكبر وأشمل بكل تأكيد.
برسيز
في الآونة الأخيرة تم افتتاح مقهى راقٍ للنساء فقط في مدينتي، تجتمع فيه الفتيات والسيدات الراغبات بالابتعاد عن صخب المقاهي وعيون روداها المترصدين، أو اللواتي لا يَسمح لهنّ أزواجهنّ عادة بالذهاب إلى المقاهي، ثم سمحوا لهن بذلك الآن لمعرفتهم أن كوكب زمردة بات حقيقياً، وهو ما نشعر به بسخرية عندما نكون في ذاك المقهى.
أصبح ذاك المقهى بالتدريج المكان المفضل لسيدات المجتمع المخملي، لا سيما اللواتي يُعرفن بتدينهنّ. كذلك تلجأ إليه السيدات الراغبات بتدخين سيكارة من دون لوم اللائمين وثرثرة العائبين، زد على ذلك الفتيات الزاهدات ببريق المقاهي المختنقة بدخان الأراكيل، التي تجري فيها عادة مواعيد صامتة بالعيون. لكن الأجمل من كل ذلك هو مراقبة ما يدور في المقهى، لا سيما حينما تنحني أنثى رقيقة لتسأل بمودة إن كنتُ أودّ لعب الشطرنج أو البرسيز معها.
*****
لا ينتهي الحديث هنا عن جانب يتحرّج كثيرون من الخوض فيه، وهم محقون في ذلك، فالمرأة، نون النسوة، وتاء التأنيث المكسورة عند سكون من يجاورها أو «غيابه»، تبقى خطاً أحمر لدى مجتمع جعلها نقطة ضعفه، وجعلها مثلها كعب أخيل بدل أن تكون نقطة ارتكاز ومنبع قوة. أقول، رغم الحرج من هذا الموضوع ومحاولة إخفائه، إلا أنه موجود وسيبقى كذلك ما بقيت الأوضاع على حالها. لعلّها ضريبة الحصول على وطن أفضل، تلك التي ندفعها جميعاً، وفي التاريخ أحداث مشابهة في بلدان كثيرة، نهض بعدها النساء والرجال واقفين وأكملوا المسير.
استجابةً لطلب إحدى النساء اللواتي ينطبق عليهن كثير مما سبق، أختم بهذه الكلمات للكاتب الفلسطيني ابراهيم جابر ابراهيم
حين يعود الرجال من الحرب
سأحبّ واحداً منهم
وآخذه إلى بيتي
ذاك الذي يمشي آخر القافلة
ويظل ينظر خلفه
يشعر بالخجل… لأنه عاد سالماً.