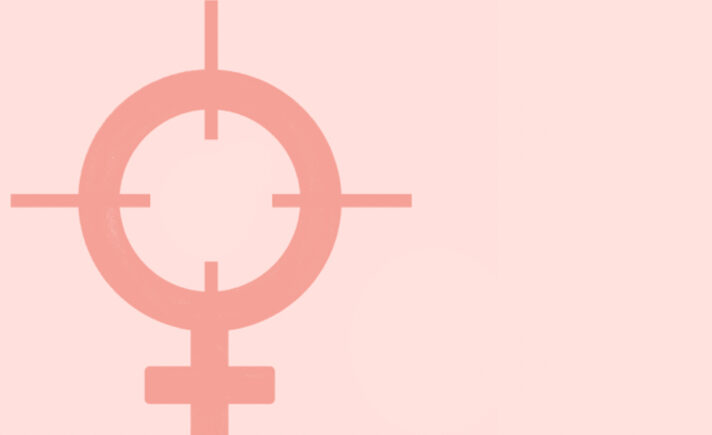الجنسانية للنسوية هي كالعمل للماركسية: أكثر ما يخص المرء وأكثر ما يؤخذ منه. تُجادل النظرية الماركسية بأن المجتمع يُبنى بشكل أساسي من العلاقات التي يُشكلها الناس أثناء عملهم وصنعهم لأشياء يحتاجونها للاستمرار إنسانياً. العمل هو العملية الاجتماعية التي تشكّل وتحوّل العوالم المادية والاجتماعية، خالقةً من الناس كائنات اجتماعية في خضمّ خلقهم هم للقيمة. العمل هو النشاط الذي من خلاله يُصبح الناس أنفسهم. الطبقات هي البنية التي يتموضع فيها هذا النشاط، والإنتاج هو غايته؛ رأس المال هو مادته المتخثرة، والسيطرة إشكاله.
تُضمر النظرية النسوية طرحاً موازياً: عملية تشكّل الجنسانية وتوجيهها والتعبير عنها تَنظم المجتمع في جنسين: النساء والرجال، وعلى هذا التقسيم تُبنى كل العلاقات الاجتماعية. الجنسانية هي العملية الاجتماعية التي تخلق، وتنظّم، وتوجّه، وتعبّر عن الرغبة، فتخلق من خلال ذلك الكائنات الاجتماعية كرجال ونساء، وهؤلاء يخلقون المجتمع بعلاقاتهم. وكما العمل للماركسية، الجنسانية هي منتَج اجتماعي منتِج بدوره، كوني الطابع وخاضع للتاريخ في نفس الوقت، ويَجمع في تشكيله بين المادي والعقلي. وكما أن التجريد المنظم لعمل البعض لصالح البعض الآخر يُعرّف الطبقة – العمال – كذلك فإن التجريد المنظم لجنسانية البعض من أجل استخدام البعض الآخر يُعرّف الجنس – النساء. الغيرية الجنسية هي البنية التي يتموضع فيها هذا النشاط، والعائلة والجندر مادته المتخثرة، والأدوار الجنسية هي طابعه المعمّم إلى درجة الشخصية الاجتماعية، والتكاثر نتيجته، والسيطرة إشكاله.
الماركسية والنسوية نظريتان في القوة وتوزيعها: في اللامساواة. كلاهما يقدم تصوراً عن الترتيبات الاجتماعية القائمة على عدم تكافؤ ممهنج وعن حيازتها لعقلانية داخلية خاصة على الرغم من عدم عدالتها. لكن تخصص كل نظرية ليس عارضاً. حرمان المرء من عمله في الماركسية، ومن جنسانيتها في النسوية، يحدد مفهوم كل منهما لفقدان القوة بألف ولام التعريف. لا تهدف النظريتان إلى التموضع بجانب بعضهما للتأكد من عدم إهمال مجالين اجتماعيين مختلفين ومستقلين، أو عدم إغفال مصالح مجموعتين من الناس، أو عدم تجاهل دور نوعين من العوامل. لا! تهدف كل نظرية على حدة للقول إن العلاقات التي يعمل فيها الكثير ويربح القليل، أو يَنكح فيها البعض ويُنكح البعض الآخر، هي الحيز التأسيسي للسياسة.
ماذا لو أخذنا أقوال كلا النظريتين على محمل الجد بشكل متساوٍ، كلاً حسب افتراضاته؟ هل يمكن لعمليتين اجتماعيتين أن تكونا تأسيسيتين في الوقت عينه؟ هل من الممكن إخضاع مجموعتين بأشكال متضاربة، أم أنهما تتناوبان فقط؟ هل يمكن التوفيق بين نظريتين، تدعي كل منهما أنها تشرح الشيء نفسه – القوة بحدّ ذاتها؟ أم أن هناك علاقة بين حكم القلة للكثرة منذ القدم وواقع أن هذه القلة طالما كانت رجالاً؟
في حال مواجهة ندية بينهما، تطرح كل نظرية على الأخرى أسئلة جذرية: هل الهيمنة الذكورية إحدى نتائج الرأسمالية أم أن الرأسمالية هي إحدى تعبيرات الهيمنة الذكورية؟ ما الذي يعنيه للتحليل الطبقي لو أمكن للمرء التأكيد أن مجموعة بشرية يجري تعريفها واستغلالها بوسائل مستقلة تماماً عن الإنتاج وتنظيمه، وإن بأشكال مناسبة له؟ ما الذي يعنيه للتحليل النسوي لو أمكن للمرء التأكيد أن الراسمالية لن تتغير بشكل مادي لو تحققت المساواة بين الجنسين، أو حتى لو سيطرت النساء؟ إذا كانت البنى والمصالح التي تخدمها الدولة الاشتراكية والدولة الرأسمالية تختلف طبقياً، هل تتساويان على صعيد اللامساواة الجنسية؟ هل يشكل هذا قاسماً مشتركاً بينهما ضمن الحد الذي قد تتشابهان فيه بشكل عام؟ هل هناك علاقة بين سيطرة بعض الطبقات على طبقات أخرى، وسيطرة كل الرجال على كل النساء؟
بدلاً من مجابهتها، تجاهل الماركسيون والماركسيات، كما النسويات، هذه الأسئلة؛ أو أدغموها ببعضها البعض. انتقد الماركسيون النسوية بصفتها برجوازية الطابع، في النظرية كما في الممارسة، بمعنى أنها تعمل لمصلحة الطبقة السائدة. وجادلوا بأن تحليل المجتمع على أساس جنسي يعني تجاهل الانقسامات الطبقية بين النساء، وتقسيم البروليتاريا. وحاججوا بإمكانية إرضاء مطالب النساء بشكل كامل من خلال الرأسمالية، ولذلك فإن مساعيهن تُضعف الجهود من أجل تغيير جذري وتَحرفها. المساعي لتذليل العقبات في وجه ذاتية المرأة – المرافعة عن حقّ المساواة في فرص الحياة بغضّ النظر عن الجنس – تبدو لهؤلاء ذات طابع فرداني وليبرالي. ما يجمع بين النساء يأتي من الطبيعة وليس من المجتمع، فيما يتم التعامل مع التحليلات العابرة للثقافات التي تنظر إلى أوضاع النساء الاجتماعية وكأنها غير تاريخانية وغير عابئة بالخصوصيات الثقافية. كما أن تركيز النسويات على المشاعر والمواقف بوصفها أجزاء مهمة من الواقع الاجتماعي يعتبر مثالياً، أما بيئة النسويّة، المتشكلة بشكل أساسي من نساء الطبقة الوسطى المتعلمات، فيجري تقديمه كشرحٍ وافٍ للطابع الانتهازي لهذه الحركة.
أما النسويات فيجادلن بأن الماركسية مُذكّرة في نظريتها وممارستها، بمعنى أنها تتحرك ضمن نظرة الرجال للعالم ولخدمة مصالحهم. فتحليل المجتمع حسب المعايير الطبقية وحدها يتجاهل التجربة الاجتماعية المتميزة لجنس دون غيره، ويغطي على وحدة التجربة النسائية. ويمكن في الواقع تلبية المطالب الماركسية، وقد جرى ذلك بالفعل، دون أن تتغير علاقات اللامساواة التي تربط النساء بالرجال. لطالما رأت النسويات أن الحركات العمالية واليسارية تقلل من قيمة عمل المرأة واهتماماتها، وتهمل دور المشاعر والمواقف النفسية من خلال تركيزها على المؤسسات والتغيير المادي، وتحط من قيمة المرأة في الإجراءات والممارسة والحياة اليومية، وتفشل عموماً في تمييز نفسها عن أي إيديولوجيا أو مجموعة أخرى تطغى عليها مصالح الرجال. يتهم الماركسيون والنسويات بعضهم بعضاً بأنهم – حسب تعبير كل طرف بخصوص الآخر – يسعون لـ«الإصلاح» – أي لتغييرات تخفف وتحسن الأمور دون أن تتصدى لأسس المشكلة، في حين أن المطلوب هو انقلاب جذري. في صورتها الأكثر تطرفاً، لا تكتفي هذه النظرة المتبادلة بالقول بخطل تحليل النظرية الأخرى، بل أيضاً بأن نجاحها هو في الواقع هزيمة.
لا تخلو هاتان المرافعتان من الصحة. فحسب النظرة النسوية، يقوم الجنس – على الصعيد التحليلي كما في الواقع – بتقسيم الطبقات، وتلك حقيقة لطالما رغب الماركسيون في إنكارها أو تجاهلها بدلاً من شرحها أو تغييرها. وبشكل موازٍ، ينظر الماركسيون إلى شرائح من حركة تحرر المرأة بوصفها مجموعة مصالح خاصة تعبر بشكل أساسي عن الميسورات من النساء: المتعلمات والموظفات. اعتبار مجموعة المصالح الخاصة هذه معادلة لـ«حركة تحرر المرأة» ينفي إمكانية مساءلة تعريف «المصالح» و«المقاومة» بشكل يعطي مرئية أكبر للشريحة الأضيق اجتماعياً من صاحبات القضية. لكن وفي الوقت نفسه، فإن المدافعات عن مصالح النساء لم يكنّ دوماً واعيات طبقياً، والبعض منهن استغل المنطق الطبقي من أجل تحصيل بعض المكاسب، حتى عندما عنى ذلك تغييب مصالح لا الطبقة العاملة عموماً فقط، بل تحديداً النساء منها أيضاً.
فعلى سبيل المثال، في عام 1866، وفي تحرك اعتبر تاريخياً بمثابة إطلاق للموجة النسوية الأولى، رفع جون سيتورات ميل عريضة للبرلمان الإنكليزي للمطالبة بحق المرأة في الانتخاب مستخدماً التبرير الجزئي التالي: «تحت أي ظرف وحسب أي شرط تم منح الرجال حق الانتخاب، لا يوجد أدنى مبرر لعدم إعطاء النساء الحق ذاته. لا تختلف معظم نساء أي طبقة في آرائهن السياسية عن رجال تلك الطبقة نفسها». ربما ما عناه ميل هو أنه إلى الحد الذي تُقرر فيه طبقة المرء رأيه السياسي، لا أهمية للجنس. بهذا الشكل، تبدو المحاججة للبعض شديدة الضيق. ويمكن في الواقع استخدامها لجعل حق الانتخاب لدى النساء محدوداً بأولئك «المنتميات» إلى رجال الطبقة الذين يمارسون هذا الحق سلفاً، بما يعمق استثناء الطبقات الأدنى، بما في ذلك «نساؤها».
طريقة المحاججة هذه لا تتوقف عند حق الانتخاب ولا عند القرن التاسع عشر. فمنطق ميل ينتمي إلى بنيان نظري يستند إليه الكثير من التنظير النسوي المعاصر ويجعل الكثير من النقد الماركسي مبرراً. فكرة ميل الداعية للسماح للنساء بالانخراط في السياسة تعبر عن اهتمامه بألا تحدّ الدولة من حكم الأفراد لأنفسهم، من حريتهم في تطوير مواهبهم بغرض النمو، من قدرتهم على المشاركة في المجتمع والعمل لفائدة الإنسانية. بوصفه إمبريقياً عقلانياً، رفض ميل رد ما يمكن شرحه من خلال البيئة الاجتماعية إلى الطبيعية البيولوجية. وبوصفه نفعياً، وجد أن معظم أنواع اللامساواة على أساس الجنس خاطئة أو مشكوك بصوابها أو غير منتجة وبالتالي غير عادلة. حرية النساء كأفراد في تحصيل الحدود القصوى لنمائهن الذاتي دون تدخل عشوائي هي بكل بساطة امتداد لالتزامه الأصلي بقدرة الرجل العصامي على تطوير نفسه حسب كفاءته، ولذلك فهو يُدين التمييز الجنسي من باب حدّه للمبادرة الفردية وحرية «دعه يعمل».
قدرة هذا النوع من التحليل على استيعاب الاعتبارات الماركسية محدودة. فالمرء قد يستطيع مد طرح ميل ليغطي الطبقة بصفتها عاملاً اجتماعياً وعشوائياً آخر يقود إلى تطور غير فعال للمواهب وتوزيع غير عادل للموارد بين الأفراد. لكن هذا يبقى بعيداً عن التحليل الطبقي على الرغم من ماديته. ميل لا يمكن أن يسمح بتساوٍ في المداخيل حتى، وذلك لأن التوزيع غير المتساوي للثروة هو تماماً ما تنتجه حرية «دعه يعمل» والمبادرة الشخصية غير المضبوطة. مفهوم الحق الفردي الذي تحتاجه هذه النظرية على الصعيد القانوني (خصوصاً ولكن ليس حصراً في الحيز الاقتصادي)، أي المفهوم الذي ينتج التوتر بين حرية الفرد والمساواة بين الجميع، يؤطر النسوية الليبرالية، معطياً بذلك وجاهة للنقد القائل إن النسوية تنتمي للقلة صاحبة الامتيازات.
كذلك فإن النقد الماركسي للنسوية بصفتها مشغولة بالمشاعر والمواقف النفسية يستند إلى شيء حقيقي: مركزية «رفع الوعي» لدى النسوية. فرفع الوعي هو التقنية التحليلية، والبنية التنظيمية، ومنهج الممارسة، ونظرية التغيير الاجتماعي في حركة تحرر المرأة. فمن خلال رفع الوعي، في سياق جماعي غالباً، ينكشف الغطاء عن السيطرة الذكورية ليتم تحليلها عبر التجارب الجماعية للمرأة ومن جهة نظر تلك التجارب. ولأن الماركسيين يميلون إلى فهم انعدام القوة بصفته تجربة صلبة ومفروضة على المرء من خارجه، فهم أيضاً يعتبرون أن التغيير نفسه يجب أن يكون صلباً ومن خارج بنى السيطرة. في رفع الوعي، يتبدى ضعف المرأة بصفته داخلياً ومفروضاً من الخارج في الوقت عينه، بحيث تصبح «الأنوثة»، على سبيل المثال، هوية بالنسبة للمرأة وانجذاباً بالنسبة للرجل. مفهوم النسوية للوعي ومكانه في النظام والتغيير الاجتماعي ينبع من هذا التحليل العملي. ما تعتبره الماركسية تغييراً في الوعي ليس شكلاً من أشكال التغيير الاجتماعي بحد ذاته. أما بالنسبة للنسوية فباستطاعته أن يكون كذلك؛ لكن الوعي النسوي ليس في العقل فقط، لأن قهر النساء لا يحدث في العقل فقط. فالألم، والعزلة، و«التشييء» الذي تعايشه المرأة التي تم تدليلها وإسكاتها إلى أن انعدمت ذاتيتها – النساء اللواتي «بتن بشعات وخطرات بسبب كونهن نكرات لوقت طويل» – يصعب على المحرومين مادياً النظر إليه كشكل من أشكال القمع، سيما بالنسبة للفقيرات اللواتي لم يسبق أن قام رجل من الرجال بـ«تدليلهن» قبل ذلك.
وبشكل مواز، لم تتم إساءة فهم الماركسية فقط. النظرية الماركسية حاولت بالفعل فهم كل أنواع التفاوت الاجتماعي الهامة من خلال منظار طبقي. بهذا المعنى، يبدو الجنس كما العرق والقومية تحدّياً مستمراً وغير مستوعب تماماً أمام حصرية أو أولوية الطبقة في شرح الواقع الاجتماعي. كثيراً ما يحاول الماركسيون والماركسيات مدّ تحليلهم الطبقي ليشمل النساء، في تقسيم ودمج لا يبدو بالنسبة للنسوية صالحاً للتعبير عن تجربة النساء المشتركة والمختلفة. في عام 1912، على سبيل المثال، توجهت روزا لوكسمبورغ لمجموعة من النساء بخصوص قضية حق الانتخاب: «معظم تلك النساء البرجوازيات اللواتي يتصرفن كلبوات في الصراع ضد الامتيازات الذكورية سيتحولن إلى حملان وديعة في معسكر المحافظين ورجال الدين بعد أن يحصلن على حق الانتخاب. بل سيكنّ أكثر رجعية بأشواط من الذكور من أبناء طبقتهنّ. باستثناء القلة ممن لديهن مهنة أو وظيفة، لا تشارك البرجوازيات في الإنتاج الاجتماعي. هن فقط مستهلكات للفائض الذي يمتصه رجالهن من الطبقة العاملة. هن طفيليات على طفيليات هذا الجسم الاجتماعي». أما تعاطفها فيتوجه لنساء الطبقة العاملة اللواتي يستمددن حقهن في التصويت من كونهن «منتجات في المجتمع كالرجال». في نقطة عمياء في منظورها تعادل تلك التي في منظور ميل، تدافع لوكسمبورغ عن حق النساء في التصويت على أساس طبقي، مع أن التصويت كان سيفيد النساء بغض النظر عن طبقتهن في كلا الحالتين.
لا لوكسمبورغ ولا معظم الماركسيين والماركسيات فكرن بالنساء كنساء، بغض النظر عن التمايزات الطبقية وبمعزل عن البيولوجيا. وكما ميل، وبدون وعي، يبدو وكأن لوكسمبورغ تعترف أن النساء يستمددن موقعهن الطبقي، وما يعنيه من امتيازات أو محدوديات، من خلال ارتباطهم بالرجال. قد يشرح هذا بالنسبة لنسوية أو نسوي لماذا لا تتحد النساء ضد الهيمنة الذكورية، لكنها لا تشرح هذه الهيمنة، التي تخترق الفوارق الطبقية حتى عندما تتخذ شكلاً مختلفاً في كل طبقة. ما يميز المرأة البرجوازية عن خادمتها المنزلية هو أن الرجل يدفع للثانية (وإن بالكاد) في حين يعيل الأولى (وإن وفق شروط)، لكن هل هذا اختلاف في الإنتاجية الاجتماعية أو في مؤشراتها فقط؟ مؤشرات هي نفسها منتج لمكانة المرأة المتدنية. لوكسمبورغ ترى في زمانها أن البرجوازيات «طفيليات على طفيليات»، لكنها تفشل في ملاحظة ما يشتركن به مع النساء العاملات اللواتي هن «عبيد العبيد». في حالة المرأة البرجوازية، أن نتوقف في تحليلنا لعلاقة النساء بالرأسمالية عند ما يتعلق بالرجال فقط يعني أن نلاحظ الجانب غير المباشر. ألا نفعل ذلك في حالة المرأة العاملة يعني ألا نلاحظ جانبها غير المباشر.
يعزز الرصد النسوي لوضع المرأة في الدول الاشتراكية من النقد النسوي النظري للماركسية، وإن كان لا يبت نهائياً في دور الماركسية في خلق هذا الوضع تماماً. فحسب النظرة النسوية، قامت هذه الدول بإيجاد حلول لكثير من المشاكل الاجتماعية، لكن دون أن تتمكن من معالجة إخضاع المرأة. ليس النقد هنا أن الاشتراكية فشلت في تحرير المرأة بشكل تلقائي أثناء تحويلها لعملية الإنتاج (على فرَض أن هذه العملية جارية على قدم وساق)، ولا يهدف النقد للتبخيس من أهمية هذه التحولات بالنسبة للنساء: «هناك فرق بين مجتمع يعبر عن التمييز الجنسي من خلال قتل الرضيعات الإناث، ومجتمع يعبر عن التمييز الجنسي من خلال تمثيل غير منصف للنساء في اللجنة المركزية للحزب الحاكم، وهذا فرق يستحق أن نموت من أجله». النقد هو أن هذه البلدان لا تجعل العمل من أجل النساء أولوية تميزها عن الدول غير الاشتراكية. تقيّم الدول الرأسمالية عمل النساء حسب معايير «الكفاءة» التي يضعها الذكور، وفي الدول الاشتراكية تبقى النساء غير مرئيات إلا من خلال قدرتهن كـ«عاملات»، وهذا مصطلح قليلاً ما يشمل عمل المرأة الخاص: في البيت، في تقديم خدمات جنسية، في تربية الأطفال. اهتمام القيادات الثورية بإنهاء حصر النساء في الأدوار التقليدية يبدو بدوره محصوراً في تجنيد عمل النساء لصالح النظام الحاكم، بما يجعل النسويات يتساءلن عن مصالح مَن تحديداً يخدم هذا التحرر. تكتسب النساء حرية العمل خارج المنزل ولكن يبقى الرجال متحررين من العمل داخله. هذا يحدث أيضاً تحت الرأسمالية. عندما يخدم عمل المرأة أو نشاطها حاجات طارئة، تصبح فجأة مساوية للرجل، ولكنها سرعان ما تتراجع عندما ينتهي الظرف الطارئ. لا تجادل النسويات أن الأمر سيّان في حال تذيّل النساء للنظام الإقطاعي أو الرأسمالي أو الاشتراكي. بل أنه على الرغم من التغييرات، التذيّل يبقى تذيلاً.
في أماكن مثل كوبا والصين، حيث تم نقد هذه المواقف والممارسات، يبدو التغيير تدريجياً ومحفوفاً بالمخاطر، حتى عندما تبدو الجهود هائلة. إذا كان استلام زمام الدولة والقدرة الإنتاجية قادراً على قلب علاقات العمل، فإنه ليس قادراً على قلب العلاقات الجنسية بنفس الوقت أو بنفس الطريقة، كما كان قد تنبأ تحليل طبقي للجنس. التكنولوجيا والاشتراكية، وكلاهما يدعي قدرته على تغيير دور المرأة في عملية الإنتاج، أخفقتا في إنصاف المرأة في علاقتها مع الرجل. حسب النظرة النسوية، كل شيء أخفق. على أقل تقدير، المطلوب جهد إضافي منفصل، جهد قد يتمكن من تشكيله نظام وعلاقات عمل ثورية، لكنه يبقى منفصلاً مع ذلك. في ضوء هذه التجارب، تبدو نضالات النساء في الدول الرأسمالية والاشتراكية بالنسبة للنسويات أقرب إلى بعضها بكثير من قربها للنضالات اليسارية في أي مكان.
محاولات إيجاد توليفة بين الماركسية والنسوية، والمسماة النسوية الاشتراكية، لم تعترف بعمق التضاد والكينونة المستقلة لكل نظرية. تبقى التناقضات نفسها في نهاية المطاف كما في بدايته، وتُحسم بشكل نسوي أو ماركسي، وفي أكثر الأحيان تغلب الماركسية. الممارسة النسوية الاشتراكية كثيراً ما تنقسم حسب الخطوط ذاتها، فتبدو وكأنها عبارة عن عضوية في منظمتين مختلفتين، أو دعم متبادل بين مجموعتين مرتبط بقضايا محددة. تطالب النسويات المنظمات اليسارية والعمالية بالانتباه لقضايا المرأة، في حين تتابع الماركسيات قضايا متعلقة بالطبقة داخل المنظمات النسوية، أما المؤسسات التي تعرّف نفسها كنسوية اشتراكية منذ البداية فكثيراً ما تتشكل لتعود وينفرط عقدها، تماماً بسبب الاختلافات بين النسوية والاشتراكية.
معظم المحاولات للتوفيق تسعى لتستوعب جاذبية القضية النسوية من خلال إدماج قضايا عزيزة على قلوب النسويات – العائلة، العمل المنزلي، الجنسانية، الإنجاب، الحياة الاجتماعية والشخصية – ضمن قالب نظري ماركسي جامد. فحسب المذاهب الماركسية المختلفة، باتت النساء إما طبقة، أو فئة، أو «كاست»، أو مجموعة ثقافية، أو فصيل من المجتمع المدني، أو تناقض ثانوي، أو تناقض غير عدائي، وبات تحرر المرأة جزءاً من البنية الفوقية أو جانباً هاماً من الصراع الطبقي. وفي معظم الحالات تم اختزال النساء إلى نوعية محددة، مثل «النساء العاملات»، وتم التعامل مع هذه النوعية كمعادل للنساء جميعاً. أو، فيما بات أشبه بالمنعكس اللاإرادي، باتت النساء كناية عن «العائلة» وكأن هذا الشكل الفريد لتقييد المرأة يمكن افتراضه وعاءً لشرطها. أو يتم تحليل المعنى الماركسي لإعادة الإنتاج، وعلاقات الإنجاب، بوصفه كناية عن التكاثر البيولوجي، وكأن إخضاع النساء للرجال يمكن شرحه من خلال فروقاتهم الجسدية فقط، وكأن هذا المعادل الاجتماعي للفروق البيولوجية يجعل من تعريف النساء «مادياً»، ولذلك يبدو وكأنه مستند في نهاية المطاف إلى تقسيم للعمل، ولذلك يمكن اعتباره حقيقياً، وبالتالي غير عادل. الجنسانية إن تم ملاحظتها على الإطلاق تُعامَل كما «الحياة اليومية» وكأنها حيادية على أساس الجندر، وكأن معناها الاجتماعي يمكن افتراضه، وكأنه نفسه أو متساوٍ أو مكمّل لبعضه عند الرجال كما عند النساء. وعلى الرغم من اقتراب استراتيجيات الإدماج هذه من التعبير عن نظرية موحدة للمساواة الاجتماعية، إلا أنها دائماً تنتهي إلى توليفة غير متوازنة، يجري فيها، على الرغم من كل التعاطف، اختزال «سؤال المرأة» إلى سؤال آخر، بدلاً من التعامل معه بوصفه «الـ»سؤال، الذي يقتضي التحليل حسب شروطه الخاصة.
تقف النسوية الاشتراكية أمام مهمة التوليف وكأن لا شيء مهماً في كلا النظريتين يعترض زواجهما – بالفعل يبدو لها الزواج وكأنه تم بالفعل وينتظر الاحتفال فقط. الفشل في دمج النظريتين على أساس ندي ينبع من الفشل في مواجهة كل منهما على أرضيته: على مستوى المنهج. يقوم المنهج بتشكيل نظرة كل نظرية للواقع الاجتماعي. يعرّف المنهج للنظرية إشكاليتها المركزية، مجموعتها، صيرورتها، ويخلق بناء على ذلك مفهومها الخاص للسياسة. إذاً، العمل والجنسانية كمفهومين يستمدان معناهما وأهميتهما من الطريقة التي تقارب فيها كل نظرية من النظريتين عالمها، فتستوعبه وتفسره وتسكنه. هناك بلا شك علاقة بين كيف ترى النظرية ما تراه وما هو الشيء الذي تراه: هل هناك منهج ماركسي بلا طبقة؟ منهج نسوي بلا جنس؟ المنهج ينظم طريقة فهم الحقيقة، يحدد ما يمكن اعتباره دليلاً، ويعرّف ما يمكن التعويل عليه كبرهان. بدلاً من الانخراط في جدل حول أسبقية الجنس على الطبقة أو بالعكس، مهمة النظرية هي سبر التناقضات والصلات بين المناهج التي رأت أصلاً أن من المهم استخدام هذه المفاهيم لتحليل العلاقات الاجتماعية.
لم يتم النظر إلى النسوية بوصفها ذات منهج، أو حتى طرح نظري أساسي يمكن الاشتباك معه. لم يتم النظر إليها بوصفها تحليلاً ممنهجاً، بل مجموعة رخوة من العوامل، والتظلمات، والمواضيع، والتي بإمكانها إن أُخذت سوياً أن تصف لا أن تشرح حظوظ الجنس الأنثوي المتعثرة. التحدي هو أن نظهر أن النسوية تتمحور بشكل ممنهج حول شرح مركزي للامساواة الجنسية من خلال مقاربة متميزة لموضوعها يمكن تطبيقها على الحياة الاجتماعية بأسرها، بما في ذلك الطبقة.
تحت مسمى النسوية، تم شرح وضع المرأة بصفته نتيجة للبيولوجيا، أو للإنجاب والأمومة، للتنظيم الاجتماعي للبيولوجيا، أو قوانين الزواج، العائلة الأبوية التي تنتج المجتمع الأبوي، أو بسبب أدوار جندرية مصطنعة والمواقف المرتبطة بهم. حسب هذه المحاولات، ومن خلال النظر إلى الطبيعة والقانون والعائلة والأدوار الاجتماعية بوصفها نتائج وليس أساسات، أعتقد أن النسوية تعتبر الجنسانية الفضاء الاجتماعي الأول للسلطة المذكرة. مركزية الجنسانية لا تنبع من المفاهيم الفرويدية، بل من الممارسة النسوية في مجالات عدة، بما في ذلك الإجهاض، وتحديد النسل، واستغلال التعقيم، والعنف المنزلي، والاغتصاب، وسفاح القربى، والعلاقات المثلية النسائية، والتحرش الجنسي، والبغاء، والعبودية الجنسية النسائية، وصناعة المنتجات الإباحية. في جميع هذه المجالات، الجهود النسوية تواجه وتغير حياة النساء بشكل ملموس ومعاش. مع بعضهم، تنتج هذه التجارب نظرية سياسية نسوية تتمحور حول الجنسانية: محدداتها الاجتماعية، إنتاجها اليومي، تعبيراتها من الولادة وحتى الوفاة، وفي النهاية، سيطرة الذكور.
البحث النسوي في هذه المسائل المحددة بدأ بكشف عام للمواقف التي تشرعن وتخفي وضع المرأة، أي المغلف الفكري الذي يحيط بجسد المرأة: مفاهيم مثل أن النساء يرغبن بالاغتصاب ويُثِرن الرجال طلباً له؛ أن تجارب الفتيات مع سفاح القربى أحلام تخفي وراها رغبة؛ أن النساء العاملات يتآمرن ويتقدمن من خلال «المضاربات» الجنسية؛ أن بائعات الهوى شهوانيات؛ أن ضرب الزوجة تعبير عن شدة الحب. تحت جميع هذه الأفكار يقبع الإكراه العاري وارتباطات عامة بتعريف المرأة الاجتماعي بوصفها جنساً. البحث في الأدوار الجنسية، المتتبع لمقولة سيمون دو بوفوار «أن المرء لا يُخلق بل يصبح امرأة»، يكشف عن عملية معقدة: كيف وماذا يتعلم الإنسان ليصبح امرأة. الجندر باختلاف الثقافات هو خاصية مكتسبة، موقع يُعطى، بأوصاف تختلف بغض النظر عن البيولوجيا، وعبر أيديولوجيا تنسب هذه الأوصاف للطبيعة.
اكتشاف أن الشكل النموذجي للمرأة هو الصورة الأنثوية النمطية يعرّي «المرأة» بوصفها اختراعاً اجتماعياً. نسخة المجتمع الصناعي المعاصر عنها هي لكائن مطواع، ناعم، سالب، حنون، مرهف، ضعيف، نرجسي، طفولي، عاجز، مازوشي، منزلي، مبرمج للاهتمام بالأطفال والمنزل والزوج. التكيف مع هذه القيم يخترق عملية تربية البنات والصور الجديرة بالتقليد التي يتم تقديمها للنساء. النساء اللواتي يقاومن هذه القيم أو يفشلن في تبنّيها، بما في ذلك النساء اللواتي لم يُخلقن لينجحن أصلاً كالنساء السوداوات أو أبناء الطبقة العاملة ممن لا يمكنهن الصمود في الحياة إذا كنا ناعمات وعاجزات وضعيفات، أو اللواتي يعبرن عن احترامهن لذواتهن بقوة، واللواتي يملكن طموحاً بأبعاد مذكرة، هؤلاء يتم اعتبارهن نساء أقل، إناثاً أقل. النساء اللواتي ينصعن أو ينجحن في تمثل هذه القيم يُرفعهن كنماذج وقدوات، يتحولن إلى رموز للنجاح حسب معايير الرجال، ويتم تصويرهن كراضيات بموقعهن الطبيعي، وصرف النظر عنهن في حال تذمّرن (على اعتبار أنهن شاركن في صناعة وضعهن).
إذا وضعت الأدبيات عن الأدوار الجنسية بمحاذاة البحوث المتعلقة بالمسائل أعلاه، سيتبين أن كل عنصر من عناصر الدور الجندري الأنثوي هو في الواقع ذو جذر جنسي. الانكشاف يعني واقع/مظهر التواصل الجنسي السهل؛ السلبية تعني القبول والمقاومة المعطلة، المفروضة بسبب التمرن على الضعف الجسدي؛ النعومة تعني القدرة على إيلاج شيء صلب. أما العجز فيعني الحاجة للمساعدة؛ والانكشاف يعني الحاجة إلى ملجأ، وهذا بدوره يعني الحاجة إلى حضن يتحول إلى غزو، لتتم مقايضة حصرية الدخول مقابل الحماية… من الداخل نفسه. المنزلية تشير إلى الذرية، والتي هي دليل خصوبة، وترتبط بصورة الانتظار في المنزل في اللباس المناسب. اعتبار المرأة طفلاً يرتبط بالنزعة البيدوفيلية، الانجذاب إلى الأطفال، والتركيز على أجزاء معينة من الجسم يشير إلى الفيتيشية، فيما تمجيد الشخصية الفارغة يشير إلى الانجذاب للموتى. تعني النرجسية أن تتبنى المرأة هذه الصورة عن نفسها: «قفي بثبات، سنرسم لك صورة، لكي تباشري فوراً بالظهور مثلها». المازوشية يعني أن الاستمتاع بالانتهاك يصبح دليلاً على حساسيتها. المثليات يخرقن الجنسانية المفترضة في الجنس الأنثوي إلى حد أنهن لا يُعتبرن نساء أصلاً.
اجتماعياً، الأنوثة تعني النعومة، وهذا يعني الجاذبية للرجال، أي الجاذبية الجنسية، أي التوافر الجنسي حسب معايير الرجال. ما يعرّف المرأة إذاً هو ما يثير الرجل. البنات الجيدات «جذابات» فيما البنات السيئات «مستفزات». التنميط الجندري هي العملية التي من خلالها تقوم النساء بتعريف أنفسهن ككائنات جنسية، ككائنات توجد من أجل الرجال. إنها العملية التي من خلالها تستبطن النساء صورة الذكور عن جنسانيتهم بوصفها هويتهن كنساء. ليست مجرد وهم. البحث النسوي في تجارب النساء عن الجنسانية يعيد النظر في مفاهيم سابقة عن القضايا الجنسية ويعيد تعريف مفهوم الجنسانية نفسه وتعريف محدداته ودوره في المجتمع والسياسة. حسب المراجعة هذه، يصبح المرء مرأة – أي تكتسب وتتماهى مع وضعية الأنثى – ليس من خلال النضج البيولوجي أو التشرب بمفاهيم اجتماعية، بل بالتحديد من خلال تجربة الجنسانية: اتحاد معقد للحسية، والعاطفية، والهوية، وتأكيد المكانة. الجنس كجندر والجنس كجنسانية يتم تعريفهما إذا من خلال بعضهما، لكن الجنسانية هي التي تحدد الجندر لا العكس. هذا الكشف المركزي غير المكتوب بشكل مباشر في كتاب كايت ميدلتون سياسة جنسية يعالج الثنائية المبينة في مصطلح «جنس»: ما تتعلمه المرأة لكي تمارس الجنس هو ما يجعلها تصبح امرأة، جندر المرأة يأتي من خلال التجربة، وهو شرط من أجل «ممارسة الجنس» – المرأة كمادة جنسية للرجال، استخدام جنسانية المرأة من قبل الرجال. في الواقع، إلى المدى الذي نستطيع القول إن الجنسانية اجتماعية، فإن جنسانية المرأة هي استعمالها (من قبل الذكور)، تماماً كما أن أنثويتنا تعني اختلافنا (عن الذكور).
الكثير من الأمور التي تبدو جنسية من نقطة التموضع هذه لم تعتبر هكذا من قبل، ولم يجرِ النظر إليها كمنتِجة لسياسة. لطالما اعتُبر سفاح القربى على سبيل المثال مسألة تتعلق بالتمييز بين الشر الحقيقي، جريمة ضد العائلة، وبين توهمات أو أحلام فتيات. منع الحمل والإجهاض أُطّرا كمسألتين تتعلقان بالتكاثر، وجرى التخاصم حولهما كتقييدات اجتماعية مقبولة أو غير مقبولة للطبيعة. أو نُظر إليهما كمسائل خاصة، يجب حد تدخل الدولة فيها وفي غيرها من الأمور الحميمية. التحرش الجنسي لم يكن قضية أصلاً، ومن ثم باتت المسألة القدرة على تمييز العلاقات الشخصية، أو الغزل المحبب، عن استغلال السلطة. المثلية الأنثوية، في حال كانت مرئية، اعتُبرت أحياناً انحرافاً وأحياناً لا، يمكن أو لا يمكن تحملها. إنتاج المواد الإباحية نُظر إليه من زاوية حرية التعبير في مقابل الحد من الإباحية والعنف. البغاء تمت مقاربته إما كشهوانية وتهتك متبادل أو كتبادل متكافئ لحاجة جنسية جراء حاجة مالية. أما في الاغتصاب فتمحورت المسألة حول إذا كان الجماع مُثاراً/مقبولاً من الطرفين أم إكراهياً: هل كان جنساً أم عنفاً؟ على اختلاف هذه القضايا وتحتها جميعاً، الجنسانية نفسها تنقسم إلى ممالك متنازعة: تقليدياً، الدين أو البيولوجيا؛ وفي العصر الحديث، الأخلاق أو علم النفس. لكن بشكل شبه مطلق: لا سياسة.
حسب المنظور النسوي، تعبّر صياغة كل قضية، حسب المعايير أعلاه، أيديولوجياً عن المصلحة نفسها التي تؤطر المشكلة واقعياً أو مادياً: المصلحة حسب وجهة نظر الذكر. النساء يختبرن هذه الأحداث الجنسية التي ترمز إليها هذه القضايا ككل متناسق تستعيد فيه كل قضية-حدث باقي القضايا-الأحداث. الثيمة التي تعرّف الكل هي سعي الذكر للسيطرة على جنسانية المرأة – الرجال لا كأفراد ولا ككائنات بيولوجية وإنما كمجموعة جندرية تعرفها الذكورة بصفتها منتجاً اجتماعياً يعرفه هذا السعي للسيطرة. فعلى سبيل المثال، النساء اللواتي يحتجن للإجهاض ينظرن إلى منع الحمل لا بصفته كفاحاً في سبيل التحكم بالعواقب البيولوجية للتعبير الجنسي فقط، وإنما كذلك بالإيقاعات والتقاليد الاجتماعية المتعلقة بالجماع الجنسي. كثيراً ما تبدو هذه التقاليد معادية لقدرة المرأة على حماية نفسها حتى عندما تكون التكنولوجيا متوافرة. كمثال على هذه التقاليد، تلاحظ النساء أن التحرش الجنسي يبدو في كثير من الأحيان أشبه بالمبادرة الجنسية الغيرية في عالم محكوم باللامساواة الجندرية. قلة من النساء يستطعن رفض مبادرات جنسية غير مرغوبة، كوننا نتحدث عن «قبول» المرأة (وهو فعل ساكن بحد ذاته) بدلاً من «مبادلتها للرغبة» (وهذا يعكس فاعليتها) كخط فاصل بين الجماع والاغتصاب يكشف، بحدّ ذاته، عن اللامساواة. كذلك هي الكمية المهولة للقوة الذكورية التي تتبدى في التركيز فيما إذا كانت المرأة قاومت أم لا، والذي تتآمر عليه ثقافة عامة تشجع على السلبية. إذا كان يتم تصوير الجنس نمطياً بوصفه شيئاً يفعله الرجال للنساء، يجب إذا التساؤل ما إذا كان القبول مفهوماً ذا معنى. بنفس المعنى فإن الإيلاج يبدو شديد المركزية في التعريف القانوني للاغتصاب والتعريف الذكوري للجماع، أكثر بكثير مما هو مركزي لانتهاك المرأة جنسياً أو للذتها الجنسية. الاغتصاب ضمن إطار الزواج يعبر عن إحساس الزوج بأحقيته في الدخول في امرأة يمتلكها: سفاح القربي يوسّع هذا الحق. على الرغم من أن غالبية النساء يُغتصبن من رجال يعرفنهم، إلا أنه كلما كان الرجل أقرب للمرأة بات ممنوعاً على المرأة وصف فعلته بالاغتصاب. البورنوغرافيا تصبح صعبة الفصل عن الفن والإعلانات ما إن يتوضح أن المهين للنساء يبدو جذاباً للمستهلك. عاملات الجنس يبعن الأحادية التي تروج لها البورنوغرافيا. حقيقية أن جميع هذه القضايا ترمز إلى سلوك لا يتناقض مع النظام وليس استثنائياً تدعمها تجارب النساء كضحايا: هذه السلوكيات لا تعتبر غير قانونية، وهي منتشرة على نطاق واسع. وكما أن تجربة النساء تعني تمويه الخط بين الطبيعي والانحرافي، فهي كذلك تنسف التمييز بين ما هو استغلال للمرأة والتعريف الاجتماعي لماهية المرأة.
تكشف هذه الاستقصاءات النسوية أن الاغتصاب وسفاح القربى والتحرش الجنسي والبورنوغرافيا والبغاء ليست توظيفات للقوة الجسدية، أو للعنف، أو للسلطة، أو للاقتصاد، بل هي استغلالات للجنس. وهي ليست بحاجة لأن تعتمد في إكراهها على أنماط من الجبر غير جنسية، ولا أن تقوم بذلك: القول بأن أشكال الإكراه هذه لها بحد ذاتها هوية جنسية يبدو أقرب إلى الدقة. لا تضفي هذه الممارسات طابعاً إيروتيكياً على شيء آخر: الإيروتيكية هي في صلب تكوينها. وهي ليست تشويهات للفن والأخلاق: بل هي هي الفن والأخلاق من وجهة نظر الذكر. وهي لها طابع جنسي لأنها تعبر عن علاقات، وقيم، ومشاعر، وتقاليد، وسلوك ثقافة جنسانية تجد جزءاً من قدرتها على الإثارة في أن يكون الاغتصاب والبورنوغرافيا وسفاح القربى والمثلية الأنثوية انحرافاً أو شذوذاً أو هرطقة.
الجنسانية إذاً هي شكل من أشكال القوة. الجندر، بصفته اختراعاً اجتماعياً، يجسد هذه الجنسانية وليس العكس. الرجال والنساء ينقسمون حسب الجندر ويتشكلون في الجنسين اللذين نعرف، من خلال الالتزامات الاجتماعية التي تفرضها الغيرية، والتي تمأسس السيطرة الجنسية المذكرة والخضوع الجنسي المؤنث. هذا يعني أن الجنسانية هي مربط فرس اللاعدالة الجندرية.
المرأة كائن يعرّف نفسه ويعرّفه المجتمع بصفته صاحب جنسانية موجودة من أجل شخص آخر، هو الذكر. جنسانية المرأة هي قدرتها على إثارة هذا الشخص. إذا كان الجنسي في المرأة هو بالتعريف ما يعتبره الذكر ضرورياً للإثارة، أليس من الممكن القول إن المتطلبات الذكورية استولت على الجنسانية الأنثوية بحيث أن الأخيرة باتت تقتصر على تلك المتطلبات؟ أن نواجه الجنسانية الأنثوية بهذه الطريقة يعني أن نتساءل إن كان هناك جنسانية أنثوية من الأساس! إذا كان الوجود من أجل شخص آخر هو كل ما تحتويه جنسانية المرأة المنتَجة اجتماعياً، فهذا يعني بالضرورة أنه لايمكن الهرب منها بالانفصال، أي غياب الرجل المادي المؤقت، ولا يمكن إلغاؤها من خلال مجرد استبدال العفة بالممارسة، والتي تبدو في هذا السياق وكأنها مجرد قيام المرأة بتقليد الرجل. كما تقول سوزان سونتاغ: «السؤال هو: ما هي الجنسانية التي ستستمتع بها النساء في حال تحررهن؟ إزاحة الصعوبات أمام التعبير الجنسي للنساء لن يكون نصراً إذا كانت الجنسانية التي ستستمتع بها النساء هي نفسها الجنسانية التي تحولهن إلى أشياء… هذه الجنسانية «المتحررة» لا تعكس إلا فكرة مزيفة عن الحرية: حق كل إنسان أن يستغل وينزع إنسانية شخص آخر لفترة وجيزة. من دون تغيير في تقاليد الجنسانية نفسها، تحرر المرأة سيبقى هدفاً بلا معنى. الجنس بحد ذاته ليس تحريراً للمرأة، ولا المزيد منه». هذا السؤال هو بالمعنى الأعم عن قدرة المجتمع على تحديد ماهياتنا. إذا كانت النساء يعرَّفن اجتماعياً، بحيث لا يمكن اختبار الجنسانية الأنثوية أو الشعور بها أو الحديث عنها أو حتى الإحساس بها بمعزل عن التعريف الذي يُسقطه المجتمع لها، أي بمعزل عن إلغائها، فهذا يعني أنه ليس هناك نساء! هناك فقط أجساد تتبنى تصورات عن حاجات الرجال. بالنسبة للنسوية، التساؤل ما إذا كان هناك جنسانية أنثوية يساوي التساؤل ما إذا كان هناك نساء.
منهجياً، المفهوم النسوي عن أن الشخصي هو السياسي محاولة للإجابة على هذا السؤال. بالتخلي عن أي مفهوم غريزي أو طبيعي أو ميتافيزيقي أو إلهي للسلطة، يحاول هذا المفهوم أن يموضع جنسانية النساء على أرضية علائقية بشكل كامل، فيثبت قوة النساء وعدم رضاهن في نفس العالم الذي يقفن ضده. الشخصي هو السياسي ليس بتشبيه ولا رمز ولا مقارنة، ولا يعني أن ما يحدث في الحياة الخاصة شبيه أو يقارن بما يحدث في الفضاء العام. ولا هو بتطبيق لتصنيفات من الحياة الاجتماعية على الحياة الخاصة، كما يفعل إنجلز عندما يقول أن الزوج في العائلة يمثل البرجوازية والمرأة تمثل البروليتاريا. ولا يقوم هذا المفهوم بالمساواة بين فضاءين يبقيان على صعيد التحليل متمايزين عن بعضهما، على طريقة رايش حين يشرح سلوك الدولة بمصطلحات جنسية. ولا هو دمج لفضاء ضمن فضاء آخر كما حين يشرح لازويل السلوك السياسي بوصفه تحويلاً للمشاكل الشخصية إلى مواد عامة. ما يعنيه هو أن تجربة النساء الخاصة تحدث في ذلك الفضاء الذي تم تصنيفه اجتماعياً بصفته شخصياً-خاصاً، عاطفياً، داخلياً، محدداً، فردياً، حميماً – بما يجعل من معرفة سياسة الوضع النسائي مساوياً لمعرفة الحيوات الخاصة للنساء.
المضمون الرئيسي للسياسة الحقيقية الحاكمة لحياة النساء الشخصية هي ضعفهن المعمّم في مواجهة الرجال، والذي يعبر عن نفسه ويعاد تشكيله يومياً من خلال الجنسانية. أن نقول إن الشخصي هو السياسي يعني أن نستطيع اكتشاف والتحقق من الجندر بصفته تقسيماً للقوة من خلال تجارب النساء الحميمية في تحويلهن إلى أشياء جنسية، والذي يبدو معادلاً ومعرّفاً لحياة النساء بصفتهم الجندر الأنثوي. لذلك، بالنسبة للنسوية، الشخصي هو إبستمولوجياً السياسي، وإبستمولوجيا الشخصي هي سياسته. النسوية بهذه المعنى هي التنظير لوجهة نظر النساء. إنها نظرية «المرأة العادية» حسب لغة جودي غراهن في اقتباس عن مفهوم «اللغة العادية» لأدريين ريش. رفع الوعي هو تعبيرها الجوهري. لا تستملك النسوية منهجاً موجوداً سلفاً، كالمنهج العلمي، فتقوم بتطبيقه على فضاء جديد من المجتمع لتكشف طبيعته السياسة الموجودة سلفاً. رفع الوعي لا يقتصر فقط على معرفة أشياء مختلفة بوصفها سياسة، لكنه يعني التعرف عليها بطريقة مختلفة. تجربة النساء للسياسة، للحياة كأدوات جنسية، يُفسح المجال لمنهج محدد في تملّك الواقع: المنهج النسوي. بوصفها نوعاً خاصاً من التحليل الاجتماعي، داخل ولكن خارج أيضاً البارايغم المذكر، تماماً كما هي حيوات النساء، تملك النسوية نظريتها الخاصة عن العلاقة بين المنهج والحقيقة، المرء ومحيطها الاجتماعي، حضور ومكان الطبيعي والروحي في الثقافة والسياسة، والوجود الاجتماعي والسببية نفسها.
بعد تشييئهن ككائنات جنسية ووصمهن في نفس الوقت كشخصيات محكومة بالعواطف اللاموضوعية، ترفض النساء التمييز بين الفاعل العالم والشيء المعلوم – التقسيم بين الذاتي والموضوعي، بصفته الوسيلة لفهم الحياة الاجتماعية. بعد أن آذتها الموضوعية، فباتت فريستها، ولُفظت خارج عالمها بوصفها كائناً محكوماً بذاتيته الداخلية، تقبع مصلحة المرأة في الانقلاب على التمييز بين الموضوعي والذاتي بحد ذاته. من خلال التقدم عبر التحليل كما عبر التضمين في نفس الوقت، يبدو رفع الوعي وكأنه التعبير عن منطق سليم وعن تصور نقدي للمفاهيم. بأخذها المشاعر المتجسدة كما التفاصيل العادية المشتركة بصفتها مادة للتحليل السياسي، تكتشف النسوية المساحات الأكثر تأذياً، الأكثر تلويثاً، ولكن أيضاً الأكثر خصوصيةً والأكثر حميميةً ومعرفةً، فتعيد استملاكها. هذه العملية يمكن وصفها بـ«التجربة الداخلية الجماعية والعطوفة لبناء نظام حسب ضرورته الداخلية» والتي تشكل في عين الوقت استراتيجية تفكيك هذا النظام أيضاً.
من خلال رفع الوعي، تستوعب النساء الواقع الجماعي لشرط المرأة من منظور داخلي لتجربتها وليس من خارجها. الزعم بوجود سياسة جنسانية تأسيسية على الصعيد الاجتماعي يتموضع من خلال هذا المنهج على كون النسوية منظور النساء وليست منظوراً من النساء. دعوى النسوية بكونها وجهة نظر النساء هو دعواها بكونها حقيقة. في فهمها لنفسها، تحتوي وجهة نظر النساء على ثنائية مشابهة لتلك الثنائية في منظور البروليتاريا الماركسية: ما يحددها هو الواقع الذي تقوم النظرية بتفجيره، ولذا فهي تمتلك مدخلاً خاصاً للواقع. لا تعتبر النسوية رؤيتها ذاتية، أو منحازة، أو غير محددة، بل هي نقد للعمومية المدعاة والحيادية والكونية التي تدّعيها النظريات السابقة. تلك النظريات لم تكن «نصف صحيحة» بل مستندة إلى «خطأ كامل». لا تتحدى النسوية فقط الانحياز الذكوري لكنها تشكك في الدافع الكوني نفسه. القول بانعدام التموضع (لمقولة ما بحيث ينتفي كونها وجهة نظر ذاتية) يتم كشفه كأداة للهيمنة الذكورية.
«تمثيل العالم»، تكتب سيمون دو بوفوار، «كما العالم نفسه، هو من صنع الرجال: يصفونه من وجهة نظرهم ويخلطون بين وجهة النظر هذه والحقيقة المطلقة». التوازي بين تمثيل العالم وصناعته يجب الحفاظ عليه: الرجال يخلقون العالم من وجهة نظرهم، وتلك بدورها تصبح الحقيقة الموصوفة. هذا نظام مغلق، وليس تشويشاً في الرؤية. القوة لخلق العالم من وجهة نظر المرء هي القوة في صورتها المذكرة. الموقف الإبستمولوجي المذكر، المتوافق مع العالم الذي يخلقه، هو «الموضوعية»: الموقف الذي يدعي عدم تورطه، الموقف من بُعد ودون تموضع محدد، بما يبدو وكأنه شفاف مع واقعه. لا يستوعب هذا الموقف تموضعه الخاص، لا يعترف أن ما يرنو إليه هو فاعل مثله، أو أن الطريقة التي يستوعب فيها العالم هي طريقة لإخضاعه. ما يمكن معرفته بشكل موضوعي هو شيء جامد. المرأة من خلال نظرة الرجل هي شيء جنسي. ما يمكن معرفته موضوعياً يتوافق مع العالم ويمكن التأكد منه من خلال الإشارة إليه (كما يفعل العلم الحديث) لأن العالم نفسه مسيطَر عليه من قبل وجهة النظر ذاتها. إن سلطة الذكور، التي تجمع ككل أشكال السيطرة بين الشرعية والقوة، تمتد من تصوير الواقع إلى بنائه: إنها تصنع النساء ومن ثم تتحقق من هن النساء من خلال مطابقة ما تدعيه مع ما تخلقه، مؤكدةً بذلك في نفس الوقت طريقتها في الوجود ونظرتها عن الحقيقة. الإيروتيكية المتوافقة مع هذا هي «استخدام الأشياء لاختبار النفس». أو كما عبرت عن الفكرة ممثلة بورنوغرافية مكرهة: «تفعلها، تفعلها، تفعلها؛ ومن ثم تصبحها». الفيتيشية تنطق باللسان النسوي.
تشييء النساء يجعل من الجنسانية واقعاً مادياً في حيواتهن، لا مجرد واقع نفسي، أو موقفي، أو أيديولوجي. يلغي هذا التشييء التمييز بين المادة والروح. وكما قيمة السلعة، تصبح جاذبية المرأة الجنسية فيتيشية، فيتم تصويرها كنوعية للشيء بحد ذاته، عفوية ومبنية داخله، مستقلة عن العلاقات الاجتماعية التي تخلقها أساساً، غير متحكَّم بها من السلطة التي تطالب بها. وطبعاً من الجيد إذا أثبت الشيء تعاونه: أي إذا أدت الأمور إلى نشوة المهبلية؛ إلى نشوة يتم تصنّعها. جنسية المرأة، كما فحولة الرجل، تصبح أكثر حقيقيةً كلما باتت أكثر أسطورية. تتجسد. السلع لها قيمة، ولكن فقط لأن القيمة خاصية اجتماعية تتشكل من نفس العلاقات الاجتماعية التي، بدون وعي، تفتتن بهذه القيمة التي تحددها. أجساد النساء تمتلك ذات الجاذبية الحقيقية، أو ربما ذات الرغبة. يصور سارتر هذه المشكلة على المستوى الإبستمولوجي: «ولكن إذا رغبتُ بمنزل، أو بكوب ماء، أو بجسد امرأة، كيف يمكن لهذا الجسد، أو الكوب، أو العقار أن تسكن في رغبتي، وكيف لرغبتي أن تكون أي شيء سوى وعيي بهذه الأشياء بوصفها جذابة». بالفعل. الموضوعية هي الموقف المنهجي الذي يشكل التشييء عمليته الاجتماعية. التشييء الجنسي هو العملية الأساسية لإخضاع النساء. إنه يوحّد الفعل مع الكلمة، الخلق مع التعبير، النظرة مع التنفيذ، الحقيقة مع الأسطورة. الرجل ينكح المرأة؛ مبتدأ فعل مفعول به.
يسائل هذا التحليل التمييز المفترض بين التشييء والاستلاب. التشييء حسب المادية الماركسية هو دعامة الحرية البشرية، عملية العمل التي من خلالها يتجسد الفاعل في المنتجات والعلاقات. الاستلاب هو التحريف المشروط اجتماعياً لهذه العملية، التعامل مع المنتجات والعلاقات كأشياء جامدة منفصلة عن الفاعلية البشرية. ولكن من وجهة نظر الشيء نفسه، فإن التشييء هو الاستلاب. بالنسبة للنساء، لا فرق بين التشييء والاستلاب، لأن النساء لم يفعلن التشييء، بل كانوا موضوع التشييء. النساء كانوا الطبيعة، المادة، المفعول بهن، الخاضعات للفرد الفاعل الساعي لتجسيد نفسه في الواقع. التشييء ليس مجرد وهم لمن يتم تشييئهم، بل هو واقعهم أيضاً. المستلَب الذي لا يستطيع استيعاب نفسه إلا بوصفه آخر ليس مختلفاً عن الشيء الذي لا يستطيع استيعاب نفسه إلا بوصفه شيئاً. أن تكون «آخر» الرجل يعني أن تكون شيئه. وبشكل مشابه، مشكلة أن يتمكن الشيء من التعرف إلى نفسه بوصفه شيئاً هي نفسها مشكلة المستلب حين يفقه استلابه. وهذا بدوره يُحيلنا إلى فهم النسوية لوعي النساء. كيف يمكن للنساء، المخلوقات كأشياء في عقولهن، المتواطئات في أجسادهن، أن ينظرن إلى شرطهن بوصفه هكذا.
من أجل الإحاطة بوعي النساء، وطبعاً من أجل رفعه، على النسوية أن تستوعب أن قوة الرجل تخلق العالم قبل أن تشوّهه. قبول النساء بشرطهن لا يعني أنه مقبول في حال لم يعد هناك خيار سوى أن تصبح المرأة شخصاً يقبل طواعية بدور النساء. لذلك وفي نهاية المطاف، لا يمكن التدليل على واقع قمع المرأة أو دحضه عيانياً. إلى حين مواجهة هذه الحقيقة على مستوى المنهج، ستتم مواجهة نقد الموجود بالإشارة إلى واقع المنقود. قيد النساء، ذلهن، دونيتهن، تورطهن، بالإضافة إلى إمكانية مقاومتهن، حركتهن، أو استثنائهن، ستبدو وكأنها عوائق أمام وعيهن بدل أن تكون منافذ للدخول إلى ما يجب على النساء الوعي به من أجل تغير أوضاعهن.
سلطة الذكر واقع. لكنها ليست ما تدعيه: الواقع الوحيد. سلطة الذكر أسطورة تجعل من نفسها حقيقة. رفع الوعي يعني مجابهة سلطة الذكر بوصفها ثنائية: فهي كاملة من جهة، ووهم من جهة أخرى. في رفع الوعي تتعلم النساء أنهن كن قد تعلمن أن الرجل كل شيء، وأن النساء عكسهم، وأن الجنسَين على الرغم من ذلك متساويان. فحوى الرسالة ينكشف بوصفه صحيحاً وخاطئاً في نفس الوقت، وكل جزء يكشف زيف الجزء الآخر. فإذا نظرنا إلى مقولة «الرجال كل شيء، النساء عكسهن» من زاوية النقد الاجتماعي وليس كمجرد وصف بسيط، يتبدى أن النساء هن بالفعل مساويات للرجال، وفي كل مكان مقيدات. تصبح قيودهن مرئية، ودونيتهن – لا تساويهن – نتيجة إخضاعهن وطريقة من طرق تحقيق هذا الإخضاع. وفي المقلب الآخر، في اللحظة التي نعي أن هذه ليست مساواة، أن الحياة كما نعرفها يخترقها تفاوت اجتماعي بين الجنسين، نصبح غير قادرين على تعريف الكينونة النسائية بوصفها اللاذكورة، بوصفها نفي أو عكس فقط. للمرة الأولى، سؤال ما تكونه (لا ما لا تكونه) المرأة يتموضع على أرضيته الخاصة في عالم ليس من إنتاجه وليس على صورته، ويجد – باستجماع نقدي لصورة المرأة المتشظية والمستلبة – ذلك العالم الذي قامت المرأة بصناعته ورؤية لصورته الكاملة. تكشف النسوية عن السلطة المذكرة بوصفها خرافة كاملة السيادة، شيئاً وهمياً بنتائج حقيقة. تلتقط زورا نيل هيرستون هذه الثنائية في قولها «أهل البلدة لديهم سلة من المشاعر الجيدة والسيئة بخصوص موقع جو وممتلكاته، لكن لا أحد لديه الجرأة على تحديه. لقد أذعنت له البلدة لأنه يمتلك كل تلك الأشياء، وبنفس الوقت هو يمتلك كل تلك الأشياء لأن البلدة أذعنت له». إذا كان الموقع والممتلكات والسيطرة يخلقون بعضهم علائقياً، يصبح السؤال متمحوراً حول الشكل والحتمية. يطرح هذا على النسوية تحدي أن تضع نظريتها عن وجهة نظر المرأة في مواجهة السلطة.
النسوية هي النظرية الأولى التي تخرج من رحم من تدافع النظرية عن مصالحهم. منهجها يستجمع الواقع الذي تسعى لتصويره كنظرية. وكما المادية التاريخية منهج الماركسية، رفع الوعي هو المنهج النسوي: إعادة البناء النقدية والجماعية لتجربة المرأة الاجتماعية، كما تعيشها وتختبرها المرأة. على هذا المستوى، تفترض النسوية والماركسية علاقات مختلفة بين الفكر والمادة، على صعيد علاقة التحليل نفسه بالحياة الاجتماعية التي ينبغي سبرها، وعلى صعيد مشاركة الفكر في صناعة هذه الحياة الاجتماعية التي يحللها. إلى الحد الذي تقدم المادية نفسها كمنهج علمي، فإنها تفترض وتُحيل إلى واقع خارج الفكر ذي مضمون موضوعي، أي مضمون متجرد من وجهة النظر الاجتماعية. على العكس من ذلك، يبحث رفع الوعي في ما هو في جوهره علائقي واجتماعي، في ذلك الخليط من الفكر والمادة الذي يشكل جنسانية المرأة بمعناها الأعمّ. يقارب العالم من خلال عملية تتشارك مع المنهج في ذات المحددات: وعي النساء لا كأفراد أو كأفكار ذاتية بل ككائن اجتماعي جماعي. يقف هذا المنهج داخل محدداته من أجل أن يقوم بكشفها، وينقد تلك المحددات من أجل أن يقيّمها حسب معاييره هو، من أجل أن تكون له معاييره الخاصة. تقلب النسوية التنظير بحد ذاته – السعي نحو تحليل حقيقي للحياة الاجتماعية – إلى سعي من أجل الوعي؛ وتقلب تحليل اللامساواة إلى استجماع نقدي لمحددات وعي المرأة. هذه العملية هي تغييرية بقدر ما هي استبصارية، لأن الفكر والمادة لا يمكن فصلهما ولأنهما يؤلفان بعضهما بعضاً في واقع عملية قمع المرأة، تماماً كما أن الدولة بوصفها قمعاً والدولة بوصفها أيديولوجيا مشرعنة للقمع لا يمكن فصلهما للأسباب ذاتها. السعي من أجل الوعي يصبح ممارسة سياسية. رفع الوعي يكشف عن علاقات الجندر بوصفها حقيقة جماعية، ليست شخصية أكثر من العلاقات الطبقية. وهذا يعني أيضاً أن العلاقات الطبقية قد تكون هي الأخرى شخصية، وذلك لأنها – لا على الرغم من كونها – جماعية. فشل الماركسية في استيعاب ذلك قد يعني أن فشل العمال في البلدان الرأسمالية المتقدمة في تنظيم أنفسهم اشتراكياً مرتبط بفشل الثورات اليسارية في تحرير المرأة نسوياً.
تقف النسوية في علاقتها مع الماركسية كما تقف الماركسية في علاقتها مع الاقتصاد السياسي الكلاسيكي: نتيجتها الأخيرة ونقدها النهائي. بالمقارنة مع الماركسية، ينقلب موقع الفكر والمادة في المنهج والواقع لدى النسوية، في لحظة استيلاء على السلطة تخترق الفاعل بالمفعول به والنظرية بالممارسة. في حركة مزدوجة، تقلب النسوية الماركسية على رأسها، ومن الداخل إلى الخارج.
كي يجيب على السؤال القديم – كيف تُخلق وتوزَّع المادة؟ – احتاج ماركس لخلق فهم جديد تماماً للعالم الاجتماعي. وكي تجيب على سؤال آخر مساوٍ في القدم، أو كي تسائل واقعاً مساوياً في القدم – ما الذي يشرح عدم مساواة المرأة مع الرجل؟ أو، كيف تصبح الرغبة سيطرة؟ أو، ما هي سلطة الذكر؟ – تقوم النسوية بتثوير السياسة.