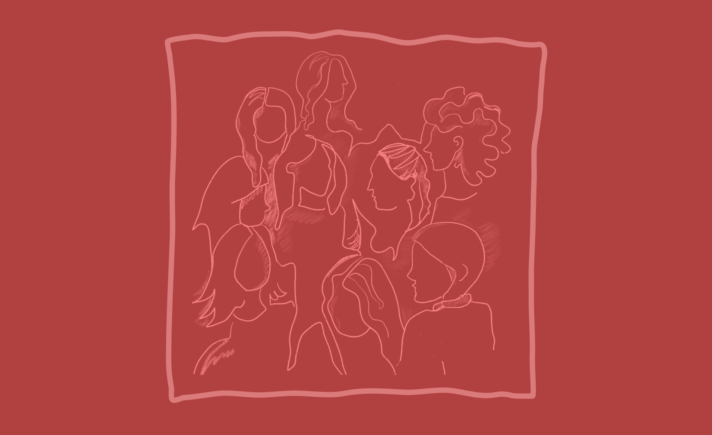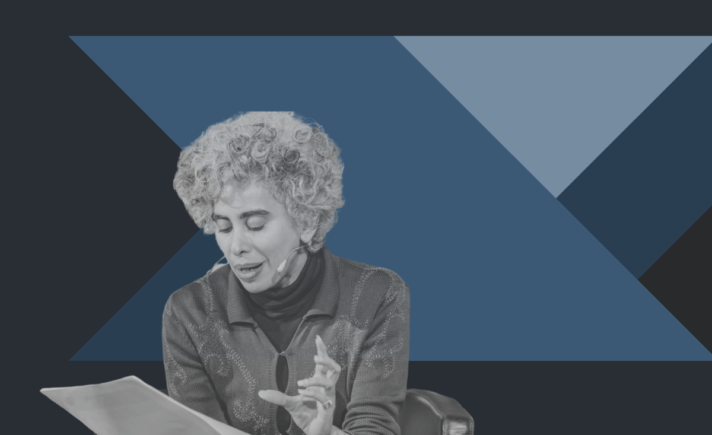قتل الهواء الطلق
تحاول رشا بسيس ألا تنظر إلى الكاميرا. تخبئ الجميلة النحيلة وجهها.
«انظروا هذه هي رشا بسيس»، أترونها، ومن يشكك في ذلك فلينظر إلى تلك العينين.
فرجة مسرحية تنقلها عين كاميرا، تظهر فيها شجرة في نهاية زقاقٍ فارغٍ. خلفية المشهد كان لون التراب الباهت الذي لا يرقى حتى لشقرة الصحراء! كادر مثالي لتصوير سينمائي وتنفيذ فرجة مقنّعة لحياة واقعية. الجسد يخفي تضاريسه السّواد، لولا حجابٌ ورديٌ لبدا مثل ملاءةٍ مرمية على حائطٍ. تبتعد عين الكاميرا عن مرمى تفاصيل الجسد. كيف لأحدٍ أن يخمّن ما كانت تفكر فيه رشا حينما أجبرها قاتلها على أن تضع عينيها في عين الكاميرا، ليجعل من عينيها عيوننا جميعاً. تحديقنا في عينيها هو ذلّنا، وتحديق الكاميرا في جسدها يقول لنا بلسان القاتل: لقد محوت ذلّي بذلّكم! نظافة غسيل عاره موجهّة لنا، وموجهّة لجمهور الفرجة الذي سيعيد له حقه بتأكيد رجولته، وما حصل هو أنّ فعل الفرجة سلبه نظافته!.
كأنّ ابتعاد عين الكاميرا عن جسد رشا يبغي إخبارنا أنّها نجسة كجسدٍ مصابٍ بالجذام مثلاً، ننفر منه دون قصد. زخات الرصاص تخترقها، تنثرها، تتوقف لثواني، وبتهالكٍ تحرّك الصبية كفّها، وكأنّها تتشهد، فيأتي الصوت «لسه ما ماتت»، إصراراً من قاتليها على تمزيق الجسد.
شريط مصور من أفلام القتل المتكرر للنساء مختلف عن الشريط الذي صوّره رجالٌ من جبهة النصرة سنة 2015، عندها كانت الكاميرا قريبة والرجال يحيطون بالمرأة الخمسينية التي كانت ترجو قاتلها أن ترى أولادها قبل موتها، وكان الرد بطلقات مباشرة في الرأس، ثم ظهر بعده شريط مصوّر لامرأةٍ أخرى تقتلها علانية أيدي مقاتلي جبهة النصرة، كانوا يقرؤون على مسامعها حكم القتل الصادر بحقها، حكم أٌقرّه شرعيّوها، أقرّته الجماعة إذن!
رأينا في مشاهد القتل تلك مسرحةً لتمزيق الجسد الذي ارتكب المعصية (هذا بفرض أن المعصية وقعت) وبما أنّ العقاب من جنس الفعل جاء الفعل عنيفاً يوازي إعلاء ذكورة الرجل القاتل ورفع مكانته من جديد في مجتمعه.
في قضية رشا نرى أنّ وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في تصوير فعل القتل، وهي من رددت اسمها واسم أخيها ضمن بيئة ضيقة مشوبة بالعنف والتوتر والانفلات. ينتمي الأخ القاتل للفصائل المسلحة التي قاتلت من أجل إسقاط النظام، وليس من أجل المطالبة بحرية النساء وتغيير أعراف وتقاليد المجتمع. القاتل لا يفكر حتى بذلك وبعيد كل البعد عنه!. هو نازح في حرب طويلة، وفاقد للانتماء أتى بأخته النازحة أيضاً ليقتلها على مسرح الهواء الطلق. في مجتمعاتنا نتستر على الفضيحة غالباً، والتقنية الحديثة في آليات التواصل هي التي أتاحت لنا إظهارها.
هذا قتل مباشر ومسرحي لا يختلف عن قتل السّاحرات الذي انتشر بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر، حيث شكّلت نسبة النساء اللواتي أحرقن في محاكم التفتيش سبعين بالمائة، حينها لم يكن هناك ثورة رقمية لتجعل الرؤوس محشوة بصورٍ يُعاد إنتاجها في العقول. النساء الجميلات الذكيات كُن يُسقنَ للمحرقة بأدنى تهمة تمردٍ أواختلافٍ عن بقية أفراد المجتمع، إحدى وسائل تعذيب النساء هي عبارة عن قطعة معدنية مكوّنة من أربعة جوانح مطبقة، يدخلونها في رحم المرأة، ثم يتمُّ فتح تلك الجوانح داخل الرّحم، لِتُسحب هذه الأداة بعنفٍ. كان تمزيق تلك المنطقة من أجساد النساء هو الشغل الشاغل لرجال الكنيسة حينها.
في المسرحة الحاصلة الآن، تغيب تلك المعاني المباشرة للهوس بوحشية تمزيق أعضاء النساء، لكنّ السبب والغاية والنتيجة واحدة، إنها أفعال الإضمار التي لا نجرؤ على الحديث بها علانية.
جريمة شرف
يسمى قتل رشا «جريمة شرف»، وتحتل سوريا الآن المرتبة الثالثة في العالم من حيث نسبة جرائم الشرف التي كنّا قرأنا عنها في مدن خارج وداخل سيطرة النظام. قاتل رشا قام بتصوير فعلته حيث يسيطر الانفلات تحت سلطة المجالس المحلية الضعيفة، في مناطق تستمد قوانينها من الشرع، تلك حقيقة واقعة، ولكن علينا ألاّ ننسى أنّ التأسيس لعملية الإفلات من العقاب كانت عبر القانون الذي يعرفه السوريون، والمنصوص عليه بالمادة رقم 548 من قانون العقوبات، وهو يمنح الذكور حق القتل بناء على ما يسمى «العذر المُخفِف»، وقتل رشا كان جزءاً من ذلك التساهل والتواطؤ القديم، عميق الوجود منذ قرونٍ مضت في عرفنا الاجتماعي.
نفذ الرجل جريمته بوضوحٍ وفخر وانتشاء. لقد انتصر الثقافي على البيولوجي، وقتل الرجل أخته، أمّا نحن فنردد في سياق اللغة إنّ جريمته هي جريمة شرف، إنّ التسمية بحد ذاتها تضمر قبولاً أريحياً بها. لغتنا أيضاً شكل من أشكال العذر المخفف والإفلات من العقاب، نستخدمها رجالاً ونساء. عندما نقول جريمة شرف، فنحن نبدأ بمفردة جريمة أولاً، والتي قد تصيبنا بالخوف؛ هناك جريمة، يا لَلهول! ثم نلحقها بمفردة شرف، تلك الكلمة تحمل معنىً وجودياً أساسياً في حياتنا وتكمل احترام المرء لذاته، قد يختلف مفهوم الشرف من سياق حضاري لآخر، لكن هذا المفهوم يساهم في كل الأحوال في تكوين ذواتنا، إذن تعذر اللغة الجريمة بإضفاء صفة الشرف عليها، هكذا بكل بساطة، تنفى عنها فظاعتها، تبرر اللغة للقاتل فعله وكأنه جزءٌ مما تصبو إليه النفس البشرية. أجل اللغة مسرح آخر!
بين إشهار وإخفاء
ظهرت صورةٌ لفتاة تدعى رحاب ضمن ما عُرف بصور قيصر، وهو اسم مستعار لعسكري سوري انشق عن النظام سرّب عشرات آلاف الصور لضحايا التعذيب في سجون نظام الأسد. كانت مهمته تصوير جثث المعتقلين في السجون. كان جسد الفتاة غير معدٍ للفرجة، مجرد شيء موضوع باعتيادية وإهمال، وُضعت على رأسها علامة وحسب تدل على رقم الفرع الأمني الذي اعتقلت فيه. تنسى الكاميرا أنّها امرأة، جسدها يتساوى مع أجساد الرجال، نظن هذا لوهلة، جسدها مستور بين الرجال العراة. لكن هذا لا يهم! جسد الضحية هنا بلا جنس، ونحن لا نعرف الظروف الفعلية التي قتلت رحاب فيها تحت التعذيب، كل ما نراه هو ما تبقى من جسدها. تلك الصورة كانت معدة للإخفاء وليس للمَسرحة والفرجة، ولم تكن موجّهة لأحد، لا تتمايز عن غيرها من الأجساد المرمية، والتي تماثل أشكال الهياكل العظيمة وتبدو عليها أثار التعذيب. إننا هنا في حضرة صور الإبادة الجماعية، خارج حدود الجنس وخارج حدود العقل.
في صورة جسد رشا إشهار لقتل إنسانيتنا ورفع عالم الذكورة، صورة معدة لتخويفنا. وفي صورة جسد رحاب إخفاء ينطوي تحت تمجيد الديكتاتور، وكلتا الصورتين جعلتا إخفاء الوجود الحيّ للجسدين المهمة الأهم.
حقل الرماية
يشكل جسد المرأة الموضوع الأكثر أثيرية لشهوة القتل، كأنه المرغوب والمُستفز الشيطاني، يحصل هذا في عدة دوائر عميقة ومتباينة ضمن طبقات المجتمع، وهذا الأمر يتفاوت في درجة عنفه وحدته وتنويعات تمثلاته، بدا هذا جلياً في السنوات السبع الأخيرة، بعد أن تباينت الفروقات السوسيولوجية بين الجغرافيات السّورية التابعة لعدة احتلالات عسكرية. إن ما فرضته تقنية التواصل والحوار الجديدة قد غيرت شكل المسارح من كواليسها الواقعية المرتكزة على الاشاعة الشفوية المستترة، إلى مسارح افتراضية متجاورة علنية، تُستخدم فيها شتى أشكال الفنون عمادها الأساسي، الفرجة، تلك المساحة الصغيرة والمتاحة لأي إنسان بأن يصنع فيها مسرحه الخاص، حيث يستخدم الصورة واللغة المكتوبة والفيديو المباشر وشبكة الرسائل المستترة لنشر صورة مفترضة عن الأشخاص، إنّه عالم جديد، لغتنا وصورنا وفنوننا وكل قدراتنا الإبداعية تخرج عبره! وفيه يكون المجال متاحاً بشكل أوسع لقتل النساء معنوياً، فكيف تكون تلك المسارح المتنقلة لقتل النساء في عالمنا المشوش هذا؟!
إنّ النساء اللواتي تجاوزن العمر الجنسي، يخضعن لتعنيف أقل، ويغبن عن حقل الرماية المباشر وربما النساء اللواتي يلجأن إلى مبدأ التقيّة الذي تفرضه أخلاق المجتمع المنافقة قد ينجون، وهن بهذا يضاعفن ضريبة ألم وعذابات النساء المقاومات والمتمردات اللواتي يعتقدن أنّ تغيير المجتمع يتطلب شجاعة للبدء بالخطوة الأولى نحو التغيير، أيضاً بعيداً عن حقل الرمي يمكن أن تكون هناك نساء محميات بسلطة ما يستمددنها من قوّة تقرّها قوانين المجتمع؛ (عائلة، طائفة، قبيلة، سلطة ثقافية عبرقريب ذكر ……) إنهنّ محميات إلى حدّ ما بتلك الحدود التي تجعل الرماية عليهن أصعب.
لماذا، مثلاً، تكون المرأة المستقلة عن أشكال السلالات السلطوية عرضة للقتل أكثر من غيرها في دوائر المجتمع الأكثر انفتاحاً، نحن هنا لا نتحدث عن بيئة تشبه البيئة التي قتلت فيها رشا. إننا في تلك البيئة التي تهاجم فعلاً مسارح قتل السيئات الواضحة والمعلنة، ولكن! ….
كيف يكون القتل هنا؟
لدينا مثال بسيط عن «الرغبة». قد يبدو غريباً أن أتحدث الآن عن الرغبة في عالمنا المعجون بالموت! ما دفعني الآن للتحديق في مسرحة الجسد هو ذلك الهوس المستمر بقتل النساء مؤخراً، أو اختيار امرأة على الأقل كل أسبوع، تخضع في الفضاءات الافتراضية لمحكمة تفتيش علنية، يكون موضوعها الجسد المضمر بكلمة «رغبة». هذه حقيقة فعلاً! إذن علينا ألا ننكر أنّ هذا الهوس بأعضاء النساء هو هوس الرغبة بها. يمكن تسميتها على طريقة رينيه جيرار «بالإجماع العنفي على الإبدال الذبائحي»، حيث تخرج علينا كل فترة زمنية قصة ما لتطهير نفس القاتلين المعنويين والحقيقيين الذين لا يستطيعون التوقف عن التحديق في أجساد النساء. يريدون أن يقولوا: نحن فوق رغبتنا بهذا الجسد الذي عليه أن يختفي شكلاً ومضموناً! إنه قربان مهم لتطهير أنفسهم؛ نفوسهم التي يعتقدون أنّ الرغبة تلوثها!
عبودية الجسد والرغبة
يبقى جسد المرأة مُصاناً خارج حقل الرمي والتصويب عندما لا يقوم باستفزازٍ واضحٍ لقيم يرسمها العرف المجتمعي، لكن أن تجتمع في المرأة قوة الإرادة العقلية للتصرف بجسدها وأن تكون لها حرية الاختيار والتمرد، فهذا يعني أنّها تملك السيطرة على هذا الجسد، وهو ما سيؤدي لنزع ملكية الآخر عنه، حيث ستمتلك المرأة الحرية المطلقة في تقرير مَحطّ رغبتها هي، ستكون فاعلاً وليس مفعولاً به دائماً، وهذا ما يشكل استفزازاً لا يمكن المسامحة فيه إلا بقتل معنوي وواقعي، وهو جزء بسيط من أنواع قتل أخرى قد نتحدث عنها لاحقاً. قتل يتجلى بإسقاط الأهلية العقلية والأخلاقية.
إنّ حق الرجل في أن يكون صاحب رغبة وليس محطها غالباً، هو جزء من فاعلية وجوده وحقه المكتسب بملكيّته لجسد المرأة التي تعود لتاريخ قديم، رجولته ووجوده تكون بفعل الوطء، بينما إهانة المرأة في هذا الفعل لأنها موطوءة.
تهمة الجسد بمعنى حريته، كفيلة بطرد النساء عن دوائر النشاط المجتمعي والسياسي والأدبي وغيرها من الفعاليات، إحدى النساء الناشطات اللواتي أجريتُ حواراً معهنّ تحدثت عن الرعب الذي عاشته في بداية الثورة من رسائل التهديد التي كانت تصلها من رجل «قاتل معنوي متنمر» بتركيب صور عارية لها، هذه المرأة عاشت مستقلة متجاوزة الكثير من المصاعب والأخطار وناضلت من أجل حقها في اختيار شريك حياتها متجاوزة حدود الطبقات الاجتماعية والأديان، لكني لمحت الذعر في وجهها وهي تروي لي شهادتها، وكان جوابها عندما دهشتُ حيال خوفها ذاك: «قبل كان الأذى أقل، وكانت دوائره أضيق، أخاف من المرايا التي يجعلوننا نحدق بها وهم يقومون بتشويه صورنا علانية! هذه الصور لن تؤذيني فقط، بل ستؤذي كل المحيطين بي، لا أحتمل هذا أبداً»، ثم اختفت عن وسائل التواصل الاجتماعي وهي لم تتجاوز الثلاثين بعد، أي ضمن العمر الجنسي لحقل الرماية. فتاة أخرى، في بداية العشرينات، عندما كتب عنها أحدهم كلاماً بذيئاً على صفحات التواصل الاجتماعي يتناول جسدها بطريقة مهينة، كان همّها الأول كما قالت لي: ولكن هل سيصدّق الآخرون هذا؟! هل يمكن أن أتحول إلى مجرد صورة امرأة سيئة! ليست تلك الفتاة بالضعيفة، لكنها تعرف أن دائرة العنف عندما تتحوّل إلى لغة وصورة علنية ستصيبها كما يقال «بالعدوى الوبائية» وستنتشر تلك المقولات ليس على ألسنة الناس كما كان يحصل سابقا، بل مثل إعلانات شوارع يمكن أن تصادفها في عوالم الافتراض التي صارت مقاهي الناس الرقمية وكأنّها ساحات قرى صغيرة.
تلك الفتاة صارت تستخدم اسم رجل في وجودها الافتراضي!
مسرح الاحتفاء بالشرف
في بدايات الثورة انتهج النظام مبدأ الإشاعة والقتل المعنوي لشخصيات نسائية سورية وقفت إلى جانب المتظاهرين، تلك النساء خرجن عن روايته بأن هؤلاء ليسوا إلا خونة ومتطرفين، كنّ من المتحررات فكرياً، منهن الشاعرة والكاتبة والفنانة، لكن الصفة الأبرز التي وصمت تلك الأسماء هي كلمة «عاهرة»، وهي الكلمة المفتاح لإسقاط الأهلية الأخلاقية ونفي الثقة عن صاحباتها، ومن استخدم تلك القائمة كن النساء من طرف نظام الأسد أيضاً وليس الرجال فقط، كان هذا بدايةً. لاحقاً وبعد تحول العنف إلى مرايا موشوريّة بين المُعَنفين أنفسهم صار المعارضون والمعارضات يستخدمون الاتهامات فيما بينهم وكل ما ردده النظام عنهم، وتم إعادة إنتاج عنف وكراهية لم تتوقفا عند حد حتى هذه اللحظة.
وفي المقابل لا نقع على مفردة «عاهر» في مقالات تتناول سمعة المعارضين من الرجال. بقي جسد الرجل خارج التشويه، ولعل هذا أمر طبيعي لا يشكل عيباً أو سبباً لإسقاط مشروعية المعارض الرجل، لأنّ ذلك جزءٌ من كينونته وحقه، وهو مجال فخرٍ وتبجحٍ وليس نقصٍ وعارٍ.
مسرح تأنيث القتل
تم تناول جسد المرأة بوجهه الأكثر ابتذالاً عندما أُنّثَ جسد القاتل.
كانت صورة بشار الأسد تُعرض على صفحات بعض المعارضين بجسد أنثى كدلالة على تصغيره والنيل منه واحتقاره، وهذه الصورة المكررة مرت قبلاً في بلدان عربية عدة كليبيا، حيث ظهر معمر القذافي بجسد امرأة شبه عارية، وكان هذا التعبير جزءاً من غضب الناس ورفض تكريسهم لصورة الديكتاتور كرجل، إذ تقول الصورة: إنّ هذا الرجل ذو الصفات المرعبة المتوحشة يسيء لعالم الذكورة. قتلهُ يتطلب تأنيثهُ. إنه انتهاكٌ لفخامة الجسد الذكر، وتأنيث فعل وحشيته هو جزءٌ من لا إنسانيته. لا يجب أن يحمل بشار الأسد جسد رجل لأنه امرأة. إن هذا أسوأ ما يمكن أن يوصف به رجل بأن يقال له «حريمة»، فلا بأس أن يكون جسد القاتل هو امرأة! والنجاسة تلحق بالجسد الأنثوي وهو ما يليق بمجرم حرب.
إن قتل أجساد النساء واغتصابهن معنوياً وشيطنتهنّ ليس بجديد، فلا أحد يريد التقليل من أحد وإهانته إلا ويسب أعضاء أمه أو أخته… لأن الفعل بالعضو الأنثوي يخص عائلته وملكيتها الممنوحة له شرعاً وعُرفاً، إنّه أكبر إهانة قد يتلقاها رجل، هذه ليست صورة، هذه لغة يومية محكية يتداولها النساء والرجال.
في سياق أخر، أُرِيدَ إلحاقُ الإهانة بشخصية نسائية معارضة، لحقوا بها وتلصصوا عليها (ليس النظام وأزلامه هذه المرة، بل المعارضون). جسد امرأة في صورة مسروقة لم تقم هي بنشرها (ثياب سباحة) كفيل بجعل تلك المرأة أيضاً سبةً ومجالاً للسخرية وللغة العيب ولإسقاط الأهلية. موضوعنا هنا ينحصر في أدواتهم كإظهار الجسد والتحديق فيه وكشفه كنوع من أنواع القتل المعنوي.
تحول ظهور ممثلة مصرية مؤخراً كانت قد أظهرت جزءاً من جسدها إلى قضية رأي عام مشغول الآن بأجساد النساء وأعضائهن! أُجبرت الممثلة في مشهد مُذلٍ ومهين على الكذب علانية لتداري ما وُصِفَ بالفضيحة. لقد لجأت العديد من النساء لتقديم تبريرات تردُّ على انتهاكاتهن وقتلهن معنوياً في الفضاء العام. ذلك ما أسميه بذل العبيد المضاعف الذي اضطرت إليه تلك النساء.
مسرح الجسد النبيل
الجسد النبيل هو الجسد الغائب. الجسد المعلن فوق الشبهات هو القربان، le Sacrifice حسب رينيه جيرار.
نعلي من شأن الأجساد التي رحلت أثناء الثورة والحرب، نرثيها، نقدسها، إنّها أجساد المعتقلات والمخطوفات والمغيبات قسرياً والقتيلات… لم يعدن هنا ليأخذن حصة الآخرين في الحياة، لقد رحلن وأفسحن الطريق، هذا ما لا يريد أن يسمعه كثر ممن يتهامسون بوحشية مستترة. الحقيقة أنّهن أخيراً حِلْنَ موضوعاً مقدساً وليس جسدياً.
من جهة أخرى، نتماهى نحن النساء مع صورة القربان، ونُربّى على انتهاجها في سلوكنا اليومي، سواء أدركنا ذلك أم لا. ننتظر طويلاً لندرك ما هو الحق في الرغبة والحق في المساواة، وكيف نستطيع التفريق بين حقوقنا وبين الواجب المجتمعي وبين انتمائنا الإنساني، إنّ كل وجودنا نحن النساء يتماشى مع فكرة القربان، لا بأس أن تكون المرأة مضحية، فهذا سيعلي من قدرها وقيمتها. إنّ صورة المرأة الأكثر إرضاءً هي تلك المقترنة بالإيجاب السلبي، إنها الجسد المطاوع لامرأة تصمت عن اقتراف الأخطاء ولا تدخل التجربة بكل تنويعاتها من مجالات التفكير والسياسة والجنس والابتكار. أحسن النساء أعطفهن وأحنهن وأكثرهن إلهاماً، المهتمة بمن حولها، الراضية بمظلوميتيها، والمضحية بنفسها من أجل سعادة الآخرين.
شهدتُ بعض جوانب النقاشات التي دارت في كواليس الثورة في بدايات سنة 2012، عندما تشكلت بعض الكتائب الإسلامية وأخذت تفرض على حياة النساء قوانين صارمة. سخر بعض الرجال المؤيدين للثورة، وتهكموا على اعتراض ناشطات على اعتبار هذه الكتائب جزءاً من الثورة، كان العنف الذي جوبهت به بعض الناشطات مخيفاً، لِمَ هو مخيف فعلاً؟ لأنّ ما حصل يعني أنه قيل لهن ببساطة: هذه ليست ثورتكن! لقد صنف هؤلاء الرجال غالباً النساء الفاعلات في الثورة كَبشرٍ من الدرجة الثانية، وكأني بهم يقولون: هذا ليس وقت حقوقكن، التحرير أولاً وفي مرحلة قادمة يمكن التفكير بحريتكن. لقد طالب رجال فاعلون في الثورة ولو بصمت أن تخرج تلك الناشطات عن حقيقتهن الوجودية. هذا يشبه أن تنتظر من الخشب الذي تضطرم به النار ألاّ يحترق! هذا خارج فعل الطبيعة، إنهن نساء، وحقوقهن جزء من حقوق الإنسان التي طالب بها رفاقهن، وقد وجدن أنفسهن وجهاً لوجه أمام معضلة كبرى تتمثل في تلك الازدواجية طويلة العهد المختفية تحت مظاهر الثقافة والنضال، إنه مسرح آخر لقتلهن أيضاً!
إعادة إنتاج العبودية
في إحدى الشهادات التي سجلتُها، اعتقلت فتاة من مدينة حلب على حاجز مكون من نساء ورجال تابع لإحدى الميليشيات العاملة مع المخابرات، وهي ميليشيات خاصة كانت تقبض الأموال مقابل إلقاء القبض على مطلوبين، توقعت الفتاة أنه عندما تناوب عليها الرجال واحداً إثر أخر، أن تتخذ النساء موقفاً مما يحصل ويتعاطفن معها، لكنهن كنّ ينظرن إلى فعل هتك جسدها مشجعات ضاحكات.
امرأة أخرى اعتقلها تنظيم داعش، عذبّتها امرأة أخرى، لكنها كانت أكثر قسوة من الرجال، إذ كان عليها إثبات أهليتها لذلك، خاصة أن الاختلاط ممنوع في قوانين داعش، وعلى الجلادة إتقان دور الجلاد الذكر كما ينبغي!
وفي مجال آخر كان لي أن أتابع عمل أربع نساء يعملن محررات لمواقع الكترونية باللغة العربية، ثلاثة من أصل أربعة كنّ ينشرن مقالات الرجال فقط.
عادة ما تلجأ النساء إلى شكل من أشكال الحماية لجعل أنفسهن بمنأىً عن الاستباحة، سواء وعَين ذلك أم لا، كثير من النساء يكرهنَ الحديث في حقوق المرأة، ويعتبرنَ أنّ هذا يقلل من أهميتهن، ويرددن أنّ النساء كارهات لبعضهن، لذلك فهن فوق التقسيم الجندري، إنهنّ أكثر وعياً وكمالاً ويتندّرن على ما يسمى بـ «حقوق المرأة»، أتفهّم ذلك! فلا يمكن تصوّر مثل هذه الأفعال كنوع من «كره الذات» بل أظنه جزءاً من اللبس الذي يتحدث عنه النساء والرجال معاً، أظن أنهن يطوعنّ أنفسهنّ مع الشر لأنهنّ لا يقدرن على تفكيك تعقيده، إنهن في حالتهنّ هذه، سيَكُنّ من طرف تلك الضفة الناجية بنفسها في حال احتمينَ بالأقوى، هذه طريقة سهلة لسلامهنّ.
تلطيفاً أصف فعلهن بالكسل والجبن لمواجهة معركة انتمائهن الجندري، معركتهنّ المحكومة بسلطة الأقوى العسكرية والسياسية والدينية والطائفية… وغيرها، تلك القوى التي تختلف تنويعات عرضها لأشكال القتل تبعاً للقدرة المسرحية التواصلية في الواقع والافتراض.