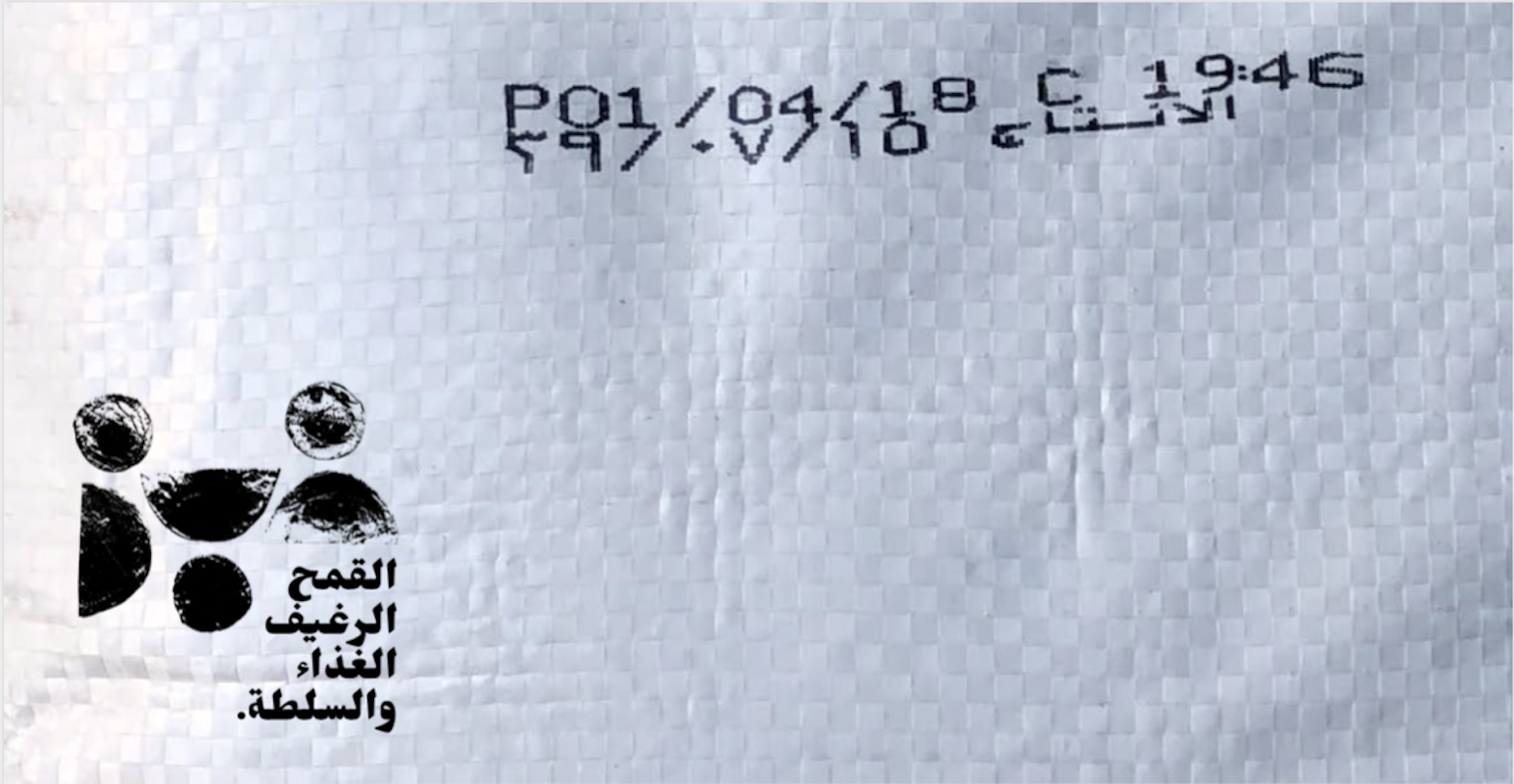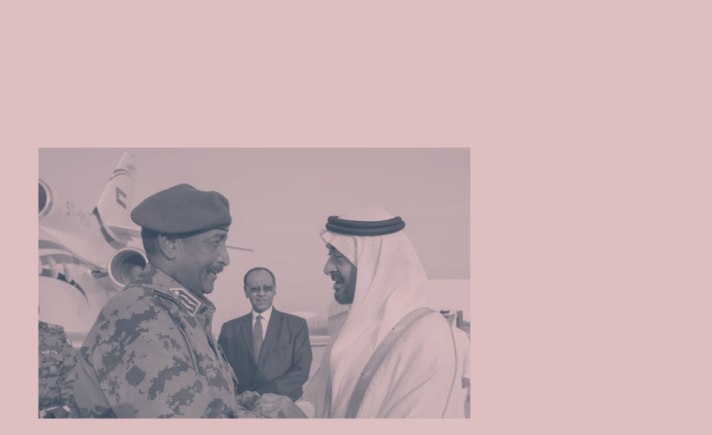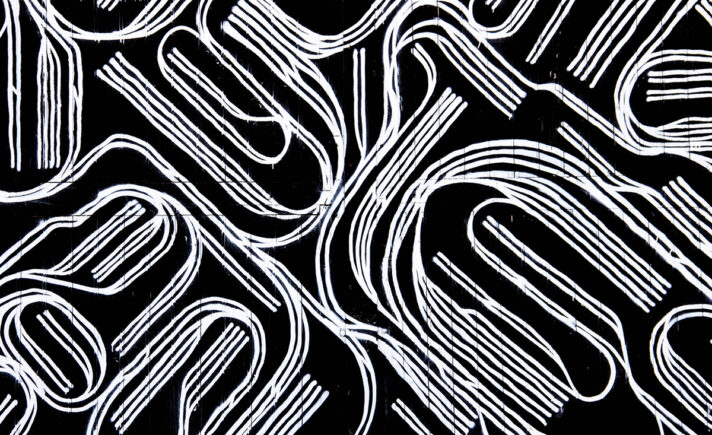مقدّمة
ظهرت فكرة الأمن الغذائي لأول مرة بعد قمة الغذاء العالمية الأولى في عام 1974، عندما أدلى هنري كيسنجر بالإعلان الخاطئ الذي قال فيه إنّ الجوع سينتهي في عشر سنوات. يبدو الحدث مدعاة للسخرية إلى حدّ ما، إذ أن ما يسمّى بـ «أزمة الغذاء العالمية» كانت ستأتي لاحقاً. يستفيد خطاب الأمن الغذائي من نقص الوصول إلى الغذاء باعتباره السبب الرئيسي وراء الجوع، في حين أن معظم الذين يعانون الجوع في جميع أنحاء العالم هم/نّ منتجون/ات للأغذية من الريف. كما أنّ مفهوم الأمن الغذائي هو «إنتاجيّ» في طبيعته، أي أنه رغم كون الوصول إلى الغذاء جزء من المفهوم، فإنّ إنتاجية الغذاء هي التّي اكتسبت الزخم في الخطابات الرئيسية التي ترعاها برامج البنك الدولي.
رغم أنّ أجندة الأمن الغذائي غالباً ما تتمحور حول وعد «تعداد السكان المتزايد» بـ«الوصول» إلى الغذاء، فإنّه نوع معيّن من الغذاء الذي تتمّ عولمته كسلعة متجانسة، ويتم الترويج له عبر الثقافات والحميات. يُثمّن هذا الخطاب قدرة الحكومة على شراء الأغذية وتحرير الأسواق، وغالباً ما تعارض السيادة الغذائية، التّي تهدف إلى الحد من تجارة الأغذية العالمية وتثبيت إنتاج الأغذية في الإنتاج الزراعي الإيكولوجي المحلي. إن الصدام بين المشروعين واضح: الأول يركز على قدرة الدولة على الاستيراد والتصدير، والأخير على مجتمعات الفلاحين/ات القادرة على الإنتاج محلياً. وفي حين أن الأمن الغذائي لم يكتسب زخماً حتى السبعينات، إلا أن التراكمات التاريخية للحميات المستوردة والمرتكزة على القمح قد أحدثت تأثيرها قبل ولوج وكالات الأمم المتحدة في أسواق الغذاء، ومهّدت الطريق أمام برامجها التنموية.
لقد كان القمح مُعتمَداً في مصر خلال الفترة العثمانية ثم الناصرية: يُصنع الخبز من القمح، والخبز يغذي الشعب – الأمّة، وهو الخطاب الذي انزلق عضوياً إلى وكالات التنمية الحديثة. وبالمثل، في حين أن هيمنة خطاب الأمن الغذائي واضحة في الأدبيات والعلاقات الدولية في الوقت الحاضر، إلّا أنّه ليس الخطاب وحده هو الذي يدعم مثل هذا النظام: الأمن الغذائي يتطلب سلعة معولمة تكون متاحة بسهولة وتنقذ «فقراء العالم» من جوعهم/نّ. وقد منح القمح والخبز هذا الشرف الديالكتيكي في تخفيض الاستقلالية الزراعية لبلدان الجنوب العالمي وإطعام الأشخاص أنفسهم، الذّين واللواتي جرّدتهم/نّ الزراعة التجارية من مهنهم/نّ. وبالتالي، من غير المفاجئ، على محدوديّته، أنّ جميع المحادثات حول الأمن الغذائي في مصر تدور حول القمح وحده دون البذور الأخرى.
النّظام الرّأسمالي والإنتاج الغذائي
يؤكد النظام الرأسمالي، مثل كتيّب «الدكانجي» للمحاسبة، لا على الاقتصاد السياسي والتفاوتات النظامية وراء الجوع، وإنما على الفجوات بين الإنتاج والاستهلاك أو البيع والشراء. يحتاج القمح، باعتباره سلعة معولمة، إلى أن يتم إنتاجه بكثرة وبيعه بأسعار منخفضة لتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك؛ ومع ذلك، تتمّ تغذية المستهلكين/ات الأفراد غير القادرين/ات على تحمّل تكاليف أغذية غير مستندة على القمح بحلول قصيرة الأجل، ومرتكزة على زعزعة استقرار صغار المزارعين/ات.
يسلّط خطاب الإنتاجية الضوء على فجوة مبنيّة بين النمو السكاني والإنتاج الغذائي، ويدّعي أن وجود سلعة غذائية تنتجها وتسيطر عليها التكتلات الدولية من خلال اتفاقيات ثنائية مع الحكومات، تفرض نظاماً غذائياً محدداً على الشعوب، هو الحلّ الضامن لتغذية عدد السكان المتزايد. وبالتالي، فإن السوق المفتوحة لا تقرر فقط مفهوم الجوع من الشبع، ولكنها تقرّر أيضاً نوع الغذاء الذّي بإمكانه أن يجلب الخلاص لمعدات الناس الفارغة. لا نزال نسمع عن «قوى لا يمكن السيطرة عليها» وراء التحولات في أسعار السوق، كما لو أن هذه التحولات تتجاوز قدرة أو وكالة المنتجين والدول على حد سواء، كما لو أن السوق تكتسب وعياً خاصاً بها، كما لو أنّ تجارة القمح ليست مسعى محسوباً بتفصيل يدفع الدول الفقيرة إلى دخول السوق كمستهلكين دائمين لمنتوجات معولمة. استقرار الأسعار هو استراتيجية غير كافية للأمن الغذائي، ولمن لا يستطيع تحمل هذه الأسعار على أي حال. نحن بحاجة إلى التفكير في علاقات عمل أكثر إنصافاً جندرياً، وبيئات إنتاج أكثر أماناً، وتمكين الفلاحين/ات والشعوب من السيطرة على ما يُنتَج ويُؤكل، بدلاً من المطالبة بالقمح المعولم كحلّ. وبالتّالي، عندما حُلّت «أزمة الغذاء العالمية»، أتت مع زيادة كارثية في أسعار القمح بنسبة 130٪ في عام 2007-2008، الحاصلة في الوقت ذاته مع ارتفاع أسعار النفط وتميزت بنهاية الغذاء الرخيص والبيئة الرخيصة. وساهمت السياسات المركزيّة للحكومات في قطاع الزراعة في زيادة السيطرة الاحتكارية على الأنظمة الغذائية للبلاد، كما أدى اختراق التمويل في سوق الأغذية إلى خلق هوامش ربح «مقبولة» لمستثمري رأس المال. وبالتّالي، أصبح القمح سلعة أكثر من كونه غذاءً: ففي 1940-1973، كانت الولايات المتحدة تهدف إلى تحقيق أجندتها التنموية بعد الحرب العالمية الثانية باستخدام إنتاج الحبوب. وبالمثل، استوردت الهيمنة الاستعمارية البريطانية حمية القمح واللحم البقري إلى مستعمرات سابقة. ومن ثمّ في الثمانينيات، استخدمت «النظم الغذائية» الزراعةَ التجاريةَ لتشكيل الدولة الذّي امتدّ إلى تصنيع الهويات الوطنية حول الاستهلاك، ممركزاً هذا الاستهلاك على القمح والبذور.
حالة مصر: سيادة أم أمن غذائي؟
تعتبر إعانات القمح والخبز المدعوم مقوّمات أساسية لسياسات الإصلاح الزراعي في مصر، وهي أيضاً أساسية للعقد الاجتماعي بين الدولة ومواطنيها. امتداداً من محمد علي الذي أعاد هيكلة سلسلة القمح القيميّة من الإنتاج والتخزين والتوزيع، أُجبر المزارعون على زراعة القمح. أنشأ محمد علي سلسلة القيمة التي من شأنها أن تغذي جيشه المتنامي، وقُدمت إعانات الخبز التي من شأنها أن تضع الأساس لاحقاً لدعم الخبز الذي قدّمه عبد الناصر من أجل تغذية القوى العاملة المدينيّة. وشهد القطاع الزراعي في مصر تعديلين هيكليين كبيرين في القرن الماضي وحده. الأول هو مركزية الزراعة التّي قام بها جمال عبد الناصر، والتي ركزت على إنشاء نظام زراعي يغذي القوى العاملة الحضرية من خلال إنتاج فائض زراعي يتم شراؤه بتكلفة منخفضة من قبل الدولة، كجزء من عمليات التجانس لبناء الدولة. أمّا الثاني، فكان في الثمانينيات والتسعينيات حين تم دفع تحرير التجارة الزراعية من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والذي تم الترويج له كأسلوب مناسب للتنمية في بلدان الجنوب.
غالباً ما ألغت سياسات الاصلاح الاقتصادي الرقابة على الأسعار، وخففت من العوائق أمام التجارة وتنظيم السوق. كما قامت بخصخصة بعض شركات الدولة واتخاذ تدابير تقشف مالي لتقليل الدعم الحكومي والخدمات (ويلسون 1994؛ أمينزادي 2003؛ تايلر وغانس -مورس 2009؛ أغارول 2011). في حالة مصر ، تمت إزالة العديد من الإعانات الغذائية في ذلك الوقت ولم يعد إنتاج الطحين خاضعاً للحكومة بشكل صارم، إذ تمّ إدخال واردات القمح والطحين إلى سلسلة القيمة الانتاجية وأصبح الخبز غير المدعوم متوفراً (كمال 2015). سمحت هذه التغييرات في سلسلة قيمة القمح للواردات أن تصبح جزءاً لا يتجزأ من إنتاج الخبز المدعوم.
أعادت إصلاحات ناصر الزراعية توزيع الأراضي إلى طرود صغيرة للمزارعين أصحاب الأراضي الصغيرة، حيث لعبت الزراعة دوراً مركزياً في مشروع بناء الدولة. على حدّ تعبير عبد الناصر، كان الهدف أن «تساهم المشاريع الزراعية في التنمية الصناعية وتساهم المشروعات الصناعية في التوسع الزراعي» (عبد الناصر 1955). وبناءً على ذلك، أصبحت عوائد الإنتاج الزراعي مُمركزة، إذ طالبت الدولة المزارعين ببيع إنتاجهم بتكاليف منخفضة للغاية في محاولة لإطعام قوتها العاملة الصناعية الحضرية المتنامية.
ما يتبقى خارج هذه المعادلة هو أن الخبز المدعوم كان أداة أخرى للسيطرة على المزارعين: كانت الإعانات ممكنة بفضل فرض الحكومة تكلفة الإنتاج المنخفض على المنتجين الزراعيين. وكان هؤلاء المزارعون الطرف الذّي تحمّل تكلفة الإعانات، في حين أنّهم لم يستخدموا أبداً الخبز المدعوم لغذائهم الخاص. أدى هذا التحول إلى إضفاء صبغة التصنيع المباشر على الزراعة، حيث أصبحت جميع المدخولات جزءاً من العمليات الصناعية أو التكنوقراطية لتوسيع الإنتاج الزراعي المصري. وعلى الرغم من أن الزراعة لم تكن ممركزة في وحدات الإنتاج جغرافيّاً، إلا أنها كانت مركزية في تنوع مدخلاتها ومخرجاتها. وبدأ المزارعون أصحاب الأراضي الصغيرة في الانسحاب من نظامٍ تَرَكَهم محرومين اقتصادياً (بروملي وبوش 1994)، مما مهد الطريق أمام نظام التجار والوسطاء الذي ما زال مسيطراً إلى حد كبير، والذي يستمر في استغلال المزارعين ويحد من قدرتهم على تجميع الثروة.
تم محو استراتيجيات تخزين البذور إدخال بذور هجينة متجانسة خلال عقود من الإصلاحات الزراعية المركزية التي قامت بها الدولة، مما أدى إلى محو الخطوط الأساسية المحيطة بمعالجة البذور وتخزينها واختيارها للزراعة في المواسم التّالية. أصبح تنوع المعرفة بالبذور وتركيباتها الجينية محدوداً. أصبحت البذور مواضيع مختزلة إلى مجرد مكوّن لآلة التنمية والتطوير، بشكل أساسي، مع محو جميع الممارسات المحيطة بالبذور. لم تتعدَ قيمة البذور الجينيّة والرمزيّة مجرّد قدرتها على إطعام الأمة. بل تمّ تحسينها لإنتاجيّة أكبر ولتصبح وحدة قابلة للقياس. أصبح تكاثر البذور وتنوعها الجيني متجانساً لضمان التناسب الغذائي والإنتاج المُكسِب. وأصبحت العناصر الإنتاجيّة البيولوجية تخضع لحوكمة الدولة، بحيث أصبح الأشخاص ذوو القدرة الإنتاجية سواء كانوا مزارعين أو مالكي أراضٍ صغيرة متجانسين ومستخدَمين في بناء الدولة القومية.
في مصر، أصبح القمح، كما ذكرنا سابقاً، الدواء الشافي لإنهاء الجوع والفقر. أصبح القمح المحصول الوحيد الذي يضمن الأمن الغذائي للبلد، مما أدّى إلى توجيه كميات كبيرة من رأس المال نحو واردات القمح. قبل التعديل الهيكلي لصندوق النقد الدولي على القطاع، كان 61 في المائة من القمح المزروع محلّياً من أصناف متنوعة طويلة بعيدة الأمد، ثم استُبدلت بأصناف قزميّة قصيرة الأمد (خير الله 1999). إذ استخدمت الأسر القاطنة في الأرياف أصنافاً طويلة بسبب غلّتها العالية في إنتاج القش، بينما شجّعت الدولة المزارعين على زراعة فائض مشتريات القمح بأسعار أعلى من قيمتها في السوق، مبقية على أكثر من نصف إنتاج القمح في المزرعة وخارج السلسلة القيميّة. منذ ذلك الحين، ركّزت التعديلات الهيكلية المعنيّة بالمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في أوائل العقد الأول من القرن العشرين على الإمداد الذاتي، لا على المحاصيل المروَّجة في السوق.
تم تجاهل النقاشات عن البذور وجمعها وتوزيعها من خلال طرق غير رسمية إلى حد كبير في مجموعة المقالات المنشورة عن إنتاج القمح. ومع ذلك، هناك ذكر متكرر لأهمية تحسين أنواع المحاصيل بشكل عام في المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على القمح، من أجل الأمن الغذائي. إن مسألة تبني أنظمة محسّنة للبذور وإيصالها من إطار سياسي وممأسس قد فشلت، وفقاً لتقارير كثيرة، بسبب التجمعات التنظيمية وأصحاب المصالح بشكل أساسي. رغم ذلك، تمكنت التقارير والدراسات حتى الآن من معالجة الهيمنة التي تم وضعها لضمان عمل الأسر الريفية كمنتجين للغذاء من أجل القوى العاملة الحضرية المتنامية. وقد تمّ التعتيم على مسألة تبني أنواع معينة من البذور ذات الغلة العالية أو البذور المتاحة الأخرى وصارت غير مقروءة، إلى جانب الأشكال غير المقروءة الأخرى لأشكال مقاومة أصحاب الحيازات الصغيرة لمركزة الإنتاج الزراعي للدولة، سواء كان ذلك من خلال تخزين البذور أو خبز الأرغفة واستخدام الخبز المدعوم من الدولة كعلف للحيوانات أو منع إنتاج القمح من الأسواق التي ترعاها الدولة. وقد تمّ الحدّ من مدى محو ممارسات البذور لدى المزارعين من خلال الإخفاقات المؤسسية والسياساتية، أي الإصلاح الاقتصادي الذي أدى إلى تآكل المنافع الاقتصادية التي يجنيها صغار المزارعين.
إنتاجُ الأمّةِ وغذائِها: السياسات الأحيائيّة بين الاصلاحات الديمغرافيّة والفلاحيّة
عندما نتحدث عن السياسات الإحيائية للتكرار أو إعادة الانتاج، حسب فوكو، بإمكاننا رؤية الروابط بين إعادة إنتاج الأمة وإعادة إنتاج البذور، إلى الحد الذّي يكون فيه عمل المرأة الإنجابي محجوباً ومستولى عليه في إنتاج الأمة، من خلال العمليات الحيوية السياسية. ليست السياسة الإحيائية امتداداً للسياسات المعيارية، بل هي إعادة صياغة لها. في عصر الثبوتية، تحدد المفاهيم المعيارية المتجذرة في العلوم الطبيعية ومفهوم الإنسان الحديث العمل السياسي الذي يسمح للسيادة السياسية بتحييد منافسيها. وتشير السياسات الإحيائية إلى تمزق تاريخي في صياغة السلطة السيادية أو السلطة التي تعمل من خلال حرمان الغير من السلع والمهارات والخدمات. إن الطابع الفريد للسياسات الإحيائية هو أنه بإمكانها أن تتخلص من حياة الناس الخاضعين لها بالمعنى الحرفي، ولكن بإمكانها أيضا تحييدهم من خلال الإنتاج. هكذا أعطت آليات هذه السياسات نهضة جديدة لأنظمة الإقصاء والسيطرة الحديثة، كالنظام العنصري أساساً، وأنظمة عزل أخرى تتمركز على الجنسانية.
«كانت اللحظة التاريخية للتّأديب هي اللحظة التي ولد فيها فنّ جسد الإنسان الموجّه لا لنمو مهاراته وتكثيفها، بل لتكوين علاقة آلية تجعل هذه الأجساد أكثر طاعة كلما أصبحت أكثر فائدة، والعكس بالعكس» (فوكو 1977 ، 137-138). أدى انقاص مهارات الفلاحين إلى زيادة إنتاجيتهم، وفي الوقت نفسه إضعاف قدرتهم على الوصول والتنقل عبر القطاعات والطبقات الاجتماعيّة. كما أن إضافة العمل إلى الفلاحات والحد من تكاثرهن زاد أيضاً من مساهمتهن في عملهنّ غير مدفوع الأجر في تنمية الاقتصاد، وزاد من خضوعهنّ داخل الأسرة للزوج وللدّولة. الطريقة التي يعمل بها التأديب أو الضبط، حسب تعريف فوكو، هي أنّه يسمح بزيادة الإنتاجية الاقتصادية للجسد أثناء إضعافه لضمان خضوعه للهيمنة السياسية. كونه تقنية أو عمليّة، يكون التأديب/الضبط ناجحاً عندما يتداخل مع الضرورات الاقتصادية والسياسية. وقد كانت الزراعة التجارية التّي ترعاها الدولة متلازمة مع هذه الضرورات، إذ شدّدت على تراكم ميزانية الدولة عن طريق نزع الملكية وتراكمها عن طريق النزوح؛ مطلّقة بذلك المُنتِج/ة من وسائل الإنتاج. وبفعلها ذلك، حدثت عملية «إزالة الطبع الفلّاحي عن المنتجين» أو «إزالة الطبع الزراعي عن الأراضي»، مما شكّل نهاية لتعددية مهارات معظم المزارعين. ليس الأمر مفاجئاً في منطق الرأسمالية: إذ تتطلب عملية بناء الدولة وضرورات السوق إنتاج طبقة عمّالية غير متخصصة ومحدودة من أجل العمل اليدويّ الموحّد. هكذا يخدم طلاق المزارع من سلسلة إنتاج البذور مجانسةَ العمل، التّي هي عنصر أساسي في الأمن الغذائي. أولاً، تمّ عزل الفلاح عن الأشكال المحلية من الإنتاج الزراعي، ثمّ انتزعت تعدّدية مهاراته وخضعت لعمليّة توحيد، مما سمح له بالوصول إلى جانب واحد من سلسلة الإنتاج فقط. لقد استعملنا المذكّر هنا عمداً إذ أنّ هناك جزءاً من السكان الذّي تمكّن من تفادي مشروع التجانس، ألا وهو النساء. يكون عمل النساء غير مقروء ومخفيّاً عن متطلبات الأنظمة الغذائية المستوردة، وهو نقيض منطقي للتجريد من المهارات ونزع التّعدّدية التّي تأثّر بها المزارعون الرّجال. إذ كلّما ازدادت حاجة السوق إلى تجريد الفلاحين الرّجال من مهاراتهم، كلّما ازداد عبء الكدح المرتبط بالفلاحة على أكتاف النساء. وبسبب أدوارهنّ المُجندرة التّي تتوقّع منهنّ تقديم الرعاية والعمل المنزلي، لم تفقد النساء في مجتمعات الفلاحين نشاطهنّ التعدّديّ، بل اكتسبنَ مهارات إضافية من أعمال قُمنَ بها دون تعويضات ماديّة.
يتطلب بناء الدولة تصنيع «جسد اجتماعي» متجانس بالامكان التنبؤ بعمليّاته وقياسها والتّحكم فيها. إن تأديب/ضبط أجساد النساء أمر بالغ الأهمية للسياسات الإحيائية بسبب مركزية النّساء في «الجسد الاجتماعي» المتشكل من خلال معدّلات المواليد والوفاة والحالة الصحية والحياة وإنتاج الثروة وتداولها. هكذا تعكس علاقة إنتاج جسد المرأة وجسد الأمة، كمواقع للضبط والتّأديب، عملية بناء الدّولة – الأمة.
هكذا تظهر لنا سلسلتان: أوّلاً، سلسلة «الجسد – الهيئة – التأديب/الضبط – المؤسسة» التّي خضعت لها النساء من خلال تنظيم الأسرة وتنظيم النسل، ولا سيّما التي استهدفت النساء القاطنات في الأرياف، وثانياً، سلسلة «السكان – العمليات البيولوجية – الآليات التنظيمية – الدولة» حيث أن الشّعب هو المتلقّي لصفات هويّة موحّدة. تتناول السلسلة الأولى الإنسان على أنه فرد، والثانية تتعامل معه كجنس أو نوع. وتكون الأجهزة الإنجابيّة والجنسية أساسيّة في الرّبط بين المحورين. فتعمل الزراعة التجارية مع السياسات الديموغرافية لتعزيز التقسيم بين الأنوثة والذّكورة، وبهذا تقوي حضور ثنائيّة الذكر/الأنثى في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، خالقة كسوراً مجندرة في مجتمعات مهمّشة من الفلاحين/ات في أثناء ممارستها لتقنية التّأديب على الجنس البشريّ الموجود في إطار الدّولة الأمّة. تقوم هذه المجموعة بإنتاج القمح واستهلاكه، بينما يتمّ إضعافها بعمليات النزوح والتهجير وضبطها من خلال السياسات الديموغرافية.
خاتمة
في حين أننا نطرح أسئلة فورية حول سلسلة إنتاج القمح المرتبطة بالبذور، فإنّنا قد أغفلنا ممارسات توفير البذور ونشرها، التّي لا تتلاءم مع نموذج الزراعة الصناعي. تبقى البذرة وتنوعها الجيني والممارسات القائمة حولها مخفية، إلى درجة أنّنا عندما نتعامل مع ظروف العمل نادراً ما نفكّر في الأجساد المستخدمة للإنتاج والتّكاثر، مثل النّساء والبذور، كجزء من عمليات الإنتاج الزراعي، بينما تظهر أجساد المؤسسات والدولة الأمّة على حساب الأجساد المنتجة، فتظلّ النّساء في مخيلاتنا محصورات في المساحة الخاصة التي لا تزال مخبأة وغير مرئية، مع كونها مُستغلَّة في بناء الدولة القومية. وسمح هذا الإخفاء للفلاحات بحماية تعدّدية المهارات وتفادي عمليّة التجانس الزراعي أحياناً، ولكنه ساهم أيضاً في جعل عمل النساء الساكنات في الأرياف غير مقروء وغير واضح، مثلما عتّمَ على مقاومة صغار المزارعين في كلّ مراحل سلسلة إنتاج القمح القيميّةـ وعلى كيفيّة تأثير تجانس البذور وفقدانها لتنوعها على زعزعة مفهوم السيادة الغذائية لدى صغار الفلاحين. ومع ذلك، وجدت عملية التجانس طريقها إلى النساء كمُنتِجات للشعب – الأمة، والبذور كمُنتِجة لغذاء الشّعب – الأمة من خلال السياسات الديمغرافية. هكذا يخدم الظهور إلى المجال المرئيّ والإخفاء منه بناءَ الدولة: فهي تشرف على العمل الذي تريد السيطرة عليه وضبطه، وتغضّ الطرف عن العمل الذي يتمّ منحه مجاناً، في فعل واع من إعادة الانتاج السياسي الإحيائي.