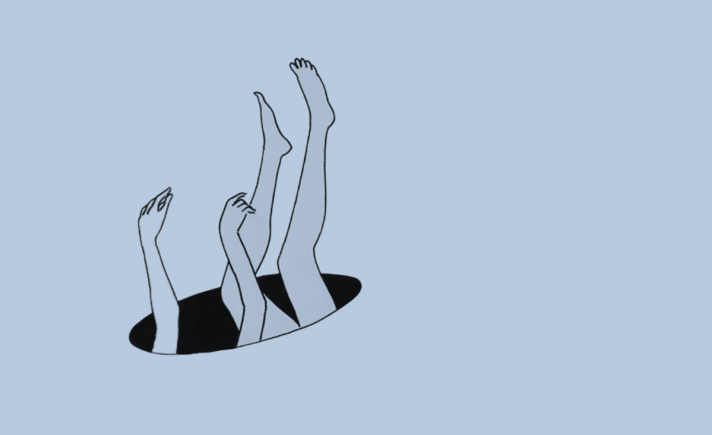استيقظتُ ذلك الصباح على صوت المنبّه، فلم يكن ثمة نوافذ في غرفتي الصغيرة، كحمّام قديم مهترئ، ترسل الشمس منها تحيات الصباح. لا يمكن للمرء أن يتخيّل غرفة كهذه هنا في مدينة المال والأعمال والإبهار العمراني، دبيّ. لكن المدن كالبشر، لها دوماً أسرار لا يعرف كُنهها أحد!
منذ أن اشتريت كومبيوتري هذا، الذي ما زالت شاشته الزرقاء ساطعة أمامي، لم أعد أشعر بأن غرفتي بدون نوافذ. لدي الآن نافذة Windows، أرحبُ من أية نافذة في قصر سلطان، وأكثر تلونّاً وغنىً. حين أنتهي من عملي كل يوم، أدخل هذه الغرفة وأشرّع نافذتي الزرقاء على العالم.
كنتُ قد استدنت مبلغ 3000 درهم من رفيق نصر الدين الذي كان يشعر بشيء من الذنب تجاهنا، نحن اللذين أتينا منذ سنتين إلى هنا كي نجمع ما يساعدنا على تحقيق أحلامنا: أنا لأدرسَ السينما في كوبا، وحازم كي يجمع ثروة يعود بها إلى سوريا ليفتتح مشروعاً ما هناك، ويقبر فقر أهله الأزلي.
طيلة سنتين من العمل هنا لم أستطع أن أوفّر درهماً واحداً من راتبي، فـ 1300 درهم شهرياً لم تكن تكفيني كفاف العيش، فكيف لي أن أوفّر منها؟! حازم كان يردّد على مسامعي كل يوم وهو يحشو سندويشات الماكدونالدز باللحم:
– سيأتي يوم وأجلب لأمي غسالة أوتوماتيكية وجلاية وبراد 24 بوصة. سأشتري لها بيتاً صغيراً وقطعة أرض لتزرعها. أعرف أن هذا اليوم سيأتي يا صديقي!
ويمسح يديه بمريلة كان لونها أبيض فيما مضى. كنتُ أموت من الضحك. ينطق جملته هذه كما نطق القسّ الفرنسيسكاني ويليام فون باسكرفيل جملته الشهيرة في ضباب فجر شتوي في دير بعيد شمال إيطاليا أوائل القرن الرابع عشر:
وهل تعرف مكاناً ثابتاً يعتبره الله بيتا له؟!!
عيناه تحملان الإيمان ذاته الذي كان في عينيّ شون كونري، لكنها لا تحمل ببساطة أية وسامة مشابهة لوسامة كونري! ذاك الكائن الشاحب المشوب بالبياض وهو يلتحف معطفه الطويل ويغيب في العتمة.
في الحقيقة، هذا المطعم الذي أعمل فيه يشبه إلى حدّ بعيد ذاك الدير العتيق في أبينين: نظرات الريبة والشك، الكره والشهوة، تخرج من عيون العمّال حولي، كما كان يمكن للمرء أن يشعرها بجلده وروحه وهي تطلّ من عيون رهبان الدير الذي تحكمه الطائفة البنديكتية. هنا أيضاً يتمّ التعامل مع الضحك باعتباره عملاً شيطانياً يشوّه الوجوه، كما كان يتمّ التعامل مع الضحك هناك في بيت الله قبل سبعمائة عام. الأمر الذي يجعل المراقب يرمقنا بنظرة غاضبة مليئة بالحقد إذا رآنا نفتر ولو عن ابتسامة صغيرة، وذلك قبل أن يستعمل لسانه مهمتراً بشتائم مضمرة. أراه الكاهن العجوز يورغ دي بورغوس ذي العينين الزجاجيتين وهو يهدر:
الضحك يقتل الخوف، وبدون الخوف لن يكون هناك إيمان.
له ذات الوجه الكريه الكاره.
ضحك العمال الصغار، الهامشيين مثلنا، في عالم المال الجبّار يجعلنا غير قابلين للسيطرة! لأنه يقتل رهبته أمامنا، يقتل خوفنا من أسياده، وهذا ما كان من المستحيل القبول به، لذلك فقد كان الضحك محرّماً هنا، تماماً كما هو الحب محرّم. لكن أين أنتم من اسم الوردة يا تافهين؟! وكيف ستستخلصون من الوردة اسمها الأبدي، كلمتها النقية، وأنتم غارقون في مكان تموت فيه كل ورود العالم؟!
يعود صديقي حازم ليهمس من جديد وهو يطرق في عمله: أعرف أن هذا اليوم سيأتي يا صديقي!
كنت أقول له في قلبي: كس أمك أنت وأحلامك التافهة!
لكنه كان يسمعني ويداري ابتسامة.
لكن يوماً بعد يوم صار حلمي بأن أنتمي إلى عالم المول السحري، ذاك الذي أعمل به يومياً، يبتعد، وكذا حلمي بدراسة السينما في كوبا! يوماً إثر يوم يزداد التصاقي الإجباري بعالم العمال، المتّسخ الملوّث بالمعاناة ورائحة العرق الواخزة. لم أعد قادراً على تحمّل روائح شرائح اللحم والدجاج والخبز الصغير المقرف، حين أشمّ رائحة الصوص الأرجواني مع قطع المخلّل تنقلب معدتي، وأكاد أستفرغ كل ما في جوفي. لذلك صرت أضع الكمامة طيلة الوقت بحجة أني أحمل الكثير من فيروسات الإنفلونزا!
صرتُ أحاول أن أستحضر طيلة وقت العمل كل الأفلام التي شاهدتها يوماً، أن أتخيّل مثلاً كيف صوّر أنغمار بيرغمان فيلمه الصمت، هو القادم من رحم طفولة متزمّتة ضيقة لأب كان قسّاً بروتستنتياً لم ينهوس يوماً إلا بتطهره المسيحي. إذن من الممكن أن يخرج من رحم العتمة شيءٌ في غاية الجمال!
الصمت يعمّ حولي، أرى الأفواه تتحرك بدون صوت، الأجساد تمشي وتنتقل من مكان إلى آخر بدون صوت، أرى الزبائن يطلبون ما يريدون ويأخذونه بصمت لا يمكن أن يكون إلا للمقابر البعيدة! أدور، أنا ذاك الصبي جون، بشورتي الحائل وشعري الأشقر، بين ردهات فندق غريب شبه فارغ إلا من أقزام على هيئة مهرجين ومدير عجوز يتكلّم من بين أسنانه
أنا لست بحاجة إلى إله، ولست بحاجة إلى الملائكة أو الشياطين. أنا ملاكُ وشيطانُ نفسي!