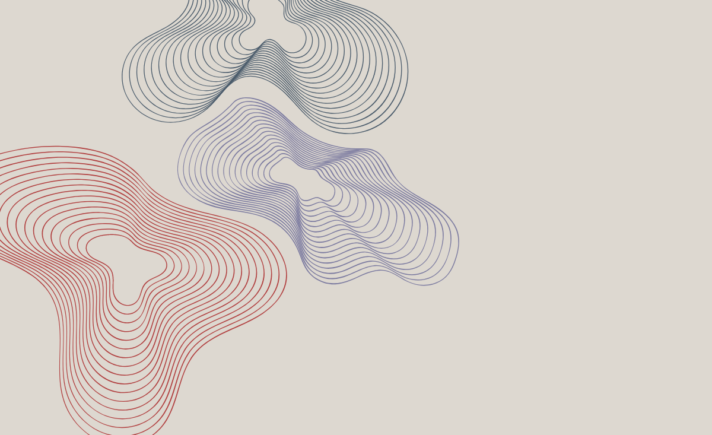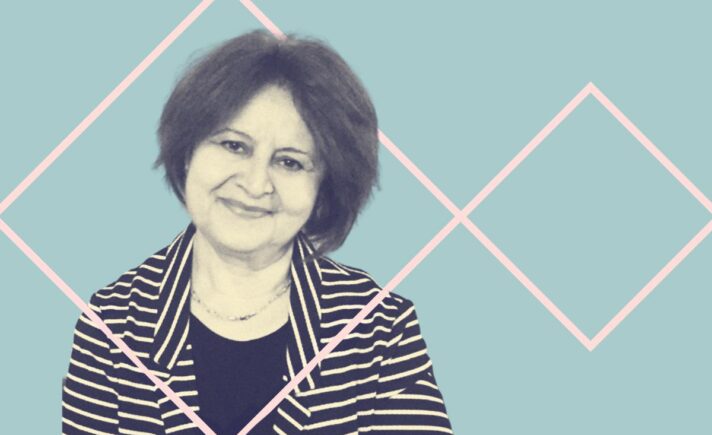أين كنتِ يا خولة قبل 2011، وماذا كنتِ تعملين؟
أين كنت؟ يبدو السؤال بسيطاً يمكن أن نجيب عليه بعملٍ كنت أقوم به، أو مكانٍ كنت أعيش فيه. غير أن سؤالنا البسيط هذا يعني اثنتين وأربعين سنة من الحياة المليئة بالخيارات والمواقف. تربيتُ في أسرة كبيرة وبسيطة تنتمي إلى الطبقة المتوسطة، ولدتُ في دمشق، ودرستُ في مدينة السقيلبية التابعة لمحافظة حماة، ثم حصلتُ على شهادة البكالوريا في الصبورة، وهي مدينة صغيرة تقع بين السلمية والرقة. عدتُ بعدها إلى دمشق لأدرس الاقتصاد.
في طفولتي الدمشقية تعرّفتُ على جوٍ بدا مألوفاً، ولكني عرفتُ تميّزه فيما بعد: جوٌّ العمل السياسي في السبعينات. أصدقاء إخوتي، وزوّار البيت والجيران، وكثيرون ممن دخلوا بيتنا، كانوا ممن سيدخل السجن بعد ذلك لسنوات طويلة، بينما يختار أخي الهروب والمنفى المستمر. هذه الذاكرة حملت بذور المعارضة الأولى، إذ كنت أحبُّ هؤلاء الناس وأتمنى أن أكبر لأكون مثلهم. لذلك لم أدخل حزب البعث في بداية المرحلة الثانوية، وكان يشار إلينا كشيوعيين معارضين في مرحلة الثمانينات، وفي بيئة اتسمت بالموالاة غير المشكوك فيها.
في الجامعة تعرّفتُ على نهايات الحركة اليسارية المقموعة والمقضي عليها، وعلى المتخفّين من حزب العمل الشيوعي، الذين استطاعوا الإفلات من حملات الاعتقالات المتتالية، وكانت أقساها حملة الـعام 1987. والنتيجة كانت اعتقالاً لمدة خمسة أشهر ونصف في عام 1990، قضيتُ معظمها في قبو الأمن السياسي في دمشق، ويومان فقط مع المعتقلات السياسيات في سجن دوما. كانت تجربة قاسية ومليئة بالمشاعر، مرحلة التعذيب الذي استمر لمدة شهر، الزنازين والتواصل مع المعتقلات والمعتقلين عبر الحوائط الصلدة، السجانون وتناقضاتهم الإنسانية. الطريف في السنوات التالية للاعتقال هو أنني كنت أشعرُ بالخجل لأنني استطعت «النفاذ» بهذه الفترة القصيرة بالمقارنة مع السنوات الطويلة التي قضاها آخرون في السجون. ولم أستطع التخلص من هذا الشعور إلا بعد سنوات طويلة، ففي عام 2007 كتبتُ لأول مرّة نصّاً عن تجربة السجن، وأسميته خمسة أشهر على قدمٍ واحدة، وقد استقيتُ الاسم من التعليقات التي كنت أسمعها من المعتقلين الآخرين حين أذكر لهم تجربة اعتقالي، فيبادرون بالقول: «فقط خمسة أشهر!! هذه أقضيها على قدم واحدة!». كانت رغبتي بالكتابة مرتبطة بعملي في مجال حقوق الإنسان وكلّ المستجدات في سوريا بعد الـ 2000. كنت أريد أن أقول: ليس من حق أحد أن يسلبنا حقنا في الحياة، فزمن حياتنا محدود ولا يحق لهم سرقته منّا ولو كان لدقائق أو أيام أو أسابيع أو أشهر.
في سؤال أين كنتُ قبل الثورة؟ لا يغيب كوني زوجة معتقلٍ سابق، وكذلك أنني حُرِمت من حقي في السفر لأكثر من خمسة عشر عاماً، وكذلك من حقي في العمل ضمن دوائر الدولة، والنظرة الاجتماعية المتراوحة بين الشفقة والنقمة والنبذ، لكوني امرأة تعرّضت للاعتقال، والله أعلم بما حصل معها خلاله.
بعد خروجكِ من سوريا ومكوثك لفترة في لبنان، لجأتِ إلى ألمانيا ومن ثم ذهبت إلى تركيا. عندي فضول أن أعرف لماذا بدّلت ألمانيا بتركيا. ألستِ قادرة على مواصلة نشاطكِ من ألمانيا؟
كنتُ نازحة وهاربة في سوريا، ثم هاربة في لبنان، ثم لاجئة في ألمانيا، وفي تركيا أخذتُ ترخيص إقامة وشعرتُ بالقرب من سوريا. عند تناول موضوع اللجوء والترك القسري للبيت ثم للبلد، أعتقد أنه من المهم أن ندرس أكثر نفسية اللاجئين، خاصة أنهم يسلكون سلوكيات متقاربة، فيختارون بداية المكان الأقرب لبيتهم، ثم المكان الأقرب لموطنهم، يجاورون الحدود، يبنون الخيام، يأتون بكل ما هو مؤقت كي لا يشعروا بالألفة مع المكان ويستطيعوا التخلي عنه بسرعة. في أحيان كثيرة يُبقون أغراضهم في الحقائب، يختارون الخفيف كي يحملوه لحظة العودة، والرخيص كي يستطيعوا التخلي عنه دون ندم.
بالنسبة لي كانت الثورة هي ما حلمتُ به طوال حياتي، لحظة التغيير الكبير التي يشارك فيها أغلبية الناس، لحظة التمرّد على الصمت، وإعلاء الصوت بكل قوة، فأعليتُ صوتي وأعلنتُ انتمائي للثورة والتغيير. اضطررتُ لترك بيتي في فترة مبكرة، لأنني كنت أعتقد أنه من المهم العمل باسم صريح منذ أول يوم وأول كلمة.
سافرتُ في منتصف 2013 إلى لبنان، وكنتُ أظن أنه سفر مؤقت لضرورات عمل كنا نقوم به. في تلك المرحلة أُغلِقت الحدود وتمّت محاصرة يبرود وتعذّرت العودة مجدداً، فبقيتُ في لبنان لسنة ونصف على أمل التغيير والعودة. وقد كان البقاء في لبنان صعباً جداً، فاضطررت للمغادرة إلى ألمانيا بعد تأجيل. إقامتي في ألمانيا كانت فترة لأخذ النَفَس والاستراحة، كنتُ متعبة ومشتتة، وبحاجة لإعادة بناء حياتي النفسية والعملية. لحِق بي زوجي جلال بعد خروجه من السجن، وبعد أن قابلته في تركيا، أحسسنا وقتها أنها مكان يمكن أن نعيش فيه. لم يستطع جلال الانسجام مع العيش في ألمانيا، ولا البدء من الصفر، وسعى بكل الوسائل للعودة إلى تركيا، وعاد فعلاً ليبدأ عمله في غازي عينتاب. من جهتي وبعد سنة من ذلك، عدتُ إلى تركيا لأعمل من هناك.
لا تعنيني ألمانيا، ولا البدايات الجديدة، فكل شيء مؤقت بانتظار العودة إلى بيتي وبلدي. ربما أنا أكبر عمراً من الانبهار بأوروبا، وبالحياة السهلة نسبياً للاجئين هناك مقارنة مع بلدان الجوار السوري. ما زلت قادرة على العمل، وعملي ما زال هو مستقبل سوريا وحاضرها المؤلم. شاركنا مع كلّ الناس في الثورة، وعلينا تحمّلُ نتائجها التي وصلنا إليها مع كلّ الناس. صحيحٌ أن الأغلبية يبحثون عن الخلاص الفردي، والحلول الفردية، ومن حقهم ذلك في زمن الحرب، وصحيحٌ أيضاً أن أوروبا بلاد الفرص والتقدير وتحقيق ما كان البعض منا يحلم به ولم يستطع تحقيقه، ولكن علينا ألّا ننسى لماذا وصلنا إلى هنا، وكمّ الألم الذي ما زال يدفعه من بقي هناك.
أنت مديرة «شبكة المرأة السورية». هل لكِ أن تحكي لنا عن ظروف نشوء «شبكة المرأة السورية»، وعن موقعها ضمن الحراك المدني والسياسي؟
أنا مديرة مكتب شبكة المرأة السورية في تركيا، ولست مديرة للشبكة. إذ تتألف إدارة الشبكة، حسب النظام الداخلي لها، من سبع عضوات وأعضاء يتمّ انتخابهن/م كلّ سنتين خلال مؤتمر الشبكة. فضلاً عن انتخاب لجنة قانونية للشبكة، مؤلفة من ثلاث عضوات وأعضاء، أما المكتب في تركيا فهو الجهة التنفيذية للشبكة وتقوم بتنفيذ السياسات والمشاريع التي يتمّ التوافق حولها، وكذلك تنفيذ قرارات لجنة التنسيق والمتابعة وسياساتها.
كان اللقاء الأول حول الشبكة في ستوكهولم عام 2013، وخلال ذلك اللقاء تمّ التوافق على تأسيس منظمة نِسوية سورية. تبلورت الفكرة أكثر وأخذت شكلها النهائي خلال مؤتمر عُقِد في القاهرة في السنة نفسها. كان الغرضُ من تأسيس الشبكة أن تكون هناك جهة جامعة للأفراد والمنظمات المعنية بالمرأة، وأن تقوم الشبكة بالتنسيق بينها والعمل على الوصول إلى الأهداف فيما يتعلق بالمرأة وتواجدها السياسي وإلغاء أشكال التمييز ضدها قانونياً ودستورياً، والعمل على خلق رافعةٍ اجتماعية لتحسين وضعها اجتماعياً.
بعد خمس سنوات من تأسيس الشبكة، أصبح تواجدها مهماً، واستطاعت جذب كثيرٍ من المنظمات والأفراد، نساءً ورجالاً. كما استطاعت أن تؤكد تواجدها في اللقاءات والاجتماعات المتعلقة بالمرأة السورية، وكذلك بمنظمات المجتمع المدني. لدينا ممثلات للشبكة في كلّ المواقع المعنية، كما أن كثيرات من النساء الفاعلات سياسياً وقانونياً واجتماعياً هنَّ عضوات في شبكة المرأة السورية. وقد يكون من أهمّ ما كرّس تواجد الشبكة وأعطاها تميّزها، هو إشراك الرجل في النضال من أجل قضايا المرأة، حيث يتواجد دائماً في الشبكة ونشاطاتها نسبة 20% من الذكور.
بعض عضوات الشبكة يسكنَّ في سوريا، والجزء الآخر موزع على تركيا وأوروبا وبلدان أخرى، كانعكاس لوضع السوريين عامّة. إلى أي مدى نجحت الشبكة أن تكون صلة الوصل بين نساء الداخل والخارج؟ وإلى أي مدى نساء الداخل قادرات على التجاوب مع نشاطات الشبكة نظراً للوضع الأمني التعيس الذي يعانين منه غالباً؟ وهل تواجه الشبكة صعوبات بالتواصل مع هؤلاء النساء، مادياً ومعنوياً؟
بعد خمس سنوات من تأسيس الشبكة، حصلت تغييرات كثيرة وكبيرة، وطالت السوريين والسوريات كافة، بمن فيهم/ن رجال ونساء الشبكة. تغيّرت مواقف البعض، وانسحب البعض، وفضّل البعض العمل السياسي الصرف، بينما تغيّرت ظروف الجميع، بين داخل وخارج سوريا. فشهِدنا موجة لجوءٍ كبيرة، وتوزعٍ لأعضاء وعضوات الشبكة في منافي وبلدان كثيرة، امتدت على كافة أرجاء الكرة الأرضية. فعلى الرغم من أن كثير من أعضاء الشبكة في بداية تأسيسها كانوا من داخل سوريا، ولكن اليوم أصبحت النسبة الأكبر خارج سوريا بفعل الحرب والوضع الأمني الصعب.
وأيضاً على الرغم من صعوبة متلازمة الداخل/الخارج، إلا أن هذه المتلازمة باتت تمتلك نوعاً من المرونة، وتقبلاً من الجميع. وقد استطاعت الشبكة ضمن ظروف صعبة أن تقوم بمشاريعها في الداخل خلال السنوات 2014/2015/2016، حيث اختارت مناطق مشتعلة مثل درعا أولاً ومن ثم مناطق ريف إدلب، في حين اختارت دولَ اللجوء في عامَي 2017/2018 (غازي عينتاب – تركيا).
وقد يكون من الأهمية بمكان ذكر أن الصعوبات لا تتعلق فقط في علاقة الداخل/الخارج، فالخارج مشتت وموزع ومن الصعب جمعه في مكانٍ واحد ولا يمثل كتلة واحدة على الإطلاق. فضلاً عن ترافق التشتت الجغرافي بالظروف الصعبة التي تحيط بحياة اللاجئين/اللاجئات، من ناحية المكان أو الحصول على ترخيص إقامة أو الوضع المادي الصعب. وكذلك حالة الداخل الموزع والمقطع والذي لا يمكن جمعه، ويخضع بدوره لشروطٍ أمنية وسياسية ومدنية متناقضة في بعض الأحيان بين مناطق النظام ومناطق المعارضة بمختلف أطيافها وتشكيلاتها. وكلّ هذه الجهات تشكل خطراً أمنياً على القيام بالأنشطة، لدرجة اختيار السرية في بعض الحالات للقيام بأي نشاط.
وهكذا اختارت الشبكة مؤخراً أن تجري مؤتمراتها الكترونياً، نظراً لصعوبة جمع جميع العضوات والأعضاء فيزيائياً. وقد كانت تجربة ناجحة كرّرتها الشبكة في مؤتمرها لعام 2017، فنجحت في اختيار إدارة جديدة لها ولجنة قانونية، وكذلك متابعة عمل المكتب الرئيسي في عينتاب – تركيا.
بعد تردد طويل، ظهرت في الفترة الأخيرة تكتلات نِسوية ثورية، من بينها «شبكة المرأة السورية». الاستعداد للتكاتف بين النساء يوحي بأن ثمة بوادر لحركة نِسوية بين السوريات. هل يبشرنا هذا التعاون بموجة حقيقية على المدى القريب، أم أن واقع الحرب هو الذي فرضها، وهي قد لا تختلف في تطلعاتها عن أي مجموعات نسائية أو رجالية استنفرت لضرورة الظروف، وستعود إلى مكانها حالما تتحسن الأوضاع ولو قليلاً؟ وعلى ماذا بنيتِ رأيك؟
لا أعتقد بأن ما ظهر من تكتلات نِسوية جاء بعد تردد، بل نتيجة طبيعية لمحاولات كثيرة سابقة تمَّ قمعها، أو الاستيلاء على نجاحاتها، أو وضع العراقيل في وجه تطورها، وبالتالي إماتتها أو تحجيمها وتقزيمها خلال سنوات طويلة من القمع والديكتاتورية امتدت منذ الستينات وحتى قيام الثورة السورية في الـ 2011.
أيضاً ليست مجرد بوادر لحركة نِسوية بين السوريات، بل هي حركة نِسوية تُثبتُ جدارتها وقوتها وتمتد بين السوريات والسوريين كذلك. كما أن هناك كثيراً من الداعمين الرجال للحركة النِسوية، فمثلاً شبكة المرأة السورية لديها عضوات وكذلك أعضاء، وهم أعضاء فاعلون ومدافعون شرسون عن القضية النِسوية. كذلك فإن الحركة السياسية النِسوية التي ظهرت هذا العام، تضمّ بين أعضائها رجالاً ونساءً.
أظهرت الثورة السورية برأيي ثوريتها على صعيد وضع المرأة بشكلٍ كبير جداً، ومستمر سوف نرى نتائجه بشكل أوضح بكثير في المستقبل القريب والبعيد. فالمرأة التي خرجت من منزلها لا تعود إليه كما كانت. نحن نعلم، وملؤنا الألم، أن مناطق بأكملها خسرت استقرارَ مئات السنين، هذا الاستقرار الذي كان يضمّ فيما يضمّه التمييز والعنف ضد المرأة. الألم على المجريات اليومية لسنوات الحصار والدمار الذي حملته الحرب، ولكني من جهة أخرى قد أكون متفائلة على صعيد ما أحدثته هذه التغيرات بالنسبة لوضع المرأة.
التاريخ يعطينا أمثلة كثيرة عن التطور في وضع النساء، والذي لم يكن سهلاً على الإطلاق. فالقرن المنصرم يمكن اعتباره مائة عام من الانتصارات للمرأة عالمياً، ولكن هذه الانتصارات أتت على خلفيات الحرب والدمار والأدوار الجديدة التي لعبتها المرأة بكلّ احترافية، فاستطاعت انتزاع حقوقها، وأحدثت فيما أحدثت ثورات أخرى على صعيد المجتمع والعلوم والفلسفة. وربما كانت الثورة الجنسية في خمسينات القرن الماضي فاتحة جديدة للتغيرات التي شارك فيها الرجال والنساء على صعيد أوضاع المرأة وحقوقها الاجتماعية، من خلال تغيّر الصورة النمطية عن المرأة وعلاقتها بجسدها والأدوار التي يمكن أن تقوم بها.
يمكننا القول إن التغيرات الاجتماعية هي الأهم، وهي التي ستعطي للتغيرات القانونية والدستورية شرعيتها بين الناس، إذ على الرغم من أنّ بعض المواد الدستورية والاتفاقيات الخاصة بالمرأة كانت موجودة، غير أنها لم تكن فاعلة اجتماعياً ولم تحقق أهميتها وضرورتها بالنسبة للنساء، فسارت الأمور كالمعتاد بعيداً عمّا يجب أن يكون.
تختبر النساء السوريات اليوم تجارب جديدة وغريبة عليهنّ، بلدان جديدة مع قوانين تحميهنَّ وتعطيهنَّ حقوق وحريات للتصرف بحياتهنَّ وأجسادهنَّ وما يُرِدنَ القيام به. كما يختبرنَ أن يكنَّ صاحبات قرار، ومعيلات ومتصرفات بأسرهنَّ في غياب الرجل. سمعنا عن حالات الطلاق الكثيرة بعد اللجوء إلى بلدان تحمي النساء، وهي حالات شملت شرائح متنوعة من النساء، ومن بيئات لم يكن بالإمكان أن تتقبل مثل هذه الحالات في وضع الاستقرار السابق للثورة. رأينا كذلك نجاحات أخرى، نوع من خلط المهام والأعمال والمهن بين الرجال والنساء. الحرب انتزعت المرأة من بيئتها الراكدة، ولكن الثورة أعطت للمرأة بعداً جديداً مؤثراً وثورياً سنرى نتائجه ولا بدّ.
يقال إن المرأة ميّالة إلى المدني أكثر من السياسي؟ هل هذا صحيح برأيك؟
المرأة، أو لنحدد أكثر هنا ونقول «الأنثى»، ميّالة إلى الاستقرار بسبب ارتباطها بالأطفال. التربية تتطلب استقرار الوضع لفترة زمنية طويلة نسبياً كي يصبح استمرار الحياة ممكناً. وإذا عدنا إلى العصور البدائية وبدايات تشكل مجتمع إنساني، نجد أن الأنثى هي التي كانت وراء استمرار النوع البشري، لأن الإنسان بحاجة إلى فترة طويلة من الرعاية والتنشئة إلى أن يكبر ويصبح قادراً على الاعتماد على نفسه.
ومع تطور المجتمعات البشرية والانتقال إلى المجتمعات الذكورية، أصبح هذا الجانب من اهتمام المرأة مقونناً دينياً واجتماعياً وأصبح يعتبر الدور الوحيد للمرأة، ولا مكان لها في الأدوار الاجتماعية الأخرى، كالسياسة والحروب والشأن العام بتنوعه. وكانت المرأة التي تحاول دخول هذه المجالات متهمة، وفي بعض العصور قُتِلت بتهمة السحر والشعوذة.
عودة إلى سؤالك عن المدني والسياسي. لقد شاهدنا مع بداية تزايد العنف ضد الثورة السورية، كيف انتقلت النساء إلى العمل الإغاثي بكل أشكاله: غذاء وصحة وسكن ولباس. المشكلة التي وقعنا فيها (وأعتقد أن النساء في الدول المتقدمة وقعنَ فيها قبلنا) أننا تركنا المجال السياسي ليحتله الرجال، وفي كثير من الأحيان كانوا يحتلونه ليس لكفاءتهم، وإنما لكونهم ذكوراً فحسب. وقد انتبهت بعض النساء أخيراً لهذا التراجع الحاصل، وحاولنَ التعويض بشتى الوسائل، فلا تطور على المستوى المدني للنساء دون تطور ثوري على مستوى العمل السياسي.
فهل تمّ استبعاد النساء أم أن النساء هنَّ من ابتعدنَ؟ أرى أن موقف النساء كان ثورياً على المستوى السياسي والاهتمام بالشأن العام ومستقبل سوريا وضرورة التغيير، وكذلك ثورياً من ناحية تناوله قضايا التمييز ضد المرأة اجتماعياً ودينياً وقانونياً. ولكن مع التحولات المأساوية التي شهدتها الثورة، والتي طالت أعداداً كبيرة من المجتمعات المنضمة إليها، اتبعت النساء غريزة البقاء والاستمرار، فهنَّ أكثر التصاقاً بالمجريات الحياتية اليومية. أما بالنسبة للعمل السياسي فهو لا يعكس حجم المأساة، وإن كان هدفه هو تمثيل الواقع. وهكذا ابتعدت النساء فعلاً عن السياسي- النِسوي، لصالح العمل المدني بكل أشكاله.
ولكن حين انتبهنَ إلى «المؤامرة» ضدهنَّ وضد مشاركتهنَّ وتواجدهنَّ، اندفعنَ مجدداً محاولاتٍ تعويض ما فاتهنَّ. وهذه العودة هي التي خلقت حملات السخرية والإهانات الكبيرة لتواجدهنَّ، واعتباره تواجداً غير فاعل ولا قيمة له. كما أن تواجد بعض النساء اتخذ في بعض الأحيان صبغة خيانة ما، من خلال القبول بالتواجد في تشكيلات خزعبلية مثل مجلس ديمستورا، أو القبول بوجود شكلي غير فاعل في بعض الهيئات المعارضة، واللجنة الاستشارية النسائية الخاصة بالمعارضة. فضلاً عن أن الأجواء السياسية بمعظمها طاردةٌ للنساء، بسبب الحكم المسبق عليهنَّ ووضع معايير كثيرة لاختيارهنّ، وكذلك جراء الهيمنة الذكورية على العمل السياسي، التي تحاول الاستيلاء على حصة النساء من التواجد في الشأن العام.
بغض النظر عن كل الأخطاء والإهانات والتواجد الشكلي، غير أن النساء يناضلنَ حقيقة ويحاولنَ بشكلٍ جدي كسر حواجز كثيرة توضع أمام تواجدهن السياسي. وقد أصبحن اليوم عارفات أكثر بأهمية التواجد السياسي لتحصيل الحقوق، والمشاركة في مستقبل سوريا.
لديَّ هنا سؤال متعلق بمكان قضية «النِسوية» في النقاش العام السوري، وبالسجال حولها وضمنها. إلامَ يعود هذا الوضع القلق للمسألة النِسوية في النقاش السوري؟ هل فقط لأن ساحة النقاش عميقةُ الذكورية؟ أم أن هناك عوامل أخرى يمكن أن يكون لها دور في هذا المجال؟ وهل تتحمل النِسويات جزءاً من هذه المسؤولية؟
كثيراً ما نسمع اليوم، ومن نساء كما من رجال، انتقادات على ما يمكن تسميته «الحراك النِسوي السوري» من قبيل: لماذا اليوم؟ ولماذا حراك نِسوي بمعزلٍ عن الحراك الثوري السوري؟ وماذا تريد النساء حتى ينفصلن عن باقي الحراك الثوري والسياسي؟ ولماذا هذا الإغراق بالنِسويات في كل مكان، والتركيز على تواجد المرأة رغم أن ما يجري في سوريا هو حراك سياسي أولاً وأخيراً ونتائجه تتعلق بالمجتمع السوري ككل!! البعض يتعامل بتقززٍ مع هذا التواجد والتركيز، وبعض النسوة ينحين أنفسهنَّ عنه، كمن يريد أن يزيح تهمة النِسوية والتمييز لصالح المرأة، وبعضهنَّ الآخر لا يستطعنَ رؤية أنفسهنَّ سوى ضمن حراكٍ سياسي لا يحمل هذه الصفة التمييزية.
لفهم هذه الظاهرة، من المفيد العودة إلى وضع المرأة في مجتمعنا تاريخياً وخاصة على الصعيد الديني والسياسي. فالمجتمع السوري هو مجتمع متدين في أغلبه، على مختلف الأديان والمذاهب الموجودة فيه، وإن كان الإسلام هو الغالب عليه. الإسلام ومنذ نشوئه كان ذا طابع تمييزي تجاه المرأة، وأحدث نوعاً من القطيعة مع ما قبله، حين أطلق على الفترة الزمنية التي سبقته تسمية الجاهلية (من الجَهل وعدم المعرفة)، وبالتالي تمَّ رفضه، بما فيه من أعرافٍ وتقاليد تتعلق بمكانة المرأة الاجتماعية والدينية. ويمكننا القول إن ما تبقى في ذاكرتنا من خلال ما نُقل إلينا وما تمّ التركيز عليه، هو صور مشوّهة لا تعكس الواقع. جاءت الأديان لترسي قواعد التغيرات المتعلقة بالمجتمع الذكوري، ولتُحدِث قطيعة شبه تامة مع المجتمعات الأمومية، فمن الفلسفة اليونانية التي حجّمت دور المرأة، والتي بقيت امتداداتها في الأديان الباطنية لشعوب المنطقة، إلى الأديان الثلاثة التي امتدت لتصبح الأديان الرئيسة في العالم ككل، استمر هذا التحجيم والتهميش والتنجيس والرفض لأي دورٍ يمكن أن تقوم به المرأة أو كانت تقوم به، بما فيها دورها المعتاد سابقاً كإلهة.
هذا الوضع الديني المتدني انعكس على وضعها السياسي والمدني، فحتى النساء اللواتي نستشهد بهنَّ اليوم من تاريخ ما بعد الأديان الثلاثة، هنَّ نساء طارئات يمارسن دورهنَّ بالوساطة، ويندر جداً أن يمارسنه بشكل مباشر، وإن مارسنه فليس كحق لهنّ، وإنما لوضع طارئ مثل موت الزوج، أو عدم وجود الابن أو صغر سنه. بينما تمَّ على الصعيد العام تكريس نموذج المرأة الفاضلة بالمعايير الجديدة، التي تشوّهت مع مرور الزمن لتصبح جزءاً من الحرملك، أو من السبايا أو سوق النخاسة. كذلك تمَّ تكريس دور المرأة الضحية، أو الأم المضحّية بأولادها الذكور في سبيل نشر الدعوة.
عودةً إلى وضع المرأة السورية: على الرغم من بِدء الحراك النسوي مع بدايات القرن المنصرم، وبِدء تواجد النساء في المشهد العام الثقافي – الاجتماعي – السياسي – التحرري، غير أن هذا الدور لم ينضج بعد الاستقلال بفعل تسلّط الديكتاتوريات العسكرية على المجتمع، مما أحدث قطيعة مع نضالات نساء النهضة. فشهدنا بالتالي انسحاباً من المشهد العام، ترافق مع انسحاب المجتمع ككل من السياسة. غير أن انسحاب النساء كان أكثر تجذراً، بالرغم من أنه تخللته مشاركات نسائية في الحراك السياسي المعارض في سبعينات وثمانينات القرن الماضي. هذه المشاركات كانت محدودة ومرفوضة اجتماعياً، خاصة لأن معظمها جاء عبر الأحزاب اليسارية، فكان من السهل إحداث القطيعة بينها وبين السائد، واتهام النساء المشاركات بالانحراف وبالتالي تحجيم دورهنَّ. في هذا الوضع لم يكن هناك مكان خاص لحراك نِسوي مستقل بذاته عن الحراك التحرري العام، فكان الشعار السائد «لا حرية للمرأة دون حرية المجتمع»، ولا حركة نِسوية مستقلة، وإنما فقط من خلال الأحزاب السياسية المعارضة أو المتوفرة.
قد يكون مردّ هذا إلى ارتباط حركة التحرر على مستوى العالم بالحركة اليسارية والأحزاب الشيوعية، التي ربطت كل أشكال التحرر والتقدم للشعوب بانتصار حركة التحرر الشيوعية على مستوى العالم. وأيضاً لأنه تمَّ وضع اليدّ على المجتمع المدني من قبل الديكتاتوريات، فلم يُسمَح بوجود أي حراك مدني تحرري مستقل عن الديكتاتورية، بما فيها القضايا المتعلقة بالمرأة.
وبالرغم من أن ثمانينات القرن الماضي في سوريا حملت بصمة خاصة تتعلق بوجود النساء المعتقلات السياسيات في السجون، غير أن هؤلاء السياسيات المعتقلات اعتُقِلن على خلفية مواقف سياسية خاصة بتواجدهنَّ أو تعاطفهنَّ مع أحزاب سياسية طالها القمع، وليس لكونهنَّ نِسويات، إلى درجة أن النِسوية كانت أقرب للشتيمة في تلك الحقبة. فمن جهة كانت معظم المعتقلات المحسوبات على اليمين (الإخوان المسلمون) رهينات، وبعضهنّ فقط كُنَّ من المناضلات السياسيات، وجميعهن لم يكن لديهنَّ أي برنامج من أي نوع يتعلق بالمرأة. ومن جهة أخرى كانت اليساريات ينتمين إلى أحزاب اليسار التي ناضلت لتحرر المجتمعات من الديكتاتورية، ولم يكن هناك نضال نِسوي خالص يعملنَ من أجله. ولم تعطهنَّ الديكتاتورية فرصة تطوير أي برنامج خاص على صعيد المرأة. أما العمل النِسوي فقد كان يتمحور حول الاتحاد النسائي، الذي تمّ وضع اليد عليه وفقد دوره منذ الستينات.
عمِلت الحركة النِسوية في كل العالم على تطوير أدواتها التي تلائم زمانها ومكانها. على سبيل المثال، كتابة السيرة الذاتية، وجلسات الكلام النسائية، والعلاج السلوكي وغير ذلك. هل تعرفين ما هي الأدوات التي ناسبت المرأة السورية حتى الآن، ونساء شبكة المرأة السورية على وجه الخصوص، في مشوارهن الصعب نحو الحرية والعدالة؟ وهل لاحظتِ أي تفكير جاد بهدف تحديد هذه الأدوات وتطويرها ومن ثم نشرها كمثال للأخريات؟
أتذكر مع بدايات الثورة السورية، والأشهر الأولى منها تحديداً، مشاركتي في مظاهرة انطلقت في مدينة دوما مركز الغوطة الشرقية، والتي عانت وشهدت كثيراً من الإجرام في حقها على مدار السنوات الثماني الماضية. كان انطباعي عن المدينة (وهو انطباع كرّسته الدراما والقطيعة بين مكونات السوريين)، أقرب إلى «باب الحارة» فيما يتعلق بالمرأة. خلال تلك المظاهرة التي انطلقت من الجامع الأكبر في المدينة، كنتُ المرأة الوحيدة لنصف ساعة، وفي نقطة التجمع كانت هناك حوالي خمسة عشر امرأة يقفنَ على جنب، ويحميهنَّ الرجالُ بأيديهم المتشابكة. وعلى الرغم من تقبل وجود امرأة غريبة سافرة تسير مع الرجال (وهو التقبل الثوري الذي ميّز تلك المرحلة من بدايات الثورة)، غير أننا ما إن التقينا مع كتلة النساء الصغيرة تلك، حتى تمَّ فرزي لأكون جُزءاً منهن.
ما وددتُ الإشارة إليه في مثالي هذا هو التواجد بحدِ ذاته في بيئة ثورية لا تتقبل عادة مشاركة المرأة في الشأن العام، فكيف في حراكٍ سياسي قد ينقلب إلى عنفٍ في حال بدأ النظام بإطلاق الرصاص على المشاركين والمشاركات في المظاهرة. هذا التواجد العلني للمرأة كان من أولى الأدوات التي فرضتها النساء، ليكون لهنَّ دورهنَّ في الثورة.
بدأت تالياً التجمعات النِسوية التي تعنى بالشأن العام بنبش المسكوت عنه سياسياً، فبدأ التعرّف على الملفات الغامضة لسوريا الديكتاتورية: ماذا يعني قانون الطوارئ، وأي تغيير نريده لسوريا، وما هو دور المرأة في ذلك التغيير، وما دورها في الثورة؟ ومع استمرار الثورة، وتحوّلها إلى حرب أهلية، وحرب بالوكالة عن أطراف كثيرة خارجية، أصبحت أوضاع النساء تعكس السيطرة السياسية والعسكرية، فانقلبنَ من ثائرات مشاركات بشكل مباشر في كل الأعمال المدنية (إغاثة ونشاط مدني) إلى مقموعات ومنزويات في منازلهن، إلى لاجئات مسؤولات عن عوائلهنّ. الأوضاع كانت متردية وتعكس تدهور الوضع العام لجميع السوريين، ولكنها أوضح وأكثر فجاجة عند النظر إلى أوضاع السوريات خاصة.
ومع هذه التغيرات، بدأ يتشكل صوت خاص للنساء، منبعه الإحساس بالظلم والتهميش، فالسياسيات السوريات شعرنَ بالتهميش في التشكيلات السياسية التي ظهرت، والمُشارِكات في الحراك الثوري شعرنَ بالتهميش والإقصاء والتقوقع عند سيطرة الميليشيات العسكرية. وبدأ إظهار التلاعب بالمرأة من خلال التركيز على الأدوار النمطية التقليدية (المرأة الضحية – الأم الثكلى – اللاجئة المعيلة)، الذي رافقه استغلالٌ للنساء إعلامياً وسياسياً واقتصادياً وجندرياً في كل المستويات والمجالات.
هذا الشعور بالاستغلال والتهميش والإقصاء ولّد أدوات أخرى لا تقلُّ أهمية، تتعلق بأهمية زيادة الوعي لدى المرأة لتكون قادرة ومتمكنة من المشاركة السياسية الفاعلة، ولتكون ناجحة في المجالات التي تعمل فيها وتكون قادرة على تمثيل غيرها من النساء في المجتمعات الجديدة التي ولّدتها الحرب. من هنا كان للتجمعات النِسوية التي نشأت دورٌ مهمٌّ (بما فيها شبكة المرأة السورية). فعلى الصعيد السياسي عمِلت على تجميع وإظهار الطاقات الموجودة بين النساء، ليكنَّ ممثلات سياسياً في التشكيلات السياسية وفي المحافل الخاصة بالوضع السوري. وعلى الصعيد المجتمعي تمَّ العمل على مشاريع تمكين النساء ليكنَّ قادرات على تحسين شروط حياتهنَّ وظروفهنَّ، ويصبحن أكثر استقلالاً وأقلّ تبعية.
خلال هذا كله، نشأت أدوات جديدة وَسَمَت الحركة النِسوية، من ضمنها التجمعات واللقاءات الخاصة بالنساء، البوح النسائي والتدريب عليه ليكون بوحاً قابلاً للنشر وتجربة موثقة، معارض فنية نِسوية، مشاركات واعتصامات نِسوية، فعاليّات على هوامش المؤتمرات. كما ظهرت أشكال تمرّد فردية، وصلت في بعض الأحيان إلى مستوى ظاهرة، مثل نزع الحجاب، طلب الطلاق، العودة إلى الدراسة، وممارسة تجربة العمل لأول مرّة. ربما لا ينسحب على هذه الخيارات تسمية الأدوات بالمعنى الضيق، إلا أنها تعكس حالة التغير الكبيرة التي تمرّ بها النساء.
يحصل كثيراً أن تُطرَحَ قضية المرأة من قبل المعارضة، ولكن غالباً عندما يكون النظام هو المجرم، كأن يعتقل امرأة أو يقتلها أو يهجّرها. والنظام مجرم بحق كل السوريين، رجالاً ونساءً وأطفالاً. ولكن قلّما يظهر نقد حقيقي موجه من المعارضة إلى سلوك أعضائها تجاه المرأة، كما لو أنه تمّ حمايتها وتمثيلها على أكمل وجه. بل على العكس، تُهاجَم الثائرات اللواتي يخضن في قضية المرأة بشكل أوسع وأشمل. برأيي لا توجد حساسية كافية تجاه قضايا المرأة، ولا حتى عند النخبة. وبما أن هؤلاء (ما زالوا) ينادون بالثورة، أقول إنها ثورة ضيقة الأفق إذن. هل من أمل بتوسيع روح الثورة لتشمل حركات تحررية اجتماعية وسياسية، كالنِسوية وغيرها؟ وماذا فعلت وستفعل النِسويات بهذا الخصوص بالذات؟
كما ذكرتُ في سؤال سابق، فإن وضع المرأة وتقلباته عَكَسَ وضع الثورة بشكل فجّ. فمع بدايات الثورة وانتشار الروح الراغبة بالتغيير الجذري على صعيد سوريا، كانت النساء ثائرات ومشاركات، خرجنَ بعد قمع مجتمعي وديني وسياسي من منازلهن ليكنَّ في قلب الثورة. ولكن مع تردي وضع الثورة وانتقالها إلى طور العسكرة والتحزبات الضيقة والسيطرة على المناطق والتدخلات الخارجية، انعكس ذلك على وضع المرأة وتقوقعها وفرض رؤى تتعلق بها وبمكانتها. هذه الرؤى ليست من خارج المجتمع على الإطلاق، بل هي ما كان سائداً من قبل، لذلك فُرِض على النساء نضال جديد يتعلق بأبسط متطلبات حياتهنَّ، وخاصة على الصعيد الشعبي.
بينما على صعيد الشأن السياسي، كان على السياسيات أن يعينَ أهمية الحراك النِسوي وعدم انفصاله عن السياسي، ليكنَّ ممثلات حقيقيات لبنات جنسهنَّ في مواقع صنع القرار. وأقول هنا أن الوعي زاد لدى السياسيات بعدم انفصال السياسي عن النِسوي، فلجأن إلى بنات جنسهنَّ وإلى الداعمين لقضية التحرّر النسوي، لكي يكنَّ في المواقع التي يرغبن بالتواجد فيها. هذا الارتداد إلى النِسوي، عكس تخلف المعارضة وذكوريتها، التي لم تتنازل عنها لولا الضغط المباشر عليها سواء من الحراك النِسوي السوري، أو من الأطراف الدولية المتدخلة في القضية السورية. فتحوّل التمثيل النسائي في هذه التشكيلات من تواجد عرَضي إلى تواجد حتمي لا يمكن إلغاؤه. وهذا ما سبّب الإزعاج لأغلبية المعارضة الذكورية غير القادرة على تقبل مشاركة النساء في صنع القرار.
نجحت الثورة برأيي في تسليط الضوء وفضح التمييز ضد المرأة وعلى كافة الأصعدة، كما نجحت في إشراك النساء وزيادة وعيهنَّ بحتمية تواجدهنَّ في تقرير مستقبل البلد، وليس فقط في مجالات محدودة كان يتم دفعهنّ إليها، فأصبحت المرأة السياسية ظاهرة. صحيح أنه تمَّ تناولها ومهاجمتها ونبذها كلمّا أمكن ذلك، ولكنها أصبحت أمراً واقعاً.
ما زال من المبكر تلمّس النتائج على المجتمع والحراك النسوي السوري، لأننا نحتاج إلى وقت أطول لخلق التغيير اللازم على الصعيد الاجتماعي والوعي الجمعي العام. ولولا الثورة السورية، لما أمكن العمل على ذلك وتطويره وتجذيره في المجتمع السوري التمييزي ضد المرأة.
في مرحلة ما من تاريخ النِسوية، حاولت النِسويات الغربيات تسييس الشخصي عبر طرح المشاكل التي تحدث خلف باب المنزل. ولكن ثمّة خوفاً عند النساء والرجال السوريين من الشخصي، وتركيزاً على العام. كم من مرّة سمعنا عن قانون الجنسية المجحف فعلاً، والذي لا يمسّ سوى عدد محدود من النساء، وفي الوقت نفسه نقلل من الكلام عن ظروف الزواج المجحفة، وشروط الطلاق الأكثر إجحافاً. هل تعرفين بأن النساء السوريات هنَّ الأكثر تقبلاً لمبدأ تعدد الزوجات بين النساء العربيات؟ فيما يخصّ المرأة لا نجرؤ على القريب والجذري، لنصبَّ جُلّ طاقتنا على البعيد والطرفي. هناك رهبة من الذاتي، ما السبب برأيك؟ وهل يمكن لحركة نِسوية حقيقية أن تتخلى، ضمن هذه الظروف المضطربة، عن طرح الذاتي وعلاقته مع المحيط المباشر كإشكالية؟
الخوف من طرح الشخصي يتعلق بالقناعات، سواء الدينية أو الموروثة اجتماعياً وعرفياً، وكذلك بالذاكرة المتجذرة في عقول السوريين والسوريات على وجه الخصوص. القانوني يمكن العمل عليه أكثر، لأنه بالإمكان تغييره، ولكن الموروث والديني يحتاج إلى بيئة أكثر انفتاحاً، وتربية تمتد لأجيال حتى يمكن تغييره.
في ظرفنا السوري، نجد أن النساء يصبحن أكثر جرأة عندما يصبحن أكثر وعياً، وعندما يصبحن في بيئة جديدة تحميهنَّ وتصون حقوقهنّ. لذلك نسمع بحالات الطلاق عندما تصل العائلات إلى أوروبا بعد رحلة لجوء مريرة، ونسمع بذلك من بيئات لم تكن المرأة فيها تتجرأ على طرح ما تريد فيما يتعلق بالبيت والزوج، ولم يكن بإمكانها لو بقيت في بيئتها أن تختار ما تريد. وفي أول فرصة حماية لها، عبّرت وبادرت إلى فعل ما سكتت عنه طويلاً.
تتعلق الجرأة إذن بمستوى أعلى يجب النضال من أجله، وهو تسييس المطالب النِسوية، لتصبّ لصالحهنَّ على المستوى القانوني، وعلى صعيد دور الدولة في تقديم الحماية والدعم للنساء، وعلى أدوات دعم وفرض هذه التغييرات حتى تصبح أمراً واقعاً يؤثر على بنية المجتمع ووعيه تجاه النساء على المدى الطويل. ويبقى العمل على الذاتي ممكناً ومستمراً من خلال محاولة الوصول إلى البيئات المهمّشة، والعمل على رفع مستوى وعيها. وهذا ما تحاول شبكة المرأة القيام به فعلاً.
من أفضل التجارب على هذا الصعيد هي التجربة التونسية، ونحن نعرف أن التغييرات لصالح النساء في تونس بدأت من الأعلى على شكل قوانين، أما التغيير في الذهنية فيحتاج إلى سنوات وعمل دؤوب على المستويات الأدنى ليتم التغيير. في أوروبا الوضع مختلف، إذ أنَّ التغيير كان وليد ثورة اجتماعية وفكرية جاءت رداً على حروب فجّرت تناقضات المجتمع وخلقت أدوراً جديدة وغير معتادة للنساء فيها. أي أن التغيير كان من المستوى الأدنى وتمّ فرضه على المستوى الأعلى، ليتجلى على شكل قوانين ألغت التمييز ضد المرأة وخلقت أدوات حماية للنساء.
يبدو لي أحياناً أن النصوص التي تُكتب عن المرأة السورية وصفية بالدرجة الأولى. هل صحيح أننا قد نحتاج إلى عقود قبل أن نصبح قادرات على التنظير النِسوي العميق؟ وهل يمكنكِ أن تدلّينا على الكاتبات السوريات صاحبات المحاولات المُرْضية في هذا الاتجاه، كاتبات كتبن حديثاً أو في الماضي القريب؟
التجربة النِسوية السورية في مجال التنظير فقيرةٌ جداً للأسف، ولم تفرز كاتبات منظّرات ومحللات كما ظهر في دول عربية أخرى، فكنّا وما زلنا نعتمد على ما أنتجته كاتبات مثل فاطمة المرنيسي، وقبلها نوال السعداوي. أعتقد أن سنوات الثورة ساهمت في كشف هذا النقص، ولكنها لم تفرز من يمكن أن يغطيه. كان الإنتاج على مستوى البوح النِسوي (كاتبات غير محترفات)، وعلى المستوى الأدبي (سمر يزبك وروزا ياسين الحسن)، وعلى مستوى جميع الأعمال الإبداعية الأخرى. هذا الكشف للواقع ترافق مع بحوث ودراسات رصدت هذه الفجوات (مية الرحبي ولمى قنوت)، وساهمت في خلق أرضية مهمّة يمكن العمل عليها على صعيد التنظير النِسوي، ومزيد من الجرأة في طرح مواضيع كان مسكوتاً عنها. ويمكن التعويل عليها للمستقبل.
أنتِ تكتبين أيضاً. تبوحين كما قلتِ لي. الكتابة هي إحدى أدواتك الشخصية في سبيل الانعتاق. إلى أي مدى ساعدتك الكتابة، هل أصبحتِ حرّة يا خولة؟
لنبدأ من النهاية: هل أنا حرّة؟ لا أعتقد أنني أصبحت حرّة بعد كما أطمح أن أكون، فما دمتُ أمارس الصمت، ولا أتطرق لكثيرٍ من المواضيع الإشكالية، فهذا يعني أنني أفتقد للحرية التي أرغب أن أكون عليها. البوح كان علاجاً في فترة من الفترات في حياتي، فلا زلتُ أتذكر عدم قدرتي على الحديث العلني عن تجربة الاعتقال، إلى ما بعد مضي أكثر من 17 عاماً منه. في عام 2007 كتبتُ عن هذه التجربة، ثم أعدتُ الكتابة بتفصيل أكثر. وقتها شعرتُ بالتحرر من الذاكرة المشحونة بكثير من المشاعر منها الخوف والغضب، والرغبة بالانتقام، لذلك أسمّيه البوح العلاجي الذي مكنني من وضع نهاية لتجربة، والبدء بمرحلة جديدة.
مع بداية الثورة، كان البوح أداةً ثورية بالنسبة لي، مارستُ البوح حول تجربتي المُعاشة في الثورة جمعة بعد جمعة. تنقلَ هذا البوح معي في مناطق ومدن كثيرة، كنتُ أمارس دوري بنقل ما يحدث من الخاص إلى العلن، في وقت كان قلّة فيه يتحدثون عمّا يجري.
كما كان البوح وسيلة تخفيف من وطأة التجارب السيئة التي أمرّ بها: اعتقال زوجي، خوفي وهروبي، والتطورات السلبية في مسارات الثورة. مارستُ كتابة المقال وكذلك الشعر، كنت أعتبرها ضرورة، إذ يجب توثيق ما يحدث بالطرق والأدوات التي نمتلكها. وهذا ما كنتُ أمتلكه وأتقنُ القيام به.
وعلى ذكر كتاباتك، هلا شاركتنا مقتطفاً عزيزاً على قلبك، لنقرأه معاً على صفحة الجمهورية.
في تجاربي المرتبطة بالثورة، كل ما كتبته كان يوثِّقُ لحظات أعيشها، ولكني سأختار هنا ما يوثّق مشاعري بعد أن أصبحت لاجئة في ألمانيا، وقبل أن أتركها لأعود إلى تركيا. ما زلتُ لاجئة متنقلة بين الدول، وأنتظر العودة إلى استقراري في بيتي في دمشق.
تحت سقف المنفى
لم يعد يعنيني كل هذا الزحام
لا الموت ولا غاياته
لا الحب ولا تجلياته
لا الوطن ولا تفريعاته
لم تعد تعنيني كل المعاني المستحيلة
سأقول للرجال إني حصرم عجوز
وللنساء إني تجاويف جوز الهند
للحب إني ضرست
ولرجلي الوحيد إني هاوية بلا قرار
لم يعد يعنيني هذا الوطن البديل
وهذا السرير البديل
وهذا الحلم المسروق في ساعة غفلة
سأقول لهم إني مللت طلب الرحمة
وإن الشفقة خرجت من عيوني مع ماء النهر
إني أكره طعم الفورست
ولكنة اسمي معلوكاً كبصقة
لم تعد تعنيني بداية البدايات
الـ50 متر لشخص و65 لشخصين
أريد متراً بنصف متر
لا يملكها أبناء أرضي
وهنا تكفيني جرّة الفخّار لأنفجر رماداً لا يعنيه أين تحمله الريح
كل الصور كذبة
كل تجميلات الكلام كذبة
كل هذه الحرية وهم
أنت الهارب من السجن
الغربة سجنك
بحجم سرير وكيبورد
إن هربتَ فتعلّم أن تهرب جيداً
كغجري يعشق صهيل الخيل
كحصانٍ شارد لم يدّجنه أحد
كسرٍّ عاشقٍ يعوي حبيبته على مفرق جبل
لا تكن متعرجاً كمائة مسلك للكعبة صوب عرفات
لا تكن مفضوحاً كصفحة فيسبوك لناشط رديء
لا تكن وحيداً كسائح يترصد نفسه قبالة صرح غريب
إن أعلنتك الهزيمة فكن جديراً بها
كمحارب لم تُفقِدهُ المعارك أسنانه فتشبث بذيل ثوبهألمانيا 15 تشرين الأول 2016