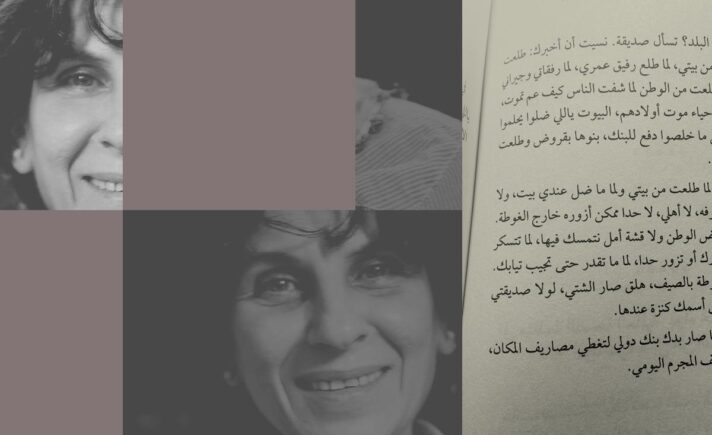داخل مدينة قدسيا، التي تبعد عن دمشق حوالي 10 كم، ويستغرق الوصول إليها من مركز العاصمة نحو 45 دقيقة، توجد مساحة تبلغ ما يقارب خمسة دونمات، يُحتجَز داخل أسوارها اليوم نحو مئة وأربعين طفلاً، هم أطفال سجن الأحداث الذي عاش جميع فصول الحرب السورية التي مرت على المدينة.
وكان اسم مدينة قدسيا قد بدأ يظهر على شاشات التلفاز منذ العام 2011، واقترن بالمظاهرات التي خرجت فيها مبكراً، إذ كانت من أبرز بلدات الغوطة الغربية التي أعلنت العصيان في وجه النظام. بعدها تحوّلت قدسيا إلى واحدة من المناطق التي شهدت اشتباكات بين قوات النظام وفصائل المعارضة التي سيطرت على أجزاء كبيرة منها، قبل أن يفرض النظام حصاراً خانقاً عليها منتصف تشرين الأول 2013، الأمر الذي انتهى بسيطرة قوات النظام عليها خريف 2015 بعد تهجير قسم كبير من أهلها.
سجنُ الأحداث في قدسيا، أو معهد خالد بن الوليد، الذي تأسس عام 1976، «يهدف إلى إصلاح الجانحين وتزويدهم بما يحتاجونه في الحياة من دراسة ابتدائية ومهنية وتربية فكرية وأخلاقية وبدنية، وتنمية شعورهم القومي ليصبحوا مواطنين صالحين»، حسب ما ينصّ عليه نظامه الداخلي. وقد تمكنتُ من دخول المعهد، مُخفياً هويتي الصحفية طبعاً.
الأسدية تعرفة مرور
عند الدخول إلى السجن، أول ما يستوقفك هو مخفر الشرطة التابع لوزارة الداخلية، الذي يُعدُّ القوة الأساسية المسؤولة عن حمايته.
يبدأ الشرطي بسؤال سيدة من الزوار: «ماذا أحضرتِ لنا اليوم؟».
تجيب السيدة الخمسينية: «علبتين متة وعلبة حلاوة مثلما طلبت».
يفتّشُ الشرطي أغراض السيدة ثم ينظر إليها باندهاش: «ما هذا؟ ممنوع إدخال الأدوات الإلكترونية»، في إشارة إلى لعبة فيديو بين الأغراض.
تُخرِجُ السيدة 500 ليرة سورية وتضعها في يد الشرطي، ثم تقول: «خليها تمرق».
يقول الشرطي: «ما بتمرق إلا بأسدية»، في إشارة إلى أنها يجب أن تدفع ألف ليرة (فئة العملة المرسوم عليها صورة حافظ الأسد) كي يسمح لها بإدخالها.
تُخرِج السيدة 500 ليرة أخرى من جيبها وتضعها في يد الشرطي: «هي وحدة ثانية، وهيك صارت أسدية». عندها يسمح لها الشرطي بالمرور.
بما أنني كنت أدخلُ سجن الأحداث للمرة الأولى، استغربتُ هذا التصرف العلني، فاقتربتُ من السيدة متسائلاً بصوت منخفض: «لربما تعرف الإدارة بذلك، أو ربما يخبرهم أحد الموجودين هنا».
تجيب السيدة وهي تحمل أغراضها: «مو فارقة، هذه المسرحية اعتدتُ عليها، الجميع يعلم بأننا ندفع للشرطة، وإذا وافق الشرطي لا أحد يمنعنا بمن فيهم الإدارة».
المعارك على أبواب السجن
لم يكن سجن الأحداث خارج دائرة الحرب، بل كان حدّاً فاصلاً وخط تماس بين منطقتي سيطرة قوات النظام وسيطرة فصائل المعارضة، وهو ما أدى إلى أن تكون الحرب جزءً محورياً من ذاكرة الأطفال داخل السجن.
خارج السجن، التقيتُ بزياد (24 عاماً)، الذي يعمل الآن في أحد المحلات التجارية داخل العاصمة دمشق. عندما يسمع زياد اسم «خالد بن الوليد» يتبادر إلى ذهنه فوراً ما يُعرَف باسم سجن الأحداث، وعند ذكره تختلط الابتسامة بالحزن والخجل في وجه زياد.
يستذكر زياد أيام السجن، يقول: «كُنّا نسمع أصوات المدفعية والرشاشات الثقيلة التي تصل إلينا من خلال الشبابيك والجدران. في كثير من الأحيان كانت فوارغ الرصاص تسقط في باحة السجن».
بحسب زياد، فإن احتدام المعارك في محيط السجن، كان دائماً يُصعّد خلافاً في الآراء السياسية بين اليافعين الموقوفين هناك: «كان البعض يسرُّ للآخرين بأنه معارض، أو أن له أقرباء أو حتى أهلاً في الجيش الحرّ آنذاك، بل إن البعض كان يتوعد بأنه سوف يطلب من فصائل المعارضة قتل عناصر الشرطة التي تسيء التعامل مع الموقوفين عند دخولها السجن». يضحك زياد قائلاً: «لكن ذلك لم يتحقق». يتابع كلامه: «في حين أن العديد من الموقوفين من خلفيات مؤيدة كانوا يظهرون ولاءهم، ويفخرون بعلاقاتهم الأمنية».
يواصل زياد استعادة ذكرياته: «كُنّا نستطيع تمييز السلاح المُستخدم من خلال صوته، وكان هذا واحداً من أساليب تمضية الوقت، إذ يتنافس الموقوفون على معرفة ماهية الأصوات، وتتمحور النقاشات حول نوع السلاح الذي أصدر هذا الصوت؛ هل صوت المدفعية هذه للنظام أم للمعارضة؟ استعضنا عن ذلك بكلمة صادر، التي تختصر فكرة أنها صادرة من النظام، أو كلمة وارد التي تعني أنها سقطت بالقرب منا، وقد أرسلتها فصائل المعارضة».
«النزوح» إلى عدرا
في نهاية العام 2011، ومع سيطرة مسلحيّ المعارضة على أجزاء واسعة من مدينة قدسيا، تم نقل اليافعين إلى سجن عدرا المدني الذي يبعد حوالي 40 كم عن سجن خالد بن الوليد.
يضع زياد يده على جبينه محاولاً التذكر: «عند نهاية عام 2011، لا أذكر الوقت بالتحديد لكن مع قدوم الشتاء في يوم من أيام كانون الأول، تم جمعنا في الباحة وعرفنا أنه سوف يتم نقلنا إلى سجن عدرا المركزي الذي يسيطر عليه النظام. صعدنا إلى الحافلات، كان الوقت مساءً والمطر يهطل بشكل خفيف، كان الخوف من القادم هو أكثر ما يقلقنا. فجأةً تلاشت الخلافات فيما بيننا، ونمت روح الجماعة خوفاً من المجهول الذي ينتظرنا ونحن في الطريق إلى سجن يقبع فيه مجرمون حقيقيون. لقد كان كل شخص فينا لا يعتبر نفسه مجرماً رغم الأحكام التي تلقيناها، بل كنا نعتبر أن كل ما قمنا به كان عبارة عن شقاوة تشبه مشاغبة المدرسة، لكن لسوء الحظ تم اكتشافنا ونقبع الآن هنا، في سجن الأحداث، ريثما تنتهي محكوميتنا ونعود لممارسة حياتنا الطبيعية. أما الآن فإننا سوف نقابل مجرمين حقيقيين، أصبحنا نتخيل أشكالهم كما في الأفلام، لذلك قررنا أن نبقى كتلة واحدة. يزداد هطول المطر، تُفتح أبواب السجن العملاقة كما في القلاع التاريخية، يصعد إلى حافلتنا أحد عناصر الشرطة قائلاً: «يلا يا ولاد نزلوا واحد واحد لعندي». أدركنا هنا أننا عدنا صغاراً بمجرد أن خرجنا من سجن خالد بن الوليد للأحداث، ووطئنا أرض سجن عدرا». بهذه الكلمات يلخص زياد أولى لحظات وصوله مع زملائه إلى سجن عدرا المركزي.
ما الذي تغيّر عند الانتقال إلى سجن عدرا؟ حملنا هذا السؤال إلى العديد من الأحداث الذين انتقلوا من سجن خالد بن الوليد إلى سجن عدرا، وكان من بينهم محمد (24 عاماً). دخلنا إلى استديو تصوير يعمل فيه في البحصة، أحد أحياء دمشق، وبدأنا الحديث مع محمد الذي قال: «أكثر ما يسيطر على ذكرياتي في تلك الفترة هو الخوف، لقد كان سجن عدرا بمثابة رعب لنا، كُنا في خالد بن الوليد ملوك المكان، نعرف أدق تفاصيله. عند انتقالنا إلى عدرا المركزي، كان هنالك حرص شديد على ألّا نختلط بموقوفي الأفرع الأمنية والمعتقلين السياسيين، لذلك تمّ توزيعنا بين موقوفي المخدرات وجرائم القتل. كان سجن عدرا بالنسبة لنا حياة نخاف منها، مكاناً أكبر مما اعتدنا عليه».
بقي الأحداث المعتقلون هناك حوالي ستة أشهر، قبل أن يقوم النظام بعقد اتفاقية مع الفصائل التي كانت تسيطر على أجزاء من مدينة قدسيا، تضمن أن يبقى سجن الأحداث تحت سيطرته، ليعودوا بعدها إلى مكان احتجازهم الأول، معهد خالد بن الوليد.
تراجع الاهتمام وانتشار الفساد
السجن الذي يُقدَّم رسمياً على أنه معهد لإصلاح الأحداث الجانحين، وتأمين إعادة انخراطهم في المجتمع بشكل صحيح، بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كان على أرض الواقع مختلفاً تماماً.
يحتوي المعهد على هنغارات فيها ورشات حدادة وزراعة، وعلى ملاعب رياضية، ويُفترَض أن يقوم على الأنشطة أساتذة مختصون، كما أنه من المقرر وجود أنشطة تشغيل وتدريب، إضافة إلى تعليم المناهج الدراسية. لكن عند الحديث إلى موظفين هناك، خارج جدران السجن، تبين أن هذه الهنغارات توقفت عن العمل منذ نهاية عام 2011، وتعرض جزء منها للسرقة والتخريب نتيجة العمليات العسكرية.
براء(36 عاماً)، موظفةٌ إدارية في السجن، اعتبرت أن الفترة الذهبية للمعهد كانت من عام 2002 حتى عام 2008، عندما كان محمد سعدة مديراً له. وبحسب براء: «لم يقتصر الأمر على تعليم الحرف اليدوية فقط، بل أيضاً كان هناك مختبرات زراعية بإشراف مختصين، مع طموح لتوسيع تلك المختبرات، لكن لاحقاً بدأ الاهتمام يتراجع من قبل إدارة المعهد إلى أن أتت الحرب، حيث انخفضت النشاطات إلى ما يقارب 15 بالمئة من نشاط المعهد السابق».
انخفاضُ مستوى التعليم والعناية بالمعهد، الذي تكلم عنه الموظفون مُلقين باللوم على الإدارة، ليس فقط ما يعاني منه السجن، بل هناك العديد من المشاكل التي لا يُفصح عنها موظفو المعهد.
السجن/المعهد يقع تحت سلطة وإدارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، التي من المفترض أن تقوم بالإشراف الكامل على نشاطاته، وتأمين ميزانية خاصة للموظفين والمختصين، وللأدوات والمعدات اللازمة للقيام بالنشاطات داخل السجن. لكن بحسب مصادر من داخل السجن، فإن الوزارة تعاقدت منذ عام 2010 مع جمعيات أهلية للقيام بهذه الأنشطة، مما وفّرَ على الوزارة ميزانية موظفين ومختصين للقيام بذلك، عبر إحالة الأمر برمته إلى جمعيات تنفق على تلك النشاطات.
يشتكي المحتجزون داخل سجن الأحداث من نقص في الطعام أيضاً، الذي تبلغ حصة الشخص الواحد منه 100 غرام معكرونة، 100 غرام من الرز، والقليل من الزعتر. هذا النقص يردّه الموظفون إلى قلة المخصصات التي تقوم بإرسالها الوزارة، رغم أن مستودعاتها مليئة بالطعام وفق مسؤولي السخرة داخل سجن الأحداث.
قلّة الطعام تؤدي إلى تنشيط سوق بيع وشراء الطعام، حيث يقوم المراقبون داخل السجن بشراء حاجيات السجناء الأحداث من خارج السجن ويقبضون عمولة مقابل ذلك، وهذا يُعدُّ سبباً كافياً لعدم إيصال مطالب المحتجزين بضرورة زيادة مخصصات الطعام.
الخوف والمخدرات في السجن
ليس الفساد ونقص الطعام هو ما يعاني منه السجن فقط، بل أيضاً نقص الأمان وانتشار الأمراض النفسية دون وجود العدد الكافي من المختصين.
تقول رشا التي تعمل مع إحدى الجمعيات الناشطة في سجن خالد بن الوليد للأحداث: «المشكلة ليست فقط في النقص الكبير في عدد الأخصائيين النفسيين ضمن المعهد، المشكلة أعقد بكثير، وإذا لم يتم الافصاح عنها ومعالجتها ستتفاقم».
بحسب رشا ومن خلال ملاحظاتها وتعاملها مع الموقوفين الأحداث، فإن: «انتشار الحشيش والحبوب المخدرة من نوع كبتاغون، تُعدُّ من أكثر الظواهر انتشاراً في المعهد، إذ أن خمسين من أصل مئة وخمسين موقوفاً يتعاطون أنواعاً من المخدرات بشكل مستمر».
لا تستبعد رشا أن يكون بعض هؤلاء الموقوفين مرتبطين بشبكات منظمة تعمل على تجارة المخدرات وربما الإتجار بالبشر، ويعود إلى المعاملة السيئة التي يتلقاها الموقوفون داخل السجن، إضافة إلى نزولهم يومين أسبوعياً إلى منازلهم، حيث يكونون هناك خارج الرقابة وبالإمكان اصطيادهم وتجنيدهم، ولهذا نرى الانتشار الكثيف والمخيف لظاهرة المخدرات.
هناك خللٌ منذ البداية في القانون نفسه، فالقيادة دون حيازة شهادة سوق مثلاً عقوبتها الاحتجاز في سجن الأحداث، وهناك يحتكّ الموقوف مع أصحاب جرائم خطيرة كالقتل أو تجارة المخدرات أو السرقة، ليتحول السجن إلى مركز للانحراف أكثر منه للإصلاح، في ظل ضعف برامج التوعية داخل المركز.
بحسب روايات وصلت للجمهورية، نتحفظ عن ذكر مصادرها، فإن تهريب الحبوب المخدرة يتمّ أحياناً عن طريق الموقوفين أنفسهم أثناء خروجهم ودخولهم إلى السجن، إذ يقومون بتهريب المواد في ثيابهم بعد رشوة الشرطة لضمان عدم التفتيش، لكن في الحالة الغالبة، تدخل المخدرات والحشيش والتبغ والأجهزة الخلوية عن طريق عدد من المراقبين بالاتفاق مع عناصر الشرطة، دون يكون لدينا دليلٌ حسيٌّ على ذلك.
ثمة أمرٌ آخر يضرّ بالحالة النفسية للموقوفين الأحداث ويمنعهم من الاندماج ويعزّز روح العدوانية لديهم، وهو عقوبة السجن الانفرادي. وبحسب رشا فإن هناك عدة حالات لموقوفين قضوا خمسة عشر يوماً في السجن الانفرادي بسبب خلاف مع أحد المراقبين أو نتيجة عصيان أوامر، ليكون الطريق الأسهل لتأديبهم من وجهة نظر إدارة السجن هو هذه العقوبة القاسية والمؤذية نفسياً بشدة.
أجواء الخوف التي تسيطر على سجن الأحداث دفعت العديد من الموقوفين بحسب رشا إلى محاولات للانتحار، كما يلاحظ انتشار «التنمر» بين الموقوفين، إي تبادل الإساءات والعدوانية الشديدة، ليس بين الموقوفين أنفسهم فقط، بل بين الموقوفين والمراقبين المسؤولين عنهم. ومن المفترض أن يكون المراقبون حاصلين على شهادة جامعية باختصاص علم اجتماع، لكن على أرض الواقع فإن معظمهم لم يحصل حتى على الشهادة الإعدادية، ويتم تعيينهم من قبل ضباط في الأمن الجنائي حيث تدخل المحسوبيات في ذلك.
تذكر الاختصاصية النفسية أيضاً أن هناك حالات استعصاء تحدث داخل سجن الأحداث أيضاً، من بينها استعصاءٌ في عيد الفطر العام الماضي، نفذه خمسة وعشرون موقوفاً، وقاموا خلاله بإشعال ثيابهم، أو جرح أنفسهم، وهو ما تفسره رشا بضعف الاهتمام وانعدام الرعاية.
وفقاً لعدد من المتطوعين الذين قاموا بنشاطات داخل السجن، فإنه في عام 2016 حصلت إدارة المركز على ميزانية لتركيب كاميرات مراقبة داخل جميع الغرف والممرات، تكشف عن كل ما يحدث داخل المركز، لكن بعد مرور ستة أيام على تركيب الشبكة التي كلفت ما يقارب مليوني ليرة سورية (4 آلاف دولار)، تمّ تخريبها من قبل مجهولين، عبر قطع الأسلاك الواصلة إلى المركز الرئيسي، وبحسب مصادر متقاطعة من المتطوعين فإن مدير المركز أمر بفتح تحقيق، لكن اتصالات أمنية منعت التحقيقات في ذلك.
ثمة محتجزون في سجن الأحداث على خلفية قضايا سياسية أو قضايا ذات صلة بالثورة والحرب أيضاً، وبحسب مصادر من داخل السجن فهنالك ما يقارب 12 حدثاً متهماً بقضايا إرهاب، تم توقيف قسم منهم خلال مداهمات أمنية، وبعضهم تم القبض عليه خلال عمليات عسكرية. ويُمنع هؤلاء من النزول في عطلة الأسبوع إلى بيوتهم، وكذلك لا يوجد وقت محدد للإفراج عنهم، وإنما يتوقف هذا على الوقت الذي سوف تصل فيه ملفاتهم إلى محكمة الإرهاب، وذلك يتوقف بدوره على الأموال التي يدفعها ذووهم للتعجيل بملف محاكماتهم.
*****
داخل جدران معهد خالد بن الوليد لإصلاح الإحداث الجانحين، يسكن الخوف والإدمان وتعشش آثار الحرب، وهي أمورٌ ستلقي بآثارها حتماً وتخلّف ندوباً في ذاكرة المراهقين المحتجزين، الذين تنتظرهم خارج جدران السجن أوضاع اجتماعية واقتصادية وسياسية لن تساعدهم على مواصلة حياتهم بسلام.