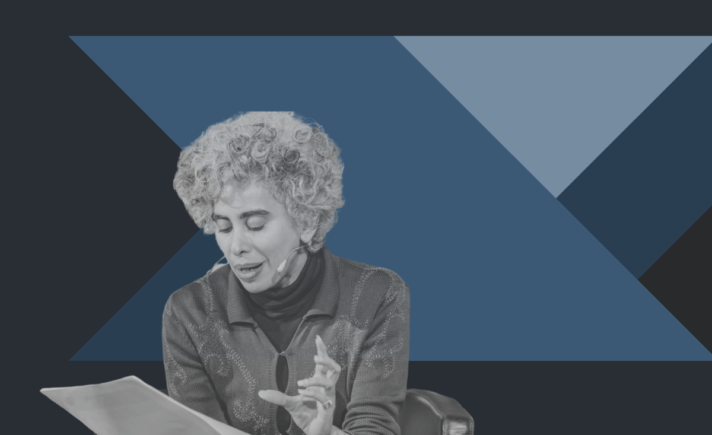لم يكن هناك مجالٌ للملل لدى متابعي الساحتين السياسيتين الإيطالية والإسبانية خلال الأيام العشرة الماضية، فقد عاشت إيطاليا، ثالث اقتصادات منطقة اليورو، فصلاً جديداً من فصول حياتها السياسية المتقلبة دوماً، وهي التي مرّ على حكمها خمسة وستون رئيساً للوزراء منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ويحمل الفصل الأخير من هذه التقلبات كلّ ملامح المرحلة الترامبية-البوتينية العالمية. وقد عاش البلد عاصفةً حادّة منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في آذار الماضي، خصوصاً مع إرهاصات تشكيل حكومة يمينية- شعبوية، ناتجة عن تحالف حركة النجوم الخمس وتحالف الشمال بعد تشكيل الحركتين أول أغلبية برلمانية أوروبية مُناهِضة صراحةً للبُنى السياسية- الاقتصادية الأوروبية، بما في ذلك العملة الموحّدة.
أما إسبانيا، رابع اقتصادات اليورو، فقد تخلّت عن نفورها المعتاد من التحولات السياسية الحادّة، وشهِدت إسقاط حكومة الحزب الشعبي بقيادة ماريانو راخوي عبر حجب الثقة البرلمانية عنها بموافقة جميع الكُتل البرلمانية -عدا حزب «مواطنون»، والحزب الشعبي نفسه، بطبيعة الحال- لصالح تشكيل حكومة اشتراكية بقيادة زعيم الحزب الاشتراكي بيدرو سانشيث.
كان الأسبوع الأخير من شهر أيار قد بدأ مع ما يبدو أنه تشكيلٌ لحكومة إيطالية يرأسها جوسيبي كونتي، وهو أستاذ جامعي متخصص في القانون الخاص، ومجهول الهوية للغالبية العظمى من الإيطاليين حتى ما قبل تعيينه لأيام؛ ويسيطر عليها لويجي دي مايو وماتيو سالفيني، رأسا حركة النجوم الخمس وتحالف الشمال، الحزبين المُشكّلين للأغلبية البرلمانية اليمينية- الشعبوية. لكن رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتاريلا، نفّذ ما كان قد وعد به قبل أيام ومارس حقّ النقض على تشكيل الحكومة، وذلك لاعتراضه على تسليم وزارة الاقتصاد لباولو سافونا، الاقتصادي العجوز (81 عاماً) الداعي لخروج إيطاليا من العملة الأوروبية الموحّدة. وأمام انهيار بورصة ميلان، والعديد من البورصات الأوروبية الأخرى بسبب تصاعد احتمالات ذهاب إيطاليا إلى انتخابات جديدة، أسفرت الضغوطات عن التخلي عن توزير سافونا، لتتشكّل حكومة برئاسة كونتي نفسه (المتهم بتزوير سيرته الأكاديمية)، يقودها فعلياً نائباه، «الشمالي» سالفيني، الذي خصّ نفسه بوزارة الداخلية؛ و«النجومي» دي مايو، الذي احتفظ بحقيبة العمل والتنمية الاقتصادية. ومن ضمن سلسلة من الأسماء المشهورة بمواقفها العنصرية أو النيوليبرالية المتطرفة، ركّزت الصحافة على اختيار جوليا غرييو، وزيرة الصحة الجديدة المنتمية لحركة النجوم الخمس، والمعروفة برفضها لأن يكون تلقيح الأطفال إجبارياً وعاماً، ليكون مثالاً ساطعاً عن نوعية الحكومة العتيدة.
وقد يبدو اسم «تحالف الشمال» مألوفاً لمُتابعي أخبار السياسة الأوروبية في العقدين الأخيرين مقارنةً بحركة النجوم الخمس، إذ كانت هذه الكتلة الحزبية شريكاً أصغر لحكومات الملياردير سيلفيو برلسكوني المتعاقبة، قبل أن تتغلب عليه في الانتخابات الأخيرة لتتصدّر قوائم الأحزاب اليمينية الإيطالية. يرتاح التحالف اليميني المتطرف في أجواء الجبهة الوطنية الفرنسية، أو حزب البديل الألماني أوروبياً، كما يتمركز نفوذه في الشمال الغني، وتنشغل أفكاره أساساً بتضادّين، الأصغر مع الجنوب الإيطالي نفسه، والأكبر مع «الجنوب العالمي»، لا سيما مع أبناء هذا الأخير القادمين إلى إيطاليا.
أما حركة النجوم الخمس، التي أسسها الكوميدي بيبي غرييو عام 2009، فهي مزيجٌ متفجّرٌ من العدمية السياسية والغضب والمظلومية، يتكوّن عالمها اللفظي من تعبيرات الاحتقار للسياسيين عموماً، ولكل أنواع البُنى السياسية، لا سيما الأوروبية منها. لا إيديولوجيا واضحة ولا توجّه سياسي متّسق، وبخطاب يكاد يُختَزَل بـ «فليذهب كل شيء (سياسي) إلى الجحيم». وقد شهدت الحركة تصاعداً في شعبيتها خلال سنوات الأزمة الاقتصادية، واستفادت من أن التصويت لها جاء بمثابة حركة احتجاج على «طبقة سياسية» إيطالية سيئة السمعة، لتصل إلى صدارة القوس البرلماني اليوم بنوابها الـ 227 (من أصل 630).
وسط هذا المشهد اليميني- الشعبوي يترنّح الحزب الديموقراطي، الحزب الأساسي في الديموقراطية الإيطالية خلال النصف الثاني من القرن العشرين، بعد أن فقد مئة وثمانين نائباً في الانتخابات الأخيرة، وبات صراعه مع ذاته بعيداً جداً عن الصراع من أجل السلطة، ما دعى زعيمه، ماتيو رينزي، إلى الاستقالة.
وفيما بدا أنه نفيٌ لأي استقلالية لرئيس الوزراء عن سطوة نائبيه، تبنّى كونتي، خلال خطابه البرلماني الأول، كل نقاط الحلف الشعبوي-اليميني، تحديداً خفض الضرائب؛ و«تنظيف إيطاليا» من أكثر من نصف مليون مهاجر غير شرعي (حسب تقديرات الحِلف الحاكم)؛ و، طبعاً، الانفتاح على روسيا واتخاذ موقف رافض للعقوبات الأوروبية- الأميركية عليها.
على الغرب، كانت الأمور في إسبانيا مستقرة خلال أسابيع إرهاصات تشكيل الحكومة الإيطالية، فرغم أن البرلمان الإسباني الحالي هو الأكثر تنوّعاً في تاريخه إثر تضعضع الثنائية الحزبية بين الحزبين الشعبي والاشتراكي، والتي سيطرت على الغالبية العظمى من القوس البرلماني الإسباني تاريخياً، وظهور حزبي بوديموس (يسار) ومواطنون (يمين- وسط) ككتل برلمانية وازنة، إلا أن حكومة راخوي كانت مستقرة بفضل اتفاق كتلة الحزب الشعبي مع حزب مواطنون، وتوافقات نقطية مع بعض الكُتل الأخرى لتأمين الأغلبية البرلمانية. كان راخوي قد «انتصر» في أزمة كتالونيا الأخيرة، وعززت البيانات الماكرو-اقتصادية المشيرة لانخفاض البطالة والعجز خِطابه كمنقذ إسبانيا من أزمتها العقدية، كما نجح في تمرير ميزانية عام 2018 أواسط أيار بعد استعصاب برلماني طويل. كان راخوي مرتاحاً، لكن «غورتل» كانت بالمرصاد.
فضيحة «غورتِل» هي إحدى أكبر قضايا الفساد في تاريخ إسبانيا، وقد كُشفت منذ أكثر من عشرة سنوات، حين افتضح وجود شبكة موازية للحزب الشعبي، تُدير آلية استجلاب «تبرعات» غير شرعية للحزب من رجال أعمال وشركات كبرى، خصوصاً في قطاع الإنشاءات، مقابل حصولها على عقود وتسهيلات في بعض البلديات والمقاطعات التي يحكمها الحزب الحاكم، ويتم تصريف هذه التبرعات غير الشرعية عبر استخدامها لتدعيم حملات الحزب الانتخابية «بالأسود» بفضل شركة علاقات عامة أُسّست لهذا الغرض، وأيضاً لصرف رواتب غير مُصرّح بها لقيادات من الحزب. «غورتل» وملابساتها وتفاصيلها وشخصياتها وتطوراتها جزء من الحديث اليومي الاسباني منذ عام 2007، وباتت اعتيادية لدرجة أنها نُسيت ضمن الأجندة السياسية. لكنها زلزلت هذه الأجندة حين ظهر حكم المحكمة حول الجزء الأكبر من القضية أواخر أيار الماضي، والذي جاء قاسياً بحق قيادات من الحزب الشعبي ورجال أعمال مقرّبين منه، وما هو أهم: أدانت المحكمة الحزب الشعبي كمستفيد من الفساد، وثبّتت أن الحزب تمَوّل بشكل غير شرعي خلال سنوات طويلة.
بيدرو سانشيث، زعيم الاشتراكيين الاسبان، والذي عُرِفَ لاحقاً أنه لم يكن يعلم حتى أن حُكم «غورتِل» على وشك أن يصدر، التقط اللحظة وأعلن نيّته تقديم طلب حجب ثقة في البرلمان الإسباني، والترشح بنفسه لتشكيل حكومة اشتراكية بديلة في حال فاز حجب الثقة بالأغلبية. لكن آلية حجب الثقة غير مطروقة في البرلمان الإسباني، المُعتاد على مراحل استقرار مديدة، إذ لم يسبق في تاريخ الديموقراطية الإسبانية أن حظي أي من الطلبات الأربع التي قُدّمت سابقاً بالنجاح. إضافة إلى ذلك، لم يحظ سانشيث بصورة السياسي الناجح في أي وقت، لا في السياسة الإسبانية ولا في حزبه، إذ لم يعش إلا هزائم انتخابية متلاحقة، ومحاولة مثيرة للأسى لإخراجه من قيادة الحزب عن طريق «انقلاب» داخل اللجنة الفيدرالية (قيادة الحزب) أدت لاستقالته قبل عودته المفاجئة عبر الانتخابات الداخلية بعد أشهر. لكن أحكام الفساد المتلاحقة ضد الحزب الشعبي، إضافة لعمل دؤوب ضمن كواليس البرلمان، ودور بوديموس في ابتزاز الحزب القومي الباسكي، الخارج للتو من اتفاق مع الحزب الحاكم لتمرير الميزانية العامة، أدت لانقلاب السياسة الإسبانية رأساً على عقِب خلال ثلاثة أيام فقط، إذ مرّ حجب الثقة برلمانياً بموافقة جميع الكُتل عدا الحزب الشعبي و«مواطنون»، وحظيت مبادرة سانشيث بالأغلبية، وعاد الاشتراكيون لحُكم إسبانيا، رغم أن كتلتهم الحالية (89 نائباً من أصل 350) هي أصغر الكُتل الاشتراكية في تاريخ الديموقراطية الإسبانية.
لا تبدو فُرص سانشيث بإنهاء الفترة التشريعية الحالية كبيرة، وغالباً ما سيضطر لإعلان انتخابات مبكرة بعد أشهر، فحجم كتلته البرلمانية الحالي يضطرّه للتوافق مع كُتل شديدة التنافر فيما بينها لتمرير أي تشريع برلمانياً، وخطواته الأولى في اختيار أعضاء حكومته تجعل من الواضح أنه قد بدأ الحملة الانتخابية، إذ شكّل حكومة بأغلبية من النساء، و«اشتراكية-ديمقراطية» على طراز حكومات ثاباتيرو منتصف العقد الماضي. كارمن كالبو، نائبة رئيس الوزراء، تحمل حقيبة «وزارة المساواة»، المستعادة بعد إلغائها في الحكومات السابقة، كما عُيّن جوزيب بوريل، الاشتراكي الكتلوني المخضرم ورئيس البرلمان الأوروبي سابقاً، وزيراً للخارجية؛ وفرناندو غراندي-مارلاسكا، القاضي في المحكمة الوطنية سابقاً، والمشهور بنشاطه من أجل إقرار سياسات وقوانين تقدّمية، وزيراً للداخلية؛ وحقائب الاقتصاد والمالية والعمل، ثُلاثي الاقتصاد الاسباني، بيد أكاديميات مخضرمات في العمل في الاتحاد الأوروبي. وعدا تشكيل الحكومة، قدّم تعهدات بفتح حوار من أجل إنهاء أزمة كتالونيا، وإن ضمن الالتزام بأطر الدستور الإسباني.
يحاول سانشيث أن يقول بصوتٍ عالٍ أن الاشتراكية- الديموقراطية ذات التوجّه الأوروبوي قد عادت، وأن هناك طريقاً لها لا يمرّ بتحويلها لنسخة ملطّفة عن الخطاب اليميني الصاعد، ولا شك أن صياغة هذا الخِطاب كانت بارعة في وضوحها. ثمة تساؤل كبير يُطرح حول مدى إمكانية أن تجد هذه الصرخة صدىً انتخابياً في إسبانيا بعد شهور، أو بعد عامٍ على الأكثر، وتنال شرعية عبر كسبها للانتخابات، لكن التساؤل الأكبر مطروحٌ تجاه مستقبل خطابٍ اشتراكي-ديمقراطي في أوروبا باتت فيها أنجيلا ميركل وجهاً «ليبرالياً» بالمقارنة مع الحكومات الأوروبية الصاعِدة تباعاً.
من المتهوّر البحث عن متوازيات بين إسبانيا وإيطاليا من خلال أحداث الأيام العشر الأخيرة، فهناك تباينات كبيرة للغاية بين الدولتين رغم مشتركات كثيرة في البنية الديموغرافية والمشكلات البنيوية في السياسة والاقتصاد، لكن هناك حكومتان جديدتان في البلدين، متنافرتان للغاية، ولا مشتركات بينهما من أي نوع، لكن خبر تشكيل الحكومتين لاقي «ارتياحاً» متشابهاً في بورصتي مدريد وميلان، فرأس المال يفضّل وجود استقرار، أياً كان نوع «الاستقرار».
اشتراكيون ديموقراطيون أو يمينيون-شعبويون، «بزنس آز يوجوال».