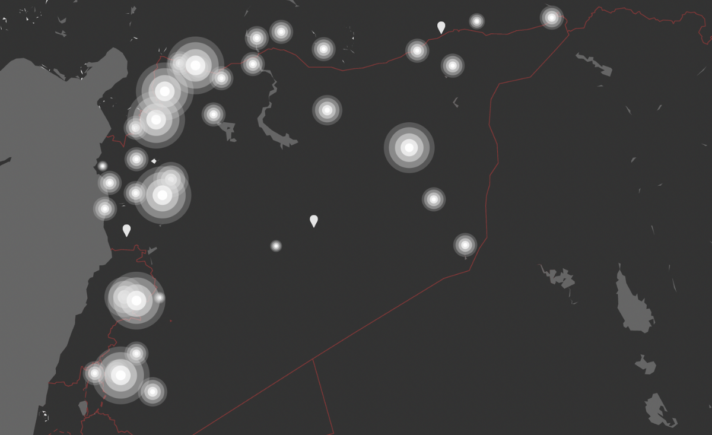مقدمة
«رؤوس الميدوزات البحرية التي علقت بحوافر خيله، هي أدقُّ الشواهد على أنّ شيئاً لم يكن ليقف في وجه تقدّم أمير بُروسيا العليا ألدوس بن كارل أهرنبرغ، وأنّ وصوله أواسط غاليا، ثم سقوطه نحو بافاريا، ليس إلّا ترتيباً يقدّم ويؤخّر فيه على إيقاع الرعب، بيد أنّ التوقف المُفاجئ الذي صَدَمَ طاقم الحرب بأسره، كان الطعنة المسمومة التي أنفذها في صدرِ الأمير، عبدُهُ الصقلبي ابن النجار.
فرغَ فردريك، الأخ غير الشقيق للأمير، من صلب العبد ثم سلخ جلده؛ إذ استعصى خلاصُ روحه ولم تَفِضْ على صليبه، فَتَّشوا حُجرته الواطئة فلم يجدوا فيها ما يثير ارتباط العبد بأمراء الإقطاعات البافارية المناوئة للأمير ألدوس، نُتَفٌ من الأوراق الممزقة عثروا فيها على خُطوط بالعربية، «جهادُ الخصيّ ثغورَ الرّوم» «مُشّوا بآذان النّعام المُصلّم»، تبدو كتدريبات على ألوان الطغراء أكثر منها دعوات ثأرية.
لم يكن ابن النجار يتقنُ العربية، بل ولا أيّة لغة أخرى سوى مفردات الطاعة يتمتمها بالسلافية العتيقة، كذلك كانوا يعتقدون خطأً. هو من الجيل الثاني أو الثالث المُتسرّب نحو أوروبا، بعد أن فقدَ قومُه الصقالبة كلّ حظوة في بلاطات الطوائف المسلمة جنوبيّ أوروبا المحررّة».
(1)
وَضَعَ جابر القلم، ليس كنايةً عن إنهاء كتابة روايته التاريخية التي ظلّت تُحرِّضُهُ على الرجوع المضني إلى كتب التراث، حتى جاء الفصل التراجيدي الأخير «مصرع الأمير ألدوس»، سَلِسَلاً دون عناء. كان جابر قد أخرج مسوّدات الحكاية المُعتّقة كما رسمها في خياله، إنها اللحظة التي انتظر، وأعدَّ كلّ شيء لها، النيلَ من السلالات النبيلة لعائلة الأمير، حفظَ الجغرافيا والتجارة التي أودت بالخصيّ بين البلاطات، الحروب كل الحروب بهزائمها وانتصاراتها، رسم صورة مبتكرة لمشهد الاغتيال، حاكه على الوتيرة الحشيشيّة التي تستهوي مُصمّمي ألعاب «الأسيسين كريد».
لم يكن ليجد نفسه بين أولئك الروائيين التاريخيين الذين لا يطعّمون الورق إلا بالورق، ورق الروايات بورق المراجع والكتب. أراد أن يكتب رواية فريدة وخارج التصنيف، لكنّه بدأ يدرك تأخره عن موعد الإنهاء، على الأقل وفقَ جدوله الخاص، وليس التزامات النشر. لم يقتنع بالمسافات الفارغة التي تركها في حياة أميره البطل، خشيَ أن تَدُلَّ على ضعف وتشكيك، في النهاية استسلم كليّاً لها -فكرةُ الفشل-.
رَتَّبَ المسوّدات في مكتبه، أغلقَ هاتفه، استأجرَ سيارة فيات حديثة من مكتب لتأجير السيارات، ثم تذكّر أنّ وقتاً مضى على المرات القليلة التي نجح فيها بقيادة السيارة. كان البحر بعيداً عن مكان إقامته في الريف الدمشقي، ولا يثقُ بأنّ ما تبقّى له من قدرات «سَوْقيّة» تمكّنه من قطع المسافة بين منزله، حيث أودَعَ المسوّدات، وبين بحر بيروت كمساحة للتنفّس الذي يحتاج.
أمام المصائف التي راحت تفرّخ في أحراش صنوبر السويداء، لم يبقَ مجالٌ للتفكير بالبحر، وبالرغم أنّ المسافة لم تكن بعيدة، لكنّها كطعنة الخصيّ، لم تكمل تقدّمَ جابر، ولا أميره البروسي، نحو راحتهم الواثقة، إذ تَمَكَّنت انعطافةُ عينِ المرج الجُرفيّة البسيطة من سيارته، أو بالأحرى من إمكانياته على القيادة.
دُقَّ عنقه كما رؤوس الميدوزات تحت وطأة السيارة العجينية المنتشلَة من قعر الوادي، التي ضمّت رُفاة روائيٍّ شاب، قيلَ «إنّه لو أتمّ روايته الرابعة لتخلّص من عزلته التي يكره، وتحرّر مادياً من مقرّ إقامته، بيت العائلة الذي أورثه إياه أبوه»، كذلك كتب أحد أصدقائه المقرّبين، في الذكرى السنوية على وفاة الروائي الشاب جابر شهاب (2011 – 2056).
طوى موتُ جابر موتَ الأمير ألدوس، لكنّ صراع أختيه على أملاكه أظهرَ أنها كثيرة بالنسبة لرجل يعيش أربعيناته بانطوائية عجيبة. سليم مثلاً، ابن أخته الكبرى والشاب العشريني الذي شاطره سكناه في منزل ريفي كبير، كان أول الأقارب المُنقضّين بلصوصية على أرصدة خبّأها الكاتب من بيع مسلسلين دراميين لقناة تلفزيونية مُحتكِرة. جاءت حياةُ كلّ منهما على النقيض، فلمّا وَضَعَت الكتابة جابر على مشارف نجومية سريعة سيحققها له التلفزيون، ظلت الحياة الشخصية للكاتب بريئة منعزلة، لا لأنه يمجّدُ العزلة أو يعتبرُها شرطاً إبداعياً، بل لأنه ورثَ شيئاً من بُخلِ والده الذي قوّض مشاريع صداقته مع ذكور تملّكته منهم خشيةٌ مريضة. كما ورثَ أيضاً نتانةً جسديةً لطالما نَفَّرت النساءَ منه، إذ صار جسده مُستَقَرّاً للفطريات وعانى من الصدفية في آخر أيامه، ولولا المسلسلات التي باعها، وما حققته له من بعض العلاقات العامة، ولولا أنّ منزله بطابقين واسعين، ما كان ابن أخته ليشعر بالاستقلالية والنظافة حتى يقاسمه حياته. فهذا الأخير، كان قد ألهمَ خاله ذاتَ مرةٍ نحتَ شخصية «إياد» بطل «المجموعة البربرية»، أولى المحاولات القصصية التي كتبها جابر متأثراً بتيار الحركة المستقبلية، التي سينقلب عليها سريعاً. كان سليم يمنّنُ خاله طويلاً بذلك الإلهام، إلا أنّ معاناته نشأت من حالة عجيبة تنتابُه، وَصَفَها بتواضعِ الوجودي الركيك، لخاله، ذاتَ غثيان:
«أنتَ تعلمُ أنّي تركتُ دراسة الطب في الجامعة، ليس لأنني فشلتُ في تجاوز السنة الأولى، بل هناك سببٌ أعمق، سببٌ طبّي لم يدركه والدي الدكتور، يا للمفارقة! بل إنه رَفَضَ الاكتراث به أساساً، وحدكَ أنتَ من وجدتَ فيه قناعة حقيقية. فأنا عندما أقرأُ عن الأمراض أشعرُ بأنني مصاب بها، وعندما كنتُ أتخلَّفُ عن تقديم الامتحانات، لم يكن ذلك لأنني أدّعي المرض، بل لأن الحقيقة كانت كذلك. كنتُ تقريباً في الثالثة عشر من عمري عندما انتابتني الحالة الأولى، مررتُ إلى العيادة وكان أبي يُنزِلُ عدداً من المجلات الطبيّة ليقرأها المرضى في غرف الانتظار، حينها شعرتُ وأنا أقرأُ مقالاً عن الرمد الربيعي بأنني أعاني عوارضه، وبقيتُ كذلك لمدّة يومين. حدّثتُ والدي وأختك بما أُحِسُّ فسَخِرا مني، وظلّا مُصرَّين على وراثتي المهنةَ إلى أن فشلتُ وطردتُ من الجامعة. لم أفشل فقط لأني أكره حياة أبويّ، بل بسبب الدودة، نعم إنها تفتكُ بقلبي كما تفتكُ الصدفيةُ بجلدك. بل إنّكَ آمنتَ بوجودها أكثر مني وحررتها من قفصي الصدري، أو ربّما لأنّ عدواها انتقلت لي من أحد الكتب التي استعرتُها من مكتبتك. ها أنا أردُّ لك جميلَ الإعارة لتطلق حالتي ذاتَ قدرةٍ بين أبطالك. أعلمُ أنّ روايتكَ قد فشلت، عكس الرواية المُضيفة التي نَقَلَت لي العدوى، فالديدان الطفيلية كما هو معلوم لا تنتقل مباشرة إنما تحتاج لمضيف ناجح كالخريطة والأرض لميشيل ويلبيك على ما أذكر، وسبَّبَت لكَ إحراجاً صحفياً: كيف يمكن لداء يصيب الكلاب كالدودة القلبية، أن ينتقل إلى البشر؟ وإن كان ذلك ممكناً فهل من المعقول أن مجرد القراءة عنها كفيلٌ بنقل العدوى؟ أنا لم أمت كبطل روايتك التجريبية تلك، أمّا أنت فوضعتَ حداً لإلهامي لكَ بأشياء أخرى غير أمراضي. بالتأكيد عندي أشياء مهمة غير الأمراض، أحدّثكَ عنها بعد أن تنهي روايتك عن الأمراء البروسيين، وتُنهي انقطاعكَ إلى التاريخ والحقائق بحثاً عن جمهور محترم من سويّة والدي وأناقته العلمية».
أثارَ مصرعُ الكاتب بهذه الصورة المأساوية الفزعَ وتأنيب الضمير على حدّ سواء بين عدّة أوساط سياسية وأدبية، إذ باشرت الصحف والمجلات بإعداد ملفاتها عنه، وكيف أنّه استطاع التوجّه إلى الظلّ الدمشقي والاشتغال فيه بالرغم من خلفيته العائلية الرفيعة كأحد القادمين من أوروبا الأضواء، وكونه ابناً لأحد اللاجئين القدامى فيها، فالأمر ليس مجرد إضاءة عادية. هذه الخلفية الثقافية التي ما كان جابر ليُسلِّمَ بتأبيدها أو استغلالها بطريقة مُستخِفَّة، ولو أنّه اتخذها عاملاً تأسيسياً في شخصيته ولغته.
بعدها قفزت التفسيرات البوليسية لمصرعه، كالحديث عن تورّطه بعلاقة مشبوهة مع شركة أمنية خاصّة يقيم صاحبها بالقرب من منطقة عين المرج. ظلّت هذه العلاقة مُلغزة لا يُعرف عنها الكثير، وما إذا كانت مباشرة بين الكاتب وصاحب الشركة الأمنية؟ أم علاقةً بين الكاتب وأخت صاحب الشركة، الذي ثأرَ منه بوغدٍ ريفيٍ متوقَّع؟ أم أنها بحكم الجائزة الأدبية التي قيل إن صاحب الشركة بصدد تمويلها للتغطية على صفقات السلاح التي يعقدها، لكنّ شيئاً مما سبق لم يتم التثبّتُ منه.
ولم يسلم في موته هذا من وَرَثَة لوردات الحرب وصحافييهم، الذين يتهمون زمانهم بالإملال، إذ تحسّر أحدهم باسم مُستعار على زمن الانعطافات الجرفيّة الجميل، عندما كانت تبيضُ (الانعطافات) تنانينَ الـ TNT، لتبلعَ قادةَ المليشيات لا الكُتّابَ المغمورين.
(2)
لم تكن «المجموعة البربرية» أولَ وآخرَ المحاولات المُستقبلية لجابر فحسب، فالمجموعة القصصية التي تتخيّل مكاناً دمشقياً يبتعد ثلاثين عاماً، إلّا سنة، عن زمن الكتابة الحقيقي، ويقاطعُ كاتبُها خمسَ عشرة قصّة داخل ثيمة واحدة هي «مئوية موت أم كلثوم»، هذه المجموعة ستكون آخر عمل أدبي في عموم سوريا طُبِعَ بآثار النزعة المستقبلية التي امتدّت هيمنتُها عربياً قرابة ثلاثة عقود، منذ أيام «عطارد»، الصادرة عن دار التنوير 2015، أي أيام ربيع الـ TNT العربي، إلى أواسط أربعينات الإملال.
أمّا قصص تلك المجموعة فقد حدثت في يوم واحد، بين أشخاص لا يعرفون بعضهم، سوى أنّهم أشخاص دمشقيون كُلٌّ منهم كان يستعدُّ لإحياء مئوية الست، بيدَ أنّ الموتَ المُفْجع يَحولُ دون أن يعدّوا للمئوية ما استطاعوا من قوة وطقس ورباط. لم تتوغّل الملامح المُستقبليّة في المجموعة، على غرار من غمرتهم موجة العقود الانحرافية، التي طبعت سائر الفنون المتعدّيةِ فنَّ الروايةِ الذي انطلقت منه. اعتمدت المجموعة القصصية على مفارقة صادمة، بين السلوكيات المدينية لأشخاصها والواقع الثقافي لاهتماماتهم من جهة، (حسبُنا هنا أن نرى خصوصية اليوم وإرهافه: مئوية الست)، وبين الموت المتوحش أو البربري الذي يقطع سلسلة الرتم اليومي العادي، بأمراض طفيلية كما يروق للمستقبليين الفعل عادة، أمراضٌ تقلب الروتين السلمي في حياة المدينة وتنقلها إلى زمن آخر، تكشف عنه القصّة الأخيرة «الصيد في الـ 86 ديسيبل» وبطلها إياد، القرين الروائي لواقع سليم المرضي المزعوم. كان إياد يصطادُ مستمعي الست على قلّتهم في ذلك الحين الدمشقي، ويعتبرهم مجرّد مهووسين ومرضى صاخبين، يلوثون بضوضائهم السويةَ السمعية، 85 ديسبيل، التي ينصحُ بها أطباء الأذن، لكنه لا يملك كثيراً من الوقت، إذ تشرّبت دودة قلب الكلب الطفيليّة، قَلبَهُ، وها هي تتوطّنُ سريعاً في رئتيه إشارةً إلى أنّ عدّاً تنازلياً بالأيام قد بدأ، وسينتهي بموته أيضاً.
خمسَ عشرة نهايةً كانت قد تركت كلُّ واحدة منها دمشق الوادعة على شفا الدمار والفجيعة، وكأنّما اليوم الذي أُريد له أن يتوِّجَ النقلة الحضارية في سلوكيّات الناس وتوجّهاتها، سينحرف ليُغيِّرَ وجهها الرائق إلى الأبد. وهنا بدت بدايات جابر قريبة من نُقاد الملل، أمّا نقلته نحو التاريخي فقد قرأتها صحافةُ اللوردات كتزييفِ تاريخٍ ذكوريٍ فعليٍ قريبٍ، بآخرَ مُستوردٍ بعيد.
الجرعة الأدرينالينيّة الثقيلة التي رسّمت حدود الشخصيات بالموت، لم تدفع «المجموعة البربرية» كثيراً في عالم القصّة. جاء واقع الاستقرار اليومي في دمشق ليطوّع سلوكيات الأدب، بدل أن يناقضه بكسر الإملال والرتابة؛ لذلك لم تعش الموجة المستقبلية بعد هذه المجموعة، ثم عادت السردات والسرديات التاريخية بمراجعها التفصيلية لتبدو أكثر شباباً في مواجهة حركة مستقبلية عتيقة ومكررة، تعود في جذورها إلى كهول الربيع العربي، فلا هي أنجزت أبوكاليبسيتها المُهدِّدة بحذافيرها -وربّما يكون جبنها عن هذه المناجزة هو ما أودى بها-، ولا هي كذا وكذا كما فصّلَ أكثرُ من داعٍ مستقبلي اندثروا بالتوازي مع اندثار مادتهم المنقودة، بيدَ أنّ أميزهم اندثاراً كان أنيس أسعدي… ليس مُهمّاً، فالموجةُ الشابة الآن هي موجة التوجّه نحو التاريخ، بل لنقل عَودات التاريخ كتيمةٍ كبرى مدفوعةٍ بجيلٍ مطمئنٍ أقلَّ قلقاً من سابقه، يرثُ البيوت الريفية الفخمة بمكتباتها التراثية الثقيلة، كما يرثُ المهن المحترمة كالطب، والأمراضَ كالصدفية، معاً، ولا يخشى إحراجاً يُلِمُّ به نتيجة هذا التقصير أو تلك العاهة. أيضاً ليس مُهمّاً طالما أنّ ريعاً مادياً ما زالت تعيش عليه البلاد السورية، وتقتاته طبقاتها البرجوازية بشكل دوري من عدّة دول مانحة، الريع الذي استحال إلى روتين أممي معتوه لا يتوقّف بالرغم من معارضته منذ بداياته الأولى أيام الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي محمّد بن عباس، اللذين برّرا معارضتهما لمشروع صندوق المانحين؛ باعتزال بشار الأسد اللعب العلني عام 2023 أي بعد عامين من نهاية ولايته الثالثة، أو ولاية الشوكة 2014 كما صارت تسمّى عند مواليه، تمييزاً لها عن ولايتيه الوراثية الأولى عن أبيه، والوراثية الثانية عن نفسه، أو الولايتين الشرعيتين، حسب الراحل أدونيس الذي ختم مَدارَاته الحياتية حول فتنة الربيع العربي بمقولة تراثية وجدتها الحداثة الأدونيسية شديدة المعاصرة «سُئِلَ طاووس (من فقهاء القرن الأول) عن عمر بن عبدالعزيز هل هو المهدي؟ فقال: هو مهديّ وليس به؛ إذ لم يستكمل العدلَ كلّه» (تاريخ أبو زرعة 1/572)، في تلميح نقدي لاذع لعدم استيفاء مستبدّه المنتخب تمام العدل.
على عجل وبعد سنة واحدة من «مجموعة بربرية» منقبضة على نفسها أواخر أربعينيات ألفيّة متهالكة، وجد جابر ذاته المثقفة والمطمئنة في التاريخ وحكاياته، التاريخ العائد هذه المرة بمضمون تحررّي يحتفي بالقوة المتمثّلة بأمراء الإقطاع الفيودالي الأوروبي وعساكره، امتداداً من قشتالة وأرغون جنوباً وانتهاء بحدود إمارة الموسكوب شمالاً، هذا الامتداد وإن عبَّرَ عن تفتيشٍ عميقٍ في تاريخ الآخر الأوروبي المُحتفى به أو المُشرَّح روائياً، على عكس موجات التراث الذاتي والتعميق الصوفي عند مدّاحي الشرقيات كأمين معلوف وإيليف شفق، بيد أنّه امتدادٌ يحمل انقساماً معرفياً سلطوياً بين خطّين روائيّين، فإذا كان الخط الأوّل ابناً لجيل من اللاجئين المندمجين في أوروبا الغربية، خاصّة ألمانيا، وجابر شهاب واحد من ممثّلي هذا التيار بحكم أنّ والده لاجئ سوري قديم في ألمانيا، فإنّ الخط الثاني هو امتداد جيلي بشكل أو بآخر لنواة العصبة الروسية التي تشكّلت إبان تأسيس قسم اللغة الروسية في جامعة دمشق عام 2015، والتي لم تتأخّر عن تحويل شعارات إيديولوجية صرفة إلى روايات رخيصة من قبيل «من فلاديمير إلى فلاديمير»، والمقصود بفلاديمير الأوّل هو أمير مملكة روس الذي اعتنق المسيحية في القرن العاشر الميلادي، فتنصَّرَت المملكة بأسرها بتنصُّرِه، أمّا فلاديمير الثاني فهو بوتين ما غيره، قيصر الأيديولوجيا الأوراسية التي نظّر لها ألكسندر دوغين، هذا الأخير الذي فضّل أن يحاضر مراراً في طهران على دمشق. وسيمرُّ وقتٌ طويلٌ قبل أن يتمكّن مترجمو هذا التيار من ترجمة الروائع الكلاسيكية مباشرة عن الروسية، لتتمّ إزاحة ترجمة سامي الدروبي وصيّاح الجهيم لأعمال تولستوي وديستوفسكي المنقولة عن لغة وسيطة كالفرنسية، بالرغم من أنّ هذا النقل المباشر ما كان ليُنجَزَ في جيل العصبة الروسية الأولى التي كانت تعاني أدبياً كثيراً أمام الهموم الترجمانية البيروقراطية التي أناطتها بها الحكومة، فاستحال الاختصاص عصيّاً في مُعدّله حتى على الطلاب المتفوّقين، مثله كمثل كليات الطب والهندسة. ومع هذه المواجهة الشرسة تمّ ترسيخ الرواية التاريخية واستقطاب تياراتها ذاتياً، وكلُّ ما وقعَ خارج هذه المواجهة ذهب أدراج النسيان، ومنه بطبيعة الحال بقية ذيل الضبّ المستقبلي أي «المجموعة البربرية».
(3)
نجحَ سليم بقليل من العناء في جمع العائلة، أمّه وأبيه من جهة، خالته وزوجها من جهة ثانية، في منزل اشتراه بعد ستة أشهر من وفاة خاله، في ضاحية دُمَّر التي ما زال وقعُ التوسّع السكني فيها على ما هو منذ مطلع الألفية. اعتبرَ سليم هذا المنزل أرضاً محايدة تفصل الشقاق الطويل بين أمّه وخالته الألمانيّتين في كلّ شيء إلا في حقدهما الشرقي الخبيث، واللتين درّبته كلّ منهما على تهذيبٍ وكبتٍ يتّفق مع استقرارٍ دمشقيٍ مديد، وبالطبع بالاتفاق أوّلاً مع وظيفة الزوجين اللذين بدورهما لا يخلوان من ثقافة طبيّة كالدكتور وعضو مجلس الشعب عن حزب الإرادة الشعبية عبد الغني عز الدين والد سليم، واسكندر زقاق الجن مدير مطار دمشق، زوج خالته، ووارثُ اسم جدّه كأعتق خريجي الميكانيكا في ألمانيا النادرة، أي ما قبل اللجوء السوري، وكدكتور أبدي في كلية الـ «هَمَك» لعهود الأسدين الأب والابن.
ولا تتقاطع بين عز الدين وزقاق الجن خطوط الثقافة والمناصب بقدر ما تتعارض، خاصّةً عندما قاد عبد الغني حملة تشهيرية قبل أعوام، من تحت قبة البرلمان وبلبوسٍ طبّي، اعتبر فيها أنّ مشروع مطار دمشق الجديد ليس نصبة جديدة فقط ممن وُلِدَ وبفمه ملعقة ذهب عن أبيه عن جدّه، بل هو خطرٌ حقيقيٌ يهدّد مسامع أهالي دمشق وريفها الذين لم يعتادوا تحويم الطائرات المدنية فوق رؤوسهم بكل هذا القرب، على ما فيه من صخب يتجاوز في حدوده القصوى لمحركاته 160 ديسيبل، الأمرُ الذي لا يليق بسمعةِ مدينةٍ حضاريةٍ ولا بصحةِ سُكّانها. آتت الحملة أُكُلها، واحتفت جريدة قاسيون بابن الحزب البار الذي يعلّقُ صورة للراحل قدري جميل في عيادته، وكادَ خصمه زقاق الجن أن يفقد منصبه، إذ صار همّه أن يبقى مديراً للمطار القديم على علّاته، مع أنّ إصرار قريبه وطموحاته كانت تؤكّد ضرورة محاكمته وإيداعه السجن.
أعدَّ سليم المائدة لعائلة الكاتب المتوفّى، لم تكن أمّه بطبيعة الحال لتحرص على مشاركته التنسيق، وجَّه إليها دعوة من خلال البريد الالكتروني حيث تدير أعمال مصانعها الدوائية في ألمانيا، بينما يستقرُّ زوجها وابنها في دمشق، التي وصلتها متأخرة بالنسبة لتجهيز نفسي حول دعوة احتفالية لما بعد حصر إرثٍ شقاقيٍّ بالضرورة، ونقاشات زوجية قد تستغرق أكثر من أسبوع، لكنها حضرت أخيراً وحرصت على أن تبدو وزوجها قائمين عليها من خلال الابن، بالرغم من أنّ هذا الأخير قد تفرَّدَ حقاً بالإعداد، إنما باستعانة كبيرة بفريق من الطّهاة العراقيين الذين يستعمرون مطابخ العائلات البرجوازية حسب نوع الدعوة والمطبخ المراد تحضيره لمدة يوم أو يومين، قبل أن يغادروه كالأشباح تاركين الثقة تجتاح المضيفين.
وهذا ما حصل فعلاً عندما أنهوا تعمير المائدة، التي كانت تنتظرُ العائلةَ بأطباق شديدة التقليدية وشتويّة ثقيلة، كالمغربيّة والكبّة السفرجلية الحلبية بوصفها وجبة أساسية تبدو غير مُستلّة من أحد مطاعم التجهيز القريبة، لكنَّ مسَّها محظورٌ بالاتفاق الضمني بين عناصر المائدة، مقابل الاهتمام بأطباق السمك المسكوف على الفحم التي يسهل تناولها مع صوص الشوفان، ودبس الرمان الذي يُطعِّمُ تشكيلات الخضار الريفي التي تؤكّد شرقية المائدة وخلوّها من أي لمزٍ غربيٍّ مُحتَمَل، في حين اضطر سليم للسفر بنفسه إلى تركيا حتى يجلب أنواعاً من عرق الراكي التركي أو البلقاني، مودعةً في مستودعات العائلة الطبية بمدينة إزمير، الراكي الذي يحبّذه والده مع الوجبات اللحومية الدسمة، ولا يسدُّ مسدّه في حال الدسم القليل إلا بيرة أفاميا التي تسيّدت سوق الجعة الخفيفة في سوريا بعد دمار معمل سلفها الصالح بردى قبل صدور عطارد بسنتين أو ثلاث.
في نهاية الأمر ظلَّ سليم يلمّ بمفضلات والديه نوعاً ما، من ناحية قوائم الطعام أو المشروبات، بالمقابل تعاملَ بحذرِ اليائسِ مع ذوق خالته وزوجها المجهولين بالنسبة له. لكنّ شيئاً مشتركاً كان سهل القسمة والاتفاق بين أفراد الدعوة الخمسة، فعلى وقع أغنية الحلم لأم كلثوم رحَّبَ سليم بضيوفه بلباقة محايدة، وبلزوجةِ الكائنات المحترمة التقطت العائلة أطراف الحديث دون وعورة تُذكَر. بحسرة ردّدت الأخت الكبرى، أنّ القَدَرَ قد خطف جابر وكانت تُمنّي النفس برؤيته في إجازة الصيف، ليذهب زوجها إلى أنّ جابر كان مهووساً بالستّ، بل إنّه أتقن العربية التي تعلّمها في ألمانيا من خلال أغنياتها، قبل أن يقاطع مديرُ المطارِ الطبيبَ بكلام عن مبدعين قضوا شباباً ثم انتقل بالحديث الرصين إلى سيد درويش، فشدّ اهتمام مستمعه إليه، وكأنّ عداوة بينهما تبدو غير موجودة.
تململ سليم لافتاً الانتباه إلى وجوده من خلال الست، التي تفضي بشكل من الأشكال إلى قرينه الروائي «إياد»، الذي لولا وحي سليم وحالته المرضية، دودة قلب الكلب، ما كان ليوجد. قَضَمَ الطبيبُ امتعاضه من طريقة لفت ابنه الانتباه، ثم عاجلَ ضيفه عن رأيه بمصير الأمير ألدوس، وما إذا كانت المسوّدات التي جمعها من المنزل الريفي، كافيةً للإجابة عن الملف الثقافي الذي سيصدره معهد غوته في سنوية جابر الأولى؟
انتهى امتحان الخصمين على العشاء، لكنّ أعتى مخيلات الانتقام في ذهن الطبيب وابنه، لم تكن لتشتغل بهذه السرعة ولا هذا النفاذ، فقبيل وصول مدير المطار إلى منزله تمّ اعتقاله وزوجته الألمانية السورية (سيطلق سراحها بعد أسبوع)، وفي اليوم التالي لم تستيقظ دمشق على وقع حملة تطهير ومكافحة فساد كما هو معتادٌ كمحطٍّ لكلام كلِّ رئيس جديد بعد نهاية الإرث الأسدي الثقيل، إنما هذه المرّة وجدت البلاد نفسها تحت سيطرة عسكرية أنهت الفراغ الرئاسي المستمر منذ قرابة خمسة أعوام. تمَّ في هذه الحركة التي قادها الجيش دكُّ الطاقم الحكومي في السجون، واستثناء أعضاء مجلس الشعب بداية الأمر. الرؤيويون ساسةً ومثقفين قالوا: «انقلاب وجيش»، هذه ليست صعبة عليهم، لكنّ الخبر الذي ظلّ عزيزاً على الجميع ولمدّة 24 ساعة: «أيّ جيش؟». في اليوم التالي أُعلِنَ البيان رقم واحد الذي تلاه الجنرال «فيليب خنسا» من مرتّبات الحرس الجمهوري اللبناني، وأوضحَ فيه أنّ التدخل في سوريا الشقيقة لم ولن يحمل في طيّاته أيّ نوع من الوصاية أو فرضٍ لقرار سياسي أو نزعٍ لسيادة، إنما يتأتّى من الحرص اللبناني على مصلحة الأمن القومي المشترك للبلدين، وعلى بُعدٍ واحدٍ من كلّ الأفرقاء.
بالفعل لم تبدو سمات الانحياز على الوصائيين اللبنانيين، خاصّةً عندما طالت اعتقالاتهم أعضاء مجلس الشعب بعد مرور شهر واحد من تدخّلهم المُجَدول بستّة أشهر فقط، وبذلك لم يَطُل الأمر كثيراً حتى التقى عضو مجلس الشعب بمدير المطار، في مُجمّع يلبغا الذي أعدّه الجيش اللبناني، المنتشر على كامل أراضي القطر السوري من عامودا شمالاً إلى القريّا جنوباً، ليكون سجناً لكبار الشخصيات. جاء اختيار المُجمّع على مرأى من الناس، وبذلك لم يُعتبر فصلُ النزلاء عن الخارج همّاً لدى الوصائيين، بقدر ما بدا شكلاً من أشكال التجريص العلني لهم أمام الشعب الذي خلّصه هذا التدخل من استعصاء سياسي طال أمده. ضخامة المُجمَّع وكثرة النزلاء، لم تُتِح للعديلين الالتقاءَ الفعلي سوى مرّة واحدة، ولمدة ساعتين فقط، حاول فيها اسكندر أن يستفهم من عبد أموراً تتعلق بخروج زوجته من البلد فقط، ولم يكونا لينحدرا بالكلام صوب استحضارات شعرية عن المقامات الاجتماعية المرموقة عندما يُنكَّلُ بها، ولا استحضارات حول مفهوم الدولة، لا حسب اللغة ولا حسب دورات ابن خلدون العمرانية وآماده، كما يحدثُ عادةً عندما تنحطّ طبقةٌ سياسيةٌ عن مناصبها. لكن بعد افتراقهما سريعاً وعدم التقائهما ثانية، ثم عزل كلّ منهما في قطاع من قطاعات المُجمَّع المتعددة، الذي يحوي غرفاً متواضعة ومعزولة بين النزلاء، أصبحَ اسكندر يُردِّدُ أغنية عتايقية «سبحان اللي جمعنا بغير ميعاد»، ترديداً أخذَ مع الزمن هيئة التعويذة الكلامية، التي إذا ما كُرِّرَت بعددٍ معينٍ قد تخرق جدران الواقع الثقيل، بيد أنّ شيئاً من ذلك ما كان ليؤمِن به حقَّ الإيمان سليلُ الإقطاعية العلمية لجدّه، ووريثُ إمارة الـ «هَمَكَ».
خاتمة
عندما دَخَلَ جابر مُحتَرَفيَّ الخاص بميكانيكا المعدات الطبية، لم يكن ذلك الفتى الحييَّ المتواضعَ في طلب احترافِ الصنعة، بقدر ما أخذ يفتِّشُ عن استثمارٍ فنّيٍ يمكن تحصيله من خلف المبولات الجلدية وأسرّة العجزة الالكترونية، لكنّه وقف طويلاً أمام فاترينة مخصصة لأنتيكات التعويضات الأذنية، أجهزة تقوية سمع، صوانات خارجية لمن عطّلتها لهم الحروب، منمنمة فلورنسية متخيّلة لفيزيولوجيا الأذن الوسطى.
لم يتأمّلها كثيراً، ثم انتزعَ قصاصة من مجلة علمية قديمة تحوي مقالاً حول تقنية tcaps التي طورتها مختبرات الملتري الأمريكية، وهي عبارةٌ عن سُدادات ذكيّة لا تقوم على تقنية العزل إنما تعتمد التصفية، وبالتالي يستطيع الجندي من خلالها سماع الأوامر الهامسة وصدَّ أصوات المدافع الراجمة في آن.
اعتقدتُ بدايةً أنّ مثل هذه الأنتيكات الميكانيكية هي ما يقوم عليها مشروع تخرجه كطالب في السنة الأخيرة من جامعته، وددتُ أن أشاطره التقاطته العسكرية النابهة، وأعرض عليه مجموعة نادرة من كواتم صوت لبنادق قنص أتوماتيكية، لكنّهُ باغتني وقطع بصيرتي عنه عندما ارتدى قفازات طبية على عجل، ثم شرع بفتح حقيبة صندوقية، وراح يتمتم مع نفسه قبل أن يرفع رأسه صوبي ويترك يديه غائصتين في أحشائها. خَشَّنَ صوته بالثقة، وقال: «هل تعلم سيد ألدوس؟ إنّ كلّ هذه الخردة لا تقدَّرُ عندي بفلس، إنّ مشروعي بسيط ولن أتعدّى فيه الإكسسوارات: مقدّمة حول تاريخ ثقب الأذن، الأقراط، (ثم أخرج يديه من الحقيبة الصندوقية عارضاً عيّنات جمعها من رحلة تنقيب قام بها لصالح جامعة ملكية على حواف بحيرة الملح في تركيا، عاد بعدها بما اعتبره ثروة تعادل عشرة من مختبراتي)، ثم وضع ورقتين على الطاولة وصرخ: ها هو «ديوان الصلم»، مقاربة لغوية عربية-ألمانية، متخصصٌ بالشواهد والأفعال ذات الصلة المباشرة بالأذن، من السماع إلى الإصاخة إلى التشنيف». لكنّه اختار عنواناً هو فعلٌ من طراز «عاقب وأدّب»، تغيب فيه الأذن كلياً.
كدتُ أنفجرُ ضحكاً، كيف لإنسان عاقل أن يعدّ هذه الأوراق القليلة ديواناً؟! لم أُطِل ضحكي حتى لا أحرجه، بيد أنّه لم ينتظر فعل اللباقة مني، بل قطعه بجدّية عندما تابع بسط مواد مشروعه. تركَ آخرَ مادةٍ أمام عيني المفزوعتين دهشةً، إنّها جمجمة أو كما عرّفها وهو متمدد على أحد أسرّة العجزة، إنها جمجمة رطبة لمغنّية مشهورة لم تمت منذ قرون أحفورية بل في القرن الماضي وحسب، أمّا أقراط بحيرة الملح فستكون توطئةً مُقارِنَة للدخول في موضوعنا الأساسي، ألا وهو أقراط سيدة الجمجمة الرطبة، لم يدعني أخمّن كثيراً من تكون؟ ولم يكرر زيارته لي.
سمعتُ بعد فترة قصيرة جدّاً أنّه تخلى عن مشروعه وباعه لفتاة كرواتية من الاختصاص ذاته، بمقدارٍ يؤمِّنُ له تذكرة طائرة، ثم سافر بعدها إلى دمشق منكسرَ الأحلام حول ترميم الطب بالفن، وتطعيم الثاني بالأوّل. انصرفَ إلى كتابة الروايات والقصص القصيرة، وفاجأني بأنّه عاد ليراسلني منذ مدّة ويسأل أسئلة غير دقيقة حول المهنة، ما كان ليسألها ذلك الشاب العنجهي لو أنّه أكملَ دراسته الجامعية.
مع ذلك، لم أتوقّع أن يقطع الموت مراسلاته الطارئة، ولا أن أكون أنا موضوعاً ميّتاً لآخر رواية كتبها هناك في بلده البعيد، ولولا تلك الأسباب، ما كنتُ لأجدَ ضرورةً في مشقّة الحياة لبعثِ الروحِ مجدداً في اسمِ ألدوس، أو الحديث عن نفسي، أنا ابنُ أهرنبرغ.