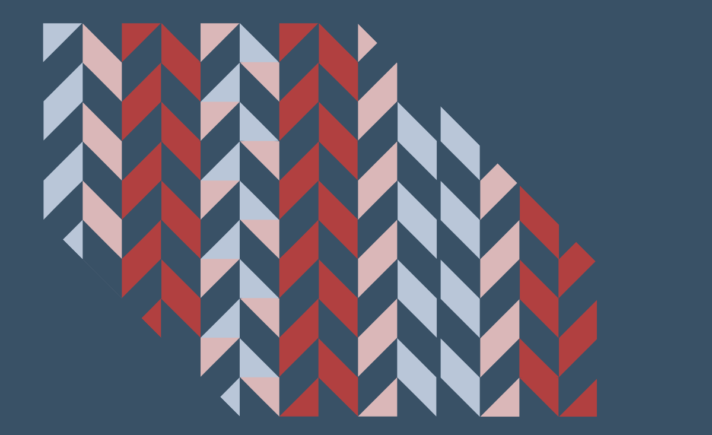أن تحيا اليوم في نصف مدينة، أن تعيشَ مذهولاً بين الموت والحياة، بين دمشق النظام ودمشق التي يحاصرها النظام، سيعني أن يعتريكَ إحساسٌ غامرٌ بالذنب لكونكَ سالماً وصامتاً رغماً عنك في ظلِّ استحالة الحركة واستحالة الفعل. أنتَ عاملٌ غير مؤثر هنا، وجودكَ وعدمه واحد.
الخيار المُتَّبَعُ بين أغلب الشباب المتواجدين اليوم في الداخل السوري، هو أن يعيشوا إنسانيتهم المقتولة بأي طريقة مُتاحة أمامهم، وهكذا استطاعت مساحةُ عيش الإنسانية المؤطرة بسياسة المنظمات على تنوعها وكثافتها، احتواءَ عددٍ كبيرٍ جداً من هؤلاء الشباب من مختلف الشرائح والاتجاهات.
أن تعيش في دمشق اليوم
عليك أن تفقدَ حواسَّكَ في دمشق. لا حاجة لها ها هنا، إذ سيغدو العالم هو نصف المدينة هذه، الآمنة نسبياً، فقط، وكأن لا شيء خارج حدودها. في نصف المدينة الميتة هذه، تستطيع التجوّل والسهر والدراسة والعمل، وحضور الحفلات والمسرح، والغناء في الطرقات، وتكوين صداقات وتربية حيوانٍ أليف. إنها نصف مدينة تُقدِّمُ كافة خيارات الحياة الطبيعية.
عَيشُ المفارقة
العيشُ وسط فوضى الوضع السوري خلقَ أساليب جديدة، استطاع بواسطتها كثيرٌ من الشباب السوريين تغيير شكل حياتهم. هذه الأساليب جمعت بين العمل الإنساني والعمل المادي والنشاطات الثقافية والفنية وغيرها، إذ لم يعد العمل الفني حكراً على أهله، ولم تعد تقسيمات أساليب الحياة وفقَ الإمكانيات المادية في دمشق أو حمص وغيرهما كما كانت عليه من قبل، فابن الشريحة المتوسطة قد يستطيعُ السهر اليوم في خمارات لم يكن يستطيع دخولها قبلاً، وأيضاً ممارسة التسوق من «الماركات»، وغيرها من الأمور التي كانت تُعَدُّ رفاهيات مقتصرة على أبناء شرائح أخرى.
أبناء جميع الشرائح الاجتماعية المختلفة من الشباب، أصبحَ اليوم بإمكانهم العمل في مجال تنمية المجتمع، وأصبحَ بإمكانهم الإحساس بدورهم في صناعة الواقع. إذ وفقَ شروط واعتبارات تتفاوت في درجاتها، قد يتمكن الشاب السوري اليوم من الخروج من إطار الحدود السابقة التي كانت تعزل قطاعات العمل الاجتماعي عن بعضها بعضاً، حتى أصبح من المتاح الدخول في عوالم كانت مغلقة على ذاتها سابقاً، ومحددةً بأنساقٍ اجتماعية معينة، كشريحة الفنانين مثلاً. وأصبحَ من المتاح أيضاً تحقيق نتاج مادي جيد نسبياً ضمن مجالات عمل جديدة.
المنظمات على مختلف تسمياتها وأنواعها وارتباطاتها، هي التي فتحت هذه الأبواب أو ساهمت في فتحها، ومنها منظمات دولية، ومنظمات شبه حكومية، ومنظمات تابعة لأخرى خارج البلاد، أصبحَ عددها كبيراً ويتزايد باستمرار، فأي مبادرة أهلية بإمكانها أن تندرج تحت رعاية إحدى المنظمات الكبرى.
لم تعد المنظمات مجرد رديفٍ لمؤسسات الدولة أو مكمّلٍ لها في مجالات العمل الاجتماعي والفني والتنموي، بل إن دور المؤسسات الحكومية هو الذي غدا ثانوياً اليوم في هذه المجالات. وتعملُ المنظمات التي عُنيِت بالجانب التنموي، إلى جانب منظمات أخرى حافظت على قوامها وأهدافها الإغاثية كالصليب والهلال الأحمر، التي يتطوع فيها الشباب كذلك.
من الضرورةِ قصيرةِ الأمد، إلى التنمية
في البدء كان كل شيء عفوياً، فالضرورة الأخلاقية، إلى جانب اليأس جراء القبضة الأمنية المحكمة في دمشق وغيرها من مناطق سيطرة النظام، جعلت الشباب المنحازين للثورة يتوجهون للعمل الإغاثي، الذي كان أكثر أماناً، وكان ضرورةً أيضاً، إذ أن جهود منظمات الإغاثة لم تكن كافية، فتشكّلت لجانٌ محليةٌ للعمل الإغاثي والإنساني بالاعتماد على جهود فردية للشباب، وكانت تطوعيةً بشكل كامل.
كانت تلك المبادرات تساعد على إيواء النازحين، وتعمل بشكل سرّيٍ ضمن ظروفٍ صعبة، لإيصال المساعدات إلى بعض المناطق التي تشهد تصعيداً عسكرياً. وبعد فترة وجيزة، وفي تحوّل سريع ومغافلٍ لم أنتبه له لحظتها، أخذت هذه اللجان تندرج ضمن مبادرات ترعاها المنظمات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة بجانب عملها التنموي والإغاثي، أو دائرة العلاقات المسكونية، وغيرها. وبطبيعة الحال، لم يكن استكمال العمل ممكناً بالجهود الفردية فقط، وأُتيحت المساعدة عن طريق منظمات وجمعيات وفّرت الأماكن أو التمويل، وأمَّنَت حمايةً وخصوصيةً لهذا النوع من الأعمال التي أصبحت تندرج ضمن سياق أهداف ونشاط المؤسسة الراعية، وهو نشاطٌ محميٌ ومستقلٌّ عن الدولة.
بهذا الوصف البسيط انتقلنا إلى ما نشهده اليوم، أسلوبُ الحياة اليومية أصبح يحاكي نشاطات المبادرات وأعمال المنظمات التي تفرض نفسها بشكل تدريجي، وصولاً إلى الهيمنة الكلية.
استوقفتني خيارات العمل في عدّة مراحل، التي كانت تنقسم سابقاً بين العمل حكومي، أو العمل الحر في القطاع الخاص الخدمي والصناعي والتجاري. وبالنسبة لطلاب الجامعات، كانت وظيفة الدولة هي الخيار الذي يتوافق ولو قليلاً مع دراستهم، أما اليوم فخيارات عملهم إما أن تندرج تحت غطاء المنظمات، أو تحت رحمة مؤسسات الدولة، والخيار الثاني هو الأصعب، وهو شبه مغيبٍ اليوم عن الجيل الشاب، إذ حافظَ كادرُ موظفي الدولة على قوامه المؤلف من آباء الجيل الحالي، فللتوظيف ضمن دوائر الدولة عليك الدخول بعدة مسابقات وتقديم طلبات توظيف، إضافة لضرورة أن تكون متخرجاً في أغلب الحالات. إلى جانب أن راتب الدولة حافظ على ثباته، ولم يحظَ إلا بعدة زيادات تكاد تكون شكلية، فهو لا يمكن أن يكفي لحياة أسرة سوريّة.
التقيتُ بـ «رنا» ضمن نشاطٍ في منطقة جرمانا، النشاط يعرض رسوم مجموعة من الأطفال النازحين، إضافةً إلى عرض مسرحي لأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكانت «رنا» هي المشرفة على العرض، وهي شابة في السابعة والعشرين، متخرجة من كلية التربية وموظفة في مركز تطوير وتحديث المناهج.
تتحدّثُ عن عملها الثابت الحكومي وتصفه: «العمل في المركز كالعيش مع أعدائك، الجميع يطمح لتحسين علاقته بمدير المركز ليكسب دخلاً إضافياً، ولا أحد يحاول أن يكون منطقياً للحظة، وخاصة بعد فضيحة المناهج الجديدة المليئة بالأخطاء. لا أحد يسعى إلى حلّ، لدينا الخبرات ولكن الشخصانية تبقى في المرتبة الأولى».
وبالحديث مع «رنا» عن عملها الإضافي، وهو مسؤولة أنشطة ثقافية في مبادرة محليّة ضمن دمشق، تقول: «أعملُ في مركز تطوير المناهج ستة أيام في الأسبوع مع راتب 30 ألف ليرة سوريّة، بينما هنا أُدرِّبُ الأطفال لمدة يومين أو ثلاثة، وأجني 60 ألفاً. في العملين توجد اعتباراتٌ شخصية، لكن الشخصانية في العمل الحكومية أصبحت مملة وسقيمة وغير قابلة للتغيير، فهي ذاتها القوالب القديمة ولا يمكن اختراقها، بينما في العمل الحرّ، يمكن أن تتراجع الاعتبارات الشخصية أمام أمور أخرى، كالوقت المبذول والمحبة والصداقة بينك وبين القائمين على العمل، إضافة لحداثة العمل فيها وإمكانية تأسيس روابط جديدة».
التنميةُ البشرية من أولويات خطة عمل العديد من المنظمات الدولية في برامجها لمعالجة الكوارث، وهو الخط الذي سارت عليه المنظمات المحليّة التي تشرف عليها وترعاها أسماء الأسد ومن أهمّها: الأمانة السورية للتنمية الاجتماعية، والجمعية السورية للتنمية.
وما يميّزُ عملَ المنظمات الدولية عن تلك المحليّة، هو وجود خطط طويلة المدى حول مفاهيم المواطنة والدولة المدنية، وهاتان النقطتان كانتا شبه مغيبتين عن المنظمات المحليّة، إضافة إلى وجود تمويل مادي أكبر، ما يجعل الجمعيات والمنظمات المحليّة تعتمدُ على تلك الدوليّة في جزءٍ كبيرٍ من التمويل.
المشاريع التنموية، وخاصة في جانبها الفني، هي مشاريع طويلة الأمد تعتمد على برامج من فعاليات لحظيّة، ولكن الهدف كما يقول أصحابها هو التأثير طويل المدى في المجتمع السوري، إضافة الى إيصال صورةٍ أو رسالةٍ عن الحياة في سوريا اليوم.
صورة الفن والحياة في سوريا
كان اللافتُ بالنسبة لي هو هذا الاعتمادُ الكبير على الجانب الفني ضمن خطة عمل أي مبادرة، الذي وَلَّدَ نتاجاً فنياً جديداً يتصدر النتاج الفني السوري ككل. وبشكل أدقّ، كان ما يثير أي متلقٍ للعمل هو القيمة الفنية للنتاج الفني التي تؤسس له وتراعاه المنظمات الدولية والمنظمات والمؤسسات المحليّة.
كنتُ أظنُّ سابقاً أن الفنان يُصاب بصدمة إزاء اضطراب الأوضاع وتدهورها، لكن الواقع هنا خلقَ شريحة فنية جديدة، تُنتج فناً بشكل يومي ومتسارع وعشوائي، ولم يعد بالإمكان تمييز النتاج الأكاديمي عن النتاج الإبداعي وعن نتاج الهواة. سوريا اليوم، هي ساحة لدخول لعبة الفن. لقد غدا الفن لعبةً في الحقيقة، ولهذه اللعبة قواعدها وظروفها الخاصة والحسّاسة، ولها روادها الذين يتزايدون ويفرضون قواعد جديدة.
العديد من التجمعات الشبابية والمبادرات القائمة على أساس الفن، نشأت وتشكلت في دمشق، وتابعت لاحقاً نشاطها وصولاً إلى محافظات أخرى. وتختلفُ النشاطات الفنية المرعية من قبل المنظمات، فمنها «نشاطات فنية إغاثية» تُعنى بالنازحين وتهتمّ بتصدير صورة عن الحياة ما بعد النزوح، تعتمد على الأطفال بمجملها. ومنها معارض الرسم وكورالات الغناء للأطفال في مدارس الإيواء. هذه النشاطات تكون متعددة ومكثفة ودورية، وتُتوَّجُ بنشاط عام تشترك فيه الجمعية الراعية مع منظمة دولية لإقامة حفل أو تكريم وغيره، كرفع أكبر علم للسلام فوق حي مُدَمَّر في مدينة حمص، يرفعه أطفال الحي ويشاركون رسومهم ومواهبهم إلى جانب بعض المتطوعين، الذين يقومون بعرض مسرحي تفاعلي، وحفل موسيقي قام به شباب الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية، وتحت رعاية من الأمم المتحدة.
أتساءلُ أغلبَ الأحيان: ما الجدوى من هذه النشاطات؟ ما الفائدة من جعل الطفل النازح يرسم ويغني فوق دمار بيته. أتذكّرُ اليوم أول نشاط من هذا النوع شهدتُهُ بالصدفة، وكان بعد دخول قوات النظام إلى بلدة الحصن بريف حمص، عندما دخل متطوعو الجمعية السورية للتنمية للقيام بمبادرة فنية.
تم تجميع أطفال القرية، الذين لم ينزحوا جراء المعارك، فوق خراب بيوتهم، والرسم أمامهم على الطريق دون مشاركتهم. كان الفصل صيفاً، وأغلبُ أطفال المنطقة يعملون في تكسير وجمع الجوز الذي صبغَ أصابهم باللون الأسود. أغلبهم لم يمارس الرسم من قبل، ولم يكن مسموحاً في هذا النشاط بمشاركة الأطفال لصعوبة ضبطهم، ولكن إحدى الفتيات الصغيرات تسللت وبللت يديها بالألوان، وعادت مبتهجة وهي تقول إنه أجمل من لون الجوز، فتلقَّت صفعات متعددة من فتاة بعمر الخامسة عشر وهي ابنة خالتها، التي كانت تدخن وتتأمل الوفود التي تزور مدينتها وكأنهم من عالم آخر. أما المتطوعون فقد تعاملوا مع الأطفال بوصفهم وسيلة، فلم يتمَّ الحديثُ أو التعاملُ معهم، بل تمّ صَفّهم وعدم السماح لهم بالمشاركة، وفي النهاية طُلِبَ منهم الابتسام لالتقاط صورة إلى جانب الرسوم.
تقول سحر، الفتاة الكبيرة: «شو رح يصير بعد ما يرسموا؟ بدي أهرب وصير متلن لو ما عم أستنى أمي ترجع»، وتشير بيدها نحو شباب الجمعية. أم سحر مختفية بعد أن اعتُقِلَت في سجن حمص منذ 2012.
أما النمط الثاني الذي ترعاه المنظمات من النشاطات ذات الطبيعة الفنية، فهو يقوم على تمويل ومساعدة فرق شبابية، كوسيلة لإيصال صوتها وممارسة نشاطاتها.
لماذا الفن إذن؟
«كان الفن وسيلتنا لنحافظ على جزء من الحضارة المتبقية فينا»، هكذا يجيب رامي، وهو شابٌ يعزف في إحدى الفرق الشبابية التي تأسست خلال عام 2014، وكانت تقيم عروضها في المقاهي بجهود شباب يدرّس بعضهم الموسيقا. توجَّه أعضاء الفرقة لاحقاً للمشاركة في مبادرات تنظمها الأمم المتحدة ضمن برنامجها الثقافي، وأصبحَ برنامجهم أوسع، وهكذا بعد بدايةٍ اعتمدت على خصوصية الموسيقا وابتداع أنماط جديدة عبر العزف الالكتروني مع الغناء الشرقي وغيره، أصبحت هذه الفِرَقُ تُقدِّمُ إلى جانب هذا خطاباً ثقافياً اجتماعياً بواسطة الموسيقا أولاً كما يقول أفرادها.
كانت حاجتهم إلى الرعاية أساسيةً، فاليوم أصبح بإمكانهم الحصول على تسهيلات وتراخيص أمنية، إضافة إلى أن برنامجهم أصبح واضحَ المعالم أكثر، وأصبحَ بإمكانهم الحصول على مِنَحٍ إنتاجية، كما يقول أعضاء الفرقة.
طرحتُ السؤال ذاته لاحقاً على مؤسِّسَة مبادرةٍ فنية واسعة المحاور، انطلقت بهدف تقديم فنٍّ متعدد الجوانب لمختلف الشرائح الاجتماعية، انطلاقاً من فكرة تقديم معرض يحتوي أعمالاً تحت عنوان «للإنسانية»، تتنوع بين الموسيقا والفوتوغراف والنحت وإعادة التدوير والكولاج وغيرها. يقوم عتاد المبادرة على جهود جماعية، ولكن تديرها وتنظمها فتاةٌ حصلت على الرعاية والتصريحات الأمنية، بعد جهود طويلة وتَدَرُّجٍ في العمل التطوعي.
حول سبب اختيارها دمشق لتقيم فيها مشروعها دوناً عن محافظات أخرى تقول ريم: «وَجدتُ في دمشق مساحةً أوسع للخصوصية لا تتواجد في محافظة أخرى، ونحن بحاجة للخصوصية، إذ لا يمكن أن نقيم عرضاً راقصاً على سبيل المثال في شارع في حمص أو حماة، فهذا سيسبب استنكاراً من قبل المواطنين. دمشق وَفَّرَت لنا مساحة من الحرية».
اعتمدت المبادرة على الجهود الجماعية لمجموعة مختلفة من الشباب، منهم الأكاديميون ومنهم الهواة، وتم تقديم نشاطات المبادرة في باب شرقي، «الحي الدمشقي الذي كان سابقاً يستقطب السياح، والذي يحوي في أزقته عدة غاليريات فنية. وقد شهد الحيُّ نقلةً كبيرةً في السنوات الأخيرة، فهو اليوم ملجأ أي شاب طلباً للسهر أو الألفة. يعجّ الحيّ بالشباب الباقين، فهو مكان للموسيقى والصخب بحديقته ومقاهيه باراته التي فتحت أبوابها على الشارع، والتي تتكاثر يومياً، ليصبح شارعاً لا تتوقف الحياة فيه. هو ما تبقى لنا من سوريا، ففيه ودَّعنا أحبتنا، وفيه خلقنا ذكريات مشتركة، وفيه نشعر بما تبقى من حياة». هكذا وَصَفَ شباب المبادرة الحي بعاطفة كبيرة تغلّف وصفهم له وتَعلُّقَهم به.
هذا الحيّ، الذي أنعشه الشباب المتبقي، هو نقطة استقطاب هذه المبادرات. وبنظرة أخرى للموضوع، وعند الحديث مع عدد من المتطوعين ومع مسؤولة المبادرة عن نتاج مبادرتهم ورضاهم عنه، كان هنالك تباين واضح في الأجوبة، فأغلبُ المتطوعين ضمن المبادرة يُقيّمون مشاركتهم فيها باستياء، فهي لم تحقق أهدافها التي كانت مرجوة، إذ لم يصل التمويل للشباب، ولم يتم تعويض المواد المُستَخدَمَة، كما لم يحققوا أرباح بيع. وبالنسبة للبعض الآخر كانت المبادرة وسيلة لإيصال نتاجهم الفني للعلن، إضافة للشعور بتفاوت المستوى الادائي بين الاحترافيين والهواة.
ركّزت مسؤولة المبادرة، خلال الحديث معها، على نقاط أساسية يكررها العديد من أصحاب المبادرات، وهي الهدف اللاربحي أولاً، أما ثانياً فهي خطوة كمساهمة في تأسيس وترسيخ مفاهيم المجتمع المدني أو مفهوم المواطنة، وبشكل عملي، المبادرة كانت تجسيداً لطموحات المسؤولة، واستطاعت إثبات نفسها ضمن سياق العمل المنظماتي، مما ساعدها على العمل مع المنظمات بصورة ثابتة.
المبادرة مُقدمة في حيٍّ رواده هم شريحة واحدة ذات سمات مشتركة، ولا أعتقدُ أن هنالك حاجة لتقديم الفن مراراً وتكراراً لهم لخلق حركة مدنية، فلو أقيمت مبادرة كهذه في حي دمشقي آخر، أو في ضاحية من ضواحي دمشق، لاصطدمت بالواقع، وهذا ما حصل فعلاً عندما انتقلت النشاطات إلى مدينة حمص.
تختلفُ حمص عن دمشق في عدم وجود حيٍّ كباب شرقي فيها، وعدم وجود مساحات للنشاط الشبابي، وهكذا فإن المبادرة التي كانت تقيمُ نشاطاتها في دمشق بشكل متسارع، لم تستطع أن تقيم نشاطها في حمص إلا بعد أكثر من ثماني أشهر، وعندما أقيمَ في الشارع سبَّبَ صدمةً لدى المتلقي، الذي شاهد مجموعة من الفتيان والشابات الذين يعزفون ويغنون في حمص للمرة الأولى ربما.
إشكالية المبادرات ليس في محتواها، وبالطبع لا يمكن تقييم محتوى فني لمبادرة تعترف بذاتها أنها حالة تجريبية، ولكن الإشكالية في الأهداف الموضوعة والمسميات الكبرى، إذ غدا هنالك تقييمات جديدة للفن والممارسة الفنية، وهذه التقييمات تزعج الأكاديميين. يقول خريج فنون جميلة: «ما فائدةُ أن أعمل على معرض خاص بي؟! أولاً سأواجه صعوبات في كيفية حصولي على موافقة، أو سأضطر للمشاركة في المعارض السنوية كمعرض الربيع والخريف، وكلنا نعرف أن مستوى الأداء هو أداء طلاب مبتدئين أو هواة. الجميع اليوم بإمكانهم الرسم والنحت، ولم يعد هذا حكراً على الأكاديمي. أستطيعُ المشاركة ضمن مبادرة، ولكني لا أستطيعُ أن أتلقى تعليمات من شخص لا يُعنى بالفن لمجرد أنه مدير المبادرة، ولا أستطيعُ تقييد عملي. لهذا لن أعمل اليوم في سوريا».
لطالما واجه الفن في بلادنا إشكاليات عدة، منها إشكاليات الأصالة والهوية، وإشكالية الارتباط المباشر بالسياسة والإيديولوجيا. وإذا كان كلُّ عمل فني يحمل في مضمونه قيمةً مولِّدَةً للجمال، تجعله يُدرَكُ في ذاته ولذاته بوصفه وحدة متكاملةً وليس أداةً، فإن هذه الوظيفة الجمالية العليا لا تستطيع أن تمنعَ تشكل تيارات تصنع فناً موجهاً ذا وظيفة محددة، تندرج ضمنه أنواع متعددة من الفنون لخدمة الوظيفة ذاتها. وفي سوريا اليوم، ومع كثافة الفن المرعي من قبل المنظمات، صار الفنّ أداةً يتم تكرارها مراراً، ويُعاد إنتاجها بأشكال مختلفة، ناقلةً الخطاب الموجه ذاته، ما جعل الفن يفقد ألقه، لتصبح كثافة وجوده أشبه بهالة ترسم فكر وخطاب المرحلة الفني، وهذا ما نشهده اليوم تحت عنوان: «خطاب الازمة السورية».
تمَّ تسليعُ وتحويل الألق الفني إلى أدوات لنقل خطابات متعددة المصادر، خطابات ترسم صورة سوريا عالمياً، تستقي من التراث وتعيد صياغته وتلوينه، وتنادي بحقوق المرأة والأطفال والمتشردين وغيرها. ورغم تعدد أشكال الخطاب، إلّا أنها تحمل في ذاتها الرؤية والأنماط الثقافية والفكرية نفسها، التي جعلت النمط الواحد سائداً في الفن المقدم اليوم من قبل المنظمات بمختلفِ أشكالها. وهذا ليس مقتصراً على سوريا اليوم، فمفهوم الفن العالمي والفن الموجه متواجدٌ دوماً، ولطالما عُنيت المنظمات برعاية الجانب الفني، ولكنّ اللافت في سوريا هو الإقبال المتزايد على كل الجوانب الفنية، حتى انها غدت أشبه بسلعة للاستهلاك. قد تسمع في دمشق عبارات تدلّ على سأم أحدهم من التصوير الفوتوغرافي، وانتقاله للنحت مثلاً.
كونت هذه الأفكار هالةً حول الفن السوري، وشروطاً لـ «فنّ الأزمة»، أسَّسَت لتصديق أهمية وفائدة النتاج الفني المرعي من قبل المنظمات، وكانت العواملُ الأكثر دفعاً ليكون فنُّ المنظمات هو الفنُّ الأول اليوم في سوريا: اللذة الجمالية، ومتعة تعميم المشاركة في اللعبة الفنية، التي تحتاج اليوم لمجهود ضئيل مقارنةً بما كان عليه الحال سابقاً.
أبواب الورشات التدريبة على مختلف أنواع الفنون، ومع مدربين وخبراء، مفتوحةٌ دوماً أمام الشباب، ولكن على المتقدِّمِ أن يكون مستعداً مسبقاً لمقابلة تدرس وضعه وفكره، وتنتظر منه أن ينطق ببعض الأفكار والجمل التي تستسيغها ذائقة القائمين عليها، وهذا ما جربتُهُ بنفسي إذ قمتُ بالتسجيل لدورة تدريبية في المسرح التفاعلي، وذهبتُ إلى المقابلة ومعي ستة آخرون تعرّفتُ إليهم هناك. كانت المقابلة جماعية، وكانت الأسئلة تدور غالباً حول الأهداف والأحلام التي ينوي الشباب القيام بها إذا قاموا بتجربة تفاعلية في المسرح. تقومُ اللجنة بدراسة قابلية المتقدمين للإيمان بجدوى ما يفعلونه وأثره على أرض الواقع، وكانت إجابات الشباب تتضمن أسماء جمعيات ومبادرات أهلية يسعون لاكتساب خبرة عملية ليقوموا لاحقاً بتقديمها عبرها، وكلَّ ما زادَ عددُ الأسماء المذكورة، كلَّ ما توسعت ابتسامة الشخص الذي يجري المقابلة. لم تتضمن المقابلة أي شيء يخصّ المسرح كخيار، وكان جوابي حول ما أرغبُ القيام به بعد مشاركتي في الدورة، هو أنني أكتفي بحبّ المسرح وحبّ التجربة، ولا يمكنني الجزم إن كنتُ سأعملُ على نشرها أم لا. طبعاً قوبلتُ بالرفض.
النمط الثالث من أنماط رعاية الفن الذي نشهده على أرض الواقع، هو التمويلات والمِنَح الإنتاجية، التي تكون غالباً من مصدرٍ خارج البلاد، من مؤسسات ثقافية تُعنى بالفن خاصةً، لها منهجية أكثر تعقيداً وأكاديمية، وتتوجه لشرائح النخبة المُمارِسة للفن، وتتنوع ببرامجها بين مِنحٍ للكتابة وأخرى للمسرح أو الموسيقا.
التعامل معها يكون أكثر فردانية وخصوصية، فهي تتطلب من المتقدم مستوىً معين من الاحترافية، إلى جانب موضوعٍ فنيٍ بعناصره، ولكنه يتطرق بشكل مباشر أو غير مباشر للواقع السوري. وهي كذلك بحاجة إلى خطاب معين وسياسة معينة في تدوين طلب المنحة، وبالحديث مع أحد الحائزين على منحة للكتابة، يقول علاء: «المرة الأولى تكون الأصعب دائماً، ولكن متى أدركنا آلية التعامل مع الجهة الممولة وآلية توجهاتها نعرف كيف نكسب المنحة. أنا الآن أترقَّبُ منحة بحثية جديدة، وأسعى للحصول على منحة ورشة مسرحية. علينا استقاء كل شيء من الواقع».
الدخيل
لم أستطع الانخراط في أي عملٍ اندرجَ بشكل جزئي أو كلي تحت رعاية المنظمات، ولا أشعرُ بالندم اليوم بعد أن شاهدت كثيراً من نتاج هذا العمل، بل إن الشعور الذي يعتريني ويعتري أمثالي هو الاغتراب، فأعينُ الناس تراقب دوماً هؤلاء الذين لا ينخرطون في سياق الحياة اليومية الروتينية، وترمقهم بنظرات قاسية تعزلنا عن سياق الحياة هذه، فنغدو مُرَاقَبين مزعجين وغير فاعلين، وسط زخم وفوضى الحياة التي خلقها العمل التطوعي.
يبدأ الإقصاء الحاد من يوميات السوري هنا بسؤال: «لماذا لم تسافر؟»، إذ يبدو أنه من المحتمّ عليكَ السفر أو الانخراط في ما بات يسمّى: «بدنا نعيش». في هذه المرحلة الخاصة، أصبحتُ أرى «مجندين إنسانيين» يصنعون وينشرون ثقافةً وفناً «منظماتياً». مجندون بكل معنى الكلمة، لهم خطابهم الخاص بعناصره البارزة، ويمتلكون من خطاب الدفاع عنه ما يكفي لإقصاء الاخرين، الغرباء اليوم.
هل أنا الغريب في محيط تم تدمير أي تساؤل وأي تفكير منطقي فيه؟ من وجهة نظري، يُفترَضُ بالعمل الإنساني أن يُطبَّقَ في كل القطاعات والمناطق، وإلا فعليه الانسحاب من نطاق الإنسانية التي ينادي بها. هل دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس وحلب وبعض المناطق الأخرى الآمنة نسبياً، هي فعلاً هي بحاجة لنمو منظمات مجتمع مدني إنساني، دون حاجة لأن تلتفت منظمات المجتمع المدني هذه أو تناقش أو تفكر أو تنظر لوضع «القسم الآخر»، المُحطَّم والمُدمَّر، والذي يُقتَلُ يومياً أمام عينيه؟ هل أكون قد ساهمتُ بتطوير سوريا، فيما أقومُ بالقفز فوق كل ما يحصل. اليوم يُهجَّرُ الآلاف، ولم تستطع منظمة دولية أو اغاثية تأمين الحماية لاعتصام صامت يطالب بوقف القصف عن أي منطقة.
لقد أصبحت مقولةُ أننا «في سوريا خُلِقنا لنأكل» أقربَ للواقع، فالجميع يعملون ليعيشوا، دون القدرة على التفكير في واقع الرهبة التي يعيشون فيها. والمساحةُ التي تُقدِّمُها أعمالُ المنظمات هي أشبه بغرف ونشاطات لتفريغ الطاقة، وتَجَنُّبِ التحديق في الحصار الأمني الخانق الذي تزايدَ بشكل مخيف عمّا كان عليه في بداية الثورة، حتى غدا كلّ من يعيش اليوم في مناطق النظام مرهوناً بالصمت أو التأييد.
الصمت، الصديقُ الأزلي
منذ ثلاث سنوات تقريباً، عند مدخل مدينة جرمانا، وهي مدينة ملتصقة بدمشق، وُضِعَت مجموعة من السواتر الإسمنتية لتشكل جداراً عازلاً ضدّ رصاص القنص. والسواتر هذه هي عبارة عن حواجز إسمنتية كانت تُستَخدمُ سابقاً لفصل الشوارع، وتكتَبُ عليها بعض الأقوال والشعارات الداعمة والممجدة للنظام. وبسبب سرعة وعشوائية عملية تشكيل الساتر في الليل، ظهرَت صباحاً أمام الموظفين وطلاب الجامعات وكلّ من يغادر المدينة ويعود إليها عبارة: «لنا القتل».
لنا القتل…
لازمتني تلك العبارة فترةً طويلةً نسبياً، ولم أعتقد يوماً أنها نتيجةُ تشكيل عشوائي، ففعلاً «لنا القتل» نحن الأحياء هنا.
لم يكن لنا سوى قتلُ الذكريات للتأقلم مع الحاضر، ومحاولة صناعة وتشكيل مستقبلٍ مرهون بالصمت، وقتل العاطفة والعقل في آنٍ معاً.
أتجوّلُ اليوم في دمشق، حيث الازدحام والضجيج، والوجوه، كثيرٌ من الوجوه والعيون الشاردة. لا تستطيع معرفة دمشق اليوم من رؤية حيٍّ واحد، لكن جولة في شارع الثورة بجانب جسر فكتوريا تكفي لكي تأخذ لمحة سريعة. وجوهٌ مقطبة مُعذَّبة، عيونٌ تبدو توّاقة للموت أحياناً. يبعث التجول هناك على البكاء، وسط ضجيج الأصوات والباعة في «سوق الحراميّة» الصغير.
أختنقُ بتلك العيون والتجاعيد، فحتى الأطفال هنا يحملون تلك التجاعيد. لا يتكلّم الناس هنا، بل يصرخون ويصرخون. بعد عودة خائبة من عملية بحثٍ عن عمل، أتجوّلُ في شارع الثورة كطريقٍ مختصر للوصول إلى باب توما وإكمال المسير نحو منزلي القابع في جرمانا؛ وبعد سوق الحرامية ومدخل سوق الخياطين، يستوقفني حاجز القلعة ليفتش حقيبتي بصمت ويسمح لي بالعبور إلى مكانٍ مختلف تماماً، فبجانب قلعة دمشق يسود هدوءٌ غريب تخترقه أصوات الحمام، وكأنك لم تكن وسط الصخب في شارع الثورة منذ عدة دقائق. محلات تجارية تبيع بالجملة وكثيرٌ من المشترين، وبعض الشباب والفتيات يجلسون على أسوار القلعة. يتوسّع هذا المشهد ويزداد حتى نصل إلى حيّ النوفرة، وبعده القميرية، كأننا نتنقل بين عوالم مختلفة ومتعددة رُكِّبَت بعبثية حول بعضها، فما بعد حاجز القلعة هو عالمٌ يمسح تماماً ما كنت قد مررت به في شارع الثورة. هذا التناقض الحاد هو دمشق، وقد ذكرتُ هنا شارعين متجاورين ليسا من الشوارع والأحياء المترفة، بل هما في قلب العاصمة تقريباً، شارعٌ للعمل وآخر للترفيه. يبعد حيّ جوبر الدمشقي مسافةً لا تتعدّى كيلومترات معدودة عن هذين الشارعين، والحيّ تعرَّضَ طويلاً للقصف على مدار الساعة.
الصمتُ هو الصديقُ الوحيد المُشتَرَك بين هذه الأحياء والأخرى النائمة، الصمت والتأقلم مع عشوائيتها وتناقضها، الصمتُ الذي هو المرادفُ الأزليُ المرافقُ لـ «لنا القتل»، والملازم لحقيقة أن تدرك الواقع وأن تعيش وأن ترى وتستمر، أن ترغب وتبقى. لا شيء سيبقى، الأفعالُ المرحلية المؤقتة وفوضى الشباب ستزول. لا صوت سيعلو عن صوت القتل، والرصاص والصواريخ والقذائف، والدم الناطق، ونَوحِ حمام دمشق.