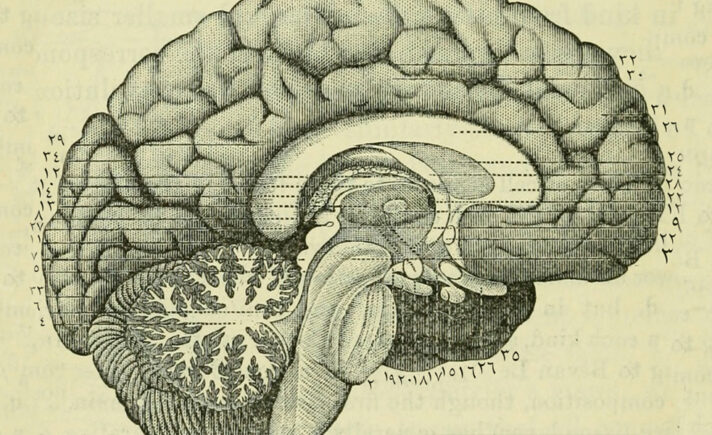تحدّاني صديقي أن أكتب نصاً إيروتيكياً، أصِفُ فيه الجسد وأبحثُ في تفاصيله، ثم أعرّجُ على الجسد الأنثوي لأتلمَّسَ خفاياه وما سيُكشَفَ لي إذا اختليتُ به على الورق. تحدٍّ كهذا لا بدّ أنْ يربكني، أنا الذي لم أكتب أبداً عن جسدي أو عن أي جسد آخر. لربما سقطتْ بعض القُبَل هنا أو هناك فيما كتبتُه سابقاً، أو حفنةٌ من كلماتِ الـ «أحبكِ» فحسب.
الموضوعُ أعمق من ذلك وله جذور ضاربة في الشخصية، تلكَ التي أكتشفُها مع مرور الزمن، ولكنّ الاكتشاف وحده ليس ما تتمناه عندما تقف أمام تحديات أو امتحانات كهذه، إنما تشذيب هذه العروقِ لتصبح ذات قالب معروف ومدروس، أو لتمسي على الأقل بنيةً معقّدة مفهومة ومرئية.
عليَّ أن أخبرك بأنني لا أمتلك من طفولتي سوى ثلاث صور فوتوغرافية، ويبدو أن أهلي كانوا منشغلين عن توثيق طفولتنا، أو لربما امتلكوا صوراً كثيرة، لكنّ ترحيلهم من الجزائر عند اندلاع الحرب الأهلية هناك، أجبرهم على ترك كل شيء خلفهم.
لم أسأل أبداً ما إذا تواجدت ألبومات لطفولتنا، وفضّلتُ عدم معرفة الجواب. هذا يعني أنني حُرِمتُ الإحراجَ الحاصل من مشاهدة الأصدقاء أو العائلة لصور جسدي العاري، وأنا أستحمّ أو أهرب من أمي حينما تريد تبديل ملابسي، وعليه، فأنا محروم من الإحراجات التي قد تكون مُحرِّرَةً بشكل من الأشكال.
في إحدى هذه الصور نقفُ، الأخوة الثلاثة، في أحد الأعياد مرتدين أطقم الجينز المتشابهة في درجة اللون، وكأنّ العيد هو حصول أبي على سعر خاص لهذه الصفقة المهولة، وحصولنا على هذه الذكرى الطفولية المضحكة، دون أي تميّز أو تمييز يُثير عند المشاهد أيّ حسٍّ أو قدرةٍ على أن يفرّق بيننا، كأننا مجموعة طلاب مثابرين يفضّلون أبداً ظهورهم بزيِّهم الموحّد.
اعتياديٌ جداً إذن، بدلةٌ كلاسيكية للعمل في تركيا، بنطال جينز لرحلة التهريب، وشورت أسود للخروج من الكامب في حال الخروج من زيارة رسمية.
الأماكن تفرض عليك ما تتذكره من الأماكن الأخرى، فبعد الطريق الطويلة والتحولات الكثيرة، ها أنا الآن في بورغنلاند حيثُ ذكريات بعيدةٌ حاضرةٌ دائماً، لذلك، تحت درجات الحرارة العالية نسبياً في الصيف، وانطلاقاً من هذه الاعتيادية النمطية المتجذرة بعد أن أصبحتُ رجلاً، تستطيعُ أن تتخيل عدم ذهابي بشورت لزيارة صديقي الستينيّ بتاريخه المهيب كقاضٍ متقاعد، أو المرور بجارتي الآنسة النشيطة، الستينية أيضاً، التي تخطط يومها وفقاً لأعراف وبروتوكولات مجتمعها.
أعرفُ أنني رجلٌ الآن، ولكنني رجلٌ مؤهلٌ للاستماع للكبار فحسب، هكذا تعودتُ في سوريا، الكبارُ الكبارْ يُعلّمون الكبارَ الصغارْ، حتى يجيء الوقت الذي يصبح فيه الكبارُ الصغار في قمة السلسلة الغذائية، فيأتي دورهم للحديث وتعليم من هم بعدهم.
عليكَ أن تهزّ برأسِك مُصغياً دائماً دون أن تعارض أو تضيف إلى حكمة الكبار ما تعتقدُ بأنكَ اختبرته في حياتِك القصيرة، وإذا كنتَ تريد الحديث ولا بدّ، فعليك أن تبحث عن رجل أصغر منكَ ليستمع إليك، وهكذا…
معضلةٌ حقيقية، ولكن أحد الأسباب المحتملة هو ما حدث في يوم من الأيام: كنا نجلس كما تعودنا في سوريا أمام المخبز الذي يمتلكه والدي، نحيي المارة ونستقبل الزبائن والزوار، فما كان إلّا أن التفتَ إليَّ أبي وقال دون أن ينتظر مني بطبيعة الحال أن أعارضه: «لقد أصبحتَ رجلاً، وليس من اللائق الجلوس أمام الكبار أو معهم مرتدياً الشورت القصير، من الأفضل لكَ ارتداء البنطال من الآن فصاعداً».
لربما كانت هذه وسيلته لإبلاغي بأنني بلغتُ مرتبة الرجال، وأن هناك بعض الأشياء التي تفرّقني عن الأطفال، وتحرمني المسموحَ لهم.
اعتياديٌ جداً إذن ألّا أكتبَ عن الجسد، لأنني عندما أكتبُ أجلس مع الكبار أيضاً، موعدٌ رسميٌ للكتابة وللقراءة، ولا يصح ارتداء الشورت لمثل هذه المواعيد. لو أنّ والدي لم يقل شيئاً من ذلك القبيل لربما تغيرتْ حياتي كلها.
لا عليك، أعرفُ أنّ كل انسان يُغيّرُ حياته بيديه، يعيد كلٌ منّا بعد فترة من الزمن النظر في كل شيء؛ النصائح العائلية، العادات والتقاليد، حتى الملابس في الخزانة. يوماً ما، ستَفتح كل الخزائن وتقرر ما يناسب وما لا يناسب، حتى أنك ستكسر حاجز القلق وتسأل صديقك المهيب الستيني بصراحة: «هل من الممكن أن أزوركَ الموعد القادم بشورت وحذاء رياضي، هل مقبولٌ إذا تجرأتُ على ذلك».
سيَسمَحُ لك بالطبع بفعل ما تريد، أنت في القرن الحادي والعشرين وفي النمسا، ولست في سوريا بعد الآن، وإن كان الصديق ذاته سيعترف بأنه ينتمي إلى الجيل القديم بتربيته الكاثوليكية الصارمة، وبأن موروثه في خزائنه من عادات وتقاليد يمنعه من ارتداء الشورت، وإن تعذّرَ بشكل ساقيه النحيلتين المُخجل.
لربما تذهب إلى ما أبعد من ذلك، فترتدي بنطالاً قصيراً قليلاً، لأن الموضة الدارجة ترتئي ذلك، وأنت مستعد للتغيير، ولترتيب خجلك بشكل يناسب ثورتك الداخلية العظيمة.
هل انتبهتَ إلى أنك تستطيع أن تسأل صديقك الستينيّ وتستشيره! وبأنه سيستمعُ لك تحكي عن تجاربك التي خُضتَها في حياتك القصيرة. هل انتبهتَ إلى أن سلسلة الرجال الكبار هنا تمتد بشكل أفقي وليس عمودياً! وأنك تستطيع أن تنادي أصدقاءك الكبار بأسمائهم الأولى، وليس بواسطة كلمة «العم» أو «الأستاذ» أو لربما بواسطة «أبو» كما تعودت لفترة وجيزة قبل مغادرتك البلاد.
كلّ الأشياء الجميلة تبدأ بتفريغ الخزائن وترتيبها من جديد، ولكن دعنا لا نذهب بعيداً ونشطح بترتيباتنا المفاجئة لنصل إلى السباحة من دون ملابس، فهنا تنغلق تلك النافذة الصغيرة المطلّة على الطفولة، ولا يمكن لأمك أن تتعذَّرَ أو تبتسم أمام الناس بعد الآن بأنك صغيرٌ وبريءٌ ومعذور.
هل نسيتَ ما قاله أبي عن أن الشورت غير مناسب للجلوس بين الكبار، تخيّل إذن ما كان سيقوله عن اختفاء الشورت مرة واحدة بين الكبار.
بالتأكيد أؤمِنُ بالجاذبية وبأن كل شيء يعلو لا بدّ أن يسقط في النهاية، وأن أوراق الأشجار تتساقط تحت تأثير ثقلها لحظة انفصالها، ولكني أعتقد بأن الأوراق تتساقط أيضاً كلما مرَّ من تحتها جسد عارٍ كتنبيه أو إشارة أنْ: «تستّرْ ولا تحرج نفسكَ والآخرين بتلك الأشياء المتدلية رغم جاذبيتها».
بشكل مشابه بعض الشيء، كان عليَّ أن أقف ليلاً في ممرِ سكني المشترك، كحراسة رئاسية محاولاً ألّا ألفتَ الأنظار، وهو ما يفسّرُ تصببي عرقاً من الداخل، خوفاً من أن يخرج أحدهم من الغرف الأخرى، ويشاهد صديقتي التي تتمشى بكل اعتيادية على رؤوس أصابع قدميها وكنزتها لا تغطي ثلث مؤخرتها، لتصل إلى الحمام، وكأن الممر فجأة أصبح من مَرَافِق شاطئ العراة، الذي اتفقنا قبل قليل بأن والدي لم يوافق عليه كخط أحمر يفصل بين الأطفال والبالغين.
لنضع تلك الليلة في خزانة الأشياء غير الاعتيادية ولنكمل يومنا بسلام.
لا أحاول أن أعتدي على تاريخ أحدهم، ولكنني أعتقد أن كلّاً منّا يرتب خزائنه بشكل مستقلّ، وبعض الخزن تستحق ترتيباً أنيقاً وتعييراً دقيقاً لا ينفجر في وجه أحدهم يوماً ما، فتسقط أوراق الأشجار لتشير:
«تستّرْ ولا تحرج نفسك، هذه الحياة موعد رسميٌ يحتملُ كمّاً مدروساً من عفوية الأطفال المبررة، ليس أكثر من ذلك».