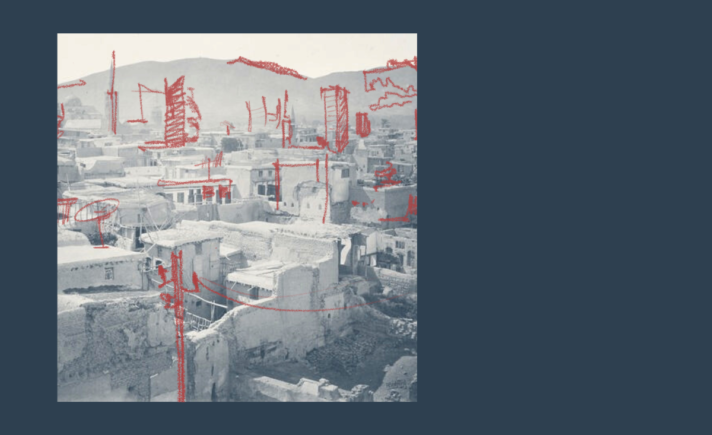حاولتُ بدايةً أن أبحث عن مقدمة لما أريد قوله. حجمُ الألم الذي رافق تلك الشهادات، وذاك الحنين الغريب لأيام الحصار المليئة بالجوع والموت والقهر والحب، مَنَعني من إضافة تلك الألفاظ التي تكون عادة مؤثرة بشكل أو بآخر، فتجعل من القشعريرة فعلاً مرافقاً للقراءة، سرعان ما يبدأ بالتلاشي مع بداية كلام من عايش تلك المرحلة، ليحلَّ مكانها شعورٌ آخر بالغبطة.
كيف يُحسَدُ من يُحاصَر؟؟!
«الحرية أن أعرف ماذا حلّ بزهوري، وشتلات البقدونس والبصل الأخضر التي وزعتُها على سطح البيت»، يضيءُ وجه ياسمين عندما تتذكر أيامها في حلب، وتقول عن الخروج:
«حين خرجتُ من حلب، وعلى مقعدي في الحافلة الخضراء المقيتة، أردتُ أن أعيش في عالم آخر. اختزنتُ مئات الصور التي مرَّت أمامي عن المدينة. كانت صور بيتي في حي كرم الميسر، على الرغم من الدمار الذي أحاط به، ولون الدهان الأزرق القاتم، وأكياس النايلون التي غطيتُ بها نوافذ البيت بعد أن تحطم زجاجها باكراً، ترافقني في الطريق. أردتُ فعلاً أن أختصرَ الوقت الذي كان يمرُّ بدقائقه كجبل على صدري. أغمضتُ عينَيّ، متجاهلةً فضولي لمشاهدة الطريق. أطفالي الثلاثة الذين احتلوا حضني وبقية المقعد الذي أجلس فيه، منعوني من لحظة الهدوء التي سَرَت في داخلي: «ماما لوين رايحين؟ ماما هونيك فيه بندورة؟ ماما فيه مدرسة؟ ماما فيه حديقة ومراجيح؟». أسئلةٌ كثيرة اكتفيتُ بهزِّ رأسي أمامها بالإيجاب. سألتُ نفسي وقتها، كيف ستكون الحياة في الجنة، أهي فعلاً تشبه أسئلة أطفالي عن حياة مُتخيلة يريدون العيش فيها، هل هناك مدينة ملاهي بأرجوحة دائرية عالية تسير بسرعة تخطف الأنفاس، كان ذلك حلمي يوم كنتُ صغيرة، أن أركبَ في إحدى هذه المراجيح العالية التي كنتُ أشاهدها على شاشات التلفاز. من المؤكد أنه لن يكون هناك كثيرٌ من الأواني للجلي أيضاً، ربما سنستخدم صحوناً كرتونية. أكثرُ ما كنت موقنةً به، أن هناك أنهاراً من المياه لسقاية زهوري وشتلات الخضار التي سأزرعها أمام البيت.
شدَّ انتباهي حديثٌ يدور بين طفلَيّ، كان أحمد يخبر أخاه الأصغر عن طعم شوكولا تذوقها حين ذهب إلى بيت جده في حلب: «حلوة وسايخة وفيها شي أبيض، وبتعلق على اللسان، ما بيصير تاكلا بسنانك، بدك تاكلا شوي شوي، بعدين بتخلص بسرعة». الصغيرُ الذي كان منصتاً على غير عادته، كان يعضُّ على شفتيه. نَظَرَ إليَّ في محاولة منه للتأكد. هذه المرة لم أكتفِ بهزِّ رأسي، ولكني وعدته بكثيرٍ من الشوكولا والبطاطا المقرمشة.
عند وصولنا إلى الطرف الآخر، كان أخي بانتظارنا، حاملاً كيساً كبيراً من أكلات الأطفال. حين ضمني إلى صدره، شعرتُ أن المدينة التي تقع خلفي قد انتهت إلى الأبد. لم يكن فرحاً بالنجاة من الحصار، كان حصاراً من نوع آخر. لم أستطع البكاء ولا الالتفات، اكتفيتُ بالصمت، وعند وصولنا إلى البيت، كانت أمي قد حضَّرَت كثيراً من الأطعمة. اختارَ أطفالي البندورة، أما أنا فقضمتُ لقمةً من رغيف خبز».
مبررات يومية للحياة
مرَّ عامٌ على التهجير، ولا تزال معظم أحياء حلب الشرقية مدمرةً وخاليةً من الحياة. بضعة آلافٍ يعيشون فيها اليوم، هم مئاتٌ ممن لم يخرجوا بالباصات الخضراء، والآخرون ممن كانوا قد غادروها قبل الحصار ثم عادوا بعد احتلالها. تعود الحياة إلى بعض أحياء حلب الشرقية ببطء شديد، وأولئك الذين أُخرجوا منها قسراً بالباصات الخضراء، لا يزالون يحاولون مواصلة الحياة خارجها.
«بعد عام من احتلال المدينة، فوجئتُ بالصور الأخيرة التي وضعها أصدقائي على صفحات التواصل الاجتماعي، كنوع من الحنين لأيام الحصار. جميعهم ذيّلَ تلك الصور بكثيرٍ من المشاعر المكبوتة، احتفلوا بها كشاهد على ذكريات جميلة». هكذا بدأ حسين العلي أبو محمد روايته عن المدينة بعد سنة من التهجير:
«كلنا فشلنا في التعايش خارج المدينة، حلب أُمّنا التي كانت تجمعنا «والأمّ بتلم». فرّقتنا الجغرافيا، وبات لكل منا قصته. كثيراً ما طُلِبَ مني الحديث عن أيام الحصار لأشخاص لم يعايشوه، كنتُ أخاف الكلام، قلتُ في نفسي سينعتني الآخرون بالكاذب، وكلما التقيتُ مصادفةً بأحد الذين أعرفهم من حلب، كنا نبدأ بإعادة تلك الأيام وكأنها أمامنا.
على الرغم من تكرار الحديث نفسه، كانت القصص تُعاد وكأنها للمرة الأولى، ربما كُنّا نخاف أن تُنسَى، أردنا لها الحياة دائماً. أوراق الباذنجان التي تحولت إلى سجائر، المعكرونة التي أصبحت خبزاً، والأهم من ذلك أننا لم نكن نحتاج إلى مبررات للحياة، كنا نعيش، كان العالم بأكمله ينظر إلينا كمشاريع أموات، والمبادرات الإنسانية تدعو إلى إخراجنا، وأهلنا في الطرف المقابل يرثون لحالنا، وربما يتأزمون لما نحن فيه، أما نحن فكنا لا نأبه بذلك كله، كنا نتجول في المدينة كأسيادها، نضحك ونقهقه. نجتمع على سيجارة واحدة وقليل من البن، والنساء يجتمعنَ في بيت واحد، يمارسن الثرثرة الصباحية أو المسائية، وتُخرِجُ إحداهن صحناً من البزر قد خبأته لتبدو كامرأة ارستقراطية. بعضنا كان يلعب ورق الشدة على ضوء لدٍّ خافت، وتبدأ عادة أهل المدينة بالسخرية من الخاسر الذي يتصبب عرقاً وكأن صاروخاً قد هبط على رأسه، وفي آخر السهرة يمدُّ الجميع أقدامهم المتعبة للحديث عن الخروج من المدينة المحاصرة. ننظرُ في وجوه بعضنا بعضاً، ثم في سقف الغرفة. هل حقاً أردنا الخروج؟ لم يكن أحد منا قد وصل إلى قرار بعد. يشقُّ صَمتَنَا صوتُ أحدهم: «إنت غشّيت، دقيت عالعشرة»، فينفجرُ الجميع بالضحك».
طغيان الحصار
توقفت المرأة السبعينية، أم محمد، عن وضع كُحلِها الحجري، الذي كانت تقول دائماً للمازحين إنه «والله دوا»، منذ خرجت من المدينة. هل اكتفت بما اختزنته من صور، فتركت لعينيها أن تذبلا؟
«يوم كنت أعيشُ في مخيم الفلسطينية»، وتعني مخيم حندرات في مدينة حلب، «كان لي جارة عجوز من مُهجَّري نكبة 1948 تشرب الماء مع السكر، وحين سألتها عن السبب، قالت إنها كانت تغصُّ بهواء المدينة، فلا أنقى من هواء حيفا. ابتسمتُ لجوابها، شعرتُ بالمبالغة في حديثها، ولكني لم أنتقدها خوفاً من إحراجها. أنا الآن أغصُّ بالهواء».
بكيَت أم محمد وهي تأخذ من الحياة قليلاً من الأكسجين رغماً عنها، استعادت أنفاسها لتقول إنها تحسد أهل الغوطة الشرقية على ما يعيشونه: «أوصيهم أن يحملوا ما يستطيعون من ذاكرة. النساء اللواتي يستخدمنَ الكحل الحجري، عليهنَّ أن يكنَّ بعيون سليمة إن استطعن ألّا يفارقن بيوتهنّ، فالهواء خارجها ثقيلٌ جداً، يحتاج إلى ماء وسكر. وأن يحملن مفاتيح بيوتهنَّ معهنَّ أينما ذهبن، صور أبنائهنّ، حفنة من تراب أرضهنّ، بقايا بذور دَفَنّها في الأرض وهنَّ ينتظرن ما يُطعمن به أطفالهنّ، فالخضار هنا بلا طعم. وأن يحملنَ الملايات التي تحمل رائحة المكان أيضاً. على الرجال أن يحتفظوا بصور عن المدينة، ببقايا رصاصات في جيوبهم، بعلبة الدخان الفضية والمشارب الخشبية وقداحات الكليبر البيضاء، بالحطاطة البيضاء والشراويل والقمصان، بالشوارب التي اصفرت من أثر الدخان، بحكايات الغوطة وبساتينها وأزقتها، بكرامتهم، بالطريقة التي يصنعون بها «الصفيحة» من لحم الجمل. لا أنسى طعمها يوماً، حين ذهبتُ مع زوجي أبي محمد إلى دوما، وقتها أدخلني إلى مطعم بالقرب من الجامع الكبير، قال لي: «هنا يصنعون الصفيحة من لحم الجمل، لحم الجمل مليءٌ بالنخوة». أما الأطفال، فليلعبوا في أزقتها حفاة، لأن كل المدن التي سيرحلون إليها ستصيبهم بالخيبة. لعلّهم يستطيعون تصديق حكايات الجدات يوماً، فيعودون، بدل أن يكتفوا بحلم العودة. عليهم أن يبنوا ذاكرتهم هناك، كيلا تموت المدينة».
أخرجت أم محمد كيساً قماشياً، بدأت بإفراغ محتوياته على أرض الغرفة بعنايةِ من يحملُ طفلاً: كيس من الزعتر، لوح صابون غار الزنابيلي، طاحونة قهوة يدوية، مشرب خشبي، صور كثيرة، مسبحة طويلة زرقاء، ثوب أخضر، طقم صلاة، وسلسلة مفاتيح من الخرز كُتب عليها «ما شاء الله»، صندوقٌ خشبي لمصحف صغير وكتاب أدعية، وزنار أبيض اللون قالت إنها ربطته على بطنها بعد كل ولادة، ومكحلة نحاسية صفراء مليئة بالكحل الحجري. هذا كل ما بقي من المدينة.