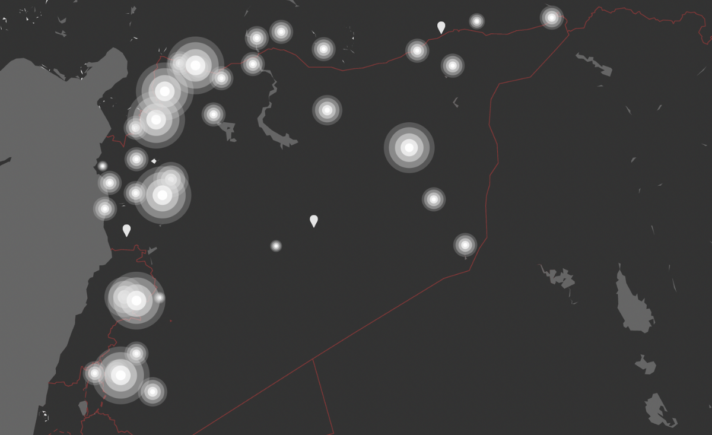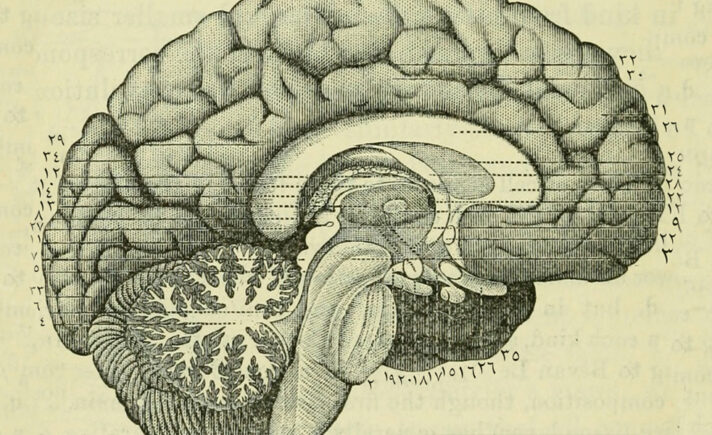اسمي حمد، وأنا في الأصل من مدينة صُبغتْ دائماً بصفة الريف القاحل، وكل ما يتبع هذه الصفة من قروية وبداوة وترحال وخيم بطابق أو طابقين، وهي النكتة التي كانت الرد المثالي على كل من يسألنا إذا كان لدينا بيوت حجرية وبنايات.
اسمي حمد وأنا من المدينة التي لم يشفع لها أنّ الفرات يمر فيها كالشريان الرئوي لتُنبَذَ فكرة الصحراء عنها، ولم يشفع لها الجسر الذي تعهد بناءه الفرنسيون في عشرينيات القرن الماضي ليقال بأن المدينة قد تلاقت في أحد أيامها مع حضارة أوروبا وتلاقحت مع حداثتها المتفجرة آنذاك، مع أن المهندس الذي أشرف على المشروع كان اسمه مسيو «فيفو»، ولا يحتاج المرء لأكثر من هكذا اسم في سلسلة علاقاته الشخصية ليقال عنه على الأقل إنه رفيع الذوق والمستوى.
ولأن فكرة البداوة كانت ملتصقة التصاقاً كاملاً، كان لا بد من الهرب إلى المدن الأخرى، حيث كان كل الشباب يسافرون بين الحين والآخر إلى العاصمة لينزلوا في النُزُل الرخيصة، ويأخذوا ما أمكنهم من شعور التمدن والانتماء إلى المحلات الفخمة والبارات الملونة المبهرجة التي لم يسمح الحظ بأن تتواجد في مدينتهم.
أما فكرة الدراسة في مدينة أخرى، فكانت رائجة ومحببة كحلم صيف لا يمكن تحقيقه بسهولة.
وليكون الوصف مكتملاً، فعلي أن أذكر واقع خدمة العلم الإلزامية التي يمكن أن يُفرز المجند فيها في أي مكان في الجمهورية ومدنها الواسعة، حيث كان الفرز إلى مدينتي أو من يشبهها من مدن ريفية شرقية تحاذي الصحراء في موقعها أو في توصيفها، تعبيراً واضحاً على أنه عقوبة منزّلة، ودليلاً قاطعاً على أن المجند لا يملك أي معارف شخصية عالية المستوى في الحكومة أو الجيش.
ولأنّ اسمي متأصلٌ في البداوة منذ حمله أعتى الشيوخ وأقسى رجال البادية، كان حديثي عن أي شيء يخص الريف موثوقاً ومعترفاً به، وبشكل بديهي كان عليَّ أن أعرف كل شيء يحصل في ثنايا القرى، أو أسمائها أو السبيل إليها، كأي «حمد» عادي وطبيعي.
كنتُ غالباً ما أسرد ما أعرفه وما لا أعرفه على مسامع سائلي، فمن الطبيعي أن أعرف أسماء العشائر وشيوخها وكيف تصنع القهوة العربية، وأعرف طعم لحم الجمال وكثافة حليبها تماماً كما يفترض أن أغني «القافية التي تلي» في كل الأغاني الشعبية، مع أنني لم أتفوه بجملة واحدة منها في حياتي.
زرتُ دمشق مرتين، وعشتُ في حلب ست سنوات كاملة، وعندي شارع مفضل في كل منهما، وعاشت مدينتي الريفيةُ فيَّ ثلاثين عاماً وأستمتعُ بالجلوس على الأرض، وأعرفُ أنّ الأصدقاء الحقيقيين هم الذين تستطيع الجلوس أمامهم ومعهم على الأرض، مع أن هذه الوضعية كانت تعدُّ شعبية زيادة عن اللزوم، ولا تناسب الصالونات أو المجالس الحديثة. وبالرغم من تغير المجالس والمدن ومرور الأيام، إلا أنني ما زلتُ أجلس على الأرض كلما استطعت، وأزور المدن وأهرب من الريف ومن الحياة التي قد تناسب اسمي نظرياً، ولا تتناسب مع ما أريد إخفاءه.
كان من المفهوم جداً أن أتذمر لأبي على هذا الاسم الذي أعطاني إياه، لأواجه بسببه أقسى النكات وأفدح السخرية من الأطفال الذين ربحوا أسماء عصرية مثلهم مثل أي طفل في مدينة عالية جميلة وذات سمعة محببة. وكان تفسير والدي وتبريره بأنّ عليَّ الانتظار قليلاً حتى أكبر، لأصبح الشاب الوحيد الذي يحمل هكذا اسم قديم، وبأنني سأشكره لأنني سأكون الشاب «الكول» الذي يحمل اسماً قديماً، مثل مدينتي التي لم تعرف كيف تشلح عنها قِدمها وتمسح عنها غبار الصحراء.
حدث بالفعل أن شكرتُ والدي في إحدى الزيارات، وقلتُ له بأنني الآن ذلك الشاب الفريد من نوعه، الذي يدرس في الجامعة ويحمل اسماً لا يحمله أحد غيري من زملائي.
من المريح أن ترتاح لاسمك، ومن المريح أكثر أن تغسل عنك المعاناة بعد عدد من السنوات.
ولكنّ الحياة تعطي وتأخذ، وهذه قاعدة لا بأس بالاقتناع بها في غالب الأوقات، عليكَ فقط أن تتمنى أن تكون دورة العطاء أطول من دورة الأخذ، أو أن تولد في عطاء وتموت في عطاء، وهكذا تكون قد خدعت الحياة وأخذت زيادة.
في خضم الأخذ والعطاء، ها أنا الآن لاجئ تم فرزه إلى الريف النمساوي بعيداً في قرية أصغر من أي مدينة حلمتُ يوماً أن أعيش فيها، لأحاول، كما اقتضت العادة، أن أهرب وأزور مدينتي غراتس وفيينا، لأحسّ بالحياة في شوارعهما ومحلاتهما، وأتضايق من السيارات التي لا تقف لي لأعبر الشارع، وأتضايق أكثر من السيارات التي تقف حتى.
كنتُ أقول دائماً إننا منبوذون كلاجئين، أو لاجئون كمنبوذين، ومرميون في الريف البعيد، وبأنّ المجتمع يخاف منا لذلك تم فرزنا في الريف بعيداً عن المدن وعن المجتمع وعن أضواء المحلات وزجاج واجهاتها، وكنتُ أتفهّمُ كيف يستلم اللاجئون قرار إقامتهم ويهربون فوراً إلى المدن الكبيرة دون وداع أو تنهد بسبب الفراق، ودون الالتفات للحظة واحدة إلى الخلف.
لم أعرف حينها إذا ما كان قرار بقائي في القرية يقع في خانة عطاء الحياة أم في خانة أخذها، ولكني بقيتُ وبدأتُ أتصرفُ كأي حمد عادي طبيعي في الريف الذي كان غريباً عليّ، أمشي بين القرى لمسافات طويلة كأي ريفي وأعرفُ أخبار جميع الجيران وأسألُ عما يحدث، من تزوج ومن سافر، ومن ذهب إلى المدينة ولم يحضر لي هدية من هناك، كأي ريفي ينحصر عالمه بين الهضبتين الصغيرتين، اللتين تشرق الشمس من خلف إحداهما وتغرق خلف الثانية.
وكما لا تتشابه المدن ولا تتشابه الأيام ولا أتشابه أنا مع نفسي البارحة، اتضحَ لي بأن الأرياف لا تتشابه. أخذ صديقي النمساوي المتقاعد من مهنة القضاء يروي لي كيف قضى حياته في المدن الكبيرة، وكيف أنه عاد إلى القرية الصغيرة بعد أن تعبَ وشاب، ليشتري لنفسه بيتاً وسيارة تساعده على التنقل بحرية في الريف ذي المواصلات العامة المتقطعة، وأخذ يدفعني للذهاب إلى المدينة قائلاً إن الريف ليس مناسباً لي الآن، وبأنني لستُ مؤهلاً لسكنه، ولمّحَ لي أكثر من مرة بأن العودة ممكنة إنما بعد عقد أو عقدين، عندما أصبح أباً لعائلة وأطفال فيلزمني حديقةٌ وكثيرٌ من الهدوء والعشب الأخضر، والحيوانات التي أشير لأولادي عليها لأعّلمهم تفاصيل الطبيعة بعيداً عن البنايات الشاهقة ودخان السيارات الوقح.
عقلي لم يحتمل الفكرة لا بالمجمل ولا بالتفاصيل، هل يُعقل أن يكون الريف هنا امتيازاً يجب أن يعمل الانسان ليستحقه، هل يُعقل أن يرى البعض الريف جنةً تأتي كجائزة آخر العمر؟ هل كنّا عمياناً، استقبلونا بعد لجوئنا ووضعونا في أجمل الأرياف الهادئة لنتعافى من الحرب والخسارات وتعب الترحال ونحكي للأشجار والطبيعة البريئة معاناتنا، ويخفّفَ نسيم الصباح العليل من ارتباك أرواحنا المهاجرة!
في ليلة من ليالي المدينة الواسعة لم أستطع النوم، بقيتُ أتقلّبُ من جنب إلى جنب وهذه الفكرةُ تنغص عليَّ سكينتي، ودورةُ عطاء الحياة تنخز خاصرتي لتذكّرني بكم المفاجآت التي تخبئها لي، وبالتفاصيل التي لم أنتبه لها في لحظتها، لأعضَّ أصابعي من الفرحة لأنني كنتُ في مكان يتمنى أغلب الناس أن تنتهي حياتهم إليه.
تمنيتُ لو أن كل الناس أصبحوا فجأة كأي حمد عادي وطبيعي، يعرفون أن الحياة تعطي أكثر مما تأخذ.