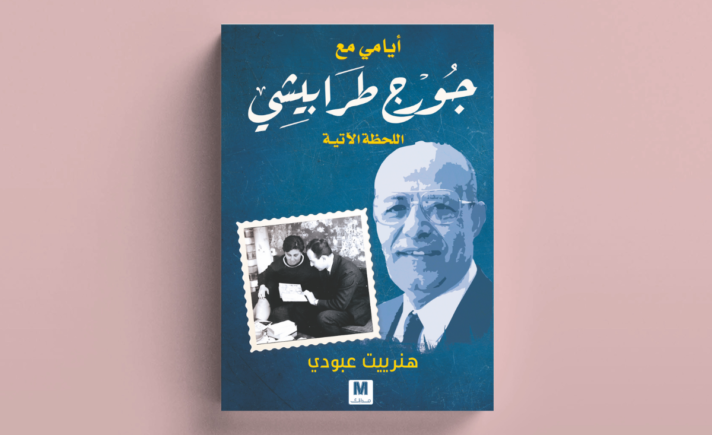أولاً – الصعود إلى «الشأن العام»
في نطاق «الجماعة المسيحية»
دخل مسيحيو سورية إلى الحقبة العثمانية وهم مثقلون بأعباء وأوضاع قاسية، ذلك أنه لم يكن قد مرّ على الحروب الصليبية سوى أقل من ثلاثة قرون، إلا أن آثارها بقيت قائمة على سكان المنطقة، مسلمين ومسيحيين. ثمة نظرة تجاه المسيحيين ستواكب تلك الحروب من قبل عامة المسلمين، وستُماهي بين الغزاة وبين مسيحيي المنطقة الذين سيُنظر إليهم على أنهم طابور خامس بين المسلمين
كانت هذه هي حال المسيحيين عندما جاء العثمانيون، الذين كان عليهم التعامل مع واقع معقد، قوامه هذا التعدد الملّي الواسع في إمبراطوريتهم المحدثة. فكان «نظام الملل» العثماني هو ما تمّ إقراره للتصدي لهذا الوضع. ويقتضي هذا النظام تقسيم السكان بحسب مللهم، وإعطاء كل ملّة حقوق التصرف في شؤونها الخاصة، الدينية والتعليمية والطقوسية وقضايا الأحوال الشخصية، وهو ما يعني أن نظام الملل هذا شكل انفراجاً كبيراً بالنسبة للمسيحيين مقارنة بوضعهم أيام المماليك. أما بالنسبة للعثمانيين، فقد كان أداةً لتنظيم العلاقة مع هذا التنوع داخل دولتهم، ففي الوقت الذي يتيح نوع من الاستقلال الذاتي لهذه الملل، فهو في ذات الوقت يسهّل ربط هذه الملل بالمركز عبر سياسات وأنظمة دولتية فوقية، كالجباية مثلاً، أو عبر النخب المناط بها إدارة هذه الملل. وكمثال على كيفية اختراق هذه الملل وصناعة النخب فيها نذكر، على صعيد المسيحيين، كيف قام العثمانيون بِرَهن «الكنيسة العربية للخارج»، وذلك عندما أُلحق «الأقباط واليعاقبة والسريان والنساطرة» بالبطريرك الأرمني، وكذلك بطريركية أنطاكية الأرثوذكسية، ومثلها بطريركية القدس، فكانتا تحت نفوذ بطريركية القسطنطينية، التي يهمين عليها اليونانيون
لقد كانت علاقات العثمانيين مع اليونان سابقة على ذلك، وتعود إلى بدايات الدولة العثمانية حين أخذت تتوسع نحو أوروبا مما أخاف اليونانيين الأرثوذكس الذين تطلعوا إلى مدد من أوروبا الكاثوليكية لصدّ هجوم المسلمين الأتراك، لكن الرد كان من قبل روما، مقر البابا، المدد مقابل خضوع الكنائس الشرقية لها
لكن، وعلى الرغم مما يَعِدُ به هذا الاتفاق من إنقاذ المسيحيين الشرقيين من المسلمين، إلا أن ردة فعل اليونانيين ستكون غاضبةً ورافضةً له، بل وسيُنعت من وقع عليه بالخيانة والهرطقة. وتفاعلت الأمور إلى درجة أن مالَ بعض الأكليروس والشعب نحو الأتراك المسلمين، الذين سيتدخلون لتنصيب وتعيين قيادات دينية تدين بالولاء لهم، مع تأييد شعبي كبير
ذكرنا ما سبق للإشارة أيضاً إلى أمرٍ سيشترك فيه أرثوذكس المشرق العربي، في سورية خصوصاً، مع أرثوذكس اليونان، وهو تجلى خصوصاً بعد الاختراق الأوروبي للدولة العثمانية، حيث تراوحت ردّات فعل الأرثوذكس العرب بين الحذر منه والرفض على الرغم من ادعاءات حماية المسيحيين في المشرق التي قدمها الأوروبيون. كان ذلك قبل تصاعد المد القومي بين شعوب الدولة العثمانية، عندما كان العامل الديني هو الأساس في تصنيف الذات والآخرين. لذلك لن تُسجَّلَ ردّات فعل عنيفة بين أوساط الأرثوذكس العرب على سيطرة اليونانيين على كنائسهم. وكذلك، كان التدخل الروسي مرحباً به في أوساط عديدة منهم. فهؤلاء جميعاً هم «أخوة في الدين»، وسينظرون على العكس من ذلك للتدخل الغربي الأوروبي «الفرنسي والانكليزي خصوصاً»، لا سيما وأن هذا التبشير الديني كان أحد مظاهر هذا التدخل. ويرصد أسد رستم هذا الموقف من خلال تقرير أعدّه السفير الفرنسي في الأستانة 1740، يرى فيه أن «ما يحيق بالمسيحيين من ضيم في ظل الأتراك العثمانيين إنما ينشأ عن مسيحيين آخرين يعاكسون إخوانهم»، حيث وقف الروم الأرثوذكس مع الدولة العثمانية في الاعتراض على التبشير الديني، مطالبين بالحد منه والالتزام ضمن حدود تواجد قنصليات بلدانهم ومواطنيهم وتجارهم. إذ إن «السبب الذي يبرر وجود هؤلاء الآباء هو القيام بالخدمات الروحية لهؤلاء التجار والقناصل»، ولذلك «لا يجوز لهم أن يقبلوا رعايا السلطان في كنائسهم ولا أن يزوروهم في بيوتهم أو أن يعلموا أطفالهم في مدارسهم لإخضاعهم إلى سلطة البابا». ثم يروي التقرير كيف استطاع الروم الأرثوذكس استصدار براءتين في 1725 «أوجبتا منع المرسلين من دخول بيوت المسيحيين رعايا السلطان وإكراه الذين اتبعوا عوائد الإفرنج على العودة إلى دينهم وطرد المرسلين من الأماكن الخالية من القناصل». ويضيف أن «هذه الأوامر نفذت في ديار بكر والموصل وبغداد وأرضروم وأنها على وشك التنفيذ في دمشق
كانت حلب أحد الأمكنة التي تعكس حدة هذا الصراع، ودور كل من روما والقنصليات والعثمانيين والكنائس فيه، بل إن هناك من يذهب إلى أن أغلب مسيحيي حلب
كانت واقعة التعدد ضمن المسيحيين أنفسهم قد فرضت نفسها على نظام الملل العثماني، فكان في بداياته يتعامل معهم على أنهم «ملّة واحدة»، لكنه سرعان ما سيعترف بهذا التعدد، لتغدو كل طائفة مسيحية «ملّة» بحد ذاتها، تتمتع باستقلالها الذاتي فيما يخص شؤونها الداخلية من طقوس وعبادات وأحوال شخصية، طالما أنها تدفع الجزية بانتظام أو لا تشكل خطراً، لا سيما بعد أن أخذ نفوذ الغرب يشتد في السلطنة. سيلعب «قانون الملّة» هذا دوراً في تعزيز مفهوم الجماعة المسيحية ومفاهيم التضامن بين أبنائها، لا سيما وأنه خارج هذه الجماعة، أي في المجال العام. لقد كان جميع المسيحيين محكومين بالقواعد العامة المستمدة من الشريعة الإسلامية، وبهذا، فإنه من الطبيعي أن يشعر المسيحي بالغربة أو القلق عن هذا «المجال العام»، ليغدو مجال الجماعة مبعث السكينة والطمأنينة. نستخدم هنا مفهوم «المجال العام» بدلالات محددة، فهذا المفهوم مع الآليات التي سترتبط به لن يبدأ بالتبلور إلا في القرن التاسع عشر تقريباً، مع استفحال التدخل الغربي، في السلطنة، فحتى ذلك الحين لم تكن هذه الأخيرة مركزية أو قادرة على مسك هذا المجال الواسع الذي تحكمه، وأن تصهره أو تلحقه بها على نحو قوي. لكن مع ذلك، يبقى أن المساحات العامة الموجودة كانت تملأها الدولة العثمانية المسلمة أولاً، ومن ثم رعاياها المسلمون، وهو ما يعني بالتالي أن ثمة حدوداً يقف وراءها المسيحيون، وهي ليست جميعها مرسومة بالضرورة من قبل المسلمين، دولة أو مجتمعاً، بل بعضها سيقوم المسيحيون برسمه لدواعي الهوية والتضامن والعيش.
نحو الفضاء العام
ما سُقناه من كلام عن «الجماعة المسيحية» أو عن الحدود الخاصة بها، لا يعني أن المسيحيين كانوا في انقطاع تام عن المجتمع، بل كان ثمة حضور في بعض المساحات التي تنتمي إلى الحقل العام، كالاقتصاد مثلاً. على سبيل المثال، لم يكن المسيحيون خارج اللوحة الاقتصادية في مدينة حلب، التي كانت عامرة ثم ما لبثت أن تراجعت بعد ازدهار الملاحة الأوروبية في المحيط الهندي والحرب العثمانية الصفوية في بدايات القرن 17، التي قضت على التجارة مع الخليج العربي وما بعده، وحرمت حلب من تجارة التوابل. لكن المدينة سرعان ما استعادت عافيتها الاقتصادية عبر تجارة الحرير ومنتجات الأرياف المجاورة والمصانع المحلية مع إستانبول والقاهرة خصوصاً، ثم مع الغرب خلال القرن 18 حيث كانت حلب مركزاً لتصدير النسيج والقطنيات. المسيحيون لم يكونوا غائبين عن هذه الحياة الاقتصادية، وكغيرهم من الحلبيين، خلال القرن 16، كانت «أنظار أكثريتهم متجهة على الأرجح صوب العالم التركي والفارسي وقد استمدوا منهما ليس فقط مواردهم المادية، بل أيضاً أذواقهم ومرجعياتهم الثقافية. وابتداءً من القرن السابع عشر تحولت أنظارهم ناحية أخرى، فانفتحوا أكثر فأكثر على أوروبا المتوسطية وتزايدت رغبتهم في ثروات الغرب المادية وغير المادية»
يرصد ألبرت حوراني هذا الصعود الاقتصادي، الذي انعكست نتائجه على صعد الثقافة والتعليم، وكذلك على الحضور السياسي، لا سيما وأن المسيحيين أصبحوا تحت حماية ورعاية الدول الأوروبية وروسيا، وفق معاهدات مع الدولة العثمانية كانت فرنسا هي السبّاقة لها منذ أيام السلطان سليمان القانوني. لقد «كانت الطوائف الأرثوذكسية وغيرها من الطوائف المسيحية تزداد ثروة وثقافة ونفوذاً طوال القرن الثامن عشر. فالحماية الأجنبية لم تمنحها امتيازات سياسية فحسب، بل وفرت لأبنائها أيضاً، وهم العاملون بالتجارة مع أوروبا في ذلك الحين، منافع تجارية ومالية. وقد اغتنى، بنوع خاص، اليونانيون والأرمن والمسيحيون السوريون الناطقون بالضاد، فارتفع مع هذا الغنى مستواهم الثقافي واشتد شعورهم الطائفي»
العلاقات الثقافية بين مسيحيي سورية والغرب تعود حتى إلى ما قبل الاختراق الأوروبي للدولة العثمانية، وإن كان هذا متاحاً لكاثوليك سورية أكثر من غيرهم، لا سيما موارنة حلب
يشير شاهين مكاريوس إلى علاقة الأجانب بالتعليم، فيذهب إلى أنهم وحيث وُجدوا، «تكثر المدارس والكتب، وحيث يقل عددهم تقل المعارف، وليس للحكومة من المدارس إلا الشيء القليل وهي قاصرة على أولاد المسلمين». ثم يذكر النهضة التي عاشتها بيروت وطرابلس ودمشق بسبب هذه المدارس، وكيف «دخل الشبان والشابات والصبيان والبنات مدارس الإفرنج على أشكالها، فنبغ منهم الأفراد وانتشر المتعلمون في كل أقصاء البلاد ونزح فريق كبير منهم إلى القطر المصري وأميركا وأوروبا. والسوريون اليوم أصحاب القلم في كل البلدان العربية فهم يحررون كل جريدة عربية تذكر في القطر المصري وغيره من الديار العربية»
لقد كان اهتمام المسيحيين في حلب باللغة العربية سابق على هذا التاريخ، بل وحتى على تأثير المدارس التبشيرية، وذلك على يد «الفئة الوحيدة التي كانت تملك ناصيتها يومذاك، (…) [أي] مشايخ الدين الإسلامي»
فيما يبدو، فقد كانت معظم المدارس الكاثوليكية ذات توجهات محافظة تعنى بالأمور الدينية وبإعداد كوادر تقنية تلبي حاجات الوساطة والإدارة التي يحتاج إليها الأوروبيون أو السوق، بينما كان اهتمام المدارس البروتستانتية يتوجه معظمه نحو تدريس الآداب واللغات والعلوم، ولهذا مثلت البروتستانتية عند البعض قوة تحررية لا بد من السير في ركابها لكسر القوالب الجاهزة والانطلاق نحو عالم أرحب. وهذا ما فعله مثقفون مسيحيون آنذاك، كبطرس البستاني الذي غادر المارونية إلى البروتستانتية وكان هذا يعني، بحسب الحوراني «أن تذهب إلى آخر مدى نحو التأكيد على الحق في أن تتبع ما يمليه عليك عقلك وضميرك»
هذه المدارس من حيث توجهاتها ومضامين مناهجها لم تكن معزولة عن الحركية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي ميزت الدولة العثمانية في قرنيها الأخيرين بعد الحضور الأوروبي فيها، والذي أطلق العنان لصعود قوى اجتماعية جديدة، معظمها من المسيحيين، على حساب القوى التقليدية التي تراجعت مكانتها وقوتها. ولهذا، فإن النخب التي ستتخرج من هذه المدارس لم تكن معزولة بدورها عن هذه الحركية، بل ستكون لسان حالها في معظم الأحيان، ويصحّ هذا على النخب المسيحية والمسلمة، لكن التنوع داخل النخب المسيحية كان أكثر وأغنى من ذلك الذي نجده بين أوساط النخب الإسلامية. نَظَرَ بعض المسيحيين للتفوق الأوروبي على أنه تفوق مسيحي، وأن الحداثة هي منتج مسيحي أيضاً، وكان هذه الرأي أكثر انتشاراً في أوساط كاثوليكية، الموارنة خصوصاً. لكن آخرين ذهبوا عكس ذلك، أي أن الوصول للحداثة لن ينجح إلا عبر تحييد المسيحية والدين عموماً عن الشأن العام والدولة، بل وأكثر، على جثة الأكليروس «المسيحي والإسلامي»، أو على حسابه
على الجانب السياسي، وفي الوقت الذي تراوحت معظم مواقف النخب الإسلامية بين الدعوة إلى مدنية مضادة للمدنية الغربية، قوامها اتباع الأخلاق الإسلامية الحميدة والخضوع للسلطان العثماني والابتعاد عن «إتقان العادات الأجنبية» (أبو الهدى الصيادي). أو كما صاغ جمال الدين الأفغاني رؤيته حول الدولة العثمانية بوصفها الحيز الجامع والأكثر صلاحاً للإسلام والمسلمين، واعتبار كل تقليد للغرب خيانة وشعوراً بالنقص. والذي أكد في خطابه لخديوي مصر، الحاجة إلى مستبد عادل، لأن الحكم الجمهوري «لا يصلح للشرق ولا لأهله اليوم». مقابل كل هذا، سنجد مواقف النخب المسيحية تتراوح بين متمسك بالإطار العثماني مع المطالبة بحقوق دستورية أو وضعية أفضل للشعوب العثمانية، وبين مأخوذ بالغرب ومستدعٍ له كملاذ وحام ومستعين به كضامن للحرية والهوية والاستقلال؛ وبين آخرين تبنوا هويات علمانية كالوطنية السورية أو العروبة، وأخيراً هناك من تبنى الكوسموبوليتية الحداثية وفكرة المواطن العالمي بوصفه مستقبل العالم، بينما التضامنات القومية أو الوطنية لا تختلف في الجوهر عن التضامنات الدينية، تُبقي العالم منقسماً وتساهم في صناعة الشرور
لم يكن المسيحيون العرب هم الوحيدون الذين استيقظت لديهم الهوية القومية من بين مسيحيي الدولة العثمانية، بل سبقهم لهذا مسيحيو اليونان والبلقان وغيرهم، وكان لثوراتهم القومية أثر كبير في بلورة الأفكار القومية عند مسيحيي المشرق. بالنسبة لليونان، سادة الأرثوذكس، أثناء ثورتهم القومية في العقود الأولى من القرن 19، لم تكن القسطنطينية «كنيستهم المقدسة» مصدر إلهامٍ للثائرين، أو حاضرة في رموز ثورتهم، بل كانت هذه الأخيرة مستمدة من تاريخ اليونان
يرصد أسد رستم هذه التحولات للكرسي الأنطاكي الأرثوذكسي، ومقره في دمشق، وعن اهتمام الصحف اليونانية التي أشارت إلى «أن الأنطاكيين يرغبون في أن يروا مطراناً وطنياً يرأسهم»
بعد عام 1860 ستبرز نخب قادمة من أوساط أرثوذكسية وبروتستانتية تنادي بالعروبة، ويذكر وجيه كوثراني مثالاً عن ذلك: المنشورات التي كانت تعلق في كل من دمشق وبيروت وطرابلس وتندد بظلم وفساد الأتراك وتبدأ بياناتها بتعابير من مثل: «يا أبناء سورية»، «يا أهل الوطن»، وتذكّر بـ «بالنخوة العربية» وبـ «الحميّة السورية»، وتدرج المطالب التالية: «استقلال نشترك به مع إخواننا اللبنانيين بحيث تضمنا جميعاً الصوالح الوطنية. أن تكون اللغة العربية رسمية في البلاد، وأن يحق لأبنائها الحرية التامة في نشر أفكارهم ومؤلفاتهم وجرنالاتهم بمقتضى واجبات الانسانية ومقتضيات التقدم والعمران»
العام الذي سيبقى في الذاكرة: مجزرة 1860
كانت المسألة الشرقية هي الإطار العام الذي حصلت بسببه، وفي سياقه، مجزرة عام 1860 في دمشق، والمجازر التي قبلها في لبنان. وكنا قد استعرضنا بعض جوانب هذه المسألة عندما تطرقنا إلى التدخل الأوروبي الفاعل في الدولة العثمانية، وما جرّه من انقلابات وانهدامات طالت العوالم الاجتماعية للسكان، وكذلك الاقتصادية والثقافية والسياسية والقانونية، كانت معظمها تصبّ في صالح صعود المسيحيين وتحسين أوضاعهم على حساب أوضاع كانت قائمة لصالح نخب دينية أو تجارية أو ثقافية مسلمة. وإذا كانت أحداث جسام، كاحتلال مصر من قبل الفرنسيين 1798 ثم استقلال اليونان وثورات مسيحيي البلقان، علامةً على ضعف دولة المسلمين وتراجعها أمام «عدو خارجي» لا يُضمر سوى الشر. لكن صعود المسيحيين، وهم مواطنو الدولة العثمانية، بدعم من ذات «العدو»، يعني أن العطب وصل إلى جسد الدولة. كانت الوصفة التي ستواجه بها نخب إسلامية هذا الضعف وهذه التحولات الجسام هي السعي لبلورة ذاتية إسلامية قوامها التناقض بين الإسلام من جهة، والغرب والمسيحية من جهة أخرى. وإذا كان هذا الأمر منوطاً بالنخب، فإن فئات اجتماعية أخرى ساءت أحوالها أيضاً، سيكون الغضب هو وسيلة تعبيرها.
يروي عبدالله حنا عن «ثورة» قام بها أهل دمشق في عام 1831، إثر تولي والي عثماني جديد أمور المدينة الذي فرض ضرائب جديدة، حيث اشتعلت المعارك في معظم أنحاء المدينة بين السكان وجنود الوالي، ومع ذلك لم يتعرض أحد من «الثوار» للمسيحيين أو لأملاكهم، على عكس اليهود الذين طالهم بعض الغضب وذلك لارتباطاتهم المالية بحكام إستانبول ودمشق وعكا بحكم عملهم كصيارفة، فكانوا مؤيدين لفرض ضرائب جديدة، لكن الثورة كانت موجهة بشكل مباشر ضد سلطة الوالي
ما إن خرج المصريون من بلاد الشام حتى كان لبنان هو ساحة المواجهة الأولى بين المسيحيين من جهة، والدروز المدعومين من قبل الأتراك والإنكليز وبعض وجهاء وعوام المسلمين من جهة أخرى. وستستمر الأوضاع على هذا النحو بين مد وجزر قرابة العشرين عاماً. خلال هذا، كانت الدبلوماسية الأوروبية تسعى إلى مزيد من الاختراق، وكذلك روسيا التي ستطالب بحماية الأرثوذكس أسوة بما نالته فرنسا على هذا الصعيد. وعندما رفض السلطان العثماني مطالب روسيا، أعلنت هذه الأخيرة الحرب التي ستسمى بحرب القرم 1854 – 1856، والتي ستنتهي بانسحاب روسيا من معظم الأراضي التي احتلتها وإعطائها حق حماية الأرثوذكس على أراضي السلطنة، ثم بإعلان «الخط الهمايوني» الذي أعلن فيه السلطان المساواة التامة بين رعيته، على اختلاف أديانهم وطوائفهم، وأتاح حرية حركة أكبر للرأسمال الغربي، وهو ما يعني المزيد من الامتيازات للمسيحيين على أرض السلطنة، فتفجرت الأمور من جديد في لبنان وارتكبت المجازر الكبيرة بحق المسيحيين
أما بالنسبة للفئات الاجتماعية التي شاركت بالمذبحة، فكانت من «التجار والباعة والزعماء العسكريين المحليين (عدا الميدان) والمهاجرين الأكراد وسكان الأرياف (الحوارنة) القاطنين حديثاً في الضواحي»
ما بعد 1860 ليس كما قبله، حيث سيغدو لجبل لبنان إدارة مسيحية تتمتع بالحكم الذاتي، وإن كان تعيين هذه الإدارة سيتم بتدخل من الباب العالي. سيشكل هذا الحدث بداية تبلور وعي مسيحي عند البيروقراطية المسيحية «المارونية» الحاكمة، يروم الاستقلال عن الأستانة وتشكيل كيانه المسيحي كملجأ جاذب لمسيحيي المنطقة. كما أفسحت المجازر المجال للمزيد من التدخل الغربي، لا سيما فرنسا، مما زاد من تخوف السلطان العثماني الذي أوفد وزير خارجيته فؤاد باشا لإنهاء الفتنة، يرافقه المسيحي الحلبي رزق الله حسون ليترجم له البيانات والبلاغات، فكان أن أنشأ فؤاد باشا محكمة لأجل هذا، حكمت على ما يقارب المئتين بالإعدام ومئات بالسجن والنفي، وكانوا جميعهم من المسلمين، وبعض من طالهم العقاب كان من النخب الدمشقية المسلمة.
ثانياً – النكوص إلى «الجماعة المسيحية»
في زمن «العروبة الأولى»… وبعد زوال دولتها
في عام 1916 سيعلن الشريف حسين ثورته ضد الأتراك، وكانت هذه الثورة محملة بتصورات ووعود حول واقعٍ ومستقبلٍ معينٍ للعرب، نجدها تتقاطع مع بعض التصورات لمثقفٍ مسيحيٍ مات في العام ذاته، ولم يتسنَ له أن يرى ما آلت إليه الأمور.
في عام 1905 نشر المثقف المسيحي نجيب عازوري كتابه «يقظة الأمة العربية»، الذي يدعو فيه إلى إقامة دولة عربية متحررة مستقلة عن العثمانيين تضم العراق وبلاد الشام وشبه الجزيرة العربية، وكذلك إلى التحالف مع الغرب من أجل نجاح هذا المشروع، أما عن شكل هذه الدولة فهو ملكية دستورية. أما الشريف حسين الذي سينطلق لتحقيق هذا المشروع، فهو لدى العازوري غير مرشح سوى لخلافة دينية، أي منصب روحي يماثل ذلك الموقع الذي يحظى به بابا الفاتيكان، بينما يرشح أحد أبناء الخديوي المصري للملكية، وهذا التصور ينبع من تصور علماني للعازوري يروم فيه فصل السلطتين الدينية والسياسية عن بعضهما البعض
بقيت العروبة كتيار ناشئ في خضم التطورات والتحولات في الدولة العثمانية حكراً على نخب عربية، كانت في معظمها مسيحية في البداية ثم ما لبثت أن انتشرت في أوساط مسلمة، لا سيما بعد 1908، كآلية دفاعية في وجه السياسات الطورانية للاتحاد والترقي. كانت الثورة انتصاراً لمشروع هذه النخب، لكنها كانت غير ذلك لدى نخب أخرى، بل ولمعظم مسلمي بلاد الشام الذين راعهم الدعم الغربي لها، وعلى هذا سيصفها أحد أبنائها، محمد جميل بيهم، بأنها «جزء من المخطط الأوروبي القديم الذي يرمي إلى الفرقة بين المسلمين والقضاء على الخلافة»
يرجّحُ البحث أن انتهاء الدولة العربية الأولى ودخول الفرنسيين إلى سورية ولبنان، كانت هي البداية الرسمية لانكفاء المسيحيين نحو ما سندعوه بـ «الجماعة المسيحية»، على ما في هذا التعبير من مغامرة تشي بالتعميم والتنميط. وعلى كل حال، كان لشكل الإدارة الفرنسية لسورية دور كبير في هذا. في مرحلة السعي العثماني نحو تحديث القوانين والمؤسسات بما يقارب النموذج الغربي الدمجي، لم يكن هذا السعي يواجَه فقط من قبل نخب تقليدية محلية مسلمة أو دولتية تهدَّدَت مصالحها، بل كذلك من قبل الغرب المقتحم الذي سعى بدوره للحفاظ على النموذج العثماني «المللي» الذي يتيح له أن يخترق ويترسخ عبر قواعد وكتل اجتماعية محلية. وربما كانت أبرز تطبيقات الغرب على هذا الصعيد بعد رحيل العثمانيين، هو إنشاء كيانات سياسية، دول، في المنطقة، على أساس الاعتبارات الدينية والطائفية، كاليهودي في فلسطين والمسيحي في لبنان والدرزي في جبل العرب والعلوي في الساحل السوري والسني في كل من دمشق وحلب. في كتاب له عن سورية التي زارها بعد استقرار الفرنسيين فيها، يقول عن غورو: «كانت سورية تمثل أمام عينيه أرضاً مسيحية»
في الواقع، لم يخلُ الأمر من اندفاعات ضد المسيحيين عبر إلحاقهم بالفرنسيين، وكانت خلفية هذه الاندفاعات إما إسلامية أو «وطنية». ووصل بعضها إلى حد ارتكاب مجازر، كما حصل عام 1920 في قرية عين إبل المسيحية، والتي قامت بها مجموعات شيعية وأخرى تابعة لأدهم خنجر وعشيرة الفواعرة، الذين حضروا في مؤتمر الحجير نيسان 1920 لمناصرة قضية الدولة العربية في وجه الفرنسيين، مع أنه كان من بين الحضور مسيحيون أيضاً. وربما كانت هذه هي المرة الأولى التي يدخل بها الشيعة على خط التناقض الإسلامي – الغربي/المسيحي آنذاك، عبر المشاركة في هذه المذبحة التي تتفاوت التقديرات حول عدد ضحاياها، ولكنها لا تقل عن مئة
ستشهد ثلاثينيات القرن الماضي ولادة أحزاب جماهيرية عروبية وإسلامية وشيوعية، تحمل تصورات حول الهوية ومستقبل البلاد، بدأت تنافس التيار الوطني الآخذ بالصعود هو أيضاً. وبالتوازي مع هذا، ستظهر أحزاب أو مشاريع مناهضة لما سبق، كحزب الكتائب اللبناني الذي يتوجه إلى مسيحيي لبنان، موارنته خصوصاً؛ أو كحزب أنطون سعادة «الحزب السوري القومي» الذي يناضل من أجل هوية قومية سورية تبدو وكأنها وسط بين الصيغة المارونية السياسية «حزب الكتائب» والتي تريد حبس المسيحيين في سجن الطائفة، وبين الصيغة العروبية الفضفاضة التي سيعود فيها المسيحيون أقلية أو أهل ذمة، كلا المشروعين عند سعادة هما دينيان، ولذلك وسمهما بالرجعية، ذلك أنه «كما لبست الحزبية المحمدية (…) في الرجعية الجديدة لباس (القومية العربية) وارتكزت على مرتكزين أساسيين هما اللغة العربية والدين المحمدي اللذين نشرهما الفتح العربي المحمدي، كذلك لبست الحزبية الدينية المسيحية في الرجعية الجديدة لباس (القومية اللبنانية) واتخذت لنفسها مرتكزين أساسيين هما الدين المسيحي ونظام جبل لبنان تحت السيادة التركية، والذي وضع عقب الحرب الأهلية الدينية المعروفة (بحركة سنة الستين)، التي جرت فيها سنة 1860 مذابح دينية منكرة»
واقع المسيحيين السوريين، آنذاك، كان أكثر تعقيداً من أن نختصره تحت عدة عناوين. ومبرر هذا التعقيد هو ذلك التعدد والتنوع في المواقف التي توزع عليها مسيحيو سورية، والتي يصل بعضها إلى حد التناقض، وقد رصدنا بعضها أعلاه؛ وأيضاً إلى الواقع المسيحي ذاته الذي كان متحركاً وحيوياً سواء على صعيد الأفكار أو الوجود الواقعي. فهم حاضرون على صعيد النخبة الوطنية المُنادية بالاستقلال، وربما كان فارس الخوري من أبرزهم على هذا الصعيد. وأيضاً في سياق العروبة التي تبلورت بعد الانتداب الفرنسي، والتي حددت تناقضها الرئيسي مع الغرب، بعد أن كانت سابقاً متحالفة معه وضد الترك، ونستذكر هنا، على سبيل المثال لا الحصر، مشاركة مطران حماة الأرثوذكسي في مؤتمر بلودان 1937، والذي أكد على «فكرة الوحدة العربية وألحَّ على طابع التضامن الديني في مفهوم القومية العربية»
لكن هناك من ذهب إلى النقيض أيضاً، كعصبة «الشارة البيضاء» التي تأسست في حلب واستطاعت أن تجد أنصاراً لها في الجزيرة السورية، وكان معظم منتسبيها من كاثوليك حلب والجزيرة، وكان لها تنظيم شبه عسكري اسمه «القمصان البيضاء». رفضت هذه العصبة ما أسمته بـ «الانتداب الدمشقي» وطالبت بـ «الانتداب الفرنسي»
في العقد الأول من عهد الانتداب الفرنسي، شهدت هجرة المسيحيين تزايداً لافتاً، وكانت معظم هذه الهجرات نحو الأمريكيتين وأفريقيا الغربية، لكن بسبب الأوضاع الاقتصادية التي ستمر بها البلدان المضيفة في الثلاثينيات المنصرمة، سوف يتراجع زخم هذه الهجرة، بل وسوف يعود بعض المهاجرين إلى البلاد
ثالثاً – في الجمهورية السورية، ثم في المملكة الأسدية
بعد الاستقلال، سيتراجع حديث المكونات «مسيحيين وسنة… إلخ»، لصالح تصورات تسعى أو تجتهد للكلام عن شعب واحد بهوية وطنية سورية، أو عروبية. تذهب كارولين دوناتي إلى أن نسبة المسيحيين في سورية عشية الاستقلال 14% من سكان سورية
وبعيداً عن أعيان المدن، توزع المسيحيون على معظم أرياف المحافظات السورية، وكان عملهم الرئيسي هو الزراعة «الفلاحة»، أسوة بمعظم أهل الريف السوري. ومع بروز «القضية الفلاحية» في الخمسينيات المنصرمة، وكان أكرم الحوراني أبرز من عبّر عنها، انجذب فلاحون مسيحيون إلى تلك القضية التي تنظر إليهم كطبقة ينبغي الاعتراف بها وبمصالحها والدفاع عنها. لذلك سيجد الحوراني من بين المسيحيين من يدعمه ويساند دعواه
ثمة مؤشرات إلى تراجع وضع المسيحيين وتزايد قلقهم في عهد الوحدة بين سورية ومصر، ليس لأن العروبة المصرية تحوي جرعات زائدة من الإسلام وحسب، وهو ما يوقظ المخاوف القديمة حول الوجود والضياع؛ بل لأن سياسات هذه العروبة كانت مستبعِدة للمسيحيين، فطوال سنين الوحدة لم يتقلد أي مسيحي منصباً وزارياً في الإقليم الشمالي «سورية»
في عهد البعث استمرَّ وزن المسيحيين في التراجع على صعيد الشأن العام، فخلال الصراعات بين ضباط البعث وغيرهم، أو فيما بينهم، التي ميّزت السنوات الأولى للبعث في السلطة، نكاد لا نجد اسماً مسيحياً وازناً بين هؤلاء. أما اجتماعياً، كنا قد رأينا كيف اجتذب البعث قبل وصوله إلى السلطة بعض الأوساط المسيحية، لكن بعد السلطة ظهرت بوادر معارضة واحتجاج عند المسيحيين تجاه بعض السياسات التي سعى إلى تطبيقها. يذكر كل من آني شابري ولوران تشابري في كتابهما «سياسة وأقليات في الشرق الأدنى»، أنه حتى عام 1967 امتنع رجال الدين المسيحيين عن التدخل في السياسة الوطنية للبعث، أو عن المشاركة في نقده الذي برز في أوساط دينية واجتماعية سنية محافظة، لكن مع إمعان البعث في فرض سياسات علمانية كان من نتيجتها «انحدار نفوذهم الاجتماعي والسياسي»، تغير موقفهم من البعث. كان لظهور مقال في مجلة «جيش الشعب» في نيسان 1967 يتعرض لفكرة الله والأديان، أن أثار الكثير من الاحتجاجات والمظاهرات، التي كان للمسيحيين حضور فيها، فقد شارك رجال دين أرثوذكس في «مظاهرات حماة المعادية للحكومة، وتدخل رؤساء الطائفة الكاثوليكية بدمشق للإفراج عن العلماء»
ما سيفعله حافظ الأسد في البداية هو أنه سوف يحاول استرضاء جميع النخب الدينية في سورية، السنّة أولاً ثم المسيحيين، عبر إقرار امتيازاتهم وخصوصياتهم، لا سيما بعد الاحتجاجات الكبيرة التي واجهته في 1973 على إثر الدستور الذي حاول تثبيته، والذي حذف منه الإشارة إلى دين رئيس الجمهورية، وهنا كانت المعارضة بشكل رئيسي من قبل فئات إسلامية محافظة. ومع اندلاع الحرب الأهلية في لبنان، سوف يتدخل جيش حافظ الأسد في البداية إلى جانب الطرف المسيحي ضد الفلسطينيين وقوى لبنانية متحالفة معهم. لم يجد هذا التدخل أثراً إيجابياً بين مسيحيي سورية، وأثار معارضات من قبل إسلاميين وتيارات يسارية، لكن انقلاب التدخل السوري ضد المعسكر المسيحي في لبنان أثار بعض القلق في أوساط مسيحية سورية تشارك المسيحية المحافظة في لبنان الرؤية في كون لبنان إنجاز المسيحيين وملاذهم. سنوات بعد ذلك ستبدأ المواجهات بين نظام الأسد والإسلاميين وستنتهي لصالح الأول في 1982، لكن الأسد سيستغل هذا الانتصار لتحقيق انتصار أكبر على المجتمع السوري ككل عبر القضاء على كل التنظيمات السياسية العلمانية اليسارية وعلى الحركة النقابية والطلابية أيضاً. أي القضاء على السياسة بوصفها فعالية تعكس مصالح الناس واختلافاتهم ومطامحهم، وتتيح لهم السعي للانتماء إلى فضاء عام مشترك كمواطنين في الدولة. آلاف الشباب والشابات سينتهون في المعتقلات والمنافي، وسيكون من بينهم مسيحيون انتمى معظمهم إلى اليسار السوري.
ستدخل سورية بعد ذلك في بيت الطاعة الأسدي، والمجتمع سيغدو غامضاً عصياً حتى على فهم أبنائه لأنه غدا موضوعاً أمنياً، فأجهزة الأمن هي الجهة الوحيدة المخولة بمعرفته ودراسته وإدارته. ولن يكون المسيحيون بعيدين عن هذا المناخ، إذ ستُلغى كل استقلالية كان قد سمح بها مضطراً نظام الأسد، وستغدو جميع الهيئات الدينية ملحقة به وتحت مراقبة الأجهزة الأمنية. وفق هذا الترتيب سيضطلع رجال الدين المسيحيين بدور الوساطة بين مجتمعاتهم المحلية وبين السلطة التي ستقرّهم على دورهم هذا وتمنحهم هذا الامتياز، وسيذهب بعضهم إلى ما هو أبعد نحو إقامة علاقات زبائنية مع جهات في الفروع الأمنية أو السلطة عموماً
نجح حافظ الأسد في حبس المسيحيين داخل الكنيسة، بعد أن أغلق كل الأبواب التي كان من شأنها أن يطل السوريين من خلالها على بعضهم بعضاً، واستسلم المسيحيون، كغيرهم، لهذا القدر القاسي. ويوماً إثر آخر تماهوا مع معجزة حافظ الأسد الذي استطاع أن «يمشي الذيب مع الغنمة»، فالذئب هنا هو ذلك المسؤول عن كل المآسي في تاريخهم. أمام حاضر فقير وسقيم ولا أفق فيه، كان يحضر هذا التاريخ لملء الفراغ، عبر حكايات الآباء للأبناء والأحفاد، أو عبر سياسة مدروسة تؤديها مؤسسات مسيحية أو رجال دين بإشراف سلطوي، والحكمة المستخلصة من هذه الرواية: «أننا بألف خير ما دام الوضع كذلك، وإلا…». بكلمة أخرى، سيغيب عن ذاكرة المسيحيين كل تاريخهم الغني، حتى القريب منه، وستثبت هذه الذاكرة عند مجزرة 1860، القابلة للتكرار إذا ما تحرر الذئب من سجن الصياد.
في عهد بشار الأسد، طرأ تغيير طفيف على المسيحيين، وهو أنهم كانوا أكثر ظهوراً مما هم عليه في عهد حافظ الأسد. لكن هذا الظهور في حقيقته لم يكن إلا ديكوراً يتزين به النظام لمعرفته بأهمية المسيحيين كوسيط بينه وبين العالم. قام بشار الأسد بتعيين عدة أشخاص من أصول مسيحية كمستشارين له، وكان لافتاً تعيين المهندس باسل قس نصر الله، وهو مسيحي، كمستشار لمفتي الجمهورية المسلم، أحمد بدر الدين حسون. وانتشرت صور بشار مع رجال الدين، مسلمين ومسيحيين، كدليل على «الوحدة الوطنية»، لكن لم يكن يوجد، على الأغلب، سوى وزير مسيحي واحد. بعد حرب العراق 2003، كان لافتاً موقف المسيحيين من الضغوط الخارجية التي أخذ يتعرض لها النظام، لا سيما إثر الفوضى التي وقع فيها العراق، والتي كان نصيب المسيحيين من مآسيها كبيراً، وجزء من هؤلاء لاذ بسورية حاملاً معه حكايات مروعة عما حل بهم
تتحدث الباحثة الفرنسية Anna Poujeau عن استعانة المسيحيين بروايات من دول الجوار أو من التاريخ، لتأكيد ما يذهبون إليه من خوف على مستقبلهم ومن احتمال استعادة وقائع الاضطهاد بحقهم. وذلك عبر رصدها لعائلة مسيحية تسكن في حي باب توما الدمشقي، مكونة من ثلاث أجيال: الجدة «أم وائل» وأبنائها وأحفادها. ترصد الباحثة الفرنسية مبررات وأشكال القلق والخوف لدى هذه العائلة بمجملها، ويكاد يصل القارئ إلى أن مخاوف أم وائل لا تختلف كثيراً أو جوهرياً عن تلك المخاوف التي لدى أبنائها وأحفادها المتعلمين، والذين انخرط بعضهم بالسياسة إلى حد ما، ويعتقد معظمهم أنهم من أهل الحداثة «الأبناء والأحفاد». ترى الباحثة أن «جيل» أم وائل يخاف لأنه ربما عانى، فأم وائل ولدت عام 1900 في إحدى قرى جبل العرب، وتحمل في جعبتها الكثير من الذكريات المؤلمة حول ظلم أصابها وأهلها أثناء مقامهم في الجبل وغيره، لكن أولادها لم يروا مثل هذه المعاناة. بِنت أم وائل شيوعية، لكنها مسيحية تخشى على المسيحيين في حال اهتزَّ الوضع القائم. والأبناء والأحفاد يعتقدون أن حال الاضطهاد الذي رأته أم وائل سيعود عليهم إذا ما تغيرت الأحوال، أو أن تمييزاً سيحلُّ عليهم فيما إذا أظهروا صلبانهم أو دينهم. تقول الكاتبة: «إنهم يعيشون هذا كما لو أنهم شهدوا ما شهدته أم وائل»
بهذه الحال استقبل مسيحيون سوريون الثورة السورية عام 2011، وكان عددهم يقدر آنذاك بحسب الباحثة الفرنسية Anna Poujeau بنحو 6% من عموم السكان السوريين
رابعاً – مسيحيو سورية بعد الثورة
انفجار البركان السوري عام 2011 كان إيذاناً بانزياحات مجتمعية كبرى، وبسورية جديدة لن يكون ما قبلها مشابهاً لما بعدها. تبدّى هذا منذ البداية ولا يزال، وتشهد على ذلك المآلات التي وصلت إليها البلاد اليوم. مسيحيون سوريون بدأوا الحديث عن المؤامرة والإرهاب والسلفيين منذ آذار 2011، في استعادة ضمنية ربما لــ «الحكمة» التي أوردناها في الفصل السابق من هذا البحث: «إننا بألف خير ما دام الوضع كذلك، وإلا…».
وفي الاصطفافات والمواقف، ينتشر في صفوف طرفي الصراع في سورية، إن جاز الحديث مجازاً عن طرفين، خطابٌ يقول بـ «وقوف المسيحيين مع النظام». يثابر على تكرار هذه المقولة موالون لهذا الأخير ومعارضون له، يرون إلى المسيحيين كتلة متجانسة تقف مع نظام الأسد وحلفائه في حربهم على عموم السوريين الثائرين، وجلّهم، موضوعياً، قَدِمَوا من بيئات «سنّية».
نقد الاستسهال القائم على إطلاق حكم على جماعة بشرية غير متجانسة اجتماعياً وطائفياً وسياسياً، لا يعني على أي حال عدم وجود ملامح عامة، صبغت هذه «الجماعة» الأهلية – الطائفية أو تلك في سورية، فيما يتعلق بالموقف من الحدث السوري، في ظل غياب أو عدم بروز اختراقات كبيرة ووازنة ضمن الجماعة الواحدة على مستوى الموقف مما يحدث في البلاد.
يروّج النظام سردية وقوف المسيحيين «والأقليات عموماً» معه، دعماً منه لرواية حربه المزعومة على الإرهاب، معرِّفاً الإرهاب بالمعارضة، والإرهابيين بكل المعترضين عليه والثائرين في وجهه. هذا مع تصدّر الحرب على الجهاديين والتكفيريين وسائل الإعلام الدائرة في فلكه، وتصدّرها خطاب الخائفين من التغيير وأيضاً، خطاب الشرائح المرتبطة مصالحها ببقاء الأسد «مسيحيين وغير مسيحيين» والمستكينة إلى استقرار الــ «كنا عايشين». وعلى الجانب الآخر، لا ينقص المعارضةَ طائفيون على مستوى الأفراد أو التشكيلات يسوقون رواية النظام ذاتها تجاه موقف المسيحيين والأقليات عموماً منه، وإن على أرضية مختلفة ولدوافع مختلفة عن دوافعه، بما يقوم لدى هؤلاء الطائفيين على افتراض «سنّية الثورة» و«أحقية السنّة بها» دون غيرهم.
خارج هذه الثنائية، «نظام ومعارضة سياسية وعسكرية»، تقع مساحة سوداء يشغلها تكفيريون جهاديون أقاموا لهم دولة إسلامية «داعش»، وجهاديون تكفيريون في العمق وعلى السطح، يحلو للبعض تصنيفهم ضمن إطار «المعارضة المعتدلة» تمييزاً لهم عن «داعش» فقط، وليس تمييزاً لهم بــ «الاعتدال» المفترَض. ولهذا التوصيف ودوافعه ونتائجه مقامٌ آخر. يعمل الإسلاميون الجهاديون هؤلاء على فرض نموذج معياري للإسلام لا ينطبق، كما نفترض، على شريحة كبيرة من السوريين السنّة. فكيف سيكون الحال مع من ليس سنياً؟ واستطراداً وعلى نطاق أعمّ: مع من ليس مسلماً؟
في النتيجة ومع اندلاع الثورة السورية، انقسم المسيحيون إلى ثلاثة فئات، بحسب بروفسور اللاهوت المسيحي في كلية هارفرد للدراسات الدينية نجيب عوض
هذه «الأغلبية الساحقة» من المسيحيين في سورية تنحاز، بحسب عوض إلى «التغيير ونهاية عهد الاستبداد والقمع والديكتاتورية، لكنها لا تعتقد أن هذا يمكن أن يتحقق بالعنف والحرب والقتال، وكذلك لا تشعر بأن البدائل السلطوية التي يمكن للمعارضات السورية أن تجلبها تستحق الثقة بها».
من الصعوبة بمكان، الوصول إلى إحصائيات أو نسب تقديرية لهذه الفئة أو تلك من عموم المسيحيين في سورية، ولا نعرف من أين استقى بروفسور اللاهوت المسيحي نسبة الأقلية هنا أو الأغلبية الساحقة هناك من بين الفئات الثالثة التي ذكَرها، إلا أن هذا التقسيم إلى ثلاث فئات والذي قدّمه البروفيسور عوض، يبقى صحيحاً بالعموم ويصحّ أن يكون نموذجاً لانقسام الشارع السوري والشعب السوري على أرضية الموقف من الثورة، مع اختلاف النسب والدوافع التي تقف وراء هذا الموقف وخصوصاً لدى تناول الجماعات الأهلية أو الطوائف، على ما يكتنف ذلك التناول من خطورة واستجرارٍ لمفردات الاتهام بــ «الطائفية والدعوة إلى التقسيم» على أرضية «الوحدة الوطنية».
مخاوف المسيحيين اليوم باتت أمراً واقعاً، بعد أن كانت غير مبررة في بدايات الثورة السورية عام 2011، يوم لم يكن ثمة «جهاديون» في سورية إلا النظام. الخوف الاستباقي من التكفيريين، والذي انتصب في البدايات، صار اليوم حقيقةً وواقعاً. حقيقةٌ وواقعٌ لا يعنيان، على أي حال، وعياً استشرافياً للمستقبل، رصيناً، لدى الجماعات الخائفة من هذا المستقبل، بقدر ما يطرحان أسئلة الاجتماع والوطنية السوريتين، وما إذا كانت الوطنية ناجزة فعلاً في ظل نظام الأسدَين «حافظ وبشار» أو حتى قبلهما، وهو ما نميلُ للإجابة عنه بالنفي. «الوطنية» في أحد تطبيقاتها، كانت شعاراً إعلامياً وسياسياً يستر عورة التناقضات الاجتماعية واللعب السياسي عليها. ناهيك عما رافق مسارات الثورة من تمرحلات بالتزامن مع الحل العسكري وحرب الإبادة التي خاضها ولا يزال يخوضها الأسد ضد معارضيه وحواضنهم، وخطاب قبل وطني «أو بعد وطني، إسلامي مرتبط بمشروع عابر للدولة». هذا الكلام هو مقدمة للدراسة والإضاءة على تفاصيل بعض المجتمعات المسيحية في سورية بعد الثورة بما لا يدعي الإحاطة الكاملة في هذا البحث، بعيداً عن أي حكم قيمة تبعاً لثنائية «الخير والشر». هو محاولة لفهم واقع المسيحيين انطلاقاً من مسار الأحداث، الذي لا ندعي القدرة على رصده بالمطلق.
الثورة على تخوم الأحياء المسيحية
«عندما عدتُ يوم 18 آذار إلى المنزل، كنتُ أخبرُ والديَّ وقد توقعتُ أنهما قد سمعا الأخبار مثلي، وأثارت لديهم ردة الفعل عينها، وكان في زيارتنا بعض الأقارب. وما إن تحدثتُ بالأمر، حتى فوجئتُ بالجميع. بعضهم وصفها بالمشكلة العرضية، وآخرون أكدوا بأن سورية لن تعرف شيئاً مما حصل في مصر. والأكثر صدمةً، كان من أدان أهالي درعا وأطفالهم، بحجة أنهم يعلمون بطش النظام، ورغم ذلك قرروا تحديه بمثل هذه الفعلة غير المسؤولة»
عمد ناشطون في الثورة، والمسؤولون عن تسمية أيام الجمعة التي تشهد التظاهرات في كافة أنحاء البلاد في العادة، إلى مخاطبة المشاعر الدينية لدى الأقليات بهدف «توظيفها إيجابياً» على ما راج وقتها، لصالح «دعم فكرة وطنية الثورة ولا طائفيتها ولا مذهبيتها». ويمكن استحضار ذلك في مثالَي «جمعة صالح العلي، 17 حزيران 2011»ـ بما تحمله من رسالة للعلويين، و«الجمعة العظيمة، 22 نيسان 2011» في رسالة إلى مسيحيي سورية في تلك المناسبة المقدسة لديهم.
وفي «الجمعة العظيمة»، تتحدثُ ماريا أنه «كان من المفترض في هذا اليوم أن تتجه المظاهرات من مختلف المناطق المحيطة بالجهة الشرقية من العاصمة باتجاه ساحة العباسيين، التي تشكل معظم شوارعها مراكز الثقل المسيحي، لكنّ الهدف كان لكونها ثاني أهم وأكبر ساحة في دمشق من بعد ساحة الأمويين، واحتلالها لاعتصامٍ سلمي سيكون في صالح الثورة السلمية ومركز حشدٍ هام».
وتكمل بالقول «كنا أنا وعدد من أصدقائي نستعد للمشاركة إلى حين سمعنا الجيران والأهالي يتحدثون (لقد وصل الإرهابيون، إنهم قادمون لاحتلال القصاع). لا أعلم لماذا لم يرغبوا بتصديقهم، وفضلوا تصديق شائعات النظام، كان التغيير يخيفهم».
ومن ضمن الشهادات نفسها الموثقة في كتاب «سورية، اللعب على الورقة الطائفية»، يتحدث سالم: «رآني صديق من خلال نافذته فصاح لي لأصعد مسرعاً، حيث قام بسحبي إلى الداخل، ووجدت في ضيافته عدداً من الأصدقاء الذين تواروا في منزله. وجدت مجموعة من الرجال المسلحين كانوا يرتدون الجعب والملابس عينها التي رأيناها في فيديو البيضة قبل أيام، حتى أني شككت أن واحداً منهم كان ممن ظهروا في الشريط». يسمع سالم هتافاتٍ من الشارع «شبيحة للأبد» و«الله سورية بشار وبس»، يضيف: «كان صياحهم مسموعاً وواضحاً وهم يطلقون الرصاص في الهواء، إلا أني لم أكن أرى المتظاهرين على الإطلاق… لا أعلم إن كنت واهماً إلا أني سمعتُ من بعيد هديراً يقول: (حرية حرية، والشعب السوري واحد). في تلك اللحظة شعرتُ أني لست وحيداً، وأن هناك من يدعمني وهم أولئك القادمون من بعيد».
كان عناصر من الشبيحة يقفون عند مدخل سوق الهال، ومعهم أسلحتهم، ثم دخل جزء منهم إلى الداخل، وأخذوا بإطلاق الرصاص، ليرى أهالي الحي أن الرصاص بدأ من الداخل وليس من الخارج. «كانت لعبةً قذرة جداً، وهكذا أطلقوا النار وهم يحملون مبرراتهم (وإن كانوا ليسوا بحاجةٍ لها) أمام أهالي المنطقة، ودخلوا جميعاً مع وصول المظاهرة، سقط يومها حوالي 200 شهيد في أكثر من نقطة… كانت مجزرةً حقيقية»
في المقابل، تتحدث وئام قائلةً عن اليوم ذاته: «كان يوم عيد، وكنا مستعدين للذهاب إلى الصلاة ككل عام أنا وأطفالي، وقد كانت صلاة هذا العام مميزةً أكثر كون العيدين الشرقي والغربي قد توافقا في اليوم عينه، لذلك كانت أبواب جميع الكنائس مفتوحة… سمعتُ في الأخبار أنهم سموا الجمعة باسم الجمعة العظيمة، ماذا يريدون من هذا الأمر التجاري؟؟ لن يستطيعوا أن يمرروا مؤامرتهم بهذه التسمية، ما يفعلونه واضحٌ لنا جميعاً. إنها مؤامرة غربية وللأسف خليجية من أجل الصهيونية ومصلحة إسرائيل، وكلنا نعلم بمخطط تفريغ منطقة الشرق الأوسط من المسيحيين». وتكمل بالقول: «شعرتُ بشيء يشبه ما حصل أيام الثمانينيات عندما هجم الإخوان المسلمون، وخلصَنا حافظ الأسد منهم. واليوم كانت لدي الثقة بأن بشار الأسد سيفعل بالمثل مع السلفيين… لقد بدأوا بإطلاق النار، وأصاب أهالي الحي الذعر، لماذا يريدون القدوم إلى حينا؟؟ ماذا سيفعلون هنا؟؟. لقد أرادوا إفساد العيد علينا، ولكن الحمد لله استطاعت قوات الأمن أن تتصدى لهم»
في حمص، قتلت قوات الأمن متظاهرين في «ساحة الساعة» بتاريخ 18 نيسان، على خلفية الاعتصام الذي شهدته الساحة. وأثناء مرور المشيعين في أحياء تشهد كثافة سكانية مسيحية نسبياً فيها، مثل باب السباع والحميدية وبستان الديوان، لقي المشيعون تضامناً ملحوظاً معهم من توزيع الماء البارد عليه من قبل مسيحيين من تلك الأحياء وصولاً إلى مشاركة هؤلاء الأخيرين في تشييع شهداء المجزرة إلى مقبرة باب النصر. وبعد دفن الشهداء توجهت حشود المشيعين إلى ساحة الساعة الجديدة التي كان محظوراً الاقتراب منها. و«بدأ الاعتصام بمجموعة من وجهاء حمص ونشطائها وشيوخها وكهنتها. والجدير بالذكر أن من قام بإنارة الساحة هو رجل مسيحي يدعى أبو جورج، تبرّع بذلك دعماً للثورة»
وفي بعض التفاصيل، قصف طيران النظام السوري يوم الأربعاء 14 تشرين الثاني 2012 قرية تل نصري، وهي قرية آشورية مسيحية تبعد عن محافظة الحسكة 45 كم، واستهدف قصف القوات النظامية كنيسة السيدة العذراء يوم الثلاثاء 4 أيلول 2012، وكذلك كنيسة القديس جاورجيوس قرب مدينة جسر الشغور، وكنيسة أم الزنار في حمص التي قامت القوات النظامية بدخولها وسرقة محتوياتها. وعلى الصعيد ذاته أيضاً، ضربت القوات السورية النظامية دير سيدة صيدنايا بقذيفة غير متفجرة على خلفية قيام القائمين على الدير بإيصال الأدوية والمساعدات الإنسانية إلى المناطق القريبة المتضررة. «للمزيد يمكن قراءة تفاصيل إضافية في التقرير المنشور على الرابط أدناه في الهامش».
بتاريخ 29 آذار 2011، اجتمع مجلس أساقفة الكنائس المسيحية في دمشق وأصدر بياناً واضحاً في تأييده للنظام ولرئيسه بشار الأسد، إذ اعتبر البيان أن «ما يحدث في بلادنا هو مؤامرة خارجية اشتركت فيها، مع الأسف، أيادٍ داخلية وزادت في أوارها الوسائل الإعلامية المغرضة التي حاولت تشويه الصورة المشرقة التي تتمتع بها سورية في الداخل والخارج… نشدد في هذا الظرف على الوحدة الوطنية وعلى عدم الانزلاق إلى الفتنة الطائفية. إننا نبارك لشعبنا الأبي بما باشر به رئيسنا الدكتور بشار الأسد، العين الساهرة على الوطن، من إصلاحات، ونرجو أن تُتابع هذه الإصلاحات، كما نأمل أن تكون هذه الأحداث مناسَبة لِوَقفة ضمير لكل مواطن سوري، مسؤولاً كان أم غيرِ مسؤول، للانطلاق إلى مستقبل أفضل… وندعو الجميع أن يصلّوا من أجل بلدنا، ليبقى الله حامياً لسورية». من جانبه، قال البطريرك مار إغناطيوس زكا الأول عيواص، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع، في بيان صدر عن «بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذوكس» بتاريخ 3 نيسان 2011 أنه «يدين وبشدة اندساس بعض الأيادي الغريبة التي تُحرك ضعاف النفوس لتأليب الرأي العام في الداخل والخارج، للوصول إلى مآرب خاصة لا تخدم مصلحة سورية ومواطنيها الشرفاء، بل تضع سورية أمام مفترق طرق لا أحد يعلم نهايتها، وقد أخطأ العقل المدبر لهذه المؤامرات إذ اعتقد بأن إشعال نار الفتنة الطائفية سيقضّ مضجع السوريين، ويضعضع الجدار المتين الذي يحمي سورية ويمتعها بالأمن والسلام». وتابع عيواص في بيانه «كلنا ثقة بقائدنا الهمام السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد، الذي منحه الله حكمة الشيوخ وهمة الشباب، بأنه سيُخرج سورية من هذه الأحداث الأليمة بحلةٍ جديدة، وبشكل يضمن لجميع المواطنين الشرفاء كافة حقوقهم المشروعة».
وفي السياق ذاته، ناشد «بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والاسكندريّة وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك»، غريغوريوس الثالث لحام، دول العالم بتاريخ 16 نيسان 2011، «ترك سورية لمواطنيها»، قائلاً: «اتركوها للسوريين وكفاكم إرسالاً للسلاح والمحاربين والمرتزقة والمجرمين بل انزعوا السلاح ولنتحد»، معتبراً أن «الحرب والعنف والسلام لم ينجحوا! وتزويد المسلحين بالسلاح على أنواعه لم ينجح! نظرياتكم ونبوءاتكم بسقوط سورية رئيساً وحكومة، منذ بداية الأزمة وفي أشهرها الأولى عام 2011، لم تنجح».
لا يمكن اختزال كل مواقف رجال الدين المسيحيين بالمواقف الثلاثة آنفة الذكر وغيرها من مواقف محابية لنظام بشار الأسد، إلا أنها تشير إلى الصلة الوطيدة التي تربط كثيرين من رجال الدين المسيحي في سورية بالنظام تاريخياً، وهو ما يتبدى في المواقف المعلنة من قبل هؤلاء. وهؤلاء، بطبيعة الحال، لهم تأثيرهم الاجتماعي وليس الديني فقط، على بعض المسيحيين السوريين. الحديث عن الإرهاب والتطرف والفتنة الطائفية كان حاضراً في خطاب وعِظات هؤلاء البطاركة والأساقفة منذ عام 2011.
يمكن بالمقابل، ذكر مثالين فاقعين على خطاب مسيحي ديني في أماكن مختلفة من سورية، وخارج دمشق، كان مغايراً لمواقف رجال الدين المسيحيين آنفي الذكر، مثلاً لا حصراً، هما الأب فرانس فاندرلاخت والأب باولو دالوليو.
الأب فرانس فاندرلاخت، والمعروف بعمله الإنساني لصالح الناس المحاصرين في حمص، هو راهب هولندي الأصل يقيم في سورية منذ العام 1966، ولم يغادر حمص طيلة فترة حصارها حتى اغتياله في حي بستان الديوان بتاريخ 7 نيسان 2014. تبادَل النظام والمعارضة الاتهامات في قضية مقتل الأب فرانس على يد أحد الملثمين، الذي أرداه قتيلاً برصاصتين في الطريق أمام منزله.
في تقرير أعده موقع NOW حول اغتيال الأب فرانس، تحدث بعض أبناء المدينة عن احتمال كونه استُهدِفَ من قبل المعارضة. ويتحدث نبيل الحمصي قائلاً: «جهات إسلامية متشدّدة كانت تضمر العداء للأب فرانس بسبب انتمائه الديني. وفي الآونة الأخيرة، راجت الكثير من الإشاعات التي تُسيء إلى سمعة الكاهن المسيحي، إذ روّج الإسلاميون معلومات تفيد بأنّه يعمل لصالح النظام ويمدّه بالمعلومات عن مواقع الثوار وتنقلاتهم».
ويكمل الحمصي: «صحيح أن هذه الإشاعات لم تجد صداها بين سكان حمص المحاصرة بحكم العلاقة المتينة التي تربطهم بالأب فرانس، لكنّها كشفت الأخير أمنياً وجعلته هدفاً سهلاً لأي جهة معارضة تختلف معه عقائدياً»
تلك العلاقة المتينة التي كانت تربط الأب فرانس بالمحاصرين، كانت سبباً لاتهام البعض الآخر النظام السوري باغتيال فاندرلاخت، فــ «وجود الأب فرانس في حمص المحاصرة قرابة عامين، يكفي ليدين النظام بأنه غير حامٍ للأقليات كما يدعي»
كتبَ الأب فان درلاخت في ذكرى مرور أول سنة على بدء قوات بشار الأسد بمحاصرة حمص وأهلها:
«سنة كاملة في حالة الحصار. إن جماعتنا الآن متألفة من 75 شخصاً، نصفهم عازبون ونصفهم متزوجون. تعيش أكثرية المتزوجين دون شريك ودون أولاد، وقد توفي في مرحلة الحصار 15 شخصاً موتاً طبيعياً، نقدّس يوم الأحد مع بعضنا البعض في كنيسة الآباء اليسوعية ونعطي بقدر الإمكان لكل طقس حقه. معظمنا من طائفة الروم الأرثوذكس ونجد أيضا مؤمنين من طوائف أخرى مثل السريان الأرثوذكس، الروم الكاثوليك، السريان الكاثوليك، البروتستانت، نجد بعضنا البعض بعد الصلاة بلقاء أخوي وبزيارات بيتية. ندعو الجماعة يوم الأربعاء إلى الفطور وتحضّر جماعة من الدير المناقيش للجميع على نار الحطب. تحب الجماعة الالتقاء ببعضها البعض وتقدم خدمات للمحتاجين، يطبخ البعض مزيداً من الأكل حتى يستطيعوا التوزيع على الآخرين، نجد اهتماماً خاصاً للمسنين ويشعر كل واحد بأنه لا يعيش وحده، بل منتمياً إلى جماعة، إن هذا الانتماء مهم لأن كل شخص يعاني كثيراً من الصعوبات ويعيش الظروف المؤلمة مختلفاً عن الآخر، ننتظر في كل مرة أن يكون الفرج قريباً ويستعمل أناس العبارة –بهاليومين- بل أصبحت هاليومين أسبوعاً وشهراً وسنة، وعلينا أن نصبر كل مرة من جديد ونواجه المجهول والمخيف. انتقل أناس من بيوتهم إلى بيت جديد بسبب الخطر وغيرهم يعانون من تضرر بيوتهم، ويتساءل الكل: ماذا سيحدث؟ كل شيء ممكن. إن أبعاد خلفيات ظروفنا غامضة وعلى التاريخ توضيحها وإدراكها، شخصياً أشعر بأهمية هذه الظروف ولا أحب أن أكون في مكان آخر، ولي الشرف أن أعيش تقريباً 50 سنة في هذا البلد العزيز عليّ واغتنيت بكنزه وتعاملت معاملة أخوية ومحبة، مثلما شاركت سورية بفيضها، أحب أن أشاركها الآن بألمها، تسمح لي ظروفي أن أتواصل كل يوم من الداخل مع الشعب السوري وألمه ولا يمكن هذا التواصل إلا بمشاركة يومية وواقعية… لا أستطيع أن أتخيل نفسي في مكان آخر».
وانتقد الأب فرانس في حديث إلى وكالة «فرانس برس» المجتمع الدولي قائلاً
الأب باولو دالوليو، كاهن يسوعي إيطالي أمضى حوالي 30 عاماً في سورية، قبل أن يقوم نظام بشار الأسد بنفيه من سورية في حزيران 2012، على خلفية موقفه الداعم للثورة السورية والذي يدين العنف والقتل المستمر فيها. لقد قرر النظام إبعاد الأب الإيطالي بذريعة أنه «خرج عن نطاق مهمته الكنسية». وذكر ناشطون في تقرير أعدته جريدة «الشرق الأوسط» أن «مغادرته تأتي بعد إنهاء خدماته من قبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام، بعد خدمة استمرت أكثر من 30 عاماً في سورية». الجدير بالذكر أن البطريرك لحام الذي أنهى خدمات الأب باولو هو نفسه صاحب العظة المذكورة أعلاه، والتي يطالب فيها «المتآمرين» قائلاً «اتركوها للسوريين وكفاكم إرسالاً للسلاح والمحاربين والمرتزقة والمجرمين، بل انزعوا السلاح ولنتحد».
في مقابلة معه بعد أن طرده النظام السوري من سورية، اعتبر الأب باولو أن «الشعب السوري دفع ثمناً مرعباً، لكن التراجع إلى الوراء مستحيل، والمجتمع الدولي صار مقتنعاً أن هذا النظام غير قادر على إحداث التحول الديموقراطي. التغيير قادم ومتوقع من قبل الجميع… لكن الوقت أصبح قصيراً لأن الناس يموتون بالشوارع وهناك مشكلة إنسانية بالدرجة الأولى ولا بد للمجتمع الدولي أن يقوم بمهماته. الشعب السوري يطالب بحرياته ولكن سقط هذا الشعب بحالة الحرب الأهلية». وتابع قائلاً «سورية جُعلت حلبة للحرب الأهلية والحرب السنية-الشيعية. وأنا أخشى أن عدم سقوط النظام سيطيل الموضوع ويوطد الحرب الأهلية على الأرض مما سيجعل من المستحيل على المسيحيين البقاء في سورية». عاد الأب باولو إلى سورية عبر الحدود الشمالية أكثر من مرة. وأخيراً، وفي 28 تموز 2013، توجه إلى مدينة الرقة في محاولة منه لـ «مقابلة قياديين في تنظيم الدولة في المدينة لطلب الإفراج عن المعتقلين السياسيين»
واستطراداً، فإن للأب باولو رمزية أخرى تضاف إلى رمزيته الشخصية لدى عموم السوريين الثائرين والمعارضين لحكم الأسد، وهي أنه الإنسان الذي ربما يكون قد دفع حياته ثمناً لمواقفه المناهضة لسياسة النظام والتكفيريين المنتشرين اليوم على أرض سورية. الأب باولو كان يعرّف نفسه في كلماته وخطبه وكتاباته بأنه صلة وصل بين مسلمين ومسيحيين في سورية والمنطقة على طريق خلاص السوريين من عذاباتهم. لم يطرح نفسه نداً وخصماً مباشراً لخطاب رجال المسيحيين المحابين لنظام دمشق، لكنه كان فاعلاً وحاضراً بسلوكه وخطابه ومشاركته السوريين في حراكهم بما جعله نقطة تحول في نظرة مسيحيين إلى مسلمين وبالعكس. وفي آخر منشور على «فيسبوك» قبل تغييبه، كتب باولو دالوليو: «أصدقائي الأعزّاء، جئت اليوم إلى مدينة الرقة وأنا أشعر بالسعادة لسببين: أولهما أنني على أرض سورية الوطن وفي مدينة محررة، والسبب الثاني الاستقبال الرائع من قبل هذه المدينة الجميلة. لقد عشتُ أمسية رمضانية من أحلى ما يكون والناس في الشوارع بحريّة ووئام، إنها صورة للوطن الذي نريده لكل السوريين. طبعاً لا يوجد شيء كامل، لكن الانطلاق جيد، أدعو لي بالتوفيق من أجل المهمة التي جئت من أجلها. إن الثورة ليست توقّعات بل التزام! السلام عليكم وشهر رمضان كريم علينا أجمعين».
وسواء كان قد اختطف «أو ربما قتل» بسبب «ذميته» وهو الكاهن المسيحي، أو بسبب مواقفه السياسية تجاه التشدد الإسلامي، أو حتى في إطار تنسيق بين تنظيم داعش والنظام على ما لوح ناشطون ومحللون كثر، فإن تغييبه هو انعكاس لصورة سورية اليوم، التي تتناهش مكوناتها الطائفية والدينية أنياب النظام وحلفائه من جهة، وسكاكين ورصاص الإسلام الجهادي «المترفّع» عن كل ما هو سوري.
وعن دور رجال الدين المسيحيين أيضاً في موقف مسيحيي سورية تجاه الثورة، اعتبر جورج صبرة، رئيس المجلس الوطني السوري سابقاً أن «عدم تحرك المسيحيين في سورية إلى جانب إخوانهم بشكل فعال في الثورة، يرجع إلى تأخر الكنيسة في إظهار موقف حقيقي يضع المسيحيين في قلب الصورة»، معتبراً أن «هناك مسؤولية على الكنيسة في هذا التقصير، لكن المسيحيين عاجلاً أم آجلاً سينخرطون في الثورة».
وحول ولاء المسيحيين في سورية للنظام حتى الآن، علّق صبرة في كلامه الذي يعود إلى شباط 2012، بأن «هناك في الطائفة المسيحية السورية من يصطف مع النظام، ومن هو موجود في صفوف المعارضة، مثل بقية الطوائف. وعلى مستوى النخب، شارك المسيحيون بفعالية في جميع نشاطات الثورة، من الميدان وحتى المنابر السياسية والإعلامية، أما على مستوى الكتل الجماهيرية وكتل المجتمع، لم يتحرك المسيحيون في صفوف الثورة». لكنّ صبرة لم يستمر على قراءته تلك لقضية مشاركة المسيحيين في الثورة من عدمها، بل ذهب في المغالاة ليكون «ملكياً أكثر من الملك»، وهو المسيحي في جذوره الاجتماعية والأهلية، واليساري والعلماني بتنظيمه السياسي «قيادي في حزب الشعب الديمقراطي السوري»، حيث استغرب لاحقاً «إدراج الولايات المتحدة جبهة النصرة على لائحة الإرهاب»، مشدداً على أن «الشعب السوري يعتبرها جزءاً من الثورة».
قضية راهبات معلولا
في أوائل كانون الأول 2013، احتجزت «جبهة النصرة» 13 راهبة وعاملتين في دير «مار تقلا» الأرثوذكسي في بلدة معلولا، بعد قيامها إلى جانب فصائل عسكرية غيرها بهاجمة البلدة القريبة من دمشق، وأُفرج عنهن في العاشر من آذار 2014 بوساطة قطَرية، في مقابل إطلاق النظام سراح 150 امرأة سورية من النساء المعتقلات في سجونه.
القضية هذه كانت مثار تناقض في طريقة تعامل النظام السوري وإعلامه معها، فهي بدأت بترويج ظاهرة الخطف التي قامت بها الجبهة بحق الراهبات، بما يعنيه ذلك من تعزيز لرواية خطر الجماعات التكفيرية على الأقليات الدينية والطائفية «وهذا قول صحيح على أي حال، بعيداً عن دوافع النظام للعمل به وترويجه». إلا أن الموضوع اختلف اختلافاً جذرياً بعد نقل الراهبات إلى معبر المصنع على الحدود السورية – اللبنانية، حيث انتشر تسجيل يظهر تّوجُّه إحدى الراهبات بالشكر «على المعاملة الجيدة لجبهة النصرة بحقهن أثناء الاحتجاز».
التصريح كان إيذاناً بانقلاب خطاب النظام السوري تجاه الراهبات الخارجات من الأسر، حيث قالت وسائل إعلامه في نشرات الأخبار: «أن تنسى راهبة تم تحريرها، أو تتناسى، الجيش العربي السوري ودماء شهداءه، فذلك يندرج في خانة الخيانة، أو على الأقل: الانحراف عن الوطن. موقفٌ أقل ما يقال عنه أنه صادم، موجع، حين تقول من نذرت نفسها لخدمة الرب ما لا يقوله أبناء سورية الذين عاشوا محنتها يوماً بيوم وساعة بساعة، ودفعوا لأجل أن تظل سورية مهداً للعيش المشترك، الدم والروح، ضريبة انتماء ووطنية وكرامة… إن كلام تلك الراهبة يرقى إلى وصمة العار…»
شكلت تصريحات الراهبة صدمة لمعسكر النظام، ومن ضمنهم مسيحيون، لما تحمله هذه التصريحات من دلالات بدا وكأنها تصب في صالح جبهة النصرة. وعلى هذا، أعدّ ناشطون مسيحيون عريضة تخاطب البطريرك يوحنا العاشر اليازجي، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذوكس، تدعوه إلى طرد الراهبة «بيلاجيا سياف» رئيسة دير مار تقلا ببلدة معلولا من الخدمة الكنسية، وتضمنت العريضة اتهاماً للراهبة إياها بأنها على صلة مع حزب «القوات اللبنانية» الذي يتزعمه سمير جعجع.
يَعتبر الكاتب والصحافي السوري إيلي عبدو في قراءته لدلالات تلك المواقف وتحولاتها، وتعبيرها عن طبيعة علاقة النظام مع الأقليات، أن «عموم المسيحيين تمنوا لو أن راهبات معلولا لم يتفوهن بكلام يخدش موقفهم الكلاسيكي الداعم، كما يقولون، للدولة. فحملة الموالين المسعورة بدت إهانة معنوية قاسية. فالراهبات يمثلن امتداداً للمؤسسة الكنسية التي تمثل المسيحيين حالياً، وشتمهنّ وإذلالهنّ كلامياً هو في عمقه شتم وإذلال للكنسية. ما يعني أن نظام الأسد أراد أن يوبخ الأقلية التي حاولت التمرد عليه، على رغم كل المشاق التي يتكبدها بغرض حمايتها، فدفع مواليه نحو إهانة الراهبات».
وفي معلولا أيضاً، وفي 4 أيلول 2013، هاجمت جبهة النصرة حاجزين للنظام في منطقتي عين التينة وجبعدين، تم الحسم السريع فيهما لمصلحة «االنصرة» ومن شارك معها من فصائل أخرى. وبعد فرار عدد من عناصر النظام الذين كانوا يتمركزون على الحاجزين إلى داخلها، اتُّخذ قرار من أمير «النصرة» في القلمون والملقب بـ «أبي مالك» بملاحقة العناصر ودخلت «النصرة» إلى معلولا. وسط هذه الأجواء التي بدأ العنف يتصاعد فيها وسط البلدة، بدأ أهالي البلدة بالنزوح إلى خارجها، قبل أن «يُتخذ قرار من الجيش الحر وجبهة النصرة بالانسحاب الفوري من المدينة» بحسب القيادي المعروف في المعارضة السورية والمعتقل الحالي في سجون النظام فائق المير، والذي كان على اتصال ببعض الكتائب المقاتلة في هذه العملية. واعتبر المير أن «الكتائب على ما يبدو تختلف من منطقة الى أخرى»
إعلام النظام تعامل مع ما حصل بالآلية المعروفة عنه ذاتها، وصارت مسألة حماية الأقليات حاضرة مجدداً بالارتكاز إلى اقتحام البلدة من قبل المعارضة المسلحة. حصل ذلك، «للمصادفة»، بعد حوالي أسبوعين من ارتكاب الأسد مجزرة الغوطة بالسلاح الكيماوي «21 آب 2013»، والتي قضى فيها أكثر من 1400 سوري في ليلة واحدة، وما تلاه من احتمالات توجيه ضربة عسكرية أمريكية عقابية نتيجة استعماله السلاح الكيماوي.
البطريرك لحام تحدث عن «محاولات تخريب حصلت في كنيسة مار الياس، وأن عمليات سرقة للبيوت حصلت، وهناك صلبان تم تكسيرها». بعد ذلك، ظهرت الراهبة بيلاجيا مرة باتصالات هاتفية مع قنوات إعلامية لتتحدث «أن أحداً من الجيش الحر لم يقترب من الكنائس، وأنه لم يتم قتل أحد، وإنما هي حالة من الخوف سيطرت على المدينة بسبب أصوات القذائف وانتشار الدخان، وهو ما أثار رعبهم في البداية».
روسيا والغرب، و«مغناطيس» المسيحيين الجاذب
قضية راهبات معلولا اللواتي اختطفن على أيدي جبهة النصرة، «خدمت» سردية النظام وحلفاءه في «محور الممانعة»، من دون أن تهتم تلك السردية اليومية المستمرة في مسارها بالبحث عن خدمة من هذا النوع. وحتى الطريقة التي تعامل بها إعلام بشار الأسد مع القضية عينها بعد تصريح الراهبة بيلاجيا سياف، لم تكن لتمحي الطريقة التي يتلقف بها النظام معطيات الواقع وتحولاته في خدمة خطابه. جاء الجهاديون السوريون وغير السوريين من المقاتلين على الأرض السورية ليقولوا للنظام بشكل غير مباشر: «نعم، أنت محقّ وعلى صواب».
الطريقة التي تعاملت بها التيارات القاعدية مع المسيحيين في سورية حين «استتبت» لها سلطة الأمر الواقع، كانت مجال استقطاب تحليلات غربية كثيرة، وكانت أيضاً «إحدى الأهداف» التي قال التدخل العسكري الروسي أنه دخل في سورية من أجلها. وهو تدخّلٌ في حلٍّ من هذه «الرسالة السامية» التي أناطها بنفسه على أي حال.
في الإعلام الغربي على سبيل المثال، عرضت القناة الأولى في شبكة ARD الألمانية وثائقياً عن الاضطهاد الذي يلحق بالمسيحيين السوريين، وعن هروب مئات الآلاف منهم إلى لبنان ومن ثم إلى أوروبا
لم يشرح المطران صليبا للغربيين الذين يشاهدون ذلك التقرير ما هي الفوارق بين الــ good friend الذي يشكله حزب الله له ولمسيحيين كثر «يحميهم الحزب» بحسبه وبحسب التقرير، وبين الإسلاميين الآخرين. وهي قصة بحاجة إلى الخوض الطويل في ماهية «حزب الله» كحزب طائفي أصولي يشبه الجهادية السنّية في مواضع ويختلف عنها في مواضع أخرى، وهي مسألة لم تَسأل عنها القناة الألمانية التي بثت لقاءات قصيرة مع مسيحيين موالين للأسد اختزلت مشهداً بالغ التعقيد بعبارة «الأسد يحمي الأقليات»، وهو ما لم يتأخر المطران صليبا في التشديد عليه.
مخاطبة الغرب واستثارة «فوبيا الإرهاب» منسوباً إلى الإسلام لدى المستعدين لتلقف تلك المخاوف في هذا الغرب، كان يسير على قدم وساق أيضاً في خطاب المسؤولين السوريين والإعلام الرسمي السوري. وربما يكون كلام بشار الأسد خير معبر عن ذلك في الحوار الذي أجراه معه الصحفي ريجيس لي سوميير، نائب رئيس تحرير مجلة «باري ماتش» الفرنسية، والذي تُمكن فيه ملاحظة جواب بشار الأسد لدى سؤاله عن رأيه بنظرة الرئيس السابق فرانسوا هولاند إليه شخصياً، وهو الذي تلخص بالقول «أنا لا أنافس هولاند على أي شيء. أعتقد أن من ينافسه في فرنسا الآن هو داعش لأن شعبيته قريبة من شعبية داعش».
«شعبية هولاند» التي افترض بشار الأسد أنها «قريبة من شعبية داعش»، هي مخاطبة لشرائح في الغرب وفي فرنسا خصوصاً، ترى في اللاجئين السوريين الهاربين من الحرب السورية «خطراً على الاستقرار الغربي والأمن فيه»، وتلمح من ناحية ثانية إلى مقاتلي داعش الوافدين إلى سورية من فرنسا وغيرها، إذ لم يكفَّ الأسد وإعلامه عن اتهام دول أوروبا بــ «تسهيل انتقالهم إلى سورية». هذا كله طبعاً في إطار «المؤامرة الكونية على سورية».
لا تحتاج دوائر إعلامية كثيرة في الغرب إلى خطاب الأسد وإعلامه لكي تعوّم المسألة السورية باعتبارها مسألة أقليات ومسيحيين. ومن ضمن الأمثلة التي يمكن سوقها كمثال على التعامل الإعلامي في بعض وسائل الإعلام الغربية، التقارير التي تنشرها منظمة «أوبن دورز» الأمريكية المسيحية حول أحوال المسيحيين الذي يتعرضون للاضطهاد في العالم. وجاء في التقرير الذي بثته قناة France 24 التلفزيونية عام 2013 أن «سورية قفزت من المكان السادس والثلاثين إلى المكان الحادي عشر على القائمة بعد أن أصبحت أقليتها المسيحية -التي كان مقاتلو المعارضة يشتبهون في بداية الأمر بأن لها صلة وثيقة بحكومة الرئيس بشار الأسد- هدفا متكرراً للمقاتلين الإسلاميين المتشددين»
السيناتور راند بول، وهو عضو مجلس الشيوخ الأمريكي قال في تصريح له إنه «في غياب بشار الأسد، سيكون هناك دولة إسلامية جديدة في سورية وستكون مضطهِدةً للمسيحيين»، معتبراً أن «العديد من المسيحيين الذين لا يزال مستقبلهم مجهولاً أيّدوا الرئيس السوري بشار الأسد خوفاً من أن يأخذ الاسلاميون الحكم في سورية، لأن المسيحيين سيتعرضون عندها للاضطهاد الشديد».
يمكن سرد وقائع كثيرة من تلك التي تختزل المسألة السورية بكونها مسألة أقليات أو مسيحيين يدّعي بشار الأسد أنه يدافع عنهم، إلا أن هذا لا يعني على أي حال أن الوجود المسيحي في سورية ليس في دائرة الخطر، وخصوصاً في ظل عدم اتضاح أفق لنهاية الحرب السورية وهو ما يتزامن مع نمو التيارات المتشددة دينياً في سورية والتطرف وإن هُزِمَ تنظيم داعش قريباً في سورية.
روسياً، تتقاطع خطابات حماية المسيحيين مع مواقف غربية ورد ذكر بعضها أعلاه في بعض الحالات، وإن مع غياب عمل عسكري غربي «فاعل» في سورية على عكس ما فعله الروس. هذا التقاطع يعبر عنه على سبيل المثال السيناتور الأمريكي ريتشارد بلاك، سيناتور فيرجينيا، في رسالته إلى بشار الأسد التي جاء فيها: «عزيزي السيد الرئيس: سُررت بالتدخل الروسي ضد الجيوش التي تغزو سورية. وبدعمهم، حقق الجيش السوري خطوات دراماتيكية ضد الإرهابيين… إنه من الواضح أن هدف الأتراك والسعوديين هو فرض دكتاتورية دينية على الشعب السوري. وإذا تمكنوا من النجاح في هذا الأمر فإن المسيحيين والأقليات الأخرى سوف يذبحون أو يباعون بسوق النخاسة. وسوف يُحرق، ويُغرق، ويُصلب، وتُقطع رؤوس كثير من السنة والشيعة المسلمين الجيدين… أشكركم لحماية حياة المسيحيين وكافة الناس الطيبين السوريين».
وقد بدأ فلاديمير بوتين وحتى قبل تدخله العسكري في سورية، باللعب على مسألة المسيحيين السوريين والخطر الذي يواجهونه بسبب غول الإسلام الجهادي. «وينقل المسيحيون العرب عن سفراء روسيا إن هؤلاء يحثونهم على تأييد موسكو الارثوذكسية حامية الأقليات وقائدة تحالفهم، وأن على المسيحيين العرب التمسك بالرئيس السوري بشار الأسد، الذي ينحدر من الأقلية السورية العلوية، وكذلك التمسك بالأقليتين الشيعية واليهودية في منطقة الشرق الاوسط»
«الخليفة» و«أهل الذمة»
بعد سيطرته على مدينة الرقة، تعامل تنظيم داعش مع المسيحيين في المحافظة على اعتبارهم من «أهل الذمة»، بدءً من فرض الجزية عليهم وليس انتهاءً بالتهديد لهم بقانون جديد لا يحمل لهم إلا «الويل والثبور». قانون قد يودي بالمسيحي المنكود الحظ الذي لا يلتزم به إلى ما لا تحمد عقباه. فَتَحْتَ عنوان «عهد الأمان الذي أعطته الدولة الإسلامية لنصارى الرقة مقابل التزامهم بأحكام الذمة»، أمرَ التنظيم بألا يُحدث المسيحيون في مدينة الرقة أو ما حولها ديراً أو كنيسة أو صومعة راهب، وأن لا يجددوا ما خرّب منها… وألا يظهروا صليباً ولا شيئاً من كتبهم في شيء من طرق المسلمين أو أسواقهم، وأن لا يستعملوا مكبرات الصوت عند أداء صلواتهم وكذلك سائر عباداتهم، وأن يلتزموا بعدم إظهار شيء من طقوس العبادة خارج الكنائس». واستأنف البيان تهديده للمسيحيين بأن «لا يقوموا بأي أعمال عدوانية تجاه الدولة الإسلامية، كإيواء الجواسيس والمطلوبين قضائياً لها، أو من تثبت (حرابته) من النصارى أو من غيرهم، أو مساعدتهم في التخفي أو التنقل أو غير ذلك. وأيضاً ألا يمنعوا أحداً منهم من اعتناق الإسلام إذا أراد هو ذلك، ولا يجوز لهم امتلاك السلاح أو المتاجرة ببيع الخنازير أو الخمور مع المسلمين أو في أسواقهم وألا يتناولونها علانية»، كما نص العهد على التزام المسيحيين «بما تضعه الدولة الإسلامية من ضوابط كالحشمة في الملبس أو في البيع والشراء وغير ذلك». وأخيراً، «يلتزم النصارى بدفع الجزية على كل ذكَر منهم ومقدارها 4 دنانير من الذهب، أي ما يعادل 17 غراماً سنوياً على أهل الغنى ونصف ذلك على الفقراء منهم». للأمانة، فإن «الخليفة البغدادي» الذي يعد راعي هذا البيان «لم يترك المسيحيين دون مقابل» في حال التزامهم بهذا النص، فبالمقابل: «يعطى المسيحيون أماناً لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسائر ذراريهم في ولاية الرقة، لا تهد كنائسهم، ولا ينتقص منها، ولا من حيزها، ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم». وبعد هذا البيان/ التخيير، «طلب المسيحيون مهلة للتشاور مع مرجعياتهم. ثم عقد اجتماع بحضور ممثل عن الدولة الإسلامية وأكثر من عشرين ممثلاً عن المسيحيين اختاروا، ووقعوا نيابة عن طائفتهم»
يذكر أن العائلات المسيحية «خضعت في الرقة لدورة تعريفية من عناصر داعش حول كيفية التعامل مع المسلمين والحقوق والواجبات المفروضة عليهم كمسيحيين استمرت 7 أيام». داعش سيطر على المدينة بعد انسحاب «جبهة النصرة» وكتائب إسلامية غيرها منها وعلى رأسها «حركة أحرار الشام»، وبايع عدد من مقاتلي «جبهة النصرة» تنظيم «داعش»، وانسحب الباقون مع الكتائب المتواجدة في الرقة من المدينة، علماً أن أمير النصرة في الرقة والملقب بـ «أبو سعد الحضرمي» قد أُعدم على يد داعش.
أمير جبهة النصرة في سورية، أبو محمد الجولاني، حاول «طمأنة» المسيحيين بطريقة مواربة تحمل بين سطورها ما تحمله من انتقاص للمواطنة لدى المختلف دينياً، إن قُيض له أن يتمكن من مناطق يقطنها مسيحيون. قال عنهم في مقابلته الشهيرة مع الإعلامي أحمد منصور على قناة الجزيرة: «النصارى أغلبهم يقفون في صف النظام ونقاتل فقط من يقاتلنا، وليس لدينا حرب الآن معهم ولا نحملهم مسؤولية ما تفعله أمريكا أو ما يفعله أي من النصارى في العالم، أما القرى الشيعية التي نحاصرها الآن فهي قرى تحاربنا».
لم يهدد الجولاني المسيحيين ويتوعدهم على ما فعل تنظيم البغدادي، إلا أن «النصارى» وفقاً لما يمكن أن يقرأه المرء من هذا التصريح العمومي ليسوا مواطنين سوريين بنظره، طالما أنهم «نصارى، بالنسبة له»، وطالما أنه ألمح إلى الارتباط، وإن نفياً للتهمة عنه، بينهم وبين الغرب و«النصارى في هذا العالم». وفي السياق ذاته، تناقلت صفحات إعلامية مختلفة أخباراً عن تعرض مسيحيين في محافظة إدلب إلى التهجير بعد سيطرة فصائل إسلامية على رأسها جبهة النصرة للمنطقة في أيار 2015.
مسيحيو «الوسط»، دير الزور، والشمال السوري
احتجز تنظيم «داعش» 90 مسيحياً في شباط 2015، في هجومه على قريتي تل شاميرام وتل هرمز الآشوريتين التابعتين لمحافظة الحسكة، وذلك بعد سيطرته عليهما على حساب «وحدات الحماية الكردية». «تناقلت وسائل إعلام عديدة لاحقاً أخباراً عن أن المختطفين بلغوا 200 شخص». ثم قام التنظيم في تشرين الأول من العام نفسه بإعدام 3 من هؤلاء المختطفين رمياً بالرصاص.
اعتُبر شباط 2015 تاريخاً مفصلياً في حياة المسيحيين الآشوريين الذين لا يتجاوز عددهم 50 ألفاً في سورية، نتيجة ما تعرضوا له من اختطاف ثم قتل وتهجير. هذه الأحداث المأساوية شجعت الآشوريين على الانخراط في تنظيم وتعزيز العمل العسكري في قوات تحمل الهوية الآشورية، رغم أن الانتظام في قوات وميليشيات عسكرية قد بدأ بعد عامين من اندلاع الثورة السورية. هكذا، أنشأ «حزب الاتحاد السرياني» جناحاً عسكرياً له تحت اسم «السوتورو»، بعد «الفراغ» الذي تركه انسحاب النظام من الشمال الشرقي لمدينة الحسكة. كما نشأ «المجلس العسكري السرياني لحماية المناطق الآشورية»، وهذا الأخير يتبع لــ «قوات حماية الشعب الكردية»، في حين تتبع «قوات حماية الجزيرة» إلى النظام مباشرة
وتلاقت ثلاثة فصائل وتنظيمات آشورية مسيحية هي «تجمع شباب سورية الأم» و«التجمع المدني المسيحي» و«الحزب الآشوري الديموقراطي» في مدينة القامشلي، ووضعت «وثيقة عمل مشترك» تنطلق من «ثوابت وطنية أجمعت عليها هذه الفصائل تتضمن الإيمان المطلق بوحدة سورية أرضاً وشعباً، ورفض كل أشكال التدخل الخارجي، والإيمان بضرورة التغيير السلمي الديموقراطي، ونبذ العنف والتطرف بكل أشكاله، ثم اعتماد الحوار أساساً لحل جميع القضايا».
في المشهد العسكري في المنطقة، باتت عشرات القرى الآشورية- المسيحية في منطقةِ تقاطع النيران بين تنظيم «داعش» من جهة، وبين «حزب الاتحاد الديمقراطي – PYD» ومسلحي المجلس العسكري السرياني واللجان الشعبية الموالية لنظام الأسد في منطقة «الخابور» شمال غرب الحسكة، من جهة ثانية. «وفي كانون الثاني 2015، دخل داعش إلى قرية تل هرمز وطلب من الأهالي إزالة الصلبان من فوق الكنائس مهددين هؤلاء السكان في حال عدم القيام بذلك. لاحقاً، دخل عناصر حرس الخابور و PYD والمجلس العسكري السرياني ورفعوا الصلبان مجدداً فوق كنيسة القديس بيثيون، ما جعل الاشتباكات بين داعش والأطراف الآشورية المحلية وداعميها تتصاعد وسط نزوح كامل سكان قرية أم هرمز إلى قرية أم غركان القريبة منها».
أما في «رأس العين – سري كانيه»، المدينة الحدودية مع تركيا وذات الغالبية الكردية، والواقعة في الشمال الشرقي من سورية، فقد شنَّ داعش بتاريخ 11 آذار 2015 هجوماً مكّنه من السيطرة على قرية تل خنزير القريبة من المدينة. يقطن في رأس العين مسيحيون ينقسمون إلى «السريان الأرثوذوكس والسريان الكاثوليك والأرمن الكاثوليك والأرمن الأرثوذوكس»، وقد «شهدت موجة من الهجرة باتجاه أوروبا بعد بدء الاشتباكات والعمل العسكري في المنطقة والتي كان الجيش الحر طرفاً فيها في تشرين الثاني 2012»، وانضم مسيحيون في المدينة إلى «الجيش الحر» للقتال في صفوفه ضد قوات النظام.
لم تتوقف الاشتباكات لاحقاً بين «حزب الاتحاد الديمقراطي – PYD» وتنظيم داعش، وبعد أن كان «الجيش الحر» طرفاً عسكرياً في المنطقة بات «الاتحاد الديموقراطي» هو المسيطر عليها، خصوصاً بعد الضربات التي تلقاها الجيش الحر على يد النظام وطيرانه.
في دير الزور، غير داعش اسم المدينة ليصبح اسمها «ولاية الخير»، لأنّ اسمها الأول يشير، وفقاً للتنظيم، «إلى الدين المسيحي، سيما كلمة (دير)، ما دفع التنظيم الى تغييره»، وقد هاجرت العديد من العوائل المسيحية من المدينة بعد حصار النظام لها وتعرضها للقصف اليومي. وعن ذلك، يتحدث أحد المسيحيين من أبناء دير الزور: «النظام لم يرحمنا بقمعه، ولكن بعد ظهور التنظيمات المتطرفة كتنظيم داعش والنصرة، قررتُ السفر خوفاً من تكرار مشهد مدينة الرقة في دير الزور». باتت المحافظة شبه خالية من المسيحيين، وهي التي كان يتركز الوجود المسيحي فيها في مدن ثلاث: البوكمال، الميادين، ودير الزور المدينة.
«الكنيسة الوحيدة الموجودة في منطقة البوكمال تعرضت أكثر من مرة للقصف عام 2012 على يد قوات النظام السوري، ومع سيطرة جبهة النصرة على المدينة في كانون الأول 2013، أصدر قاضي (الهيئة الشرعية) التابعة للجبهة قراراً يقضي بهدم الكنيسة بشكل كامل. وفي أيلول 2014، سيطر داعش بشكل كامل على البوكمال وريفها ومدينة القائم العراقية واستولى على أملاك اتباع الديانة المسيحية كاتباً على جدران ممتلكاتهم: ملك للدولة الإسلامية»
تأخرت مدينة حلب، ثاني كبرى مدن سورية بعد العاصمة دمشق، في طرق أبواب الثورة السورية سواء في طورها السِّلمي ثم لاحقاً العسكري. وبقيت من دون حضور قوي على المشهد السوري قياساً بمدن سورية غيرها «حمص مثلاً».
بالنسبة لمسيحيي المدينة، وبعد ازدادت حدة المعارك بين النظام ومعارضيه، اتخذت دول أوروبية إجراءات لإجلاء المسيحيين من المدينة وترحيلهم إلى بلجيكا وتشيكا وسلوفاكيا والمجر، وهذه الدول، ما عدا بلجيكا، كانت قد رفضت استقبال أي لاجئين مسلمين، وأعلنت أنها لن تستقبل غير «مسيحيين سوريين». أما من بقي منهم في المدينة فقد شارك بعضهم في حمل السلاح إلى جانب النظام، ولعل الأبرز من هؤلاء كانوا من الأرمن الذين وجد من بينهم من قاتل جنباً إلى جنب مع قوات الأسد ضد المعارضة السورية، بينما بقي الآخرون صامتين أسرى سردية المظلومية والخوف من المستقبل.
«وهل تعتقد أننا سنقف إلى جانب من ارتكب بحقنا المذابح، وكان سبباً في تهجيرنا قبل 100 عام من الآن؟ المعارضة اختارت أن تتصافح مع الأتراك، ونحن لن ننسى ماذا فعل الأتراك». هذا كلام لأحد الشباب من الأرمن في حلب، وهو في النهاية لسان حال جماعات ترى في ما يحصل في البلاد مؤامرة من تركية وغيرها من دول إقليمية على سورية. مع اندلاع «معركة حلب» لأول مرة في حزيران 2012، شارك الأرمن في القتال إلى جانب قوات النظام السوري، وهو ما «فسّر» رجال دين مثل الأب جون أسبابه ودوافعه إلى أن «الأثرياء في مدينة حلب لم يكونوا من أنصار النظام، لكنهم شعروا بأنهم اضطروا إلى حماية أنفسهم من الفلاحين المهاجرين (من الريف) الذين لجأوا إلى الحرب لتدمير قلب المدينة المتطور والحديث». وتداولت مواقع الانترنت وصفحات التواصل الاجتماعي فيديوهات للناشط اللبناني في «التيار الوطني الحر» الذي يترأسه حالياً جبران باسيل، طوني أوريان، يتوسط الجلسة بين المقاتلين الأرمن في حلب والذين التحقوا بــ «قوات القدس» المقاتلة إلى جانب قوات النظام السوري ويحثهم على القتال، معتبراً هؤلاء أناساً «تركوا كل الفوارق المذهبية والطائفية والتحقوا بأهم معركة تحصل بتاريخنا المعاصر في وجه كل شياطين الأرض».
وبحسب أسامة أبو زيد، المستشار القانوني للجيش السوري الحر، فإن «لواء القدس، الذي تشكل في عام 2013 من قبل النظام، وضم في المرحلة الأولى مقاتلين فلسطينيين بشكل أساسي، قد توسع لاحقاً ليضم مقاتلين من جنسيات وقوميات مختلفة من شيعة إيران ولبنان ومن الأفغان والأرمن»، لافتاً إلى أنّه اليوم أشبه بمجموعات صغيرة من «المرتزقة»، مكملاً بالقول «لا نعتقد أن هناك أعداداً كبيرة من الشبان الأرمن في صفوفه، إلا أن النظام يصر على محاولة تضخيم الأعداد بمسعى منه للإيحاء باتساع رقعة أنصاره من قوميات وطوائف مختلفة»
مدينة محردة المسيحية، والواقعة شمال حماة «20 كم»، كانت نقطة تماس في الاشتباكات التي وقعت بين النظام السوري والمعارضة السورية المسلحة. وفي آب 2014 وصلت جبهة النصرة إلى أطراف المدينة، وتمكنت كتائب المعارضة من «اقتحام الحي الشرقي لمدينة محردة في آب 2014… فيما أعلن الثوار مدينة محردة وما حولها منطقة عسكرية بالكامل جراء الاشتباكات داخل وفي محيط المدينة». وقصفت قوات المعارضة المسلحة المدينة لاحقاً بقذائف الهاون. تراجعت المعارضة بعد ذلك من مواقعها التي استولت عليها تحت الضربات العسكرية لها من قبل نظام الأسد.
في آذار 2017، عادت مدينة محردة إلى واجهة الأحداث، حين اندلعت معارك كبيرة في مناطق عدة من ريف حماة بين النظام وحلفائه من جهة، والمعارضة المسلحة بتنويعاتها «جبهة النصرة (جبهة فتح الشام)، جيش النصر، جيش العزة، جيش إدلب الحر، والحزب الإسلامي التركستاني»، بهدف «السيطرة على مدينة حماة والمطار العسكري» بحسب المعارضة. ولم يكن ثمة أي محاولة لاقتحام المدينة او التعرض لسكانها هذه المرة. وقال الناطق العسكري في «جيش العزة» النقيب مصطفى معراتي، «أن سبب تحييد مدينة محردة، ذات الغالبية السكانية المسيحية، جاء لنزع حجة المسألة الطائفية واللعب على موضوعة حماية الأقليات التي يحاول النظام التركيز عليها». وقد وجه «جيش العزة» كلمة مصورة إلى أهالي محردة والمجتمع الدولي، بيّن فيها هذا الموقف. يأتي ذلك رداً على الموقف الذي صدر عن مركز «حميميم» الروسي، والذي اعتبر في بيان له أن «مدينة محردة هي الخط الأحمر، فعَلى التنظيمات الإرهابية أن تتعامل مع ذلك بجدية تامة لتجنب العواقب. ونحن نؤكد على استمرارية الدعم الجوي الذي توفره قاذفاتنا للقوات الحكومية في الريف الشمالي لمدينة حماة الذي يتعرض لهجمات إرهابية».
«القريتين»، منطقة سورية في ريف حمص تشبه أحوال المسيحيين في بعض تفاصيلها فيها ما حصل للمسيحيين في الرقة، حيث سيطر «داعش» عليها في 7 آب 2015 بعد معارك مع قوات النظام السوري. واختطف التنظيم عشرات من سكان المدينة المسيحيين. وبعد سيطرته عليها، أصدر «داعش» عبر المكتب الإعلامي لما يسمى «ولاية دمشق» وثيقة تتضمن 12 شرطاً لـ «منح الأمان للمسيحيين» من زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي. وتضمّن الاتفاق الذي وقّع عليه مسيحيّو القريتين مقابل عودتهم إلى منازلهم في القرية «أن يدفعوا الجزية، وقدرها 4 دنانير من الذهب، ما يعادل 4.25 غرامات، لأغنياء (أهل الذمة)، ونصف ذلك على متوسطي الحال، ونصف النصف على الفقراء من المسيحيين… ويحظر الاتفاق على المسيحيين إظهار الصلبان أو الكتب المقدسة أو استخدام مكبرات الصوت أثناء الصلاة، كذلك يمنعهم الاتفاق من بناء دير أو كنيسة أو صومعة لراهب في المنطقة».
خامساً: على سبيل الخلاصة
تتصاعد خطورة الوضع الميداني على المناطق التي يقطن فيها المسيحيون في الوقت الذي تمتثل أمام هؤلاء تجربة تهجير أقرانهم في العراق، بالتزامن مع انتعاش خطابات غربية تنظر إلى الشرق «السحري»، «سورية في حالتنا هذه»، كعالم آخر لا يمكن تفسير النزاعات فيه إلا بالدين والطائفة. بلدنا، من هذا المنظور، غارق في الإيديولوجيا الدينية والإسلام الحربي الذي تقيم السياسة وحراك الشارع والمطالب والكرامة في مكان بعيد عنه. وإذا تمت الالتفاتة إلى السوريين، تَبدَّوا كتلاً وأجساداً وعقولاً يسيرها الدين لتنقض على «أديان» غيرها في ذات الرقعة الجغرافية، كطبعٍ قارٍّ غير قابل للتجاوز لدى هؤلاء «المسلمين»، وهو «طبع لا يلجمه إلا بشار الأسد» بالنسبة لهم على ما يبدو.
تسييس النزاع السوري بعيداً عن «جوهرانية المجتمعات» في الأمثلة السابقة يقتصر، إن تمت قراءة الأحداث من وجهة نظر سياسية، على نظام «سياسي»، «علماني»، يحمي سوريين معرَّفين بطائفتهم من خطر سوريين آخرين معرّفين بطائفة أخرى، وهو ما ألمح له البطاركة السوريون الذين ذكرناهم أعلاه بشكل غير مباشر في خطبهم التي تكيل المديح للنظام السوري ورئيسه، مع ملاحظة الفارق في «الكفاءة» اللفظية والمهنية بين المدافعين عن «حامي الأقليات» في الغرب وبينهم في سورية.
حاولت هذه الدراسة توثيق غيض من فيض المشهد المسيحي بعد الثورة السورية وقبلها، من دون ادعاء الإحاطة بكافة جوانب وتنويعات المجتمعات المسيحية السورية. وإذا كان واضحاً أن المسيحيين ليسوا كتلة واحدة، إنما مجموعات تختلف بحسب المنطقة التي يلقي الحدث السوري بظلاله عليها، فإن ذلك لا بد أن يقودنا إلى الحديث عن الشرخ الذي لحق بالوطنية السورية قبل أن يلحق بالمجتمع السوري ما لحق به تجاه الحرب الدائرة اليوم. ثمة روابط ما قبل وطنية توجه مسار الجماعات ونمط وآليات التفكير فيها، وهي روابط كان ممنوعاً على السوريين، والمسيحيين خصوصاً في حالتنا المدروسة هنا، أن يعبروا عنها. ويتضح من خلال ارتفاع عتبة التأثر الجمعي بما يلحق بسوريين آخرين أن المسألة ليست متعلقة بجماعات تكفيرية، بل بغياب الثقة لدى سوريين مسيحيين تجاه سوريين منتفضين ضد نظام الأسد، يفسَّر حراك هؤلاء المنتفضين بالدين غالباً.
هذا ليس حكم قيمة على أي حال، بقدر ما هو محاولة لوضع اليد على الجرح الذي سيبقى مفتوحاً تحت عنوان «المجتمع السوري»، في الوقت الذي يلوح أن مجتمعات سورية مختلفة في الدين والطائفة، ومجتمعات مسيحية من ذات اللون الديني تعيش في بلد واحد، لا تزال تنظر إلى سورية بعد كل ما حدث من زاوية «الوحدة الوطنية التي يحميها طاغية». وإذا بات لدينا اليوم طغاة كثر على الأرض السورية يرتدون اللبوس الديني الإسلامي بالتزامن مع البقاء المؤسف للطاغية الأول، فإن ذلك يعني أن الاحتراب الطائفي سيستمر ما دامت القوى الدولية لم تتخذ قرارها بإنهاء الحرب السورية، سواء تمثلت هذه الأطراف بالغرب والولايات المتحدة، أو بالروس الذين يتلخص المشهد لديهم بالإبقاء على نظام الأسد. وغني عن القول إن الحل لن يكون باستجرار سرديات حماية الأقليات في الشرق، ولا بكون الإسلام هو الحل.
هذا كله لأن نظاماً حكم سورية لخمسين عاماً، لم يكن نظاماً سياسياً على الإطلاق، إذ تبدو السياسة التي يناط بها العمل على حل التناقضات الموروثة وبناء ثقة وطنية بين عموم السوريين، طارئة على مسيرة نصف قرن من حكمه. وإن حضرت السياسة لديه، كانت موجهة إلى الخارج، تحت عنوان الاستقرار سابقاً، وحماية الأقليات حالياً، وما بينهما من أوهام لا تزال تجد من يتلقفها حتى اليوم.
*****
ملحق رقم 1
المسيحيون السوريون في الثورة السورية
إعداد: رند صباغ
مقدمة
ما زال ملف المسيحيين يحتل حيزاً كبيراً من النقاش تستدعيه الأوضاع الراهنة في سورية، جزءٌ من هذا النقاش يخوض به محاسيب النظام السوري الذين يجتهدون لإبراز هذا الأخير كحامٍ للمسيحيين، بقصد استرضاء الغرب أو الحفاظ على المسيحيين في صف النظام؛ وجزءٌ آخر قادم من الغرب ذاته، وبعضه يستذكر المسيحيين في سياق الخوف عليهم من الوحش القادم. ويختلط في هذا الخطاب الأخير غالباً بعض من ترسبات استشراقية ونضالية مسيحانية أو علمانية تخشى الإسلام، وربما علاقاتٌ ومصالح يقف ضدها انقلاب واقع الحال.
كثيرٌ من هذه النقاشات تسودها حالة من السطحية الدعائية، التي لا تحترم لا وقائع ولا احصائيات، فنحن نرى، مثلاً، أن بعض المنابر العالمية التي تعرف نفسها على أنها تلعب دور المراقب لرصد الانتهاكات التي يتعرض لها المسيحيون، تخلط بين استهداف المسيحيين بصفتهم الدينية وسقوطهم كضحايا جراء أحداث العنف. فإيراد عدد الضحايا من المسيحيين في سورية دون ذكر عدد الضحايا بشكل عام في البلاد، وإن كان الرقم صحيحاً، يعطي إيحاءً خاطئاً للقارئ، ويوجهه إلى فهم راديكالي للوقائع التي تفتقر للمصداقية الكاملة عند نقلها.
أما الخطأ الآخر والأكثر تواتراً، فهو التعامل مع المسيحيين السوريين ككتلة مصمتة ومنفصلة عن مجموع السوريين الكلي. وبالتالي، فإن هذه الكتلة قد تمتلك خصائص وعوامل مشتركة يمكن دراستها والتأثير بها وفهم أفعالها بشكل واضح، مما قد يقود إلى افتراض أن المسيحيين ليسوا جزءً من الثقافة السورية، وأنهم يختلفون بشكل كبير في أسلوب حياتهم وأنماطهم اليومية عن أترابهم من السوريين المسلمين.
بيد أن النقطة الأساسية التي تخلق الفارق الجوهري بين الأقلية المسيحية في سورية وغيرها من الأقليات، هي غياب الكتلة لحساب التكتلات وعدد من المجموعات، وبروز الفرد بشكل أوضح. فلا كتلة مسيحية في سورية كما أنه لا كتلة سنية في سورية، وإن تباينت نسب التعداد السكاني في كلا العينتين بشكل كبير. إلا أن هناك بعض العوامل المشتركة بينهما والتي تسمح بمقارنتهما إلى حدٍ ما. فالمسيحيون السوريون حالهم حال السنة في سورية، يتوزعون على كافة الأراضي السورية ولا ينحصرون في مناطق محددة، وإن عرفت بعض المحافظات كثافة أكبر بقليل من غيرها، أو تغيرت الموازين بفعل الهجرات الداخلية التي تبدلت أكثر من مرة في القرن الأخير.
وقد تبدو منطقة وادي النصارى «وادي النضارة رسمياً»، ومشتى الحلو والقرى المتجاورة بين ريف حمص وريف طرطوس منطقة مسيحية، لكنها لا تمتلك كفة الكثافة العددية بقدر ما تمتلك كفة التجانس الديني. والمسيحيون أيضاً متباينون اقتصادياً وتعليمياً وينتشرون في جسم المجتمع بشكل رأسي، وينتمون إلى ما لا يقل عن 14 طائفة رسمية، مما يجعل مرجعياتهم الدينية مختلفة أيضاً.
لا يمكن الغوص في معرفة نسبة المشاركة المسيحية في الثورة، فهي وبحسب الأسباب التي أوردناها في المقدمة لا تنطوي على عوامل قابلة للقياس، سواءً من حيث تجانس المجموعة البشرية جغرافياً واجتماعياً وثقافياً، أو من حيث علاقتها بالسلطة الدينية «إن صح التعبير»، إلا أن الواقع منذ 2011 يطرح أمامنا عدداً من المعطيات التي أثارت اللغط والتساؤل حول موقف المسيحيين حيال الثورة السورية. هكذا، سنحاول قدر المستطاع فهم الخطوط العامة، دون الادعاء بأن هذا الفهم أو التقسيم دقيق بشكل كامل.
فمنذ انطلاق الثورة السورية في آذار 2011، شارك عدد لا بأس به من الشباب السوري المسيحي بدرجات متفاوتة، وكان من بين أوائل المشاركين في المظاهرات السلمية في عدد من المحافظات، إضافة لحضور واضح لبعض الشخصيات المسيحية المعارضة في الساحة السياسية. إلا أن هذه المشاركة لا تعكس موقفاً مسيحياً، بل موقف أفراد، فالنظر للموقف المسيحي رسمياً يعتمد على موقف الكنيسة التي اتخذت خطين واضحين لا ثالث لهما: فهي إما مع النظام بشكل واضح، أو تحيد بنفسها بشكل من الأشكال دون إثارة غضب النظام.
العوامل الأساسية في مواقف المسيحيين الأولى إبان الثورة
ينقسم المسيحيون بين فئات المجتمع الثلاث الأساسية في شكل التعاطي مع الثورة السورية، فمنهم من يدعمها بالفعل بدرجاتٍ مختلفة بدءاً من المشاركة الفعلية ووصولاً إلى مجرد تبني فكرة الثورة، ومنهم من يفضّل الحياد، وآخرون يوالون النظام بدرجات مختلفة أيضاً، بين مؤيدين صامتين وصولاً إلى التشبيح والمشاركة في الأعمال القتالية.
وربما يمكننا تقسيم العوامل على هذا الشكل:
1- الخوف من التغيير وعدم الاستقرار
لم يعرف المسيحيون الاستقرار الفعلي خلال تاريخِ طويلٍ في المنطقة حتى النصف الأول من القرن العشرين، والذي كان حافلاً بالأحداث الدموية في مطلعه. وهي أحداث لم تقابل بأي شكل من أشكال التعويض والمصالحة الفعلية، حتى أنها لم تؤرخ «باستثناء مجازر الأرمن»، ما جعل مجالات نقل التاريخ شفوياً أكبر بكثير، وهو ما يحمل حالاتٍ من الشحن العاطفي والمبالغة، وعدم الدقة.
هذه الذاكرة وإن بدت بعيدة بعض الشيء، إلا أنها ما تزال ملحةً في أذهان المسيحيين، وتشير بأنهم سيكونون ضحيةً سهلة لأي شكل من أشكال التغيير وعدم الاستقرار. فلا يمكن معرفة آثار التغيير وأسلوب تعاطي أي سلطة مستقبلية مع المسيحيين. وهنا نستطيع إيراد أحد الأمثلة خلال الثورة:
في إحدى قرى ريف إدلب المسيحية، قامت قوات من «الجيش الحر» بالسيطرة على القرية، إلا أنها لم تقترب من الكنائس فعلياً أو حسب ما يشاع، لكن الكنيسة توقفت عن قرع الأجراس يوم الفصح، ما دفع قائد القوات الموجودة بالتساؤل حول السبب، فأخبره الكاهن بأنه لا يعلم من الذي يحكم وما هي التوجهات، لذلك كان عليه الحذر لفهم التغيرات الحالية. لكن قوات «الجيش الحر» رحبت بقرع الأجراس وممارسة الشعائر الدينية، إلا أن توجس الكاهن لم يكن خاطئاً فخلال أيام سيطرت جبهة النصرة على المنطقة وغيرت واقع المسيحيين بشكل كلي.
وكثيراً ما تسمع من المسيحيين أنهم ممتنون لمجرد قدرتهم على ممارسة شعائرهم وإبراز هويتهم الدينية بشكل واضح، وقرع أجراسهم والاحتفال بأعيادهم دون أية ضغوطات، بالإضافة إلى وجود القوانين التي تكفل لهم المساواة «سلباً أو إيجاباً» مع مواطنيهم المسلمين في الحقوق والواجبات.
2- التجارب المجاورة في الشرق الأوسط
لم تكن الأحداث الدامية في المحيط الإقليمي لتجعل المسيحيين أكثر جسارة على اتخاذ المواقف الحازمة. فمنذ حرب لبنان الأهلية، وفكرة المؤامرة الغربية لتفريغ المشرق العربي من المسيحيين تجد لها أصداءً كبيرة في الأوساط المسيحية، وهي لم تكن رادعاً لمنعهم من الهجرة الكثيفة. كما أثرت حرب العراق بتبعاتها على المسيحيين بشكلٍ واضح، حيث أنتجت هجرة مسيحية كبيرة بعد استهدافهم من تنظيمات إرهابية نمت في ظل الوجود الأمريكي. إلا أن العامل الأهم كان خلال الربيع العربي، وإن كانت تونس وليبيا واليمن دولاً لا تحمل تواجداً مسيحياً، إلا أن أحوالها المبكرة إبان الثورات لم تكن تدفع إلى التفاؤل، في حين شكلت مصر الثقل الأكبر. ويرى كثيرٌ من المسيحيين السوريين بأن مشاركة الأقباط في ثورة 25 يناير لم تحمهم من الاضطهاد المتكرر والعنيف في كثيرٍ من الأحيان، ولم تمنحهم حقوقاً أوسع، بالإضافة إلى سيطرة الإخوان المسلمين في حينها.
3- الحذر من الإرهاب
ربما يعتقد البعض بأن شبح الإرهاب حديث العهد على سورية، إلا أن المخاوف لم تكن كذلك، فالشائعات التي كانت تتحدث عن وجود خلايا إرهابية ضبطها النظام قبل أن تبدأ بعملياتها كانت شديدة التواتر (وإن صح بعضها بشكلٍ من الأشكال)، بالإضافة لوجود هذه التنظيمات بشكل واضح في دول الجوار، وهو الأمر الذي كان يخلق تردداً دائماً في معادلة الأمن والأمان مقابل الحريات والحقوق. فلم يكن يمر العام دون أن يتبادل المسيحيون في سورية شائعات عن خلية كانت بقصد قتل المسيحيين لولا ضبط النظام لها بوقتٍ مبكر.
4- الخوف من النظام
لم يكن المسيحيون أقل تعرضاً للاضطهاد والاعتقال من قبل النظام قبل الثورة، بل كان نصيبهم من بطش النظام مماثلاً لما ناله باقي السوريين حين ممارسة العمل السياسي. وكالجميع، ابتلوا ببلطجة وتدخل أجهزة الأمن في حياتهم وأعمالهم. وبالتالي كان المسيحيون على دراية كافية بمدى بطش وديكتاتورية النظام، وهذا ما زاد لديهم المخاوف من محاربته، وما سيتأتى عن هذه المحاربة من نتائج دموية ستكون كفيلة بقلب الطاولة على السوريين ومن بينهم المسيحيين.
5- علاقة المسيحيين بالشأن العام
كما ذكرنا سابقاً فقد ابتعد كثيرٌ من المسيحيين بشكل ملحوظ عن الشأن العام، ويبدو الأمر جلياً بشكل أكبر بين شرائح الشباب أو الأجيال التي لم تعرف سوى نظام البعث. فانحصر نشاطهم الاجتماعي بالكنيسة من خلال مجموعاتها الكشفية، ما جعلهم يشكلون دوائر أصغر ينتمون إليها. وصار الحضور على الأصعدة الثقافية والفكرية والسياسية أو حتى التطوعية قليلاً جداً. وكان من شأن هذا الابتعاد أن يؤثر على علاقة المسيحيين الشباب ببقية أطياف الشعب السوري وفهمهم بشكل أكبر، ولعب أي دور في التغيير حتى الاجتماعي البسيط، ما وضع قسماً كبيراً منهم في عزلة طائفية وفئوية، كانت كفيلة بابتلاع أية شائعات دون تردد، وزيادة الشعور الأقلوي على حساب الشعور الوطني الجماعي.
6- الخطاب الديني في الثورة
لم يكن الخروج بالمظاهرات من الجوامع واضحاً بالنسبة للكثير من المسيحيين، بل استُخدِمَ بشدة من قبل النظام لإشعارهم بأن هذه المظاهرات كانت بمطالب فئوية وليست وطنية. وظهر هذا الأثر جلياً في جميع الأحاديث الداخلية أو حتى في الصفحات المسيحية على وسائل التواصل الاجتماعي، فتم تغييب المسبب الرئيسي لاعتماد الجوامع كمراكز للتجمع لصالح التأويل الديني. إضافة لما سبق، عززت بعض أشكال الهتافات وخروج بعض رجال الدين الإسلامي مثل عدنان العرعور على واجهة الأحداث هذا التوجس، فبعض الهتافات كانت تلقى تواتراً كبيراً حتى أنها كانت تأخذ حجماً أضخم عند تناقلها أو يضاف إليها جمل لم تكن في الحقيقة موجودة. فكان أبرز الشعارات التي أثارت المخاوف «المسيحية على بيروت والعلوية على التابوت»، وهو شعار لا يمكننا التبين من صحته ونسبته إلى المعارضة، في حين استخدمت المظاهرات في مراحل متقدمة من الحراك السلمي بعض الشعارات الدينية مثل «قائدنا للأبد سيدنا محمد»، ولاحقاً بعض الشتائم للعلويين. كما ظن كثيرٌ من المسيحيين بأن الأمر هو عبارة عن خلاف إسلامي-إسلامي بين السنة والعلويين وعليهم أن يحيدوا أنفسهم عنه.
7- الشائعات القادمة من أماكن تواجد المسيحيين
تناقل المسيحيون أيام الحراك السلمي كثيراً من الشائعات التي تتحدث عن خروج المظاهرات في أماكن يتواجد فيها المسيحيون بنسب أقل، وكيف قام المتظاهرون بحرق المنازل أو نهبها، أو حتى طرد المسيحيين من المنطقة. وكانت هذه الشائعات تحمل أثراً عميقاً يجعل المسيحيين يعتقدون بأنه أياً كانت مواقفهم، فسيدفعون الثمن بسبب انتمائهم الديني، وهذا ما ازداد بعد اشتداد حدة المعارك، سواءً من خلال دخول بعض الفصائل المسلحة لقرىً مسيحية، أو بما استهدفته القذائف العشوائية في أحياء كل من دمشق وحلب ذات الغالبية المسيحية، وإن ادعت هذه الفصائل أنها لا تتقصد المسيحيين، بل تستهدف المناطق الأقرب إليها والتي تحتوي على مراكز عسكرية أو أمنية للنظام. هذا أمر واقعي بدرجة من الدرجات، حيث ينشر النظام السوري المواقع الأمنية بشكل واضح في أماكن تواجد المسيحيين.
8- التطمين بحجة الذمية
حاولت بعض الفئات السورية المعارضة طمأنة المسيحيين باستخدام خطاب خاطئ، حيث طرحت هذه الفصائل أو الفئات المحافظة رغبتها في عدم المساس بالمسيحيين بإسناد الأمر إلى أنهم «أهل الذمة». لم يعلم هؤلاء بوقع هذه الكلمة على المسيحيين، والتي تجعلهم أكثر بعداً وتوجساً مما سيأتي بعد النظام في حال سقوطه. فمصطلح أهل الذمة يعيد ذاكرة الاضطهاد الذي عاشه المسيحيون طوال قرون حتى نهاية الخلافة العثمانية، والتي ترتبط بالضرورة بدفع الجزية، والتعامل معهم كمواطنين من الدرجة الثانية، والحد من إمكانيتهم في التعبير عن معتقداتهم وممارستهم للطقوس. كما يمثل مصطلح أهل الذمة في الوعي المسيحي شكلاً واضحاً من أشكال الوصاية، ويلغي مفهوم دولة المواطنة لصالح الدولة الدينية، وهو الشكل الذي لن يحظَ بأي دعم من المسيحيين.
9- دور الكنائس السورية
مالت الكنائس السورية في مواقفها الرسمية لكفة النظام السوري، وذلك لسبب واضح وهو ارتباطها به بشكل قوي، وأثر النظام في التعيينات الكنسية والكهنوتية، بالأخص وأن دمشق تحتضن ثلاث كراسٍ بطريركية هامة، وهي الكرسي البطريركي لأنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس، بالإضافة إلى كرسيي أنطاكية والقدس والإسكندرية للروم الملكيين الكاثوليك.
والملفت في الأمر، أن رجال الدين والكنيسة المسيحية استطاعت استعادة الاستقطاب المسيحي بشكل مفاجئ، وأثرت بشكل ممنهج في الوعي الجمعي للطوائف المختلفة. كما سهلت بعض الكنائس تجنيد جزء من الشبان المسيحيين في الخفاء بالاتفاق مع الأمن، وتعاملت مع المقاتلين في صفوف الدفاع الوطني والشبيحة على أنهم شخصيات وطنية يحمون سورية بشكل عام والمسيحيين بشكل خاص. إلا أن الكنيسة كانت حريصة دوماً على استخدام سورية أو الوطن أكثر من استخدام فكرة المسيحيين وحدها.
كيف تعامل النظام مع مناطق المسيحيين عسكرياً وأمنياً بعد اندلاع الثورة؟
عوّل النظام بشكل كبير على الولاء المسيحي، فركز دعايته في مناطق تواجد المسيحيين الأكثر كثافة، أو من خلال نفوذه في الكنائس لكسب أكبر شكل من أشكال التأييد، والذي لم يكن يكفيه أن يكون ضمنياً، بل عمل النظام على إظهاره وترسيخه. ساهم النظام بتنظيم احتفالاتٍ أسبوعية في دمشق في ساحة باب توما ذات الطابع المسيحي كل جمعة بالتزامن مع المظاهرات، بالرغم من أن رعاة هذه الاحتفالات لم يكونوا مسيحيين إلا أنها كانت ترسخ خطاباً واضحاً ورسالةً جلية.
لكن العسكرة في كثيرٍ من الأحيان كانت ظرفية، ولم تكن حالة دائمة. وكانت تتلقى الدعم بحجة أنها تقصد الدفاع عن الوجود وحماية المناطق، وليس الموالاة أو المعارضة لأحد، كما حصل في الجمعة العظيمة في دمشق، حينما استطاع وبشكل غير مباشر حشد شباب من أحياء دمشق المسيحية عن طريق نشر شائعات بأن المتظاهرين سيدخلون ساحة العباسيين ومنها سيقومون بحرق منازل المسيحيين والاعتداء عليهم، ما جعل الشباب يتطوعون لمقاتلة المتظاهرين. كذلك الأمر في معلولا، أو في بعض قرى ريف حمص، وإن كان بعضها يحتمل أكثر من سيناريو لفهم حالة التسليح. ويعتقد كثيرٌ من المسيحيين أن حقهم الطبيعي يجعلهم يقاتلون أي فئة تريد السيطرة بالقوة على مناطقهم، وهذا لا يندرج تحت خانة التشبيح أو الدفاع عن النظام. في حين تمت الاستفادة من موالي النظام المتنفذين في مناطق أخرى لتجييش الشباب، وربما كان المثال الأكثر وضوحاً في مرمريتا، في وادي النصارى، حيث استخدم النظام عدداً من شباب البلدة لإخماد الثورة في الحصن، وكانت أفعالهم في كثير من الأحيان أشد عنفاً ومباشرة مما يقوم به النظام نفسه.
كما حاول النظام في كثير من الأحيان العفو بشكل واضح عن بعض معارضيه المسيحيين، والتعامل معهم بشكل مختلف، إلا أن هذا لم يكن يعفيهم من الاعتقال، وبالأخص إن لم يكن المعتقلون من أسرٍ كبيرة أو مؤثرة، ولم يكن أحد يعرف عن هذا الاعتقال غالباً، ويتم كتمانه من العائلة كي لا يتعرضوا لشكل من أشكال النبذ الاجتماعي.
وعليه، ربما كان السبيل الذي اتخذه معظم المسيحيين اليوم هو الهجرة، حيث تقول بعض المصادر الكنسية بهجرة أكثر من ثلثي مسيحيي سورية في السنوات الست الأخيرة، وهي هجرة مسيحية لم يشهد التاريخ السوري نظيراً لها فيما سبق.
*****
ملحق رقم 2
دراسة حالة: المسيحيون في يبرود
إعداد: رند صباغ
شكلت يبرود بحكم طبيعتها الجبلية الوعرة وتوافر المغاور فيها ملجأً للمسيحيين الأوائل، قبل اعتبارها حاضرةً مسيحية في القرن الثالث الميلادي، وتميل التقاليد الكنسية إلى اعتبار القديس توما «رسول القلمون» لكثرة الكنائس التي شُيِّدت على شرفه في كلِ من يبرود ومعلولا وجبعدين وعين التينة وصيدنايا والنبك. وليس في هذا الرأي ما يشير إلى استحالة هذه الفكرة كما يقول الباحث «نور الدين عقيل» في كتابه «صفحات من تاريخ يبرود والقلمون»، إذ من المعقول أن يكون القديس توما قد مَّر بالقلمون إبَّان سفره إلى الهند، وهكذا تكون قد سنحت له الفرصة ليبشر بالمسيحية في جبال القلمون حيث انتشرت فيها كثيرٌ من الأديرة
حافظت يبرود، التي بحسب العالم الأثري الألماني ألفرد روست احتضنت حضارة إنسان ما قبل التاريخ، على أغلبية مسيحية طوال العهدين الأموي والعباسي، وبدء التعداد المسيحي في التراجع مع حكم المماليك، ليشكل المسيحيون نصف السكان تقريباً طوال الحكم العثماني. وفي ظل الفرمان العثماني القاضي بمنع ترميم الكنائس تعرضت كنيسة يبرود أقدم أثر مسيحي في سوريا لبعض التهدم في جدارها الشرقي، وجُدد بناؤها حوالي العام 1838 بعد أن سمح بذلك الفاتح المصري إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا عندما مرَّ ببلدة يبرود بعد حملته على بلاد الشام وطرد العثمانيين منها بين عامي 1831-1841 وفتحها
يذكر أنه ومع حملة إبراهيم باشا على بلاد الشام بدأت أول هجرة مسيحية من يبرود، حيث هاجرت بعض العائلات المسيحية إلى مصر طمعاً بحياةً أفضل، تبعتها موجات من الهجرة أدت إلى تناقص شديد في أعداد المسيحيين لعل أبرزها تلك التي حدثت بعد الحرب العالمية الأولى نحو الأمريكيتين، وكان الدافع لها اقتصادياً.
وعلى الرغم من تناقص عدد المسيحيين في يبرود بشكل درامي على امتداد القرن الماضي، إلا أن المدينة شهدت حالاً استثنائياً من التعايش بين اتباع الديانتين، ولم يسجل أي خرق أو احتكاك، حتى أن العوائل المسيحية كانت منتشرة في جميع أحياء البلدة «القامعية، زقاق المبلط، حي المطاحن، السوق، اسكفتا، الصالحية». وفي عام 1925 إبان الثورة السورية الكبرى حاول عدد من «الموتورين» من إحدى البلدات القريبة، الهجوم على مسيحيي يبرود، فقامت العائلات المسلمة -منهم آل حي- باستقبال مسيحيي يبرود في بيوتهم وحمايتهم.
كما خرّجت مدرسة الراهبات في البلدة جيل المتعلمين والأكاديميين من المسيحيين والمسلمين، وليس بالإمكان حصر أعلام المسيحيين في يبرود الذين نبغ منهم كثيرون كشاعر المهجر زكي قنصل والطبيب أنيس دهبر، ورجل الأعمال موسى كريم الذي قام بحملة تبرعات لبناء المشفى الوطني في المدينة والذي افتتح في رئاسة القوتلي الأخيرة.
ابتداءً بالوحدة مع مصر ومروراً بعهد البعث انهارت أعداد المسيحيين في يبرود، إذ شهدت فترة الستينات هجرة الطبقة الأكثر ثراءً وتهريب أموالها معها، وكانت المرحلة الأولى من الهجرة تلجأ إلى لبنان وفي المرحلة الثانية انطلقت نحو المغترب البعيد.
تبعتها موجة هجرة جديدة كأحد مرتجعات الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت عام 1975، وتحوّلت نوعاً ما إلى اقتتال طائفي بين مكونات البلاد من مسيحيين وسنة وشيعة ودروز. فتحت الحرب الأهلية باب الهجرة للبنانيين عموماً ومسيحيي لبنان خصوصاً، الذين تربطهم بمسيحيي سورية علاقات قرابة وتجاور. لذلك فإن الهجرة اللبنانية دفعت بشكل أو بآخر إلى تشجيع الهجرة السوريّة، فمن يبرود هاجرت عائلتا شيحا وأيوب المسيحيتين بالكامل، ولم يبق سوى منزل قديم مهجور لآل أيوب في المدينة.
الهجرة الثالثة تزامنت مع تمرد الإخوان المسلمين في سورية، والذي بدأ عام 1979 على يد «الطليعة المقاتلة»، وهي الجناح العسكري للحركة، واستمرّ حتى 1982 وتمركز في حماة وامتدّ نحو مناطق ومدن سوريّة مختلفة، وأدى إلى رفع وتيرة هجرة المسيحيين رغم ابتعاد يبرود تماماً عن دائرة العنف أو الأحداث، إلا أن الهجرة كانت لعموم المسيحيين في سوريا حتى أن تزايد الهجرة بشكل متسارع، وصل إلى درجة أن الدولة السوريّة قامت في أواسط الثمانينات بمنع إصدار تأشيرات الخروج لمسيحيي البلاد
ويرجع حنا بطاطو في كتابه، فلاحو سورية: أبناءُ وجهائهم الريفيين الأقل شأنًا وسياساتهم، الهجرة المسيحية إلى عامل اقتصادي مرتبط بسوء التخطيط والنظام الحاكم، خاصةً أنه ورغم انتشار التعليم في يبرود بنسبة تفوق التسعين بالمئة إلا أن أغلب الأسر بقيت تعتمد على الزراعة كمصدر جانبي للدخل، يقول بطاطو: «في الثلث الأول من التسعينات. في البحث عن الأسباب سنجد أن السبب الرئيسي هو غياب التخطيط أو عدم الالتزام بالخطط، جراء المحاباة أو الرشاوي أو شراء الولاء وشتى أشكال الفساد الذي يحوز على رضى ومباركة القيادات العليا في دولة البعث، طالما أنه يعزز السيطرة. سحب المياه الجوفية بدون رقابة وبشكل يفوق إعادة امتلاء أحواض المياه الجوفية أدى إلى «ذبح المياه» حسب تعبير فلاح من القلمون. وأدى فرط استعمال نهر بردى للأغراض الصناعية والمنزلية إلى «موت بردى» وتحول مياهه إلى «ماء آسن وملوث يقتل الشجر ويؤدي إلى يباسه» على ما يقول أحد فلاحي الغوطة المسنين».
قبيل الثورة السورية وصلت نسبة المسيحيين لعشرة بالمئة من السكان، إلا أن ملامح العيش المشترك بقيت استثنائية، فلدى زيارة الرئيس الأرجنتيني كارلوس منعم لمسقط رأسه تم استقباله بذات الحفاوة في بيت العائلة وفي كنيسة المدينة، على الرغم من أن منعم ارتد عن الإسلام واعتنق المسيحية عندما أراد الترشح لرئاسة الأرجنتين، لأن دستور البلاد يفرض أن يكون الرئيس مسيحياً، ولم تثر ديانة ابن المدينة أي تساؤل أو رد فعل سلبي في حينه.
التيارات والأحزاب السياسية في يبرود
بدأت علاقة أهل يبرود بالسياسة أو المجال العام باكراً، استناداً إلى المرجعيات والزعامات التقليدية التي انحصرت تقريباً في شخص محمد خير عقيل الزعيم المحلي
وكان للحزب الشيوعي القاعدة الأوسع بين مسيحيي يبرود، على الرغم من أن المؤسس مسلم من المدينة، بينما لم تلق الأفكار الشيوعية رواجاً عند المسلمين، إلا أن مسيحيي يبرود شكلوا استثناءً عن القاعدة العامة بحيث يذكرهم المؤرخ حنا بطاطو بالاسم قائلاً: «كان للجذور الريفية لمعظم الشيوعيين البارزين الأوائل أثرٌ في جعلهم ذوي حساسية تجاه مشكلات الفلاحين، ولكن لم تخدم هذه الحساسية الشيوعيين فهم لم يتقدموا في الريف إلا بين الفلاحين المسيحيين في يبرود، ويمكن تقصي الأسباب في عدم مثابرة الشيوعيين، وفي ضعف المواصلات، وفي سيطرة الصوفية على العدد الأكبر من الفلاحين، إضافة إلى الخلفية الأقلوية لجميع القادة الشيوعيين البارزين، باستثناء ناصر حدة الذي كان العربي السني الوحيد في قيادة الحزب»
ومن الممكن هنا رصد انقسام عمودي في مجتمع يبرود على صعيد الانتماء السياسي، حيث انتمى المسيحيون لليسار بكل أطيافه حتى يومنا هذا، في حين التزم المسلمون بالزعامة التقليدية ثم بالتيار العروبي لاحقاً. تجلى هذا الانقسام واضحاً زمن الوحدة مع مصر، حين اتخذ المسيحيون موقفاً سلبياً من الوحدة مع مصر تبعاً لخلفياتهم المسيحية والشيوعية في آنٍ معاً، وعلى ما يؤكد الاستقراء السابق أنه وفي عام 1961 وبعد الانفصال مباشرةً اجتمع خمسون من قيادات الصف الثاني من حزب البعث، وقرروا العمل تحت اسم حركة الوحدويين الاشتراكيين. واعتبر هذا الاجتماع الذي انعقد في أوائل عام 1962 مؤتمراً تأسيسياً لــ «حركة الوحدويين الاشتراكيين»، وانتخب سامي صوفان ابن يبرود أميناً عاماً للحركة.
الحركة التي رفعت شعار الوحدة الفورية مع مصر، والتي جذبت إلى صفوفها خلال فترة قصيرة استثنائية فئات كثيرة من المثقفين، والأوساط الشعبية، فوصل تنظيمها الأفقي إلى ما يقرب الثلاثين ألف عضو*، حتى تموز 1963 لم يكن في تعداد أعضائها من مسيحيي يبرود ما يتجاوز أصابع اليد الواحدة
أما بالنسبة للتيار الإسلامي، فلم تملك التيارات الإسلامية أو «الإسلام السياسي» إن جاز التعبير أي أرضية أو حاضنة في مدينة يبرود عبر تاريخها الحديث، على الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين في سورية، والتي أعلن رسمياً عن تأسيسها في 3 شباط 1945 مع تسجيلها في وزارة الداخلية ومن ثم صدور كراس «أهدافنا ومبادئنا»، عقدت مؤتمرها التأسيسي الأول في يبرود في أيلول عام 1946
أما بالنسبة لحزب البعث الحاكم، وعلى الرغم من الخلفيات الناصرية لمسلمي يبرود، فإنه لم يحظَ بأي نفوذ أو شعبية في المدينة، وكذا الحال بالنسبة للمسيحين بحيث لم يتبوأ أحد أبناء المدينة منصباً قيادياً في الحزب، وبقي المسيحيون مخلصين لليسار وحتى تياراته المعارضة، وتعرض الكثير منهم للاعتقال والتصفية أثناء حكم الأسد الأب. ففي عام 1990، وبعد إعدام تشاوشيسكو، كتب بعض الشبان المسيحيين على الجدران في المدينة يبرود «اليوم تشاوشيسكو وغداً حافظ الاسد». وفي اليوم التالي شنَّ جهاز المخابرات حملة اعتقالات واسعة في صفوف الشبان، وأتى الشبيحة يومها وأخذوا من أخذوا ومنهم منير فرنسيس الذي ذهب ولم يعد.
وعن منير فرنسيس كتبت خولة دنيا: «في فضاوة السجن كان التعذيب أقل من المعتاد، عرفنا السبب بعد أيام من اعتقالنا، فهناك من مات تحت التعذيب في الزنزانة السادسة. قالوا لنا كان هناك منير فرنسيس، ابن يبرود، المعتقل بتهمة (المكتب السياسي) والكتابة على الجدران. أصيب بنوبة كلوية جراء الضرب الهمجي في مخفر النبك قبل المجيء به إلى الفرع، وعدم تلقيه العلاج، واستمرار التعذيب. بعد خروجنا من السجن زرنا يبرود وزرنا بيت منير وسمعنا حكاية التابوت المصفح الممنوع فتحه، وكيف أُجبر الأهل على دفن ابنهم من دون وداع يليق به»
تجدر الإشارة أنه وفي عهد الأسد الابن، وإذا جاز اعتبار التشيع خياراً سياسياً، فقد بدأت بعض الحالات الفردية بإعلان تشيعها، وبات هناك ما يشبه التنظيم الاجتماعي للأفراد الشيعة ترأسه أحد أبناء المدينة المغتربين في الكويت، إلا أنه لم يتعدّ الحالات الفردية رغم دلالته الكبرى.
مسيحيو يبرود والثورة السورية
لا يمكن الحديث عن مشاركة مسيحيي يبرود في الثورة السورية عام 2011 بمعزل عن أبناء المدينة أو عموم الشعب السوري. إلا أن تجربة مسيحيي يبرود تحمل ملامح خاصة لا بدَّ من ذكرها، أولها الطابع المعارض تاريخياً لمسيحيي المدينة، ووقوف كنيسة يبرود ولو على خجل مع رعيتها في مواجهة النظام. ولا يمكن بأي حال وصف سلوك كنيسة يبرود بالداعم للنظام أو الحيادي لجملة وقائع سنوردها تباعاً.
ورغم الضغوط التي مارسها النظام على المسيحيين بشكل خاص لمنعهم من الانخراط بداية الثورة، إلا أن المعارضين من المسيحيين، رغم قلة عددهم نسبة إلى عدد المسيحيين في يبرود بدايةً، كانوا من أوائل المنخرطين في الثورة والمشاركة في تنظيم المظاهرات. حيث التحقت يبرود بكافة مكوناتها بالثورة السورية في وقتٍ مبكر، ففي الجمعة الأخيرة من نيسان 2011 خرجت مظاهرة من جامع العجمي وتعرضت لاجتياح قوات النظام، وتجددت التظاهرات، وفي نهاية الشهر السادس من العام نفسه، وإثر اعتقال إحدى الناشطات من مظاهرة مسائية في ساحة الحرية، اعتصم حوالي 400 متظاهر حول المخفر لإخراج الفتاة، ليقابلوا بإطلاق نار من عناصره، ما دفعهم إلى إلقاء الحجارة عليهم. وسريعاً، تدخل الأمن العسكري الذي فتح عناصره النار على المتظاهرين، مما تسبب في إصابة أربعة متظاهرين، ومقتل الشاب خالد النمر.
حضرَ في جنازة خالد النمر أكثر من 25 ألف مشيّع، من كل قرى وضياع القلمون المجاورة، وكان لاستشهاده الفضل الأكبر في انقلاب المزاج العام، وكسر حاجز الخوف لدى الناس، لتتوالى الأحداث بعدها بسرعة، من اتساع المد الشعبي للثورة، وبدء ظهور السلاح لحماية المظاهرات، ومن ثم تشكيل كتيبة «سباع الجرد»، عبر معارك الاستيلاء على شعبة الحزب والمخفر وبناء الجمارك والبلدية.
مع دخول عام 2012 سيطرت المعارضة المسلحة تماماً على المدينة التي شهدت عملاً مدنياً وإغاثياً مكثفاً للنازحين إليها، وشهدت هدوءً نسبياً طوال سنتين حتى تاريخ استعادة النظام للسيطرة عام 2014. ويرجع البعض الهدوء الذي عاشته المدينة إلى كون مسيحيي يبرود هم من الكاثوليك الملكيين، كتابعية مسيحية للفاتيكان، والتي فرضت على السلطة السورية نوعاً من الترتيب يحيّد المنطقة من الهجوم العسكري لجيش الأسد، مما ساهم في خلق هوامش حرية تشمل كامل مكونات المجتمع اليبرودي. لكن تبقى هذه النظرية في إطار التواتر والافتراض.
المظاهرات شبه اليومية المناهضة للنظام كانت تسلك طريق «شارع المطاحن»، الحي المسيحي التاريخي، وصولاً إلى «ساحة الرويس» قلب المدينة، وكانت تجمع في صفوفها مكوني المدينة مسيحيين ومسلمين، وقد حاولت قوى مسيحية لبنانية التدخل وتقديم الدعم المالي لمسيحي يبرود وحاولت الاتصال بناشطيها المسيحيين، إلا أنهم رفضوا تدخل أي قوة أو جهة غير سورية في ثورتهم، سواء كانت دينية أو سياسية.
يصف الصحافي الفرنسي الذي زار يبرود، ريمي فيليب، واقع المسيحيين في المدينة قائلاً: «شطر لا يستهان به من سكان يبرود من المسيحيين (40 في المئة، وفق المسؤولين المحليين). والنظام يسعى الى استمالة الأقليات الدينية، والتفافها حوله لتناصب العداء للغالبية السنية. ويحاول المسيحيون السوريون النجاة من براثن هذا الفخ، ويلتزم كثيرون منهم الحياد. ورغم الحياد الرسمي، فقد برزت مجموعات مسيحية مؤيدة للثورة والجيش الحر. وانضم ميشيل ويوسف، وهما من السريان الكاثوليك، إلى اللجنة الأمنية في المدينة، لكنهما لا يشاركان في القتال، ولسان حالهما: (نحن كمسيحيين لا نؤيد حمل السلاح، لكن الخيارات أمامنا قليلة في مثل هذه الحال… وعائلاتنا تخشى ما هو آت)». لكن خوف ميشيل ويوسف ضعيف الصلة بالدين، فهنا، يتعايش المسلمون والمسيحيون. لكن «ما يقلق المسيحيين هو وجه سورية الجديدة، في وقت لا يجدون سنداً لهم أو حامياً. وتزعم الحكومتان الأميركية والفرنسية أن مصير المسيحيين يشغلهما، لكنهما لم تحركا ساكناً لحمايتنا. من يحمينا في يبرود هم الجيران المسلمون». ويصوم مسيحيو يبرود في شهر رمضان، وتجمع مراسم العزاء المسلمين إلى المسيحيين
كما تم تمثيل المسيحيين في مجلس الثورة في المدينة إلى جانب التمثيل في تنسيقية يبرود والمجلس المدني فضلاً عن المجلس المحلي، كما ساهموا بشكل فعال ضمن الحملات الإغاثية، في حين ساهم الأغنياء منهم بتقديم الدعم المالي والمساعدات.
وقد تكون يبرود المدينة السورية الوحيدة التي انطلقت فيها مظاهرات من أبواب كنائس المدينة، كمظاهرة «أحد الأب باولو»، وشارك فيها أكثر من ألفي ثائر في نهاية العام 2011 بعد قرار السلطات السورية بترحيله خارج سوريا لمواقفه الداعمة لثورة، كما شارك أكثر من ثلاثة آلاف متظاهر قداس الشهيد المصور باسل شحادة في صيف 2012، بعد منع تشييعه من قبل الأمن في إحدى كنائس حي باب توما في دمشق. ومن أكثر العبارات الثورية التي رددها ثوار مدينة يبرود «إن هُدم مسجدك تصلي في كنيستي، وإن هُدمت كنيستي أصلي في مسجدك».
شهدت المدينة أيضاً تظاهرات ميلاد الحرية احتفالاً بميلاد السيد المسيح عام 2011، والتي شارك في أعدادها وتنسيقها شباب وشبان من يبرود مسيحيين ومسلمين. كما دعت كنيسة النجاة في المدينة الثوار مسلمين ومسيحيين إلى وجبة افطار في 03/08/2012 للتضامن مع الثورة السورية. وقبل الدعوة، عقد جميع الشباب الثوري المسيحي المشارك في الفعاليات الثورية في يبرود لمناقشة تأسيس كيان ثوري للتعبير عن فعاليتهم في الحراك. وتقرر تشّكيل تجمع «مسيحيون احرار»، وكانت أبرز قرارات التجمع: الحفاظ على سلمية الثورة وعدم التطوع في كتائب الجيش الحر العاملة في المدينة. وكان لانتشار صور الإفطار واتشاح رجال الدين المسيحيين بعلم الثورة أن شكل صفعة قوية ترد على خطاب النظام الإعلامي، لكن النظام سارع في تصعيد ضغطه على مسيحيي يبرود. فكثرت حالات الاعتقال للمواطنين الذين أرادوا الخروج من المدينة، وتم قصف منازل أحياء مسيحية مما أدى لسقوط جرحى، وتعرضت كاتدرائية الروم الكاثوليك في المدينة للقصف بأربع قذائف هاون أدت إلى دمار جزئي في جدارها.
شكلت يبرود أيضاً استثناءً من خلال مشاركة المسيحيين في كتيبة الأمن الداخلي في المدينة، والكتيبة كانت غير مسلحة ولا تدخل في عمليات عسكرية ضد النظام، عناصرها يحملون هراوات خشبية ووضعت إشارة على كتفهم الأيسر كتب عليها «كتيبة الأمن الداخلي في مدينة يبرود»، وتنحصر مهامها في تنظيم شؤون المدينة أمنياً.
ووفقاً لتقرير لوكالة الأناضول للأنباء بتاريخ 3 آذار 2013، فقد بقي في يبرود أكثر من أربعة آلاف مسيحي في المنطقة المحررة الواقعة في ريف دمشق، حيث يشاركون باقي سكان المدينة أفراح الثورة وأتراحها، فهم كعموم السكان شاركوا في بدايات الثورة السورية وساروا في المظاهرات السلمية يطالبون بالحرية، ويعانون اليوم من تبعات الثورة الاقتصادية والمعيشية.
لا تعني الوقائع والأحداث التي ذكرناها سابقاً أن مسيحيي يبرود بالكامل كانوا من مؤيدي الثورة، إلا أن الموقف المسيحي مرَّ بمراحل مختلفة، وبإمكاننا الجزم أن الموقف بات إما معارضاً أو حيادياً بعد قتل المهندس المسيحي بسام غيث تحت التعذيب في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، بالإضافة إلى عدد من الناشطين الآخرين. كما لا يمكن الحديث عن مسيحيي يبرود والثورة السورية دون ذكر اختطاف راهبات معلولا في الشهر الأخير من عام 2013 وصفقة إخراجهم بوساطة قطرية، والتي شكل إتمامها مقدمةً لاقتحام المدينة من قبل جيش النظام وحزب الله اللبناني. لكن بحسب ناشطين، كعامر القلموني الناطق باسم «الهيئة العامة للثورة السورية»، فإن الراهبات لم يتعرضن للخطف، بل أخذن بغرض حمايتهن من قصف النظام، وأنهن أقمن في منزل أسرة مسيحية سورية «جورج الحسواني». يوم الأحد 16 آذار عام 2014 وبعد 33 يوماً من القصف المتواصل، دخل مقاتلو «حزب الله» اللبناني إلى أحياء يبرود، وخلال أقل من 5 ساعات أعلنوا سيطرتهم على المدينة وبدأوا بتمشيط أحيائها، خلال المعارك وقبلها فرغت يبرود من مسيحيها تماماً، حيث انتقل المدرجون على قوائم الاعتقال لدى النظام إلى لبنان، بينما تمكن الآخرون من النزوح إلى دمشق والقرى المجاورة. وبعد سنتين من سيطرة المعارضة المسلحة وملامح العيش المشترك والتنظيم المدني الواضح في المدينة، عمل النظام على ترويج صور للدمار والتخريب الحاصل في «كنيسة السيدة للروم الكاثوليك». هذا التخريب تحول وعبر إعلام النظام ومن يسانده إلى علامة فارقة جعلها النظام مادةً للتداول بين المؤيدين، وكان من بين الصحفيين الذين حضروا إلى يبرود الصحفي البريطاني روبرت فيسك، الذي استسهل استخلاص العبر والمقولات استناداً لما شاهده من تدمير في الكنيسة
اليوم وبعد مرور أكثر من سنتين على استعادة النظام للمدينة، عادت بعض الأسر المسيحية لممارسة حياتها بشكلٍ طبيعي، إلا أن عدداً كبيراً من أبنائها فضل عدم العودة، والاستقرار مبدئياً في لبنان بانتظار الهجرة إلى كندا أو أوروبا. كما انخرط قسم من الشباب المسيحي المعارض في مشاريع الإغاثة في مخيمات اللجوء، في الوقت الذي يقوم فيه «حزب الله» اللبناني بإخلاء عدد من المنازل في منطقتي اسكفتا والقاعة، والتي تحوي قيوداً عقارية لمسيحيي يبرود، ليوطّن عائلات مقاتليه فيها، بحجة أنها تلزمه للأمور العسكرية، بحسب «الهيئة العامة للثورة في مدينة يبرود».