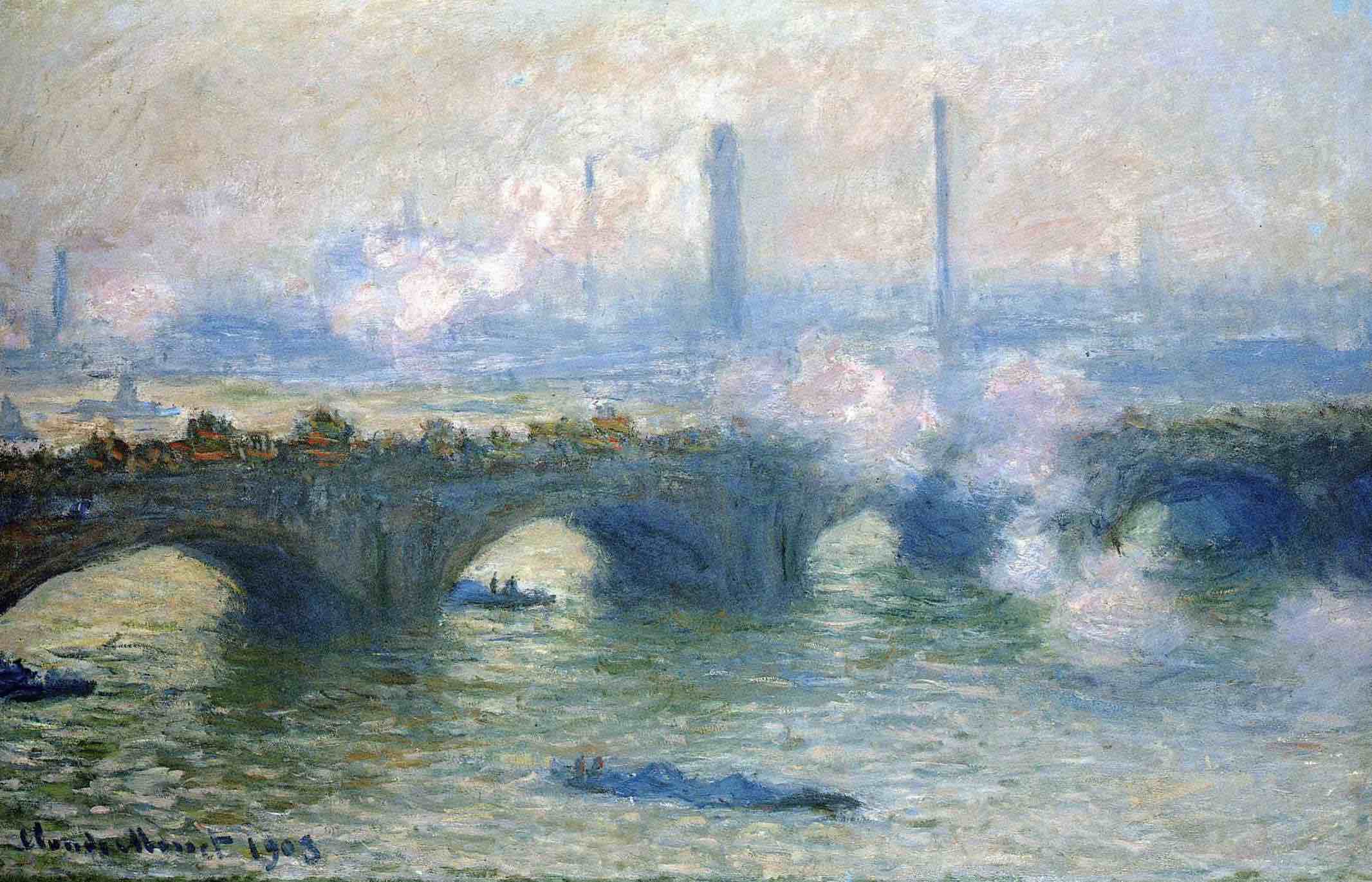خلافاً لمقولة «الفن للفن» ومقولة «الأدب للأدب»، قد يكون من الصعب أن ينعزلا، أي الفن والأدب، عن حركة المجتمع وتطلعات أفراده للقيم المطلقة مثل الحرية والعدالة، بالإضافة إلى أن تطورهما مرهون بالحركة الأدبية والفنية التفاعلية في المجتمع، إذ أن إثارة ذائقة المتلقي «الجمهور» من الدلالات القيمية المهمة للقصيدة، ويصعب أن تحقق القصيدة تطورها في غياب الرأي النقدي. وإذا سلّمنا بأنّ الماضي القريب جداً من تاريخ الأدب السوري قد ترك مجالاً للانطواء على الذات والانشغال بتفاصيل الحياة اليومية، فإن الثورة وما تبعها من حرب ذات سمات خاصة لم تترك للذاتي مجالاً واسعاً أمام العام الذي يسم المرحلة، فهي، أي الحرب، تهدّد الكل، ولا تميّز بين شاعر وقارئ.
ولما كانت القصيدة العربية طاعنةً في التاريخ، ومرت بسلسلة طويلة من حلقات التطور في المبنى والمعنى عبر كثيرٍ من الشعراء، ابتداءً من هلهلة الشعر العربي وصولاً للقصيدة الجديدة «القصيدة النثرية»، ومن هؤلاء الشعراء من تربع سنام الشعر ومنهم من جلس على درجاته العالية، ومنهم من خاض في التكرار والتقليد ولا نجده إلا اسماً في مكدّسات الكتب التي تُعنى به تاريخياً لا أدبياً، فلذلك لا يمكننا أن نبتدئ سبر حال القصيدة في سورية بعد بداية الألفية الثالثة دون المرور على الأقل على بدايات التحول الجدي في بنية القصيدة وشكلها، وإذا كانت القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة من الأشكال التي برزت بقوة في فترة ازدهار الشعر في العصر الحديث، منذ جلاء الفرنسيين عن سورية في أربعينيات القرن الماضي حتى أواسط سبعيناته، فسنعنى بالبداية من الثمانينات، عندما أصبحت القصيدة الجديدة في سوريا واقعاً بعد أن كانت محل اتهامات الكتّاب والنقاد قبل ذلك، وعلى رأس من انتقدها شوقي بغدادي، عندما أوضح في مقال قديم أن الصهيونية وراء قصيدة النثر، وشوقي بغدادي كان رئيس تحرير مجلة «الموقف الأدبي» الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب الحالي، وموقف اتحاد الكتاب العرب من قصيدة النثر معروف للقاصي والداني، وفي حوار أجرته المجلة العربية معه، أي مع شوقي بغدادي، يصف قصيدة النثر بالاستيراد الأوروبي (الناقدة الفرنسية سارا برنارد)، ويرفض تسميتها «قصيدة»، ثم يرجع ويقول إنه يقرأ لـ «شعراء نثريين» لبنانيين، وليس كثيراً للسوريين، وكثيرون وافقوه رأيه. ولكنَ شعراء القصيدة الجديدة لم يأبهوا بكل هذا، حتى أن شيوخ قصيدة التفعيلة كثيراً ما تخللت قصائدهم مقاطع نثرية، ولبعضهم دواوين نثرية كاملة مثل محمود درويش ونزار قباني، وبالطبع لا ننسى أوائل من كتبوا قصيدة النثر منذ الخمسينيات، وعلى رأسهم جد شعراء النثر السوري محمد الماغوط.
أدت النكسات الحاصلة في الثمانينات (اجتياح حماة، الحصار على سورية، حرب الخليج، اجتياح لبنان والحرب الأهلية فيها، الاتفاق المصري الإسرائيلي ….إلخ) إلى تراجع الحالة الجماهيرية وانكفائها، ومع السقوط المدوّ للواء القومية العربية والقضية الفلسطينية إزاء مصالح أنظمة الحكم الناشئة في البلدان العربية لم يعد شحن الجماهير عبر منبر الشعر المكان المناسب للشعراء المحبطين في تلك المرحلة، فجنحوا للذاتية ومشاغل الحياة اليومية مبتعدين عن القضايا المتساقطة واحدة تلو الأخرى، وعزّز ذلك الديكتاتورية السافرة في سورية، التي لم تقتصر بممارساتها على الإخوان المسلمين والشيوعيين، بل تعدتهم لتطال كل كاتب أو فنان أو صحافي يجاهر برؤية مضادة لرؤية الطغمة الحاكمة، خصوصاً بعد سيطرة فرسان البعث على الأندية الأدبية والصحف وكافة وسائل الإعلام ودور النشر.
من هذا الواقع، فإنه لا يمكننا أن نلّوم إلى حد كبير شعراء تلك الفترة، بل يمكن أن نعتبر جنوحهم عن القضايا العامة وعن التطور المتسلسل في شكل القصيدة العربية شكلاً من أشكال الدفاع عن الذات؛ الذاتُ المبدعة من وحل المرحلة والذاتُ البشرية من سطوة نظام الحكم القائم، وبالرغم من انتشارها وشيوعها بين شعراء تلك المرحلة، لم تواكب قصيدةَ النثر القراءةُ النقدية الكافية لتحديد درجات التحديث فيها وفرز أشكالها والسمات الفارقة بينها حسب كتّابها، فظلت رهينة بين آراء المتذوقين وبين آراء الرافضين على اختلاف أذواقهم ومقدراتهم النقدية، ولكنّ أسماءً بارزةً استطاعت فرض هذا الشكل الجديد بعيداً عن التأثر بالأدب الأجنبي، فكانت قصائدهم امتداداً للشعر العربي الأصيل، وخارجةً من بيئاتهم لا تنفصل عن اهتمامات الجمهور المكبوتة.
أما مع بداية الألفية الثالثة فقد مسّت الشعراءَ ملامحُ التطور الحضاري، ووسمت قصائدهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون، وهذه ليست صفة سلبية بالضرورة، فبالإضافة لما أسلفنا عن غياب الحلقة النقدية الواصلة في سلسلة تطور القصيدة الجديدة وانعدام الأندية الأدبية والفكرية وقلة الصحف والمجلات ذات الاهتمام، كان هناك طارئان على الواجهة الثقافية في سورية والوطن العربي، الأول تطور الأعمال الدرامية واحتلالها المرتبة الأولى في جذب الجمهور، ولم يقتصر تأثيرها على هذا بل تركت آثاراً واضحة في أغلب قصائد شعراء هذه الفترة، فأصبح واضحاً الميل لإثارة الصورة البصرية عبر رسم المشهد من خلال ذكر تفاصيله في القصيدة، وذلك بدلاً عن إثارة الصورة البصرية من خلال الصورة الشعرية ذاتها، فنجد الشاعر يذكر بإسهاب مكونات غرفته «صحن سيجارة، طاولة، ملاءة، سجادة، كأس… إلخ» أو الموجودات في الطريق أو الحارة، كما مالت مفردات بعض الشعراء للألفاظ الأكثر تداولاً، وكأنهم يماشون شيوع (اللهجة البيضاء) السهلة على الجميع. والأمر الثاني هو التطور التكنولوجي وظهور وسائل التواصل الاجتماعي، من جهةٍ لفتَ انتباه الكتّاب، فظهرت المفردات التقنية والتكنولوجية في عناوين الدواوين والقصائد وفي تركيب جملها، مثل عنوان الديوان الحائز على الجائزة الاولى لاحتفالية دمشق عاصمة الثقافة العربية 2008 (أبحثُ عنكِ على google) لقيس مصطفى، ومن جهةٍ أخرى أثرت وسائل التواصل الاجتماعي على بنية القصيدة وعلى غرضها، فاهتم كثيرٌ من الشعراء بنشر مقاطع شعرية قصيرة للحديث عن حدث طارئ أو حالة مؤقتة يمر بها، لتصبح كثيرٌ من الدواوين لاحقاً ليست إلا تجميعاً لمقاطع غير متصلة من حيث الفكرة والصياغة، ناهيك عمّا يشكله ذلك من استهلاك للذخيرة اللفظية والشعورية لدى الكاتب. كما تماشى البعض مع خصائص وسائل التواصل الاجتماعي من حيث عدد الأحرف الأقصى المسموح به في النص المنشور؛ على (فيسبوك سابقاً) وعلى (تويتر حالياً)، وربما يكون هذا المحدد خارجاً عن المحددات الفنية في القصيدة مثل الوزن والقافية أو المقطعية الصوتية في شعر الهايكو الياباني. وهنا ينبغي تمييز هذا عن القصيدة القصيرة جداً التي تقوم على التكثيف والإيجاز واللا-دقة في المعنى لتفتح باب التأويل، ولهذه القصيدة جذرها التاريخي في الأدب العربي في الشذرات والموشحات، ولها امتدادها المعاصر في محاكاة الأدب العالمي مثل الياباني والأوروبي، ولكنّ محددات القصيدة القصيرة جداً أو الشذرة هي محددات فنية وبنيوية داخلية، وليست حالة استجابة لشروط تقنية في مواقع وصفحات العالم الافتراضي، ولا بدّ للذائقة السليمة أن تميز ما بين القصائد القصيرة جداً وبين النصوص القصيرة التي تفرضها مواقع التواصل، على الرغم من وجود الاثنتين في المكان نفسه وضمن الشروط التقنية نفسها.
ليس لدى أمي فيسبوك
ولا واتساب
….. إلخ
(إبراهيم قعدوني)
وقد يكون فيما أسميه شخصياً «الثقافة المستعارة» الخطر الأكبر، فمن السهل جداً أن تسأل الباحث (google) عن أي موضوع يخطر في بالك أو تضطر له، فيجيبك بسرعة البرق ويقدم بين يديك مادة معرفية صحيحة كافية لتكتب بها مقالاً أو تصدّر من خلالها رأياً (خاصاً)، الأمر الذي قد يؤدي لتراجع الثقافة المكتنزة لدى الكاتب، وإذا نظرنا إلى هذا الخلل زمنياً سنحصل على كتابة مكرورة، إذ أن الإبداع ما هو إلا هضم الداخل المعرفي واسترجاعه ببصمة خاصة عند حاجته.
وبالشكل العام ما زالت النماذج الأدبية المعاصرة في زمن السرعة والإنترنت ومحركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بحاجة للكم والكيف لإطلاق الأحكام النقدية عليها، ومما لا شك فيه أنّ روّاداً سيحملون لواءها ويثبتونها كشكل من أشكال تطور النص الأدبي.
فتحت الألفية الثالثة أبوابها على نكسة كبيرة للشعور العربي وخاصة في سورية؛ إنها الحرب على العراق ومن ثم سقوط بغداد، وما لبغداد من وقع ديني وعروبي وحضاري وحتى أدبي في النفوس ما يغنينا عن الحديث عنه. أصبحت القومية العربية وانطباعاتها في الضمير الفني والأدبي في سورية الملاصقة للعراق مجرد أوهام المرحلة الماضية، ثم جاءت بارقة أمل بعد سقوط الشعارات وتهاوي القضايا، وعلى حدة من زيفها أو حقيقتها، فقد كانت أسلوب الهروب الوحيد في اللاشعور العربي من ذاكرة الهزائم المرة. أتحدثُ عن حرب تموز التي خاضها حزب الله في جنوب لبنان، إذ حاول العديد من الشعراء الشباب الكتابة لهذا الحدث ولكن ذلك لم يأتِهم بنفع، فالنظام الديكتاتوري الذي يدرك حجم هذه الكذبة رهنها لـ (شعرائه) المرتزقة في ذلك الوقت.
حال الركود هذه استمرت منذ أواسط السبعينات في القرن الماضي حتى لحظة الانعطاف الحقيقي على مستوى البلدان العربية وسوريا منها خصوصاً، «الربيع العربي». وبلا شكّ، فإن الثورة فعل جماهيري، وبانطلاقة الثورة السورية خرجت الجماهير من انزوائها وركودها إلى الساحات. ولسنا هنا في محل تقييم الفعل بل في محل وصفه، وفي كل الحالات سيكون لهذا الفعل أثره الانقلابي على مستوى الفن والأدب في سورية، ولعل الحديث عن هذا الأثر ونتائجه ما زال مبكراً، فالمخاض لم ينته بعد، ولكن لا ضير في وصف المخاض ذاته، وهنا سأتحول في كلامي عن القصيدة الجديدة في سورية من «قصيدة النثر» إلى «قصيدة ما بعد الثورة» بكافة أشكالها.
***
لن نغرق في وصف الحدث، لأنه معلوم للجميع، بل سنقف عند نقاط فارقة فيه. ابتدأت الثورة بفعل شعبي غير مُساق بإيديولوجيا محددة، بل طرحَ قضايا مطلقة مثل الحرية والعدالة ولم يخلُ من مطالب سياسية ذات بعد فطري إن جاز التعبير، وفي أتون العقاب الأمني الجماعي الذي فرضه النظام، ثم انتهاجه لسياسة الاعتقال والتهجير، ولجوئه لسياسة الاحتلال الداخلي في إعلان الحرب على الشعب، واستخدام كافة الوسائل للقضاء على الثورة، برزت مؤثرات قوية في الشعراء وقصائدهم.
فُرِضَ على الشعراء الظرف الشاغل بطبيعته عن الكتابة، فهم كانوا جزءً أصيلاً من الحراك وليسوا فرقة موسيقية على قارعته، كان عليهم أداء واجبهم كلٌّ حسب اختصاصه إن كان طبيباً أو مهندساً أو عاملاً… إلخ، وبعضهم خاض تجربته الخاصة في العمل الثوري المسلح. وقادةُ الثورة الشعبيون، الذين تحققت تحت قيادتهم إنجازات مبهرة، لم يكونوا في ظرف يقيمون فيه للكلمة أي اعتبار قيمي أو وجداني، وكذلك كانت حشود الثائرين. وبعد انزياح الشعور الثوري إلى الإيديولوجيا الدينية والمذهبية في أوج القوة والإنجاز، مارست سلطة الأمر الواقع قيوداً غليظة على الكتّاب والفنانين من حيث المحلّل والمحرّم، فبالإضافة لطرحها، متأثرة بالماضي القريب، لأفكار تتناقض مع لغة الفن والشعر الجانحة للسمو والإطلاق مثل الطائفية والمناطقية والعشائرية، عممت نظرةً إنكاريةً للكتّاب والفنانين والمفكرين، وهذا لا يبتعد كثيراً، من زاوية الإقصاء، عن ممارسات بعض الكُتل والأحزاب والمجلات الإلكترونية الناشئة داخل سورية وخارجها، من حيث اهتمامها بالكتّاب انطلاقاً من انتمائهم الحزبي أو اعتماداً على المعرفة الشخصية أو القربى.
كذلك كان للحصار المفروض على كثير من المناطق بعد فترة وجيزة أثره الكبير في تراجع كم وسوية المنجز الفني والأدبي، بما يغتصب الوقت بتأمين مستلزمات الحياة اليومية «ماء – طعام – دواء»، وانقطاع الكهرباء الذي حرم أصحاب الثقافة المستعارة من الخل الوفي، السيد غوغل. ولعل من أهم أسباب تراجع كم وسوية المنتج الأدبي، هو مطالبة الصحف والمواقع الإلكترونية للكتّاب بمقالة أو توصيف مجرد عن الحرب والحصار، وما كان من الكتّاب إلا أن يستجيبوا أمام الحاجة الملحة لقوت الحصار والحرب، وهو المال. ومما عاناه الشعراء أيضاً تعرّضُ كثيرٍ منهم للاعتقال والتعذيب، وصحيحٌ أن الغالبية منهم اعتقلت على يد قوات النظام، ولكن لا يمكن تجاهل من اعتقلتهم وقتلتهم داعش، وكذلك الذين اعتقلوا وعذّبوا، ومنهم من غُيّب، لدى التشكيلات الإسلامية وبشكل أقل لدى التشكيلات العسكرية الثورية، ويبقى تغييب الشاعر ناظم الحمادي وأصدقائه مثالاً مستمراً.
مجمل هذه الظروف وَسمَت قصائد هؤلاء الشعراء القليلة، إن لم تكن نادرة، بإحساس الغربة عن واقعهم المعاش، وبملامح الشكّ بالهوية. نشرَ كاتب هذا البحث عبد الله الحريري، المحاصر في جنوب دمشق، على صفحته الشخصية في فيسبوك:
أيّها العاري…
كجذعِ النخلِ في الصحراءْ
لا جارةٌ تهواك…
لا وادٍ يشي بالماءْ
لا أصدقاءْ
إلّاكَ، والذئب الذي…
… ودماءْ
ومن صفات قصائدهم محاولة استرجاع الذاكرة القريبة قبل الاعتقال عجزاً في احتمال ذاكرة الصدمة، وبرز ذلك في القصائد الخارجة من المعتقلات، ففي قصيدةٍ مهرّبة من المعتقل آنذاك لوائل سعد الدين الذي أمضى في معتقلات النظام السوري قرابة ثلاث سنوات:
وهناكَ بعدَ الجسرِ
قرب المتحفِ الوطنيَّ تحديداً
وعلى رصيفِ اليانصيبِ
وباعةِ الكتبِ القديمةِ
كنتُ أنظر في وجوهِ الناسِ
أُمعِنُ في ملامحهم
أعدُّ همومهم
وحضورهم
لأقول ما يرتجُّ في صدري
وأكتبُ ما يرددُ شاعر
ونقيضهُ
كم سرتُ تيّاهاً بذاكَ الشارعِ…
المرصوفِ بالأحجارِ
أبحثُ في العناوينِ الكثيرةِ
عن يقينٍ واضحٍ
سورُ التكيّةِ لا يسوِّرُ نصف قلبي
والطريقُ إلى الحجازِ
يلفه الإيقاعُ من جهتينِ قانيتينِ
أمشي مطمئناً
أن شيئاً ما سيرقصُ
في زوايا القلبِ…
تأخذني دمشقُ
فأحتفي بخيالِ إمرأةٍ رمتني بالخطايا
جينَ خبَّأتُ المدينةَ بين كنزتها
وضكّةِ صدرِها العالي
لتأتي مرحلة جديدة وهي مرحلة التراجع الثوري الفاضح، فقد تدخل حلفاء النظام ورجحت الكفة لصالحه بالفعل، وتراجع الحس الثوري أمام سفور التبعية للقرار الدولي من القوى الثورية، ثم الاقتتال الثوري-الثوري الذي قصم ظهر البعير. وكعادتهما، الفن والأدب، صديقا الشدائد، فانفتحت القرائح على الكتابة. كتبَ أوس المبارك، المحاصر في الغوطة الشرقية، في مقاله «حصار الكتابة: سؤال الجدوى والمعنى» المنشور في موقع الجمهورية:
قد تصبح الكتابة فعل المقاومة الأخير لئلا تموت بصمت، لأن تحفر وجودك رغماً عن كل قاتليك، وقد تضيء الكتابة شيئاً حول فهم الإنسان، فلا يوجد أفضل منها الآن من أجل قضيتنا، إذ سورية اليوم صورة العالم الذي نعيش فيه.
وقد تساعدنا الكتابة في تفكيك كل العقد رويداً رويداً، في الفهم والإحاطة بعد عمل دؤوب على تناول المعطيات وتحليلها ومقاربة أسبابها وإمكانيات التأثير والجذب نحو مركز العدل، وكيف نعمل لدفع اليائسين من أجل استعادة أحلامهم وآمالهم الكريمة، عبر إخراجهم من حالة العجز وعدم الفهم إلى عمل محدد من أجل خرق ثقوب أكثر في الملاءة التي رفعت أمام وجوههم، فحين تكثر الثقوب لن تعود للملاءة وظيفتها وستسقط.
وهذا الأمر بدأ لتوه، تقتضي الحكمة عدم الإسراف في تفصيله، فهو يحتاج لفسحة زمنية تتيح للشاعر استدراك ذاكرته المستعصية واسترجاعها ليصوغها كموقف عام عبر قصيدة ذاتية الطبع والطباع، وأستشهد بما كتبه محمد المطرود:
ربّما يلزمنا كنقاد وشعراء سنين من العمل على موضوعية ظاهرة الكتابة أثناء الحرب، ببساطة لا يمكن أن تكتب عن الظاهرة وما زالت السيرورة مستمرة، لا يمكن الإحاطة بها وما زالت جميع شروط تَكونُها موجودة وضاغطة لا يمكن أن تكتبَ عن برميل متفجر، يتلوّى في السماء وكلُّ الخوف يسكنك، أين سيسقط وكم من الأرواح سيحصد؟!… جريان الموت بهذا الشكل الاعتباطي، لن يجعلَ البحث في الظاهرة سليماً ومعافى ومتخلّصاً من ردةِ الفعل، والكم الهائل بغثّه وسمينه سيقرأ كظاهرة ربّما سترتقي لمستوى تشكيل النسق، لكن مهما كان من أمرِ ما يحدث فثمةَ نصوص مميزة قفزت بأصحابها من زاوية المغمور إلى زاوية المشهور، يقابلها نصوص أودَت بآخرين، كُرسوا وتمَّ التنظير لهم على أنهم منجزين، ومنجزهم فوق النقد، في حين يبدو أنَّ الثورات كما هي تغير العادات فهي تكشفُ العاهات أيضاً!
ومن الشعراء من فُرضت عليهم الهجرة بسبب الاعتقال المتكرر والملاحقة الأمنية، وقد امتازوا بالظهور وتعدد الدواوين الصادرة عنهم، والاهتمام عندهم بترجمة النص إلى لغة أجنبية كان أكثر بكثير من الاهتمام بإيصاله للقراء العرب والسوريين، ومن اتخذ منهم الثورة والحرب والحصار مادة للكتابة فقد امتاز بالكلام البعيد وكأنه رجع الفكرة وليس الفكرة ذاتها، وكأن مأساة الداخل السوري عصا شاعر الشتات التي يهشّ بها على غُربته، وتبقى قصائد شعراء الشتات عنها محاولات تتكئ مجبرة على الثقافة الملحمية المتوارثة، فقد ورد نص لعمر سليمان في دراسة سيرياذا؛ والعنوان نحتٌ من الإلياذة، التي أعدها عماد الدين موسى ونشرها موقع العربي الجديد، حول الشعر السوري في الشتات، يحاول فيه عمر أن يصوّر مشهداً ربما عاش جزءً منه، ولكنه يوحي لمركب جمعي الصور:
هذه قريتي
إنما أين الحجارة المغسولة بالدخان؟
وأين رائحة البارود القريبة؟
أين أخي وقد كنا واقفين على الشرفة بانتظار الذبح؟
أين أصابع الأطفال الممزقة؟
وكتب عيسى الشيخ حسن في سيرياذا أيضاً:
يتّهمون القصيدة بسرعة التأثر، ونقل الحدث في مسارب الانفعال، ولكن التراجيديا السوريّة اليوم أكبر من أن تعبر عنها نصوصنا القصيرة، وعندما تتوقف الحرب، وتعود سوريّة جديدةً متعافية واحدة (ما أتمناه)، سنحتاج إلى نصوص ملحميّة طويلة ينام في ظلّها الناجون والغرقى، ستكون هناك تراجيديّات على أيّ حال، نحن الآن نبشّر بتلك القصيدة، التي تتخمّر في كلّ زهرة دم تقطف على مرأى العالم.
كانت القصيدة في حاجة إلى ربيعٍ أيضًأ، وكانت فرصةً لنفض سجّادة الكلام.
وعلى ما يبدو أن للفوارق الحضارية والعمرانية، وللعناوين الجديدة، وقعها في نفوس شعراء الشتات، فكثيراً ما نجد «مترو الأنفاق» في قصائدهم، وكذلك أسماء المدن وأسماء الشوارع والمدلولات الزمنية كالتواريخ. لا أعرف ما هو وجه الشبه بين هذه الظاهرة وبين شعراء الستينات والسبعينات من القرن الماضي، عندما كانوا يوقعون قصائدهم بأسماء المدن الأوروبية ويضعون التاريخ تحتها. إذا قلنا إنه أحد علامات اللاانتماء، فهل كان شعراء القرن الماضي، في مرحلة الذروة الأدبية، لا منتمين!؟ لا يبدو هذا التعليل دقيقاً. وقد يكون ما سبق جليّاً في قصائد غياث المدهون، رغم سرعته عن البقية في رسم ملامح خاصة في قصائده.
ويتباين الكتّاب الشباب أنفسهم في تقييمهم لأثر الهجرة والشتات في القصيدة، ما بين ناظر من زاوية ذاتية، وبين جانح إلى مواكبة الحدث السوري العام بكل تفاصيله، وفي مثال عن الرأي الأول ما كتبه عمر سليمان في سيرياذا:
إذاً لا دور مباشراً للكلمات في التقليل من هذا الحطام، لا دور للحبر وقد طغت لغة الدم، إنما نكتب في الشتات لكي نكون، ومن جانب آخر، فإن هذا الشتات أغنى تجربتي الشعرية، خصوصاً بعد أن تعلمت لغة جديدة واختلطت بكتاب وشعراء هنا في فرنسا، حيث أقيم.
هذا طور قصيدتي، لذلك فإن الشتات برأيي ليس سيئا دائماً.
وعن الرأي الثاني ما كتبه فادي سعد في سيرياذا نفسها أيضاً:
بقيت القصيدة السورية في الشتات ذاتية، شخصية؛ وهذا ليس بالضرورة حكماً سلبياً في زمن آخر، لكن في الزمن السوري هذا، تبدو هذه المقاربة في الكتابة الشعرية، وبرأيي الشخصي، أنانية وصغيرة في أغلب الأحيان.
كان يمكن للشعر (السوري) أن يلتقط اللحظة ويعبّر عنها إذا كسر بعض قوالبه، فلا قَدَرَ في أساليب الشعر، مثلاً، القصيدة الملحمية (تاريخ الشعر بدأ ملحمياً) كان يمكن أن تكون أكثر مواكبة لروح وتاريخية الحدث السوري، لكن القصيدة السورية بقيت صرخة شخصية لشعراء غنائيين منفيين.
***
في القصيدة الجديدة لدى الشعراء الشباب نرى صورة شعرية غير تامة؛ طيف تصوري، وكأن الشاعر يرمي لطرح حالة نفسية عوضاً عن الصورة الشعرية ولكنها لا تصل كاملة للقارئ، وربما تكون هذه الصفة ملاصقة لقصيدة النثر منذ ثمانينات القرن الماضي، ولكنها لم تنجح في طرح حالة نفسية متنامية عبر الزمن والشعراء، أعني أن القصيدة إذا كانت تبوح عن مكنونات ذاتية مأزومة نفسياً، فينبغي أن تصل هذه الحالة لذروتها ثم تبدأ بالاستواء تدريجياً مع الزمن عبر القصائد المتسلسلة للشعراء المتعاقبين. أمام هذه الحالة يمكن الحديث عن شيء من ضياع الهوية، يقول رائد وحش:
كيف يكون لنا ما للغيوم
تذهب دون أن تدري معنى لـ «أين»؟!
كيف يكون لنا ما للجبال
تبقى دون أن تفكر بفلسفة لـ «هنا»؟
يُقال إن تاريخ الدول يكتبه المنتصرون، أما الإنسان والشعوب فيكتب تاريخهما الشعراء والفنانون، والمقلق ما يتفلَّتُ من الذاكرة عند كل الشعراء السوريين الشباب؛ هذا ما يسمونه في علم النفس «ذاكرة الصدمة»، عندما يدافع الإنسان عن نفسه بالنسيان، ونحن لا نقول إن الحدث الدامي يُنسى، ولكن يلتهمه اللاشعور، فيستحيل استرجاع أثره الأليم في الذاكرة. كتبت نادين باخص:
لم أكن أتخيل
أن الذاكرة يمكن أن تموت أيضاً
من شدة التعذيب
ولا تجد لها قبراً
فقط تغور تحت الأنقاض
إن الأنقاض التي تتحدث عنها نادين هي «اللاشعور» وليست أنقاض المدن، هل اللاشعور والخراب مكانٌ واحدٌ للموت؟ إذا كان كذلك، فينبغي ألّا تستسلم عقول الشعراء والفنانين المبدعة، وعليها أن تنبش آبار الذاكرة دوماً، فإن للأجيال حصة من مأساتنا، وكما أسلفنا في مقدمة البحث، إن الحرب تأكل الذاتي في العام، وستبقى كتابةُ شعر الأسطورة السورية الحقيقية، المهمةَ الملقاةَ على عاتق الشعراء الذين عاشوا تجاربهم الشخصية في الثورة والحرب والحصار والاعتقال والتهجير والاغتراب.
وربما كانت هناك ظروف مبررة لتراجع الحالة التفاعلية بين الشاعر والجمهور، وبين الشعراء أنفسهم، ولا شك أن غياب الأندية والمجلات الأدبية سبب وجيه يحد من هذا التفاعل، ولكن لم يكن هناك ميل لدى الشعراء لاستغلال وسائل التواصل الاجتماعي للتعويض عن ذلك، طبعاً لا يمكن إنكار ازدياد مستوى التعارف والتواصل عبر هذه الوسائل، لكنه لم يرقَ إلى مستوى إيجاد أندية أدبية فعلية، إنما مجرد صفحات تظهر في فترة محددة ثم تتراجع، ولا يعيرها أحد من النقاد الاهتمام، والأمر بالنسبة لي يبدو مثل الجهود المشتتة، إذ أن ما يمر به الشعراء من تجارب خاصة لا بد سيفضي لحداثة في شكل ومضمون القصيدة، وفي حال بقيت هذه الحداثة حالات خاصة غير متصلة بصفات عامة وغير خاضعة لعدسة الناقد، فستنكفئ أدراجها وستبقى مجرد نزوات إبداعية تتميز عند الشاعر فلان ولا تنجح عند الشاعر فلان، ولن ننجح بوضع صفات وملامح خاصة بها، وسنسقط تماماً كما تسقط المرحلة.