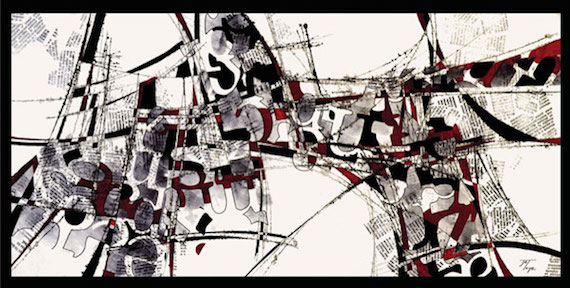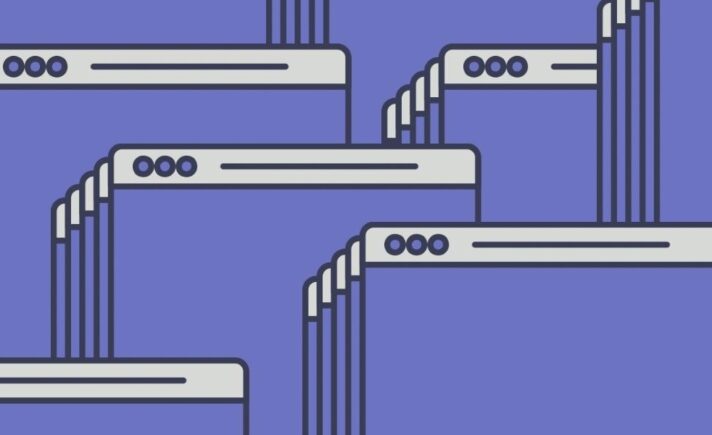في خمسينات القرن الماضي، استخدم روبرت كابا، المصوّر الفوتوغرافي الهنغاري الشهير، مصطلح «الجيل أكس» (Generation X) في مجموعة من مشاريعه الفوتوغرافية التي تُصوّر حياة الشباب واليافعين الذين ترعرعوا في سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية. أُعيد استخدام التسمية عدّة مرات خلال العقود الثلاثة اللاحقة في نصوص النقد الثقافي والاجتماعي الراصدة لتبدّل سلوكيات وأهواء وطباع الشباب مع تغيّر الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الغرب، ومع صعود وانكسار السرديات والإيديولوجيات الكبرى، لكن الاستخدام الأكثف للتسمية، والأكثر عمقاً في محاولة تعريفها، حصل في الثمانينات والسنوات الأولى من التسعينات، وإن دون الوصول إلى تعريف مُوحّد وحاسم. اصطُلح في النهاية -ضمن تعريفٍ فضفاض- على أن «الجيل أكس» هو ذاك الذي يجمع من وُلد بين بداية السبعينات والسنوات الأولى من الثمانينات، أي الجيل الذي كان مُراهقاً أو في مقتبل شبابه مع انهيار الكتلة الشرقية، واكتساح النماذج الاستهلاكيّة الأميركية المُوحّدِة (ممثلة بقناة MTV)، وبداية انتشار التقنيات الرقمية وتغلغلها في الحياة الاعتيادية للطبقات الوسطى في أوروبا والولايات المتّحدة.
بعدها، ظهر مصطلح «الجيل واي» (Generation Y) للإشارة إلى مواليد منتصف الثمانينات وما بعد. يُشار إلى هذا الجيل أحياناً باسم «الميلينيالز» (الألفيين)، ويُشار إلى هذا الجيل بكونه أول جيل «رقمي بالولادة»، أي أنه كبر والتكنولوجيا الرقمية جزء طبيعي من حياته، من التلفزيون عبر الأقمار الصناعية وشيوع تقنيات الفيديو (ثم الدي في دي)، وتطوّر ألعاب الفيديو بدءاً من «أتاري» البدائية وصولاً إلى الإصدارات المتتالية من بلاي ستيشن، ثم انتشار وتطوّر الانترنت الكبير منذ الصيغة الأولية للتصفّح وصولاً إلى شبكات التواصل الاجتماعي اليوم. الذين هم أكبر من هذا الجيل يُعتبرون «مهاجرين رقميين»، أي أن ظهور وانتشار التكنولوجيا الرقمية على صعيد الحياة اليومية شكّل تحدياً لنمط حياتهم الذي اعتادوا عليه في يفاعتهم وشبابهم، واضطروا -بدرجات مختلفة من النجاح- لـ «التأقلم» مع هذا الوجود.
هناك الكثير من النصوص والكتب والدراسات في تشريح وتفكيك ونقد هذه التقسيمات الجيلية، أكثرها -بطبيعة الحال- صادرة في بلدان غربية، وتدرس ظواهر المركز الغربي. هناك الكثير من التداخل بين الأجيال، أو تغيّرات في سنوات البدء، عند محاولة إيجاد متوازيات ضمن دول العالم الثالث، أكان لأسباب اقتصادية بحتة، أو أيضاً بسبب مقاومة أنظمة حاكمة كثيرة لانتشار التكنولوجيا الرقمية بحيث أعاقت انتشارها إلى حين. لكن إحدى نتائج العولمة الأهم أنها، رغم كل الفجوات الاقتصادية بين القارات والبلدان، قد حوّلت العالم إلى رقمي، مع كل تبعات هذا التحوّل من تغيّرات في أنماط الثقافة والاستهلاك.
ولدتُ عام 1984، أي في العام الذي تعتبر النصوص الاجتماعية-الثقافية الأكثر شيوعاً أنه أحد أعوام الحدّ بين «الجيل أكس» والألفيين في الغرب، وعشت طفولتي ومُراهقتي في سوريا، حيث لم نكن بمعزلٍ كامل عن تطوّرات العالم الرقمي، وإن كنا متأخرين خطواتٍ عديدة في بعض المجالات، وشبه معزولين في مراحل معيّنة عن مجالات أخرى. لذلك، عشت وأقراني خليطاً من سمات الجيلين المذكورين أعلاه: كانت ألعاب الفيديو جزءاً من طفولتنا، وكنا نحضر أفلاماً ومسلسلات مُسجّلة، ثم صرنا نتابع التلفزيون عبر الأقمار الصناعية وتحرّرنا من هيمنة التلفزيون المحلّي. بدأتُ باستخدام الكمبيوتر مبكراً، لكنني أتذكر بوضوح اللحظة التي كان فيها الويندوز نقلة تقنيّة هائلة، أو الأيام التي لم يكن فيها وجود كمبيوتر في المنزل دون اتصال بالانترنت شيئاً غريباً. عاش جيلنا (بالمعنى الأصغر للكلمة) كل تحوّلات الحياة الرقمية من أول إصدارات شركة سيغا، وحتى نتفلكس اليوم. وعلى مستوى الانترنت، عشنا الانتقال من الانترنت الأول، الذي كان فيه المُستخدم العادي مجرّد متلقٍ أو متصفّح، إلى الانترنت 2.0 مع بداية القرن، حيث أصبح بإمكان المستخدم إنشاء المحتوى أو التأثير في المحتوى المنشور (عبر التعليقات، أو ضمن المنتديات، أو إنشاء صفحات شخصية في مواقع شبكية، أو مدوّنات)، وحتى عالم وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، والتي تطغى على نسبة مئوية عالية جداً من الاستخدام اليومي للانترنت عبر العالم. أما بما يخص الموبايلات فلم أقتنِ جهازاً حتى عام 2003، وكنت في سنتي الجامعية الأولى، ولم أنتقل من الموبايل العادي إلى السمارت فون حتى أواخر عام 2010.
نبدو، نحن مواليد النصف الأول من الثمانينات، وكأننا «السن المحيّر» الذي يُشار إليه في دعايات متاجر الألبسة. كبرنا وبداياتُ التكنولوجيا الرقمية منتشرة بشكل كبير، لكننا عشنا تحوّلات جذرية وسريعة جداً فيها، لاحقناها بسهولة أكبر من أجيال «المتأقلمين»، وإن دون مرونة وسرعة من هُم أصغر منّا ويحملون هواتفاً ذكيّة وهم بالكاد مراهقون اليوم. نتذكّر بسهولة غياب ما يُعتبر اليوم أساسياً وبديهياً، وأكاد أجزم أن أياً منا، حين يدخل في حالة ضغط نفسي شديد لأن بطارية هاتفه قد نفذت، يتساءل كيف كنا نعيش دون موبايلات، أو نتذكّر بحنين أطلال الزمان الذي كانت فيه بطارية الموبايل العادي تدوم عدّة أيام. نبدو وكأننا أبناء المهاجرين الذين وصلوا إلى بلدٍ جديد وهم أطفال: لا هم أبناء هذا البلد الجديد تماماً، ولكنهم في الوقت ذاته ليسوا غريبين عنه بالكامل.
لقد كان لهذه التحوّلات العميقة أثرها كذلك فيمن كان مهتمّاً بالشأن العام، ومُتابعاً للأحداث السياسية والاجتماعية، ويُحاول أن يكون فاعلاً في النقاش فيها، أو في التأثير في مجرياتها. هذا النص هو سرد خبرة شخصية في التعاطي مع الشأن العام السوري عبر الانترنت. هي قصّة متأثرة بظروف وتحوّلات ذاتية بقدر ارتباطها بتحوّلات التقنيات، وأيضاً بقدر تأثرها بتحوّلات السياق العام السوري والعربي، لذلك، قد تتشابه مع خبراتٍ كثيرة، دون أن يعني ذلك أنها تشكّل نموذجاً بالضرورة. لقد شكّل الانترنت انفتاحاً كبيراً في التعاطي مع المجال العام بجميع قطاعاته ومستوياته، وتضاعُفُ احتمالات وإمكانيات تشكّل الخبرات الشخصية المختلفة هو أحد أهم أوجه هذا الانفتاح، وهذا الانقلاب الكبير، بالذات، هو ما يحاول النص الإشارة إلى أهميته.
الشأن العام عبر شاشة
بدأت علاقتي بالسياسة مع نهاية المرحلة الإعدادية وبداية الثانوية، أي قبل وفاة حافظ الأسد عام 2000 بعام أو عامين. وقد تم ذلك بتأثير من والدي، الذي لم يكن منتظماً في حزب أو مجموعة، ولم يُمارس السياسة، لكنه كان مهتمّاً ومُتابعاً، وكانت له أهواء يسارية إلى حدّ ما، وإن ذات انشغال كبير بالمسألة الديموقراطية بتأثير من أدبيات ياسين الحافظ، وأيضاً بما عايشه خلال اغترابه في اسبانيا في فترة وفاة فرانكو والتحوّل الديموقراطي ومُراجعات الأحزاب اليسارية لأدبياتها. في تلك الفترة قرأتُ كتاباً لياسين الحافظ، وبالكاد فهمت منه شيئاً. عدا تأثري بوالدي، تأثرت (بل بالأحرى انبهرت) بمجموعة أصدقائه، وقد كان منهم حزبيون قضى بعضهم سنيناً طويلة في السجن، وقد كنت سعيداً بدورٍ مفيد لي ضمن المجموعة هو أنني كنت أسهّل لهم استخدام الإيميل، وكان حينها قد بدأ ينتشر، وكان وسيلة توزيع منشورات وبيانات وأخبار صادرة عن أحزاب كالحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي أو التجمع الوطني الديموقراطي، أو جمعيات حقوق الإنسان. أذكر أنني قرأت معهم بيان الـ 99 في إيميل مُحوّل عشرات المرات قبل أن يصلنا، وعلى كمبيوتر منزلنا (بنتيوم 3) شاهدنا فيلم ابن العم في ربيع 2002، وكان قد وصل إلى الرقة في اسطوانة سي دي، وتناقله المهتمّون بسرّية وحذر وكأنه رزمة كوكائين. لم يكن هناك يوتيوب آنذاك.
تركتُ الرقة متوجهاً إلى اسبانيا في صيف 2002. كانت الانتفاضة الفلسطينية الثانية في أوجها، وكان ربيع دمشق قد وُئِد، وأُدخِلَ العديد من المشاركين فيه إلى السجن، لكن كان ما يزال هناك بعض الإحساس (المتأمّل) في أن هناك تغيّراتٍ ما لا بد وأن تحصل. وفي اسبانيا، وجدتُ في الانترنت حلاّ رائعاً للمسافة: لم أعد في البلد، لم أعد في المنطقة، لكنني أريد أن أتابع، وأريد أن أناقش. للمفارقة، اكتشفت لاحقاً، نتيجة التقنية الأفضل وبسبب الفلات من حجب المواقع، أن متابعتي من اسبانيا كانت أوسع وأفضل من متابعة من كان يعيش في الرقة.
كتبتُ أول مقالٍ لي بالعربية عام 2003، وأرسلته باسمي الصريح إلى موقع «الرأي». لسوء الحظ فُقد جزء كبير من أرشيف الموقع على ما يبدو، وإن أتى هذا التلف -هنا فقط- لحسن حظّي، إذ كانت مقالة سطحيّة للغاية عن أزمة «الشباب» الذين لا يجدون مساحات للنقاش والعمل ضمن الشأن العام. في تلك الفترة، لم تكن تقنية المدوّنات قد تطوّرت بعد باتجاه تسهيل إنشاء مدوّنة لمن لا يمتلك خبرات تقنية عالية. كانت هناك بضعة مواقع تتيح إنشاء «صفحات فرعية» شخصية. لكنني لم أكن حينها قد قررتُ أن تكون المقالة أو النص الطويل المُرسل إلى موقع أسلوباً في المساهمة في النقاش، بل كنت أبحث عمّا هو أبسط، وما هو أكثر مباشرة، وما هو «أسرع». وهنا كانت المنتديات.
حسناً، هنا يجب أن نتوقف قليلاً كي أطلب من الجيل الأصغر منّي ألا ينفجر ضاحكاً. ما بقي من ذاكرة المنتديات اليوم هو كليشيه المواضيع المُعلّبة، والردود الجاهزة من طراز «شكراً لمرورك العطِر». لكنّ جزءاً جوهرياً من نشاطنا السياسي والثقافي، ونقاشاتنا العامة (وأتحدّث هنا عن عدد كبير جداً من أبناء جيلي) تمّ عبر المنتديات. كان هناك العديد من المنتديات السورية الشهيرة، لعلّ أكبرها كان «شبابلك». لكنني، في أواخر عام 2003 انضممت لمنتدى آخر، أصغر بكثير، وكان يبدو «محلّياً» للغاية آنذاك، وهو منتدى أخوية.
نشأ منتدى أخوية كمبادرة الكترونية لمجموعة من الأصدقاء الحماصنة، وقد جمعهم الانتماء لإحدى الأخويات المسيحية، لكنه لم يكن منتدىً دينياً، بل كان الجانب الديني يشغل مساحة صغيرة جداً. كانت الاهتمامات فيه متنوّعة، من الحوار العام حول المواضيع الاجتماعية والثقافية الدارجة، ونقاشات الكتب والروايات، وتطوّرات تقنيات الهاتف وبرمجيات الكمبيوتر، وحتى متابعة الأخبار. وصلتُ إلى المنتدى بالصدفة عن طريق غوغل. ولفت نظري آنذاك أن قسم «منبر أخوية الحُر» لا رقابة عليه بقرارٍ شجاع للغاية من القائمين عليه. وقد كنت من أوائل أعضاء المنتدى من خارج الوسط الاجتماعي للمؤسسين. قد يبدو الأمر بسيطاً واعتيادياً للغاية اليوم، لكن إمكانية كتابة شيء من على بعد آلاف الكيلومترات وأن يرد عليك الآخرون بعد دقائق كان أمراً باعثاً للإحساس الدافئ بالقرب.
واظبتُ على المشاركة في المنتدى اعتباراً من ربيع وصيف 2004، وخلال أشهر بسيطة نمى المنتدى بسرعة، خصوصاً ضمن أوساط المهتمّين بالشأن السياسي، الذين كانوا يصلون إليه في غالب الأحيان عبر البحث في غوغل عن مواضيع وكلمات مفتاحية سياسية، وأيضاً في أوساط المهتمين بالثقافة والكتب، إذ احتوى المنتدى، بمبادرة وجهد كبيرين من مرسيل شحوارو -والتي ابتُليت بصداقتها منذ تلك الفترة- على عدد هائل من الكتب الالكترونية. كنتُ أحد أولئك الذين أُطلق عليهم لقب «المنبرجيّة»، أي المواظبين على قسم «منبر أخوية الحُر»، حيث كنا نناقش كثيراً، نتفلسف كثيراً، ونتشاجر كثيراً، كالفيسبوك اليوم، وإن بنطاقٍ أصغر وحميمية أكبر. لم نكن كلّنا معارضين، ولم يكن المعارضون متشابهين فيما بينهم. كان هناك تنوّع كبير في الآراء والمواقف، وأيضاً في المنابت الاجتماعية الطبقية والدينية والمناطقية. لكن كان يجمع أغلب «المنبرجيّة» حسّ مشاغب، وطليعي في خراقته إلى حد كبير، ورغبة كبيرة في كسر المحظورات، ونشر ما يُحاوَل منعه أو حجبه لمجرّد أنه ممنوع أو محجوب (كان كريم عربجي، وقد كان من ضمن مجموعة المشرفين التي كنت لفترات عديدة جزءاً منها، شرساً في دفاعه عن هذا الموقف). كان هذا المنتدى، على سبيل المثال، أحد المواقع العربية القليلة التي قررت عدم منع نشر الكاريكاتيرات الشهيرة التي ظهرت عام 2006 وشغلت العالم وأشعلت المظاهرات والاحتجاجات. وبسبب نشر الكاريكاتيرات تلقّى المنتدى هجمة قرصنة أخرجته عن الخدمة أشهراً طويلة. بعدها بفترة قصيرة، حُجب الموقع في سوريا.
لم تكن الجرأة في طرح المواضيع السياسية السورية المختلف الوحيد في هذا المنتدى، بل كان هناك دوماً جرعة إضافية من الجرأة في مقاربة كافة المواضيع، بما في ذلك -بطبيعة الحال- المحظورات الدينية. كان منتدى أخوية ملاذاً للمشاغبين قلّ مثيله، ولم يوفّر فقط مساحة حرّية للنشر والتفاعل، بل إنه أيضاً كان -إلى حد كبير- مساحة أمان لتقبّل ما ليس مألوفاً، ومُجتمعاً افتراضياً موازياً دامت حلقاته الاجتماعية إلى ما بعد إغلاق المنتدى.
في أخوية تعرّفتُ وصادقتُ حسام ملحم ودياب سرّية وطارق غوراني، ثم الراحل كريم عربجي. وفي أخوية تعارف جزء من المجموعة التي قررت تنظيم نفسها في تجمّع شبابي باسم «شمس» (شباب من سوريا)، وتم اعتقالهم لهذا السبب مطلع عام 2006. الأصدقاء الثلاثة الأوائل كانوا جزءاً من هذا التجمع، وتلقوا احكاماً تراوحت بين خمس وسبع سنوات، ليعيشوا بعدها تجربة سجن صيدنايا الرهيبة.
في صيف عام 2007 اعتُقل كريم عربجي، وحُكم بالسجن سنتين ونصف بتهمة «نشر أخبار كاذبة». خرج كريم من السجن عام 2009، وتوفّي أوائل آذار عام 2011، وشُيّع في جنازة مهيبة في دمشق حضرها عدد كبير من أعضاء المنتدى، والكثير من الناشطين السياسيين والحقوقيين (في هذا المقطع، تظهر رزان زيتونة بشكل خاطف في الدقيقة 3:35). كان منتدى أخوية قد أُغلق قبلها بأكثر من عام، وتُرك متاحاً للتصفّح فقط. لكننا نحن «المنبرجيّة» القُدامى تراسلنا وقررنا نشر نعي كريم عربجي، وكتابة بيان تحيّة لروح كبير «المنبرجية». كُلِّفتُ بكتابة هذا البيان، وكان أصعب نصّ كتبته حتى الآن.
في التدوين
أنشأتُ مدونتي باللغة العربية نهاية عام 2006. كانت منصات التدوين قد تطوّرت وانتشرت، وكانت منصة بلوغ سبوت التابعة لغوغل قد أتاحت إنشاء مدونات باللغة العربية قبلها بعدّة أشهر فقط. لم أبدأ وحدي رحلة التدوين من بيئة أخوية، فقد أسست مرسيل شحوارو حينها مدونة «لمحات»، وشيرين الحايك مدونتها «طباشير». كان هناك مجتمع تدويني سوري ذو ملامح واضحة، وإن كان صغيراً، ومقسوماً بشكل أساسي بين المُدونين بالعربية والمدونين بالإنكليزية، مع وجود مدوّنين باللغتين مثل رزان غزاوي أو أنس قطيش أو يزن بدران.
لتجربة التدوين، بالتعريف، طابع ذاتي وانفرادي. ليست عملاً عاماً، بل كان كلٌّ منا محرراً وناشراً لمدونته الشخصية. لكن كانت هناك شبكة قويّة من المدونين -على صغر عددهم مقارنةً بمصر أو تونس- وساعد وجود مواقع تجميع عناوين تدوينات (Aggregators) مثل «كوكب سوريا» أو شبكة «المدوّن- مجتمع المدوّنات السورية» على أن نتعارف ونتابع بعضنا البعض. في الواقع، لم يكن الطابع العام للمدونين السوريين سياسياً بشكل مباشر، ولم تكن السياسة الشأن الأكثر تداولاً. بعضنا كان مُسيّساً ومباشراً في خطابه، وبعضنا الآخر كان يُقارب الموضوع بطرق أقل صدامية، أو يتجنّب خوض السياسة المباشرة ويفضّل مواضيعاً اجتماعية أو ثقافية أو أدبية، أو الشؤون التقنية والعلمية. لم نكن «مناضلين» بالتعريف، لكن كان في التجربة جرعة نضالية عالية، وهذا ما سأعود إليه لاحقاً.
كان هناك الكثير من المدوِّنات الإناث، وبعضهنّ حققن مكانة رفيعة وشاركن بفعالية كبيرة في تحريك نقاشات مهمة في السياسة والاجتماع، وشاركن في تنظيم حملات. لكن التدوين السوري، عموماً، فشل في الإفلات من إحدى الآفات الكبرى في الساحة الثقافية السورية، آفة لا تقتصر عليها بين الساحات الثقافية العربية بكل الأحوال: الذكوريّة. كان هناك ضربٌ من «تقسيم العمل» الذي يبدو بديهياً بشكل مؤسف، وهو افتراض أن الإناث يكتبن الخواطر، أو يتحدّثن عن مشاعرهن، أو يُشاركن في الشأن العام فقط في قضايا «نسائية»، فيما باقي القضايا للذكور. وكان الدفع إلى هذا الاتجاه واضحاً في تعليقات القرّاء (والقارئات) على التدوينات المنشورة في مدوّنات الإناث، وحصل في أكثر من مرة أن تحوّل الموضوع إلى شجار بين مدوّنين. لقد كان التدوين ساحة مناسبة ومرشّحة لكسر هذا العُرف، ولتكوين نوع من مساحة الأمان والدعم لمن يرغبن في تجاوز «تقسيم العمل» هذا، لكن العمل في هذا الاتجاه لم يرتَقِ للمستوى المطلوب.
لا يتّسع المجال هنا لتقديم شرحٍ وافٍ عن مُجريات ساحة التدوين السوري خلال سنوات ما قبل الثورة. ستُظلم مواضيع كثيرة، وستُغيّب أسماء كثيرة سهواً. لكن بعض المحطات المهمة تحتاج ولو لإشارة. أحدها هو التعاطي مع العدوان الإسرائيلي على غزّة عام 2008، وأيضاً الحملة التي أطلقها مدونون سوريون لمناهضة القوانين التي تخفف العقوبات بحق مرتكبي جرائم الشرف في العام نفسه.
عدا شبكتنا السوريّة، وفّرَ التدوين لكثيرين منّا شبكة علاقات عربية، لا سيما في الأردن ومصر ولبنان وفلسطين. كنا نعتمد في ذلك على مواقع التجميع، وعلى شبكات متابعة وترجمة مثل «أصوات عالمية»، وعلى لقاءاتٍ كانت تُنظَّم من قبل جمعيات ومؤسسات إعلامية أو معنية بالحريات الإعلامية كي نتعارف. لم تكن علاقات تحوّلَ كثيرٌ منها إلى صداقة وثيقةً فحسب، بل كانت شراكة همّ بكل ما تعنيه الكلمة، ساعدونا حين احتجناهم في حملات من أجل إطلاق سراح مدوّنين معتقلين، وساعدناهم في الشأن ذاته. بعد الأيام الأولى من الثورة المصرية، وحين حجب نظام حسني مبارك وسائل التواصل الاجتماعي وبات تناقل المعلومات ودعوات التظاهر وتحذيرات التواجد الأمني أصعب، شكّلت مجموعة من المدونين السوريين، بمبادرة من حسين غرير، خلية عمل لنسخ المعلومات والبيانات ونشرها على مدوناتنا، ثم في مدونة أُعدِّت لهذا الغرض. كانت الفكرة بسيطة: رابط غير معروف للسلطات المصرية يؤدي إلى مدوّنة جماعية فيها عدد كبير من المدونين السوريين، وبالتالي فاعلة على مدار اليوم، ننسخ ونلصق فيها باستمرار كل ما نجده من أخبار، وإن حُجِبَ هذا الرابط فإنشاء آخر مسألة تستغرق دقائق. تلقّت تلك المدونة التفاعلية عشرات آلاف الزيارات خلال ساعات، وأفادت رفاقنا المصريين إلى أن قطع النظام المصري اتصال الانترنت عن مناطق واسعة من مصر.
تجدر الإشارة أيضاً إلى موقفين من فترة الثورات العربية، حصل أولهما بعد تنحّي حُسني مبارك، وقبل اندلاع الثورة السورية بنحو ثلاثة أسابيع. تلقى بعض المدونين حينها رسالة من أكاديمي وإعلامي مُتابع للتدوين، وتربطه علاقة ودّ وصداقة مع عدد من المدونين، يسألهم عن إمكانية عقد لقاء غير رسمي، في مكان «غير رسمي» مع بثينة شعبان، المستشارة الإعلامية لبشار الأسد. وكان يبدو أن النظام، وقد سمع بوجود ظاهرة اسمها «المدونون» في السياق المصري والتونسي، قد قرر البحث عنها في سوريا و«استيعابها». حصل نقاش كثيف بين مجموعة من المدوّنين، كما استُشير بعض الثقاة من كتّاب ومثقفين وناشطين حقوقيين، وبعدها قرّرت المجموعة حضور اللقاء وقد حضّروا مجموعة طروحات ومطالب جريئة. افتعلت بثينة شعبان موقف المستمع و«المتفهّم» للمطالب، وإن اعتبرت بعض الشكوى من القبضة الأمنية «مبالغاً به»، كما قدّمت وعوداً بإصلاحات جذرية وكفّ يد الأجهزة الأمنية وغيرها. أتت دعوة ثانية بعد اندلاع الثورة بأيام، لكنها قوبلت بالتجاهل. ورغم أن بثينة شعبان كانت قد طلبت عدم نشر مجريات اللقاء إلا أن مجموعة المدونين كانوا قد قرروا نشرها لحظة اعتقال أي مدوّن، وهذا ما فعله حسين غرير بعد أيام من اعتقال المدوّن أنس معراوي، مؤسس موقع أردرويد.
الموقف الآخر حصل بعد أيام قليلة من اندلاع الثورة. فكّرت مجموعة من المدونين حينها بضرورة الخروج بنص موحّد، يُشاركه عدد كبير من الناس، ويُنشر في اللحظة نفسها. كان هناك اهتمام كبير بأن ينشره أكبر عدد ممكن من الناس في داخل البلد. جرت نقاشات كثيرة حول النص وروحه، وقد كانت النقاشات طويلة نتيجة أن الصورة لم تكن قد توضّحت بعد، وكان هناك تباين كبير في الآراء بين المتحمّس للثورة والمتخوّف منها، والداعي للانتظار والترقّب، أو حتى الخائف من التبعات الأمنية. في النهاية، تمكّنت المجموعة من إنشاء نص يمثل حلّاً وسطاً بين جميع هذه الآراء، لا يتبنى لغة صِدامية أو ثورية، لكنه يدعو لإطلاق الحريات والسماح بالتظاهر السلمي وفتح حوار وطني حول التغيير السياسي. نُشر النص بالتزامن في عشرات المدوّنات في التاسع عشر من آذار 2011، ولاقى أصداءً كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وعن التدوين
أسوةً بالكثير من زملائي، أحتفظ بذكرى جميلة عن التدوين، وأشعر بقرب حميمي مع ما أعتبره تجربة تأسيسية في الكتابة ومقاربة الشأن العام. لذلك، أجد نفسي غيوراً على التدوين، ممتعضاً من أغلب ما يُكتب عنه (وعليَّ هنا أن أتفهّم أي امتعاضٍ محتمل من مدونين آخرين من هذا النص)، ولا أجرؤ على تقديم تأريخ أو مراجعة للتجربة السورية في التدوين، وهذا النص لا يرقى لذلك بشكل متعمّد.
في الواقع، وبغض النظر عن إشكالات المُراجعة والتأريخ، أجد أن أهم ما يجب أن يُقال عن التدوين اليوم إنه يجب أن يُحرَّر من السرديات التي لبسته في فترة الربيع العربي. فخلال ثورات تونس ومصر، وبكثير من الخفّة الإعلامية الباحثة عن تفسيرات سطحية وأبطال واضحين، حُوِّلَ المدوّنون، وعموم مستخدمي الانترنت للتواصل والنشر، إلى ما يشبه الحزب الطليعي الثوري، وبالتالي حُمِّلوا ما لا طاقة لهم به، وما لم يطلبوه ولم يسعوا إليه كمجموعة. لا شك أنه كان هناك مدوّنون كثر مشاركون في الثورات، ولبعضهم مشاركات بارزة، لكن إلباس جميع المدوّنين بزّة «ناشط فوق العادة» كان مجحفاً وقاسياً، ولم يكن صحيحاً بكل حال، وظلم كثيرين.
في حديثي عن التدوين والكتابة الالكترونية في السياق السوري تطرّقتُ بشكل شبه وحيد للشأن السياسي و«المُعارضة»، وهذا نابع من اهتمامي ونشاطي الشخصيين. هناك مدوّنون ومُستخدمو انترنت كثر كانوا «مناضلين» بكل ما في الكلمة من معنى، وبعضهم قضى في السجن سنوات طويلة عقوبةً له على نضاله، ولتجربتهم ونضالهم وخسارتهم كل التقدير بطبيعة الحال، لكن اقتصار منظورنا عن التدوين وعن الكتابة والتواصل الالكترونيين على حالات النضال السياسي المباشر -خاصة في السياق السوري- يجعلنا نفقد الصورة العامة، ويغطّي جزءاً كبيراً من «ثورية» أن تكتب عن أي شيء في «سوريا الأسد»، خارج القنوات الرسمية، المرضي عنها والمُراقبة.
بعد اغتيال سمير قصير عام 2005، كتب ياسين الحاج صالح في ملحق النهار مقالاً بعنوان «الموت الضروري لسمير قصير» يقول في أحد مقاطعه:
نختزن، نحن السوريون، رصيداً هائلاً من الشعور بانعدام الأمان، غرسته في أعماقنا تجارب صادمة مديدة. نعتبر نفسنا مقياساً للا أمن (ربما ينافسنا العراقيون)، ونحسد من يحظى ولو بالقليل منه. الأشياء الخطرة التي تثير لدينا منعكس اللا أمن كثيرة جداً. الكتابة فعل أمني، الكلام فعل أمني. وكان فتح دكان حلاقة والعزاء بميت أفعالاً أمنية كما ذكّرتنا قائمة من 67 فعلاً أُعلن عن نزع الصفة الأمنية عنها أخيراً.
كانت الكتابة، أيّ كتابة، فعلاً أمنياً. لم يكن ذلك متعلقاً فقط بالكتابة السياسية. أي كتابة دون سيطرة، أو دون المرور بالأقنية الرسمية المُعترف بها لإنتاج الكلام كانت فعلاً ذا كمونٍ متمرّد بالتعريف، حتى لو كانت كتابة مقال أو تعليق لا يُزعج أحداً. أن يظهر اسمك الصريح ولو على وصفة طبخ على الانترنت هو أمرٌ مخيف، قد يفلت الشخص المعنيّ من هذا الخوف، لكنّ من المُحال ألا يثير الأمر خوف أحد مقرّبيه. كان جلّناً يشعر باللا أمان حتى وهو خارج البلد، لأن لديك في الداخل من تخاف عليهم، ولأننا، كشباب، كُنّا نُعاني من أول تمظهرات النظام الأمني في خوف عائلاتنا وأقربائنا من أي نشاطٍ لنا خارج سكّة الأمان: دراسة، عمل، صمت. كلّ ما هو خارج خارج سكّة «دعص» هذه هو فعلٌ أمني.
اعتُقل كثيرون على كلام قالوه أو كتبوه على الانترنت كان يمكن أن يظهر في سيناريو أي مُسلسل «ناقد»، مثل «بقعة ضوء»، أو يُنشر في جريدة أو مجلّة «مرضيّ عنها». لماذا قالوا أو كتبوا دون أن يُصرّح لهم؟ لماذا يريدون أدواتهم الخاصة والحرّة؟ لهذا كان الفيسبوك محجوباً، وكانت منصة بلوغ سبوت محجوبة، وكان عليك أن تُسجّل هويتك كي تستخدم كمبيوتراً في مقهى انترنت، واستُثمرت أموال طائلة لشراء أنظمة رقابة وحجب قبل الثورة وخلالها. ليس الأمر متعلقاً بماذا تفعل الآن بهذه الأداة، الانترنت الحُر، بل بماذا يمكن لهذه الأداة أن تسمح لك أن تفعل. الكمون المتمرّد للأدوات الحرّة هو سبب رعبٍ للزمرة الأسدية، ولذلك وجدنا غلّهم وحقدهم وعنفهم تجاه باسل الصفدي. اعتُقل باسل عام 2012، وأُعلن قبل يومين أنه أُعدم عام 2015. لم يُعتقل باسل وحده في تلك الفترة، بل اعتُقل عدد كبير من التقنيين الذين عمل معهم باسل، أو ربما كان فقط صديقاً شخصياً، وكانت التهمة «العلاقة مع باسل الصفدي». لماذا؟ لأن باسل الصفدي كان خبيراً ومهتماً بإنتاج أدوات الانترنت الحُر على مستوىً عالٍ، وأحد أهم مُدخلي هذه التقنيات على الساحة العربية.
كيف تتصل بالانترنت دون حجب، كيف تنشر دون تعقّب، كيف تتواصل دون رقابة. هذا كثيرٌ على نظام رئيس الجمعية العلمية السوريّة للمعلوماتيّة.
*****
كأغلب زملائي المدوّنين، خفّ نشاطي التدويني تدريجياً مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وطغيان السرعة في التفاعل عبرها على الإيقاع الأبطأ للمدوّنة، ثم انقطع نشاط مدونتي مع انطلاق تجربة الجمهورية. كنتُ أعودُ إلى مدونتي أحياناً لأحرّكها منطلقاً من الشعور بالذنب تجاهها، وهي موطن ما أعتبره تجربة تأسيسية لعلاقتي مع الشأن العام والكتابة، ثم قررتُ قبل عام من الآن إغلاقها بعد حفظ أرشيفها كنوع من تكريمٍ شخصي لتلك المرحلة، رغم أنني لم أعد لقراءة ذلك الأرشيف. ما زلت أعرّفُ عن نفسي عفوياً بأنني «مدوّن»، والكثير من أصدقائي المقرّبين وشركائي في العمل والنشاط العام هم «مدوّنون» (وكأننا لا نعترف بوجود «مدوّن سابق»). لم نكن حزباً طليعياً ثورياً، ولم نحرّك ثورة أو نقلب نظام حكم. كنا عاديين، نحاول قدر الإمكان أن يكون ما نعيشه «عادياً»، نتلمّس مساحاتنا وأدواتنا، ونكتب -قدر الإمكان- بحرّية، ونفرح كأطفال حين تأتي تعليقات على المقالات، أو حين يتعدّى رقم الزوّار الرقم المُعتاد. تغيّرت الأدوات اليوم، وتطوّرت وتعقّدت وأصبحت أكثر مباشرةً وأسرع، وربما بعد سنوات سنكتب مقالاً مشابهاً لهذا عن فيسبوك وتويتر.
المهم، اليوم، أن حسين غرير، بعد عقدٍ واعتقالين، ما زال يدوّن…