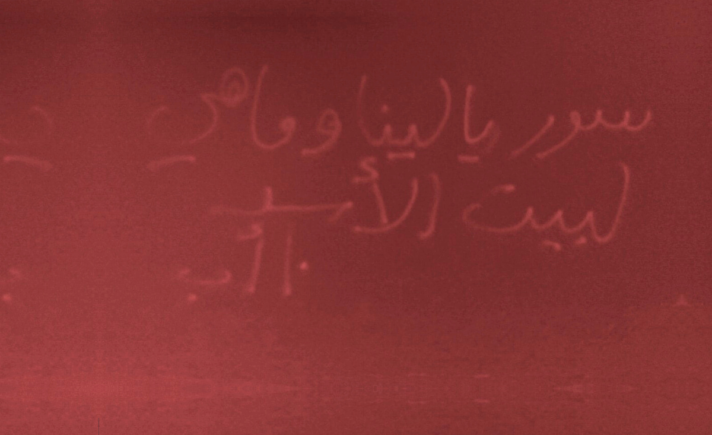كمن يثقب عن عينيه غشاوة الوهم، ويرنو إلى المجهول بحذرٍ شَكوك، صمتٌ لا تساوره الحياة وصفيرٌ عميقٌ في أذنَيّ، تتهاوى خمس سنوات في رأسي فوق بعضها مثل المدن التي أصبحت كومة من التاريخ والدماء، كأني أمسِ أتيتُ إلى جنوب دمشق مُثقِلاً جعبتي بالأمل، متأكدّاً من رقصة النصر القريبة في ساحة الأمويين.
جنوب دمشق الذي كان أوسع من الحلم، منحني وقتها سعادة أكبر بكثير من التعب الذي كنا نناله في غرف العمليات في المشفى الميداني، من طريق المطار شرقاً إلى طريق دمشق-درعا غرباً، ومن تلة صهيا جنوباً إلى مشارف حي الزاهرة الدمشقي شمالاً، كان للجيش الحر سمات المخلّصين، وللمعارك سحر التقدم نحو الأمام، وتفاصيل الحرب اليومية من معارك طاحنة وقصف لا يكاد يتوقف أشبه بأسطورة مستمرة تعوّدنا عليها بحلوها ومرّها، وصرنا نميّز القذائف من صفيرها أو من صوت انفجارها، فلكل بندقية ومدفع نغمه الخاص، وآذاننا تمرّست على مقامات الحرب وإيقاعاتها.
لم يكن مفاجئاً اتصال أخي فتاح بي قبل ثلاثة أشهر، فاتصالاتهم بي متكررة لأني الأخ الأكبر المعرّض للموت في أي لحظة في منطقة صغيرة محاصرة، سَلَّمَ عليَّ كعادته واطمأن، ولكنه لم يطلب أي شيء آخر، فقط أخبرني أن أخي حمودة يتألم بشدة من ركبته اليسرى. وبشكل عادي، وأنا طبيب العظمية في جنوب دمشق، أخبرتُه بضرورة الذهاب إلى أقرب مشفى عام في عنتاب التركية.
في عيادة العظمية كثيرةٌ هي الشكاوى المماثلة لشكوى أخي حمودة، ألمٌ في الركبة بعد مباراة كرة قدم أو بعد حادث دراجة نارية خفيف أو بسبب التقدم في السن. الحياة تستمر رغم الحرب، فقد جهّز المقاتلون ملاعب صغيرة لكرة القدم، ولم يتوقفوا عن عادة «التشبيب» بدراجاتهم النارية، وإن لم يموتوا بسبب الحرب فهم يهرمون ويصابون بأمراض الشيخوخة.
لم أفكّر قط أن حمودة لم يتجاوز ثماني عشرة سنة من عمره، وأنه لا يملك أن يلعب كرة القدم أو أن يركب دراجة نارية، وهو الفار من داعش التي تلاحقه في سورية، إلى تركيا منذ عشر أيام فقط. نسيتُ ثلاثة مرضى يأتونني شهرياً في جنوب دمشق بقصة ألم خفيف، وتُظهر الصورة الشعاعية علامات السرطان. نسيتُ ذلك لمدة خمسين يوماً كان ألم حمودة وحجم ركبته يزدادان فيها تدريجياً، وقد عانى ما عانى في المشافي العامة بتركيا من الإهمال والتمييز، لتبشّره الصورة الشعاعية بعد طول انتظار بورم في الركبة، إنه السرطان، آهٍ يا سخرية العمر.
وبعد انتظار ليس بأقل من سابقه أُجريَت الخزعة التي قرَّرَت بتر ساقه، لكن هذا الضيف الثقيل أحب حمودة كما أحببتُه فأبى أن يفارقه. شابٌ وسيمٌ عيناه نهمتان للحياة وكأنه يريد أن يلتهمها، هذا ما وشت به صورته، قبل ثلاثة أشهر، فأنا لم أره بهذا الاكتمال من قبل. كانت آخر مرة أراه فيها وعمره لا يزيد عن عشر سنوات، والآن ينام أخي الصغير على فراش بارد في مشفى بعيد، غريباً في كل شيء وعن كل شيء، يمررون له الحياة عبر أنبوب بلاستيكي دقيق في وريده.
نَحُلَ الشاب اليافع واصفرَّ وجهه، وأصبح للدقائق معنىً غير المألوف. لا ينتظر هذا الفتى موعده الأول مع فتاة أو موعده للذهاب مع أصدقائه إلى قهوة الكرنك في الرقة، إنه ينتظر الذين لن يودعوه إلى نومه الأخير. تموت المدن ولا ينجو أهلها، ربما جمعتهما لعنة الزوال المحتمة، الرقة التي شقّت الشمسُ عنها حجابَها، وبدأت تغصّ بالمثقفين والأدباء والفنانين والسياسيين، تلفّها داعش بجلبابها وعمامتها السوداوين، ويحكم العالم عليها بالزوال، ونزولُ معها.
كالمضروب على رأسه بجبل، بَرَقَت أمامي تراجيديا سقوط المدن والبلدات المحررة بأيدي قوات النظام، كان سقوطها سريعاً وغريباً، انسحب من انسحب وخان من خان وقُتلَ هناك من قُتل، هناك في شوارع وأحياء عرفناها جيداً وتركناها دون اكتراث، وتركنا فيها العديد من ملاعب كرة القدم والدراجات النارية وجثث المقاتلين، لتضيق بنا الأرض وكذلك الحلم. وتورّم المنسحبون مثل ركبة حمودة، وبدأ القتال، الجيش الحر وداعش كخصمين أكثر اتضاحاً من غيرهما في الحرب السورية المترامية، بالكاد استطعنا أن ننجو بأنفسنا من المشفى الميداني في الحجر الأسود الذي سيطرت عليه داعش، لنكمل عملنا في مشفى ميداني جديد في بلدة يلدا، وحوصرنا في أضيق من أن ترنو عينٌ إلى أفق. غربَنَا داعش، وشمالنا قوات النظام، وشرقنا وجنوبنا حزبُ الله اللبناني ولغاتٌ شتى يجمعها الراتب الشهري الإيراني. حاصَرَتنا كسرة الخبز، لا طعام نتقيؤه ولا أنابيب بلاستيكية في الوريد مثل حمودة، اصفرّت الوجوه وعمّ الشحوب في الشوارع والبيوت والمشفى الميداني وفي السماء الضيقة فوقنا. نحن ساومنا الموت باتفاقية أسميناها «هدنة»، وقال النظام عنها «بداية المصالحة الوطنية»، ولكن بأي شيء سيساوم حمودة الموت، لقد أطعمه رجله حتى منتصف الفخذ ولم يشبع، هل الموت محاصرٌ فينا نحن السوريين؟!
يقول المُحاصَر للمُحاصَر «كلانا في الهم شرق»، أي شرقٍ وقد غاصت قدماي في الـ «هنا»، لا جهات أعقبها إلا جهة القلب. وحيدٌ أنا في لا نهاية المصيبة، شهيقي يشجّ أضلاعي كرمح، يتعبني الهواء فوق ظهري، أنا حكيم هذا الحصار في جنوب دمشق. اتسعت أحلامنا فضاقت علينا الحدود، محفوفون بالأعداء من كل حدب وصوب، كل سيوفي تكسرت عندما خسرنا اللواء وحاصرَنا الجوع، بأي شيءٍ سأقاتل هذا الألم الآن؟! غريبٌ في حريتي وثورتي وسقوطي، وغريبٌ عن موت أخي، ورثتُ عن ملوك الغربة، أبي حيان التوحيدي ومحمود درويش، جهلي بهم، أنا الدرويش الوحيد، أي صوفيٍّ يلبسني ملاءته لأدور في هذا الفراغ حاملاً رأسي بين كفيّ لأضعه جانباً؟ لستُ أكثر الغرباء حظّاً بالألم، من حُرِمَ من أبويه وإخوته جميعاً طاعنٌ في الألم أكثر مني، من قُتِلَ أبناؤه أمام عينيه موثوقٌ إلى العذاب أكثر مني، ولكنّ عينيَّ أصغر من أن تتسعا لكل هذا التضخم، وِسادةُ نومي أصبحَت كأني أضع رأسي على جبل، قدماي وحذائي، مقود سيارتي، حفرة في الطريق أصبحت بعمق هاوية، أطراف المرضى المكسورة، وجوه أصدقائي أصبحت صفحات مليئة بالتاريخ المدمى. أنا مصاب بسرطان الوجع، كنتُ شاهداً على كل آلام جنوب دمشق، ومفرداً في ألمي، أهشُّ برجل حمودة المبتورة على الحصار والجوع، وأسندُ عليها كفَّي وصدري، أنا راعي هذا الجنوب بما قوَّسَت المصائب ظهري.
***
صفيرٌ عميقٌ يعمّ جنوب دمشق، كتاب العصر الجاهلي لشوقي ضيف يصفّق فوق طاولتي من نسمة لا أعرف أي حاجز عسكري سمح بمرورها، لم أكن بطلاً في هذه الحقيقة، ولست قادراً على تغييرها، أنا قنّاص المصائب الحاذق، أشعلتُ سيجارةً حادّةً في الحلق، حارّةً في الرئة، وحاولتُ أن أقولَ عن عمّار العيسى، جرّاح العظمية الوحيد في جنوب دمشق، وعن أخيه حمودة، وأمعنتُ من شرفة الحصار في المسافة اليابسة بينهما، وبكل ما أوتيتُ من جاهلية رميتُ عليها عقب سيجارتي، ولم تحترق.