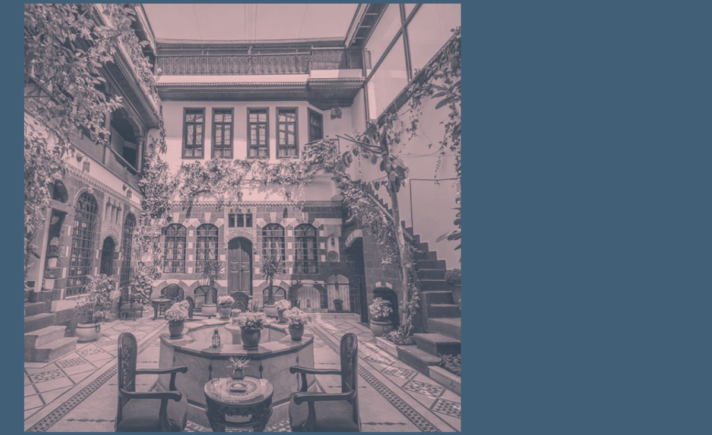1- كيف نكتب كتاباً، زمن الحرب؟
كما كتب الناس قبل الحرب، وكما سيكتبون بعدها: نقرأ كُتُباً، ونراقب ما يحدث حولنا، ثم نكتب كُتُباً ومقالات؛ بعضها ممل، وبعضها ممتع.
2- كيف نكتب كتاباً جيداً، زمن الحرب؟
كما تُكتَب الكتب الجيدة دوماً: بصدق وأمانة، ووضوح ناصع، ومحبة.
لا يوجد أسرار باطنية تدل على الكتابة الجيدة. كل ما في الكتابة مفتوح في الهواء الطلق: كتابات رديئة لكتّاب غير معنيين بالكتابة بل بالشهرة؛ ومواضيع سخيفة لتسلي القارئ؛ ومواضيع أسخف لتثير الشعب الضَجِر؛ ومواضيع دينية وقومية وإثنية لتعزّز الجهل أو العنف؛ ثم تأتي الكتابات الجيدة التي لا نعرف كيف تُكتَب بالضبط، ولكنها تتصف بالصدق: لا واجب خارجي، أخلاقي أو اجتماعي أو ديني، ينير درب الكتابة الجيدة: فقط الصدق مع الذات، لا غير.
3- عمّاذا نكتب، زمن الحرب؟
عن أي شيء، وعن كل شيء؛ يكتب كل منا عمّا يثير اهتمامه الشخصي: عن ذكريات الطفولة الوهمية؛ فلسفة أبيقور المتقشّفة الداعية للذة؛ خطاب «زنقة زنقة»؛ شكوك المعرّي، أو خمريات أبي نواس؛ «باب الحارة»؛ النيل الخالد أو بردى الفقير؛ زيجات سعاد حسني؛ قصة قناة «الجزيرة»؛ لغز اختفاء البطل حسين هرموش؛ انتحار «كاواباتا»؛ «مجمّع يلبغا»؛ كوابيس الرضّع؛ شوكولا «غراوي»؛ بؤس العائلة البشرية عندما تعزف إنغريد برغمان البيانو في فلم «سوناتا الخريف»، تاركةً ابنتها خارج الموسيقا والتواصل البشري؛ الفارق بين الفلافل السورية والمصرية؛ ملابسات الكشف عن وجه الشاب الشيخ أبي محمد الجولاني؛ خلاف روسو وهيوم، الشخصي والفكري؛ صعود وهبوط سارية السوّاس؛ قصائد غوته الإيروتيكية؛ الحدود اللبنانية السورية؛ موقف الإمام محمد عبده من الاحتلال الإنكليزي؛ ذُل المطارات؛ الهجوم الكيماوي في الغوطة؛ كيفية إعداد وتجهيز «الشنكليش»؛ نازية عبد الرحمن بدوي؛ الإرث الفكري شديد التنوّع والغنى لفقيد الثقافة السورية والعربية والعالمية العماد أول مصطفى طلاس؛ وردة وبليغ؛ الدروز وصلاح الدين الأيوبي؛ تفجير خلية الأزمة؛ وأشياء أخرى، لا تُحصى.
نكتب، إذن، عمّا يعنينا بحق، في عالم لا يعنيه ما يحصل لنا. الكتابة، أو الكتابة الجيدة، هي تلك التي تثير كاتبها، وتملكه، وتحبسه، إلى أن يقول ما سيقول، غير عابئ تماماً بردّ فعل القرّاء؛ ولكنه يتحرّق شوقاً إلى ردّ الفعل هذا، في تناقض يشكل جوهر الكتابة الجيدة. وهذا الجوهر لا يتغير، ثابت ثبوت الطبيعة البشرية المُريب المشكوك بأمره: بين الرغبة الجارفة غير العقلانية في التعبير عن النفس، وبين الشرط الضروري لقبول الناس لما أنجزناه، يحيا الكاتب.
في زمن الحرب، لا نستطيع أن نكتب عما يعنينا حقاً، فتفقد الكتابة معناها: لا يستطيع الكاتب أن يكتب عما يعنيه حقاً، وراء الحرب، زمن الحرب: تأكل الحرب اهتماماتنا، العادية والاستثنائية، لتسجننا في زمنها: تتقلّص حياتنا واهتماماتنا من عالم لا حدود له، إلى عالم تحده الحرب من كل جانب: حصار مزمن، وجوازات سفر لا تأخذك إلى أي بلد، وقتلى لا تغادر أرواحهم أرضنا ويومياتنا، ومفقودون لا يغيبون ولا يظهرون، كروح الله ترف فوق المتوسّط. تصبح الحرب هي الحياة، والكتابة محبوسة فيها، ولها، وعنها.
4- كيف ننقذ الكتابة، من الحرب، زمن الحرب؟
الجواب، للأسف، أن الكتابة، غالباً، تسقط في الحرب في تفاهة الحرب ذاتها. كل محاولة لإنقاذها تعني إما التخلي عن دور الكاتب في الحرب ليعتزل الحرب، وبالتالي يعتزل الواقع بأكمله؛ أو أن يتفرّغ للحرب، وبالتالي يخسر كل ما يربطه بالحياة الحقة، تلك التي تقع خارج الحرب.
في الحالة الثانية، يتحول المرء إلى كاتب تقارير عن الحرب: لا يستطيع رؤية ما هو خارجها، أو حتى داخلها، وراء اليومي المباشر: كل ما يعطي لحياتنا معنى إنسانياً متعالياً يختفي: ساعات الضجر الطويلة المُنهكة العذبة الفارغة تماماً؛ التسكع الأحمق في شوارع خالية بلا هموم ولا أفكار؛ قراءات متناثرة غير مترابطة: مذكرات زوجة دوستويفسكي، رسائل ديغا، المواقف والمخاطبات؛ وبالطبع، الرغبة بالكتابة عن مواضيع هامشية جداً، كنوم الظهيرة، والقبلة الأولى، والأرق الوجودي لمن تجاوز الأربعين: لا إمكانية للتغيير، ولا للاستمرار على الدرب نفسه؛ أو مواضيع عميقة، إن شئت: روايات محفوظ التاريخية؛ نظرية المعرفة عند لايبنتز؛ تصوّف الشيخ تولستوي. يختفي كل ما له معنى، لنغرق في تفاصيل تحليلات سياسية، لا نملك أدنى قدرة على تغييرها.
في الحالة الأولى، عندما تدّعي أنك وراء الحرب تماماً، ولا تعنيك ما تفعله بك وبواقعك، تكتب ما تشاء عن الوجودية أو الشعر الأمريكي الحديث أو سينما فيلليني؛ تقرأ ما تريد من شعر الجاهليين؛ تسلّي نفسك بالاستشراق ومبالغات سعيد ومبالغات نقّاده؛ تكتب عن كل شيء، إلا الحرب: تخسر الواقع، وتكسب الكتابة، كما تعتقد، مخطئاً: يأكلك الشعور بتأنيب الضمير، ليلوّن كتابتك نفسها، في النهاية، بنفاق يكاد يشع من كل كلمة.
لا يمكن إنقاذ الكتابة من الحرب. كل ما نستطيع فعله هو أن نعيش الحرب، ونجرّب الكتابة زمن الحرب، ونسأل أكثر عن معضلة الكتابة في الحرب.
5- هل نتوقف عن الكتابة، كلياً، زمن الحرب؟
قد يتوقّف البعض عن الكتابة زمن الحرب، كما يتوقف البعض عن الحياة، عملياً: كثياب منشورة متروكة للريح، جفّت ولم يجمعها أصحابها؛ تركوها هاربين إلى بلدان لا تريدهم ولا يريدونها.
كل يوم، نسيم خفيف أو ريح صرصر تعبث بثيابنا، والحياة تجري وحدها، تاركةً إيانا محبوسين في حرب لا كتابة فيها…
6- هل نكتب عن الحرب، فقط، زمن الحرب؟
بالطبع، لا. ليس فقط بسبب تفاهة تسجيل لحظات الحرب، ولكن لأن مفهوم الكتابة نفسه يتعدّى اللحظي واليومي. ليس صحيحاً، على الإطلاق، أننا نكتب ما نعيشه فقط: لو صح هذا، لتحول الكاتب إلى آلة تسجيل عمياء، كما هو حال كتّاب الواقعية الاشتراكية. نحن لا نكتب عن السلم في زمن السلم؛ ولا نكتب عن الحر في الصيف أو عن البرد في الشتاء؛ ولا عن الحب في سنوات الزواج الأولى: الكتابة تستقل بنفسها عما يحيط بها بشكل مباشر. الكتابة، أو الكتابة الجيدة، هي تجاوز الواقع، من خلال رؤيته والعيش فيه بكافة تفاصيله، إلى عالم آخر، أوسع وأغنى.
يبدو لي أن إحدى الطرق لحرب الحرب هي ألا نقبل بما تفرضه علينا: أي أن نحرر الكتابة من أسر الحرب.
7- هل نكتب عن اللا-حرب، كاحتجاج ثقافي على الحرب؟
الحل الثاني المتمثل في الكتابة عن أي شيء، إلا الحرب، قاتل، كالحرب ذاتها.
يستند جواب الهروب من الحرب إلى تيار طويل عريض في الفلسفة، يمتد من سحيق الزمن إلى اليوم، وغداً: من الرواقيين إلى المتصوفة بأنواعهم، هنوداً ومسلمين ومسيحيين وعلمانيين؛ إلى يسوع في معظم أقواله التي تدعو إلى الزهد في انتظار ملكوت الله القادم قريباً؛ مروراً بأبيقور وأتباعه؛ والفلاسفة المتشككين بمعظم أشكالهم المختلفة، خصوصاً القدماء؛ والإسلام التقليدي، بكافة طوائفه؛ وبقية الأديان المتحالفة مع السلطات؛ إلى بعض ما قاله أعظم فيلسوف، إيمانويل كنط: يرى هذا التيار أن الإنسان الحر هو حر في روحه الداخلية الخاصة الشخصية، ومهما تكالبت علينا نكبات الزمن ونوائبه، لا تستطيع أن تمس الإنسان الذي في داخلنا. شخصياً، أعتقد أن هذا كلام فارغ وحكي فلاسفة وزعبرة زهّاد: أن ينكمش الإنسان على نفسه، فيما العالم يحترق حوله، هو وصفة للتعاسة لا مثيل لها، وللخذلان، وللعبودية. على العكس، يبدو لي أن الرغبة بالتغيير والمشاركة السياسية والاجتماعية، التي تتعدّى المرء وحياته الخاصة، هي حاجة جوهرية لأية حياة بشرية، إن لم تكن جوهر الحرية الكاملة الخالصة.
ولكنني، اليوم، مع طول أمد الحرب، وتسارع انهياري النفسي، واستسلامي الروحي لقوى الشر، المتمثلة في الإحباط والكسل وقبول الحرب بما هي قدرٌ لا مهرب منه، وعدم قدرتي على تغيير مجرى الأحداث، أو المساهمة في تغييرها، أعود إلى وصفة التعاسة هذه، متسائلاً إن لم تكن تحوي بعض الأمل.
بمعنى ما، ربما علينا أن نعيد تأويل هذا المذهب، كي نحيا دون يأس: طالما الأمل بمستقبل أفضل، جمعياً وليس فردياً، حيٌّ في داخلك، لن تخسر حريتك، مهما تكالبت علينا نوائب الدهر.
ربما، هذا هو السبيل الوحيد لمواجهة حرب لا نهاية لها في الأفق.
الكتابة، إذن، يجب أن تكون داخل الحرب، لنرى ما هو خارج الحرب.
8- هل تختلف الكتابة زمن الحرب، نوعياً، عنها قبل الحرب؟
لا أعتقد ذلك؛ على الأقل، إن تكلمنا عن جوهر الكتابة، لا عن أشكالها المختلفة ووسائط نشرها. بالرغم مما يُقال هنا وهناك، يبدو لي أن الكتابة لا تتغير، جوهرياً. وهذا موقف شخصي متشدد، لأنني، للأسف الشديد، دقة قديمة، متحجّر في مواقفي الفكرية وذوقي الجمالي: لا أجد الكثير مما يغري في الكلام عن وسائل التواصل الاجتماعي وسرعة الزمن والعالم قرية صغيرة وأمور أخرى شبيهة. الكتب الجيدة هي الكتب الجيدة، سواء وُجدت منسوخة بخط اليد أو مطبوعة أو مرئية على شاشة حاسوب أو قارئ إلكتروني؛ والكاتب الجيد هو ذلك الصادق الأمين المتوتر الساذج اللمّاح الحزين المرح. لا تتغير صفات الكتاب، ولا الكاتب، مع الزمن والحضارة والتكنولوجيا والاحتباس الحراري، أو مع الحرب والسلم: كل هذا يبقى على الهامش، هامش الكتابة الجيدة.
9- لماذا نكتب، زمن الحرب؟
نكتب زمن الحرب للأسباب ذاتها التي كنا نكتب لها قبل الحرب، وكما سنكتب، أو سيكتب غيرنا، بعدها: لأننا نريد أن نعبّر عن أنفسنا.
10- هل تنقذنا الكتابة من الحرب؟
بالطبع، لا: لا شيء ينقذنا من الحرب.
الكتابة، بحسب البعض، فعل يمثل ذروة الإبداع الإنساني والتجلي الإلهي: مزيج من السحر والإلهام والنبوغ والأصالة؛ والكاتب أو الكاتبة يُجسّدان أعلى درجة في جسر يفصل، أو يصل، البشر والملائكة.
هكذا، يبدو أن الكتابة، كفعل سام، تنقذنا من شرور الحرب.
ولكن هذا كلام خاطئ، جملة وتفصيلاً: ليس الكتّاب نوعاً مختلفاً من البشر، بل هم أناس عاديون: عصابيون أكثر قليلاً من المعدّل الطبيعي؛ فاشلون في العلاقات العاطفية أكثر قليلاً من أصحاب المهن الثابتة؛ أكثر ضعفاً أمام النقد من الطلاب والأساتذة؛ يخافون من الجمهور والمناسبات الاجتماعية، كما هو حال معظم الناس. وهم ليسوا استثناء، حتى في توترهم الظاهر ورغبتهم الدفينة في أن تبتلعهم الأرض أثناء نقاش عملهم وآرائهم مع الغرباء: يشاركهم في هذا المراهقات المجدّات، وطلبة الرياضيات والفيزياء، وأبناء الريف في المدن، والعرب في الغرب، والرياضيون الفاشلون، ومطربو الدرجة الثالثة في المطاعم والكباريهات، ومرتزقة قتلة على طرفي القتال لا يعنيهم إلا ما يجنونه شخصياً من فوائد.
الكتابة، بشكل عملي، وعلى الأرض كممارسة، تبدو رديفة بشكل رئيس للملل وأوقات الفراغ والتسكع والشهوة الحائرة والجوع نصف الجدي والشبع غير المكتمل والأفكار غير الواضحة والندم شبه الأبدي والعتمة الداخلية والهدوء الذي لا عاصفة بعده: لا شيء في الكتابة قدسي أو نبوي؛ الكاتب والكاتبة يشبهان لاعبي الورق في مقاهي الربوة، وطلاب يهربون من الحصص الدراسية إلى الحدائق ليدخنوا بعيداً عن الأعين، والأم التي تختلس خمس عشرة دقيقةً لتتجول وحيدة وتأكل قطعة كيك بالشوكولا بعيداً عن متطلبات الأولاد التي لا تنتهي: ترفٌ لا يملكه إلا البشر، لينفقوا وقتهم بلا معنى ولا هدف.
وبالطبع، لا يوجد جسر بين البشر والملائكة: الكتابة في زمن الحرب، أكثر مما هو قبلها، أو بعدها، تهدم وهم هذا الجسر السحري: كلنا في برزخ واحد نقتل الوقت حتى تنتهي الحرب: بعضنا يكتب، وبعضنا يلعب الورق، وبعضنا يقتل، وبعضنا يقاوم، وبعضنا يعبر البحر، أو لا يعبره، وبعضنا يتناسى الحرب كأنها أنفه الذي لا يراه، وبعضنا يعيشها بكامل تفاصيلها كأنها حياته المنتظرة.
اللذين يكتبون، على العموم، لا يشعرون بالرضى أبداً عما أنجزوه، يأكلهم الشعور بالذنب لعجزهم أمام الحرب: بالضبط، كحال أولئك اللذين لم يكتبوا حرفاً في حياتهم.
إذن، لا شيء ينقذنا من الحرب: لا الكتابة، ولا غيرها.
علينا أن نحيا هذه الحرب إلى نهايتها؛ وأن نكتب، أيضاً، نهايتها تلك: لن ينقذنا ذلك من الحرب، ولكنه يعني أننا نعيش، أو أننا عشنا، بالرغم من الحرب، كما نريد، تقريباً!