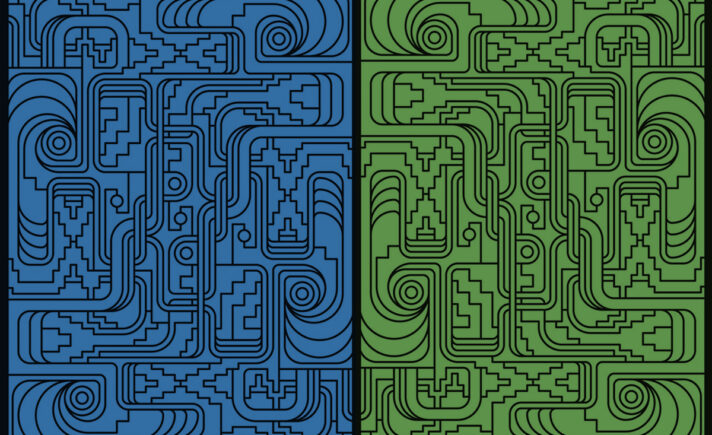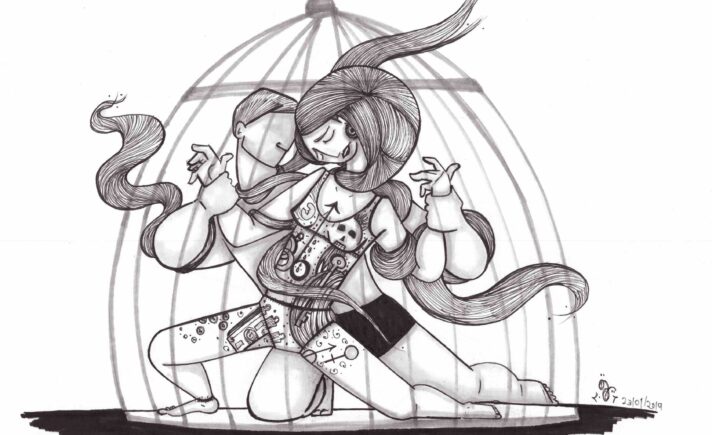مقدمة
لا يكاد يجد الباحث أية محاولة جادة لدراسة الازدراع القانوني (أي استنساخ القانون الوضعي الحديث) في العالم العربي، وربما الإسلامي ككل، في الأكاديميا القانونية الأميركية، خصوصاً بالمقارنة مع مناطق أخرى غير غربية، كأميركا اللاتينية أو شرق آسيا. ليس السبب قلة الاهتمام الأكاديمي بالشأن القانوني في العالم العربي/الإسلامي، فقد سالَ حبرٌ كثيرٌ حول الدساتير العربية على سبيل المثال، ناهيك عن التشريعات التي أصبحت منذ عقدين جزءً لا يتجزأ من عالمنا المعولم، كقوانين الاستثمار الأجنبي أو الملكية الفكرية، أو القوانين التي تعالج تلك القضية المريرة والملحّة: الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب! ما لا يمكن العثور عليه هو دراسات حول «المدونة القانونية الأوروبية»، أي الصيغة الأساسية التي تم استدخال القانون الحديث من خلالها إلى منطقتنا لتصبح السمة المميزة والمستقرة للنظام القانوني المعاصر.
ثمة سبب بسيط وراء ذلك، سأعبّر عنه بصراحة.
منذ فترة طويلة، يحتكر دراسةَ القانون في العالم العربي/الإسلامي باحثون إسلامويون
لا حدود لجرائم الازدراع بالنسبة للإسلامويين ومن لفّ لفّهم، وهي جرائم تختلف باختلاف «الاتجاه النظري» للمتحدث.
فإذا كنتَ أخلاقوياً ذا ميول إسلامية، ستعتبرُ أن النظام القانوني الأوروبي والنخبة الحداثية الدخيلة، قاما على أنقاض النظام التربوي الديني-الأخلاقي وطبقة الفقهاء التي كانت مهيمنة في زمن ما قبل الحداثة. من هنا تنبع جميع الشرور، بما في ذلك التخبط الأخلاقي الذي يعيشه المسلمون المعاصرون – وقد يصل بك الجدل إلى ردّ العنف الأصولي إلى هذا التخبط الأخلاقي (خالد أبو الفضل).
أما إذا كنت ذا ميول «تقليدوية» معادية لمفهوم الدولة القومية، فسيكون موقفك قريباً من موقف زميلك الأخلاقوي. ستعتبر «التقاليد» شكلاً من أشكال «الخطاب» الذي قضى عليه الازدراع القانوني (طلال أسد). التقاليد ضرورية، وقد كانت تقدم للمسلمين «رؤيةً للعالم»، إلا أن ذلك تفكّكَ على يد الحداثة والليبرالية والإنسانوية والعلمانية، وهو ما تجسد بعملية الازدراع بطريقة أو بأخرى. وفقاً للإخوة التقليدويين، لا يجوز للتغيير أن يأتي إلا من داخل «التقاليد»، من رَحِمها إذا جاز التعبير، وبشكل تدريجي حصراً. ذلك أن أي تمزق «إبستمولوجي» تكابده هذه التقاليد سيكون له عواقب مفجعة – أي انقلاب قانوني يأتي على يد نخبة أوروبية علمانية ليبرالية إنسانوية هو أمرٌ مفجع.
لكن ربما يغمرك حنينٌ ما إلى أيام «التقاليد»، عندها ستعتبر أن الازدراع علامة على أن الزمن الجميل قد ولّى إلى غير رجعة. في العصور الإسلامية التي سبقت الحداثة، دأب جمهور الفقهاء ومجتمع المؤمنين على التعايش في وحدة عضوية مستقلة تماماً عن الحاكم (وائل حلاق). كان الحاكم يأتي ويذهب، بينما استمرَّ العناقُ المقدّس بين الفقهاء والعامة على مرِّ الزمان وتعاقبِ الحكام. الفقهاء يحكمون وفق احتياجات المجتمع الذي هم منه وهو منهم. تكمن رومانسية هذه النظرة في افتراض وجود مجتمع تسوده «الوحدة» ولا تعصف به أية صراعات اجتماعية داخلية، إلى أن جاء الازدراع وفجّره إلى شظايا.
وإذا كنتَ من رفاقنا الممانعين المُعادين للإمبريالية، فستهاجم الازدراع وتتهمه بتسهيل الحكم الاستعماري ومركزة النظام القانوني وقوننة كتب العلماء (عزة حسين). ستجادلُ أن المركزة والقوننة هما ما حوّل النظام القانوني الإسلامي، والذي كان منفتحاً وتعددياً، إلى نظام موحد وصارم على الطريقة الأوروبية. هنا من المتوقع أن يتأثر القارئ ويشعر بالاستياء، فمن الواضح أن نظاماً تعددياً يعطي القاضي أو الفقيه مجالاً واسعاً للحكم والاجتهاد أفضل من نظام صارم لا تُتَاح فيه تلك الخيارات.
أما إذا كنت ليبرالياً مختصاً في الشأن الدستوري، فستجادل بأن الفقهاء كانوا ضمانة «فصل السلطات» عن ولي الأمر، الأمر الذي زالَ بعدما أطاح الازدراع بزمن الفقهاء وشريعتهم. إنها عواقب لا يمكن وصفها إلا بأنها وخيمة، إذ ما كان يمكن للاستبداد في العالم الإسلامي أن يتفاقم لولا إسقاط طبقة العلماء وما كانت تقوم عليه من ضوابط وتوازنات (نوح فيلدمان).
لذا وجبَ نبذُ الازدراع القانوني الأوروبي في العالم الإسلامي باعتباره «سقط متاعٍ» لا يستحق الدراسة الأكاديمية، فهو عمل دخيل تسبب بخراب عميم. الأجدر بالمقابل توجيه الاهتمام العلمي لدراسة الماضي والبحث عن سبل استرداده. وهكذا فإن المشروع الأكثر إلحاحاً بالنسبة لهؤلاء الأكاديميين تمثل بإعادة الوصل ما بين «قانون المسلمين» والمسلمين – لقد غُيِّبوا عنه ظلماً وبهتاناً.
الاختلاف الإسلامي
وبالفعل، يبدو أن هناك إجماعاً علمياً في الولايات المتحدة حول قانون العالم الإسلامي، وهو لا يعدو في الحقيقة إجماعاً حول الهوية. قد يعني القانون أشياء مختلفة لأناس مختلفين عبر العالم، أما بالنسبة لـ «المسلمين» فالقانون هو في المقام الأول مستودع للهوية.
الإصرار على أن قانون المسلمين هو مستودع الهوية الإسلامية يتضمن، برأيي، مشروعاً سياسياً مزدوجاً، أحدهما ينضوي تحت لواء الآخر: خلق نقاش –بل وحتى صراع– حول معنى كلمة «مسلم» (من هو المسلم الحق؟) وكلمة «قانون» (ما هو قانون المسلمين الجدير بهم؟). وهكذا بينما يموج النسيج الاجتماعي في العالم «المسلم» بمحاور صراع عديدة: حول توزيع الثروة، حول الحقوق والحريات وحول التمثيل السياسي، يخرج علينا الإسلاموي ونصيره الأكاديمي الأميركي مقترحَين فتح جبهة صراع أخرى حول الهوية والقانون. إنها دعوة للسفسطة حول الهوية عبر إثارة الجدل بشأنها.
فيما حقق المشروع الإسلاموي قدراً طيباً من النجاح فيما يتعلق بالسؤال الأول، أي سؤال «من هو المسلم؟»، ما تزال المسألة المتعلقة بالقانون غير محسومة بعد.
اسمحوا لي أن أشرح ما أعنيه بهذه القصة. خلال الصيف الماضي دعتني إذاعة البي بي سي لمناقشة أحد مؤلفي كتاب حروب الكوير، وهو كتابٌ يتحدث عن مؤسسة إيلغا (المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات والمزدوجين وثنائيي الجنس والمتحولين والمتحولات) وعن مناقب ومثالب هذه المؤسسة. كما هو معروف، تقوم إيلغا بحشد المناصرة الدولية لحقوق المثليين، وتحظى بدعم ناشطين مثليين غربيين متحمّسين. الكتاب مثير للاهتمام بالفعل، وهو يغطّي مناطق واسعة من العالم يتكشف فيها الصراع المحلي حول حقوق المثليين. ورغم ما يسود الكتاب من موقف عام مناهض لـ«الإمبريالية الثقافية» (كما يتوقع المرء من أكاديميي هذه الأيام)، إلا أن المؤلّفين يتبنّيان مواقف دقيقة ومفصّلة حيال مختلف المناطق التي يناقشها، حيث يركّزان على تعقيدات التضامن الدولي: متى يكون مفيداً للنشطاء المحليين الحصول على دعم الدولي، ومتى يضرهم ذلك ويثير حولهم زوابع رهاب المثلية أو يعرّضهم لتحريض مفتوح وعلني. لكن فجأة حين وصلا إلى العالم الإسلامي تلاشى التحليل «الدقيق والمفصّل» وتبنّيا موقفاً بسيطاً جداً: لا تقربوا العالم الإسلامي!
حاولتُ التصدي لذلك التعميم والإصرار على أن هناك بالفعل نشطاء يدافعون عن حقوق المثليين في العالم الإسلامي، وأنهم كغيرهم قد يحتاجون إلى دعم دولي «محسوب» وقد يطلبونه بأنفسهم. حاولتُ التفريق بين «الأممية» و«الكونية»، وهو ما تعامى عنه مؤلفا الكتاب: الأممية تتعلق بتقديرات سياسية متفاوتة محكومة بالزمان والمكان، أما الكونية فتتعلق بمبادئ عالمية تنطبق على المسلمين كغيرهم – فهم أيضاً يتطلعون إلى قيم كونيّة. غير أن محاوري أصرَّ على رأيه، وكرّرَ على مسامع جمهور البي بي سي أن كلامي «طائش» وخطير جداً. كانت المناقشة متوترة وذات إيقاع سريع، وانتهت خلال عشرين دقيقة فقط. خرجتُ مقهورة. شعرتُ أنّ أحداً رمى لي بسطل هوية ثم أرغمني على حشر رأسي فيه. العجيب أن الأخ عرّف عن نفسه كـ «تقدمي».
لماذا هذه القصة؟ لأن تحويل «المسلم» (وهو كائن اجتماعي معقد) إلى هومو إسلاميكوس (شخص متمحور حول هويته الإسلامية) هو مشروع إسلاموي بامتياز. في الحقيقة أعتقدُ أن المشروع الإسلاموي بمجمله قائم على مطابقة المسلم مع الهومو إسلاميكوس، أو تحويله إليه بالتدريج عبر إخفاء سيرورة صنع هذا المخلوق (والتي أسميها الحاكمية الإسلاموية). لم تتوقف هذه الحاكمية عن إنتاج «الإنسان المسلم» –الموضوع الأثير لدى الخطاب الإسلاموي المعاصر– على مدى العقود الثلاثة الماضية، أي منذ انطلاق ما يسميه الإسلامويون بكل فخر «الصحوة الإسلامية». بمرور الوقت أصبح غضُّ النظر عن آليات إنتاج هذا «المسلم» علامة تقدّم ومدعاة فخر ويقين أخلاقي لدى الليبراليين من دعاة التعددية الثقافية من أمثال الأخ الذي حاورني على البي بي سي. لا حقوق لمثلييّ الجنس بالنسبة لكم أيها المسلمون، لأن مصطلحات «مثلي» و«حقوق» دخيلة على هويتكم!
الحجاب ونقيضه
أنا اليوم في الرابعة والخمسين من عمري، وقد شهدتُ صعود وتفاقم ظاهرة الصحوة الإسلامية بين أبناء جيلي، لذا اسمحوا لي أن أستطردَ قليلاً لأعرضَ عليكم ما شهدتُه كامرأة من السيرورات الاجتماعية التي أطلقتها «الصحوة الإسلامية».
لكن مهلاً! لن أروي لكم أية مأساة، فلا تتوقعوا حكاية عن قطع أو جلد أو رجم، ولا حكاية تستدرّ عطفكم على امرأة «شرقية» أو تستفيض في «العنف» الذي يجرح مشاعركم الليبرالية. كان كل ما حدث «طوعياً» – كما تحب النسويات المسلمات الشابات أن يؤكّدن اليوم، ووراءهن فيالق الموجة النسوية الثالثة! كان كل شيء «طوعياً» على طريقة الأخت الفاضلة صبا محمود.
نساء جيلي عاصرنَ صعود ثم نفوذ ثم هيمنة ما سأسميه «حاكمية المرأة المسلمة». هذه المرأة «المسلمة» ظهرت بيننا، في العائلة والمدرسة والعمل والحارة. كانت مثلنا، ثم في ليلة وضحاها لم تعد مثلنا. «ابتعدت عنا» (عاطفياً أو مجتمعياً أو عاطفياً ومجتمعياً) لأن هناك إلهاً هداها وألهمها أن تُسلِم نفسها إليه. قال لها تحجبي فتحجبت؛ غطت شعرها، سحبت الأكمام إلى معصميها، وأرخت التنورة إلى كاحليها. ثم راحت تَعِدُنا بحسناته إذا تحجبنا نحن أيضاً، قبل أن تهددنا بنقمته وغضبه وزبانيته إن نحن تجاهلناها وعصيناه. عذاب القبر هو مجرد بداية العقاب الإلهي الطويل الذي سيحيق بنا، ستزحف الديدان والثعابين على جلدنا المكشوف الذي رفض الحجاب، ثم…
شهد جيلي انتصارات كاسحة حققتها هذه «المرأة المسلمة». نجتمع مع صديقاتنا لنحتفل بعيد ميلاد إحداهن، وإذ بواحدة تدخل علينا محجبة! نذهب للدراسة أو للعمل، وإذ بزميلة لنا تبادرنا وقد تغير شكل رأسها تماماً! نذهب إلى زيارة عائلية، وإذ بابنة عم أو ابنة خال تزهو بحجابها الطازج.
ومع انتصار وهيمنة حاكمية هذه المرأة، صار سفورنا يُعرَّفُ بأنه لا-حجاب، وتلاحقت الألقاب تنعت مرتديات اللاحجاب بالمتغرّبات، ثم الكافرات، ثم العاهرات الفاسقات اللواتي ينشدن فتنة الرجال. وما إن أصبح الحجاب زي الأغلبية الساحقة حتى أصبح اللاحجاب دليلاً على المسيحية، فحتى البغايا صرن يرتدين الحجاب.
يا له من إنجاز باهر! يا لها من شهادة على نجاح «الصحوة» كمشروع حاكمية اجتماعية: عندما أصبح ما نرتديه نحن يعرّف اجتماعياً على أنه لا-حجاب، وهامشيته تحولت إلى دلالة على مسيحية اللامحجبة، وقتها فقط وجد دالّ «المرأة المسلمة» مدلوله. ما أريد قوله، باختصار، أنه لا يمكن أن يشيع مصطلح كـ «المرأة المسلمة» دون أن يرافقه مشروع اجتماعي يخلق مدلولاً يتناسب توصيفه مع الدالّ: «امرأة مسلمة».
كان ذلك فظيعاً للغاية، ولا سيما بالنسبة للمسيحيات اللواتي وقعت عليهن المصيبة مزدوجة. فمع تنامي الصحوة الإسلامية صارت المسيحية مسيحيةً مرتين: مرةً كفرد في طائفة تسمى «المسيحيين» (والتي سيُهرع الإسلامويون ليؤكدوا أن «لديها حقوقها هي أيضاً»، مستبدلين المواطنة السياسية بالانتماء الطائفي)، ومرةً باعتبارها تلك الكائنة التي ترتدي مسيحيتها –لاحجابها– على رأسها وتعلن على الملأ حيثما ذهبت: «أنا مسيحية»!
ليست المسألة أننا لم نكن مسلمات قبل وصول هذا الحجاب وقدوم هؤلاء «المسلمات» إلينا. كنا محتشمات في سفورنا، وقد عشنا حياتنا (بما في ذلك علاقاتنا مع الرجال كأصدقاء أو زملاء أو شركاء رومنسيين) كما يتوقع المرء من النساء في مجتمع محافظ. كان ثمة طبعاً مجال للمناورة والتأويل واللهو والتمرد السري، لكن الخطاب حول أجساد النساء ولباسهن وحياتهن الجنسية كان وما يزال محافظاً إلى أقصى حد. حاولتُ أن أشرح آليات عمل تلك الأعراف وآليات مقاومتها في مقال لي عن جرائم الشرف، لذا لن أخجل منكم: تفضلوا.
لقد جاءت «الصحوة» وجعلت من أجسادنا بؤرة لصراع الهوية، وذلك بعد أن ردّدت على مسامعنا أن ملابسنا ليست إسلامية. كان موسماً مفتوحاً للنيل من أجسادنا، والتي أصبحت مركز جدل عام يدور حول ما يليق وما لا يليق بنا أن نرتديه. هذا الجدل يخوضه رجال مسلمون «ولدوا من جديد» وتحولوا إلى مرجعيات واجبة الطاعة، سواء في العائلة أو في المدرسة أو في أماكن العمل، بل حتى من أعلى المآذن. بل صرنا نتعرض حتى لتأديب الشارع، فقد وضعَ التحرشُ هيمنة العقيدة الإسلاموية موضع التنفيذ. صرنا نمشي على غير هدى، وصرنا نخاف من منظرنا أمام الناس. سحبنا الأكمام إلى المعصمين، والتنانير إلى الكاحلين، والصدر غطيناه حتى الرقبة، وقمنا بمحاكاة الحجاب دون أن نكون محجبات. اشتغلت الحاكمية الاجتماعية على سطح جلدنا الخارجي وفي عمق جهازنا العصبي. أذكرُ كل ذلك كلما عدتُ إلى الأردن، ورأيت محجبات في عائلتي يُهرَعن إلى الإمساك بالأوشحة ليغطين رؤوسهن كلما سمعن صوت رجل «غريب» على الباب.
لقد تحولت الحاكمية الاجتماعية إلى حاكمية ذاتية.
من العيب إلى الحرام
يمكن تبسيط ذلك بمراقبة النقلة اللغوية ضمن العائلة: من «العيب» أيام كنا مجرد مجتمع مسلم محافظ، إلى «الحرام» بعد أن تحولنا إلى مجتمع هومو إسلاميكوس. في الحالة الأولى، كنا نفاوضُ أمهاتنا حول ملابسنا، وكنَ يُحذّرننا من «كلام الجيران» الذين قد ينتبهون إلى أننا نتجاوز الأصول. «إيش رح يقولوا الجيران إذا شافوكي هيك؟» هذا ما كان لأمهاتنا الغاضبات أن يخبرننا به حين يَرَين تنانيرنا أقصر من المعتاد. كنا نحاجج ونترجى، نشرح ونتفاوض، نفوز أحياناً فنخرج من المنزل يغمرنا شعور بالانتصار والجاذبية، ونخسر أحياناً أخرى فنعود إلى غرفتنا تملؤنا الخيبة والغضب، متململين من التخلف الفظيع الذي نعانيه مع أهلنا!
لكن في عالم «الحرام»، تصبح فساتيننا موضع نقاش عام يتجاوز «الجيران». في عالم الحرام، نحن حديث الشارع والإذاعة والتلفزيون والمئذنة، مضطرات للتفاوض مع أخينا (أو جارنا، أو صاحب المتجر، أو سائق التاكسي) المسلم الذي ولد من جديد، والذي سيأمرنا من الآن فصاعداً باسم كتاب منزّل. مع هيمنة الخطاب الإسلاموي دخلت ملابسنا عالماً جديداً، تسود فيه «الشريعة» ويشترط أن يكون كل شيء فيه «شرعياً» لكي نبقى في نطاق الحلال – كما يحب الإسلامويون أن يقولوا. في عالم الحرام لا بد من إخضاعنا للاختبار الإلهي حول ما يجوز وما لا يجوز كشفه، كم من اليدين، كم من القدمين، كم يضيق الثوب، كم لوناً فيه… لم يعد الجيران هم من يراقبوننا، بل عيون الله من عليائها – ليس الله الغفور الرحيم بطبيعة الحال، بل الشديد العقاب. كأن ملابسنا انتقلت من اختبار أمّنا «المنطقي بشكل عام» لتخضع لاختبار «وسيط» أو حتى «تدقيق صارم» من أخينا المتدين.
إلى أين أذهب بكل هذا الكلام، ربما تتساءلون، وما علاقة كل هذا بالازدراع القانوني؟
حسناً، لعلّي أشبّه الازدراع بلباسنا ما قبل الحجاب، أيام كنا مسلمين فحسب، أي قبل أن يحوله الإسلاميون إلى بؤرة توتر هوياتي يسري في كامل الجسد الاجتماعي. ومثل لباسنا قبل الحجاب، كان «القانون الوضعي» (كما يحب الإسلامويون أن يسموه باستخفاف) قانوناً مسلماً بما فيه الكفاية، مسلماً إلى حد ما، مسلماً بطريقة لا تثير أي انتباه أو اهتمام محموم، كان مسلماً بشكل تلقائي. كان، مثل لباسنا، مسلماً فحسب. بالتأكيد كان يحتوي على مشكلات أخرى، لكنها لن تحلّ بتدقيق إسلاموي صارم في هويتنا.
تبيّنَ في واقع الأمر أن هذا الانشغال بالهوية هو إلهاءٌ باهظ الثمن، وهو من طينة الإلهاءات التي يستعملها اليمين الأميركي: تأطير مشاكل المجتمع بمنطق التهديد الذي يشكله الآخرون، ثم تصور حالة من التناغم العضوي يحكى أن المجتمع كان عليها قبل أن يأتي المهاجرون، قبل أن تظهر النسويات، قبل أن ينتشر السود (إلخ) ويخرّبوا كل شيء. بالنسبة للإسلامويين كان هناك مجتمع متناغم، ثم جاءت الدولة الحديثة بقانونها العلماني وخرّبت كل شيء.
العصر الذهبي لدراسة القانون الإسلامي
الملاحظ أن هذا المشروع الإسلاموي، المتمثل بإخضاع المدونة القانونية «الأوروبية» لاختبار الإسلاميّة، شهدَ عصراً ذهبياً –وجيزاً– مع صعود الدستوريّة في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي. أصبحت المحاكم الدستورية في العالم العربي، كغيرها في بلاد أخرى، أكثر انفتاحاً على فكرة المراجعة القضائية للتشريع (لأسباب معقدة لن أخوض فيها). انتعشت فجأة المواد الدستورية الصامتة مثل «الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع»، وأصبحت ممارسات المراجعة القضائية خبراً ساخناً في كل مكان. جرت مراجعة قضائية لجميع أنواع التشريعات، بما في ذلك تلك التي لا تعتبر «إسلامية بما يكفي» بتأثير من ضغوط مرافعين إسلامويين أمام المحاكم الدستورية.
شاركَ في التعليق على هذه الظاهرة باحثو القانون الإسلامي في الأوساط الأكاديمية الأميركية، والذين راحوا يمدّون يد العون للمحتجين دستورياً. عاد البعض إلى كتب الفقهاء المسلمين، نفضوا الغبار عن بعض المصطلحات القديمة واستخدموها للتعبير عن الدستورية بلغة إسلامية، آمِلين في التأثير على طريقة مقاربة القضاة المسلمين فحسب لمهمتهم – كأن القضاة كانوا تائهين وينتظرون ذلك الفرج من السماء. عرض البعض صياغات لاختبار الإسلامية بطريقة «معيارية»، بدلاً من تلك «العقائدية» الصارمة، في حين رأى آخرون في الدستورية الباب الأمثل لـ «الشريعة الإسلامية» لكي تتسلّل وتقضم القانون الوضعي الغريب ثقافياً، في انقلاب صامت أو هجوم خلفي، بحيث يتقدم قانون الفقهاء حكماً بعد حكم ليعود إلى وضع «القانون الطبيعي» (محمد فضل). كما تمت الإشادة بالقضاة الذين يُجرون مراجعات القضائية بطرق «معقولة إسلامياً»، في طمأنة لقراء غربيين أن الدستورية بطريقة «معقولة إسلامياً» هي عين المطلوب في العالم العربي، وأن هناك قضاة جاهزين يمكنهم بالفعل القيام بذلك.
لكن لم يخلُ هذا المشروع من مؤرّقات، فقد برع المتقاضون الإسلامويون في مهاجمة الإصلاح التشريعي ما إن يمسّ النساء أو الأقليات الدينية أو حرية التعبير. من هنا بدأ الباحث الليبرالي يحاول فتح الباب بحذر مع التصدي لأية شرائع قد تسيء لسمعة المشروع القانوني الإسلامي. وفي حين دأب الباحثون ذوو الحساسيات الليبرالية على البحث عن عقيدة إسلامية «مرجعية لكن غير استبدادية» (خالد أبو الفضل)، رفض آخرون الموقف الدفاعي تماماً ولجأوا، بالعكس، إلى الهجوم المضاد القائم على «الفروقات الثقافية». وفقاً لهذا الموقف، يمكن تفنيد كل ما قد يبدو مسيئاً للحساسية الإنسانوية الليبرالية باتهام هذه الأخيرة بسوء فهم «الاختلاف» (صبا محمود). بعبارة، ذهب هؤلاء إلى عرين النسبوية المعرفية.
إن كنتَ أكاديمياً متخصصاً بالقانون الإسلامي في الولايات المتحدة منذ حوالي عقدين، لا شكَّ أنكَ عشتَ أياماً رائعةً حتى وقت قريب. لقد أشعرتكَ المراجعات القضائية في المحاكم الدستورية ومبدأ الشريعة كمصدر وحيد للتشريع بأهمية عملك. الساعات الطويلة التي قضيتها لوحدك تفكّ طلاسم رجال سُمر ماتوا في القرن العاشر وكلامهم حول تعدد مستويات المشروعية الدينية، في محاولة منك لإسقاطه على حدث معاصر، أصبحت تؤتي أكلها أخيراً. من جهتها أغدقت دول الخليج النفطية كثيراً من المال، على شكل تبرعات، لتأسيس برامج متخصصة بالشريعة الإسلامية في جامعات النخبة في الولايات المتحدة، مما رفع من قيمة أعمالك البحثية. بدأت كتاباتك تعمّ المؤتمرات والندوات التي تموّلها تلك البرامج. كتاباتك مثيرة. الطلب يزداد عليك.
يا له من أمر ملائم! تلك المكانة المرموقة ضمن الأكاديميا القانونية الأميركية التي اعتليتها بعد سقوط جدار برلين كانت ضربة حظ مبهجة للغاية. لقد ركِبَتْ نصوصك وسائط نقل تجوب العالم وترتفع بك أكثر فأكثر، ولا سيما بعد وصولها إلى العالم «المسلم». حصلت على آفاق واسعة للشهرة، ولا سيما في ظل انهيار المؤسسات الأكاديمية في ذلك الجزء من العالم، فهي منهكة بعد عقود من الفشل التنموي ومجمل إنتاجها البحثي عاجز عن المنافسة – إنه أقل قيمة، إما من الناحية الموضوعية أو بسبب الحيثية العالمية التي تتبوأها حضرتك. لم تكن بحاجة إلى الاطلاع على شغلهم، أما هم فلم يكن بإمكانهم ألا يسمعوا بك مع مرور الوقت.
ولا ننس أنك استفدت من نظريات القانون الأميركي واستخدمتها في مشروع قانونك الإسلامي الإحيائي، فأضفى عليك كل ذلك هالة من الحنكة والتفرّد والابتكار، فقد حولتَ الشريعة الإسلامية، وهو موضوع مملّ للغاية بالنسبة لما لا يحصى من طلاب القانون في العالم العربي/الإسلامي، إلى موضوع مثير، إلى نشاط فكري. ثم مع صعود الإسلامويين، راحت دراساتك تُطمئن الشباب المسلم الذي ولد من جديد أنه يستطيع أن يكون مسلماً وبعمق فلسفي في الوقت ذاته؛ ما عليه إلا أن يقرأ لك. لقد كنت الفقيه «المسلم» الذي لم يكونوا يعرفونه بكل أسف.
الربيع العربي
ومع اندلاع الربيع العربي وتزايد حظوظ الإخوان المسلمين في مصر، وتحديداً بعد إقرار الدستور الإسلاموي عام 2012، مرَّت عليكَ لحظةٌ شعرتَ فيها أنك الفقيه الذي يترقبه الجميع. ها هو ذا الدستور المفصّل بالحرف لكي يعطي لأبحاثك مكانة استشارية؛ لا شك أنها مسألة وقت قبل أن تتلقى مكالمة هاتفية تعيّنك قاضي الإخوان المعتمد في المحكمة الدستورية العليا في مصر.
لكن يا حسرة! سقط كل شيء بعد التظاهرات الحاشدة في تموز/يوليو 2013، وبعد سقوط الإخوان المدوّي. في اللحظة التي بدا فيها أن المسلم والهومو إسلاميكوس قد أصبحا شيئاً واحداً (يبدو أن الانتخابات بعد سقوط مبارك كانت مبشّرة للغاية)؛ في اللحظة التي كان فيها العالم يترقب شريعة إسلامية «مرجعية لكن غير استبدادية»؛ فجأة اندفعت الجماهير المصرية بمئات الآلاف لتشجب حكم الإسلامويين ونهجهم. «كانوا عاملين زي طايفة»؛ «فاكرين انهم هم اللي عارفين كل حاجة واحنا الغلابة اللي عايزين هداية»؛ «مكنوش مهتمين غير ف مصلحتهم»…
يا لطيف!
تبدى أن «المرجعية» و«الاستبدادية» تماهيا في تجربة الناس تحت إسلامك الذي يريد إصلاح إسلامهم. لقد نزلوا إلى الشوارع يطالبون أن يعودوا مسلمين فحسب.
والآن ماذا ستفعل؟ داعش على كل لسان في نشرات الأخبار؛ حرب دولية تشن ضدهم، وضدهم وحدهم. إنهم يذكرون الله وشريعته أثناء ذبح ضحاياهم. «هل هذا إسلامي؟» يتكرر ويتكرر السؤال من حولك. روحكَ تتمزق وأنتَ تشرحُ لهم أن هذا ليس «الإسلام الذي تعترفُ به». تشعرُ بالإحباط. تدركُ أن أيام المجد انتهت، وأنها مرت كأنها أيام معدودة. تعود وتفسر لكل من يسألك: إنها الوهابية؛ فرقة تكفيرية متطرفة ذات تمويل سعودي؛ لقد أخطأت مصر حين أطاحت بالإخوان بالقوة؛ لقد حذّرناكم من أن العنف لن يؤدي إلا إلى عنف، أنه بالنتيجة يقوّي الفئات المتطرّفة… ثم لا تلبث أن تعود إلى السيمفونية القديمة: لقد تاه المسلمون في فلك العلمانية الحديثة الفاسدة؛ لقد تشوّشت أخلاقهم؛ إنهم عاجزون عن تمييز الحق من الباطل… وما إن يأتي ذكر الإرهاب المترعرع في أحضان الغرب حتى تلهج بالقول إن الإسلاموفوبيا تولّدُ العنف.
يتصل بك صحفي ويسألك: هل من الإسلام أن يرفض طفل يبلغ من العمر 14 عاماً مصافحة معلمته، كما هي العادة في المدارس السويسرية؟ وهل ذلك المرسوم السويسري القاضي بتغريم أي طالب يرفض مصافحة معلمته ضربٌ من الإسلاموفوبيا؟ تتملككَ الرغبة برشق هاتفك عرض الحائط. لم تكن تمانع أن تلعب دور المفتي قبل ذلك، لكن لم يكن هذا الدور بالضبط ما كنت تتمناه. يسرحُ فكركَ أكثر… لقد وعدتَ نفسكَ أن تكون قاضياً في المحكمة العليا في مصر، وها أنت ذا تشتغل «ع الطلب» لتقديم فتاوى استثناء للأقليات المسلمة في الغرب، بينما تنأى بنفسك عن أية أسئلة تتعلق بداعش والعنف الإسلامي.
ختاماً
حسناً… كل ما أحاول أن أقوله هو: مشروع الشريعة الإسلامية الذي لقي احتفاءً هائلاً في الأوساط الأكاديمية الأميركية قد وصل الآن إلى طريق مسدود. دعاته الذين كانوا يترقبون تحولات في العالم الإسلامي تسمح بأسلمة القانون يقفون اليوم موقفاً دفاعياً، فهم إما مشغولون بتفسير العنف الإسلاموي المتفجر بشكل شبه يومي، أو يقومون بالوساطة الفكرية بين منظومة قانونية ليبرالية وأقلية دينية تطالب باستثناء إسلامي لها منه.
هذا كله مؤسف برأيي الشخصي. لقد حاز هذا المشروع على موارد فكرية ورمزية ومالية كان يمكن أن تذهب لدراسات أخرى. كان يمكن ضخها في مشاريع لاستقصاء النظام القانوني الوضعي في العالم العربي والإسلامي –والناجم عن الازدراع القانوني– ونقد السكون والتراجع الفقهي التي يعتريه. لقد توافرت جميع الشروط اللازمة لذلك إذ تنامت بالفعل ثورة حقوقية منذ التسعينيات توّجها الربيع العربي: شباب يؤمنون بحرياتهم وحقوقهم اندفعوا وقادوا الجماهير الغفيرة للإطاحة بمبارك، ثم بالاندفاع نفسه جابهوا المحاكم بقضاياهم. قرأوا دستورهم بتمعّن ودافعوا عن حقوقهم فيه بينما كان يجري هدر موارد هائلة على «دراسات الشريعة الإسلامية»، والتي تستثني المسلمين من علم القانون المقارن. كان يمكن لهذه الموارد أن تقدم سنداً نظرياً للحراك الحقوقي الذي كان يختمر على الجانب الآخر من العالم، ولا سيما أن النظرية القانونية الأميركية هي الأكثر إبداعاً وتطوراً في العالم. ربما لو حدث ذلك لكنّا في عالم مختلف اليوم.
يبدو أن انتباهنا كأساتذة قانون تشتّت في حوار طويل وفارغ حول الهوية والاختلاف، في حين كان علينا جميعاً الخوض في حديث عن الحقوق والحريات.